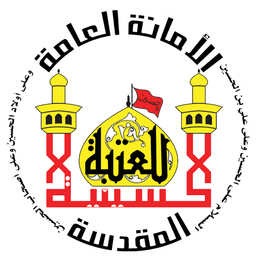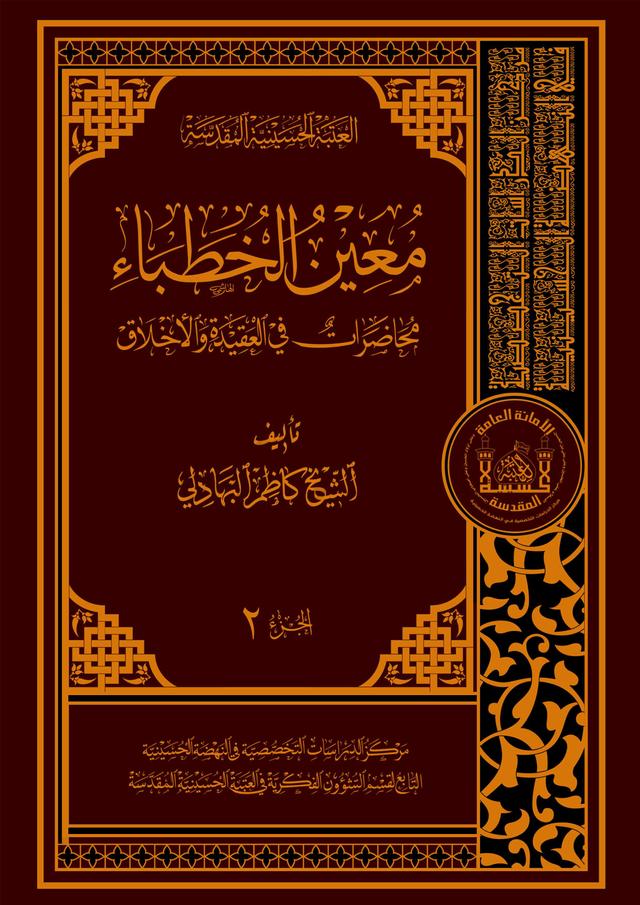بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين.
إنّ العلم والمعرفة مصدر الإشعاع الذي يهدي الإنسان إلى الطريق القويم، ومن خلالهما يمكنه أن يصل إلى غايته الحقيقيّة وسعادته الأبديّة المنشودة، فبهما يتميّز الحقّ من الباطل، وبهما تُحدّد خيارات الإنسان الصحيحة، وفي ضوئهما يسير في سبل الهداية وطريق الرشاد الذي خُلق من أجله، بل على أساس العلم والمعرفة فضّله الله على سائر المخلوقات، واحتجّ عليهم بقوله: (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)[1]، فبالعلم يرتقي المرء وبالجهل يتسافل، كما بالعلم والمعرفة تتفاوت مقامات البشر، ويتفوّق بعضهم على بعض عند الله إذ (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)[2]، وبهما تُسعد المجتمعات، وبهما الإعمار والازدهار، وبهما الخير كلّ الخير.
ومن أجل العلم والمعرفة كانت التضحيات الكبيرة التي قدّمها الأنبياء والأئمّة والأولياء^، تضحيات جسام كان هدفها منع الجهل والظلام والانحراف، تضحيات كانت غايتها إيصال المجتمع الإنساني إلى مبتغاه وهدفه، إلى كماله، إلى حيث يجب أن يصل ويكون، فكان العلم والمعرفة هدف الأنبياء المنشود لمجتمعاتهم، وتوسّلوا إلى الله} بغية إرسال الرسل التي تعلّم المجتمعات فقالوا: (وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)[3]، فكانت الإجابة: (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)[4]، ما يعني أنّ دون العلم والمعرفة هو الضلال المبين والخسران العظيم.
بل هو دعاء الأئمّة^ ومبتغاهم من الله لأنفسهم أيضاً، إذ طلبوا منه تعالى بقولهم: «وَاملأ قُلُوبَنا بِالْعِلْمِ وَالمَعْرفَةِ»[5].
وبالعلم والمعرفة لا بدّ أن تُثمّن تلك التضحيات، وتُقدّس تلك الشخصيّات التي ضحّت بكلّ شيء من أجل الحقّ والحقيقة، من أجل أن نكون على علم وبصيرة، من أجل أن يصل إلينا النور الإلهي، من أجل أن لا يسود الجهل والظلام.
فهذه سيرة الأنبياء والأئمّة^ سيرة الجهاد والنضال والتضحية والإيثار؛ لأجل نشـر العلم والمعرفة في مجتمعاتهم، تلك السيرة الحافلة بالعلم والمعرفة في كلّ جانب من جوانبها، والتي ينهل منها علماؤنا في التصدّي لحلّ مشاكل مجتمعاتهم على مرّ العصور والأزمنة والأمكنة، وفي كافّة المجالات وشؤون البشر.
وهذه القاعدة التي أسّسنا لها لا يُستثنى منها أيّ نبيّ أو وصيّ، فلكلّ منهم^ سيرته العطرة التي ينهل منها البشر للهداية والصلاح، إلّا أنّه يتفاوت الأمر بين أفرادهم من حيث الشدّة والضعف، وهو أمر عائد إلى المهام التي أُنيطت بهم^، كما أخبر} بذلك في قوله: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ)[6]، فسيرة النبي الأكرم’ ليست كبقيّة سِيَر الأنبياء^، كما أنّ سيرة الأئمّة^ ليست كبقيّة سِيَر الأوصياء السابقين^، كما أنّ التفاوت في سِيَر الأئمّة^ فيما بينهم ممّا لا شكّ فيه، كما في تفضيل أصحاب الكساء على بقيّة الأئمّة^.
والإمام الحسين× تلك الشخصيّة القمّة في العلم والمعرفة والجهاد والتضحية والإيثار، أحد أصحاب الكساء الخمسة الذين دلّت النصوص على فضلهم ومنزلتهم على سائر المخلوقات، الإمام الحسين× الذي قدّم كلّ شيء من أجل بقاء النور الربّاني، الذي يأبى الله أن ينطفئ، الإمام الحسين× الذي بتضحيته تعلّمنا وعرفنا، فبقينا.
فمن سيرة هذه الشخصيّة العظيمة التي ملأت أركان الوجود، تعلّم الإنسان القيم المثلى التي بها حياته الكريمة، كالإباء والتحمّل والصبر في سبيل الوقوف بوجه الظلم، وغيرها من القيم المعرفيّة والعمليّة، التي كرَّس علماؤنا الأعلام جهودهم وأفنوا أعمارهم من أجل إيصالها إلى مجتمعات كانت ولا زالت بأمسّ الحاجة إلى هذه القيم، وتلك الجهود التي بُذلت من قِبَل الأعلام جديرة بالثناء والتقدير؛ إذ بذلوا ما بوسعهم، وأفنوا أغلى أوقاتهم، وزهرة أعمارهم؛ لأجل هذا الهدف النبيل.
إلّا أنّ هذا لا يعني سدّ أبواب البحث والتنقيب في الكنوز المعرفيّة التي تركها× للأجيال اللاحقة ـ فضلاً عن الجوانب المعرفيّة في حياة سائر المعصومين^ ـ إذ بقي منها من الجوانب ما لم يُسلّط الضوء عليه بالمقدار المطلوب، وهي ليست بالقليل، بل لا نجانب الحقيقة فيما لو قلنا: هي أكثر ممّا تناولته أقلام علمائنا بكثير، فلا بدّ لها أن تُعرَف لتُعرَّف، بل لا بدّ من العمل على البحث فيها ودراستها من زوايا متعدّدة، لتكون منهجاً للحياة، وهذا ما يزيد من مسؤوليّة المهتمّين بالشأن الديني، ويحتّم عليهم تحمّل أعباء التصدّي لهذه المهمّة الجسيمة؛ استكمالاً للجهود المباركة التي قدّمها علماء الدين ومراجع الطائفة الحقّة.
ومن هذا المنطلق بادرت الأمانة العامّة للعتبة الحسينيّة المقدّسة لتخصيص سهم وافر من جهودها ومشاريعها الفكريّة والعلميّة حول شخصيّة الإمام الحسين× ونهضته المباركة؛ إذ إنّها المعنيّة بالدرجة الأولى وبالأساس بمسك هذا الملف التخصّصي، فعمدت إلى زرع بذرة ضمن أروقتها القدسيّة، فكانت نتيجة هذه البذرة المباركة إنشاء مؤسّسة وارث الأنبياء للدراسات التخصّصيّة في النهضة الحسينيّة، التابعة للعتبة الحسينيّة المقدّسة، حيث أخذت على عاتقها مهمّة تسليط الضوء ـ بالبحث والتحقيق العلميّين ـ على شخصيّة الإمام الحسين×، ونهضته المباركة، وسيرته العطرة، وكلماته الهادية، وفق خطّة مبرمجة، وآليّة متقنة، تمّت دراستها وعرضها على المختصّين في هذا الشأن؛ ليتمّ اعتمادها والعمل عليها ضمن مجموعة من المشاريع العلميّة التخصّصيّة، فكان كلّ مشروع من تلك المشاريع متكفِّلاً بجانب من الجوانب المهمّة في النهضة الحسينيّة المقدّسة.
كما ليس لنا أن ندّعي ـ ولم يدّعِ غيرنا من قبل ـ الإلمام والإحاطة بتمام جوانب شخصيّة الإمام العظيم ونهضته المباركة، إلّا أنّنا قد أخذنا على أنفسنا بذل قصارى جهدنا، وتقديم ما بوسعنا من إمكانات في سبيل خدمة سيّد الشهداء×، وإيصال أهدافه السامية إلى الأجيال اللاحقة.
المشاريع العلميّة في المؤسّسة
بعد الدراسة المتواصلة التي قامت بها مؤسّسة وارث الأنبياء حول المشاريع العلميّة في المجال الحسيني، تمّ تحديد مجموعة كبيرة من المشاريع التي لم يُسلَّط الضوء عليها كما يُراد لها، وهي مشاريع كثيرة وكبيرة في نفس الوقت، ولكلٍّ منها أهميّته القصوى، ووفقاً لجدول الأولويّات المعتمد في المؤسّسة تمّ اختيار المشاريع العلميّة الأكثر أهميّة، والتي يُعتبر العمل عليها إسهاماً في تحقيق نقلة نوعيّة للتراث والفكر الحسيني، وهذه المشاريع هي:
الأوّل: قسم التأليف والتحقيق
إنّ العمل في هذا القسم على مستويين:
أ ـ التأليف
ويُعنَى هذا القسم بالكتابة في العناوين الحسينيّة التي لم يتمّ تناولها بالبحث والتنقيب، أو التي لم تُعطَ حقّها من ذلك. كما يتمُّ استقبال النتاجات القيِّمة التي أُلِّفت من قبل العلماء والباحثين في هذا القسم؛ ليتمَّ إخضاعها للتحكيم العلمي، وبعد إبداء الملاحظات العلميّة وإجراء التعديلات اللازمة بالتوافق مع مؤلِّفيها، يتمّ طباعتها ونشرها.
ب ـ التحقيق
والعمل فيه قائم على جمع وتحقيق وتنظيم التراث الحسيني، وقد تمّ العمل على نحوين:
الأوّل: التحقيق في المقاتل الحسينيّة، ويشمل جميع الكتب في هذا المجال، سواء التي كانت بكتابٍ مستقلٍّ أو ضمن كتاب، وذلك تحت عنوان: (موسوعة المقاتل الحسينيّة). وكذا العمل جارٍ في هذا القسم على رصد المخطوطات الحسينيّة التي لم تُطبع إلى الآن؛ وقد قمنا بجمع عدد كبير من المخطوطات القيّمة، التي لم يطبع كثير منها، ولم يصل إلى أيدي القرّاء إلى الآن.
الثاني: استقبال الكتب التي تمّ تحقيقها خارج المؤسّسة، لغرض طباعتها ونشرها بعد إخضاعها للتقويم العلمي من قبل اللجنة العلميّة في المؤسّسة، وبعد إدخال التعديلات اللازمة عليها، وتأييد صلاحيتها للنشر، تقوم المؤسّسة بطباعتها.
الثاني: قسم مجلّة الإصلاح الحسيني
وهي مجلّة فصليّة متخصّصة في النهضة الحسينيّة، تهتمّ بنشـر معالم وآفاق الفكر الحسيني، وتسلِّط الضوء على تاريخ النهضة الحسينيّة وتراثها، وكذلك إبراز الجوانب الإنسانيّة والاجتماعيّة والفقهيّة والأدبيّة في تلك النهضة المباركة، وقد قطعت شوطاً كبيراً في مجالها، واحتلّت الصدارة بين المجلّات العلميّة الرصينة في مجالها، وأسهمت في إثراء واقعنا الفكري بالبحوث العلميّة الرصينة.
الثالث: قسم ردّ الشُّبُهات عن النهضة الحسينيّة
إنّ العمل في هذا القسم قائم على جمع الشُّبُهات المثارة حول الإمام الحسين× ونهضته المباركة، وذلك من خلال تتبّع مظانّ تلك الشُّبُهات من كتب قديمة أو حديثة، ومقالات وبحوث وندوات وبرامج تلفزيونيّة، وما إلى ذلك، ثُمَّ يتمُّ فرزها وتبويبها وعنونتها ضمن جدول موضوعي، ثمّ يتمُّ الردُّ عليها بأُسلوب علمي تحقيقي في عدَّة مستويات.
الرابع: قسم الموسوعة العلميّة من كلمات الإمام الحسين×
وهي موسوعة علميّة تخصّصيّة مستخرَجة من كلمات الإمام الحسين× في مختلف العلوم وفروع المعرفة، ويكون العمل فيها من خلال جمع كلمات الإمام الحسين× من المصادر المعتبرة، ثمّ تبويبها حسب التخصّصات العلميّة، والعمل على دراسة هذه الكلمات المباركة؛ لاستخراج نظريّات علميّة تمازج بين كلمات الإمام× والواقع العلمي. وقد تمّ العمل فيه على تأليف موسوعتين في آن واحد باللغتين العربيّة والفارسيّة.
الخامس: قسم دائرة المعارف الحسينيّة الألفبائيّة
وهي موسوعة تشتمل على كلّ ما يرتبط بالإمام الحسين× ونهضته المباركة من أحداث، ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، وأعلام، وبلدان، وأماكن، وكتب، وغير ذلك، مرتّبة حسب الحروف الألفبائيّة، كما هو معمول به في دوائر المعارف والموسوعات، وعلى شكل مقالات علميّة رصينة، تُراعَى فيها كلّ شروط المقالة العلميّة، مكتوبة بلغةٍ عصـريّة وأُسلوبٍ حديث، وقد أُحصي آلاف المداخل، يقوم الكادر العلمي في هذا القسم بالكتابة عنها، أو وضعها بين يدي الكُتّاب والباحثين حسب تخصّصاتهم؛ ليقوموا بالكتابة عنها وإدراجها في الموسوعة بعد تقييمها وإجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل اللجنة العلميّة.
السادس: قسم الرسائل والأطاريح الجامعيّة
يتمّ العمل في هذا القسم على مستويين: الأوّل: إحصاء الرسائل والأطاريح الجامعيّة التي كُتبتْ حول النهضة الحسينيّة، ومتابعتها من قبل لجنة علميّة متخصّصة؛ لرفع النواقص العلميّة وإدخال التعديلات أو الإضافات المناسبة، وتهيئتها للطباعة والنشر. الثاني: إعداد موضوعات حسينيّة ـ يضمّ العنوان وخطّة بحث تفصيليّة ـ من قبل اللجنة العلميّة في هذا القسم، تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعيّة، وتوضع في متناول طلّاب الدراسات العليا.
السابع: قسم الترجمة
الهدف من إنشاء هذا القسم إثراء الساحة العلميّة بالتراث الحسيني عبر ترجمة ما كتب منه بلغات أخرى إلى اللغة العربيّة، ونقل ما كتب باللغة العربيّة إلى اللغات الأخرى، ويكون ذلك من خلال إقرار صلاحيّة النتاجات للترجمة، ثمَّ ترجمته أو الإشراف على ذلك إذا كانت الترجمة خارج القسم.
الثامن: قسم الرَّصَد والإحصاء
يتمُّ في هذا القسم رصد جميع القضايا الحسينيّة المطروحة في جميع الوسائل المتّبعة في نشر العلم والثقافة، كالفضائيّات، والمواقع الإلكترونيّة، والكتب، والمجلّات والنشريّات، وغيرها؛ ممّا يعطي رؤية واضحة حول أهمّ الأُمور المرتبطة بالقضيّة الحسينيّة بمختلف أبعادها، وهذا بدوره يكون مؤثّراً جدّاً في رسم السياسات العامّة للمؤسّسة، ورفد بقيّة الأقسام فيها، وكذا بقيّة المؤسّسات والمراكز العلميّة في شتّى المجالات. ويقوم هذا القسم بإصدار مجلّة شهريّة إخباريّة تسلّط الضوء على أبرز النشاطات والأحداث الحسينيّة محليّاً وعالميّاً في كلِّ شهر، بعنوان: مجلّة الراصد الحسيني.
التاسع: قسم المؤتمرات والندوات والملتقيات العلميّة
يعمل هذا القسم على إقامة مؤتمرات وملتقيات وندوات علميّة فكريّة متخصّصة في النهضة الحسينيّة، لغرض الإفادة من الأقلام الرائدة والإمكانات الواعدة، ليتمّ طرحها في جوٍّ علمي بمحضر الأساتذة والباحثين والمحقّقين من ذوي الاختصاص، وتتمّ دعوة العلماء والمفكِّرين؛ لطرح أفكارهم ورؤاهم القيِّمة على الكوادر العلميّة في المؤسّسة، وكذا سائر الباحثين والمحقّقين، وكلّ من لديه اهتمام بالشأن الحسيني، للاستفادة من طرق قراءتهم للنصوص الحسينيّة وفق الأدوات الاستنباطيّة المعتمَدة لديهم.
العاشر: قسم المكتبة الحسينيّة التخصّصيّة
يضمّ هذا القسم مكتبة حسينيّة تخصّصيّة تعمل على رفد القرّاء والباحثين في المجال الحسيني على مستويين:
أ ـ المكتبة الحسينيّة التخصّصيّة، والتي تجمع التراث الحسيني المخطوط والمطبوع، أنشأتها مؤسّسة وارث الأنبياء، وهي تجمع آلاف الكتب المهمّة في مجال تخصّصها.
ب ـ المجال الإلكتروني، إذ قامت المؤسّسة بإعداد مكتبة إلكترونيّة حسينيّة يصل العدد فيها إلى أكثر من ثمانية آلاف عنوان بين كتب ومجلّات وبحوث.
الحادي عشر: قسم الإعلام الحسيني
يتوزّع العمل في هذا القسم على عدّة جهات:
الأُولى: إطلاع العلماء والباحثين والقرّاء الكرام على نتاجات المؤسّسة وإصداراتها، ونشر أخبار نشاطات المؤسّسة وفعّاليّاتها بمختلف القنوات الإعلاميّة ووسائل التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع.
الثانية: إنشاء القنوات الإعلاميّة، والصفحات والمجموعات الإلكترونيّة في وسائل التواصل الاجتماعي كافّة.
الثالثة: العمل على إنتاج مقاطع مرئيّة في الموضوعات الحسينيّة المختلفة، مختصرة ومطوّلة، وبصورة حلقات مفردة ومتسلسلة، فرديّة وحواريّة.
الرابعة: إعداد وطباعة نصوص حسينيّة وملصقات إعلانيّة، ومنشورات حسينيّة علميّة وثقافيّة.
الخامسة: التواصل مع أكبر عدد ممكن من القنوات الإعلاميّة والصفحات والمجموعات الإلكترونيّة في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتزويدها بأنواع المعلومات من مقاطع مرئيّة ومنشورات وملصقات في الموضوعات الحسينيّة المختلفة الشاملة للتاريخ، والسيرة، والفقه، والأخلاق، وردّ الشبهات، والمفاهيم، والشخصيّات.
الثاني عشر: قسم الموقع الإلكتروني
وهو موقع إلكتروني متخصّص، يقوم بنشر إصدارات وفعّاليّات مؤسّسة وارث الأنبياء، وعرض كتبها ومجلّاتها، والترويج لنتاجات أقسامها ونشاطاتها، وعرض الندوات والمؤتمرات والملتقيات التي تقيمها، وكذا يسلِّط الضوء على أخبار المؤسّسة، ومجمل فعّاليّاتها العلميّة والإعلاميّة. بالإضافة إلى ترويج المعلومة الحسينيّة والثقافة العاشورائيّة عبر نشر المقالات المختلفة، وإنشاء المسابقات الحسينيّة، والإجابة عن التساؤلات والشبهات.
الثالث عشر: قسم إقامة الدورات وإعداد المناهج
يتكفّل هذا القسم بإعداد الدورات الحسينيّة في المباحث العقديّة والتاريخيّة والأخلاقيّة، ولمختلف الشرائح والمستويات العلميّة، وكذلك إقامة دورات تعليميّة ومنهجيّة في الخطابة الحسينيّة، كما يضطلع هذا القسم بمهمّة كبيرة، وهي إعداد مناهج حسينيّة تعليميّة وتثقيفيّة لمختلف الفئات وعلى عدّة مستويات:
الأوّل: إعداد مناهج تعليميّة للدراسات الجامعيّة الأوّليّة والدراسات العليا.
الثاني: إعداد مناهج تعليميّة في الخطابة الحسينيّة.
الثالث: إعداد مناهج تعليميّة عامّة لمختلف شرائح المجتمع.
الرابع: إعداد مناهج تثقيفيّة عامّة.
الرابع عشر: القسم النسوي
يعمل هذا القسم من خلال كادر علمي متخصّص وبأقلام علميّة نسويّة في الجانب الديني والأكاديمي على تفعيل دور المرأة المسلمة في الفكر الحسيني، ورفد أقسام المؤسّسة بالنتاجات النسويّة، كما يقوم بتأهيل الباحثات والكاتبات ضمن ورشات عمل تدريبيّة، وفق الأساليب المعاصرة في التأليف والكتابة.
الخامس عشر: القسم الفنّي
إنّ العمل في هذا القسم قائم على طباعة وإخراج النتاجات الحسينيّة التي تصدر عن المؤسّسة، من خلال برامج إلكترونيّة متطوِّرة، يُشرف عليها كادر فنّي متخصّص، يعمل على تصميم أغلفة الكتب والإصدارات، والملصقات الإعلانيّة، والمطويّات العلميّة والثقافيّة، وعمل واجهات الصفحات الإلكترونيّة، وبرمجة الإعلانات المرئيّة والمسموعة وغيرهما، وسائر الأمور الفنيّة الأخرى التي تحتاجها أقسام المؤسّسة كافّة.
وهناك مشاريع أُخرى سيتمّ العمل عليها إن شاء الله تعالى.
إنّ التأريخ لمقتل الإمام الحسين× يعتبر من الأعمال العلميّة والعقديّة المهمّة في التاريخ الإسلامي؛ وذلك لأنّ هذا النوع من التأليف والتصنيف يؤرّخ لحقبة زمنيّة خطيرة في العالم الإسلامي، وكان لها امتداد حاضر إلى يومنا، وهو امتداد طريق الخير والحقّ الذي كان يمثّله الإمام الحسين×، وطريق الباطل والانحراف الذي كان يمثّله يزيد بن معاوية والدولة الأمويّة.
والقيمة التأريخيّة للمقتل الحسيني ـ من جهة علميّة إثباتيّة ـ تعتمد على مجموعة من الأمور، من أهمّها قدم الكتاب وقربه من عصر الواقعة أو قربه من المصادر المعتمدة التي نقلت الواقعة ولكنّها لم تصل إلينا، ومنها: المنزلة العلميّة التخصصيّة للمؤلّف؛ فإنّ سعة الاطّلاع ودقّة المراجعة وكثرة المتابعة والخبرة في النصوص وممارسة التأليف ومعرفة الطرق والأسانيد كلّها عوامل مؤثّرة في شخصيّة المؤلّف للوقوف على وقائع المقتل بالشكل الصحيح والمناسب.
وقد احتوى هذا الكتاب (المصرع الشين في قتل الحسين×) على كلا العنصرين، فهو من مؤلّفات بدايات القرن السابع تقريباً، وذلك العصر كان حافلاً بالمصادر التي بدّدها التأريخ على مرّ القرون ولم تصل إلينا، كما أنّ مؤلّفه هو السيّد علي بن موسى المعروف بابن طاووس، وهو من كبار العلماء، ومن المتبحّرين والمكثرين في التأليف والتصنيف وجمع الأخبار ونقدها وتبويبها وتنظيمها، بالإضافة إلى تعدد تأليفاته في باب المقتل الحسيني.
نسخة الكتاب
إنّ النسخة التي اعتمدنا نصّها تعتبر الوحيدة لهذا الكتاب المهم، وقد كانت طيّ الكتمان والخفاء طيلة هذه القرون، وقد عثرنا عليها في بحثنا المكثّف عن المقاتل الحسينية لإدراجها ضمن موسوعة المقاتل الحسينية التي تعمل عليها المؤسسة والتي صدر منها عدّة أجزاء إلى الآن.
وقد قمنا بتحقيقه والتعليق عليه بما يناسب المقام وضوابط التحقيق في المؤسسة.
وفي الختام نتقدّم بالشكر لقسم التحقيق بالخصوص سماحة الشيخ حيدر البهادلي؛ لما بذلوه في مقابلة الكتاب ومراجعة متنه وتخريج نصوصه وتحقيقه وتقويمه.
نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا إنَّه سميعٌ مجيبٌ.
اللجنة العلمية في
مؤسسة وارث الأنبياء
للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد..
تُعَدّ دراسة وتحقيق المخطوطات من الدراسات الإنسانية المهمة التي تُعنى بالموروث الثقافي وتحقيقه؛ لإخراجه بصورة صحيحة ومتقنة، إذ إنّ كثيراً ما يتسبّب سقط حرف أو كلمة في قلب المعنى المراد إلى غيره، فهنا يجب على المحقّق أن يخرج الكتاب المخطوط إلى أيدي القرّاء بصورة الصحيحة شكلاً ومضموناً كما أرادها صاحب المخطوط.
ولا يخفى علينا أنّ واقعة الطف من الوقائع الخالدة في الإسلام، إذ تحتلّ مكانة واسعة وعميقة في ضمير كلّ إنسان مسلم، فكانت ولا زالت النهضة الحسينية بمجرياتها مدار كتابات الكثير من المؤرخين والباحثين، وإن اختلفت كتاباتهم باختلاف رؤيتهم لهذه القضية، والتي تُعدّ أهم قضايا التاريخ الإسلامي، بامتداد جذورها، كيف لا، وصاحبها سبط النبي الأعظم’ الذي قال فيه: «حسين منّي وأنا من حسين».
ومن هذا المنطلق ولأهمية تاريخ عاشوراء ارتأينا القيام بتحقيق مخطوط (المصرع الشين في قتل الحسين×) للسيد ابن طاووس (ت664هـ)؛ وذلك للكشف عن جوانب جديدة تفتح لنا مجالاً لتفسير كثير من روايات واقعة الطف، وتفصح عن رؤية جديدة، فارتأينا التعامل مع قضية المقتل بلحاظ تاريخي تحقيقي واضح. فعقدنا العزم على تحقيقه ودراسته؛ لإخراجه إلى النور لأول مرة.
ولم يكن العمل على ذلك بالشيء السهل الخالي من المصاعب، بل واجهتنا صعوبات متعدّدة، من أهمّها كيفية العثور على نسخة مخطوطة لهذه السفر المهم؛ لقلة نسخه في مكتبات وخزائن المخطوطات العالمية، كحال الكثير من الكتب أمثاله المؤلّفة في تلك الحقبة، التي نالها الضياع والتلف.
وقد عثرنا على مخطوطته الوحيدة المصورة في المملكة العربية السعودية في مكتبة المصغرات الفيلمية بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة. وكان زمن نسخ المخطوط يعود إلى القرن العاشر، كما هو مذكور في الرسالة السابقة على رسالة المصرع الشين، وبنفس الخط، وكما ذكر المستشرق إتان كلبرك بأنّ تاريخ نسخ المخطوطة هو القرن العاشر. ومثبت عليها بعض المعلومات (ORIENTAL MANUSCRIPT 26-6-1957 WVH)) (OR NR:959) ونسخة المخطوط موجودة ضمن مجموعة من العناوين المثبتة على بداية هذه المجموعة وهي :
1ـ رسالة في جواز لعن يزيد.
2ـ رسالة في المصرع الشين في قتل الحسين×.
3ـ أخذ الثأر على يد السادة الأخيار.
4ـ نبذة من جواهر العقدين في فضل الشريفين
وكان عدد أوراق المخطوط (225) ورقة، وفي كلّ ورقة ثلاثة عشر سطراً. وفي نهاية كلّ صفحة يكتب الناسخ أول كلمة من الصفحة التي تليها وهي طريقة ترقيم القدماء، وهي نسخة كاملة جيدة، خطها جيد وواضح إلّا أنّ فيها بعض الكلمات غير واضحة وكثيرة الأغلاط والتصحيف وكثير من الكلمات لم تنقط، وغير ذلك من المشاكل، فكان أول المخطوط (بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على كلّ أمر، الحمد لله الذي برهن باهر قدرته الباهرة على إثبات وحدانيته ببرهان وجود الموجودات الباطنة والظاهرة). وآخرها (هذا آخر المصرع الشين في قتل الحسين× ويتلوه أخذ الثأر على يد السادة الأخيار إبراهيم والثقفي المختار على التمام والكمال والحمد لله وحده). وبعد بيان المقدّمة من المؤلف صرّح باسمه، قائلاً: (قال عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاووس الحسيني ـ جامع هذا الكتاب ـ عن أبي مخنف لوط بن يحيى رحمة الله عليهم أجمعين في مصرع الحسين×).
وهناك من شكّك في نسبة الكتاب للسيد ابن طاووس، وأنّه لا علاقة لابن طاووس بهذا الكتاب، وإنّما أُضيف اسمه على الكتاب مع نصوص من كتابه اللهوف في قتلى الطفوف، وإنّما هذا الكتاب بالحقيقة هو مخطوط مقتل أبي مخنف الأزدي المنسوخ في القرن العاشر الهجري.
ويمكن الإجابة عن هذا التشكيك عن طريق القرائن الآتية:
القرينة الأولى: تصريح السيد ابن طاووس ـ بعد مقدّمة الكتاب ـ بأنّه هو الذي جمع هذا الكتاب، ويروي رواياته في مصرع الحسين× بواسطة المؤرخ الكبير أبي مخنف لوط بن يحيى (ت:157هـ) رحمة الله عليهم أجمعين.
القرينة الثانية: ابتدأ السيد ابن طاووس برواية أبي مخنف في مقتل أمير المؤمنين×، ثم خلافة ابنه الإمام الحسن×، وبعض أحواله وما جرى عليه أيام حكم معاوية، وأنتهى به الأمر إلى عزل نفسه من الخلافة في الكوفة. ثم ترك الإمام الحسن والحسين العراق وذهبا إلى المدينة المنورة.
وهذا لم نجده في مقتل أبي مخنف في نسخه ومطبوعاته الموجودة بين أيدينا. فالظاهر أنّ السيد ابن طاووس وصل إليه كتاب أبي مخنف الكبير، وأخذ منه المناسب لتأليف كتاب المصرع الشين.
القرينة الثالثة: ذكر المؤلف ـ أعني ابن طاووس ـ مقدّمة شبيه وقريبة من مقدّمة كتابه اللهوف في قتلى الطفوف لخص فيها مقامات وفضائل أهل البيت^، وما جرى عليهم من مصائب، لاسيما سيد الشهداء×. ثم ختمها بروايات عن أهل البيت^، ذكر فيها أجر وثواب البكاء على سيد الشهداء×. وهذا شاهد واضح على أنّ الكتاب المذكور لابن طاووس.
القرينة الرابعة: إن المستشرق اليهودي (إتان گلبرگ) عدّ كتاب المصرع الشين من مؤلفات السيد ابن طاووس تحت الرقم (29).
القرينة الخامسة: نقل السيد ابن طاووس روايات كثيرة في كتابه المصرع الشين ليست موجودة في كتاب مقتل أبي مخنف الموجود، وبلغت نسبة تلك الروايات الربع من مجموع روايات الكتاب التي تخطّت الـ(80) رواية، وهذا بحدّ نفسه يبعد التشكيك في نسبة الكتاب لابن طاووس.
القرينة السادسة: نقل السيد& روايات في مقتله المصرع الشين بلغت (14) رواية عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت:290هـ)، وهو متأخر زماناً عن طبقة أبي مخنف بأكثر من قرن. وهذا أيضاً يقوي نسبة تأليف الكتاب للسيد ابن طاووس&؛ إذ لم نجد ذلك في نسخ وطبعات مقتل أبي مخنف، بل لا يمكن أن تكون في مقتله؛ لما ذكرنا من تأخّر أبي عبد الرحمن عنه بقرن من الزمن.
القرينة السابعة: نقل المؤلف الأحداث في كتابه المصرع الشين برواية طويلة وواسعة عن أبي مخنف، وفيها أكثر تفصيلاً من بقية كتب المقاتل، ثم ذكر أيضاً في موارد عديدة أكثر من رواية في الحادثة الواحدة. وهو يعدّ من باب الفائدة والسعة في مصادر الروايات لكتابه (المصرع الشين) حتى تفرّد في بعضها.
القرينة الثامنة: إنّ السيد ابن طاووس الذي جمع كتابه هذا، حاول أن يرتّب أحداث وروايات المقتل حسب ما يراه مناسباً. وهذا الترتيب في كثير من الموارد يختلف زيادة ونقيصة عن روايات مقتل أبي مخنف في نسخه ومطبوعاته المتوفرة عندنا.
القرينة التاسعة: كثير من روايات المقتل في المصرع موجودة في الكتب المتأخّرة كالمنتخب والبحار وأسرار الشهادات وناسخ التواريخ وغيرها. ولعلّه وصل إليهم نسخ أو كتاب المصرع الشين للسيد ابن طاووس.
القرينة العاشرة: لم نجد في نسخ مقتل أبي مخنف الواصلة إلينا بعض الروايات والأشعار في كتاب المصرع الشين، وهذا قرينة على أنّ السيد ابن طاووس& في كتابه هذا له أكثر من مصدر في تأليفه، نعم كان الأكثر منها اعتماده على مقتل أبي مخنف الذي وصل إليه.
القرينة الحادي عشر: ورد في كتاب المصرع الشين في بعض مروياته ما يوافق رواية اللهوف لفظاً ومضموناً. وهو يقرّب انتساب الكتاب للسيد ابن طاووس.
القرينة الثانية عشر: في الروايات رقم (75 و76 و78) ما يشير إلى أنّ الكتاب من تأليف السيد ابن طاووس؛ حيث علّق السيد في ذيل الروايات المذكورة بتعليقاتٍ لم ترد في رواية أبي مخنف في المقتل المتداول ولا غيره ممّن نقل عنه.
فلا ينبغي التشكيك في صحة نسبة الكتاب إلى السيد ابن طاووس&.
ولأجل إعداد هذا التحقيق للمصرع الشين في قتل الحسين× تطلّب منّا الاستعانة بمجموعة من المصادر والمراجع التاريخية التي أفادت الدراسة كثيراً، وتنوّعت بين كتب المقاتل والمعاجم اللغوية والكتب الأدبية وكتب التاريخ العام، وكتب البلدان ومعاجمها، ومن أهمها:
اعتمدنا في التحقيق على كتب الحديث الشريف عند الفريقين، والتي تُعدّ المصدر الثاني من مصادر التاريخ الإسلامي بعد القرآن الكريم، لما شملت من معلومات مهمّة رفدت البحث بحقائق ثابتة. وهي الكتب الأربعة وغيرها وكتب الصحاح والمسانيد عند العامة وغيرها.
تأتي كتب المقاتل في طليعة المصادر التي اعتمد عليها التحقيق، وتُعدّ أحد مرتكزاته، لأنّها اهتمّت بنقل روايات مقتل الإمام الحسين× ولم تقف عند ذلك، فتطرّقت إلى مسيرة الإمام منذ خروجه من المدينة موضع استقراره ومحل سكنى رسول الله’ حتى وصوله لكربلاء، ومن أبرز كتب المقاتل هو مقتل الإمام الحسين لأبي مخنف الازدي، كما استعنّا بكتب أخرى، من قبيل كتاب مقتل الحسين× المستخرجة مروياته من كتاب تاريخ الأمم والملوك للطبري، ومقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وأصحابه في كربلاء المنسوب لأبي مخنف، وكتاب مقاتل الطالبين لأبي الفرج الأصفهاني الذي اختص بذكر مقاتل أهل بيت النبوة^، وكتاب مقتل الحسين× للخوارزمي، وكتاب مثير الأحزان لابن نما الحلي، وكتاب مقتل الحسين× المسمّى اللهوف في قتلى الطفوف لابن طاووس، وكتاب المنتخب للطريحي، وكتاب بحار الأنوار، وكتاب إكسير العبادات في أسرار الشهادات، وكتاب ناسخ التواريخ وغيرها. فجاء الكتاب على ذكر أحداث المقتل، مقرونة بتحقيق الكثير من المعلومات المستفادة من كتب المقاتل التي لا غنى عنها بصفتها ذات العلاقة والاختصاص.
رفدت كتب التاريخ العام تحقيقنا بالكثير من المعلومات التي تخصّ الأحداث السياسية، يأتي في مقدمتها كتاب الأخبار الطوال للدينوري الذي يُعدّ مصدراً مهماً في نقل تفاصيل الحروب والأحداث السياسية، وكتاب تاريخ اليعقوبي لأحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي، الذي يحتوي على معلومات وافية ونصوص قيّمة، تميّزت عن بقيّة المصادر التاريخية سيّما ما يخصّ طلب البيعة ليزيد، وكتاب تاريخ الأمم والملوك للطبري الذي يُعدّ من المصادر العامة والأساسية لدراسة التاريخ الإسلامي، فجاءت أحداثه مرتبة حسب السنوات، وقد كان لهذا الكتاب أهميّة كبيرة في إغناء هذا التحقيق؛ إذ احتوى على مرويات لوط بن يحيى الأزدي، فنقل لنا وقائع واقعة الطف بشكل مفصّل. وكتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي الذي يُعدّ من المصادر المهمّة في التاريخ الإسلامي؛ إذ انفرد في ذكر بعض الروايات فيما يخصّ عدد جيش الإمام الحسين×، كما اعتمدنا على عدد من مصادر التاريخ العام الأخرى ككتاب ينابيع المودة لذوي القربى للقندوزي.
كانت لهذه الكتب نصيب كبير في دعم التحقيق بمعلومات قيمة عن عدد من الشخصيات الواردة في أحداث المقتل، ومن أهم هذه الكتب كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد الذي أفاد الدراسة بتقديم تراجم وافية لشخصيات الصحابة والتابعين، الذين أسهموا في أحداث واقعة كربلاء، وكتاب طبقات خليفة بن خياط لابن خياط، حيث كانت له أهمية خاصّة؛ لما فيه من معلومات قيمة على الرغم من كونها مقتضبة، ومن كتب التراجم والتي شكّلت مصدراً مهمّاً عوّلنا عليه في تراجم الرجال كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر القرطبي، وكتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الاثير، وكتاب سير أعلام النبلاء للذهبي الذي أمد الدراسة ـ فضلاً عن تراجم الشخصيات ـ بمعلومات هامّة عن أحداث واقعة الطف، وكتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، وكتاب إبصار العين في انصار الحسين× للسماوي، وغيرها من كتب التراجم.
وقد كانت جملة من كتب الأنساب التي لا غنى عنها في تتبع التسلسل النسبي لكل قبيلة لها نصيب في تحقيق مخطوط المصرع الشين، منها كتاب أنساب الأشراف للبلاذري الذي امتاز بالسعة والشمول بذكر النصوص والروايات التي لم يقف عليها مؤرّخ أخر، سيّما ما يخص الأنساب وأحداث واقعة كربلاء، وكتاب جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي، وكتاب الأنساب للسمعاني، فقد اختص بذكر الأنساب والتعريف بكثير من الشخصيات وغيرها من الكتب.
تعد كتب الفتوح من المصادر المهمة التي اعتمدنا عليها في التحقيق، منها كتاب الفتوح لابن اعثم الكوفي الذي اهتم بروايات واقعة الطف اهتماماً كبيراً، والتي زادت من ترصين تحقيق كتاب المصرع الشين فيما يخص كلّ ما يتعلق بمسيرة الإمام الحسين× وأحداث مقتله.
لم يفتنا الرجوع إلى الكتب الجغرافية ومعاجمها من الكتب المهمّة التي لا غنى عنها في معرفة مواقع البلدان والمدن والأقاليم، والتي تكمن أهمّيتها في احتواء أغلبها على ذكر الأحداث التاريخية، من قبيل كتاب معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري، وكتاب معجم البلدان لياقوت الحموي والذي امتاز باتساع مادته الجغرافية، وكتاب مراصد الاطلاع في معرفة أسماء الأمكنة والبقاع لابن عبد الحق البغدادي الذي جاء في حقيقة الأمر مختصراً لكتاب معجم البلدان، فكانت الإفادة منه في تحديد وتعريف مواقع المدن الواردة في الدراسة. وكتاب أطلس الحسين للباحث عباس الربيعي الذي امتاز بتحقيق الأماكن والمواضع التي مرّ بها الإمام الحسين×، وكتاب من كربلاء إلى دمشق للكاتب محمد عبد الغني السعيدي الذي بحث فيه المواضع والمناطق التي مرّ بها سبايا أهل البيت^ من كربلاء إلى دمشق.
المعاجم اللغوية والكتب الأدبية
اعتمدت الدراسة على جملة من المعاجم اللغوية التي رفعت الغموض عن بعض المفردات بشرح وتفسير ألفاظها، منها كتاب العين للفراهيدي، الذي يعد من أقدم المعاجم اللغوية، فقد أفادت الدراسة منه كثيراً في توضيح المصطلحات المبهمة، وكتاب الصحاح للجوهري، وكتاب لسان العرب لابن منظور، وكتاب القاموس المحيط للفيروزآبادي، وكتاب معجم الوسيط لمجمع اللغة العربية.
أمّا المصادر الأدبية فهي الأخرى لا يمكن الاستغناء عنها في مجال التاريخ الإسلامي ففيها كثير من الحقائق التاريخية التي يستطيع المحقّق أن يستنتجها، منها كتاب العِقد الفريد لابن عبد ربه، فقد تعرّض لذكر سيرة الإمام الحسين× وموقفه من بيعة يزيد، وكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، الذي أفاد الدراسة كثيراً، باعتباره موسوعة جامعة للأخبار والأدب والأنساب وأيام العرب وأحوالهم الفكرية، وغير ذلك.
وأمّا الوجه في تسمية هذا الكتاب بـ"المصرع الشين"، فلم نجد تصريحاً للمؤلف& في ذلك، ولا لغيره، إلّا أنّه يمكن استظهار وجه تسميته من ظاهر العنوان؛ بأن نقول إنّ المراد به الإشارة إلى عظمة الجريمة التي ارتُكِبت في يوم عاشوراء، وقبح ما جاء به الأعداء من انتهاك حرمة رسول الله’، وحرمة أهل بيته^، وانتهاك حرمة الإسلام الذي لم يجوّز مثل هذه الجريمة في حقّ عامة المسلمين فكيف بسادتهم. فهو مأخوذ من الشَين بمعنى القبح والعيب، مقابل الزين[7].
رتّب السيد ابن طاووس& كتابه هذا على النحو الآتي:
أ: المقدّمة
ب: الأحداث التي سبقت بيعة يزيد التي أشار بها إلى شهادة أمير المؤمنين× وما جرى على الإمام الحسن× من بعده مع معاوية بن أبي سفيان وشهادته×.
ج: مكاتبة أهل الكوفة ـ في زمن معاوية ـ للإمام الحسين× بعد استشهاد أخيه× يدعونه للمسير إليهم، وأيضاً كانت فيها رسائل بين معاوية والإمام×.
د: وفاة معاوية ووصيّته لابنه يزيد بالبيعة والحكم.
هـ: مبايعة الناس ليزيد وامتناع الإمام× لمّا كان في المدينة وما جرى من أحداث في هذه الفترة.
و: خروج الإمام× من المدينة إلى مكة.
ز: مكاتبة أهل الكوفة للإمام× يدعونه للمجيء إلى الكوفة.
ح: إرسال الإمام× مسلم بن عقيل إلى الكوفة وتفاصيل ما جرى عليه وعلى غيره.
ط: مسير الإمام× إلى العراق وتفاصيله.
ي: وصول الإمام× كربلاء، وما جرى فيها من أحداث إلى شهادته×.
ك: دخول السبايا إلى الكوفة، وما جرى من أحداث فيها عليهم وعلى غيرهم.
ل: مسير السبايا والرؤوس إلى الشام. ثم يذكر المؤلف أحاديث وردت عن النبي’ فيها أخبار عن شهادة الإمام الحسين× ويرجع يكمل ما جرى على السبايا في مسيرهم.
م: دخول السبايا والرؤوس إلى الشام وما جرى عليهم من أحداث وتفاصيل.
ن: رجوع السبايا إلى المدينة المنوّرة وما كان فيها.
1ـ يُعدّ كتاب المصرع الشين من كتب المقاتل التي كُتِبت في القرن السابع، وبتأليف من عالم متضلّع.
2ـ عنوان الكتاب (المصرع الشين في قتل الحسين×) هو الاسم الذي اختاره المؤلّف السيد ابن طاووس لكتابه.
3ـ روايات هذا المقتل قريبة من رواية الطبري عن أبي مخنف، خاصّة الأحداث التاريخية التي قبل مسير الإمام× إلى العراق، وبعده وما يتعلّق بأحداث مسلم وهانيء، وبعض أحداث كربلاء والكوفة. نعم توجد في كثير من الأحداث اختلاف عن رواية الطبري عن أبي مخنف، وخاصّة ما جرى على السبايا أثناء مسيرهم إلى الشام وبعض التفاصيل هناك.
4ـ لم يذكر السيد المؤلف أسانيد الروايات، بل اكتفى بذكر الراوي الأول للرواية مثل: (عمار، عدي بن حرملة، علي بن الحسين×، حميد بن مسلم، جديلة الأسدي وغيرهم).
1ـ وردت الأسماء المهموزة بدون همزة سواء متوسطة أو متطرفة مثل: (ساير والثلاثا ... وما شاكل).
2ـ وضع همزة (ابن) وحذفها ليس بحسب الضوابط المتفق عليها.
3ـ توجد أخطاء إملائية كثيرة في كتابة بعض الكلمات، فالكلمات المنتهية بالألف الممدودة كُتِبت بالألف المقصورة وبالعكس.
3ـ وردت بعض الكلمات غير منقطة، ولكن أثبتناها بحسب قرينة السياق.
3ـ توجد أخطاء نحوية في بعض الكلمات.
4ـ توجد أخطاء في أسماء بعض الشخصيات والأماكن والكلمات.
5ـ وردت الصلاة على النبي’ عند ذكره المبارك بأسلوب العامة، أي بالصلاة عليه دون آله^ إلّا في موارد قليلة كانت بأسلوب أتباع أهل البيت^، وكذا ورد فيه الترضي على أهل البيت^ بدلاً عن التسليم.
1. ترجمة الشخصيات التي لها دور بارز في النهضة الحسينية، أو ترتبط بها ارتباطاً مباشراً، سلباً أو إيجاباً.
2. بيان المعاني اللغوية للكلمات المبهمة وبيان المواقع الجغرافية.
3. تخريج الروايات والحوادث التاريخية من مصادرها الأولية أو المصادر الثانوية المتأخرة زماناً عن المؤلف.
4. الإشارة إلى المواضيع التي تخالف معتقدات الإمامية وردّها.
5ـ إن كان هناك خطأ إملائي أو مطبعي في المتن، يُشار له ويُصحَّح في الهامش. وإن كان الخطأ متكرراً بكثرة في الكتاب من قبيل إثبات همزة (ابن) في مواضع وجوب حذفها أو حذفها في مواضع وجوب إثباتها، وكتابة الهمزة المتوسطة ياء، وكتابة الألف المقصورة ممدودة أو بالعكس، وحذف الهمزة السائبة من قبيل (كربلا)، فيشار لها في المورد الأول فقط؛ رعاية للاختصار.
6ـ اعتمدنا في التحقيق على كتب التاريخ والسير والمقاتل، بالخصوص على مقتل أبي مخنف؛ لكون المصنف& ينقل عنه. كما اعتمدنا كثيراً على نور العين وأسرار الشهادات والمنتخب؛ لكثرة التشابه بينها وبين كتاب المصرع الشين الذي نحن بصدد تحقيقه، من جهة سردها للأحداث، ومن جهة نقلها عن مقتل أبي مخنف.
7ـ ذكر المؤلف الصلاة على النبيّ’ من دون الصلاة على آله^، فأضفناها بين معقوفتين []، وكذا أضفنا بين معقوفتين بعض الكلمات أو الجمل التوضيحية للمتون التي نقلناها في الهامش.
8 ـ أضفنا عناوين رئيسية تنسجم مع الأحداث التي ذكرها المؤلف، ووضعناها بين معقوفتين [].
9 ـ ترقيم الروايات الرئيسية حتى يسهل على القارئ معرفة تسلسلها والاستفادة منها.
هو السيد علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد المعروف بـ (ابن طاووس) يرجع نسبه إلى الحسن المثنى بن الإمام الحسن× ابن أمير المؤمنين×.
وُلِد في مدينة الحلة سنة (589هـ) نشأ وترعرع فيها، ثم هاجر إلى بغداد وأقام فيها أكثر من عشر سنوات في زمن الدولة العباسية ثم رجع إلى الحلة، وانتقل بعدها إلى النجف، ثم إلى كربلاء، فبقي هناك ثلاث سنين، ثم انتقل إلى الكاظمين فبقي فيها ثلاث سنين ثم عاد إلى بغداد سنة (652 ه)، فبقي فيها إلى حين احتلال المغول.
كُلِّف السيد في زمن المستنصر بقبول منصب الافتاء تارة. كما تسلّم نقابة الطالبيين بالعراق من قبل هولاكو سنة (661هـ)، واستمر بها إلى آخر حياته.
قال عنه الشيخ النوري في خاتمة المستدرك: «السيد الأجل الأكمل الأسعد الأورع الأزهد، صاحب الكرامات الباهرة رضي الدين أبو القاسم وأبو الحسن علي بن سعد الدين موسى بن جعفر بن طاووس آل طاووس، الذي ما اتفقت كلمة الأصحاب على اختلاف مشاربهم وطريقتهم على صدور الكرامات عن أحد ممّن تقدّمه أو تأخّر عنه غيره. ثم تبرك بذكر بعض كراماته».
وأثنى عليه الحر العاملي في أمل الآمل بقوله: «حاله في العلم والفضل والزهد والعبادة والثقة والفقه والجلالة والورع أشهر من أن يُذكَر، وكان أيضاً شاعراً أديباً منشئاً بليغاً».
وغير ذلك كثير من أقوال العلماء فيه.
1. الشيخ أسعد بن عبد القاهر بن أسعد الأصفهاني.
2. بدر بن يعقوب المقري الأعجمي.
3. تاج الدين الحسن بن علي الدربي.
4. الشيخ الحسين بن أحمد السوراوي.
5. كمال الدين حيدر بن محمد بن زيد بن محمد بن عبد الله الحسيني، وغيرهم.
1. إبراهيم بن محمد بن أحمد بن صالح القسيني
2. السيد أحمد بن محمد العلوي
3. جعفر بن محمد بن أحمد بن صالح القسيني
4. الشيخ تقي الدين الحسن بن داود الحلي
5. جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، المعروف بالعلامة الحلي.
6. العلامة سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر، (والد العلامة). وغيرهم الكثير.
اهتم السيد بالتصنيف في مجال الأدعية اهتماماً زائداً عنه في سائر الجوانب، حتى كأنّه الصفة الغالبة لمصنّفاته. ومع ذلك فإنّه قد ألّف في سائر العلوم[8]، كالفقه والأخلاق والتاريخ والسيرة والمناقب والملل والنحل ومحاسبة النفس والفهارس، منها:
1 - الإبانة في معرفة أسماء كتب الخزانة.
2 - الإجازات لكشف طرق المفازات فيما يخصني من الإجازات.
3 - أسرار الصلاة.
4 - الأسرار المودعة في ساعات الليل والنهار.
5 - الاصطفاء في تاريخ الخلفاء.
6 - إغاثة الداعي وإعانة الساعي.
7 - الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرة في السنة.
8 - الأمان من أخطار الأسفار والأزمان.
9 - الأنوار الباهرة.
10 - البهجة لثمرة المهجة.
11 - التحصيل من التذييل.
12 - التحصين في أسرار ما زاد على كتاب اليقين.
13 - التراجم فيما ذكره عن الحاكم.
14 - التعريف للمولد الشريف.
15 - التمام لمهام شهر الصيام.
16 - التوفيق للوفاء بعد التفريق في دار الفناء.
17 - جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع.
18 - الدروع الواقية من الأخطار فيما يعمل مثلها كلّ شهر على التكرار.
19 - ربيع الألباب في معاني مهمات ومرادات.
20 - روح الأسرار وروح الأسمار، ألّفه بالتماس السيّد محمد بن عبد الله بن علي ابن زهرة.
21 - ري الظمآن من مروي محمد بن عبد الله بن سليمان.
22 - زهرة الربيع في أدعية الأسابيع.
23 - السعادات بالعبادات.
24 - سعد السعود.
25 - شفاء العقول من داء الفضول.
26 - الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف.
27 - الطرف من الأنباء والمناقب في شرف سيد الأنبياء وعترته الأطائب.
28 - غياث سلطان الورى لسكان الثرى.
29 - فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رب الأرباب.
30 - فتح الجواب الباهر في شرح وجوب خلق الكافر.
31 - فرج المهموم في معرفة الحلال والحرام من علم النجوم.
32 - فرحة الناظر وبهجة الخواطر.
33 - فلاح السائل ونجاح المسائل.
34 - القبس الواضح من كتاب الجليس الصالح.
35 - كشف المحجة لثمرة المهجة.
36 - لباب المسرة من كتاب مزار ابن أبي قرة.
37 - اللطيف في التصنيف في شرح السعادة بشهادة صاحب المقام الشريف (جعله في ضمن كتاب الإقبال).
38 - المجتنى من الدعاء المجتبى.
39 - محاسبة النفس.
40 - مسالك المحتاج إلى مناسك الحاج.
41 - مصباح الزائر وجناح المسافر.
42 - مضمار السبق في ميدان الصدق.
43 - الملاحم والفتن في ظهور الغائب المنتظر.
44 - الملهوف على قتلى الطفوف.
45 - المنتقى في العوذ والرقى.
46 - مهج الدعوات ومنهج العنايات.
47 - المواسعة والمضايقة.
48 - اليقين باختصاص مولانا أمير المؤمنين علي×.
49 ـ المصرع الشين في مقتل الحسين×. وهو الكتاب الذي بين يدي القارئ.
توفي (رضوان الله عليه) في بغداد بكرة يوم الأثنين خامس شهر ذي القعدة من سنة (664هـ).
أمّا مدفنه الشريف فقد اختلفت فيه الأقوال:
قال الشيخ يوسف البحراني: «قبره غير معروف الآن»[9]. وذكر المحدّث النوري: «... في الحلة في خارج البلد قبة عالية في بستان تُنسَب إليه، ويزار قبره ويتبرك فيها، ولا يخفى بعده لو كان الوفاة ببغداد، والله العالم»[10]. ويدفع هذه الشكوك ما ذكره السيد في (فلاح السائل) من اختياره لقبره في جوار مرقد أمير المؤمنين× تحت قدمي والديه، قال قدس سره: «وقد كنتُ مضيتُ بنفسي وأشرتُ إلى من حفر لي قبراً كما اخترتُه في جوار جدي ومولاي علي بن أبي طالب× متضيفاً ومستجيراً ووافداً وسائلاً وآملاً، متوسلاً بكل ما يتوسّل به أحد من الخلائق إليه، وجعلتُه تحت قدمي والديَّ رضوان الله عليهما، لأنّه وجدتُ الله جل جلاله يأمرني بخفض الجناح لهما ويوصيني بالإحسان إليهما، فأردتُ أن يكون رأسي مهما بقيتُ في القبور تحت قدميهما»[11].
مضافاً إلى ما ذكره ابن الفوطي في كتابه الحوادث الجامعة، قال: «وفيها ـ أي سنة 664 ه ـ توفي السيد النقيب الطاهر رضي الدين علي بن طاووس، وحُمِل إلى مشهد جدّه علي بن أبي طالب×، قيل: كان عمره نحو ثلاث وسبعين سنة»[12].
فما ذكره هو الصحيح ومقدّم على أقوال الآخرين؛ لمعاصرته لتلك الفترة، ولهذا فهو أفضل من أرّخ حوادث القرن السابع الهجري.
وبالجملة: هو الحسنيُّ نسباً، والمدنيُّ أصلاً، والحليُّ مولداً ومنشأ، والبغداديُّ مقاماً، والغرويُّ جواراً ومدفناً.
وفي الختام لا يفوتنا أن نتقدّم بالشكر الجزيل لإدارة مؤسسة وارث الأنبياء× للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية، لما قدّموه من مساعي ذلّلت لنا الصعاب. والشكر موصول للجنة العلمية على متابعتهم وملاحظاتهم التي أكملت ما فاتنا، ولجميع كوادر المؤسسة التي كان لها دور في ظهور هذا الجهد إلى النور، ونسأل الله أن يتقبّل منّا ومنهم هذا العمل.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمة النبيّ محمد’ وعلى ذريته وصحبه المنتجبين، وكلّ من ناصرهم وقاتل معهم، صلاة دائمة غير منقطعة، إنّه سميع مجيب.
قسم التحقيق
14/10/2021
ملحق (1) : صورة الصفحة الأولى من مخطوطة الكتاب[13]
ملحق (2) : صورة الصفحة الثانية من مخطوطة الكتاب[14]
ملحق (3) : صورة الصفحة الأخيرة من مخطوطة الكتاب[15]
وبه نستعين على كلّ أمر
الحمد لله الذي برهن باهرَ قدرتِه الباهرة على إثبات وحدانيته ببرهان وجود الموجودات الباطنة والظاهرة، القدير الذي قدّرا[16] بقدرته، وحكم عليهم بحكمته، فأرواحهم صايرة[17]، وحيّر الألباب وكتب على الأحباب، فالأنبيا[18] والمرسلين والأوليا الصالحين[19] مطيعة حاضرة[20]. سلب الأنفس بالفجيعة التي بلغ درأوها[21] إلى جبرئيل، والفظيعة التي عظمت على الربّ الجليل[22]. وكيف لا يكون ذلك وقد أصبح لحم رسول الله مجرجراً[23] على الرمال، ودمُه الشريف مسفوكاً بسيف الضلاّل، ووجوه بناته مكشوفة لعين الشايق[24] والشامت، وتلك الأبوار المعظّمة عارية من البنات[25].
|
مصايب بدّدت شمل التي |
فيا ليت فاطمة[27] وابنها[28] ينظران إلى أولادهما ما بين مسلوب وجريح من الطابقه[29] الكافر[30]. وبنات النبوّة مشقات[31] الجيوب، وناشرات الشعور، وبارزات الخدود[32]، والدموع والدموع[33] لهم غامرة[34].
فيا أيها النظر والأفهام[35] حثّوا أنفسكم بمصرع هؤلا[36] العترة الكرام، ونوحوا بالله على تلك الوجوه العظام، وساعدوهم على تلك الرزية[37] القاهرة[38].
فإنّ نفوس أوليك الأقوام، وواسع[39] سلطان الأنام، وثمرة فواد[40] سيد الأنام، وقرّة عين البتول، ومن كان يرشف[41] بفمه الشريف ثناياهم[42] الرسول، ويفضّل اُمّهم وأباهم حيث أقول شعره[43]:
إن كنتَ في شكٍّ فسل عن حالهم جاءت[49] إليه على يد جبريلِ |
فكيف طاب للنفوس مع تداني الأزمان مقابل جدّهم بالقرآن[50] وتكدير عيشه بتعذيب ثمرة فواده وتضعيف قدره بإراقة دم أولاده[51].
فأين موضع القبول بوصيته في عترته وآله؟ وما الجواب عند لقايه وسواله[52] فقد هدم القوم ما بناه، ونادى الإسلام وا كرباه.
ألم تعلموا أنّ محمد[53] مأثور في جميع أحبابه مقهور، والملائكة تعزيه على جليل مصابه والأنبيا شاركوه في أحزانه[54]؟
فيا أهل الوفا بخاتم الأنبياء ابكوا على هذه المصايب الذي[55] يتسلى بها المرء في جميع الأحباب[56].
فقد رُوِي عن محمد الباقر[57] أنّه قال: كان زين العابدين[58] يقول: أيمّا عين ذرفت[59] لقتل الحسين× حتى تسيل الدموع على الخدود بوّأها الله} غُرفاً[60] في الجنة يسكنها[61].
ورُوِى عن جعفر الصادق[62] (رضي الله عنه) قال: مَن ذُكِرنا عنده ففاضت عيناه ولو قدر جناح ذبابة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زَبَد البحر[63].
ورُوِى عن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) أنّه قال: مَن بكا[64] فيما أصابنا ضمنّا له على الله الجنة[65].
وقال عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاووس الحسيني ـ جامع هذا الكتاب[66] ـ عن أبي مخنف لوط بن يحيى[67] رحمه[68] الله عليهم أجمعين في مصـرع الحسين×:
1ـ قال: لما قُتِل أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب[69] (رضي الله عنه) حين
قتله بن[70]
ملجم[71] بجامع الكوفة. تولّى الخلافة بعده
ولدُه الحسنُ[72]، وكنيته
أبا[73] محمد، ولقبه الزكي، وأمّه فاطمة
بنت رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) سار إلى المدينة في إثر بيعته، وكان
قيس بن سعيد[74]
قايد جيوشه وعساكره فخرجت عليه الخوارج[75]
فقُتل قيس[76] فرجع الحسن إلى الكوفة فلقيه الخارج
الأسدي[77]
وواسه[78]
وغافله وضربه بالخنجر في فخذه فهرب بفخذه فقال بالأمس قتلتوا[79]
أبي[80] واليوم تريدون قتلي[81].
ثُمّ إنّه دخل الكوفة وعزل نفسه من الخلافة وكتب إلى معاوية[82] يعلمه بعزل نفسه ودفعها إليه كالنيابة بمال معلوم وقدره ألفين[83] دينار في المبايعة[84].
ثُمّ خرج الحسن والحسين يريدان قبر جدّهما (صلى الله عليه [وآله] وسلم) بالمدينه الشريفه، فدخلت عليهم مشايخ العراق يعتبانهما[85] على خروجهما من أرض العراق، فوعظهم موعظه عظيمه يقول فيها: اتقّوا في أموركم تكونوا الآن حفظاً لأموالكم ودمايكم، وإصلاحاً لشانكم، فارضوا بقضا الله تعالى وقدره، وسلّموا الأمر إليه، والزموا بيوتكم. واعلموا أنّي سمعتُ من أبي أمير المؤمنين× يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): مَن أحبّ قوماً بعثه الله معهم[86]، وأنتم معنا في زمرتنا[87].
قال: ثُمّ مضينا من عنده والحسين× يأمر غلمانه بالخروج إلى[88] المدينه، والكأبة والحزن في وجهه[89]، وهو يقول: (لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا)[90] وقد كان قدر الله قدراً مقدوراً[91]. والله، لو اجتمعت الأنس والجن على أن لا يكون أمراً[92] لما كان لمستطاعوا[93]. لقد كنتُ طبتُ نفساً بالموت حتى عزم علىّ أخي الحسن× أن لا أنقض عهداً، ولا أحرّك ساكناً ما دام الرجل حياً فأطلبه كرهاً منّي[94]، وقد قال الله : (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)[95]. والآن قد كان صلحاً، وكانت بيعه كنتُ لها كارهاً ولا تنظر[96] ما دام الرجل حياً، فإن هلك نظرنا ونظرتم. فقلنا له: يا أبا عبد الله، ما نحزن لأنفسنا، وإنمّا نحزن إلّا لكم أن تُضَاموا[97] في عِزّكم، وتُنقَصوا من حقّكم. ونحن أنصاركم وشيعتكم متى دعوتمونا أجبنا، ومتى أمرتمونا أطعناكم[98]. فقال×: شكر الله فضلكم ومقالتكم، وعرّفها لكم.
ثُمّ إنّ الحسن والحسين÷ خرجا وخرجوا معهما مشيّعين ومودّعين، فلمّا جازا دار هند[99] نظر الحسين إلى الكوفة وتمثّل بهذه الأبيات:
|
وما عن قلا[100] فارقتُ دار معاشري |
قال: ثُمّ ودّعهم مشايخُ أهل الكوفة ورجعوا، وسار الحسن والحسين÷. وندبهما على الصلح وردّ الحرب حجر بن عدي[106]، وكان قد حضر عند الحسين يوماً[107] وأنشأ يقول[108]:
|
دعاني رسول القوم من أرض مسكني يقول إمام الحقّ أضحى مسلما |
قال حجر: والله، لقد رأيتُ وجهه (صلوات الله عليه) قد أشرق نوراً، وقال: يا حجر، إنّ الناس ليسوا مثلك، ولا يحبّون ما تحبّ، ولا يتمنّون ما تتمنّا[113].
وخرج من عنده، وكان منهما ممّا[114] كان من خروجهما إلى المدينه،
فأقاما على
ذلك حتى قُبِض الحسن (صلوات الله عليه وسلامه) فكتب نفر من أهل الكوفة
من وجوه الشيعه إلى الحسين× يعزونه بمصابه على الحسن ويحثّونه على المسير إليهما[115]
وذلك أنّهم اجتمعوا في دار سليمان بن صُرد الخزاعي[116]، وفيهم
بني[117] جعده[118]، وكتبوا إليه: بسم الله الرحمن
الرحيم، إلى الحسين بن علي بن أبي طالب×من شيعته وشيعه أبيه×، فإنّا نحمد الله
إليك الذي لا إله إلّا هو أمّا بعد قلنا: قد بلغَنا وفاه أخيك الحسن (صلوات الله
عليه) يوم وُلِد ويوم قُبِض ويوم يُبعَث حياً، وغفر الله وتقبل حسناته وألحقه بنبيّه،
وفسّح له في قبره، وضاعف لك الأجر بالمصاب، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون. ما
أُصيبت به هذه الأمّه أمتاً[119] عامه، وما رُزِيت به شيعتنا خاصّه
لقد رزيوا به الرزا[120]
العظيم، وأُصيبوا بالمصايب الجليل[121]؛ مصاب بن وصيهم، وابن بنت نبيهم،
علم الهدى، ونور البلاد والتقى، والمُرجأ[122] لإقامه الدين، وإنفاذ حكم الكتاب،
ومحو الجور، وإظهار الحق، وإعادة سنن المرسلين الصالحين. واصبر رحمك الله على ما
أصابك (فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ
عَزْمِ الْأُمُورِ)[123]؛ فإنّ فيك خلف[124] ممّن كان قبلك، وإنّ الله سيهدي
بك على يديك المؤمنين، وبك تزول عنهم كلّ شدة، وكلّ من اهتدى بهدايتك، ونحن شيعتك
المصابه بمصابك المحزون[125] لحزنك، والمسـرون بسـروركم[126]، والمهديّون بهدايتك، والمنتظرون
لأمرك، شرح الله صدرك، ورفع ذكرك، وغفر ذنبك، وردّ عليك حقك. والسلام ورحمة الله
وبركاته[127].
ثُمّ إنّ الناس صاروا يقولون إن هلك معاويه لم يعدل عن الحسين بن علي× عليه أحدٌ. ثُمّ اتصل الخبر بمعاويه أنّ الحسين× يختلفون[128] الناس إليه، ويُكثِرون الجلوس عنده. وأكثروا من ذكره عند معاويه، فكتب إليه معاويه كتاباً فيه يقول:
بسم الله الرحمن الرحيم أمّا بعد فقد انتهت إليّ أمور، وما أظنّ أنّ لك فيها رغبه. ولعمر الله إنّ مَنْ أعطى الله صفقته يميني[129] وعهد الله وميثاقه لجدير بالوفا. فإن كان الذي بلغني عنك باطل فأنت والله سعيد ويحفظ نفسك تبدوا وبعهد الله توفي ولا تلومني[130] في قطيعتك، فإنّك متى أنكرتَني أنكرتُك، ومتى تكذّبْني أكذبتُك. فلا تشقّ عصا الأمه فتسير[131] بذلك فتنة، وقد جرّبتَهم وبلوتَهم، وأبوك كان قبلك وهو أفضل منك، وكان قد فسد عليه رأيه. فانظر لنفسك ولدينك، ولا تستخف بك السفها، الذين لا يعلمون. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته[132].
فكتب إليه الحسين جواب كتابه، يقول: بسم الله الرحمن
الرحيم أمّا بعد فقد
بلغني كتابك، وفهمتُ خطابك، ولعمري إنّ الحسنات يذهبن السيات[133]، ولا يهدي ويسدد إلّا الله. وما
ذكرتَ أنّه بلغني عنك فإنّما رقا[134]
إليك المارقون والمشّاون[135] بالنمائم المفرّقون بين الجموع،
وكذبوا وأيم الله. والسلام[136].
قال: فلمّا وصل الكتاب إلى معاويه أمسك ولم يجبه ووصله بما كان يصل إليه؛ وذلك أنّه كان يبعث إليه في كلّ سنه ألف ألف دينار سوا[137] عروض وهدايا من كلّ صنف. والله أعلم[138].
2ـ ذكر الكلبي[139]
في حديثه أنّ معاويه لما حضرته الوفاه ومرض مرضاً
شديداً ـ وكان ابنه يزيد[140] لعنه الله غايباً[141]
عنه؛ وذلك أنه كان والياً على حمص[142] ـ فدعا بورقه ودواه، وكتب بعد أن
تزايدت عليه الأمراض وبدت علته[143]،
وتغيّر حالته، فكتب وصيته يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، أمّا بعد إنّ خير
الأشيا[144] الحاريات[145]
التقدم بالوصايا، فقد قال الله تعالى (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ)[146] اعلم يا بُني أنّه قد جاني[147]
ما كان بعدُ من الموت المحتوم على جميع العباد، وأوصيك يا بُني بوصيه لن تزال بخير
ما دمتَ حافظها.
أوصيك ما دمتَ بعدي[148] راعياً وبذمتي وافياً ولوصيتي حافظاً، أوصيك بأهل الحجاز خيراً؛ فإنّهم منك وأنت منهم، وعيبهم يلزمك وعارهم يلحقك، فمن قدِم عليك منهم فأكرمه، ومن غاب عنك تعاهده، ومن تخلّف منهم فافتقده. وأوصيك بأهل الشام خيراً بعد كتابيك ونصرتك[149]، وهم أنصارك وأعوانك، وإذا ما دهمك أمر[150] وقهرك عدوّ فارمِِ بهم إليه، فإذا انتصفتَ من عدوّك فردّ بهم إلى بلاهم[151]، يتخلّقوا بخلاقتهم[152]، ولا يتخلّفوا عنك وينالوا منك. وعليك بأهل العراق خيراً، انظر لهم في أمورهم، وأحسن سياستهم، وإذا سألوك أن تعزل كلّ يوم عامل[153] افعل، فإنّ عزل عامل أهون من شقّ العصا على المسلمين ونقض عهد المؤمنين. واعلم يا بني أنّي قد وطّيتُ[154] لك البلاد، ومهّدتُ لك المهاد، وذلّلتُ لك الصعاب، وقمعتُ لك أرقاب[155] العباد. ولستُ أخشى عليك بعد موتي إلّا من أربع[156] نفر بأنّهم لا يبايعوك[157] على الأمر ولا يطيعونك، الأول عبد الرحمن بن أبي بكر[158] فإنّه صاحب دنيا، فدعه ودنياه، وما يريد لا لك ولا عليك. والثاني عبد الله بنعمر[159] فإنّه صاحب قراه[160] ومحراب، فدعه وما هو عليه لا لك ولا عليك. والثالث عبد الله بن الزبير[161] يغور[162] عنك كما يغور الثعلب، ويجثو جثوة الأسد، فإن حاربك فحاربه، وإن سالمك فسالمه، ولا تطيعه[163] في ترك الأمر، وإن شار عليك فاقبل مشورته. وأمّا الرابع فإنّه الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنهما) فإنّه لا تدعه الأمه حتى يخرجه[164] إليك، ويحملونه عليك، ويكاتبونه فإن أنت ظفرتَ به فاحفظ قرابته من رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)[165]. واعلم يا بني أنّ أباه خيراً[166] من أبيك، وأمّه خير من أمك، وجدّه خير من جدك، وأخاه خيراً من أخيك، وخاله خير من[167]، وعمّه خير من عمّك. فإياك أن تهمل وصيتي أو تنسى نصيحتي، فإذا قضيتُ نحبي وصرتُ إلى ربي فلا يواريني في لحدي إلّا عمُّك أبي[168] عبد الله عمر ابن العاص[169]، فإذا واراني وهَمّ بأن يصعد فجرّد سيفك، والزمه بالبيعة قبل أن يصعد من القبر؛ فإنّه إذا بايعك لا يختلف عليك منهم أحد. وهذه وصيتي إليك والسلام[170].
ثُمّ ختم الوصيه ودفعها إلى أخصايه[171] وكان الضحاك بن قيس الفهري[172] وكان من خواصّ أصحابه، وأمره أن يدفع الوصيه ويسلّمها إلى يزيد عند مقدمه. هذا ما كان من أمر معاويه.
وأمّا يزيد فإنّه لمّا قرأ كتاب أبيه ارتحل مجدّاً[173] حتى ورد دمشق[174] فوجد أباه قضى نحبه ولم يحضره؛ وذلك أنّه لمّا كتب الوصيه أُغمِى عليه فحرّكوه فإذا هو ميتا[175]، فضجّت دمشق بموته.
ثُمّ أخرج الضحاك بن قيس جميع الجند بدمشق ثُمّ أخرج أكفان معاويه مطويه مبخره على يديه، ثُمّ صعد المنبر ثُمّ نادى: معاشر الناس ألا وإنّ أمير المؤمنين معاويه كان عمود العرب، وسيد ذوي الحسب، وعمادها الأمد، وركنها الأسدّ عند الله. ومتّعه الله ما شا من عمره، ثُمّ قبضه لأجلٍ محدود ووقت معلوم، فأجاب لمّا دعا، وهذه أكفانه، ونحن مدرجوه فيها وتاركوه مع ربّه. ثُمّ نزل من على المنبر، وأخذ في أمر معاويه[176] ثُمّ واراه في لحده عمر بن العاص، كما سبق في الوصيه[177].
3ـ قال أبو مخنف (رضي الله عنه): حدّثني مَن أثق به أنّ يزيد لمّا وصل إليه كتاب أبيه مع البريد أنشد من وقته يقول:
|
جاء البريد[178] بقرطاس يحثّ[179] به |
ثُمّ إنّ يزيد سار وقدِم دمشق فوجد أباه لم يقضى[187] نحبه[188] فقعد عند رأسه فوصّاه بما تقدّم ذكره. ثُمّ قال له: يا بُني اعلم أنّ أبا بكر ولي هذا الأمر بعد رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ثُمّ مضى، وولى من بعده عمر فأسرى[189] كسيرهما، وتقلّد هذا الأمر من بعده عثمان بن عفان فأسرى كسيرتهما[190]، ثم وليتُ من بعدهم[191] فوطّيت البلاد، وأعطيتُ المال في حياتي، وورّثتُه بعد وفاتي، فإذا متُ فاجهد أن لا يلحدني إلّا عمّك أبي[192] عبد الله عمر بن العاص، ولا تدعه يصعد حتى يبايعك ويوس[193] لك الأمر، ويدبّر الأمر فيه الملك[194]؛ فبه استوسق[195] النظام، وبرأيه تدفع الأمور الجسام؛ فإنّه خير موازر وأكرم ناصر، ثُمّ قضى معاويه نحبه، وألحده عمر بن العاص، وهَمّ بأن يصعد، فجرّد يزيد سيفه، وقال: بايع يا عمر، فهزّ لحيته، وقال فعلها معاويه حياً وميتاً، ثُم بايع، وبايع له الناس كافه.
ثُمّ إنّ يزيد رجع إلى منزله فأقام فيه ثلاثه أيام لم يظهر للناس، فلمّا كان في اليوم الرابع خرج لهم أشعث[196] أغبر[197]، وقال: أقبل فرقا[198] المنبر فحمد الله، وأثنى عليه وصلى على النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، ثُمّ قال:ألا وإنّ أمير المؤمنين معاويه قد عرفتم ما آثره[199]، وما تحقّقتم مفاخره، كان عبداً صالحاً، دعاه مولاه فأجابه، وقد وُلِّيتُ هذا الأمر من بعده، وقد أوصاني في بعض وصيته أن أُحسِن إلى مسياكم[200]، وأتجاوز عن زلتكم، وأتعاهد أموركم، وأغفر خطيتكم، وأصفح عن محركم[201]، وأقوّى ضعيفكم، وأعترف بالحق لشريفكم. ولستُ معتذر[202] لكم، فما أنتم قايلون؟ قال: فبقى الناس متحيّرون[203] لا يدرون ما يقولون، أيعزّونه في الرزيه أم يهنئونه بالولايه. فقام إليه عبد الله بن همام السّلولي[204]، فقال له: يا أمير المؤمنين، آجرك الله على الرزيه، وأجزل[205] لك في العطيه، وبارك لك في الموهبه السنيّه[206]. لقد ورثتَ جليلاً، وأُعِطيتَ عظيماً، فاشكر الله على عطيته، واصبر على رزيته، واكتفي[207] به في نزول بليته، واساله المعونه على توليته.
فبينما عبد الله بن همام يخاطبه، أُدخِل عليه الضحاك بن قيس فوقف بين يديه، وقال له: السلام[208] يا أمير المؤمنين، وخليفة المسلمين، أصبحتَ خليفه، وورثتَ خليفه، فآجرك الله على الرزيه التي لا شيء أفضع[209] منها، وبارك لك في الموهبه التي لا شيء أفضل منها، وأعانك على الرعيه التي لا يكون أطوع منها. ثُمّ أنشأ يقول:
|
اصبر يزيد فقد
فارقت ذايقة[210] |
فعند ذلك تبسّم يزيد بن معاويه، وجزّاه خيراً، ونهض فرحاً مسروراً، وقد بايعوه[216] الناس عنقاً[217] واحداً[218].
4ـ قال أبو مخنف: وكان والي المدينه يومئذ مروان بن
الحكم[219] فعزله
يزيد[220] وولى مكانه
الوليد بن عتبه[221] وولي
مكه عمر بن سعد[222] بن العاص[223]
وولي
الكوفه النعمان بن بشير[224]
وولى الريّ[225] عمر بن
سعد[226] وولى عبيد
الله بن زياد[227]
البصره.
وأمر جميع هؤلا أن يأخذوا البيعه على كافّة الناس فبايعوه[228] جميع الناس والبلاد ما خلى[229] الكوفه والمدينه فإنّهم لم يبايعوه، فكتب إلى عامله بالمدينه أعني الوليد ابن عتبه: أمّا بعد يا أبا محمد إذا قرأتَ كتابي هذا فخذ البيعه على جميع مَن قِبلك عامّه وعلى هاولاي[230] الأربعه خاصّه[231]، وهم: عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه) فمن أطاع وبايع وإلّا فضرب[232] عنقه، وأنفذ برأسه مع جواب كتابي هذا. والسلام عليك.
ثُمّ طوى الكتاب ودفعه إلى يزيد العامري بن لؤي[233]،
فأخذه وسار
مجدّاً[234]
من وقته وساعته حتى ورد المدينه، وكان قدومه لعشر خلون من شعبان[235].
وسلّم الكتاب إلى الوليد ابن عتبه فأخذه وفضّه[236]
وقراه[237] وفهم معناه، أنفذ[238] من وقته وساعته. واستدعا[239] بمروان بن الحكم، ـ وكان قد ولّاه؛
لأنّه كان أميراً قبله على المدينه. ومنهم مَن قال إنّه كان أميراً بدمشق ـ فلمّا
رآه رفع مكانه وأكرمه، ثُمّ قرأ عليه كتاب يزيد، وما قاله في حقّ البيعه من هولا
الأربعه، وما قد أمره به فيهم، وشاوره فيما يفعله فيهم. فقال له مروان: إنّ الرأي
عندي أن تنفذ إليهم في ساعتك وتحضرهم عندك، فإذا صاروا في قبضتك تأخذ البيعه عليهم
قبل أن يبلغهم أنّ معاويه قد مات، فلا نأمنهم أن يأخذ كلّ واحد منهم الرياسه لنفسه[240].
5ـ قال أبو مخنف: فأرسل الوليد إليهم ليلاً، وقال لهم
بايعوا أمير المؤمنين
يزيد بن معاويه؛ فإنّ معاوية قد قضى نحبه، وقد بايع كافّة الناس ليزيد. فقال له
مولاي الحسين×: ـ وكانوا مجتمعين عند قبر رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ـ
يا هذا لما[241] أقبح ما تريد بنا؛ نبايعك ليلاً!
ولكن أجمل من هذا أن نبايعك نهاراً جهاراً، ويبايع الناس، ولا يختلف أحداً[242]، فعاد الرسول وأخبر الوليد بذلك،
ـ وكان الوليد فتاً[243]
حيياً ـ فرجا[244]
أن يفعلا ذلك، فأمسك عنهما، فقال له مروان: الري[245]
أن تنفذ إليهم، وتلزمهم ببيعة يزيد؛ فإن فعلا[246] وإلاّ فاضرب أعناقهم، ولا تخرهم[247] من ساعة إلى ساعه، وامتثل فيهم
أمر صاحبك. فقال له الوليد: ويحك أضرب رقام[248]
قوم سامعين غير عاصين، مطيعين غير مخالفين ولا عصاه! فلمّا أضجوا[249] طلبهم فلم يقف لهم على أثر ولا
أعطى لهم أحد اخبر[250][251].
6ـ قال صاحب الحديث[252]: ثُمّ إنّ القوم توجّهوا من وقتهم وساعتهم إلى مكه[253]. فلمّا صاروا في بعض الطريق التقى بهم عبد الله بن عمر؛ لأنّه لم يحضر بالمدينه، فقال لهم: ارجعوا ولا تفارقوا جماعه المسلمين. فقالوا له: إنّ معاويه قد مات، وقد ولى الأمر من بعده يزيد ابنه، ولسنا نرجع ونحن متّجهين[254] إلى مكه؛ لننظر ما يكون من الأمر، ثُمّ مضوا. وأقبل عبد الله بن عمر فقدم المدينه من يومه، فأقام بها ينظر ما يكون من الأمر حتى جاته الأخبار من ساير الأمصار بأنّ الناس جميعهم بايعوا ليزيد، فعند ذلك تقدّم عبد الله بن عمر فبايعه[255] ليزيد[256].
قال عبد الله بن عباس[257] وجابر بن عبد الله الأنصاري[258] رضي الله عنهما قالا: ولم يُرَ لبيعه بن عمر؛ وذلك أنّه قال: اللّهم إذ كان ذلك خيراً فأنا رضيٌّ[259] به، وإن كان شراً فإنّي كاره له صابر عليه بايع[260]. وبايع عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله المقدّم ذكره، والمسوم[261] بن محزومه[262].
[دخول الإمام الحسين وأهل بيته^ على الوليد]
7ـ وفي رواية أخرى: أنّه لما جأ[263] رسول الوليد، وهم مجتمعين[264] عند قبر رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) نظر إليه مولاي الحسين (رضي الله عنه) مقبل[265] عليهم، فتبسم ضاحكاً وقال لمن حضره: لا شكّ أنّ معاويه قد قضى نحبه، وقد غلب يزيد على الأمر. وهذا رسوله إليكم من قِبل الوليد لتبايعوا، فما أنتم قايلون[266]؟ فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر[267]: أمّا أنا فأُخل[268] داري وأُغلق بابي. وقال عبد الله بن عمر: أمّا أنا فأُقبل على قراءة القرآن ولزوم ولزوم[269] المحراب وقا[270] عبد الله بن الزبير: أمّا أنا فلا أسمع ولا أطيع ولا أبايع يزيد أبداً.
وقال الحسين×: وأمّا أنا فلا بد ما أدخل[271] على الوليد وأناظره، وأطلب حقي
منه. ثُمّ نهض الحسين× في أهل بيته ومواليه، وأقبل مع رسول الوليد إلى الباب.
فأوقف من كان معه على الباب، وقال لهم: إذا أنا دخلتُ عليه وخاطبتُه وناظرتُه،
وسمعتم الزعقات وقد علت، والضجه وقد ارتفعت، فاهجموا عليّ واستنقذوني من القوم.
فقالوا له: حبّاً وكرامه، ثُمّ إنّه دخل إلى الدار، ونظر إلى مروان جالساً إلى
جانب الوليد وهو يحادثه، فسلّم عليهما، فردّوا عليه السلام، ونهض له الوليد فجلس
بينهما. ثُمّ قال له الحسين×: لِمَ ذا استدعيتَني؟ فقال: تبايع يزيد بن معاويه رمى[272] له كتاب يزيد، فقراه الحسين× حتى
أتى على آخره ثُمّ جلد[273] به الأرض، فقال: ما كنتُ أبايع لزيد قط، ولا أطيع له. فقاله[274] مروان:
تبايع أمير المؤمنين. فقال الحسين×: كذبتَ ويلك يا بن الزرقا[275]، يا طريد رسول الله، وإنّك لتعلم أنّك كاذباً[276] في قولك؛
نحن المؤمنون فمن أمرّه علينا؟! فعند ذلك وثب مروان وجرّد سيفه، ودفعه إلى الوليد،
فقال له: حتى ما أصنع؟ فقال له مروان: تدفعه إلى سيّافك وتأمره أن يضرب عنق الحسين
بن فاطمه، وتمتثل فيه أمر صاحبك. فقال له الوليد: ويكون جدّه وأبوه خصماي[277] يوم
القيامه! فأقبل الحسين× على مروان وقال: ويلي[278] عليك يا بن
الزرقا والله لا كان ذلك[279] حتى يكون هنات وهنات[280]، وتذهب نفوس
وتطير راوس[281]. وعلى[282] كلامهما،
فسمعوه أهلهم[283] ضجتهم[284]، فكان أوّل
مَن جرّد
سيفه ـ وهجم عليهم الدار ـ علي بن الحسين الأكبر[285]، وعلي
الأصغر[286] والعباس[287] ويحيى بن علي[288]
وأبو[289] بكر بن علي[290] وإبراهيم بن
علي[291]
وحمزه بن علي[292] وجعفر بن
علي[293] وعمر الأصغر بن علي[294] ومطهر بن علي[295]
والقاسم بن الحسن بن
علي[296]
ومحمد بن عبد الله بن جعفر الطيار[297]
وعون بن عبد الله بن جعفر الطيار[298]
ومحمد بن الحسن[299]
وعبد الله بن الحسن[300]
ومسلم بن عقيل[301]
وعبد الله بن عقيل[302]
وعبد الرحمن بن عقيل[303] ومحمد
بن عقيل[304]
(سلام الله عليهم أجمعين)[305]،
فهجموا
عليهم وهمّوا بأن يضعوا سيوفهم فسكّنهم[306]
الحسين× وحبسهم[307]
عما عزموا عليه، وقال لهم مهلاً فإنّا أهل بيت نحسن لمن يسي[308] إلينا. ثُمّ خرجوا عن الدار، فقال
مروان: والله إذا خالفتَ أمري ليطولَنَّ عليك ما تراه مرة أخرى، ولم تقتله وتدعه
حتى تقوى شوكته. وجعل يسفّه رأيه كمنفٍ[309] لمن يقتله. فقال له الوليد: ويحك،
والله ما أردتَ بي إلّا ما تذهب بديني ودنياي وآخرتي، وتبقى لي في المخازي ذكراً
مويداً لا يفنا وأبؤا[310]
بغضب من الله.
وبلغ بن الزبير ما جرى للحسين× مع الوليد فرحل فلحق بمكه، وأقام بها. وكان يجلس للقضا والحكم ثُمّ لحق به مولا[311] الحسين× ومعه أهله ومواليه وبنوا[312] عمه[313]. وبلغ الناس قدوم الحسين مكه فأقبلوا يهرعون[314] إليه من كلّ جانب وفج[315] وواد. وكان الحسين× يجلس في مجلس وابن الزبير في مجلس[316].
8ـ قال أبو مخنف: وبلغ يزيد
نزول الحسين× وعبد الله ابن الزبير مكه فصعب عليه، ثُمّ استدعا[317]
بدواة وبيضا[318] وكتب
إلى عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) كتاب[319] وهو فيه[320]: بسم الله
الرحمن الرحيم؛ أمّا بعد فإنّ عمك[321]
حسين وبن الزبير التويا[322]
عن بيعتي ولم يطيعا، مرصدي الفتنه معرض[323] أنفسهما
للهلكه، فأمّا بن
الزبير فإنّه إن خالفنا قتلناه، وأمّا
حسيناً[324] فقد أحببتُ أن أعتذر إليكم أهل
البيت فيما كان منه؛ فإنّه قد بلغني أنّ رجالاً من شيعته من أهل العراق يكاتبهم
ويكاتبونه، ويمنيهم الإمارة ويمنونه الخلافه. وقد تعلمون ما بيننا وبينكم من القرابه
ونتايج[325]
الأرحام وعظيم الحرمه وقد قطع ذلك حسيناً[326] وبثه[327]، وأنت زعيم أهل بيتك وسيد بلادك
ولا حافر لأحد مراده، فكم حافر أراد غيره فوقع فيه. فاتقى[328]
الله في أهل بيت نبيك (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، وكم آمل لم يدركه، وكم راجٍ
طول عمره وسعة أجله فبينما هو كذلك إذ أتاه أجله بانقضا[329] أمله وبت عمره وأنف كأس[330]
دهره وخرجه[331] عن سلطانه إلى سلطان الله وقدرته.
فاقبل ما أقول لك من النصيحه، واتق الله في دماً[332]
هذه الأمه، وخذ بحظك من الصلاه والركوع والسجود والصيام في آنأ[333] الليل ويناسير[334]
النهار، ولا يشغلنّك عن ذات الله شاغل؛ فإنّ ملاذ الدّنيا يفنى ويزول، وكل ما
عملتَ من التقوى تبقى فاجمع همّك فيما يرضى ربك يكفيك[335]
فيما أهمّك، ولا تُرضِى[336]
المخلوقين بسخط الخالق. وانظر حسيناً ولا تعجل لعلّ الله أن يجمع شملاً ويَشْعَب
صَدْعاً[337]
ويسلم[338]
شعثاً، واكتب إليّ بكلما[339] يحدّث قلبك من حاجة، والسلام. هذا
ما كان من أمر يزيد[340].
[مكاتبة أهل الكوفة للإمام الحسين×]
9ـ قال أبو مخنف: وبلغ أهل الكوفه موت معاويه، ومسير الحسين× من المدينه إلى مكه، وما جرى له مع الوليد بن عتبه بالمدينه[341].
10ـ قال أبو مخنف: فلم يزالوا[342] أهل الكوفه في هرج ومرج[343]، ومشاوره حتى اجتمعوا بسيّدهم ورايسهم[344] هاني بن عروه المدحجي[345] (رضي الله عنه)، وقالوا: يا أبا الدّيان اعلم أنّ صاحب هولا القوم قد مات ـ يعنون به معاويه ـ قد[346] وَلى الأمر من بعده يزيد ابنه، وقد قصدناك لتشير علينا فيما نفعله برأيك؟ فقال لهما[347]: الرأي عندي أن تكتبوا إلى سيدكم وبن سيدكم الحسين بن علي (صلوات الله عليهم وسلامه)، وتكون الكتب كلّها على لسان رجل واحد، وتسيلونه[348] القدوم عليكم، والمصير إليكم. فعند ذلك اجتمعوا راوسا[349] الكوفه جميعهم، وكتبوا إلى الحسين× كتاباً يقولون فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أمّا بعد يا بن محمد المصطفى وعلي المرتضى أقدم علينا وسير[350] إلينا؛ يكون لك ما لنا، وعليك ما علينا، فإنّ لك الوفا بذمتنا، وعهد الله لك في أعناقنا أن نذب[351] عنك بأسيافنا، ونطعن برماحنا ونجاهد بين يديك بمجهودنا، واحكم فينا بحكم جدّك (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، فإنّا بذلك راضون وبه مؤمنون. واعلم يا أبا عبد الله أنّك تقدِم على جنود مجنّده، وأعوان على طاعتك متآلفه. وإن تقدر على مجيك[352] فابعث إلينا مَن ترتضيه من أهل بيتك، يحكم فينا بالحكم الذي أنزله الله} على جدّك (صلى الله عليه [وآله] وسلم) وأبوك[353]×، العجل العجل الوحا الوحا[354] الله الله.
ولم تزل الكتب منهم تتواتر، والرسل تتبادر حتى ورد إليه في تلك السنه[355].
11ـ في روايه أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن حنبل[356] (رضي الله عنه) ـ قال بإسناد يرفعه إلى الزبير بن الحرث ـ قال: حدثني غالب بن همام الفرزدق[357]، قال: لقيتُ الحسين بن علي× بذات عِرق[358] حين توجّه إلى الكوفه فقال له: إنّ معي حمل بعير من كتبهم.
[إرسال مسلم بن عقيل× إلى الكوفة]
فلمّا تواترت الكُتب إلى الحسين× استدعا[359] بن عمر بن مسلم بن عقيل[360] (رضي الله عنه) وقال له: اعلم أنّ كتب هولا القوم قد تواترت عليّ بسبب المصير إليهم[361]، وأنّي لاستحي من الله أن أقعد عن نصرة قوم قد استنصروني، وقد رأيتُ من الرأي أن أنفذك إليهم لتأخذ البيعه عليهم، وتنتظر مَن يبايع ومَن يمتنع، فإذا بايعك الناس فاكتب إليَّ حتى أصير إليك. ثم كتب معه وما[362] أراد، واستدعا دليلان[363] يدلّانِه الطريق.
12ـ قال عبد الله أحمد[364] بن حنبل (رضي الله عنه): فاستقبل مسلم طريقه الأدلا[365] فضلّوا طريقهما وأصابهما عطشاً شديداً[366]، فمات أحدهما ووقع الآخر على الجاده[367] ومكثا يومان[368] لم يطعما شياً[369] فاستدعا مسلم بن عقيل (رضي الله عنه) بدواه وقرطاس وكتب إلى الحسين×: أمّا بعد يا سيدي، اعلم أنّ الأدلا غلطا الطريق فمات أحدهما عطشاً، ووجد الآخر طريقه. فإذا قرأتَ كتابي فاعفني من هذا المسير فإنّا قد بقينا يومان[370] لم نطعم فيهما شياً لا من طعام ولا من شراب. ثُمّ دفع الكتاب إلى قوم طالبين[371] مكه، وقال لهم: سلّموا هذا الكتاب إلى الحسين×. فأخذوا[372] القوم الكتاب وساروا، فلمّا وصلوا إلى مكة سلّموا الكتاب إلى الحسين×. فأخذ الحسين وفضّه وقراه وفهم معناه، ثُمّ كتب إلى مسلم كتاباً يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أمّا بعد يا بن العَمّ فإنّي أخبرك أنّي سمعتُ جدّي رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) يقول: ما فينا من تطيّر[373] ولا من يُتطيّر به[374]. فإذا قرأتَ كتابي هذا فسر على اسم الله تعالى لما أمرتُك به، والسلام.
ومكث مسلم مكانه يومين حتى عاد له جواب الحسين إليه[375] فلمّا قراه سار من وقته وساعته مجدّاً حتى قدم الكوفه[376].
وأقبل إلى دار سليمان بن صرد الخزاعي[377].
في[378] رواية أخرى حتى دخل الكوفة ليلاً
فنزل دار المُختار بن
عبد الله[379] الثّقفي (رضي الله عنه)[380] فجعل الناس يختلفون إليه، وقرا
عليهم كتاب الحسين×[381]
فقام عابس بن أبي حبيب البكري[382] فحمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر
النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، وقال: يا بن عم رسول الله إنّي لستُ أعلم بما
في قلوب الناس، ولكنّي أخبرك بما في نفسي، وإنّي إذا دعوتَني أجبتُك، وإذا أمرتَني
أطعتُك، وأجاهد بنفسي بين يديك حتى ألقا[383]
الله تعالى. ثُمّ جلس فقام من بعده حبيب بن مُظاهر[384] (رضي الله عنه)، فقال: يرحمك الله
قد قضيتَ ما أوجب عليك، وإنّا ـ والله ـ على مثل ما ذكرتَ[385]،
وجعل أهل الكوفه يدخُلون عليه عشـره عشـره وعشـرين عشـرين، وأقلّ وأكثر، ويبايعونه. فبايعه في ذلك اليوم من أوله
إلى آخره ثمانون ألف رجل[386].
قال[387]: وبلغ ذلك النّعمان بن بشير ـ وكان خليفة يزيد على الكوفه ـ فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، وذكر النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، وقال: معاشر الناس، إنّي والله لا أقاتل من لا يُقاتلُني، ولا أثب على مَن لا يثب عليّ إليَّ[388]، واحذروا الفتنه وشقّ العصاه[389] على السلطان؛ فإنّه والله إن صحّ عندي ذلك أحد[390] منكم لأضربَنَّ عُنُقه، ولو لم يكن لي ناصرٌ ولا ولا[391] معينٌ. فقام إليه عبد الله بن شُعبه الحضرمي[392]، وقال له: أيّها الأمير إنّ هذا الأمر لا يتم الاّ بالقهر وسفك الدّما، وهذا الذي تكلّمتَ به كلام المستضعفين في ذات الله. ولا أكون من الظالمين[393]، ثُمّ نزل من على المنبر، وخرج عبد الله بن شُعبة (لعنه الله)، فكتب إلى يزيد كتاباً يقول فيه: من عبد الله بن شُعبه إلى أمير المؤمنين يزيد بن معاويه، أمّا بعد فإنّ مسلم بن عقيل قد قدم إلى الكوفه، وقد بايعه شيعة الحسين×. فإن كان لك في الكوفه حاجه فانفذ إليها رجُلاً قوياً، فإنّ النّعمان ضعيف[394]. ثُمّ كتب له عمر بن سعد (لعنه الله) بمثل ذلك[395].
قال: فلمّا اجتمعت الكتب عند يزيد فدعا مولا[396] له يقال له: سَرحُون[397] فقال له: أمَا تنظر إلى حسين بن علي كيف قد أنفذ إلى العراق بن عمّه مسلم بن عقيل، وهو بايع أهل الكوفه. وقد بلغني أنّ النّعمان بن بشير ضعيف فيهم. ثُمّ قرا عليه الكتب الذي[398] جات من عند أهل الكوفه، وقال له: ما عندك من الرّأي؟ فأشار عليه بتوليه عبيد الله بن زياد، وعزل النّعمان بن بشير، ففعل ذلك، وضمّ إليه المصريين[399] من الكوفه كتبوا إلىَّ يخبروني[400] بأنّ مسلم بن عقيل بالكوفة يجمع الناس ويبايعهم للحسين× وقد نقضت كنانتي[401]، فلم أجد فيها سهماً أرمي به عدوّي أجرى[402] منك، فإذا قراتَ كتابي هذا فارتحل من وقتك وساعتك إلى الكوفه، ولا تدع من نسل علي بن أبي طالب أحداً. واطلُب مسلم بن عقيل فاقتُلهُ وابعث لي به، والسلام.
ودفع الكتاب إلى مسلم بن عمر الباهلي[403]، وقال له: سِر إلى البصره، وادفع هذا الكتاب إلى بن زياد فلمّا أتاه وقراه تاهّب[404] للسير إلى الكوفة[405].
[دخول رسول الإمام الحسين× إلى البصرة]
فبينما هو كذلك إذ قَدِمَ عليه رسول[406]
من الحسين إلى روسا[407]
البصره والأشراف منهم يدعُوهُم إلى
نصرته والجهاد بين يديه، منهُم: الأحنف بن قيس التميمي[408]
وعبد الله بن عمر[409] والمنذر بن الجارود[410]
ومسعود بن عمر الأسدي[411]
وعمر بن عبد الله القرشي[412]
وقيس بن القاسم بن حباب[413]
وغيرهم بنُسخةٍ واحده، يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي بن أبي
طالب (رضي الله عنه) إلى شيعته ومواليه من أهل البصره، أمّا بعد فإنّ الله تعالى
اصطفى محمداً (صلى الله عليه [وآله] وسلم) على جميع خليقه[414]
واكرمهُ بنُبُوّته وحباهُ برسالته ثُمّ قبضه إليه[415]
(فصلاة الله وسلامه)[416]، وقد نصح لعباده وبلّغ ما أُرسِل
به في جميع البلاد، وكان أهله وأولياوه وأصفياه[417]
وذريته أحقّ الناس بمقامه من بعده. وقد تأمّر[418]
قوم علينا من بعده فسلّمنا ورضينا كراهية الشرّ وطلب الخير، ونحن أحقّ بذلك ممّن
تولا[419]
علينا ظلماً وعدواناً. وقد بعثتُ إليكم كتابي هذا وأنا أدعوكم إلى كتاب الله
وسُنّة رسول الله، فإن سمعتم قولي، واتّبعتم أمري أهديكم[420]
إلى سبيل الرّشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[421].
قال: فلم يبق أحدٌ من الأشراف ممّن قرا الكتاب إلاّ وكتمه، ما خلا المنذر بن الجارود، وكانت بنتُهُ تحت عبيد الله بن زياد (لعنه الله)، وكان اسمه[422] الرسول ذراعاً، وكان أخاً للحسين من الرضاع[423] فلما قرأ ابن زياد كتاب الحسين× أمر بالرسول فضُرِبت عُنُقه، وصُلِب على بيت المال في محلة بني سدوس[424]، وكان ذراع أوّل رسول قُتِل في الإسلام[425].
ثُمّ إنّ بن زياد (لعنه الله تع[426]) صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه[427] ثُمّ قال: يا أهل البصره، فإنّ الخليفه يزيد بن معاويه قد ولاّني الكُوفه، وقد عزمتُ على المسير إليها، وقد استخلفتُ عليكم عثمان بن زياد بن أبي سفيان[428]، فاسمعوا قوله، وأطيعوا أمره، واحذروا مخالفته. وإياكم والزخارف[429] والخلاف، فوالله لإن[430] بلغني أنّ رجلاً منكم خالف أمره لاقتلنّ عزيزه ووليّه، ولآخذنّ الأدنى بالأقصى، والأصغر بالأكبر، والشاهد بالغايب، والجار بالجار، حتى تستقيموا ولا تكونوا فتنة أبداً[431].
ثُمّ خرج من البصره يريد الكوفه[432] ومعه عشيرتُهُ ومواليه وأشراف أهل البصره منُهم مسلم بن عمر الباهلي والمنذر بن الجارود العبدي وشريك بن الأعور الحارثي[433].
وسار حتى دخل الكوفه وكان دُخُولُه ممّا يلي البرّ وعليه ثياب بيض، وعمامه سودا مُلثمّاً كلثمام[434] الحسين×، وهو راكب بغلةً شهبا، وبيده قضيب خيزران متشبهاً بالحسين×. وكان قُدومُه يوم الجمعة وقت انصراف الناس عن الصلاه، وهم يتوقّعون قُدوم الحسين×، فجعل لا يمُرّ على ملاء[435] إلّا ويُسلّم عليهم بالقضيب، وهم يردّون عليه السلام، ويقولون له: السلام عليك يا بن رسول الله، ولا يشكُون إلّا أنّه الحسين وهو على بغلة رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم).
قال: فلمّا رأى بن زياد (لعنه الله) تباشر الناس بالحسين ساه[436] ذلك وعظم عليه وكبر لديه، فلمّا قرب من قصر الإمارة قال مسلم بن عمر: تأخّروا عن الأمير عبيد الله بن زياد، فما هو طَلِبتكُم[437]. فانكشفوا من ورايه[438]، وأشرف عليه النّعمان بن بشير من أعلا القصر، وهو يظُنُّ أنّه الحسين قد سبق إلى الكوفه، فكشف بن زياد لثامه، وقال: يا نعمان، حصّنتَ نفسك، وضيّعتَ مصيرك[439].
ثُمّ نادى في الناس الصلاه جامعه ففعل ذلك واجتمع خلق كثير فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم) وقال: يا أهل الكوفه هل تعرفوني؟ قالوا: نعم أنت الحسين بن علي بن أبي طالب. قال: ما أنا الحسين، بل أنا عبيد الله بن زياد[440]، سيف أمير المؤمنين يزيد بن معاويه، وقد ولاّني عليكم، وأمرني إنصاف المظلوم من الظالم، وإعطا[441] المحروم، والإحسان إلى محسنكم، والتجاوز عن مسيكم[442]، وأنا مُتّبع بكم أمره[443].
ثُمّ نزل من على المنبر وأمر مُناديه أن ينادي في قبايل[444] العرب بالكوفه أن يلمّوا[445] على بيعة يزيد بن معاويه من قبل أن يبعث إليكُم من الشّام رجالاً يقتلون رجالكم ويذبحون أطفالكم ويستحيون نساكم[446].
فلمّا[447] سمع أهل الكوفه ذلك منه جعل بعضهم ينظر إلى بعض، وقالوا: والله ما لنا بطاقه[448]، وما لنا وللدّخول بين السّلاطين. فنقضوا بيعة الحسين×، وبايعوا يزيد بن معاويه بغير درهم ولا دينار[449].
[ما جرى لمسلم بن عقيل× في الكوفة]
قال[450]:
وكان مسلم بن عقيل قد أصبح في ذلك اليوم متوعكاً[451]
لم يخرج إلى الصلاه فلمّا كان وقت الظُّهر خرج إلى باب المسجد فأذّن وأقام الصلاه
وحدهُ ولم يصلى[452]
معه أحد منهم[453]
أهل الكوفه، وقد كان بايعه منهم في يوم واحد ثمانون ألف رجل[454]
فلمّا فرغ من الصلاة فإذا هو بغُلام، فقال له: يا غلام ما فعلوا أهل الكوفه[455]؟
فقال له: يا سيّدي إنّهم نقضوا بيعة الحسين× وبايعوا يزيد فلمّا سمع مسلم ذلك صفق
يداً على يدٍ، وجعل يخترق الشوارع والدرُوب[456]
حتى وصل إلى محلّه بني خُزيمه[457] وهم الصَيارِفُ[458] فوقف بجانب باب شاهق[459] ينظر إليه. فخرجت إليه من الدار
جارية سودا، فقالت له: يا فتا[460]
ما لك واقف بباب هذه الدار؟ فقال لها: هي لمَن؟ قالت له: لهاني بن عروه المدحجي،
فعرفه مسلم، فقال لها: يا جاريه ادخلي عليه وقُولي له: رجل من أهل البيت، فإن
سألكِ عن اسمي فقولي له: اسمه مسلم بن عقيل. فدخلت الجاريه وخرجت إليه، وقالت له:
ادخل يا مولاي، فدخل مسلم، وكان هاني مريضاً، فنهض ليعتنقه، فلم يطق النهوض، وجلسا
ليتحدثان[461]، حتى جرى في حديثهما إلى عبيد
الله بن زياد (لعنه الله). فقال هاني: يا أخي اعلم أنّه صديق لي، ويصله أنّي مريض
فيركب ويأتيني يعودني، فخذ أنت هذا السيف وادخل بهذا المخدع[462]،
فإن جلس هو، ودونك[463] فاقتله. واحذر أن يفوتك، وإن أنت
لم تقتله قتلك. والعلامة بيني وبينك أن أقلع[464] عمامتي من على راسي، وأضعها على
الأرض؛ فإذا رأيت ذلك فاقتله. فقال مسلم: أنا أفعل ذلك إن شا الله تعالى.
[زيارة ابن زياد لهانئ بن عروة&]
ثُمّ إنّ هاني بن عروه أرسل إلى ابن زياد ويستجفيه[465] كيف لم يعهده! فاعتذر إليه، وقال: والله ما علمتُ بمرضك، وأنا رايح[466] إليك العشيّه إن شا الله تعالى.
قال: فلمّا صلّى العصر[467] ركب فرسه، وأقبل وأقبل[468] إلى هاني يعُودُه، ومعه حاجبه، فقيل لهاني: إنّ ابن زياد بالباب يريد الدّخول إليك. فقال لجاريته: ادفعي السّيف إلى مسلم، فدفعته إليه، فأخذه ودخل المخدَع، ودخل عبيد الله بن زياد، ومعه حاجبه على بن هاني[469]، وجلس إلى جانبه، وجعل يحُادثُه ويسأله عن حالته وعلّته. وهاني لا يشكوا[470] إليه، وهو مع ذلك يستبطي مسلم[471] في خروجه، فقلع عمامته عن راسه ووضعها على الأرض، ورفعها من الأرض ووضعها على رأسه، ولم يزل يفعل ذلك ثلاث مرّات، ومسلم في موضعه لم يخرج. فرجع يرفع صوته كأنّه يهذي[472]؛ ليسمع مسلم[473] ما يقول ويتمثّل بهذا الشعر يقول:
ما الانتظار
لمسلما[474] لا يحُييها |
وجعل يردّدها وبن زياد لا يفطن ويسمع التهديد. فلمّا كثُر ذلك عليه، فقال: ما شان الشيخ أراد[478] يهذي؟ فقيل له: أيها الأمير من شدّة المرض. ثم إنّ ابن زياد خرج من عنده، وركب فرسه، وأتا[479] قصره. وخرج مسلم بن عقيل بعد ذلك، فقال له هاني: يا سبحان الله! ما الذي منعك عن قتله؟ فوالله لم تظهر[480] به بعد هذا اليوم أبداً.
فقال: منعني عن ذلك خبر سمعتُه عن أمير المؤمنين[481] قال: لا يمان[482] لمن يقتل مسلماً أو مؤمناً[483]. فقال له هاني: أما والله، لو قتلتَه لقتلتَ فاجراً كفاراً[484]، ولكن خشيتَ أن تُقتَلَ به[485].
ثم إنّ بن زياد (لعنه الله) دعا مولا[486] له يقال له معقل[487]، وكان داهية دهيه، فأعطاه ثلاثه آلاف دينار[488] وقال له: أريدك تدور في الكوفه، وتسال عن مسلم بن عقيل وأصحابه، وتستانس[489] لهم، وتعطيهم هذه الدنانير، وتقول لهم: استعينوا بها على حرب عدوِّكم، وتعلمهم أنّك من أصحابهم وأنصارهم وشيعتهم؛ فإنّك إذا فعلتَ ذلك اطمانّوا إليك، ووثقوا بك، ولم يكتمونك[490] شياً من أمورهم، ثم تغدوا[491] وتروح إليهم، وتعدوا[492] إلىَّ بالخبر. ففعل معقل ذلك، وخرج يدور في دروب الكوفه، ويجلس في المجالس والمحافل ويصلي في المساجد ويتجسّس الأخبار، ويقفوا[493] الآثار، حتى وقع على مسلم بن عوسجه الأسدي[494]، وكان صاحباً لمسلم بن عقيل (رضي الله عنه)، وهو يصلي في المسجد، فجلس حتى فرغ من صلاته، ثم قام إليه وسلم عليه، واعتنقه، وأظهر له شرفه وإعظامه وإجلاله وإكرامه، وقال له: يا أبا عبد الله[495]، اعلم رجل من[496] أهل الشّام، وقد أنعم الله عليّ بحبّ أهل البيت، وبحبّ من يحبّهم، ومعي ثلاثة آلاف دينار، وقد أحببتُ أن ألقى هذا الرجل الذي قد قدم إلى الكوفه يبايع الناس لابن بنت رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، ولستُ أعرف مكانه، وأحبّ أن تدخلني عليه، وتوقني[497] بين يديه، فأنا ثقة من ثقاته، وعندي كتمان أمره والنصره له على عدوه.
فقال له مسلم بن عوسجه: يا أبا عبد الله، لقد سمعتُ منك ما لا أحبّ سماعه، وما لنا وأهل البيت؟! أعرض أعرض[498] عن هذا الكلام[499]. فقال معقل: يا أبا عبد الله لستُ ممّن تكره، ولقد أُرشِدتُ إليك فلا تقطع بي مما طلبتُ. وإن كنتَ لا تثق بي فخذ عليّ العهود والمواثيق بما تريد. فلمّا سمع كلامه صدّقه، ثُمّ قال له: أن تحلف لي يميناً: إن فويتَ[500] نجوتَ، وإن نكثتَ هلكتَ. فقال له: دونك وما تريد. فاستحلفه، وأخذ عليه إيماناً موكده[501]، ولم يزل يختلف إليه بكره وعشيه، حتى أدخله عليه، يعني على مسلم بن عقيل، ثُمّ أخبره بجميع خبره من أوله إلى آخره، فوثق به مسلم، وأخذ ببيعته. وأخذ أبو ثمامه الصيداوي[502] المال منه، وكان هو الذي يقبض المال الذي تخرجه الشيعه؛ ليستعين به على يزيد، وهو الذي يشتري السلاح والعده، وكان فارساً من الفرسان[503]، وصار داخلاً وخارجاً، وهو مع ذلك يسمع أخبارهم، ويأخذ أسرارهم وينطلق بها إلى بن زياد[504].
فلمّا صح عنده ذلك بمحمد[505] بن الأشعث الكندي[506]، وأسما[507] بن خارجه الفزاري[508]، وعمر بن الحجاج الديبا[509]، وكانت بنت عمر بن الحجاج[510] تحت هاني بن عروه، فانطلقوا إليه فوجدوه عرضت له إليك، وقد أمرنا بحضورك، فقام مع القوم[511] حتى إذا دنى[512] من القصر حسّت نفسه ببعض ما كانت[513] تنويه[514]، فقال لأسما بنت[515] خارجه: إنّي خايف من هذا الرجل، ونفسي تحدّثني بما أكرهه. فقال له: والله يا أخي[516] ما أتخوّف عليك منه شياً، وسار معه حتى دخل على بن زياد. فلمّا رآه بن زياد أعرض عنه، وكان يكرهه فأنكر هاني أمره عند ذلك[517].
ثُمّ إنّ هاني[518] سلم عليه
فلم يردّ عليه السلام. فقال له: ماذا أصلح الله الأمير؟ فقال له: يا هاني خبيت[519]
مسلم بن عقيل في ذلك[520]، وجمعتَ له
الرجال والسلاح، وظننتَ أنّه يخفى علينا، فقال: معاذ الله! فقال: معاذ الله[521]
أيّها الأمير أن أفعل ذلك. فقال بن زياد: قد فعلتَ ذلك، وأنّ الذي أخبرني به لأصدق
عندي منك. ثم قال: يا معقل، اخرُج فكذّبه. فخرج معقل، فقال: مرحباً بك يا هاني
أتعرفني؟ فقال: نعم أعرفك فاجراً كاذباً كافراً. ثُمّ علم هاني عند ذلك أنّه كان
عيناً لابن زياد (لعنه الله)، وأنّه أخبره بجميع بما[522] كانوا عليه.
ثم إنّ بن زياد قال لهاني: والله، لا أفارقك أو تأتيني بمسلم بن عقيل. قال: فغضب
هاني من كلامه،
وقال: إذاً والله لا تقدر على ذلك أو تهرق سيوف مدحج[523] دمَك. فغضب
بن زياد من كلامه وضرب وجهه بقضيب كان معه، فضرب هاني بيده إلى قايم سيفه وأهوى به
على بن زياد فجرحه جرحاً منكراً فاعترضه معقل بالسيف هاني[524]
فقطع نصف وجهه، فنادى بن زياد: ويلكم خذوه على راوس[525] الرماح، وشفار[526]
الصفاح[527]. فداروا من
حوله، فجعل يقاتل فيهم حتى قتل منهم اثنى عشر رجلاً، وهو يقول: والله لولا[528]
أنّ رجلي على طفل من آل محمد لما رفعتُها عنه حتى حتى[529]
تقطع[530].
قال: وكان سيف صارم لا يعلوا[531] به أحد فيعود إليه، فتكاثروا[532] عليه الرجال، وداروا[533] من حوله الأبطال، فضرب فيهم حتى اتقطع[534] السيف وجرح أكثرهم، فحملوا عليه حملة واحدة، فأخذوه أسيراً، وأوثقوه كتافاً، وأوقفوه بين يدي عبيد الله بن زياد، وكان بيده عمود من حديد، فضـربه على صفحة جبينه، فقتله (رحمة الله عليه). فأتى الصياح إلى قومه فأتوا إلى قصـر الإماره، وأحاطوا به، فسمع عبيد الله بن زياد الضجه، فقال: ما هذه الجلبه[535]؟ فقالوا له: هذه مدحج قد أقبلت في السلاح من أجل رايسهم[536] وعميدهم هاني بن عروه. فأقبل عبيد الله ابن زياد (لعنه الله) على حاجبه، وقال: اخرج إلى هولا فسكّتهم، فأشرف عليهم من أعلا القصر، وقال: مهلاً يا مدحج فإنّ هاني حياً[537] لم يمت، فلم يصدّقوه، فأخرَج إليهم القاضي شريح[538] فقال لهم: مهلاً مهلاً يا مدحج؛ فإنّ هاني[539] لم يمت، وإنّما اعتقله الأمير لأمر يساله عنه[540].
13ـ وفي روايه أبي[541] عبد الله بن أحمد بن حنبل (رضي الله عنه) أنّه قال: قال وهب بن جرير بن حازم عن أبيه انّه قال: لمّا طلب عبيد الله بن زياد (لعنه[542]) مسلم بن عقيل من هاني بن عروه أنكره ولم يعترف، فقال له عبيد الله: أتحلف بالطلاق والعتاق أنّك ما تعرف له موضع[543] ولم تعلم له علماً؟ فقال هاني (رضي الله عنه): إنّكم ـ بابني[544] زياد ـ لا ترضون إلّا بهذه الأيمان الخبيثه؛ لأنّكم ترجون إلى أديانكم وتتّكلون عليها في معاصيكم ومعادكم، وتنالون لها التاويل. فعند ذلك ضربه بن زياد (لعنه الله) بالعمود. وهو الصحيح[545].
14ـ وفي روايه أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن
حنبل بإسناد يرفعه
إلى شيوخه أنّ عبيد الله بن زياد (لعنه
الله) لم يعلم بمستقر مسلم بن عقيل إلّا بحيله عملها ومكيده فعلها؛ وذلك أنّه دفع
إلى مولى له ثلاثه آلاف درهم، وأمره
أن يطلب مسلم بن عقيل، وقال له: إذا وصلتَ إليه فقل له: أنا رجل من
أهل حمص، جيتُ في سبب نصره أبي عبد الله الحسين، ومعي مالاً له أستعين به، وأقوّي
به إخواني في هذا الأمر، وأريد أدفعه إليك حتى تقوّى ما أنت عليه.
وأخذ الغلام المال، وجعل يستدلّ على الرجل الذي عنده مسلم بن عقيل. وكان عند مسلم
بن عوسجه وساله عنه، فقال: مالي به علم ولم يزل يتردّد إليه، ويلج[546]
عليه حتى أنس به مسلم بن عوسجه، وأدخله على مسلم فأخذ منه المال
وبايعه. وكان في ذلك اليو[547]
قد بايع لمسلم الرفا[548].
وكان في مجلسهم رجل يهودي[549]
يزيد بن معاويه، فقال[550] له عبيد الله الحضرمي، فقام إلى
النعمان بن
بشير[551]
فقال له: إنّك لضعيف أو مستضعف. فقال: وما ذاك؟ فقال له: إنّك قد أفسدتَ المصير[552]. فقال له النعمان: أكون ضعيفاً في
طاعة الله أحبّ إليَّ من أن أكون قوياً في طاعة المارد اللعين، وما كنتُ لأهتك ما
ستره الله.
قال: ثُمّ خرج مِن عند مسلم بن عقيل (رضى الله عنه) فأخبر لابن[553] زياد خبر مسلم بن عقيل بطلبه، فخرج من عنده مسلم بن عوسجه أتى دار رجل من شيعته[554]، وقد تحقّق أنّها مكيده عليه. ثُمّ جمع له أربعة آلاف رجل من أهل الكوفه وعبّاهم[555] قلب[556] وجناحين وميمنهم وميسرهم[557]، وأقبل إلى باب قصره[558] الإماره وكان عبيد الله زياد[559] (لعنه الله) قد أقعد عشاير الكوفه، فجعلوا يكلّمونه وردّدهم[560]، وأصحا[561] مسلم يتسلّلون ويرجعون عنه، الواحد، والخمسه، والعشره، والأقل والأكثر، حتى بقى معه خمس مايه فارس. ثم اختلط الظلام...[562] وتفرّق عنه مَن بقي معه، فعند ذلك أقبل يطلب لنفسه النجاه، حتى أتى دار هاني، وأنفد[563] بن زياد خلف هاني، وساله عن مسلم بن عقيل، فأنكره، فأخرج عند ذلك صاحب الدراهم، فوافقه وجرى على هاني[564].
فهذه الروايات التي ذكرتُها فأحببتُ أنّي لا خل شي[565] منها.
15ـ قال أبو مخنف: ثُمّ إنّ مسلم بن عقيل لمّا عرف ما
قد تمّ على هاني خرج هارباً يخترق السكك والشعاب؛ يطلب لنفسه (رضى الله عنه)
مخلصاً[566]،
إلى أن خرج عن الكوفه[567]
وأتى إلى الِحيرَه[568].
فنظر إلى امرأة[569] جالسه على باب. فوقف بإزائها ينظر
إليها ثُمّ إنّه أطال وقُوفه؛ فصاحت: يا فتى، ما وقوفك على باب هذه الدار وفيها
محرماً[570] لغيرك؟! فقال: والله، يا أختي ما
خطر ببالي شياً[571]
ممّا قلتي[572]، ولا ضممتُ[573] بشـيء مما ذكرتِ. وإنّما أنا رجل
هارب مظلوم
مخيف مطلوب. فقالت له المرأه: ومن يطلبك؟ فقال: عبيد الله بن زياد، وإنّي
أريد من يجيرني بقيّت[574]
نهاري، فإذا جنّ الليل طلبتُ لنفسـي مخلصاً وخرجتُ
عن مصـركم. فقالت: ومن أيّ الناس أنت؟ قال: فقال: قريشاً[575]. فقالت:
من أيّ قريش؟ فقال: من عبد المطلب، فقالت: من أيّ عبد المطلب؟ فقال:
من هاشم. فقالت: من أيّ هاشم؟[576] فقال: من أجلِّها حسباً، وأثبتها نسباً،
وأزكاها شجرةً، وأطيبها ثمرةً، وأطولها باعاً، وأسترها قناعاً، وأعزرها[577]
فجاجاً[578]،
وأضؤها[579] سراجاً، وأنضـرها عوداً، وأطولها
عموداً. فقالت له:
لج[580] البيت ـ يا سيّدي ـ فأنا ـ والله ـ
أحق مَن أجارك، وحمي ذمارك، وكان من أنصارك، فدخل مسلم. وقد وطّيت[581] له بيتاً في أفضـى[582] الدار، فجلس وحده، وجلست منه
قريباً؛ لأن لا يكون له حاجه فتشـرع في قضائها. فلما هجم[583] الظلام وجنّ اللّيل، وقد همّ مسلم
بالانصراف، إذ أقبل ابن المرأه، وكان أبوه من قوّاد عبيد الله بن زياد، فنظر إليها
وهي تُكثر الدخول والخروج إلى ذلك البيت. فقال: مال[584]
أراكِ تتردَّدين منذ الليله؟ فقالت: من أجل رجل استجارني البارحه. فقال لها: لا
يكون مسلم بن عقيل الذي يطلبه الأمير عبيد الله بن زياد؟! ثم جعل يسارق[585]
اُمّه النظر حتى أثبت صفته، وحقّق معرفته، فلّما عرفه، قال لها: يا اُمّاه أكرميه؛
فقد والله أحسنتِ إذا أجرتيه. فقالت له: والله يا بني مالي به علم، ولا أعرفه.
وبات الغلام على باب البيت ليلته. فلمّا كان وقت
السحر انتبه
فرأى العجوز وهي تَغِطُّ[586]، ومسلم قايم يصلي وهو يقرى[587]
خاتمه
يس[588].
ومنهم مَن قال: إنّه كان يقرى (إِنَّا
فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا)[589]. قال: فخرج الغلام وفتح الباب
قليلاً قليلاً، وأقبل يسعى حتى وصل إلى باب قصر الإماره، فدخل الدِّهليز[590]،
ثُمّ إنّه جعل سبابتيه في أذنيه، ونادى: النّصيحه النّصيحه. فقال له أبوه: ما
وراوك[591] يا بُني؟ فقال: يا أبا[592] قد صارت اُمّي تجير أعدآ[593] الأمير، وأنّ عندها مسلم بن عقيل
في دارنا؛ استجارها البارحه. فسمع بن زياد كلامه، فقال: ما يقول هذا؟ فقال أبوه:
يذكر كذا وكذا، فقام بن زياد وقعد وفرح فرحاً شديداً، ثُمّ طوّق الغلام وسوّره، ثُمّ
خلع[594]
عليه[595].
ثُمّ إنّه استدعا[596]
بمحمد بن الأشعث وأمّره على ألف[597]
وقال له: انطلق مع الغلام فاتني بمسلم بن عقيل إمّا أسيراً أو قتيلاً، فسار بن
الأشعث بمَن معه، حتى وفا[598]
الدار. فلمّا قرب منها سمعت الأمرأه صوت الخيل وقعقعه اللُّجُم[599] ووهج[600] القوم واصطفاق[601] الرماح وزعقات الرجال، فأخبرت
مسلم بن عقيل بذلك، وقالت له: والله هذه خيل بن زياد مقبلة نحونا. فقال لها:
ناوليني درعي. فناولته إياه فلبسه وتقلّد بسيفه وشدّ وسطه بمحرمته[602]
وتاهّب لقتالهم. فقالت له: يا سيّدي أراك
تاهّبتَ للموت؟! فقال لها مسلم: والله ما طَلِبَةُ القوم غيري، وأخشى أن يهجمون[603] عليَّ وأنا
في داركِ فأراكِ بين يدي قتيله أو جديله[604]؛ فيسوني[605] ذلك. قالت
له: والله إنّه ليسرّني أن أكون بين يديك قتيله، ويسواني[606] أن أراك
قتيلاً بين يدي فألقا[607]
الله شهيده. فجزا[608]
مسلم خيراً، وقال: ليس هذا مقام النسا[609].
ثُمّ إنّه (رضى الله عنه) عمد[610]
إلى باب الدار فأقلعه ـ وكان ضخم الدّسيعه[611]
ـ ثُمّ هجم عليهم، وحمل فيهم، وصاح بهم صيحة عظيمه، فانكشفوا من بين يديه، فقتل
منهم أربعه عشر رجلاً[612]، وجرح جماعه؛ فوجّه محمد بن
الأشعث إلى
عبد الله[613] بن زياد (لعنه الله)، وقال: أيّها
الأمير امدبا[614]
بالجيوش والعساكر. فبعث إليه بن زياد (لعنه الله) بخمس ماية فارس، فحمل عليهم مسلم،
فقتل منهم جماعه[615].
ولم يلبثون[616] بين يديه ساعة، وجرح منهم جماعه،
وأجفل[617]
الباقون منهزمين، فوجّه محمد بن الأشعث امدني بالرجال فنفذ إليه بن زياد وقال له:
ويلك يا بن الأشعث قد نفذتُك إلى رجل واحد، قد قتل منكم مقتله عظيمه. وخرج جماعه
منهم[618]: أعطيه[619] الأمان وإلّا فناكم[620]
جميعاً. فنفذ إليه محمد بن الأشعث: يا بن زياد، ثكلتك أمّك، وعدموك[621] قومك، والله إنّك لغبي. ويلك! أظننتَ
أنّك نفذتني إلى بقّال من سوق الكوفه أو جرمقاني[622]
من جرامقه الحِيرَه؟! أوَ ما علمتَ أنّك نفذتني إلى سيف من سيوف آل محمد المصطفى
(صلى الله عليه [وآله] وسلم)[623].
ثم إنّ محمد بن الأشعث قال له: يا مسلم لك الأمان عندي. فقال: لا أمان لكم عندي يا أعدا الله الفاسقين، وجنود بن مرجانه اللعين، ثم حمل عليهم[624]، وجعل يقول شعر[625]:
|
أقسمتُ لا
أُقتَل إلّا حُرّاً |
ولا يزال يقاتلهم قتالاً شديداً حتى وقعت به ضربه على
حاجبه الأيمن؛ اختلط بها وجهه، وبدر الدم على محاجر[628]
عينيه، فغشا[629]
بصره، وهجموا عليه، وهو يكر[630]
عليهم، فأخذوه صحيحاً أسيراً، سحبوه على وجهه وأتوا به قصر
الإماره[631]. فلمّا دخل الدليز[632] نظر مسلم إلى بُرّاده فيها كيزان[633]
ماء، وكان له يومان لم يذق طعاماً ولا شراباً، فقال لساقيه: اسقني ما[634]، فإذا أنا عشتُ، وكان لي حياة
كافيتُك، وإن متُّ كان المكافي لك الله ورسوله في عرصه المحشر. فدفع الساقي إليه
كوز[635] من ماء بارد، فلمّا قرّبه فيه[636] وافقت حراره الدم برودة الما
فسقطت ثناياه في الكوز فصار الما عبيطاً[637]،
فعاد دفع[638] الكوز إلى الساقي، وقال له: خذ
فلا حاجة لي فيه حسبي الله توكلت عليه[639].
ثُمّ أدخل مسلم بن عقيل (رضى الله عنه) على عبيد الله بن زياد (لعنه الله) فلمّا رآه مسلم نادى: السلام على مَن اتبع الهدى[640] وخشي عواقب الرّدى وأطاع الملك الأعلى. فأقبل بن زياد على مسلم ووجهه ضاحكاً فرحاً[641]، فقال رجل من بعض جلسايه: يا مسلم ما ترى الأمير ضاحكاً إليك، ومقبل[642] بوجهه عليك، سلمتَ[643] عليه بالاردة[644]، ودخلتَ في طاعه أمير المؤمنين يزيد بن معاويه؟ فقال مسلم: والله ما أعلم أنّ لي أميراً غير سيدي الحسين، المعلم الطرفين، الشريف الأبوين، السيد بن السيدين. فقال له بن زياد (لعنه الله): أتفتخر بابن عمك عليا[645]، وترمي بشرّك إلينا أوَ ليس قريشٌ أكفّا؟ فقال له: يا بن مرجانه الحجّامه[646] أتساوي الأجاج[647] العذب[648]؟! أوَ يستقيم قط[649] الذاوي[650] والرطب؟! بنا هُدِيتم لا بكم هُدِينا. فقال له بن زياد (لعنه الله): يا مسلم عليك[651] سلّمتَ أو لم تسلّم؛ فإنّك مقتول في ساعتك هذه لا محالة[652]، فقال له مسلم: إن كان لابدّ لك من قتلي فليقم لي رجل حتى اُوصيه بوصيّه، وليكن قرشيّاً فقام إليه عمر بن سعد. فقال له مسلم: يا عمر هاهنا، فأخذه وانزاح[653] ثُمّ خلا به وعبيد الله بن زياد (لعنه الله) ينظر إليهما. فقال له: أوّل وصيتي إليك أنّي أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له[654]، والثانية فقد استدنتُ في قصركم[655] هذا سبع ماية[656] درهم، فتبيع درعي هذا وتقضي به ديني. والثالثه وهو[657] العظمى والحاجه الكبرى أن تكتب إلى سيّدي الحسين بن علي× بأن لا يصل إلى أرضكم ولا يقرب بلادكم فيصبه[658] ما أصابني، فقد صُنِع بي ما لم يُصنَع بأحد قط مثله. وقد بلغني أنّه قد خرج بأهله ومواليه ومن شا الله؛ قاصداً نحوكم، وأنّه والله قد صار إلى دار قد بيّتت[659] له بالغدر فليكن صلتك لأرحامنا وقرابتك إلى آباينا، وهو ذلك لأوليانا في هذه أن تبعث إليه من يخبره بما جرى وتحذره مما صرتُ عليه ليرجع من حيث جا، وينصرف من حيث شا. فقال عمر بن سعد: أمّا ما ذكرتَ من أمر الشّهاده فكلّ مسلم ومسلمه يقرّ بها. وأمّا ذكرتَ[660] من قضي[661] الدين فصاحبه بالخيار إن شا ترك وإن شا أخذ. وأمّا ذكرتَ من أمر الحسين× فلابدّ ما[662] أُعلم به الأمير[663]. ثُمّ التفت عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زياد (لعنه الله) ذلك[664] التفت إلى عمر بن سعد، وقال: قبّحك الله من مُستَكتَمٍ سراً أباح به جهراً! والله لو أسرّ اليّ بما أسرّ إليك لكتمتُ أمرَه، ولأدّيتُ عنه رسالته، وتحمّلتُ أمانته. وإذ قد فشيتَ[665] عليه ذلك. والله لا خرج[666] إلى قتال الحسين أحداً[667] غيرُك[668].
ثُمّ إنّ عبيد الله بن زياد (لعنه الله وخزّاه وقبّح
منقلبه ومثواه) أمر بأن يعلى
مسلم بن عقيل على أعلا القصر، وأن يُلقى على أُمّ راسه، ففعلوا به كما أمرهم. ثُمّ
استاذن عليه رجل من بني كنده[669]،
فقال له مسلم: يا هذا دعني حتى أُصلّي ركعتين. وافعل ما بدا لك. فقال له: ما
أُمِرتُ بذلك. فعند ذلك بكا[670] مسلم بن عقيل (رضي الله عنه) تأسّفاً
لمفارقه الحسين×[671]
ثُمّ نادى: وا شوقاه إليك يا أبا عبد الله، ثُمّ جعل ينشد ويقول:
|
جزا[672] اللهُ عنّا قومَنا شرَّ ما جزا |
فلمّا فرغ من شعره قال: يا ويلك يا عمر بن سعد! ألقِهِ في سبيل المهالك، فدَعَّه من أعلا القصر على اُمّ راسه، فقضى نحبه (رضى الله عنه)[681].
وبلغ شعره مدحج وذكرَتَهم[682] فركبوا عن آخرهم، واقتتلوا قتالاً شديداً مدة ثلاثه أيام. وكانوا يسحبون جثتهما في الأسواق، فغلبتهم مدحج، وأخذوهما وغسّلوهما وكفّنوهما وصلّوا عليهما ودفنوهما هناك (رحمة الله عليهما)[683].
وكان يرثيهما عبيد الله بن الزُّبير[684] وقيل الفرزدق[685] شعر:
|
إذا كنتِ لا
تدرينَ بالموتِ فانظُري |
قال: فبلغ مدحج، فقالوا: والله إنّ أسما قال[695] خارجه أجلّ عندنا من أمر صاحبنا هاني بن عروه، ولو كنّا طالبين بدمه لأخذنا[696] من محمد بن الأشعث، ولكنّ ذلك أمر السّلطان.
[ ما جرى بعد شهادة مسلم وهانئ]
ثم إنّ بن زياد (لعنه الله) نادى[697] ـ لمّا قُتِلَ هاني ومسلم ـ أمر براسيهما أن يذهبوا بهما إلى يزيد بن معاويه مع هاني بن أبي حبة الوداعي[698] والزبير بن الأروح[699]، ويعلموه بما كان من أمر مسلم بن عقيل وهاني بن عروه. وكتب كتاباً يقول فيه: الحمد الله الذي أخذ لأمير المؤمنين بحقّه من عدوّه وكفاه شرّه. واعلم أنّ[700] الخليفه أنّ مسلم بن عقيل ورد إلى دار هاني بن عروه، وأنّي جعلتُ عليه العيون ومكرتُ بهما حتى استخرجتُهما، وأمرتُ بضرب رقبتهما. وقد نفذتُ براسهما[701] إلى حضرتك مع هاني بن أبي جند[702] والزبير بن الأروح، وهما من أهل السمع والطاعه فاسالهما عمّا في نفسك؛ فإنّ عندهما وعلماً[703]. فلمّا وصل الكتاب إلى يزيد بن معاويه، فكتب جوابه:
أمّا بعد فإنّك كما أحبّ، وقد علمت أو علمت علم الحازم[704]. وقد سألتُ رسُوليك كما ذكرتَ فوجدتُهما فوق ما وصفتَ فاستوصِ بهما خيراً. وقد بلغني أنّ الحسين بن علي قد توجّه نحو العراق، فضعِ عليه العيون، واكتب لي كلّ يوم بما يتجدد عندك[705].
وكان محمد بن الأشعث أخذ سيف مسلم بن عقيل ودرعه، وفي ذلك يقول عبد الله بن عمر[706] شعر:
|
أتركتَ مُسلمَ
لم يُقاتِل دونَهُ[707] |
[مسير الإمام الحسين× إلى العراق]
16ـ قال: قال أبو حنيف[709]: ولما قُتِل مسلم بن عقيل وهاني بن عروه انطوى خبرهما عن الحسين× فجمع أهله وأمرهم بالرحيل من مكه إلى المدينه[710] ولم يزل سايراً حتى ورد المدينه، فأقبل إلى قبر جدّه رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فاعتنقه وبكا بكا[711] شديداً. ثُمّ حملته عينه فنام فراى في منامه رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) وهو يقول له: يا ولدي الوَحا الوَحا، العجل العجل، أقدم على أبوك وأخوك[712] وأمّك وجدّتك، ونحن مشتاقون إليك فبادر إلينا. فانتبه باكياً حزيناً شوقاً إلى رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)[713].
قال هشام المخزومي[714]: إنّ مولاي الحسين× لمّا قدم المدينه وطلب المسير إلى الكوفه، فدخلتُ عليه، وقلتُ له: يا بن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، قد أتيتُك بنصيحه. فقال له: قل، والله ما أستغشك ساعة قط. فقلتُ له: يا مولاي، قد بلغني أنّك تريد المسير إلى الكوفه، وأنّي لمشفق عليك في سيرك؛ لأنّك تاتي إلى بلد فيه أمرا[715] وعمال، ومعهم بيوت الأموال، وإنّما الناس عبيد الدرهم والدينار، ولا آمن عليك أن تتقاتل[716] مع عدوّك مَن كاتبك ووعدك بالنصر. فقال الحسين×: جُزِيتَ خيراً يا بن عمر[717] فقد نصحتَ وأحسنتَ، وأنا قابل نصحك ورأيك. قال هشام: فانصرفتُ من عنده، ودخلتُ على الحارث بن خلف بن العياض[718]. فقال له: هل أتيتَ الحسين؟ فقلت: أجل. فقال له: ماذا قلتَ له؟ وماذا قال لك؟ فأعدتُ عليه الحديث، فقال: نصحتَ وربِّ الكعبه، وأنّ الرأي الذي أشرب[719] به قَبِله أم تركه[720].
ثُمّ دخل عليه عبد الله بن العباس، وقال له: يا بن العم بلغني أنّك ساير إلى أرض العراق في هذا اليوم أو اليومين، ولكن أُخبِرك ـ يرحمك الله ـ واسمعْ منّي، فأنت تسير إلى قوم غدروا بأبيك، فإن كانوا قتلوا أميرهم، ونفوا عدوَّهم، ولزموا بلدهم، فسر إليهم، وإن كانوا ممّا فعلوا ذلك، فاعلم أنّهم دعوك للحرب الشنيع والأمر الفضيع[721]. ولستُ آمن عليك أن يغدروك ويخذلوك. ثُمّ ناشده بالله وبالرحِم أن لا يخرج، وخرج من عنده[722].
فدخل عليه عبد الله بن الزّبير فحدّثه ساعه. ثُمّ قال: لستُ أدري لأيِّ حالة تركنا هذا الأمر يتولّاه غيرُنا، ونحن أحق به وأولى. فقال الحسين×: والله لقد حدثتني نفسي بالمسير إلى الكوفه، وقد كتبتْ إليَّ شيعتي وأشراف أهل الكوفه بأن يبايعوني. فقال له بن الزبير: والله لو كان لي مثل شيعتك لما عدلتُ بها شياً. ثُمّ خشى أن يتهمه، فقال: والله لو أقمتَ بالحجاز، وأردتَ هذه الأمور ههنا لما صعب عليك. ثُمّ أقام[723] وخرج من عنده، فقال في نفسه: إنّ هذا أمر شين عنده، واخروجي[724] من المدينة إلى العراق لِيخلُوا له الحجاز.
قال: فلمّا كان من الغد أعاد عليه عبد الله بن العباس، فقال له: يا ابن العم إنّني أتخوّف عليك من هذا الوجه الذي أنت متوجّه إليه، وأنت تعلم أنّ أصحاب العراق أصحاب غدر ومكر، فلا تغترّ بهم، وأقم في حرم جدّك، فإن كان أهل العراق يريدونك ـ كما زعموا ـ فاكتب إليهم حتى يقتلوا عدوك، ثُمّ اقدم عليهم. فإن أبيت إلّا الخروج فسر إلى اليمن[725] فإنّ فيها حصوناً وشعاباً[726]، وهي أرض طويله عريضه، ولك[727] فيها شيعة، وأنت عن الناس بمعزل، فتكتب إلى الناس وترسل برسلك، وتبث دعاتك فإنّي أرجوا[728] عند ذلك أن تنال الذي تحبّ وتختار. فقال له الحسين: والله يا بن العم إنّي أعلم أنّك ناصح[729] مشفق، ولكن لا بدّ لي من المسير. قال: إذا كان ولابدّ لك من المسير فلا تخرج بصبيانك ونسايك؛ فإنّي أخشى عليك أن تقتل، كما قتل عثمان بن عفان ونساوه ينظرون إليه. ثُمّ قال له: يا بن العم اليوم قرّت عين بن الزبير بتخليتك الحجاز له وخروجك منها، وهو اليوم لا ينظر إليه معك أحد. ثُمّ خرج من عنده فمر بابن الزبير وهو جالس، فقال له: قرّت عينُك يا بن الزبير ثُمّ تمثّل بهذا الأبيات[730]:
|
يا لكِ قُنبَرة[731] بمَعمَرى |
قال له بن الزبير[737]: يكون الحسين بن بنت محمد (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ساير[738] إلى العراق، وأنت ضحك[739] شامتاً[740]؟! وأنا سمعتُ ابن عمي رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) يقول: يُقتَل بالحرم رجل يكون فتنته[741] العالم على يده. والحسن والحسين هما حبي[742] جدهما (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، فمن آذاهما فقد آذاني[743].
17ـ وفي رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل (رضي الله عنه) أنّ الحسين× لم يسير[744] إلّا لمّا وصل إليه كتاب مسلم بن عقيل[745] يخبره أنّ الناس قد بايعوا قبل هلاكه[746].
18ـ وفي رواية أخرى لأبوا[747] مخنف لوط بن يحيى الأزدي: لمّا سار الحسين× وورد المدينه فأقبل إلى قبر جدّه (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فاعتنقه وبكا فحملته عينه فنام، فراى النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم) في منامه وهو يقول: له الوَحا الوَحا أقدم يا حسين على أمّك وأخيك وجدّك وأبيك، فنحن مشتاقين[748] إليك، فبادِر إلينا. فانتبه الخليل[749]× وهو باكي[750] حزين شوقاً إلى جدّه (صلى الله عليه [وآله] وسلم). ثُمّ نهض من وقته[751]، وأقبل إلى أخيه محمد بن الحنفيّه[752] (رضي الله عنهم)، وكان يومئذٍ عليلاً ـ وكان سبب علته أنّه أُهدِىَ إليه درعاً[753] فأخذه ولبسه، ففضُل عنه، فجمع ما فضل وفركه بيده فقطعه؛ فانته[754] عين فيه، ولحقه مرض شديد ـ فحدّثه بحديث وقصّ عليه قصّته وما راى في منامه، فبكى محمد بن الحنفيّه، وقال له: يا أخي ما تريد أن تصنع؟ فقال له: الدخول إلى العراق لأنّي قلق مهموم بسبب مسلم بن عقيل، ولا شك إلّا إنّه هلك[755]. فقال له محمد: سألتُك يا أخي بحقّي عليك إلاّ ما عدلتَ عن هذا، ولا تمضي[756] إلى قوم غدروا بأبيك وأخيك، ونكثوا بيعتك، ولم يوفوا بعهدك. أقم في حرم جدّك (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، وإلّا فارجع إلى حرم الله؛ فإنّ لك فيه أعوان[757] خير أعوان[758]. قال الحسين×: لا بدّ لي من الدخول إلى العراق. فقال له محمد: والله يا سيّدي لم يُبقِى[759] إليّ الدهرُ مَن التلا[760] به عن همّي، وأجلوا[761] به حزني وغمي غيرَك. والله إنّه ليفجعني فراقك وبعد مرادك، وما يقعدني عن نصرتك ومحاربه من يحاربك ـ وكنتُ أكون[762] صحبتك ـ إلاّ ما ترى بي من التوعّك، وما لي يد تقبض على لهذم[763] ولا تمسك مخذم[764]. والله والله لا فرحتُ بعدك أبداً، ولا تلذّذتُ بشرب ما وهوى[765]. ثُمّ بكا بكا شديداً حتى غمى[766] عليه. ثُمّ قال له: يا أخي استودعك خير مُستودَع، ثُمّ اعتنقه الحسين× واعتنقه الآخر، وقال: استودعتُك الله من غريب شهيدٍ مظلومٍ[767] طريد، يُطالَب بأحقادٍ بدريه، وثارات جاهليه، وثارات اُحديه، وطعاين محمديه[768]. ثُمّ ودّعه وتوجّه سايراً في أهل بيته ومواليه.
فبينما هو سايراً[769] إذ سمع قايلاً ـ يسمع صوته ولا يرى شخصه ـ وهو يقول: يسير إلى المنايا[770] والمنايا تسير إليهم عاجلاً[771]، فأنشأ يقول شعر:
|
سأَمضِـي وما بالموتِ عارٌ عَلى الفتَى |
وبلغ عبد الله بن جعفر الطيار[775] مسير الحسين فدعا بولديه محمد وعون، وكتب معهما كتاباً، يقول فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم، أمّا بعد فإنّي سالتك يا ابن العم بالله إلّا ما رجعت عما أنت متوجه إليه، فإنّي أخاف أن يكون فيه هلاكك، فإن هلكتَ طُفِى نور الله، فلا تعجل، وأنت على الهدى ومصباح الدجى. وتوقّف فإنّي في أثر كتابي، والسلام.
فلما وصل إليه الكتاب فردّ عليه الجواب لستُ أرجع[776]. وسار، وسار معه عون وأخيه[777] أولاد جعفر[778] بين يديه وسار الحسين×، وهو ينشد هذه الأبيات:
|
إذ المر[779]
لم يحمي[780]
أباه وعرسه لحوض غشا الموت[783] شرقاً ومغرباً ونضـرب ضرباً كالحريق مقدماً |
19ـ قال أبو مخنف: وسار الحسين× متوجهاً نحو الكوفه[785] فبلغ بن زياد (لعنه الله) فبعث الحصين بن نمير[786]، وكان صاحب شرطته في أربعة آلاف فارس فنزل القادسيّه[787] قريباً من القُطقُطانِيَه[788]، وسار الحسين× حتى وصل الجناب[789] من بطن الرّمله[790]، وبعث قيس بن مهر[791] إلى الكوفه، وكتب معه كتاب[792]، يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى إخوانه المؤمنين، أمّا بعد فإنّ كتاب مسلم بن عقيل ورد إليّ يُخبرني بحسن رايكُم واجتماعكم على نُصرتنا، والطلب بحقّنا، وسالت الله سبحانه وتعالى أن يُحسن لنا ولكم الصنيع، وأن يثبكم[793] أجل الثواب، وأنا ساير إليكم إن شا الله تعالى يوم الثلاثا لثمان مضين من ذي الحجه. فإذا قدم إليكم رسولي فاصنعوا ما أنتم محتاجون إليه، والسلام.
قال: وسار قيس بن مهر بالكتاب، طالب[794] الكوفة حتى وصل القادسيّه أخذه الحُصين بن نُمير، وأوثقهُ كِتافاً، وبعث به إلى بن زياد فلمّا وصل إليه قال له: يا ويك[795] اصعد به على سور[796] هذا القصر وسُبّ الكذّاب بن الكذّاب يعني الحسين بن علي÷.
قال: فصعد قيس إلى أعلا القصر، فحمد الله وأثنى عليه، وذكر النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم) قال: أيُّها الناس إنّ الحسين بن علي بن ابي طالب فارقته بالجناب[797] من بطن ذي الرمله، وأنا رسوله إليكم فاجيبوه فهو واصل على أثري. ثُمّ سَبّ بن زيا[798] وصلّى على الحسين×[799].
قال: فأمر برميه من أعلا القصر، فرُمي وقضى نحبه (رضي الله عنه)[800].
20ـ قال عدّي بن خزيمه[801] الأسدي: حدثني عبد ربه[802]، قال: كنّا بمكه، وقد حججنا فلّما قضينا حجّنا لم يكن لنا همّه إلّا اللّحوق بالحسين×. قال: فأقبلنا نسير حتّى لحقناه، فلمّا دنونا منه إذا نحن برجل مقبل من نحو الكوفه، فمضينا إليه، وسلّمنا عليه، وقلنا: مَن الرجل؟ قال: من أسد[803]. فقلنا له: اخبرنا عن الناس بالكوفة. فقال: لم[804] خرجتُ من الكوفه حتى قُتِل مسلم بن عقيل وهاني بن عروه، ورأيتُ رأسيهما في الأسواق تلعب بهما الصبيان. فلمّا سمعنا ذلك منه أقبلنا على الحسين× وسلّمنا عليه، وسايليناه[805]، وقلنا له: رحمك الله يا أبا عبد الله إنّ عندنا خبراً، إن شيت أخبرناك به سراً أو جهراً؟ فنظر إلى أصحابه، ثُمّ قال: ما دون هولاء من سر. فقلنا له: هل رأيتَ الراكب الذي استقبلناه؟ قال: رأيتُه، وأردتُ مسايله[806]. فقالوا: قد كافيناك[807] ذلك، وقد أخبرنا أنّه لم يخرج من الكوفه حتى قُتِل مسلم بن عقيل وهاني بن عروه. فقال الحسين: (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)[808] (رحمة الله عليهما). فقلنا له: ناشدناك بالله لا تقتل نفسك وأهل بيتك، وارجع من هذا الموضع؛ فمالك في الكوفه ناصر ولا معين، ونحن نتخوّف عليك أن يكونوا[809] أهل الكوفه عوناً عليك.
قال: فوثب أولاد مسلم بن عقيل، فقالوا: والله ما نبرح حتى ناخذ بثار أبينا أو نذوق ما ذاق أبينا[810]، فنظر إليهم الحسين×، وقال: لا خير في الحياه من بعد هولا[811].
قال: فعند ذلك عزم على المسير، فقلنا له: آجرك على الله في ذلك. وبات ليلتَهُ، فلمّا كان وقت طلوع الفجر الأول قال لفتيانه وغلمانه: أكثروا من الما، واسقُوا خُيولَكُم. ففعلوا ذلك، وساروا، وجعل لا يمرُّ على باديه إلّا تبعته حتى انتهى إلى زُباله[812] فنزل بها[813].
ثُمّ قام خطيباً، فحمد الله تعالى، وأثنى عليه، وذكر النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، وقال: أيُّها الناس إنّما جمعتكم على أنّ العراق لي، والآن فقد جاني أمرٌ فضيع[814] عن بن عمّي مسلم بن عقيل وهاني بن عروه، وقد خذلتنا شيعتنا[815]، فمن كان منكم يصبر على حرّ الهواجر[816]، ووقع الصوارم[817]، وإلّا فلينصرفْ، فليس عليه من أمري شي، وهو في حِلّ من جهتي. فجعلوا يفرّون عنه يميناً وشمالاً في أودية شتى، وشعاب مختلفه[818]، حتى بقي في أهل بيته ومواليه في نيّف عن سبعين[819] رجلاً، وهم الذين خرجوا معه من مكه. وإنّما فعل ذلك لأنّه علم أنّ العرب[820] لم تتبعه إلّا أنّها ظنّت أنّه ياتي إلى بلد قريب، قد استقامة[821] له طاعة أهلها فكرِهَ أن يسيروا معه إلّا وهم يعلمون على ما يُقدِمون.
وسار حتى وصل إلى الثّعلبيّه[822][823]، فنزل بها، وإذا قد أقبل إليه رجل نصرانيّ ومعه والدته، فقال له: السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمته وبركاته. فردّ عليه السلام، وقال: يا مولاي أنا رجل نصرانيّ، وقد أحببت أن أجاهد بين يديك، فأمدّ يديك، أنا أشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهد أنّ محمداً رسول الله. وأسلمت أمُّه، وحسن إسلامهما[824].
قال: وجعل الحسين لا يمرّ بقبيله إلّا استنجدها، حتى وصل قيد[825]، وهو في خمسين ألف فارس وراجل.
وفي روايته[826] أخرى ثمانيه وسبعين ألف فارس وراجل[827]، فبينما هو نازل بقيد إذ أقبل فارس من صدر البريه على راحلة له، فقام إليه رجل يقال له: علي بن الفارضيه[828]، فأوقفه وقال له: من أين أقبلتَ؟ فقال: من الكوفه. فقال: كيف خلّفتَ مسلماً بن عقيل وهاني بن عروه؟ فقال الأعرابي: والله، ما خرجتُ من الكوفه حتى رأيتُ رأسيهما مقطوعتان[829] عن جسديهما، والحبال في أرجلهما، وهما يجران في الأسواق، وأنّ الكراع[830] والسلاح مع بني أميه. ثُمّ مضى الأعرابي، وأقبل علي بن الغاضرية[831] بما قاله الأعرابي، فأخبر الحسين×[832]، إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم.
ثُمّ قام في الناس خطيباً فحمد الله، وأثنى عليه، وذكر جدّه وأثنى عليه (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، ثُمّ قال: أيُّها الناس، إنّما جمعتُكم معي على أنّ العراق بيدي، وتحت طاعتي، والآن فقد نقضوا عهدي، ونكثوا بيعتي، وغدروني. وقد قتلوا مسلم بن عقيل، وهاني بن عروه. فمَن ذا يبايعني على الموت جداً؟ قال: فتصدّع[833] العسكر عن الحسين×[834].
21ـ قال أبو مخنف: وجعلوا يتفرّقون عنه الخمسه والعشره والأقل والأكثر حتى لم يبقَ معه سوى أهل بيته ومواليه وعددهم اثنا وسبعين[835] رجلاً كما تقدّم[836].
22ـ وفي روايه أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنّهم كانوا خمسة وأربعين فارس[837] وماية رجل[838].
23ـ قال أبو مخنف: وسار الحسين× حتى نزل بالثّعلبيّه.
فبينما الحسين
نازل بالثّعلبيّه إذ أقبل سواد عاتي[839]، فقال لأصحابه: ما هذا السواد؟
فمضى
رجل من أصحابه على راحلته غير بعيد وعاد، فقال له الحسين: ما الذي رأيتَ؟ فقال: يا
مولاي خيل مقبله نحونا، فقال: عرّجوا[840]
بنا عن الطّريق. فعرّجوا، ونزلوا على بير هناك. وأقبلت الخيل يقدمهم يزيد بن
الحصين[841] ومعه الحر
بني[842] يزيد الرياحي فقالا: يا أبا عبد
الله سبقتنا إلى الما. فأمر الحسين فسقا[843] خيلهم وسقاهم. وكان قد حان وقت
صلاة الظهر، فأذّن مؤذّن الحسين، فصلّى بهم جماعه، وكانوا صَفين. فلمّا فرغ مَن
صلاته قام فيهم خطيباً، فحمد الله، وأثنى عليه، وذكر جدّه فصلّى عليه. ثُمّ قال[844]: أيُّها الناس مَن عرفني فقد
عرفني، ومن لم يعرفني فأنا عرفه[845] نفسي: أنا بن محمد المصطفى، بن
علي المرتضى، بن فاطمة الزهرا، بن خديجة الكبرى[846]. أنا بن سيد الأوصيا، أنا بن زمزم والصفا[847]، أن[848] ابن قيس
وحرا[849]،
وما جيتُكم حتى جاتني كتبكم. فقال له يزيد بن الحصين: اعلم يا أبا عبد الله أنّ
الذين كاتبوك هم اليوم خواصّ عبيد الله بن زياد، قلوبهم معك وسيوفهم عليك[850].
فقال له الحسين: وأنت لأيّ شي جيتَ؟ قال: بعثني عبيد الله بن زياد (لعنه الله) حتى
ألقاك. فقال له: يا ويلك، وما أتيتَ إلّا وأنت عدواً[851]
لنا، معين على الغدر بنا، قبّحك الله. قال: أمّا أنت يا أبا عبد الله، فما أقدر أردّ
عليك، ولكن لو كلّمني غيرك أجبتُه عنّي وعنه، ولو خاطبني أهل الأرض. فقال له
الحسين: ما مثلك من يحارب مثلي. قال له يزيد بن الحصين: فأنت إلى أن[852]
تريد وعزمتَ عليه؟ فقال الحسين: إلى الكوفه أن شا الله. فقال له: لم أومر بذلك.
وعرجوا بالحسين على الطريق، وكان قد خرجت من الكوفه خيل لنصرة الحسين ، فيهم
الأشعث بن واثله الكندي[853] والطّرماخ بن عدي[854] (رضي الله عنهم)، فوقعوا في عسكر
ابن الحصين، فمنعهم عن الحسين، وحال بينهم
وبينه، فصاحوا يا أبا عبد الله نحن قومٌ محبيك[855]، وخواصّّ
شيعتك، وقد جينا لنصرتك، وقد حال بيننا وبينك هذا الرجل.
فصاح به الحسين: خلّ عنهم ـ ويلك ـ وإلّا كان بيني وبينك الحرب. فخلّا[856] عنهم، ولحقوا بالحسين[857].
ثُمّ ساروا حتى صبّحوا قصر بني مقاتل[858]، وإذا بمضرب[859] مضروب، وفرس مربوط، ورمح مركوز، فقال الحسين: هذا لمن؟ قالوا: الرجل[860] من الكوفه، يقطع الطريق ويخون السبيل يقال له: عبد الله بن الحرّ الحنفي[861]، يُعد بألف فارس، فاستدعاه الحسين بابن عم له وكان معه يعرف بالحجّاج بن الحرّ الحنفي[862]، فقال له: امض إلى بن عمك، واساله أن يسير معنا ويكون كأحدنا. فأقبل الحجّاج إلى بن عمه عبد الله الحر فدخل عليه فسلم، فردّ السلام عليه ورحب به. ثُمّ قال له: يا بن العم، هذا الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قد أقبل وهو يسلك أن تلقا[863].
فقال: يا بن العم اعتقني من لقايه[864]، والله ما أشتهي لقايه من غير بغض له، فعاد الحجّاج أخبر الحسين بما قال. فنهض الحسين، وأقبل حتى دخل على عبد الله بن الحرّ، فسلم عليه، فلمّا راه قام قايماً على قدميه، وقبّل يديه ورجليه، وجلس بين يديه، فقال له الحسين: أما تعرفني؟ فقال له: أعرفك حق المعرفه، وأعرف شرفك. لعن الله من لا يعرفك ويوفي بعهدك. أنت ابن محمد المصطفى وعلي المرتضى ويكفيك بهذا شرفاً في العلا. فقال له الحسين: اعلم أنّه قد ورد علىَّ من أهل الكوفه ثمانون ألف كتاب يسالوني المصير إليهم والقدوم عليهم، وقد أتيتُ إليهم فهل لك أن تكون معنا؟ فإن كنتَ لنا فلك ما لنا وعليك ما علينا، وإن قُتِلتَ بين يديَّ فزتَ بها. فقال له: يا أبا عبد الله أنا أخشى من بن زياد يدعوني إلى قتالك فإن حابتُك[865] طالبني جدّك بدمك ويكون يوم القيامه خصمي[866]، فأرد الموقف وأنا أحس[867] خلق الله متحيراً، وأمضي نار[868] جهنّم مع الكافرين. فقال له الحسين: فمَن يعلم بهذا ويتخلف عن نصرتي ويقعد عن مساعدتي؟ فقال: يا أبا عبد الله هذه فرسي لاحق[869] ليس لها في زمانها نظير، خذها وهذا كيس فيه ألف دينار خذه استعين[870] به على قومك. فقال له الحسين: امّا فرسك فما تنجيني من المقدور ولا تدفع محذور[871]. وأمّا مالُك فلا يصحبني ولا ينصرني من يطمع مني في مال ولا يرغب في نوال[872]، وجميع أصحابي راغبين[873] في العُقْبَى[874] زاهدين[875] في الدنيا. وأنت لو أردتَ تحشر معنا في زمرتنا وزمرة جدي عاناقه[876] من نور لم توقف عن مصيرك معنا ونصرتك لنا. وإن قد بخلتَ على رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) بنفسك فلا حاجة فيما قِبَلك. ثُمّ نهض الحسين من عنده وهو يقرا: (قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا)[877].
ثُمّ إنّ عبد الله بن الحر بعد خروج الحسين ندم على تخلّفه عنه، وما تكلّم به في حقّه، وجعل يلوم نفسه في ذلك، ثم أنشا يقول:
|
لقد فاز الذي
نصـروا حسيناً |
[نزول الإمام الحسين× أرض كربلاء]
24ـ وقال أبو مخنف: ثم سار الحسين حتى نزل أرض كربلا ـ وكان ذلك يوم الأربعا ـ فوقع الفرس من تحته، ولم يزل يركبُ فرساً بعد فرسٍ حتى ركب ستة[884] أفراسٍ، وهي لا تنحث[885] من تحته خُطوه. فنزل وقبض قبضه من الصعيد[886] واستنشقها. ثُمّ قال: يا قومُ ما يقال لهذه الأرض؟ فقالوا: أرض نينوه[887]. فقال لهم: هل اسم غيره؟[888] فقالوا: نعم أرض الغاضريّه[889]. فقال: لها اسم غيره؟ قالوا: نعم شاطي الفراه[890]. فقال: لها اسم غيره؟ قالوا: نعم نهر العلقمي[891]. فقال: يا قوم، بحق جدّي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) هل تعرفون بهذه[892] الأرض اسم غير هذا الاسم؟ قالوا: نعم أرض كربلا. فلمّا سمع حينئذ عرفه، فتغرغرت[893] عيناه بالدموع، وقال: صدق ـ والله ـ جدّي (صلى الله عليه [وآله] وسلم). ثُمّ تنفّس الصُّعدا[894]، وقال: ها هنا ـ والله ـ محطُّ رحالنا، وسفكُ دماينا، وسبي حريمنا، وقبور شيعتنا، ومن هاهنا يحشرون. وأنشد يقول شعر:
|
يا دهرُ أُفاً[895] لك من خَليلي |
25ـ وفي رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن
حنبل (رضي الله عنه)
بإسنادٍ يرفعه إلى سبط التميمي، قال: حدثني بهرثمه[897]
عن رجل من بني
تميم[898]،
قال: كانت لي امراه، يقال لها: جرادا[899]
كانت قبلي، تحبّ عليّ بن أبي طالب ، قال: فأقبلنا معه من صِفين[900]
حتى إذا كنا بكربلا صلا[901]
بنا صلاة الفجر، ثُمّ أخذ كفاً من تراب أرض كربلا، فشمّه، ثُمّ قال: يأتي أَغْلِمة[902]
يُقتَلون في هذا الموضع يدخلون الجنه بغير حساب. قال: فرجعتُ إلى جرادا زوجتي،
فقلتُ: ويحك أظهر هذا الكذب للناس. فقالت: وما ذلك؟ فقلتُ: إنّا رجعنا معه من
صِفين حتى كنا بكربلا صلا بنا صلاة الفجر. ثُمّ أخذ كفاً من تراب كربلا، وقال:
يأتي غِلْمة[903]
يقتلون في هذا المكان، يدخلون الجنة بغير حساب. ومن أعلمه بذلك؟! فقالت: اسكت
فانّي أشهد بالله إن كان قاله فإنّه حق وصدق. ثُمّ ضرب الدهر جانبه، ومضت عليه
الأيام، فبعث عبيد الله بن زياد (لعنه الله) إلى قتال الحسين وقد نزل كربلا، فلمّا
سمعه[904] يسال عن اسم الموضع، ذكّرني قول
عليٍّ عند رجوعه من صِفين، ورأيتُ وقوفه بالموضع، وعرفتُ الموضع، فضربتُ فرسي،
ولحقتُ بالحسين، فأخبرتُه بالخبر، فقال: أتلحق بنا؟ قلتُ: لا. قال: لا تنج[905]، لا ترى لنا سواداً ولا تسمع
صوتاً لنا؛ فإنّه لا يرا[906]
لنا أحداً[907]، ولا يسمع لنا صوتاً، ولا يغيثنا
إلّا عذّبه الله عذّبه الله[908]}. قال: فضربتُ فرسي، ولحقتُ
بالكوفه[909].
26ـ وفي رواية أبي عبد الرحمن بن[910] عبد الله بن أحمد بن حنبل (رضي الله عنه) أنّه قال: لا يرى أحداً سواد[911]، ولا يسمع لنا صوتاً، ولا يغيثنا إلّا أكبّه الله على وجهه في نار جهنم[912].
27ـ قال أبو مخنف (رضي الله عنه): فبينما الحسين مفّكراً في نفسه، إذ أقبل فارس يركض من نحو الكوفه قاصداً إلى الحصين، ومعه كتاب من عبيد الله بن زياد (لعنه الله) يقول فيه: أمّا بعد يا بن الحصين[913] اترك[914] الحسين بالغبرا[915]، بحيث لا ما ولا مرعا[916]. فلمّا قرا الكتاب قال: انزل يا أبا عبد الله. قال: فنزل الحسين، وضرب مضرب[917]، وأدخل بنيه وأهله وبنات رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ونسل فاطمه^ وحرم أَل علي بن أبي طالب (صلوات الله عليهم اجمعين) في المضرب، وأنزل أصحابه من حوله. وأمر بأن يُحفَر خدقاً[918] ويُملَأ بالحطب، ويُضرَب[919] فيه النار؛ حتى يكون القتال من جانب واحد. فلمّا نظر بن الحصين إلى ذلك استدعا[920] بدواه[921] وبيضا[922] وكتب كتاباً إلى عبيد الله بن زياد (لعنه الله) فيه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أمّا بعد أيّها الأمير أنّهم كانوا بالثّعلبيّه، فأخذتُ الرجل، وسرتُ به، وكلّ من كان معه تفرّق عنه. وجميع عسكره اثني وسبعين[923] رجلاً، منهم سبعة عشر رجلاً من أهل بيته، وقد أنزلتُه بكربلا بحيث لا ما ولا مرعا[924]، ولا جدار ولا بنا، فلمّا فرغ من كتابه طواه، ونفذ به إلى عبيد الله بن زياد (لعنه الله)، فلمّا قراه أمر منادياً ينادي في جنبات الكوفه مَن تخلّف عنّي إلى ثلاثه أيام ضربتُ عنقه فلا يَلُومَنَّ أحداً[925] أحداً، والدعا[926] بشريح[927] فولاه القنطره[928] وادعا[929] بعمر بن حريث[930] فولّاه الكوفه، وقال: لا يطلع عليكما أحداً[931] من شيعة الحسين إلّا ضربتم عنقه.
قال: فرجع رجل من العسكر يريد الكوفه، فقال له عمر ابن حريث: ويلك لِمَ رجعتَ؟ فقال له: ابنت عمي حامل وقد ضربها المخاض، وقد نفذوا أهلي خلفي، فرجعتُ لأجلها. فقال له: كذبتَ، بل أنت من شيعة أبي تُراب[932]، ثُمّ قدّمه فضرب عنقه (رحمه الله). ثُمّ رجع آخر فأتى به، فقال له: لِمَ رجعتَ؟ فقال له: من أجل دوابّ لي. فقال: كذبتَ، ثُمّ أمر فضُرِب عنقه[933].
28ـ قال أبو مخنف: ثُمّ إنّ عبيد الله بن زياد (لعنه الله) لمّا جمع العساكر نادى فيهم من يأتي برأس الحسين، فله خراج البصره والكوفه والعراق عشره سنين[934] متواليات. فلم يجبه أحداً[935]، ونادى ثانياً وثالثاً، فلم يجبه أحداً، فعند ذلك التفت إلى عمر بن سعد، وكان يزيد قد ولّاه الراي[936]، وكتب له بها عهداً ولم يمضه بعد: فقال عبيد الله بن زياد (لعنهم الله اجمعين): تخرج أنت إلى قتال الحسين، وتكفينا أمره وتخمد ذكره، وتحطّ قدره وتخمد جمرته، وتبيد مشافته[937]، وتهلك شيعته، وتفني أثره، ولا تأخذك به رحمه[938]. فها هو أقبل من الحجاز، وكلّ عسكره اثنى وسبعين[939] رجلاً، وهو بأرض كربلا، فقال ابن سعد: أيّها الأمير من هذا[940]. فقال له: واضيفا[941] إلى توليتُك طَبَرِسْتَانَ[942] وقَاشَان[943]. فقال: اعفني أيّها الأمير. فقال له: عند ذلك عبيد الله بن زياد أن أبيت الخروج فرد علينا عطانا. فلمّا نظر عمر بن سعد أنّه قد ألزمه بخروجه، وأنه لابدّ من الأمتثال لأمره قال له: لقد غلبت الشقوه[944] عليّ أيّها الأمير. ثُمّ قال له: أتريد أن توجّلني[945] ليلتي هذه؟ قال: قد أجلتُك. ثُمّ نهض من عنده وهو أنحس[946] خلق الله منحراً، وأقبحهم ذكراً، فأتى إلى داره فدخل عليه أولاً[947] المهاجرين والأنصار، فقالوا له: يا عمر بن سعد أكفرٌ بعد إيمان، وضلال بعد برهان؟! أما تتقي الله} تحارب بن بنت رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)؟! أما تعلم موضعه من الله ورسوله؟! بأيّ وجه تلقى جدّه، وأنت مطالب بإثمه؟! فقال: كلا لستُ أفعل.
وبات تلك الليل[948] لم تغمض له عينٌ، ولا استقر له مهاد[949]، بل يفكّر في قتل الحسين وملك الريّ، وترجيح الدنيا على الآخره. وغلّب ملك الري على دينه، ولم يزل كذلك حتى استحوذ على قلبه الشيطان فصدّه عن الإيمان، وأنساه ما نطق به القرآن، وغلبت الشقوة على قلبه، واحتوى الكفر على لبّه[950]، فأنشأ يقول شعر:
|
فوالله ما
أدري وإنّي لَصادقٌ |
29ـ قال: قال أبو مخنف لوط بن يحيى: وكانت أوّل راية
خرجت إلى
الحسين بن علي (رضي الله عنه) راية عمر بن
سعد في ستة[956]
آلاف فارس ثُمّ ادعا
بالشمر بن ذو[957]
الجوشن الضبابي[958]
(لعنه الله) فعقد له رايه على أربعة آلاف فارس، ثُمّ دعى[959]
بسنان بن أنس النخعي[960]
(لعنه الله) فعقد له رايه على
أربعة[961]
آلاف فارس، ثُمّ أدعى بالقشعم[962]
فعقد له راية على ثلاثه آلاف فارس وراجل، ثُمّ ادعى بخوله بن يزيد الأوصحي[963]
فعقد له رايه على ثلاثه[964] آلاف فارس وراجل، ثُمّ أدعى
بالجيش واستعرضه فكان جملته أربعة وعشرين ألف فارس وراجل[965].
ثُمّ ساروا يقدمهم الخزي والوبال والعقاب والنكال بالعدد الكامله، ليس فيهم شاميّ
ولا بصري[966]
فنزلوا بإزا[967] الحسين[968]،
وقال لأصحابه: المعروفون هاولا[969]؟ قالوا: نعم هذا عمر بن سعد قايد
جيش عبيد الله بن زياد، وزعيمهم وتحت طاعتهم. فلمّا استقر بالجيش النزول استدعى عمر
بن سعد برجل يقال له كثير بن شهاب[970]
وقيل: كان اسمه خُزيمه[971] وقال له امضِ برسالتي إلى الحسين
بن علي، وقل: يا أبا عبد الله ما الّذي أقدمك؟ وما علامة جد عزمك؟ وفِيمَ[972]
أتيتَ العراق؟ وما الذي تريد أن تصنع؟ فأقبل الرجل حتى وقف بإزا الحسين، فقال
الحسين لأصحابه: هل فيكم من يعرف هذا الرجل؟ فقالوا: نعم هذا كثير بن شهاب أو
خزيمه. وهو رجل فيه خير وصلاح وفضل ومعرفه إلّا أنّه قد شهد هذا الموقف. فقال
الحسين: سلُوه ما الذي تريد؟ فقال: الدخول على سيّدي الحسين. فقالوا له: إلقِ عنك
سلاحك وادخل. فقال: حُبّاً وكرامه، ثُمّ دخل إليه فانكب يقبّل قدميه ويتضرع بين
يديه، ثُمّ قال: يا سيّدي يا أبا عبد الله ما الذي أقدم[973]؟ فقال: كُتبكُم جات لي تتواتر
ورودها عليّ تَحثُّوني على المصير. فقال: لعن الله مَن كاتبك فكذَبك وعاهدك فخذَلك،
ومَن أزعجك مِن حرم جدّك (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، ولعن مَن خفر[974]
ذمتك، وجحد أبويك، وحال عن نصرتك.
فقال له الحسين: فأنت ترجع إلى صاحبك تخبره الخبر. فقال كثير: يا سيّدي جُعِلتُ فداك، ومَن يطيب قلبه أن يخرج من الجنّه ويدخل النار ويُصلى بغضب الجبّار؟! وأيّ عذر لي أقوم به في عرصة المحشر عند جدّك وأبيك وأمّك وأخيك فأرجع عنك إلى عدوك؟! كلّا ـ والله ـ لا كان ذلك أبداً، بل أجالد[975] بسيفي بين يديك، وأطعن برمحي محاربَك. فقال له الحسين: وصَلَكَ الله إذا وصَلتَنا، وشكر لكم ذلك إذا نَصرتَنا. وأقام مع الحسين[976].
ثُمّ إنّ عمر بن سعد ضرب مضربه بإزا الحسين، وكان يُبسَط له بِساطاً وللحسين بِساطاً[977]، فيجلسان فيتحدّثان عليه عامّه[978] ليلّهم، ثُمّ يرجع كلّ واحد منهم إلى مضـربه[979]. وكان خولي بن يزيد الأوضحي[980] من مبغضي الحسين، فكتب إلى ابن زياد (لعنه الله) كتاباً. وقيل: إنّ الشمر (لعنه الله) كتب يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أمّا بعد أيّها الأمير ممّا أُعلِمك أن عمر بن سعد قد صبا[981] إلى الحسين، وأنّه يُبسَط له كلَّ ليله بساط، فيتحدّث معه عامّه ليله، ثُمّ يرجع كلّ واحد منهم إلى موضعه، وقد أدركته الرّحمه للحسين[982]، فلمّا وصل الكتاب إلى عبيد الله بن زياد (لعنه الله) قراه، وكتب من وقته إلى عمر بن سعد: أمّا بعد إن كنتَ قد كرهتَ القتال فردّ علينا عهدنا، وإلّا نازل الحسين بالقتال، وامره[983] أن ينزل على حكمنا، وامنعه ما[984] الفرات، فقد حلَّلتُهُ للكلام[985] وحرّمتُهُ عليه[986].
وطوى الكتاب، ونفذ به إلى عمر بن سعد، فلمّا قراه فهم معناه لم يلبث حتى أدعى[987] بشبيب بن ربعي[988]، وأمّره على ألف فارس، وأمَرَهُ أن ينزل على مشرفه نينوه[989] واستدعا بعمر بن الحجّاج وكان في أربعه[990] فارس[991] وأمَره أن ينزل على مَشرَعةِ الغارضيه[992]، وأخذوا عليه المشارع من كلّ مكان ومنعوه الما[993].
30ـ قال أبو مخنف: وأقبلوا[994] أصحاب الحسين حتى يردوا الما فرشقوهم بالنبال ومنعوهم منه، فعادوا إليه وقالوا له: يا بن رسول الله ألا ترى إلى القوم قد منعونا الما، ونحن محتاجين[995] إليه! فأمر الحسين فحفر بير[996] فعمد بن سعد فطمّها ثُمّ حفر ثانيه فطمّها. واشتد بهم العطش ومنعوهم الما ثلاثه أيام. فلمّا كان صبيحة اليوم الرابع وقد كضّهم[997] العطش استدعا الحسين بأخيه العباس ـ وكان أصغر أولاد[998] عليّ ـ ثُمّ قال: يا خي[999] ما تريد؟ قال: ما ترى[1000] الحرم والأطفال كيف ينضون[1001] عطشاً؟! وأخوالك من بني كلاب[1002] نزلوا على الما ـ وكانت اُمّ العباس يقال لها: اُمّ البنين بنت حارس بن خالد الوحيد الكلابي[1003] ـ فقال له العباس: كيف أصنع؟ فقال له الحسين: تأتيهم بغته. فقال: سمعاً وطاعه. ثُمّ ضمّ إليه ثلاثون[1004] رجلاً، فأخذوا معهم القِرَب[1005] وساروا حتى أتوا المشرعه ليلاً، وكان بها عمر بن الحجاج الزبيدي بن أبي لجيه، فأحسن[1006] بهم. فقالوا[1007] لهم: مَن أنتم؟ فقال[1008] لهم: نحن من شيعة الحسين. فقال لهم: عبد الرحمن بن دحيه[1009]: وما تصنعون يا شيعة الحسين ههنا؟ فقالوا لهم: قد كفا[1010] العطش. فقال: ومن زعيم القوم فيكم؟ قالوا: معنا قرابه الأمير عمر بن الحجاج. فقال: اصبروا حتى أستأذن لكم الأمير، ثُمّ دخل عليه، فقال له: إنّ قرابتك قد وآفا[1011]، وهو يذكر أنّه عطشان، ومعه جماعة نفر[1012]، وقد وردوا الما فمنعتُهم منه. فقال: عليّ به. فأُدخِل عليه فرحّب به، وقال له: قل ما تشا. قال الحرم عطشانين[1013]، وأنا عطشان، فقال لهم: أَفرَجُوا[1014] له عن الما يشرب وحده. فقال له العباس: ويلك أكفرٌ بعد إيمان وضلال بعد برهان؟! لا أشرب ما[1015] وسيّدي الحسين ظمأن، وبنات رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) عُطَاش[1016]. فقال له: فكان[1017] أخاك الحسين أحبّ إليك من نفسك؟! فقال له العباس: يا ويلك! والله إنّ شعره من الحسين أحبّ إليَّ من قومي كلّهم. فقال له: لا أنت تشرب، ولا الحسين يشرب من الما جرعه، ثُمّ ثارت بهم الخيل، وثارت خيل العباس بهم أيضاً.
وفي روايه أخرى: أنّهم يأتون الما الّا نهاراً[1018] وهو الصحيح. ثُمّ إنّهم اقتتلوا قتالاً شديد[1019].
31ـ قال أبو مخنف: فقاتلت الثلاثين فارس[1020] التي كانت مع العباس الأربعين[1021] ألف فارس[1022] التي كانت مع عمر بن الحجاج (قبّح الله فعله). فلمّا تكاثروا عليهم التفت العباس إلى أصحابه، وقال لهم: الحقوا بسيّدي الحسين، فمضوا عنه وبقي وحدَه، فقال له الأبراد الكلبي[1023]: من أنت يا فتى؟ فقال: أنا العباس بن علي بن أبي طالب. فقال له: ابن أخت زهره[1024]؟ قال: نعم، قال: ما تشا؟ قال: أنا عطشان، فأمر أصحابه يفرجوا[1025] له عن الما فملا السقا[1026] وغَرفَ من الما، وهَمّ أن يشرب فذكر عطش الحسين، فقال: والله لا ذُقتُ ما[1027] وسيّدي الحسين عطشاناً. ثُمّ احتمل السقا وصعد من الفراه[1028].
32ـ قال أبو مخنف في روايته: إنّ العباس حمل عليهم فكشفهم عن الما، واغترف وجعل يقول:
|
لا أرهبُ
الموتَ إذ الموت رَقا[1029] |
ولم يزل يقاتل ويحمل عليهم فيقتل منهم أبطالاً ويجرح رجالاً ويتلقى سهماً منهم بنحره وصدره ويكر فيهم ويرتجز يقول:
|
تَعَدَّيْتُمْوا يا شَرَّ قَوْم
! بفِعْلِكُمْ |
فقتل منهم خلق كثير[1040] ووقف يرتجز ويقول:
|
يا نفسُ من بَعْدِ الحسينِ هُوني |
ثُمّ حمل عليهم، وحمل عليه رجل يقال له: الأبرد بن شتوي الجهني[1045] ضربه ضربةً على يمينه فقطعها، وطاحت عنه والسّيف فيها، فأخذ العباس السّيف بشماله، وحمل عليهم ويده تشخب دماً، فقتل جماعه، وهو يرتجز ويقول:
|
والله إن قَطعتُمُوا
يمينــــي |
وحمل عليهم، فحمل عليه عبد الله الشهباني[1047] فضربه على شماله فقطعها، فحمل عليهم، وهو يرتجز ويقول شعر:
|
يا نفسُ لا تخشـي من الكُفَّارِ |
وجعل العباس (رضوان الله عليه) يصادمهم[1051] حتى قلّت[1052] نفسه الزكيه عليها أفضل الصلاه والسلام. فلمّا بلغ الحسين قتله أثّر فيه الغمّ واعتر به الكابة[1053] والهمّ، ثُمّ قال: لا حولَ ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم. ثمّ إنّه أجرى[1054] فرسه حتى وقف على مصرعه، فلمّا راه بكا بُكا شديداً، ثُمّ نزل عن فرسه وجعل يقبّله ويقول: جزاك الله من أخٍ خيراً[1055]، ثُمّ قرا (فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)[1056].
33ـ وفي مسند أبي[1057] عبد الله بن أحمد بن حنبل (رضي الله عنه) بإسناد يرفعه إلى رجل من بني ضبّه[1058]، قال: كنتُ مع علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ليال[1059] نزل كربلا عند رجوعه من صِفّين فرايتُه قام تنحّا[1060] وحده ما قربه أحدٌ، وأشار بيده فقال: ههنا ـ والله ـ مناخ ركابهم وموضع رجالهم، ثُمّ ضرب بيده إلى تربة الأرض فأخذ منها قبضةً فشمّها، ثُمّ قال وا حبّذا بدماء تُسفَك فيك. وهو قايم وحده ما قربه أحداً[1061]، وأنا أنظر إليه. ثُمّ مضى ذلك لشانه، وكان من الأمر ما كان[1062].
ثُمّ إنّ الحسين خرج حتى نزلها، وكنتُ في الخيل التي بعث عبيدُ الله بها إلى الحسين، فوالله ما كان إلّا أن انتهيتُ إلى ذلك الموضع، ونظرتُ إلى مقام عليٍّ، وأشار بيده[1063]، فأثنيتُ فرسي ساعة قتل العباس، وأقبلتُ إلى الحسين فسلّمتُ عليه، وقلتُ: إنّ أباك كان أعلم الناس، وإنّي سمعتُه يقول كذا وكذا، وإنّه قام هذا المقام، وأشار بيده، ثُمّ قال: وا حيدا[1064]! واهاً بدماء تسفك فيك! وإنّك لمقتول الساعه، فخذ لنفسك واصنع ما أنت صانع. فقال الحسين: ما تريد أن تصنع؟ أتتبعنا أم تلحق بأهلك؟ قال فقلتُ: والله إنّه علىَّ عيال ودين[1065]، وما أظنّ إلّا سألحق بأهلي. فقال الحسين: أما فانظر ما هنالك. قال: فنظرتُ وإذا بمالٍ موضوع. فقال: خذ حاجتك منه قبل أن يحرم عليك، والله ما يرى البارقه[1066] أحداً[1067] ولا يسمع أحداً الواعيه[1068] ثُمّ لا يغيثنا ـ أو قال لا ينصرنا ـ إلّا كان ملعوناً على لسان محمد (صلى الله عليه [وآله] وسلم). قال فقلتُ: والله لا أجمع عليك أمرين: أخذلك ثُمّ آخذ مالك. قال: ثُمّ إنّ الحسين دعا رجل[1069] من أصحابه يُقال له: أنيس الكاهلي[1070] وقال له: اذهب إلى هولا القوم، فذكّرهم الله ورسولَه؛ عيسى[1071] أن يرجعوا عن قتالنا، فإنّي أعلم أنّهم لا يرجعون، ولكن لتكون الحجّه عليهم إلى يوم القيامة. فانطلق أنيس حتى دخل على عمر بن سعد (لعنه الله) ولم يسلّم، فقال له: يا كاهل[1072] ما منعك أن تسلِّم عليَّ حين دخلتَ؟! ألستُ مسلماً ؟! قال: لا والله.
فقال عمر: واللهِ ما كفرتُ بعد ما عرفتُ الله ورسوله. فقال له أنيس: كيف عرفتَ الله ورسوله، وأنت تريد قتل وَلد رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) وأولاده؟! فنكّس[1073] رأسَهُ ساعة، ثُمّ قال: والله إنّي أعلم أنّ قاتلهم في النار، ولكنّ الله قدّر بهذا. فلمّا سمع أنيس كلامه رجع إلى الحسين وأعلمه بما جرى[1074].
34ـ قال أبوا[1075] مخنف: ثُمّ إنّ الحسين رجع عن مصرع أخيه العباس ثُمّ جمع أصحابه، وقال لهم: يا قوم إذا هجم الظلام فخذوا لأنفسكم النجاة، وسيروا ودعوني؛ فما طَلِبة[1076] القوم غيري. فأجابوه[1077] جميعُهم، أهلُه وبنوا[1078] عمِّه ومَن معه من مواليه: بأيِّ وجهٍ نلقى الله وجدّك (صلى الله عليه [وآله] وسلم)؟ فقال لهم: ما قَصدُهم إلّا ياي[1079]، وأنتم فقد بذلتم مجهودكم، وأعطيتم ما عندكم. فقال له زهير بن القين[1080]: حاشا لله أن نفعل ذلك أبداً، بل نذبُّ عنك بأسيافنا، ونطعن برماحنا، ونحمي ما حملتْنا سروجُنا. وأعظم البليه تصير[1081] شنيعة في القبايل، وحديث[1082] في المحافل، ومثلاً تسير به الرُّكبان في البلدان، يقولون: كأنّكم سرتم مع بنت[1083] نبيِّكم، وسيّد قومكم، وزعيم دينكم، حتى أسلمتموه إلى المهالك، وخذلتموه في أضيق المسالك، حتى أشفيتموا[1084] أعدايه[1085] منه، ورجعتم عنه. واللهِ ما نزول عنك أو نُذبَح كما تُذبَح الإبلُ في مواسمها، وإلى الله المنقلب. فجزّاهم الحسين عند سماع قولهم خيراً[1086].
ثُمّ تنفّس الصعداء وأنشأ يقُول:
|
يا رَبِّ ! لا
تَتْرُكْني وَحيدا |
قال: وكان قد حان وقت صلاة الظهر فصلّى الحسين بأصحابه صلاة الظهر، ثُمّ حملته عيناه فنام فراى في منامه جدَّه رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، وهو يقول: يا حسين الوحا الوحا[1088]، فانتبه وهو باكي[1089] حزيناً ممّا رأى. فقالت له اخته زينب[1090] ـ وكانت تحبه حباً شديداً ـ: يا سيّدي نامت عيناك وانتبهت فزعاً مرعوباً مكروباً، فخير[1091] رأيتَ؟ وخير يكره[1092]؟! فقال لها: يا ختي[1093] الساعه رأيتُ جدّي وهو يقول: يا حسين الوحا الوحا. قال: فبكيت[1094] زينب‘، وقالت: بنفسي أفديك، ومهجتي من الأسو[1095] أتقيك.
ثُمّ إنّ الحسين بات في تلك الليله في جهد[1096] مجتهداً إلى الصباح، فلمّا صلّى
الغداه
نادى عمر بن سعد (لعنه الله) في عسكره: أن خذوا هبتكم[1097] فركبت الخيل،
ثُمّ عبّا الصحابه ميمنة وميسره وقلب[1098] وجناحين،
فجعل في الميمنة الشمر بن
ذي الجوشن المضابي[1099]
(لعنه الله)، وجعل في الميسره سنان بن أنس النخعي (لعنهم
الله أجمعين)، كلّ واحد منهم في ستة آلاف فارس. ثُمّ جمع بقية عسكره معه
ووقف بنفسه في القلب. ثُمّ أخذ عمر بن سعد سهماً ورمى به الحسين فوقع بباب الخيمه،
فلمّا راه الحسين قال لهم: هذا رسول حرب القوم قد أتاكم فأُعبّيكم[1100]. فقالوا له:
عَبّنا، فواللهِ لا نزال بين يديك مجاهدين، وفي طاعة الله ورسوله صابرين إلى أن
تهشّم النواجذ[1101]،
وتكلّ[1102]
السواعد، وتفلّق الهام، وتبثوا[1103]
الجسام. فعند ذلك عبّأهم؛ فجعل في ميمنته زهير بن القين (رحمه الله) في عشرين
رجلاً، وجعل في ميسرته قيس بن مشروق العبسي[1104]،
وقيل كان نافع بن هلال البجلي[1105]
(رضي الله عنه)، وجعل سعد بن مالك النخعي[1106]
على الساقه[1107] في عشرين
فارساً، وجمع ما بقي معه، ووقف في القلب. وجمع الأطفال والحريم في خيمة، وكان قد
حفر حولها خَندقاً وأضرَم فيه النار كما ذكرنا في أول الحديث حتى يكون القتال من
وجهٍ واحد[1108].
قال: فوقف العسكران ساعة من النهار، فقال الحسين لأصحابه: ما وقوفكم عن جمع الكفر وعصبة الشرك[1109]، ثُمّ أنشا وجعل يقول:
|
الْحَمْدُ لِلهِ
على الشَّدايدِ |
35ـ قال أبو مخنف: ثُمّ برز من أصحاب بن سعد رجل، يقال له جويزه[1113]، فقال: يا حسين لقد استعجلتَ بالنار في الدّنيا قبل الآخره. فما استتمّ كلامه[1114] حتى تقرّب فرسه على ساقية هناك، فوقع فتقطّع إرباً إرباً حتى لم يبقَ سوى رجله معلّقه في الرِّكاب[1115].
36ـ وفي روايه أبي عبد الله أحمد بن حنبل بإسناد
يرفعه إلى رجل يقال له
علقمه بن واثله[1116] أنّه قال: شهدتُ المقام يوم كربلا، وسمعتُ الرجل
والحسين، فبينما هو قايم إذ جاه رجل فقال: أيُّكم
حسيناً[1117]؟ فقال:
مَن أنت؟ فقال: أنا جويزة، أبشر يا حسيناً[1118] لقد استعجلتَ
النار في الدنيا قبل الآخره. فقال الحسين: اللّهم جزوه[1119]
إلى النّار. فما استتم الحسينُ كلامَه حتى تقرّب به فرسُهُ فألقته في نار الخندق، فاحترق
وعجّل الله بروحه إلى النار، فكبّر عند ذلك الإمامُ ثلاثَ تكبيرات[1120].
37ـ وبإسناده أيضاً يرفعه إلى هشام بن حسان، يرفعه عن محمد بن سيرين[1121] عن أصحابه أنّ علياً قال لعمر بن سعد (لعنه الله): كيف لي بك يا عمر إذا قمتَ صفان[1122] ما، تُخيَّر بين الجنة والنار فتختار النار؟![1123].
38ـ وبإسناده أيضاً أنّه قال: قال أنس بن مالك[1124]: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): الحسن والحسين شباب[1125] أهل الجنة، وفاطمه أمّهم سيدت[1126] نسا أهل الجنه. فمَن أحبّهم فقد أحبّني، مَن بغضهم[1127] فقد أبغضني[1128].
39ـ قال أبو مخنف لوط بن يحيى: لما هلك الرجل قال له[1129] زهير بن القين للحسين: يا سيّدي أتأذن لي أن أتكلم[1130] القوم؟ فقال له الحسين: قد أذنتُ لك في ذلك. فناداهم زهير: يا أهل الكوفة، يا معاشر العرب، أتدرون أيّ دمٍ تريقون؟! وأيّ كبد تصدعون؟! وأيّ جسد ترمون؟! وأيّ فادح تفدحون؟! وأيّ بطل تقاتلون؟! ويلكم! أما تعلمون أنّ كبد رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ترمون؟! وعن الدّين تصدّون؟! وحشاشة قلبه تلذعون؟! وعن الصراط تحيدون؟! (كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ)[1131]، ثم قرا (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)[1132] ويلكم! لو كان خارجي[1133] من بلاد الروم ما كنتم فاعلون[1134].
40ـ قال أبو مخنف لوط: ثُمّ حمل القوم بعضهم على بعض واشتدّ الحربُ عليهم، وصبر الحسينُ هو وأصحابه حتى انتصف النهار، وهم يقاتلون من وجه واحد؛ لتقارب البيوت بعضها من بعض. فلمّا نظر بن سعد (لعنه الله) إلى ذلك أمر بإحراق البيوت، فقال الحسين لأصحابه: دعوهم يحرقوانها[1135] فإنّهم إن أحرقو[1136] البيوت لم يصلوا إليكم؛ لأجل النار، ولم يكن قتالهم إلّا من وجه واحد[1137].
ثُمّ إنّ شمر[1138] (لعنه الله) حمل حتى طعن فسطاط النسا، وقال: عليَّ بالنار حتى أُحرِق بيوت الظّالمين. فحمل عليه أصحابُ الحسين، فكشفوهم، وناداه الحسين وقال: يا شمر، أتحرق حرم رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)؟! قال: نعم. فرفع طرفَهُ إلى السما وقال: اللّهم لا يعجز شمر أن تحرق جسده بالنّار يوم القيامه. فغضب شمر (لعنه الله) فصاح: يا ويلكم؟! كرّوا عليهما[1139] كرةَ رجلٍ واحدٍ وأبيدوهم عن آخرهم. فحملوا عليهم وتفرّقُوا عن شمايلهم وأيمانهم وبين أيديهم ومن خلفهم، وجعلوا يرشقُونَهم بالنّبال ويطعنونهم بالرّماح ويضربونهم بالصفاح، فبين ضَيع[1140] وجريح وقايم وطريح[1141].
فلمّا را أبوا[1142] ثمامه عمر بن عبد الله الصّيداوي إلى إحاطة القوم بهم أقبل على الحسين وقال: يا بن عم[1143] رسول الله إنّنا مقتُولون لا مُحاله، وقد حضرة[1144] الصلاه، فصلّي[1145] بنا فإنّي أرى أنّها آخر صلاة نُصلّيها، فلعلّنا نلقى الله تعالى على فريضه. فقال: نعم. ثُمّ أذّن فلمّا فرغ من الأذان نادا[1146]: يا عمر أنسيت شرايع الإسلام؟ ألا تقف عن الحرب ساعةً حتى نُصلّي ثُم نعود إلى الحرب؟ فلم يُجبهُ فناداهُ الحُصين بن نُمير[1147]: يا حسين صلّي[1148] ما بدا لك أن تُصلي؛ فإنّ الله لا يقبل صلاتك. فقال له حبيب بن مطهّر ـ وكان وقفا[1149] بين يدي الحسين (عليه الصلاة والسلام) ـ: ثَكلتك أمّك، يا ويلك! لا تُقبل صلاة بن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) وتُقبل صلاتك يا بن الحمارة[1150]! فغضب الحُصين حين ذكر أمّه، وبدر نحوه، وهو يقول شعر:
|
دونَك ضربَ السّيف
يا حَبيبي[1151] وافاكَ ليثٌ
بطلٌ نَجيبُ كأنَّه من صعده صَليبُ |
ثّم نادى: يا حبيب، ابرز إلى ميدان الحرب، ومعدن الطعن والضرب، فلمّا سمع حبيب كلامه، سلّم على الحسين وودّعه، وقال: يا مولاي إن تنقضي[1152] صلاتُك وأصلي في الجنّة، وأُقرى[1153] أباك وجدّك وأخيك[1154] السّلام.
ثمّ إنّه برز إلى الحُصين بن نُمير وهو يقول:
|
أنا حبيبٌ
وأبي مُطهرا[1155] |
ثُمّ حمل في إثر شعره على الحُصين فضربه في وجه حصانه فقطع خيشومه[1160] فوثب من تحته فأرداه إلى الأرض وهمّ أن يعلوا[1161] بضربة أخرى فحاما[1162] عنه قومه واستنقذوه منه[1163]، فحمل على رجل من بني تميم[1164] فضربه على اُمّ راسه فقتله. ولم يزل يحمل عليهم حتى قتل منهم جماعة[1165]، ثُمّ تكاثروا عليه عليه[1166] فقتلوه (رحمه الله عليه).
ولما قُتِل العباس وحبيب بيّن وجه الانكسار في وجه الحسين فقام إليه رجل يقال له: زهير بن القين (رضي الله عنه) وقال: يا بن رسول الله ما هذا الانكسار الذي نرى في وجهك؟! ألستَ تعلم أنّنا على الحق؟! قال: بلى وإله الخلق. قال: فما بالك لا تريد قتلنا؟! وإنّنا نصير إلى الجنة ونعيمها. ثُمّ برز أمامه وقال: يا مولا[1167] أتأذن لي في البراز؟ فقاله[1168]: اُبرُز شكر الله فِعالك، فَبرزَ زهير، وهو يقول:
|
أنا زُهيٌر
وبن القيني[1169] |
ثُمّ حمل على القوم فقتل منهم من العشرين[1173] رجلاً. وخشي أن تفوته الصلاة فخرج وصلّى[1174] ثُمّ برز إلى الحرب والقتال، وقال: أبشر يا بن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) بالفوز والجنّه والقدوم على جدّك رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، ثُمّ أنشأ يقول:
|
أقبِل حُسيناً
هادياً مهديّاً |
وحمل على الملاعين ولم يزل يُقاتلُ حتى قتل سبعين[1177] رجلاً ثُمّ استُشهِد أَمَامَ الحسين[1178].
وبرز من بعده بن مهاجر[1179] وأنشد:
أنا يزيد وأبي
مُهاجر |
ثُمّ حمل على القوم ولم يزل يقاتل حتى قتل منيفاً[1184] وأربعين رجلاً، ثُمّ قُتِل (رضي الله عنه)[1185].
وبرز من بعده يحيى بن كثير الأنصاري[1186] (رضي الله عنه)، وهو يقول[1187]:
|
ضاق الخناقُ
ببغي سعدٍ وابنه |
وحمل على القوم ولم يزل يقاتل حتى قتل منهم أربعين رجلاً[1194]، ثُمّ قُتِل (رحمة الله عليه)[1195].
فبرز من بعده هلال بن نافع البجليّ[1196]، وكان قد ربّاه أمير المؤمنين، وكان من الفرسان المعدوده المعروفه بالسجاعه[1197] الموصوفه. وكان رامياً بالنّبل، وكان يكتب اسمَه على النّبل ويرمي بها، فلا يخطي. فجعل في كَبدِ قوسِهِ نبله، وجعل يقول:
|
أرمي بها
مُعلمةً فواقها[1198] |
ثُمّ حمل فقتل رجالاً وجَندَل أبطالاً[1202]، ثُم قُتِل (رحمة الله عليه)[1203]. ثُمّ برز من بعده إبراهيمُ بن الحسين[1204] وأنشد يقول:
|
أقد[1205] حسينُ اليومَ تلقا[1206] أحمداً |
ثُمّ حمل على القوم، ولم يزل يقاتل حتى قتل خمسين فارساً، ثُمّ تكاثروا عليه فقتلوه (رحمة الله عليه).
ثم برز من بعده عليُّ بن مظاهر الأسدي[1211] وهو يقول[1212]:
أقسم لو
كُنّا لكم أعدادا |
ثُمّ حمل وجعل يقاتل حتى قتل سبعين فارساً، ثُمّ قُتِل(رحمه الله عليه)[1216].
ثُمّ برز من بعده المُعلّا بن العلي الذهلي[1217]، وكان معروفاً بالشدة والباس وهو يقول شعر:
|
أنا المُعلّى
والمُحرز أجلي |
ثُمّ حمل، ولم يزل يقاتل حتى قتل أربعة وعشرين[1218] رجلاً، ثُمّ اُخِذ أسيراً فوقف بين يدي عمر بن سعد فقال له: درّك[1219]! ما أشدّ نصرتك لصاحبك! ثُمّ ضرب رقبته (رضي الله عنه).
ثُمّ برز من بعده غلام أسود يقال له جرير[1220] كان لأبي ذر الغفاري (رضي الله عنه) وأنشد يقول:
|
سوف ترى
الكُفّار ضربَ الأسودِ |
ثُمّ حمل، ولم يزل يقاتل حتى قتل أربعين رجل[1223]، ووقعت في محاجِر عينيه ضربة فكبا به الجواد فأرداه إلى الأرض فأحاطُوا به فقتلوه صريعاً (رحمة الله عليه).
ثُمّ برز من بعده عمر بن مُطاوع[1224] وأنشا يقول:
|
إنّي عمر وأبي
مُطاوعُ |
ثم حمل، ولم يقاتل[1226] حتى قتل من القوم ثلاثين رجلاً[1227] ثُمّ استُشهد (رضي الله عنه)[1228].
وبرز من بعده الغُلام[1229] الذي أسلم هو، واُمُّهُ على يد الحسين، وأنشا يقول:
|
إن تُنكرُوني
فأنا بن الكَلبي |
ثُمّ حمل، ولم يزل يقاتل حتى قتل ننيفاً عشرين[1232] رجلاً[1233]، ووقع فيه سبعين[1234] طعنه، وطربوه[1235] وجعلوه هو وجواده كالقنفذ، فانجدل صريعاً، وعُجِّل بروحه إلى الجنّه (رحمة الله عليه)، وأخذوا[1236] رأسَه، ورموا به إلى الحسين فوقع بين يدي أمّه فأخذتهُ، ثم وضعته في حجرها، وجعلت تمسح الدم من على وجه، وتقول: الحمد لله الذي بيّض وجهي، وسرّ قلبي بابني، باستشهاده بين يدي ابن بنت رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، ثُمّ بكت بكا شديداً، وقالت: لحاكم[1237] الله يا مه[1238] السُوء، أشهد بالله أنّ اليهود في كنايسها والنصارى في بِيَعهِا[1239] والمجوس في قناديلها خيراً[1240] منكم. ثُمّ أخذت الرأس ورمَت بها في عسكر بن زياد فأصابت رجلاً فقتلته[1241].
ثُمّ برز من بعده الطّرماخ[1242] بن علي (رضي الله عنه)، وحمل على القوم وجعل يقاتل قتالاً شديداً، ثُمّ قُتِل (رحمة الله عليه)[1243].
فبرز من بعده العلا بن حنظله الغفاري[1244]، وحمل على القوم وجعل يقاتل حتى الرمح فجعل يقاتل[1245] بالسيف حتى كلّ[1246] ساعده وقتل منهم رجلاً، وكبا[1247] به فرسه فرماه إلى الأرض، فداروا حوله من كلّ جانب ومكان وقتلوه ضرباً وطعناً (رحمة الله عليه)[1248].
ثُمّ برز من بعده عبد الله بن مسلم بن عقيل[1249] فوف[1250] بين يدي الحسين، وقال: يا مولاي أريد البِراز فقال: يا بُنيّ كفاك وكفا[1251] آل عقيل[1252] من القتل وما هم فيه من مصاب مسلم. فقال: يا ابن العمّ[1253]، وبأيّ وجه ألقا[1254] الله ورسوله إذا أسلمتُ[1255] أنا وقومي وعشيرتي ولم أقاتل معهم[1256]. والله لا كان ذلك أبداً. وأنشد يقول:
|
نحن بنُوا[1257]
هاشم ٍالكرام |
ثُمّ حمل على القوم فقتل منهم جماعه كثيره، ورماه رجل[1260] منهم بسهم فقتله (رحمة الله تعالى عليه)[1261]. فلمّا نظر الحسين إلى ذلك قال: اللّهُمّ اُقتُل قتّاله آلِ عقيل، ثُمّ قال: إنّا لله وإنّا إليه راجِعون. ثُمّ أقبل على باقي أصحابه وقال: احملوا بارك الله فيكم[1262].
فبرز عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (رضي الله عنه) وأنشد يقول:
|
أقسمتُ لا
أدخُلُ إلّا الجنّة |
ثُمّ حمل على القوم، ولم يزل يقاتل حتى قتل أحد[1265] وعشرين[1266] رجلاً، ثُمّ قُتِل(رحمة الله عليه)[1267].
ثُمّ برز من بعده جابرُ بن عبد الله الغفاري[1268] وكان الشيخ[1269] كبيراً، قد شهد مع رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) بدراً[1270] وحنيناً[1271] فجعل يشدُّ وسطَه بعمامة، وادعا بعصابة عصّب بها حاجبَيهِ ورفعَهُما عن عينيهِ والحسن[1272] ينظر إليه ويقول له: شَكَرَ اللهُ لك يا شيخُ فعالك. ثُمّ حمل على القوم وهو ينشد ويقول:
|
قد عَلِمت
حقّاً بنُوا[1273]
غِفارِي |
ثُمّ حمل عليهم، ولم يزل يقاتل حتى قتل من القوم ستين[1275] رجلاً، ثم قُتِل (رحمة الله عليه)[1276].
ثُمّ برز من بعده مالك بن داود[1277]، ونشد[1278] يقول:
|
إليكُموا[1279] من بطلٍ هُمام |
ثُمّ حمل على القوم ولم يزل يقاتل حتى قتل خمسة عشر[1282] رجلاً ثُمّ قُتِل (رحمه الله).
وبرز من بعده موسى ابن عقيل[1283] (رضي الله عنه)، وهو ينشد ويقول:
|
يا مَعشـَرَ
الكُهُولِ والشُّبّانِي[1284] |
ثُمّ حمل، ولم يزل يقاتل حتى قتل من القوم أربعة وعشرون[1290] رجلاً، ثُمّ قُتِل (رحمة الله عليه)[1291].
ثُمّ برز من بعد[1292] أحمد بن محمد الهاشمي[1293]، وهو ينشد ويقول:
|
أبلُوا[1294] اليومَ حَسبي ودينِي بصارمٍ تحملُهُ يَميني |
ثُمّ حمل على القوم، ولم يزل يقاتل حتى قتل خمسةً وأربعين رجلاً[1298]، ثُمّ قُتِل (رحمة الله عليه)[1299].
فعند ذلك نظر الحسين يميناً وشمالاً، فبكا، وحل[1300]
ينادي: ومحمداه[1301]!
وا جدّاه! وابتاه[1302]! وا علياه! وا أخاه! وجعفراه[1303]! وا حمزتاه! وا عباساه[1304]! ثُمّ نادى: ما[1305]
من نَصير ينصُرُنا؟ أما من مُجير يُجيرُنا؟ أما من مُعين يعينا[1306]
؟ أما من طالب جنّه فيطلُب حقّنا؟ أما من خايفٍ من عذاب الله فيدفَع عنّا؟ ثُمّ
بكا بكا شديداً عالياً[1307]،
وأنشد يقول:
|
أنا ابنُ
عليِّ الطُّهرِ من آلِ هاشمٍ ونحنُ سِراجُ
الله في الأرض نزهَرُ |
41ـ قال أبو مخنف: فوقع كلامه في مَسامِع الحرّ بن
يزيد الرياحي (رضي الله عنه)، وكان له ابن عمّ فأقبل على بن عمه[1311]، وكان اسمه مُرّة بن قيس[1312]
فقال له: يا بن العم ألا تنصراني[1313]
الحسين؟ يستغيثُ فلا يُغاث! ويستجيرُ فلا يُجار! فهل
لك أن تمضي بنا إليه، ونقاتل بين يديه،
وننصره على مَن بغى عليه؟ فلعنا[1314]
نفوزُ بالشّهادتين، فنكون من أصحاب
السعاده. قال له: حاجة[1315]
لي في
ذلك[1316]. فأقبل على ولده، وقال له: يا
بُنيّ لا صبر لي على عذاب النّار، ولا على غضب الجبّار، لا[1317] أن يكون خصمي محمد[1318]
المختار. يا بُنيّ سِر بنا إلى الحسين نُقاتل بين يديه. فقال له ولدك[1319]:
لستُ لك مخالفاً فيما تريد. ثُمّ إنّهُما حملا معاً على عسكر بن زياد (لعنه الله)
فكأنّهُما جبلين[1320]. ولم يزالا يقاتلا[1321] حتى هجما على الإمام، فجعل الحر
يُقبّل الأرض بين يديّ الإمام، وقال له: يا مولايَ أنا الّذي منعتُك من الرجوع إلى
أهلك، فوالله ما عَلِمتُ أنّ هولا الملاعين يبلُغُون منك ما بلغُوا. وقد أتيتُك
تايباً ممّا كان منّي، ومواسك[1322]
بنفسي، حتى أموتَ بين يديك فهل ترى لنا من توبه؟ فقال له: تُب يتوب الله عليك، وهو
أرحمُ الراحمين[1323].
ثُمّ إنّ الحُرّ (رضي الله عنه) أقبل على ولده[1324]، وقال: يا بُنيّ احمل على أعدا الله الظّالمين، فحمل الغُلام على القوم، ولم يزل يُقاتل حتى قتل منهم أربعة وعشرين رجلاً[1325]، ثُمّ قُتِل (رحمة الله عليه)[1326]. ثُمّ نظر إليه أبوه فَفرح واستبشر، وقال: الحمد الله الّذي استُشهد ولدي بين يدي ولد رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم).
ثُمّ تقدّم إلى الإمام، وقال: يا مولا بحق جدّك رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) إلّا أذنتَ إليَّ بالبراز إلى هولا الطغاة البغاه؛ فإنّني كنتُ أوّل من خرج إليك، وإنّني أحبّ أن اُقتَل بين يديك، فقال له: ابرز، وقُل: لا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم، فبرز وهو يقُول[1327]:
|
يقول أمير
غادرٌ وبن غادرٍ إلى فية[1330] زاغَت عن الحقِّ ظالِمَه ويا حسـرة مان[1335] تفارِقَ لازِمَه |
ثُمّ حمل على القوم فقتل رجالاً وجندل أبطالاً[1341]، ورجع إلى مقامه، وهو يقول:
|
هو الموتُ
فاصنع ما أنت صانعُ يُريدونَ هَدمَ الدِّينِ والدِّينُ شارعُ[1343] يُريدون عمداً
قتلَ آل محمدٍ |
ثُمّ جَال عليهم، وقال: يا أهل الكُوفه دَعوتمُوه وزعمتُم أنّكم قاتلوا أنفسكم دونه، حتى إذا جاكم عدتُم[1345] عليه لتقتلوه، وأحطتُم به من كلّ جانب ومكان، ومنعتُمُوهُ من الذّهاب في أرض الله الطويله العَريضَه، فأصبح في أيديكم أسيراً لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، ومنعتُم أهله وأصحابه شرب الما الذي تشربنه[1346] اليَهُودُ والنّصارى والمجُوس والخَنازير، فبيس[1347] ما خلفتُم محمداً في ذريّته، لا سقاكُمُ اللهُ يومَ الظما[1348] الأكبر إلّا أن تتُوبوا وترجِعُوا عمّا أنتم عليه[1349]. ثُمّ أنشأ وجعل يقُول:
ثُمّ حمل على القوم ولم يزل يقاتل حتى قتل نيفاً وخمسين رجلاً[1355] ثُمّ قال عمر بن سعد (لعنه الله): يا ويلكُم! ارشقُوهُ بالنّبل والسِهام فجعلوا يرشقُونَهُ حتى جعلوه كالقُنفُد، وحملوا عليه فأخذوهُ أسيراً، وحزّوا رأسَهُ ورمو[1356] به إلى الحسين، فأخذهُ وجعله في حِجره، وجعل يَمسحُ ثياباه[1357] وقال: والله ما أخطات[1358] اُمُّك اذ سمّتك اُمُّك[1359] الحُرّ أنت ـ واللهِ ـ سعيدٌ في الدّنيا والآخره. ثُمّ صلّى عليه، واستغفر له، وترحّم عليه، وبكا بكا شديداً، وأنشد وجعل يقُول:
|
لنِعمَ الحَرب
حَرب[1360] بَني رياحِ فَجادَ بنفسهِ
عندَ الصّياحِ |
ثُمّ جعل ينادي واغُربتاهُ! وا قلّة ناصِراهُ! أما من مُعين؟ أما من مسعد[1366]؟ أما من ناصر[1367]؟
قال: فخرج من الخيمة غُلامان كأنّهُما قمرانِ، أحدهُما يسمى أحمد[1368]، والآخرُ أبو القاسم[1369]. وهما ولدي[1370] الحسن. وهُما يقُولان لبّيك لبّيك سيّدنا، ها نحن بين يديك! امرنا[1371] بأمرك (صلى الله عليك). قال لهما: تحاميا[1372] عن حريم جدّكُما بارك الله فيكُما[1373].
فبرز القاسم[1374] وحمل القوم[1375]، ولم يزل يقاتل حتى قتل منهم ستين رجلاً[1376]، فكمن له منهم[1377] وضربه بالسّيف على هامته، فجندله صريعاً فخرّ لوجهه وهو ينادي: يا عمّاه انجدني؛ فوثب إليه الحسين، ففرّقهم عنه، وهو يضرب الأرض برجليه حتى قضى نحبه (رحمة الله عليه ورضى عنه)، فبكا[1378] الإمام وقال: اللّهم احبس عنهم قطر السماء، واحرمهم بركاتك. اللّهم فرّقهم شيعاً[1379]، واجعلهُم طرايق[1380] قِدداً[1381]، ولا ترضى[1382] عنهم أبداً. اللّهم وإن كُنتَ حَبستَ النصر عنّا فاجعل ذلك لنا ذخراً في الآخره، وانتقم من القوم الظّالمين[1383]. ثُمّ نظر إلى القاسم وبكا، وقال: يَعُزُّ على عمِّك أن تدعُوهُ فلا يُجيبُك، ثُمّ قال: هذا يوم كثير شرّه[1384] وقلّ ناصرُهُ. إنّا لله وإنّا إليه رجعون[1385]. ثُمّ حمل القاسم إلى القتلا[1386]، فوضعه بينهم[1387]، ثُمّ برز من بعده أخوه أحمد، وله من العُمر تسعة عشر سنه[1388]، وأنشد يقول[1389]:
|
أنا نجلُ
الإمام بن عليّ |
ثُمّ حمل، ولم يزل يقاتل حتى قتل ثمانين رجلاً، ورجع إلى الإمام وقد عات[1394] عيناهُ في اُمّ رأسه، وتقلّصت شفتاه من شدّة العطش، وا عمّاهُ[1395] هل عندك شربة من الما اتقوّا[1396] بها على الأعدا؟ فقال له: يا بن الأخ اصبر فلعلّك تلقا[1397] جدّك رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) واشرب من عنده شربةً لا تظمأُ بعدها أبد[1398] فخرج الغلام، وهو يقول:
|
صبراً جميلاً
فالمنايا[1399] بعدَ العطشِ |
ثُمّ حمل على القوم في إثر[1403] عطش، فقتل منهم جماعه[1404]، وأنشد يقُول:
|
إليكُم من بَني
المُختار ضَرباً |
ولم يزل يقاتل[1406] حتى قُتِل (رحمة الله عليه)[1407].
ثُمّ برز من بعده علي بن أبي الحسين[1408]÷[1409] وأنشد يقول شعر
|
أنا عليّ بن
الحسين بن علي |
ثُمّ حمل على القوم، ولم يزل يقاتل حتى قتل رجالاً وجندل أبطالاً، ثُمّ ضربه رجل على اُمّ رأسه، فخر عن ظهره[1411] جواده إلى الأرض، ثُمّ استوى جالساً، وجعل يقول: يا باه[1412] هذا جدّي محمد المصطفى، وأبي عليّ المرتضى، وأمي[1413] فاطمة الزهرا، وجدتي خديجة الكبرى، وهم مشتاقون إليك. ثم قضى نحبه[1414].
42ـ قال أبو مخنف: فلمّا قُتِل علي بن الحسين صرخن[1415] النسوان، وصاح بهنَّ الحسين× اسكُتن؛ فإنّ البكا أمامكُنّ[1416]. وحمل على القوم ففرّقَهم عنه، وأخذ رأسه ووضعها في حِجره، وجعل يمسحُ الدّم عن وجهه وهو يقول: يا ولدي لعن الله قوم[1417] قتلوك، ما أشدّ جراتهم على الله تعالى، وعلى ولد رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم). ثُمّ انهملت عيناه بالدموع[1418].
43ـ قال عِماره عن راشد[1419] عن حميد بن مسلم الأزدي، قال: كأنّي أنظُرُ إلى امرأة قد خرجت من فسطاط الحسين×، كأنّها البدر الطالع، وهي تُنادي وا ولداه! وا مُهجة قلباهُ! ليتني كنتُ عن هذا اليوم عميا، ووُسِّدتُ قبله في الثّرى. فوثب إليها الحسين× فردّها، فقلتُ: مَن هذه؟ فقيل لي: زينب ابنت[1420] علي بن أبي طالب (رضي الله عنه). ثُمّ قال: إنّا لله وانّا إليه راجعون، ثُمّ[1421] أمّا أنت يا بُني فقد استرحتَ من كرب الدُّنيا، وصرتَ إلى روحٍ ريحان[1422] وراحه، وبقى أبوك ومن معه، وما أسرع لُحُوقه بك.
ثُمّ أقبل على اُمّ كُلثُوم وقال لها: يا أُختاه اُوصيك بولدي الأصغر؛ فإنّه طفل صغير، له ستّة أشهُر[1423]. فقالت: له يا أبا عبدالله، هذا ولدك له ثلاثه أيّام ما شرب ماء، فاطلب له من القوم شربةً من الما. فقال لها: هلمّي الطفل إليّ، فدعّته[1424] إليه، فأخذه وخرج إلى الملاعين، وقال لهم: يا ويلكم! قد قتلتم شيعتي، وأهل بيتي، وبني عمّي وأولادي. وقد بقي هذا الطفل، وهو يتلظّى عطشاً، فاسقُوهُ شربةً من المآ. قال: فبينما هو يُخاطبُهم إذ أتاهُ سهم مَيشوم، من يد رامٍ ميشوم، يهوي قوقع[1425] في نحر الطفل، فذبحه من أُذنه إلى أُذنه. ويقال: إنّ السّهم رماه عقبه بن بشير الأسدي[1426] (لعنه الله)، ويقال: أبو قدامه العامري[1427] (لعنه الله). فجعل الإمام× يتلقّى الدّم بكفّه، ويرمي به الهوى[1428]، وهو يقول: اللّهُمّ اشهد على هولا القوم الطاغين، فإنّهم قد نَذَروا أن لا يدعُوا من ذُريّه محمد (صلى الله عليه [وآله] وسلم) أحد[1429]. ثُمّ رجع إلى الخيمة، فدفع الطّفل إلى اُمّ كُلثُوم، وأنشد يقول:
|
يا ربِّ لا تتركني وحيداً فقد ترى
الكفار والجحودا |
ثُمّ نادا[1431]: يا اُمّ كُلثُوم باا قد[1432] أسلمت نفسك للموت؟! فقال: يا اُختاهُ! وكيف يستسلم[1433] من لا ناصر له ولا معين؟! فقالت له: يا أخي اردّنا[1434] إلى حرم جدّنا. فقال: يا اُختاهُ! لو تُرِكَ القَطا مكانه لَنامَ. فرفعت صوتها سُكينةُ بالبكا والنّحيب وضمّها الإمام إلى صدره، وقبّل ما بين عينيها ومسح دُمُوعها، وكان يحبها حباً شديداً، ثُمّ أنشد يقول[1435]:
|
فإن تكن
الدنيا نفيسة[1436] فقتل الفتى بالسيف في الله[1440] فإنّي أراني
عنكموا[1441] سوف أرحلُ |
44ـ قال الراوي: ثُمّ حمل على الميمنه أقلبها[1446] على الميسره، وجعل يضرب فيهم يميناً وشمالاً حتى قَتل منهم خلق كثيره[1447]. فلمّا نظر شمر إلى ذلك أقبل إلى عمر بن سعد (لعنهما الله تعالى)، وقال له: أيّها الأمير إنّ هذا الرجل يفنينا مبارزه. فقال له: كيف نصنع به؟ قال: نتفرّق فرقتين[1448] فرقة بالسّيف والرماح، وفرقة بالسّهام. فقال: افعلوا، ففعلوا ذلك ويجعلوا[1449] يرشقونه بالنّبال، ويطعنونه بالرّماح ويضربونه بالسّيوف حتى أثخنُوهُ بالجراح[1450].
قال: واعترضه حولي[1451] (لعنه الله) بسهمٍ فوقع في لبّتهِ[1452] فأرداه[1453] عن ظهر جواده إلى الأرض يخُور[1454] في دمه[1455].
45ـ ورُوِي أنّ السّهم ما رماه إلّا أبو قُدامه العامري (لعنه الله)، فخر مغشياً عليه، ووثب ليقوم، فلم يُطِق، فبقى مطروحاً على الأرض، فقصده رجلٌ من كِنده، فضربهُ على مِفرَقِهِ[1456]، فشجّه[1457]، فسال الدم من راسه ووقعت البيضا[1458] فأخذها، فدعى على الكندي، وقال له: لا أكلتَ بيمينك ولا شربتَ بشمالك وحشرك الله مع القوم الظالمين. ولمّا أخذ الكندي البيضآ، ومضا[1459] بها إلى منزله فدفعها إلى زوجته، وقال: اغسليها من الدم، فبكت زوجته، وقالت له: يا ويلك! قتلتَ الحسين وسلبتَ سلاحَه! ولا[1460] اجتمعتُ أنا وأنت أبداً. فوثب فوثب[1461] إليها يلطمها فحادت[1462] يده عن اللطمه فأصابت مسماراً في باب الدار فقطع المسمار يده من مرفقه، فلم يزل فقيراً إلى أن مات (لا رحمه الله)[1463].
46ـ قال أبو مخنف: وبقى الإمام منكباً على الأر[1464] ثلاث ساعات من النهار، وهو ينادي صَبراً على قضائك وبلايك، لا معبود سواك. فابتدر إليه عند ذلك سبعون[1465] رجلاً كلّ منهم مبادر إلى قتله، وعمر بن سعد (لعنه الله) يقول لهم: يا ويلكم! عجّلوا قتله. فكان أوّل من نزل إليه شيت[1466] بن ربعي (لعنه الله)[1467] فرما[1468] السّيف من يده وولى هارباً، وهو يقول: معاذ الله أن ألقى الله بدمك يا حسين[1469].
ثُمّ أقبل إليه سنان بن أنس النخعي (لعنه الله) وكان كوسجاً[1470] قصيراً برصاً، وقال له: بشر[1471] ما قتلتَه؟ فقال له: يا ويلك! إنّه فتح عينيه في وجهي فشبهتُهما عيني رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فاستحيتُ أن أقتل شبيهاً لرسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم). فقال له[1472]: هلُمّ إلىَّ السّيف، فدفعه إليه، فأخذه ونزل عن فرسه، وهمّ أن يعلوا[1473] به راس الإمام× ففتح عينيه، ونظر إليه فارتعد فزعاً؛ فسقط السّيف من يده، فولّى هارباً، فأقبل عليه الشمر (لعنه الله وخزاه وجعل جهنم مثواه)، وقال: يا ويلك! لِمَ رجعتَ عن قتله؟ فقال له: إنّه فتح عينيه في وجهي فذكرتُ شجاعة أبيه فذُهِلتُ عن قتله، فقال له الشمر (لعنه الله): بل إنّك جَبان في الحرب. ثُمّ قال: هلُمّ السيف إليّ، فدفعه إليه، فأخذه ونزل عن جواده، ثُمّ أقبل إلى الإمام× فركب صدره[1474]، ووضع السّيف على نحره[1475] وهمّ أن يذبحه، ففتح عينيه ونظر إليه فقال له: من أنت؟ يا ويلك! فلقد ارتكبتَ منّي مركباً عظيماً[1476]! أمّا تعرفني؟ قال: بل[1477] أنت الحسين بن علي بن أبي طالب، وأمّك فاطمه، وجدّك رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)[1478]. فقال له الحسين: يا ويلك! إن كنتَ تعلم ذلك فَلِمَ تقتلني؟ قال له: أطلب بقتلك الجايزه من يزيد بن معاويه. قال: يا ويلك! أيّما أحبّ إليك جايزة يزيد بن معاويه أو شفاعة جدّي رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)؟ قال الشمر (لعنه الله): والله إنّ دانقاً[1479] من الجايزه أحبّ إليَّ من شفاعة جدّك وأبيك. فقال له: يا ويلك! إن كان ولا بدّ لك من ذلك فاسقني شربةً من الما. فقال: هيهات! لا ذقتَ من الما شياً أو تذوق الموت غصة بعد غُصّه[1480]. فقال له: بالله إلّا ما كشفتَ لي عن وجهك. فكشف له عن وجهه فإذا هو أبرص أعور، له له[1481] بُوز كبُوز الكلب[1482]، فعند ذلك قال: صدق جدّي رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)؛ قال لأبي: يا علي إنّ ولدك الحسين يقتله رجل أبرصٌ أعورٌ، له بُوز كبُوز الكلب أو قال: شبيه الخلق بالكلاب. فقال له الشمر (لعنة الله عليه): وتشبّهني بالكلاب؟! والله لأذبحنَّك من قفاك، ثُمّ قلب الحسين على وجهه وجعل يقطع[1483] أوداجَه، وهو يقول:
|
أقتُلُك
اليومَ ونفسـي تعلمُ |
وكان كُلّما قطع منه عضواً ينادى: وا جدّاه! وابتاه[1485]! وغُربتاه[1486]! وا عطشاه! وا قلّه ناصراه! أُقتَل مظلوماً وجدّي رسول الله؟! أُذبَح عطشاناً وأبي عليّ وأمي فاطمه بنت رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)؟!
فلم يرتاع[1487] شمر الملعون لذلك[1488]، ثُمّ جزّ راسه ـ رحمة الله على الحسين ـ ورفع رأسه على قناه طويله، وكبّر العسكر ثلاث تكبيرات؛ فعند ذلك تزلزلت الأرض، وأظلَمَ الشرقُ والغربُ، وأخذت الناس الصعق والرّجفه، وتقطّعت السما سبع نقط من الدم، ونادا[1489] من السّما: قُتِل ـ والله ـ الإمام أخُو الإمام أبُو الإمام. ولم تمطر السما دماً إلّا في ذلك اليوم، ويوم نُشِر[1490] يحيى بن زكريا÷ أربع قطرات. وكان قتل الحسين× يوم الإثنين عاشر المحرم سنة ستين[1491] من الهجره[1492].
قال: وأقبلوا يسالونه[1493]
فأخذ سراويلَه يحيى بن كعب، وأخذ قميصَهُ
الأشعث بن قيس[1494]، وأخذ سيفه رجل من بني وُهَيبَه
(لعنة الله عليهم أجمعين). ومالُوا على أسلاب القتلا[1495]
فأخذوها[1496].
47ـ قال عبدالله بن العباس: حدّثني من شهد الوقعه أنّ
فرس الحسين
جعل يصهل، ويتخطّى رقاب القتلى قتيلاً بعد قتيل حتى وقف على
جثت[1497]
الحسين، فلمّا نظر عمر بن سعيد[1498]
(لعنه الله) إلى ذلك صاح، وقال:
يا ويلكم! آتوني به. فركبت الخيل خلفه، فلمّا أحسّ بذلك جعلت تلطمُ
يدها ورجلها وتكدم[1499]
بفمها حتى قتلت خلقاً كثيراً، ولم يقدر عليها أحداً[1500].
وكانت من جِياد الخيل الذي لرسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، فلمّا نظر عمر
بن سعد إلى ذلك قال لهم: خلّوا عنه، فلمّا حفوه[1501]
من حوله جعلت تقبّل جثة الإمام وتمرّغ ناصيتها في دمه، فتعجّبوا من ذلك[1502]،
ثُمّ سارت إلى الخيام، كما سيأتي إن شا الله تعالى[1503].
48ـ وأمّا رواية أخرى: أنّه كان قد تخلّف مع الحسين× ـ بعد قتل أصحابه وأولاده ـ رجلٌ يقال له الضحاك بن عبيد الله[1504] فأتا[1505] الحسين×، وقال: أبا عبدالله، قد علمتَ ما كان بيني وبينك، وقد كنتَ أود لا أراك، أقاتل معك ما دمتُ مقاتلاً، فإذا جا أمر فأنا في حل من الانصراف. فقال له: وكيف لك بالنجاه؟! فقال له: إنّ فرسي مربوط من ورا البيوت. فقال له الحسين×: أسرع وانجُ بنفسك فجزاك الله عنّا خيراً. قال الضحاك: فودّعتُه وعمدتُ إلى فرسي، فاستويتُ على متنه[1506] وصرتُ[1507] حتى صرتُ في عرض الجيش، فتبعني منهم خمسةٌ وعشرين[1508] رجلاً، فنجّاني الله منهم. وبقى الحسين وحده ينادي هل من مجير؟! هل من معين يعين الوحيد؟! هل من مجير يجير الغريب؟! هل من مسعد يسعد المظلوم؟! يا قوم، أما جدّي محمد المصطفى، أمّا أبي علي المرتضى، أمّا أمّي فاطمة الزهرى[1509]؟! وهم كأنّهم أصنام وأساطين[1510] ممثّله من رحام[1511]، ثُمّ قال: اللّهُم اشهد على هذه على هذه[1512] الفيه[1513] الباغيه والأمة الطاغية. اللّهم فرّقهم فرقاً، وشتتهم شعباً[1514]، ولا تجمع لهم شملاً، ولا توصل لهم حبلاً، وبدّدهم طرائق قدداً، واكسر شوكتهم. ثُمّ إنّه إلى[1515] خيمة النسا، وقد ألبس[1516] من نفسه، فدخل الخيمه، وهو يبكي قالت له أخته: فممّا تبكي؟ لا أبكى الله عيناً[1517]. فقال لها: وكيف لا أبكي؟! ولا مجير ولا معين ولا نصير، ولا بقي معي من يسعد ولا مجاهد ينجد، وأنا بين قوم مرتدّين، وعن دين جدّي جاحدين، وفي ضلالتهم عايدين، وهمّ بالخروج من عندها، فتعلّقت بثوبه، وقالت: مهلاً مهلاً، فوقف[1518] حتى أتزود من نظري إليك، فهذ[1519] وداع لا تلاقي بعد[1520]. وجعلت تقبّل يديه ورجليه، وخرج من عندها، فحمل على عسكر بن زياد (لعنة الله)، فأقلب الميمنه على الميسره، وحمل فأقلب الميسره على الميمنه، ثُمّ عاد فوقف بايزا الخبا[1521]، فسمع سُكينه تبكي، فأنشا يقول[1522]:
|
خيرة الله من
الخلق أبي |
49ـ قال أبو مخنف لوط بن يحيى: ثُمّ حمل ثانيه على الميمنه، فأقبلها[1548] على الميسره، وحمل على الميسره فأقلبها على الميمنه، وقتل منهم نيف عن أربعون[1549] رجلاً، وشتت أبطالهم وأذهل رجالهم، فبقوا داهشين لا يدرون ما يصنعون. ثُمّ جعل يقول:
|
يا دهر أُفٍ لَكَ
من خليلِي |
ثُمّ قال: اللّهُم إن كان حرمتنا النطر[1551] من السما فاجعل ذلك خيرة لنا، وانتقم من هولا الأعدا الظالمين المرتدين الملحدين، ولا تبقى[1552] منهم أحداً، ولا تغفر لهم أبداً، ولا تجمع لهم شملاً؛ فإنّهم وعدونا لينصرونا فخذلونا، وكاتبونا فأسلمونا وقتلونا، وعاهدونا فنكثونا[1553].
ثُمّ إنّه
حمل عليهم يميناً وشمالاً، ومع ذلك يستغيث فلا يغاث، ويستجير فلا يجار. فقال عمر
بن سعد (لعنه الله): يا ويلكم! من أراد أن ينظر إلى حمالات[1554]
علي بن أبي طالب (رضى الله عنه) فلينظر إلى الحسين اليوم. ثُمّ حمل فأقلبهم على
آخرهم، وآخرهم على أولهم، وكشفهم عن المشروعه[1555]،
وكان عليها أربعة آلاف فارس كما تقدم ذكرهم (لعنهم الله تعالى وخزاهم وجعل جهنم
متقلبهم ومثواهم)، مع عمر بن الحجاج الزبيدي وأبو[1556] الأعور الأسلمي[1557] فأزاحهم عن المشرعه، وقحم[1558]
بفرسه إلى الما، فلمّا أحس الفرس ببرد الما ولع براسه ليشرب، فلم يطب قلب الحسين أن
ينغص[1559] عليه شربه، فقال: أنا عطشان وأنت
عطشان والله لا أذقت[1560] الماء حتى تروي. فلمّا رفع الفرس
راسه ومد الحسين× ليشرب فقال بعضهم لبعض: والله لين[1561]
ذاق بن علي من الما شربه أفناكم عن آخركم، ولم يبقي[1562] منكم أحداً لا صغير ولا كبير.
فبينما هو قد غرف براحته من الما وإذا بفارس يركض نحوه ونادا: يا أبى[1563]
عبدالله، الحق خيمة النسا فقد هُتِكت. فرما[1564] الما من يده ورجع وإذا هي سليمه
لم يعرض لها أحداً[1565]. ثُمّ أحالوا بينه وبين الما،
وأحاطوا به×، وجعلوا يبرزون إليه وهو يحمل عليهم، ويقول: اللّهُم اشهد على هذه
الفية الباغيه والأمة الطاغية. ثُمّ جعل يقول: يا قوم! هبوني مجرماً أو ذمياً أو
كافراً اسقوني شربة من الما؛ اشفي بها غليلي وأروي بها الواي[1566].
وهم يقولون الما محرم عليك مباح للكلاب أو تنزل على حكم الأمير عبيد الله بن زياد.
فبينما هو يخاطبهم ويجول فيهم إذ رماه أبو قدامه العامري (لعنه الله) بسهم في نحره
فجعل يستقبل الدم براحته ويضمخ[1567]
به وجهه ولحيته، وهو يقول: يا غياث من لا غياث له، هكذا أخبرني جدّي (صلى الله علي
[وآله] وسلم)، ثُمّ كبّر أبو قدامه (لعنه الله وخزاه).
ثُمّ إنّ الحسين انصرع إلى الأرض وهو يقول: والله لئن قتلتموني ليسلطنّ الله عليكم من بعدي رجل شديد[1568] غصنه، عظيم شانه، ظاهر سخطه، قوي بطشه، مبن[1569] باسه. والله ليبيدنّكم عن آخركم، وإنّه يستاصل شافتكم، ثُمّ لا يرضى حتى يلقى باسكم بينكم، وينتقم الله تعالى لي منكم.
كل ذلك وفرس مولاي الحسين× تحامي عنه ولا تدع أحداً يدنوا[1570] منه حتى قتل جماعة. فلمّا نظر الشمر (لعنة الله عليه) إلى الحسين× به حركة ضعيفه، قال لهم: يا ويلكم! ما نتظاركم[1571] به؟! اقتلوه. فأقبلوا إليه، وحمل شبت بن ربعي (لعنه الله) فطعنه طعنه سكّنت حركاته، ثُمّ دنا الفرس من الخيام يحمحم[1572]، ويصهل. فسمعت أُمّ كُلثُوم صهيل الفرس، ولم يكن ذلك صهيلاً، بل كان بكا وعويلاً، فقالت لسكينه افتحي أزر الخبا، فقد سمعتُ صهيل الفرس فخرجت من الخبا متخمره[1573] فنظر[1574] إلى الفرس عارياً والسرّج خالياً، فصاحت وا يتماه! ووحدتاه[1575]! وا سو[1576] منقلباه! وا ذلاه! وا ابتاه! وا سيداه! ذهب الجود والفخار ومضى الدين والإسلام. يا أبتاه! غلّقت لفقدك أبواب السما، وحجبت عن إجابة الدعا. وأماطت[1577] خمارها، وجعلت ترثيه تقول[1578]:
|
على الحسين يا
أسفي ويا لهفى |
فلمّا سمعت النسا كلامها وعويلها خرجن من الخبا وانتدبن بالعويل. ثُمّ إنّ زينب‘ أقبلت إليه، فألقت نفسها عليه، وجعلت تلثم نحره، وتمسح بكمها وجهه، وجعلت تقبله، وتخضب وجهها بدمه، وتمرّغ شعرها في نحره. وهو× به حركه ضعيفه، شاخص بنظره إلى السما ونحوها، لا يستطيع ردّ الجواب. وهي معانقته تناديه: يا أخي! خاب فيك الرجا، وهُتِكنا كما تُهتَك الإما، وأبرازنا[1580] بين الملا، كأنّا لسنا أولاد الأنبيا وسيد الأوصيا، وهو يعالج سكرات الموت. ثُمّ إنّ زينب[1581] جعلت ترثيه تقول:
|
مُصيبتي فوق أن
تُرثَى بأشعاري إذا تأمّلته
ميتاً ومفتقداً |
فلما سمع باقي الحريم شعرهن خرجن فنظرن إلى الفرس
عارياً فلطمن الخُدود
وشققن الجُيوب ونادين: يا محمداه! وعليّاه[1589]! وا حمزتاه! وحسيناه[1590]! وا سيداه! اليوم مات محمدا[1591]
(صلى الله عليه [وآله] وسلم)، اليوم فُقِد عليّ المرتضى، اليوم فُقِد حمزة سيد
الشهدا وفاطمة الزهرا[1592].
ثُمّ إنّ سكنيه[1593] (رضي الله عنها) أنشات تقول:
|
لقد حطّمتنا
في الزّمان نوايبُهُ |
قال عبدالله بن زايد[1600]: رأيتُ الجواد وقد تفرّق الناس عنه، وهو راجع من الخيام، ولم يقدر عليه أحد، وقصد الفراه[1601]، ووثب وثبه فإذا هو في وسطها، ثُمّ غاص فلم يُعرَف له خبر إلى وقتنا هذا. وذُكِر أنّه يظهر عليه القايم من آل محمد[1602].
50ـ قال أبو مخنف: عن أبي عبدالله بن قيس، قال: سمعتُ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه) يوم صفّين، وقد أخذ الأعور السّلمي[1603] المآ عن الناس فلم يقدر على جرعة منه، فبعث الحسين في خمس مايه[1604] فارس، وكشف الناس عن الما. قال: فلمّا راني أمير المؤمنين قال: معاشر الناس، والله إنّ ولدي هذا يُقتَل ببطن كربلا عطشاناً، وتنفر فرسه ويصهل ويقول في صهيله: الظّليمه الظّليمه! يا اُمّة قتلت ابن بنت نبيّها! وهم يقراون القرآن الذي أُنزِل على محمد (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، ثُمّ أنشأ يقول[1605]... شعر
|
وكلّ ذي نفسٍ
وغير ذي نفسٍ |
51ـ قال أبو مخنف: ولما ارتفع ضجيج الحسين[1607]، صاح عمر بن سعد (لعنه الله): اكبسُوا[1608] عليهم الخيام، واضرموهم ناراً؛ فلا حاجة لنا في السلب[1609]. فقال له رجل كان يحبّ محمد[1610] (صلى الله عليه [وآله] وسلم): أيّها الأمير ما كفاك ما صنعتَ بابن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) حتى تحرق حريماً وأطفالاً؟ والله لقد عزمتَ أن يخسف بنا الأرض. فقال لهم: انهبوا الخيام وما فيها[1611].
قالت زينب ابنت[1612] علي بن أبي طالب (رضي الله عنها) قالت[1613]: كنتُ قايمه في جانب الخيمه إذ دخل أرزقٌ[1614] فأخذ جميع ما كان في الخيمه. ونظر إلى عليّ بن الحسين، وهو مطروح على نَطع[1615] من الأديم، وكان مريضاً وكان مريضاً[1616]، فجذب النّطع من تحته، و رماهُ إلى الأرض. والتفت إلىَّ فأخذ القناع من راسي، ونظر إلى قرطين كانا في اُذُنيّ، فجعل يعالجُهُما حتى نزعهُما، وهو مع ذلك يبكي. فقلتُ: لعنك اللهَ أنت تبكي وتسلُبُني؟ فقال لها: نعم أبكي لما يجرى عليكم. فقلتُ له: قطع الله يديك ورجليك وأحرقك بنار الدّنيا قبل الأخرة[1617].
52ـ قال أبو مخنف لوط بن يحيى: والله ما مضت إلّا أيّام قلايل حتى ظهر المختار بأرض الكوفه مطالباً بدم الحسين فوقع في يده خولي (لعنه الله) ـ وهو ذلك الرجل ـ فقال له: ما صنعتَ يوم كربلا؟ قال: أخذتُ من تحت رأس علي بن الحسين نَطعاً كان نايماً عليه، وسلبتُ زاينب[1618] قناعها وقُرطين كانا في أذنيها. قال: فما سمعتَها تقول عند ذلك؟ قال: سمعتُها تقول قطع الله يديك ورجليك وأحرقك بنار الدنيا قبل الآخره. قال المختار: والله لا جاوزتُ بك دعوتها، ثُمّ إنّه قطع يديه ورجليه وأحرقه بالنار. وسوف يأتي حديثه في أخذ الثار على المختار[1619].
53ـ قال أبو مخنف: وأقبلوا إلى علي بن الحسين ليقتلوه، فقال بعضهم لبعض: هذا صبيّ لم يبلغ الحلم ولا يحلّ لكم قتله[1620]، فاختلفوا في ذلك فجعل بعضهم يمنع بعض[1621] قتله[1622].
قال: فلمّا نظرت اُمُّ كُلثُوم إلى ذلك بكت بكا شديداً وجعلت تقول[1623]:
|
أضحكني الدّهر
وأبكاني |
قال: ثُمّ إنّ عمر بن سعد (لعنه الله) أمر بأن يطأ جثه الحسين× ففعلوا ذلك[1635].
قال الطرماخ[1636] بن عدي: كنتُ في قتلا[1637] كربلا، وقد وقع فيّ ضربتان وطعنتان، ولو حلفتُ حلفتُ صادقاً أنّني ما كنتُ نايماً، إذ رايتُ عشرين فارساً قد أقبلوا وعليهم ثيابٌ بيضٌ، يفوح منها رايحه المسك الأذفر[1638]، فقلتُ في نفسي: هذا عبيد الله بن زياد (لعنه الله تعالى عليه) قد أقبل يطلب جسد الحسين× وكنتُ قريباً منه، وإذا هو أومى بيده نحو الكوفه وإذا بالرأس قدأقبلت فركبّها على الجسد فعاد كما كان بأذن الله تعالى فإذا هو رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم). ثُمّ قال: يا ولدي قتلوك كأنّهم ما عرفوك؟ ومن شرب الما منعوك. والتفت إلى الذين كانوا معه، قال: يا أبي آدم، ويا أبي إبرهيم[1639]، يا أخي عيسى، ألا ترون ما صنعت أمتي بزيتي[1640] بعدي؟! لا أنالهم الله شفاعتي، ثُمّ استيقظتُ بما كنتُ أرى[1641].
54ـ قال الراوي[1642]: ثُمّ ساروا بالسّبايا ومعهم زين العابدين، وقد حملوهم على أقتااب[1643] المطايا من غير وطا، وخلفوا القتلا[1644] بأرض كربلا، وقد تولّى دفنهم أهل القرى.
55ـ وقد رُوِي عن جديله الأسدي[1645] عن ثقات أهل العلم مَن راى وتحقّق، قال: كنتُ بالكوفة مقيماً بها سنة إحدى وستين، عند مصرف[1646] علي بن الحسين× من أرض كربلا، فرايتُ نسا أهل الكوفه مشقّقات الجُيوب، يلطمن الخُدود، ويخمشن الوجوه. قال: فأقبلتُ على شيخ منهم، وقلت له: يا شيخ ما هذا البكاء والنحيب؟ فقال: هذا من أجل راس الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، وهو الآن عن قريب يُدخَل بها علينا، فقلتُ له: ومَن قتله؟ قال عبيد الله بن زياد (لعنه الله): فعل به هذا الفعال. قال: فنظرتُ إلى جاريه جسيمه على بعير بغير وطا، فسالتُ عنها فقيل لي: هذه اُمُّ كُلثُوم أخت الحسين×، فأقبلتُ نحوها، وأنا أحثوا[1647] التراب على راسي، حتى صرتُ تحت المحمل الذي هي عليه، ثُمّ ناديتُها: يا اُمُّ كُلثُوم بحقّ جدّك رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) إلّا أخبرتيني بالذي نالكم. قالت: ومن أين يكون الرجل؟ قلتُ: من البصرة وأنا ، والله ـ من شيعتِكم. فقالت: يا أخا ربيعة أنا ـ والله ـ أحدِّثك خبراً يقيناً كأنّك حاضر، كاتبونا لينصرونا فخذلونا وقاتلونا، وعاهدونا فنكثونا وغدروا بنا فأسلمونا. فبينما نحن كذلك في الخبا إذ سمعتُ صهيل الفرس، فاطلعتُ لأنظر إلى أخي فرايتُ الفرس عاري والسرج خالي[1648]، وصرختُ وصرختِ النسوان، فسمعتُ هاتفاً أسمع صوتَهُ، ولا أرى شخصهُ، وهو يقول:
|
والله ما
جيتُكُم حتّى نظرتُ إلى وكلُّ أمرٍ من
الرحمن مقدور الله يعلم أنّي لم أقُل زور[1655] مثلُ
المصابيحِ يغشون الدّجا[1656] نور[1657] |
قالت اُمّ كُلثُوم: سالتُك ـ أيّها الهاتف ـ بالله العظيم مَن أنت؟ فقال: أنا ملكٌ من ملوك الجنّ، جيتُ لأنصرهُ فصادفتُه قد قُتِل فوا أسفا![1664] إذا لم أكن له عضداً ولأصحابه سنداً، فعلى مَن فعل به لعنة الله. وحُمِل راس أخي كما[1665] على هذه القناه، يُطاف به البلاد، ويُشهَرون[1666] بين العباد، وسُلِبنا نحن، وحُمِلنا على الأقتاب بغير وطا. فهذه قصتنا وقضيتنا، وهذا حديثنا.
قال مسلم الجصاص[1667]: فلم أزل معهم إلى أن دخلوا الكوفه، وأقبلوا إلى موضع يقال له الكناس[1668]، فازدحم فيه، وطلع رأس الحسين على الناس، فتصارخوا[1669] النسوان والصبيان[1670].
فقالت لهم اُمُّ كُلثُوم: يا أهل الكوفه قتلتنا رجالُكُم وتبكينا نساوكم! بيننا وبينكم الله غداً إذا برزوا لفصل القضا. ما لكم؟! لا أجمع الله لكم شملاً.
ثُمّ إنّها نظرت يميناً وشمالاً، فنظرت إلى الصبيان، وهم يأخذون اللطف[1671] والأطعمه من أيدي الناس مثل خمس تمرات وخمس جوزات ورغيف، فجعلت تأخذ ذلك من أيدي الاطفا[1672] ومن أفواههم وترمي بهم[1673]. فضجّ الناس بالبكا والنحيب، وقالت: خرج وأمانة في رقبته حر وعبد وكبير وصغير، واصلنا بشي من دنياه فأنّنا أهل بيتٍ لا تحلّ لنا الصدقه، وهي تبكي. ثُمّ عرجوا إلى بني خزيمه والصيارف[1674].
56ـ قال الشعبي بن يحيى بن يعمر[1675] (رضي الله عنه): وصُلِب الراس هناك، فوالله لقد سمعتُه، وقد تنحنح واستعاذ، ثُمّ ابتدا بسورة الكهف، وأنا واقف أسمع إلى أن بلغ إلى قوله تعالى (إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى)[1676] ولم أستطيع[1677] أقف أسمع قراته فسقطتُ إلى الأرض مغشياً عليَّ، حُمِلتُ من هناك إلى منزلي، ولا أدري أين أنا من الأرض ممّا لحقني[1678].
57ـ وقد حدّثني مَن أثق به أنّه ما قع[1679] إلى آخر السوره[1680] ورواه حبيب النيسابوري.
قال[1681]: كنتُ في الكوفه وقد غُلِّقت أبوابها
وأسواقها جميعاً، والعسكر
مقبلاً[1682] إليها، فسالتُ شيخ[1683] ما الخبر؟! فأخذ بيدي وعدل بي عن
الجادة، وتزاور[1684]
عن الطّريق، وتزايد بكاوه، وعلى[1685]
نحيبه، وقال لي: عسكرين[1686] انهزم أحدهم[1687]،
وظفر الآخر. والذي انهزم كان الظافر، والظافر كان الخاسر لو يعقلون. فقلتُ: مَن
الذي انهزم والذي غنم؟ فقال لي: عسكر الحسين الشهيد انهزم في الظاهر، وهو في
الباطن ظافر بما عند الله. وعسكر عبيد الله بن زياد (لعنه الله) كان غانماً، وهو
الخاسر في الباطن والظاهر. ثُمّ بكا[1688].
فبينما نحن كذلك وإذا بالرأس قد طلع فلاحت لي شواربه والنور يتشعشع منها كالمصباح،
فخنقتني العبره، وسبقتني الدمعه، فوقعتُ مغشى[1689] عليَّ، فجعلوا ينضحون على وجهي. وأقبلت السّبايا على الأقتاب بغير وطا. واُمُّ
كُلثُوم في أوايلهم وعلى وجهها برقع خز أدكن، وهي تُنادي: يا أهل الكوفه، نحن
سّبايا رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، غُضُّوا أبصاركم عنّا، أما تستحُون
منه وأنتم تظمحون[1690] إلينا بأبصاركم، وتنظرون إلى حرمة
أولاد فاطمه الزهرا، ونسل خاتم الأوصيا[1691]؟! قال: فغضّوا[1692] الناس أبصارهم عنهم[1693]. وأدخلوهم على عدو الله بن زياد
(لعنه الله)، وليس فيهم ذكرٌ إلاّ عليّ الأصغر بن الحسين، وله من العمر ستة سنين[1694]
وكان مريضاً، فلمّا نظرهم عبيد الله بن زياد (لعنه الله) فقال: مَن هذا؟ فقالوا
له: علي بن الحسين. قال: يا ويلكم! وليس قد قتل الله علياً، وقطع نسله، وأباد من
الأرض أهله؟ فقالوا له: هذا ولد الحسين الأصغر. فعند ذلك التفت إليه (صلوات الله
عليه)، وقال: يا ويلك! يا بن زياد، إنّ الله خلق الخلق، وكتب عليهم الفنا، وأجرى
فيهم القضا، فما جرى كان سابقاً في علم الله، وأنّكم تخالفون أوامره فينا فيُصلِكم
جهنّم وسات مصيراً، فسوف تقف ويقفون، وتُسال عمّا أجرمتَ فينتصفون، فاعتدّ[1695] ـ يا ويلك! ـ جواباً لرسول الله
عند يوم فصل القضا؛ فإنّه خصيمك، وأنت مأخوذ بإثمك...[1696]. بسم الله الرحمن الرحيم (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ
الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ
زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ)[1697]. فشاط[1698] بن زياد غضباً، وقال: ما أسرع
جوابه وأجرى خطابه! اضربوا عنقه فتعلّقت به زينب عمتُّه، وقالت: حسبك يا بن زياد، وكفاك
ما قد صنعتَ، وأن تلقا[1699] الله ورسوله بدم قد سفكتَه، ومحرّم
قد هتكتَه، وشنيع ارتكبتَه حتى تضيف إليهم دمَ هذا الطفل. والله لا فارقتُه أو أُقتَل
معه. لا تفجعنا به. فقال: لا بدّ لي من قتله، فقالت: وأنا معه. فلمّا نظر بن زياد
(لعنه الله) شده تفجّعهما[1700] عليه، قال: والله لقد أردتُ أن أقتله
وأقتلها معه، ولكنّها نظرت إلى قِبل السما، ودعت إلى الله دعوه، فأجابها، فصدعت
بها قلبي، وأفلقت فوادي[1701]
فتركتُه.
قال: ثُمّ عدل إلى النسوان فقال: أيّكُم الخارجي؟ يعني اُم كُلثُوم فلم تجبه فناداها ثانيه فنادها[1702]: بحقّ جدّك إلّا كلّمتيني[1703] فقالت له: يا ويلك! هانا[1704] بين يديك، فما الذي تريد مني؟ قال لها: كيف قد رايتي[1705] تصديق وعدنا فيكم وخيبة ظنونكم فينا؟ فقالت له: يا ويلك! يا بن زياد عميت بصيرتُك وخسرتَ أخرتك، بل خيّبكم الله فينا وعاقبكم بما أسديتم إلينا. فقال لها: كذبتي[1706]. فقالت له: يا بن زياد! يكذب الفاجر الغادر الفاسق الكافر المنافق لله} ولرسوله. وأنت أولى بالفسوق والنفاق الكذوب، والشقاق والجراه على الله لمخالفته. فأبشر ـ يا ويلك ـ بالنّار، وهتك الأستار، وركوب العار، وغضب الجبار. فقال: حتى ما أصبر إلى ذلك؟! فقد أشفيتُ علتي، وبردد[1707] حرارتي، وأدركتُ فيكم أمنيتي قبل منيّتي. فقالت له: يا ويلك! بابن[1708] مرجانه الحجّامه، صيّرك يزيد من أهل الرياسه وذي الأقدار والنفاسه. والله لقد رويتم من دما أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، ولسوف يرويكم الحميم ويصليكم نار الجحيم. لقد عدتم إلى عبادة الأوثان وانعكافكم على الطغيان، ولقد استحوذ عليكم ضلال الشيطان حتى رفضتم القرآن وجهلتم البيان. فقال لها: أبيتِ إلّا السجاعه في كلامك وسرعة جوابك. لعمري إنّك من نسل أبي تراب.
58ـ قال مخنف[1709]: وكانت زينب لما دخلت على عبيد الله بن زياد (لعنه الله) انحازت[1710] مع إمايها، فنادها[1711] فلم تجبه، فسال عنها بعض امايها، فقالوا: هذه زينب أخت الحسين بنت فاطمة الزهرا. فأقبل عليها بن زياد (لعنه الله)، وقال: الحمد لله الذي أسلمكم وفضحكم، ومكّنني منكم، وأكذب أحدوثتكم. فقالت له زينب: يا ويلك! الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد نبيّه (صلى الله عليه [وآله] وسلم) وجعلنا من نسله وخص جدّنا بالرساله والاصطفا، وأعطاه الوسيله والزلفى، وأحياه بالدلالة العظمى، وحباه بالموالاة، ثم فضلنا بوالدنا على الاوصيا كفضل جدّنا على الانبيا، وجعل نورنا ظاهر[1712] كالقبس[1713]، وطهّرنا من الرجس والدنس تطهيراً. من أظهر قريش أرومه[1714]، وأكثر أكرومه[1715]. إنّما يُفتضَح الكاذب الفاسق ويكذب الفاجر، وهو غيُرنا، الذي خان وكفر، وارتدّ عن دينه وفجر، وآذى محمد[1716] خيرَ البشر، وكذّب بالآيات والسور، ولقد خيّبكم الله فينا كخيبة عاد وثمود. فقال بن زياد (لعنه الله): كيف رايتي فعلَ الله فيكم أهل البيت؟ فقالت: كتب الله عليهم القتل ثُمّ رُدّوا إلى الله مولاهم الحق في أكرم مقام، ويجمع الله بينك وبينهم في موقف العدل والانصاف فيخاصمونك عند الله، ويحاكمونك عند رسوله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فما عندك يا بن زياد؟! فاستشاط غيضاً وغضباً، وجعل يفور، وأطرقت هي رأسها إلى الأرض فتحادرت دموعها على خدها[1717] وأنشأت تقول[1718]:
|
ماذا تقُولُون
إذا قال النبيّ لكم |
قال: فلمّا فرغت من شعرها قال لها: لولا أنّكِ امرأة لضربتُ عنقكِ.
قال سهل: وجعلوا يعرضون عليه النسا وينظرَنَّ[1722] إليهن يميناً وشمالاً والراوس[1723] مع الخيّاله على الرّماح. وكانت زينب حاسرت[1724] الراس، مهتوكة الشعر[1725] وقالت له: يا بن زيا[1726] استعد للجواب غداً إذا كان القاضي هو الله، والسّجن جهنّم، والخصم جدّي رسول الله. قال: فغار زين العابدين على عمتّه وقال: يا بن زياد كم وإلى كم[1727] عمّتي وتُعرّفها بما لا تعرفها؟ فاستحيا ابن زياد (لعنه الله) من كلامه، والتفت الى بعض حجّابه، وقال: اضرب عُنُقه، فجذبه الحاجبُ إليه فلزمته زينب وغصبوها عليه، فصاحت: وثكلاهُ مرّة بعد مرّه. فلمّا سمع صراخها أمر بتخليته. ثُمّ دعوى[1728] خولي (لعنه الله) وقال: خُذ هذا الراس إليك إلى أن أطلبه منك. فقال له: سمعاً وطاعه. وأخذ الرأس وانطلق به. وكان له امرأتان أحدهما تغلبيه والأخرى نظريه[1729] فأتا[1730] بالراس منزل التغلبيه، فقالت له: ما هذا؟ فقال لها: هذا رأس الحسين علي[1731]، وفيه ملك الدنيا. قالت له: أبشر ـ يا ويلك ـ فإنّ خصمك محمداً[1732] (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، ثُمّ قالت له: والله ما عدتَ لي ببعلٍ ولا أنا لك بأهل. وأخذت عموداً، ثُمّ أوجعت به دماغه، وانصرفت من عنده إلى أهلها، وأتى إلى زوجته الثانيه، فقالت له: ما هذا؟ قال لها: راس خارجي خرج علينا بأرض كربلا، فقتله بن زياد. فقالت له: ما اسمه؟ فأبا[1733] أن يعلمها باسمه وتركها[1734] عندها تحت طشت، وبات عندها، فقالت امراته: سمعتُ قراة هذه[1735] الراس الى طلوع الفجر وكان آخر ما قرى (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)[1736] قالت: وسمعت حول الرأس ديا[1737] كدويّ النحل فعلمتُه أنّه تسبيح الملايكة[1738].
[مقتل عبد الله بن عفيف الأزدي]
قال سهل[1739]: فلمّا أصبح بن زياد (لعنه الله تعالى) جمع الناس إلى الجامع ثُمّ رقا[1740] إلى المنبر، وجعل يسبُّ علياً والحسن والحسين (عليهما[1741] السلام)، فقال له من واسط[1742] يقال له عبد الله بن عفيف الازدي[1743] وكان شيخاً كبيراً قد انكفّ[1744] بصره وكان له صحبه مع رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، فقال له (رضي الله عنه): رضّ[1745] الله فاك، وأجهد بلاك[1746]، وقطع يديك جليك[1747]. يا ويلك! ألم يكفك أنّك قتلتَ ولد رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) وأهل بيته حتى صدعتَ[1748] المنبر تسبّ عليّاً وولديه؟! ولقد سمعتُ رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) يقول: مَن سبّ علياًّ فقد سبّني، ومَن سبّني فقد سبّ الله، ومَن سبّ الله كبّه الله على منخريه في النّار[1749].
قال: فأمر زياد[1750] (لعنه الله) بضرب عُنُقه فمنعوه[1751] عنه قومه من الأزد، وحملُوه على أتانة[1752] له إلى منزله. فلمّا عسعس[1753] الليل بظلامه ادعى[1754] بن زياد بخولي (لعنهما الله جميعاً) وضمّ إليه خمسماية فارس، وقال له: انطلق الى منزل عبد الله بن عفيف واتني براسه، وإن أمكنك أسره فافعل. فسار حتى أتى منزل عبد الله وكان له بنت صغيره، فلمّا أحسّت بالقوم قالت له: هجمت عليك يابة[1755] القوم، فقال لها: يا بنيه ناوليني السيف وانتي[1756] من وراي وقولي ميمنه وميسره، ثُمّ وقف لهم في مضيقٍ[1757] وجعل يضرب يميناً وشمالاً حتى قتل منهم ثلاثه وعشرين رجلاً[1758]وهو يقول: يا ويلكم! والله لو كُشِف عن بصري لأفنيتُكم عن آخركم[1759]. ثُمّ انّهم تكاثروا عليه فأخذوه أسيراً وجاوا به إلى عبيد الله بن زياد (لعنه الله) فلمّا نظر إليه قال له: الحمد لله الذي أعماك يا شيخ. فقال له عفيف[1760]: الحمد لله الذي أعما[1761] قلبك وفتح عينيك. فقال له بن زياد (لعنه الله تعالى): قتلني الله إن[1762] أقتلك أشر قتله. فقال له عفيف[1763]: والله لقد سالتُ الله أن يرزُقني الشّهاده على يد أشرّ خلقه، وما علمتُ على وجه الأرض عاقاً لله ولرسوله أشرّ منك. ثُمّ بكا[1764] وأنشد يقول:
|
صحرتُ[1765] وودّعت الصّبا[1766] والغَوانيا[1767] |
قال: فقطع عليه بن زياد (لعنه الله) شعره عليه[1783]، وأمر بضرب عنقه فضُرِب (رحمة الله عليه ورضى عنه)[1784] .
ثُمّ ادعى[1785] براس الحسين فسلّمه إلى عُمر بن الحارث[1786] المخزومي[1787] (لعنه الله) وأمره أن يقوّر[1788] الراس، ويخرج دماغه وأوداجه وما حول الدماغ من اللّحم ففعل ذلك. وأمر أن يحسا[1789] مسكاً وكافوراً وصبراً[1790] ففعل ذلك[1791].
ثُمّ ادعا بشمر (لعنه الله) وخولي (لعنه الله) وضمّ إليهم[1792] خمسماية فارس[1793] وزوّدهم، وألطف في أرزاقهم، وأمرهم بالمسير بالحريم والروس[1794] إلى دمشق، وأن يشهرونه[1795] في كلّ بلدٍ يدخلونها[1796].
قال سهل: فلمّا رأيتُ ذلك أجمعتُ على المسير معهم، وأخذتُ ألف دينار وألف درهم، فساروا وأنا معهم، حتى قدموا القادسيه، فنزلوا بها، فأنشات اُمُّ كُلثُوم تقول شعر:
|
مالت[1797] رجالي وأفنى الدّهر ساداتي |
[حديث اُمّ سلمة وغيرها في قتل الإمام الحسين×]
59 ـ قالت اُمّ سلمة[1801] (رضى الله عنها): كان عندي رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) وهو مستلقٍ على قفاه، والحسين على بطنه في يد رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) شيء ينظر إليه وهو يبكي. فقلتُ له: يا رسول الله مالي أراك باكياً حزيناً؟ فقال لها: يا اُمّ سلمه هذه تُربةٌ أتاني بها جبريل× من أرض يقال[1802]: كربلا، فاجعليها في قارورة فإذا رايتيها صارت دماً عبيطاً، فاعلمي أنّ الحسين قد قُتِل.
قالت اُمّ سلمه: فأخذتُها من يده ثُمّ جعلتُها في قارورة، فلمّا كان في اليوم الذي قُتِل فيه الحسين، فنظرتُ إلى القاروره فإذا بها قد صارت دماً عبيطاً. قالت: فلمّا رأيتُ ذلك علمتُ أنّ الإمام قد قُتِل فلمّا نمتُ تلك الليله وأخذتُ مضجعي رأيتُ رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، وقد علاه تراب وغبار على راسه ولحيته الشريفه، فقلتُ له: جعلتُ فداك يرسول الله[1803] ما هذا التراب الذي على راسك والغبار الذي على لحيتك؟ فقال: يا اُمّ سلمه الآن رجعتُ من دفني الحسين ولدي. قالت اُمّ سلمه: فانتبهتُ فزعه مرعُوبه[1804] وسمعتُ ضجة عظيمه في المدينه، فقلتُ فقلت[1805] لجارتي[1806]: اخرجي واُنظري ما هذه الهدّه[1807] والضجه فخرجت الجاريه، وجعلت الجاريه تحول[1808] في طرقات المدينه اذ سمعت جنيّه تقول:
|
ألا عينُ
جُودي فوق خدّي |
قال: فأجابتها جنيّة أُخرى:
|
مسح الرّسول
جبينهُ وله[1810] |
قالت: فرجعت الجاريه فأعلمت اُمَّ سلمة بذلك فوضعت يدها[1815] اُمُّ سلمة يدها على رأسها، وصاحت وحسيناه[1816]، وكانت قد ربّت فاطمة‘[1817]، قال: فجعل الناس يهرعون إليها ويقولون لها: يا اُمّ سلمة، ما الخبر؟ قالت: قتل ـ والله ـ ولدي الحسين. قالوا: وكيف علمتي بذلك؟ قالت: هذه تُربةٌ دفعها إليَّ رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) من أرض كربلا أتى بها إليه جبريل، وقال: إذا صارت هذه دماً عبيطاً فيكون الحسين قد قُتِل. وأمرني رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) أن أضعها في قاروره، وقد وضعتُها. وها هي قد صارت دماً عبيطاً، والله ما كذبني رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ولا كذبه الوحي. قالوا: أراينا إياها، فلما عاينوا ذلك شقّوا جيوبهم وحثو[1818] التراب على راوسهم[1819] وسعوا إلى قبر النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم) يُعزّونه في الحسين[1820].
60ـ وعن أسما بنت عميس[1821] قالت: دخل الحسين على النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فجعله في حجره وبكى (صلى الله عليه [وآله] وسلم) «فقلتُ: فداك أبي وامي ممّا بكاك؟ فقال: بُنِي هذا ـ يا أسما ـ يقتله الفيه[1822] الباغيه من أمتي لا أنالهم الله شفاعتي. لا تخبري فاطمة فإنّها قريبة عهد بولاده[1823]. أخرجه المحب الطبري[1824].
61ـ وعن اُمّ سلمه (رضي الله عنها) قالت: كان النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم) في بيتي فجا حسين (رضي الله عنه) يدرج فقعدتُ على الباب فأمسكتُه مخافة أن يدخل فيوقظه. ثُمّ غفلتُ في شيء فدبّ فدخل فقعد على بطنه. قالت: فسمعتُ نحيبه فجيتُ فقلتُ: يا رسول الله، والله ما علمتُ به. فقال: إنّما جاني جبريل، وهو على بطني قاعد، فقال لي: أتحبه؟ فقلتُ: نعم. قال: إنّ أمّتك ستقتله. ألا أريك التربة التي يُقتَل بها؟ قال: بلى[1825]. قال: فضرب بجناحه وأتاني بهذه التربه. قالت: وإذا في يده تربه حمرا وهو يبكي، ويقول: يا ليت شعري من يقتلك بعدي؟[1826].
62ـ وفي حديث آخر عن اُمّ سلمه، وقال[1827] فيه: فقال (صلى الله عليه [وآله] وسلم): إنّ جبريل كان عندي آنفاً، فقال: إنّ أمّتك ستقتله بعدك بأرض يقال لها كربلا. أتريد أن أريك تربته يا محمد؟ قلتُ: نعم. فتناول جبريل من ترابها فراه[1828] النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ودفعه إليه. قالت اُمّ سلمة: فأخذتُه فجعلتُه في قاروره، فأتيتُه يوم قُتِل الحسين وقد صار دماً[1829].
63ـ وفي روايه ثُمّ قال: ـ يعني جبريل ـ ألا أريك تربةَ مقتله، فجا بحُصَيّات فجعلهنّ رسول[1830] (صلى الله عليه [وآله] وسلم) في قاروره، فلمّا كان ليله قتل الحسين سمعتُ قائلاً يقول:
|
أيّها القاتلون
جهلاً جهلاً[1831] حسيناً |
قالت: فبكيتُ وفتحتُ القارورة فإذا الحُصَيّات قد جرت دماً[1833].
64ـ وعن بن عباس (رضي الله عنهما) قال: رايتُ رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فيما يرى النايم نصف النهار وهو قايم أشعث أغبر، بيده قاروره فيها دم واهو[1834]، وهو يلتقطه أو يتتبع فيه شياً، فقلتُ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما هذا؟ قال: دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعه منذ اليوم، فنظروا فوجدوه قد قُتِل في ذلك اليوم. رواه الإمام أحمد وعبد بن حميد[1835].
[رجع الحديث عن مسير السبايا إلى الشام]
قال سهل[1836]: وساروا بالراس والذي معه وعبروا على تركيت[1837] وكتبوا إلى صاحبها يلقاهم؛ فإنّ معهم راس الحسين بن علي×. فلمّا قرا صاحبها تلقّاهم الكتاب[1838]، أمر بالأعلام فنُشِرت وزُيِّنت المدينه، وتداعوا[1839] الناس من كلّ مكانٍ. وخرج وتلقّاهم،وكان كلّ مَن سالهم عن الراس، قالوا: راس خارجيّ، خرج علينا[1840] بأرض العراق، فقتله بن زياد (لعنه الله تعالى). وقد أرسل بالراس إلى يزيد بن معاويه (لعنه الله تعالى) فقال رجل[1841] منهم: يا قوم إنّي كنتُ بالكوفه، وقد ورد هذا الراس، وما هي[1842] راس خارجي، بل هي راس الحسين بن[1843] فلمّا سمعت النصارى ذلك عمدوا إلى النّواقيس[1844] فأخذوها، وأعلموا الرهبان وأغلقوا البِيَع[1845] إعظاماً له. وقالوا: اللّهم إنّا نبرأ إليك من قوم قتلوا ابن نبيّهم، ثُمّ إنّهم رحلوا من تركيت وأخذوا على دَيرِ عُروه[1846]، ثُمّ على صليبا[1847] ثُمّ على وادي النّخله[1848] فنزلوا ليلاً فسمعوا بكا الجنّ على الحسين وهنّ يلطمن خدودهن ولولون[1849] ويقُلن هذه الأبيات[1850]:
|
يا نسا الحسين
أسعد |
قال: ثُمّ رحلوا من وادي النّخله وساروا حتى وصلوا إلى مدينة يقال لها: برش باد[1855] ـ وكانت مدينه كثيره الناس ـ فخرجت المخدرات من خدورهن، والمشايخ والشباب ينظرون إلى راس الإمام، ويصلّون عليه وعلى أهل بيته، ويلعنون من قتلهم وظلمهم. فلمّا سمعوا ذلك نفدوا[1856] إلى المدينه فنهبوها وأخربوها، ورحلوا من وادي لينا[1857] وساروا حتى وصلوا إلى جُهَينَه[1858]، وأنفدوا[1859] إلى عامل الموصل[1860] أن تلقّانا فإنّ معنا رأس الحسين بن علي. قال: وكان عليها أميراً[1861] يقال[1862] خالد بن النشيط[1863]، فأمر بالأعلام فَنُشرت وزُيّنت المدينه وتداعا[1864] الناس من كلّ مكانٍ فلتقّاهم على حدّ ستّة أميال[1865]، فقال بعض الناس: ما الخبر؟ فقالوا: راس خارجيّ خرج علينا من أرض العراق بأرض كربلا، فقتله عبيد الله بن زياد (لعنه الله). فقال رجل منهم: يا قوم قد انتهى إلىّ خبر هذه الراس، وليس هو بخارجي، بل هو راس الإمام الحسين. قال: فلمّا سمعوا ذلك تدعوا[1866] وأجمعوا في أربعة آلاف[1867] فارس من الأوس والخزرج[1868]، وقالوا: هذه راس بن حبيبنا، وابن بنت نبينا محمداً[1869] (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، ثُمّ إنّهم تحالفوا أن يقتلوا أميرهم خالد بن النشيط وخولي بن يزيد وشمر بن ذي الجوشن (لعنة الله عليهم اجمعين)، ومن معهم من الجنود وياخذون[1870] الراس يدفُنُوه عندهم ليكون لهم ذكراً وفخراً إلى يوم الدّين ثُمّ تدعوا بأبنائهم وأنفسهم وآبايهم[1871].
65ـ قال أبو
مخنف: حدّثني من شهد ذلك اليوم بالموصل، ثُمّ إنّه خرج
منها بنيف عن ثلاثون[1872]
ألف فارس قال: فلمّا بلغهم ذلك لم يدخُلُونها[1873]
ولم يشهروا الراس فيها، وأخذوا على تلّ أعفر[1874] وساروا حتى وصلوا
نَصيبَينِ[1875] فنزلوا بها، وأشهروا الرّاس فيها،
والحريم والسّبايا معهم، فلمّا نظرت زينب إلى ذلك بكت بكا شديداً، وأنشأت تقول:
|
أنُشهَر ما
بين البرية عنوةً[1876] |
ورحلوا من نَصيبَينِ[1881] وساروا حتى وصلوا حلب[1882]، فكتبوا إلى صاحبها أن تلقّانا فإنّ معنا راس الحسين بن علي. قال: فلمّا قرا الكتاب أمر بالأعلام فنُشِرت، وخرج فاستقبلهم بضرب البُوقات والطبول. فأشهروا الراس على الرمح، وأدخلوه من باب الأربعين[1883]، وخرجوا به إلى رُحبة الراحين[1884]، ونصبوا الرّمح من وقت الزوال إلى العصر، وكان مع ذلك أهل الدين والعقل يبكون ويصلّون عليه وعلى أهل بيته، والجهله والملاعين يقولون: هذه راس الخارجي، الذي خرج بأرض العراق على يزيد بن معاويه (لعنه الله تعالى)[1885].
66ـ قال أبو مخنف: وذلك أنّ الرُّحبه الذي[1886] نُصِب فيها الحسين[1887] لم يجز فيها أحدٌ وتُقضى له حاجه إلى هذا الوقت[1888] فباتُوا في حلب ثَمِلينَ[1889] من الخمر وارتحلوا من الغد، فعند ذلك بكى زينُ العابدين وأنشأ يقول:
|
ليت شعري هل
عاقلٌ في الدّياجي[1890] |
67ـ قال الراوي: وساروا حتى أتوا قسرين[1893] وكانت مدينه كثيرة الخير، فلمّا بلغوا ذلك غلقُوا أبواب المدينه وعلوا على الصور[1894]، وجعلوا يسبّونهم ويلعنُونهم، ويقولون: ذرية نبيّهم! والله لا دخلتم مدينتنا ولو قُتِلنا عن آخرنا، فلمّا نظروا إلى ذلك رحلوا[1895].
ثُمّ إنّ اُمَّ كُلثُوم أنشأت تقول:
|
كم تنصبون لنا
الأقتاب عاريه إلّا غدا باكياً أخاً على البلد[1900] |
قال: ثُمّ إنّهم أتوا مع مرّه بن النّعمان[1901] ففتحوا لهم به الأبواب، وسلّموا إليهم الذبايح والأطعمة، فأقاموا يومهم يأكلون ويشربون. وارتحلوا منها فنزلوا سيبور[1902]، فقالوا[1903]: يا قوم هذه راس الحسين بن علي، قتلته هذه الظلمه البغاه[1904]، والله ما يجوز في مدينتنا. ثُمّ قطعوا القنطره، وأخذوا العده، فلمّا عاينوا ذلك منهم لم يدخلوها، وكتبوا إلى يزيد (لعنه الله) وأعلموه بذلك، فأمروا[1905] بالقبض على الناظر[1906] بها، وإزالت[1907] نعمته، وأخذِ جميعِ ماله. قال: فسا ذلك على أهل سيبور.
ثُمّ ساروا إلى كفر طاب[1908] ـ وكان حِصناً صغيراً ـ فأغلقُوا الباب في وجوههم، فقال لهم خولي (لعنه الله): ألستُم في طاعتنا؟ قالوا: بلى. قالوا: فافتحوا لنا الباب، واسقُونا الما. فقالوا: والله ما نُسقيكُم الما، وأنتم منعتُم الحسين الما، ومنعتُم أهل بيته. فأجازوه إلى شيرز[1909]، فأنشد علي بن الحسين يقول:
|
ساد العُلُوجُ
فما ترضى به العرب |
68ـ قال أبو مخنف: فاجتمع أهل سيرج[1912] فقال المشايخ: يا قوم، إنّ الله تعالى قد كره الفتنه، وقد جاز هذا الرّاس في ساير البلاد ما عارضه أحدٌ، فدعُوهُ يجوز المدينه هذه. فقال الشباب: تباً لكم ولما جيتم به! والله لا كان ذلك أبداً أو نقتل عن آخرنا.
ثُمّ إنّهم أخذوا السلاح فلما نظروا[1913] المشايخ إلى ذلك حين سدوا[1914] عليهم لامه حربهم، فركبوا القنطره، فقال لهم خولي (لعنه الله): يا قوم، لا تفعلوا هذا الفعال. فحملوا عليه بالسلاح فصاح بأصحابه فاقتتلوا قتالاً شديداً، فقُتِل من أصحاب خولي (لعنه الله) ستةٌ وثمانين[1915] رجلاً[1916]، ومن أهل شيزر خمسة رجال[1917]، فقالت اُمُّ كُلثُوم: ما يقال لهذه البلد؟ فقالوا لها: شيرز[1918] فقالت: أعذب الله شرابهم، وأرخص أسعارهم، ورفع أيدي الظّلمة عنهم[1919].
69ـ قال أبو مخنف: والله لو أنّ الدّنيا مملُوّه
جوراً وظلماً ما لهم إلّا عدلاً وخيراً. ثم ساروا إلى [1920]، فنزلوا بحماه[1921] فغلّقوا الأبواب في وجوههم،
وركبوا الصور[1922]
وقالوا: لله[1923] ما تدخلون بلدتنا[1924]. فساروا إلى الرقتين[1925]. وكتبوا إلى صاحب حمص بأن تلقّانا؛
فإنّ معنا راس الحسين. وكان أميرها أخو[1926] خالد بن النّشيط، فلمّا قرا
الكتاب أمر بأعلام فنُشرت[1927] وخرج وتلقّاهم على مسيرة ثلاثة أميال.
قال: واشهروا الرّاس فيها، واتوا حمص، فازدحموا[1928] الناس على باب المدينه، وتراموا بالحجاره، حتى قُتِل على الباب ستّةٌ وعشرون رجلاً[1929]، فأتوا إلى الباب الشرقي فأُغلق في وجوههم، وقالوا: يا قوم أكُفرٌ بعد إيمانٍ أم ضلال بعدي[1930]؟! والله ما يجوز في بلدتنا هذه الرّاس أبداً، فردوه إلى تدمر[1931]، فأجازوه فيها، فأُوقف هناك عند كنيسة جرجس[1932] ـ وهي دار لخالد بن النّشيط ـ، والجهله يصفقون على أيديهم ويرقصون، ويقولون: هذا رأس خارجي خرج علينا، وعلى الخليفه يزيد (لعنه الله). ثم ساروا به إلى...[1933]، فبلغهم ذلك فتحالفوا أنّهم يقتلون خولي وشمر[1934] (لعنهم[1935] الله تعالى)، ويأخذون الرّاس منهما، فبلغهما ذلك، فلم يدخلونها[1936]. وساروا وكتبوا إلى صاحب بَعلَبكّ[1937] القانا[1938]؛ فإنّ معنا رأس الحسين بن علي. فأمر بالرايات فنُشرت، وزُيّنت المدينه، واجتمع الناس، وأخذوا بأيديهم وخرجوا، وتلقونهم[1939] على ستّة أميال من المدينه، وخلقوا[1940] وجوه خيلهم. فقالت اُمّ كلثوم (رضي الله عنها): ما اسم هذه المدينه: فقيل لها: بَعلَبكّ. فقالت: لا أفاد[1941] الله خضرواتهم ولا أعذب لهم شراباً، ولا أرخص لهم سعراً ولا رفع أيدي الظّلمة عنهم[1942].
70ـ قال الراوي[1943]: فلو إنّ الدّنيا مملُوه عدلاً ما بالهم[1944] إلّا جَوراً وظُلماً، فباتُوا ثَمِلينَ من الخمر، ثُمّ ارتحلوا وساروا إلى عند صومعه[1945]، فأنشأ علي بن الحسين يقول:
|
هذا الزّمان
فما تفني عجايبُهُ |
قال: فلما جنّهم اللّيل رفعوا الرّاس إلى جانب الصّومعه، فلمّا عَسعَسَ اللّيل بظلامه سمعوا[1952] الحرّاس دَوِياً كدويّ النحل والرّعد القاصف، فاستأنسُوا به، فروا[1953] نوراً ساطعاً وضياء لامعاً، فاطّلع الرّاهب، فنظر النور وأخذ بعنان السما، ونظر إلى باب مفتوح من السما، والملايكه تنزل كتايباً[1954]، وتنادي: السّلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على بابن[1955] بنت رسول الله. فزع الرّاهب لذلك جزعاً[1956] شديداً، فلمّا أصبحوا همُّوا بالانصراف أشرف الراهب عليهم وناداهموا[1957]: أيّها الناس مَن عميد هذا الجيش الملعون؟ فأشاروا إلى خولي وشمر بن ذي الجوشن (لعنهم[1958] الله تعالى)، وقال: يا خولي أنت عميد هذا الجيش؟ قال: أجل. قال: فما هذا معكم؟ قال: رأس خارجيّ، خرج على يزيد. فقال له: فما اسمه؟ قال: اسمه الحسين ابن علي ابن أبي طالب. قال: فما اسم اُمِّهُ؟ قال: فاطمه بنت محمد (صلى الله عليه [وآله] وسلم). فقال لهم الرّاهب: تباًّ لكُم ولما جيتُم به، ثُم بكا وقال: صدقتِ الأخبار في قيلها إنّهُ إذا قُتِل هذا الرّجل تمطُرُ السّما دماً، ولا يبقى حجر ولا مدر إلّا وصيّروا[1959] دماً عبيطاً[1960].
ثُمّ أقبل عليهم وعلى حامل الرّاس، وقال له: أهل[1961] لك أن تدفع إلىّ الرّاس ساعة وأُعيدها إليك؟ فقال: مالي سبيل إلى ذلك، وما أُمِرت أن أكشف وجهه الاّ بين يدي يزيد بن معاويه (لعنه الله)؛ لآخذ منه الجايزة، فقال له الرّاهب: أنا أعطيك عشرةُ آلاف درهم وارفع إلىّ الرّاس. فقال له: أحضرْ ما ذكرتَ، فسلّم إليه الرّاهب ذلك، فرفع إليه الرّاس، فجعل الرّاهب يُقبّل ثناياه ويبكي، ويقول: يَعُزُّ عليَّ يا مولاي يا با[1962] عبد الله إلّا أن[1963] أكون شهيداً استُشهد بين يديك، ولكن إذا لقيتَ جدّك رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فاقريه[1964] منّي السلام، وقل له: إنّي أشهدُ أن لا الهَ إلّا الله وحده لا شريك له، أنّ[1965] محمداً عبده ورسوله. ثُمّ دفع إليهم الرّاس، وقال: يا ويلكم لقد استحوذ عليكم الشيطان واخترتم الدّنيا على الآخره. فسمع بعضهم كلامه، وجلسوا يقتسمون المال فجعلها الله في أيديهم حجاره، فقال لهم خولي (لعنه الله): يا ويلكم! اكتُمُوا هذا الأمر؛ فإنّه أمر فضيع[1966]، ورحلوا من ذلك الموضع[1967].
قال سهل بن سعد: فبينما نحن سايرون وإذا بهاتف يهتف بنا؛ نسمع صوته ولا نرى شخصه، وهو ينشد ويقول:
|
أترجوا[1968] اُمّةٌ قتلوا حُسيناً |
قال: فلمّا سمعوا ذلك منه ذهلت عقولهم وجزعوا جزعاً عظيماً، وجعلوا يجدّون السّير حتى دخلوا دِمِشق.
[دخول السبايا والرؤوس إلى الشام]
قال سهل: وأقبلت الرّاس من تحتها[1972]، وإذا من تحتها قايلاً يقول[1973]:
|
جأوا[1974] براسك يا بن بنت محمد |
قال سهل: فوقفتُ في جملة الناس، وإذا قد أشرف علينا تسعة وعشرون[1980] رايه، وأُتى براس الحر بن يزيد الرياحي (رضي الله عنه) يحمله شمر (لعنه الله)، وفي أذنه رقعة مكتوب فيها قصيده، قالها في الوقت الذي صار فيه إلى الحسين×، يذكر فيه[1981] مساوي بني أميه ويذم فيها عبد الله[1982] بن زياد (لعنه الله). ويذكر من قُتِل من أصحاب الحسين×. وإنّما عُلِّقت في أذنه ليقراها أصحاب يزيد، وأقبل من بعده براس العباس بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يحمله قاسم الجحفي[1983]، وأقبل من بعده براس عون بن علي[1984] يحمله سنان، وأقبل من بعده بالنسا.
وكان عبيد الله بن زياد (لعنه الله تعالى) كتب كتاباً وأرسله مع خولي وشمر وسنان (لعنهم الله أجمعين)، وكتب فيه بجميع ما جرى، وذكر فيه أمر الحسين، وقتْله وقتْل أولاده، وتسير[1985] النسا والأطفال إليه. فلمّا وصل قريباً من دمشق أرسله مع رجل من العامة إلى يزيد بن معاوية يخبره بالقدوم، وقال له: أقرّ الله عينك يا أمير المؤمنين. قال: بماذا؟ يا ويلك! قال: براس الحسين[1986].
71ـ قال أبو مخنف: وكان عند يزيد جماعه فاستحيا[1987] وقال: لا أقر الله لك عيناً، وقطع يديك ورجليك. القِ كتابك وامضِ عنّى لشانك، فألقى الكتاب.
ثُمّ إنّ يزيد أقبل على طبيبه، وقال له: اصنع ما أنت صانع، ففصده[1988] وخرج من عنده. ثُمّ أخذ يزيد الكتاب، وفضّه وقراه وعرف معناه، ثُمّ على أنامله[1989]، وقال لمن حوله: مصيبة وربّ الكعبه، وجعل مَن قراه من بني أميه يعظّم ذلك، ويكبّره ويقبّحه وينكره، لا ا[1990] مروان بن الحكم (لعنه الله) فإنّه لمّا قراه قال: لله درك يا بن زياد، ثُمّ ضحك واستهز[1991]؛ تمرّداً على الله تعالى وعلى رسوله، ولم يزالوا سايرين حتى نزلوا من[1992] دمشق، فعند ذلك أمر يزيد أن يفتح البلد، وخرج وركب في ماية ألف فارس، وأدخل الراس من باب جيرون[1993] ثُمّ إلى باب توما[1994].
قال سهل بن سعد ـ أو سعيد بن سهل ـ: وكنتُ حاجّاً إلى بيت الله الحرام، فدخلتُ يوميذ[1995] مدينة دمشق، فوجدتُها مفتوحة الأبواب، مزينة بالرجال خضره نظره، مزينه بأحسن زينه، والناس يهرعون والصبيان يتعادون[1996]، والنسا قد خرجن، وذات الخدور قد برزن كأنّهن في يوم عيد، وقد أخذت الناس المجالس كما يلبس الأعياد[1997]. فقلتُ: يا قوم ألكم عيد لا أعرفه؟ فقالوا: أنت غريب؟ فقلتُ: نعم أنا رجل غريب، وعابر سبيل. قالوا: إنّ عبيد الله إنّ عبيد الله[1998] بن زياد أمير الكوفة، قد خرج عليه خارجي فقتله وقتل جميع أصحابه، وقد جهّزه إلى الخليفه يزيد بن معاويه. وقد أمر الخليفه بتزيين المدينه، وإشهار الأعلام. وها نحن منتظرين[1999] دخولهم.
قال سهل بن سعيد: فوقفتُ ساعه وإذا بالروس[2000] قد أقبلت بعضها على بعض، ورايتُ في جملة النسا أمراه عليها بُرقُعُ من خزّ ادكَن، وهي تنادي: وا بتاه[2001]! وا حسيناه! قال: فجعلتُ أنظر اليها. قالت[2002] فصاحت: ألا تستحي يا شيخ، تنظر إلى حريم رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)؟! فقلتُ لها: والله ما بنظراتي إليكي[2003] بريبة لا خنا[2004]، وإنمّا أنا رجل معكم ومن شيعتكم. فقلتُ[2005] له: ومن أين أنت؟ فقلتُ لها: أنا سهل بن سهل بن سعيد الشاهوري[2006]، وأنا محبّكم[2007].
ثُمّ أقبلتُ على زين العابدين، وقلتُ له: يا مولاي أنا رجل من شيعتكم، وليتني كنتُ استُشهِدتُ مع أبيكَ، وها أنا معي ألف دينار وألف درهم، فهل لك من حاجة إلى شيء من ذلك؟ فقال لي: خذ شياً من ذلك، وادفعه إلى حامل الرّاس، واساله أن يجعل الرّاس أمام المطايا، حتى تشتغل الناس بالنظر إليه عن الحريم وعنّا. قال سهل: ففعلتُ ذلك.
72ـ وفي رواية أخرى، قال: أتيتُ إلى اُمّ كُلثُوم (رضي اله عنها)، فقلتُ لها: والله لقد[2008] كان لي قدرة أو أن أستطيع لكم على دفاع إذاً لفعلتُ. قالت له: إذا أتيتَ جدّي رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، واقريه منّي السلام، وأخبره بما نالنا من بعده، وما لقينا. قال سهل: فتزايد عليّ البكا، قلتُ: حباً وكرامه، فهل لكِ من حاجة أخرى؟ قالت: نعم، هل معك شي من الوَرِق[2009]؟ قلتُ: نعم. قالت: انطلق وأرض حامل الرّاس؛ ليحله[2010] أمام المطايا؛ حتى تشتغل النّاس بنظرهم إليه عنّا، ففعلتُ ما أمرتني به[2011].
ثُمّ دعت له وقالت: يا سهل، حشرك[2012] معنا، وفي زمرتنا يوم القيامه[2013].
ثُمّ إنّ زين العابدين أنشأ يقول:
|
أُقادُ دليلاً[2014] في دمشق كأنّني وشَيخي أمير
المؤمنين أميرهُ |
قال سهل: ثُمّ نظرتُ إلى روشن[2017] فيه خمسة نسوه، فيهنّ امراه عجوز لها من العمر ثمانين سنه، فلمّا صار الرّاس بإزا الرّوشَن أخذت العجوز حجراً فضربت به الرّاس[2018]، فلمّا رايتُ ذلك قلتُ: اللّهمّ عجِّل بهلاك هذه النسوه بمحمد وآله، فوالله ما استتمّ كلامي حتى سقط الرّوشَنُ وهلكن[2019] النسوه وجماعة من الناس. وأتوا بالرّاس إلى بابٍٍ هناك، فسقط فبُنى مسجداً، وأتوا إلى باب الكراديس[2020]، وكان باب خراب، فازدحم الناس هناك فسُمِّى باب الكراديس، وأداروا به إلى باب السّاعات[2021] فأُوقف هناك زماناً. وكان الرّاس بيد خولي بن يزيد، وهو يقول: أنا صاحبُ الرُّمح الطّويل. قالت اُمُّ كُلثُوم: كذبتَ وفجرتَ يا ويلك! يا عدو الله يا ويلك! أتفتخر بقتل قتيل حمله جبريل، وناغاه مكاييل، وروباه[2022] الرّسول، وفضّله الجليل؟! يا ويلك! ألا لعنة الله على الظالمين المرتدين الملحدين والناكثين بالدّين. ويلك! بجدّه خُتِم الأنبيا، وبأبيه خُتِمَ الأوصيا، واسمُهُ مكتوبٌ فوق العرش، فَتكَت فيه سلالةُ الخنا ونسلُ الأدعيا. وأقبلت الروس[2023].
73ـ قال أبو مخنف لوط بن يحيى: وكان الحسين قد خضب شيبته الكريمه، ووجهه كأنّه بدرٌ منيرٌ في كماله، ثُمّ أخذه رجل من بني أسد، يقال له عمر بن الحجاج، وأقبل الناس إلى باب قصر يزيد، وكان عليلاً فاستيقض[2024] من نومه، فدخل خولي، وقال: يا أمير المؤمنين الرّاس بالباب، فتأذن لي في إدخاله أو أدعه بالباب؟ فقال يزيد: علىّ به. ثُمّ إنّ خولي أنشأ يقول: عند وضع الرّاس الراس[2025] بين يديهم ـ ومنهُم مَن قال: كان الشمر (لعنه الله) يقول[2026] ـ:
....
|
املأ رِكابي[2027] فضّةً أم ذَهبا |
74ـ وفي رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل (رضي الله عنه) عن أشياخه أنّه كان رجل من مدحج[2030] فأنشد الشعر:
|
املأ رِكابي
فضّةً أم ذهبا وخيرَ أهل
الأرض طرّاً نسبا |
75ـ قال أبو مخنف: فلمّا سمع شعره قال له: يا ويلك! حيث علمتَ أنَّهُ خيرُ الناس ِلِمَ قتلتهُ؟! فمالك عندي جائزه إلّا قتلك، وهذا لا يصل له[2032]. وفي رواية أبي عبد الرحمن أنّه ما قتلته[2033].
وكان يزيد عارف[2034] بالحسين، وأنّه أخير منه أصلاً وفرعاً، ولا سيما مع ما سبق من وصيه أبيه له[2035]. والشمر (لعنه الله) قتله رجل من أصحاب المختار، يقال له: الأحمر بن شمط[2036]، وهذا بلغ الحجة عليه، وأعظم لجرمه وأشد لإثمه. ثُمّ كشف المنديل عنه، فخرج من ثناياه نوراً ساطعاً[2037] حتى لحق عنان السماء[2038].
76ـ قال عبد الله بن ربيعه الحميري[2039]: إنّي كنتُ في حضره يزيد، وقد أُحضر الرّاس بين يديه، فقال له خولي[2040]: يا أمير المؤمنين أقرّ الله عيناك[2041] بالنصر والزفر[2042]، وأنّ الرّاس قدم علينا في نيف وسبعين رجلاً من أهل بيته ومواليه، فاعرضنا[2043] عليه الدخول في حكم الأمير عبيد الله بن زياد فأبا[2044] إلاّ القتال، فأخذنا عليهم من كلّ جانب حتى أخذت السيوف مأخذها من الهام[2045]، فوالله ما كان إلاّ زوال الشمس حتى أتينا عليهم جميعاً، وتركنا أجسادهم مطروحه بالعرا مجرّحه بالبيدا؛ تطلع عليهم الشمس وتسفى عليهم الرياح وتاكل لحومهم العُقبان[2046] مع الرّخم[2047] والذوبان[2048]. فأطرق يزيد هنيهة ثُمّ رفع راسهُ، وقال: قد كنتُ أقنع منكم ومن طاعتكم بدون ذلك. ثُمّ جعل ينكث ثنايا الحسين بقضيب كان معه، فخرجت جارية من داره وقالت له: يا ويلك! أتنكث بالقضيب ثنايا قبّلها رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)؟! فأمر يزيد بقطع راسها فقُطِع. وهذا دليل ثاني[2049] على أنّه لم يَقتُل الشمرَ (لعنه الله) لأنّه عرف الحق وأنكره[2050].
77ـ قال أبو مخنف: ثُمّ إنّه جعل ينكث ثنايا الحسين، وينشد يقول:
|
يا حُسنَهُ
يلمعُ في لونين |
وجعل يفتخر، فسمعت زينب، فقالت: صدق الله العظيم وصدق رسوله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) في تبليغه عن كلام الله، حيث يقول: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)[2054]. ثُمّ قالت: بلى هي عليه دايرة السواء[2055] اذ أصبحنا نساق كما تساق الغنم، كأنّا لسنا نسل خير الأمة، وأكرم من سعى على قدم. ما أجراك على الله} وعلى رسوله! أتسوق حرمه مهتوكات! ينظر إليهم القريب والبعيد والولي والعدو، في المدن والقرى على الأقتاب بغير وطا؟! لقد خرجتَ عن دينك، وظل[2056] يقينك؛ إذ شهرتنا كما تشهر الإما، فاستعدّ[2057] يا ويلك! غداً حجة عند جدّي إذا خاصمك وأبي إذا قدّم ولده وطالبك. والله خزيك[2058] ويجزيك على فعالك ومعاقبك على ذلك. ما لك وما لنا! الله بيننا وبينك[2059].
وفي رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل يرفعه إلى أشياخه، قال: كان عند يزيد لما أُتِىَ براس الحسين، ووُضِع بين يديه، وعنده رجل، يقال له أبو بريد الأعلمي[2060]، وهو ينكثه وينشد:
|
يفلّقن هاماً
من رجالٍ أعزة |
فقال له: ارفع قضيبك فوالله لقد رايتُ رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) حيث يقول: إنّكم ستبكون في ولدي من بعدي[2061].
78ـ وفي رواية أخرى أنّ يحيى بن الحكم[2062] أخوا[2063] مروان كان جالساً عند يزيد، وأنشد هذه الأبيات:
|
لَهامٌ بأدنى
الطّف أنى[2064] قرابةً أميةُ أمسى نسلُها عدد الحصـى وبيت رسول الله ليس له نسلُ[2065] |
قال أبو بريدة: لقد سمعتُ رسول الله (صلى الله عليه
[وآله] وسلم) يقول: «إنّهما ولديَّ[2066] فمن أحبّهم[2067] فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني».
فأغاضه[2068] ذلك وأسخطه. فلما راه أبو بريدة
قد اغتاض[2069]
منه، قال: يا يزيد روى أنس بن ملك[2070] أنّ رسول الله (صلى الله عليه
[وآله] وسلم) استاذن ملك القطر على النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم) أن يزوره.
وقد تقدّم الحديث[2071]. فلمّا قاله أبو بردة اغتاض يزيد،
وأمر به فخرج على وجهه[2072]
فبينما هو سلك[2073]
إذ صاح غراب على القصر من أعلاه غراب البَين[2074] فأنشد يزيد (لعنه الله) يقول[2075]:
|
يا غُراب
البَين أنعبت[2076] فقُل |
هذا دليل على أنّه رضى بما جرى، وسره بقتل الإمام المجتبا[2085]، وأنّه تحمّل أثم[2086] في قتل الحسين.فبينما هو ينشد إذ دخل عليه محقن[2087] (لعنه الله) فقال له: جيناك براس الإمام[2088] العرب. فقال له: يزيد بل ما ولدت اُمُّ مُفحز[2089] ألأم وألأم وأخبث وألعن! ويلك وأيّ فخر لنا بقتيل لئيم! ويلك أما سمعتَ قول أخت[2090] عمر بن عبد وُدٍّ حين فخرت بقتل عليٍّ لأخيها، وهي تقول:
|
لو كان قاتِلُ
عَمر غيرَ قاتله |
79ـ قال أبو مخنف: ثُمّ إنّ هند بنت عبد الله[2092] زوجه يزيد تنقبت بُرداً[2093] ثُمّ وقفت من ورا السّتر، وقالت له: عندك أحد؟ ثمّ أمر من كان عنده بلانصراف[2094] ثُمّ قال لها: ادخلي، فدخلت ونظرت إلى الرّأس وهي في الطشّت، فصرخت وقالت: هذه رأس الحسين بن علي، وأمّه فاطمه بنت محمد (صلى لله عليه [وآله] وسلم)؟! يَعُزُّ والله على فاطمه أن تقلب راس ولدها. والله لقد فعلت فعالاً استوجبت من الله به اللّعنه إلى يوم القيامه. ويلك! بأيّ وجهٍ تلقى الله ورسوله؟! فقال لها: يا هند دَعي هذا الكلام، والله ما اخترتُ قتله، وما أمرتُ به، فخرجت من عنده وهي تبكي[2095].
ثُمّ إنّ الشمر (لعنه الله) دخل على يزيد[2096] فنظر إليه شَزراً[2097]، وقال له: لما قتلتَه؟ قال: أطلب منك الجايزة. فقال لأصحابه: أجيزوه فاضربوا عنقه[2098]. وهذا لا أصل له[2099].
وحضر عند يزيد رأس الطالوت[2100] فلمّا را[2101] ما رآه وسمع ما سمع، قال له: يا أمير المؤمنين سالتُ[2102] بالله هذه راس من؟ قال له: رأس الحسين بن فاطمة بنت محمداً[2103] (صلى الله عليه [وآله] وسلم). قال له: فبما استوجب القتل؟ قال: لأنّ أهل العراق كتبوا إليه وأرادوا أن يجلسوهُ[2104] خليفه، فقتله عامِلي عبيد الله بن زياد. فقال له: يا يزيد فمَن أحقُّ بالخلافه منه؟ ما أعجب أمركم[2105]! أنا بيني وبين داود ينيف[2106] وثلاثون أباً[2107]، وتُعظّمني اليهود ويأخذون التُّراب من تحت قدمي ومسحون[2108] به وجوههم وثيابهم، ولا يرون التّزويج إلّا بي[2109]. وأنتُم بالأمس كان نبيُّكم بين أظهُرِكُم واليوم شدتم[2110] على ولده فقتلتموه[2111]! والله إنّكم لشرّ أمّة. فقال له يزيد (لعنه الله): يا ويلك! والله لو لا خبر سمعتُه من[2112] رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) أنّه قال: مَن قتل معاهداً كنتُ خصمَه يوم القيامه[2113] لَقتلتُك. فقال له: يا يزيد هذا كلام رسول الله فيمن قتل معاهداً، فكيف مَن يكون قتل ولده وذريته؟ ثُمّ قال له: يا عبد الله[2114] اشهد لي عند جدّك رسول الله بأنّي أشهدُ أن لا اله إلّا الله وحدهُ لا شريك له، وأنّ محمداً عبدُهُ ورسُولُه. فقال له يزيد (لعنه الله): الآن قد خرجتَ من دينك وقد دخلتَ في دين الإسلام، فقد برينا[2115] من ذمّتك. ثُمّ أمر بضرب عُنُقه فضربت[2116].
80 ـ وفي روايه أخرى أنّ الجالثيق[2117] لما ساله عن الرّاس، وقال له: هذا راس الحسين بن علي بن أبي طالب. وقال له: فمَن كان أحقُّ بالخلافه؟ كما تقدّم، قال يا أمير المؤمنين: قد كنتُ في هذه الساعة راقداً في البِيعه[2118] فرايتُ غُلاماً شاباً كأنّ الشمس من وجهه، وقد نزل من السّما ومعه رجالٌ كثيره. فقلتُ لبعضهم: مَن هذا؟ فقالوا: هذا محمد، وهولا الملايكه من حوله يعزّونه في ولده الحسين. ارفعه[2119] من بين يديك، والله لقد أهلكك الله تعالى. فقال له: يا ويلك! حبث[2120] بأحلامك، تخبر لنا![2121] فوالله لأفقرنّك[2122] في وجهك وبطنك وظهرك. ثُمّ قال: خذوه فخذوه[2123]، وجعلوا يسحبُوه[2124] على وجهه، ويضربُوه[2125] بالأسياط[2126]. فنادا[2127]: يا أبا عبد الله اشهدني[2128] عند جدّك رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) بأنّني أشهدُ أن لا الهَ إلّا الله وحدهُ لا شريك له، وأنّ محمداً عبدُهُ ورسولُه. فجعلوا يضربُونه حتى رضُوا جسده. فقال له: يا يزيد إن شئتَ أن تضرب وإن شئتَ أن لا تضرب، هذا رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) واقفٌ، وبيده قميصٌ من نُور، تاج[2129] من ذهب[2130]، وهو يقول: ليس بينك وبين لبس هذا القميص، وهذا التاج إلّا أن تخرج من دار الدنيا، ثُمّ تكون رفيقي في الجنّه. ثُمّ إنّهم لم يزالوا يضربوه[2131]، حتى قضى نحبه (رضي الله عنه)[2132].
قال: ثُمّ جاريه[2133] من داره وهو ينكثُ في ثَنايا الحسين، فقالت له: قطع الله يديك وجليك[2134] أتنكُثُ ثنايا طالما قبّلها[2135]رسولُ الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)؟! فقال لها: قُطِع راسكِ، ما هذا الكلام؟! قالت له: اعلم أنّي كنتُ نايمه، ولستُ بنايمه فنظرتُ إلى باب السّما مفتوح[2136]، وإذا بسُلّم بنور[2137] قد نزل إلى الأرض وإذا بغُلامينِ أمردَين[2138] عليهما ثيابٌ خُضرٌ، وهما ينزلان على السُلّم، وقد بُسطَ لهما بساطٌ من زبرجد[2139]. وقد أخذ نُورُ ذلك البساطِ من المشرق إلى المغرب وإذا برجُل رفيع القامة مدور الهامه قد أقبل يسعى حتّى جلس على البساط ونادى بأعلا[2140] صوته: يا أبي آدمُ اهبط، فهبط رجل أدمي[2141] اللّون، طويلٌ من الرجال. ثُمّ نادى: يا أبي سالم[2142] اهبط. يا أبي إبراهيم اهبط. يا إسمعيل[2143] اهبط. يا موسى اهبط. يا عيسى اهبط. ورايتُ امراه واقفةً، قد نشرت شعرَها، وهي تُنادي: يا أُمّ حوى[2144] اهبطي. يا اُختي[2145] هاجر اهبطي. يا اُمّي[2146] ساره اهبطي. يا اُختي مريم اهبطي. يا اُختي[2147] خديجه. وإذا بهاتف يقول: هذه فاطمه الزهرا بنت محمد المصطفى وزوجة المرتضى اُمُّ سيّد الشهدا، المقتُولُ بكربلا (صلى الله عليهم وسلم أجمعين).
ثُمّ نادت: يا أبتي ألا ترى ما صنعت اُمّتُك بولدي؟! فبكى رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، وأقبل على آدم، وقال: يا أبتي ألا ترى إلى فعل الطُّغاه بولدي من بعدي؟! لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامه. قال: فبكى آدم، وبكى كلّ وبكا كل[2148] من كان حاضراً من الملايكه، ثُمّ رايتُ زهى عن[2149] ثلاثين ألف رجل يقدمهم غُلام ليس فيهم مَن له لحيه غيره، وبيده لواء. حضروا بأيديهم حِراب من نار، وهم يقولون: خُذوا صاحب هذا[2150] الدّار فاحرِقوهُ بالنّار. فرايتُك وقد احترقتَ بالنّار، وأنت تُنادي: النّار النّار! أين المفرُّ من النّار؟ فقال لها: يا ويلكِ! ما هذا الكلام؟! أردتي[2151] وضعي[2152] عند مملكتي! ثُمّ أمر بضرب عُنُقها، فنادت: ألا لعنةُ الله على الظّالمين[2153].
ثُمّ إنّه استدعا[2154] بالنسا، ثُمّ أوقفهن بين يديه، فنظر إليهنّ، وجعل يسال عنهُنّ ويقول: مَن هذه؟ ومَن هذه؟ فقالوا له: هذه زينب وهذه اُمُّ كُلثُوم. فقال لها: كيف رأيتي[2155] انكال[2156] الله بكم؟ فقالت له: يا بن الطليق ـ تعني أبا سفيان حين أطلقه رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) يوم فتح مكه[2157] ـ يا ويلك! هذه إمائك[2158] وحريمك من ورا السُّتُور، وفي بطون الخدور، وبنات رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ينظر إليهنّ البرّ والفاجِر؟! فنظر إليها شزراً، فقام إليه عبد الله بن عمرو بن العاص[2159] وقبّل رأسه، وقال له: يا أمير المؤمنين إنّ الذي كلمتك به ليس شي[2160]، فسكن غضبه. ثُمّ رفع رأسه إلى سُكينه، وقال لها: إنّ أبكِ[2161] جهل حقّي، ونازعني في خلافتي. وقالت: يا يزيد لا تفرحنّ بقتل أبي؛ فإنّه كان عبداً لله صالحاً، دعاهُ إليه فأجابه، وأمّا أنت فلك بين يدي الله مقاماً يسالك فيه عن ذلك، فاستعدّ لمسالتك جواباً، ولمقامك مقالاً، وإلا[2162] ذلك جواباً. فقال: اُسكُتي يا سُكينة، ما كان لأبيك معي حقّ. قال: فقام إليه رجلٌ من لَخم[2163]، وقال له: يا أمير المؤمنين ما أريد من الغنيمه غير هذه الجاريه تكون خادماً[2164] لي. فتاخّرت سُكينة إلى عمّتها عاتكه[2165] نادتها، وتقول: يا عما ترى أنت تكون بنت رسول الله خادمه[2166]. فقالت اُمّ كُلثُوم لذلك الرجل: مررض[2167] فاك واعما عيناك[2168] وايتم عيالك. يا ويلك! إنّ بنات الأنبيا لا يكون خداما للأدعيا[2169]. قال: والله فما استتّم كلامها حتى أنزل الله على ذلك الرجل آيه من السما، فعجّل الله هلاكه[2170]. فقالت: الحمد لله الذي عجّل الله عقوبته في الدّنيا قبل الآخره. هذا جزا من تعرّض لحريم رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم). ثُمّ قالت: يا يزيد أما لك فيما رايتَ عبرة وعظه؟ فلم يجبها في ذلك بشي[2171].
ثُمّ إنّه أقبل على زين العابدين، فقال: مَن هذا؟ فقيل له: هذا بن الحسين. فقال: أليس قد قُتِل؟ قالوا: بلى كان له أخٌ أكبر منه اسمه عليٌّ، وهذا عليّ الأصغر. فقال له يزيد (لعنه الله): يا غلام أنت الذي أراد أبوك أن يكون خليفه؟ الحمد لله الذي سفك دمه، وامكنني منه، وأراح المؤمنين منه. فقال: يا زيد[2172]، مَن كان أحقُّ بالخلافة من أبي؟! وهو بن بنت رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) وبن وصي رسول الله، أما سمعتَ قول الله}: (ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلّا في كتاب من قبل أن نبرأها إنّ ذلك على الله يسير * لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله والله لا يحبّ كلّ مختال فخور)[2173]. وكان يزيد (لعنه الله) يلبس غلاله[2174] ثلجيه[2175] وثياباً فاخره، ويترد[2176] أبرداً، ويلبس نعلاً صَرّاراً[2177]، ويختال[2178] في مشيه، وينظر إلى أعطافه[2179]، فذلك[2180] قرأ زين العابدين (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)[2181]. وكان يزيد غضب غضباً شديداً من كلامه، وقال: يا غلام كأنّك بنا تتعرّض[2182]؟! ثُمّ أمر رجل[2183] عنده بضرب عنقه، فبكا[2184] زين العابدين، ثُمّ نادى بحذا[2185] البيت يقول:
|
ألا يا رسول
الله يا خيرَ مُرسلٍ |
ثُمّ تعلّقت به عماته وخالاته وأخواته، ونادى[2187] بالعويل، ونادت[2188]: ويلك يا بن زياد[2189]، أمَا رويتَ الأرض من دما أهل البيت؟! أتُريد أن تخلي الأرض من ذرية رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)؟ فبكا[2190] جلساوه[2191] عند ذلك، وقالوا له: دع عنك هذا الولد؛ فإنّه لا يحل قتله، فأمر بتخليته[2192].
ثُمّ إنّ زين العابدين أقبل على يزيد (لعنه الله)، وقال له: سالتُك بالله تعالى إن كان بينك وبين هذا[2193] الحريم قرابة فابعث معهنّ من تثق به بأن يوصلهنّ إلى المدينه. فبكا الناس لذلك بكا شديداً، فخشي يزيد (لعنه الله) الفتنه، وقال: والله لا يوصلهنّ المدينة غيرُك. وأقبل على جلسايه، وقال لهن[2194]: ما تشيرون به عليَّ؟ ما أصنع بهذا الغلام والحريم؟ فقالوا له: هذا صبي صغير، لم يبلغ الحلم، ولا يحل قتله. فأمر عند ذلك رجلاً ذرب اللسان[2195]، جريء الجنان[2196] أن يصعد المنبر، ولا يدع شيا من المساوي إلّا ويذكره في عليٍّ وولديه، ففعل (لعنه الله). فقالت له سكينة ابنت الحسن×[2197]: ويلك! لعنك الله تعالى! ما أقل حياك! وأيّ مساوي في أبي وجدي؟! فصا[2198] بها يزيد (لعنه الله)، وقال: ألا تسكتين يا بنت الخارجيّ؟! فقالت: يا بن معاويه، أيمّا[2199] أحق بالخلافه؟! أنت أو أبي؟! وجدّه رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، وأبوه عليّ بن أبي طالب، وأمّه فاطمة الزهرى[2200] سيدة نسا أهل الجنه؟! فلم يجبها ولم يعبا بقولها. فقال زين العابدين: سالتُك بالله إلّا أذنتَ لي أن أصعد على المنبر، فأتكلم بكلام فيه لله رضا وللأمة صلاح، فقال له ذلك الرجل: والله ما تكلّمتُ بهذا الكلام وأنا أدين به، وإنّي أعلم أنّه بكم فتح الله وبكم ختم الله، وإنّما أمرني يزيد بذلك فتكلّمتُ.
ثُمّ إنّ زين العابدين جعل يُكلّم المشايخ بعذوبة لسانه وفصاحة منطقه، فقالوا للخطيب: ما يضرّك أن تدعوا[2201] هذا الغلام أن يصعد المنبر؟! ما عساه أن يقول؟! وإنّه إذا صعد المنبر ونظر الناس لم يتكلّم بشي، فنزل الخطيب من على المنبر، وقال له: اصعد يا غلام. فصعد زينُ العابدين المنبر فحمد الله وأثنى عليه بمحامد لم يسمع السامعون مثلها، وأكثر من الصلاه على رسول الله (صلى الله عليه وسلم وعلى آله)، ثُمّ قال: أيُّها الناس مَن عرفني فقد عرفني، ومَن لم يعرفني فأنا اُعرّفُه بنفسي، أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنا بن حج ولبا[2202] أنا ابن من طاف وسعى[2203] أنا بن زمزم والصفا، أنا ابن مكة ومنا[2204]، ابن البشير النذير، ابن[2205] الداعي إلى الله بأذنه، والسراج المنير، أنا بن دنا فتدلا[2206]، فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا بن علي المرتضى، أنا بن فاطمه الزهرا، أنا بن خديجة الكبرى، أنا بن صريع كربلا، أنا بن مجزوز الراس من القفا، أنا بن العطشان حتى قضا[2207]، أنا بن الذي افترض الله ولايته فقال: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا)[2208]، ألا إنّ الاقتراب[2209] للحسنه مودتنا أهل البيت.
ثُمّ قال: يا يُّها[2210] الناس فضّلنا اللهُ بخمسٍ خصال، فنبيّنا محمد (صلى الله عليه [وآله] وسلم) وهو أفضل الأنبيا، وبيتنا مختلف الملايكه، وفيه نزلت الآيات. ونحن قادة العالمين، وبنا فتح الله وبنا ختم[2211]، وأُعطينا خمسُ[2212] خصال، فعبب[2213] السماحه والشجاعه والهدى والحكم بين الخلايق والمحبه في قلوب المؤمنين. قال: فقام إليه المؤذن فقطع خطبته. فلمّا قال: الله أكبر، قال زين العابدين: كبّرتَ كبيراً، وعظّمت عظيماً، وقلتَ حقّاً. فلمّا قال: أشهد أن لا إله إلّا الله، قال: أشهد بها مع كلّ شاهد، واحتملها عن كلّ جاحد. فلمّا قال: أشهد أنّ محمداً رسول الله، بكا زين العابدين حتى علا منه البكا والنحيب. ثُمّ قال: يا يزيد! محمدٌ جدّي أم جدّك؟ قال: بل جدُّك. قال: فلِمَ قتلتَ ولده وآل بيته؟ قال: فلم يعد عليه جواباً. قال: ثُمّ قام ودخل داره، وقال: لا حاجة لي في الصلاه اليوم، فلم يصلّي[2214] ذلك اليوم[2215]..
وقام إلى زين العابدين رجل يقال له المهنا[2216] بن عمر، فقال له: كيف أصبحتَ يا ابن رسول الله؟ فقال: كيف مَن[2217] قُتِل أبيه[2218] بالأمس، وهو يتوقّع القتل اليوم، وإلى الله نشكوا[2219] ما أصبحنا وأمسينا فيه[2220].
ثُمّ قال: أصبحت العرب تفتخر على العجم بمحمد (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، وأصبحت قريش تفتخر على العرب؛ لأنّه منها، ونحن أهل البيت المظلومين المقهورين[2221]. فعلت الأصوات بالبُكا والنّحيب، فخشى يزيد (لعنه الله) الفتنه، فقال للخاطب: لِمَ تركتَه صعد المنبر، وتكلم بهذا الكلام[2222]؟ فقال الخاطب: والله ما علمتُ أنّ مثل هذا الغُلام يتكلّم بمثل هذا الكلام. فقال يزيد (لعنه الله): ويلك! هذه العصا من تلك العُصَيّا[2223]، وهل تلد الحيّة إلّا حويه[2224]؟! أما علمتَ أنّه من بيت أهل النبوة؟! فقال له الخاطب: يا أمير المؤمنين حيث علمتَ أنّه من أهل بيت النبوه فلِمَ قتلتَ أباه وقومه؟! فقال يزيد (لعنه الله): أبدل الله لنا بك مَن هو خير منك، ولا بدلّك بنا من هو شر لك منّا. ثم أمر بضرب عنق الخاطب[2225].
قال: فقاموا[2226] له أهل الشّام كأنّهم كانوا نِياماً فاستيقظوا فعطّلوا أسواقهم، وقالوا: يا ويلك! هنا راس بنت[2227] رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) بيننا؟! والله ما علمنا ذلك إلّا أنّهم قالوا: راس خارجي، خرج علينا بأرض العراق. قال: فلمّا سمع يزيد (لعنه الله) ذلك، ونظر إلى ما هم فيه استعمل هذه الأجزا من القران وفرّقها في المساجد. وكانوا إذا صلّوا وضعوا الأجزا بين أيديهم حتى يشتغلوا بها عن ذكر الحسين فلم يُشغلُهُم ذلك عن ذكره. قال: فلمّا علم يزيد (لعنه الله) أنّ أهل الشام لا يشغلهم ذلك عن ذكر الحسين فنادى فيهم أن يحضروا، فلمّا تكامل الناس، قام فيهم خطيباً، ثُمّ قال: يا هل[2228] الشام أنتم تقولون: إنّي قتلتُ الحسين! والله ما قتلتُه، ولا أمرتُ بقتله. ثُمّ ادعا بالذين حزّوا رأس الحسين، فوقفوا بين يديه، وقال لشيت[2229] بن ربعي (لعنه الله): يا ويلك! أنت قتلتَ الحسين أو أمرتُك بقتله؟ فقال: والله ما قتلتُه، بل قتله المصابر بن الذهبيه[2230]. فدعاه يزيد، وقال: يا ويلك! يا مصابر أنت قتلتَ الحسين؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين، بل قتله شمر (لعنه الله). فالتفت إلى شمر (لعنه الله)، وقال: يا ويلك! أنت قتلتَ الحسين أو أنا أمرتُك بقتله؟ فقال: يا أمير المؤمنين لعن الله من قتله. قال: ومَن قتله؟ قال: سنان بن أنس. فقال لسنان: يا ويلك! أنت قتلتَ الحسين؟ فقال: لعن الله مَن قتله. قال: فغضب يزيد (لعنه الله) من كلامهم، وقال: يا ويلكم! يحيل بعضكم على بعض! فقال له قيس بن الربعي[2231]: يا أمير المؤمنين أقول مَن قتل الحسين؟ قال: قل. فقال: ما قتل الحسين إلّا الذي عقد الرايات، وفرّق الأموال، وسيّر الجيوش. قال له: ومَن ذلك يا ويلك؟ قال له: أنت يا أمير المؤمنين. قال فغضب يزيد (لعنه الله) من كلامه، فقام ودخل داره، ووضع الرأس في طشت وغطاه بمنديل ديبقي[2232] أحمر، ووضعه في حجره، ودخل في بيت مظلم، وجعل يلطم على رأسه، ويقول: مالي ومال الحسين بن علي؟! فدخلت عليه زوجتُه هند بنت عبيد الله بن كثير، وقالت له: يا ميشوم! ألا أخبرك بما رايتُ البارحه في منامي؟ قال لها: وما ذاك؟ قالت له: رايتُ كأنّ باباً فُتِح من السماء، والملايكه تنزل كتايب أمام هذه الرّأس، وتنادي: السلام عليك يا عبد الله[2233]، السلام عليك يا بن بنت رسول الله. وإذا سحابة قد نزلت من السما، وفيها رجال كثيره، وفي جملتهم رجل دريّ اللون قمري الوجه، فأقبل يسعى، حتى انكبّ على ثنايا الحسين يقبّلها، وهو يقول: يا ولدي، قتلوك ومن شرب الما منعوك! تراهم ما عرفوك! فلم يرد عليها يزيد شيا[2234] أبداً من ذلك.
81 ـ قال الراوي: فلمّا أصبح الصبح الجميع[2235] حريم رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، وقال لهم: أيّما[2236] أحبّ إليكم المقايم[2237] عندي ولكم الجايزه السنيه، وإلّا[2238] المسير إلى المدينه؟ قال: فاخترن المسير إلى المدينه، إلى حرم رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم). قال: فقدّم إليهن المحامل والهوادج والقباب[2239] وفرشها بأوطا فراش، يكون من الدينقي[2240] والإبرسيم والمُلحَم[2241] وفرغ الأموال على الأنطاع[2242]، وقال لهنّ خذن هذا المال عوضاً عن مصابكم، فقلْنَ له: يا ويلك! ما أقلّ حسابك[2243] أتقتل ساداتنا ثُمّ تعطينا عوضاً عن ذلك؟! لا كان ذلك أبداً[2244]. فحمّلهن من الثياب والذهب والفضة، وأضعف عليهن أضعافاً ممّا أُخِذ منهن[2245].
ثُمّ ادعا بالجمال فأبركها ووطّأها، وادعا بقايد من قوّاده[2246]، وضمّ إليه خمسماية[2247] فارس، وأمره بالمسير إلى المدينه، فسار بهنّ، وأحسن إليهنّ في الصحبه. فلمّا أشرفْن على المدينه، فتجدّدت عليهنّ الأحزان، فشققْن الجيوب، ولطمْن الخدود، ونشرْن الشعور، وساعدتهن نسا المدينه[2248].
82 ـ قال أبو مخنف: والله لقد كان ذلك اليوم أشبه الأيام بيوم مات فيه رسولُ الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم).
قال: وكان الوليد بن عتبه (لعنه الله تعالى) على المنبر، فسمع البكاء والنّحيب، فقال: ما هذا؟ فقيل: هذا صراخ نساء الهاشميات، وأنّهم[2249] قد دخلن المدينه، وذكر الحسين (عليه السلام عليه السلام[2250]) فتحادرت دموعه، ونزل عن المنبر.
ثُمّ إنّ بنات رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) أخذن ما كان أعطاهنّ يزيد (لعنه الله) من المال والثياب، وأعطوه إلى القايد الذي سار معهن، وقلن له: خذ هذا جزا لما فعلتَ معنا؛ فلقت[2251] أحسنتَ لنا الصحبة. فقال: والله لا أملك، بل أعطوني القِرَب؛ فقد أستعين بها، وأنا محتاج إليها لأجل الطريق. فسلّموا إليه القِرَب، وعاد ساير[2252] إلى أن دخل دمشق.
ثُمّ إنّ اُمّ كُلثُوم أقبلت حتى دخلت المسجد، ونادت: السلام عليك يا جدّاه، إنّى ناعيةٌ إليك الحسين×، ثم جعلت تمرّغ خديها على المنبر، وجعلوا الناس يُعزّوها[2253] ثلاثه أيام[2254].
ثُمّ إنّ زين العابدين أقبل على عمِّه محمد بن الحنفيه (رضي الله عنه) فأخبره بقتل أبيه×، وما صُنِع فيه، فبكى حتى غُشِى عليه. ثُمّ ادعى بدرعه فلبسه، وتقلّد بسيفه، وركب جواده، وصعد الجبل. والناس يشاهدونه فانفلق الجبل نصفين، فدخل فيه، وانطبق عليه بقدره الله تعالى[2255].
وأمّا رأس الحسين فإنّه اشتراه خادم ليزيد، وأعاده إلى الجسد، ودُفِن معه بكربلا[2256] صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله تعالى على ظالميهم وغاصبيهم ومانعهم[2257] حقَّهم من الخلافه، ومن شرب الما، وخُلِّدوا في جهنم مع الخالدين الآبدين، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين[2258].
هذا آخر المصرع الشين في قتل الحسين×، ويتلوه أخذ الثار على يد السادة الأخيار إبراهيم والثقفي المختار على التمام والكمال والحمد لله وحده.
· القرآن الكريم
(أ)
1ـ إبصار العين في أنصار الحسين×، الشيخ محمد طاهر السماوي (ت1370هـ)، تحقيق: الشيح محمد جعفر الطبسي، نشر مركز الدراسات الإسلامية لممثلية الولي الفقيه في حرس الثورة الإسلامية في إيران، ط1، 1377ه.ش/1419ه.ق.
2ـ الأبواب (رجال الطوسي)، الشيخ الطوسي (ت460هـ)، تحقيق جواد القيومي الأصفهاني، نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّسين، قم المشرّفة ـ إيران، ط1، 1415هـ.
3ـ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الشافعي (ت840 هـ)، تحقيق أبو عبد الرحمن عادل بن سعد، وأبو إسحاق السيد بن محمود بن إسماعيل، نشر الرشد، الرياض ـ المملكة العربية السعودية، ط1، 1419هـ/1998م.
4ـ الاحتجاج، أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (ت548هـ)، تعليقات وملاحظات السيّد محمد باقر الخرسان، نشر مطابع النعمان، النجف الأشرف.
5ـ الأخبار الطوال، أحمد بن داوود الدينوري (ت276هـ)، تحقيق عبد المنعم عامر، القاهر، نشر دار إحياء الكتب العربي، ط1، 1960م.
6ـ الاختصاص، محمد بن محمد المفيد (ت 413هـ)، صحّحه وعلّق عليه علي أكبر الغفاري، رتّب فهارسه السيّد محمود الزرندي المحرّمي، نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم المقدسة ـ إيران، ط2، 1414هـ/1993م.
7ـ اختيار معرفة الرجال (رجال الكشـي)، الشيخ الطوسي (ت460هـ)، تحقيق وتصحيح وتعليق: مير داماد الأسترآبادي، تحقيق: السيّد مهدي الرجائي، نشر مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم ـ إيران، 1404هـ.
8ـ الأخلاق الحسينية، جعفر البياتي (معاصر)، منشورات أنوار الهدى، قم ـ إيران ط1، 1418هـ.
9ـ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، محمد بن محمد بن النعمان المفيد (ت413هـ)، تحقيق مؤسسة آل البيت^ لتحقيق التراث، نشر دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، ط2، 1414هـ/1993م.
10ـ أساس البلاغة، جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت538هـ)، نشر دار ومطابع الشعب، القاهرة ـ مصر،1960م.
11ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّ (ت463هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي، نشر دار الجيل، بيروت ـ لبنان، ط1، 1412هـ/1992م.
12ـ أُسد الغابة في معرفة الصحابة، علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير (ت630هـ)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان.
13ـ الإصابة في تميز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، نشـر دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط1، 1415هـ.
14ـ أطلس الحسين، عباس الربيعي (معاصر، نشر هيئة تراث الشهيد الصدر، بغداد ـ العراق)، ط1، 1432هـ/2010م.
15ـ إعلام الورى بأعلام الهدى، الشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي، (ت548هـ)، تحقيق مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، نشـر مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم المشرَّفة ـ إيران، ط1، 1417هـ.
16ـ الأعلام، خير الدين الزركلي (ت1410هـ)، نشـر دار العلم للملايين، ط5، 1980م.
17ـ أعيان الشيعة، السيّد محسن بن عبد الكريم الأمين (ت1371هـ)، تحقيق وتخريج: حسن الأمين، نشر دار التعارف للمطبوعات، بيروت ـ لبنان.
18ـ الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني (ت356هـ)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان.
19ـ إقبال الأعمال مضمار السبق في ميدان الصدق، السيّد رضي الدين علي بن موسى جعفر بن طاووس(ت644هـ)، تحقيق: جواد القيومي الأصفهاني، نشـر مكتب الإعلام الإسلامي، طبع مطابع، مكتب الإعلام الإسلامي، ط1، 1414ه.
20ـ إكسير العبادات في أسرار الشهادات، آغا بن عابد الشيرواني الحائري المعروف بالفاضل الدربندي(ت1285هـ)، تحقيق محمد جمعة بادي وعباس ملا عطية الجمري، منشورات ذوي القربى، قم ـ ايران.
21ـ إكسير العبادات في أسرار الشهادات، آغا بن عابد الشيرواني الحائري المعروف بالفاضل الدربندي (ت1285هـ)، تحقيق محمد جمعة بادي وعباس ملا عطية الجمري، دار الصفوة، بيروت ـ لبنان، ط1، 1429هـ ـ 2009م.
22ـ إكمال الكمال، ابن ماكولا(ت 475هـ) نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان.
23ـ أمالي ابن سمعون الواعظ، أبو الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس البغدادي (ت387)، دار البشائر الإسلامية، بيروت ـ لبنان، ط1، 1433هـ.
24ـ الأمالي الخميسية (الشجرية)، يحيى بن الحسين الشجري الجرجاني (ت499هـ)، رتّبها: القاضي محيي الدين محمد بن أحمد القرشي العبشمي (ت610هـ)، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل، نشر دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط1، 1422هـ/2001 م.
25ـ الأمالي، أبو القاسم علي بن الحسين الشريف المرتضى (ت436هـ)، تحقيق تصحيح وتعليق: السيّد محمد بدر الدين النعساني الحلبي، نشر منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم ـ إيران، ط1، 1325هـ/ 1907م.
26ـ الأمالي، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت460هـ)، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة للطباعة والنشـر والتوزيع، نشـر دار الثقافة ـ قم ـ إيران، ط1، 1414ه.
27ـ الأمالي، محمد بن علي بن الحسين الصدوق (ت381هـ)، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة، نشـر مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة، طهران ـ إيران، ط1، 1417ه.
28ـ الإمام الحسن× في مواجهة الانشقاق الأموي، سامي البدري (معاصر)، دار الفقه للطباعة والنشر، قم المشرَّفة ـ إيران، ط1، 1433هـ/2012م.
29ـ الإمام الصادق×، الشيخ محمد حسن المظفر (ت1375هـ)، نشر دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان)، ط3، 1397هـ. ش/1978م.
30ـ إمتاع الأسماع بما للنبيّ’ من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي (ت 845ه)، تحقيق وتعليق: محمد عبد الحميد النميسي، منشورات محمد علي بيضون ـ دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط1، 1420هـ ـ 1999م.
31ـ أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى (البلاذريّ)، (ت 279هـ)، (الجزء الأول)، تحقيق: الدكتور محمد حميد الله، دار المعارف بمصر، (الجزء الثاني والثالث منه) تحقيق: محمد باقر المحموديّ، ط1، 1394هـ/1974م، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. والثالث، دار التعارف، ط1، 1397هـ/1977م. (الجزء الخامس منه) تحقيق: إحسان عبّاس، جمعية المستشرقين الألمانية، سنة 1400هـ/1979م، (الجزء السادس منه) لم يثبت عليه هوية المعلومات. (الجزء السابع والثامن منه) تحقيق الدكتور سهيل زكار، الدكتور رياض زركلي، ط1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان. (الجزء الثاني عشر منه) تحقيق وتقديم: سهيل زكّار ورياض زركلي، ط1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان.
32ـ الأنساب، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (ت562ه)، تقديم وتعليق: عبد الله عمر البارودي، نشـر دار الجنان، بيروت ـ لبنان، ط1، 1408ه/1988م.
33ـ أنصار الحسين، محمد مهدي شمس الدين (ت2001م)، نشر الدار الإسلامية، ط2، 1401هـ/1981م.
(ب)
34ـ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، الشيخ محمد باقر المجلسي (ت1111هـ)، نشر مؤسسة الوفاء، بيروت ـ لبنان، ط2، 1403ه /1983م.
35ـ البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت774هـ)، تحقيق علي شيري، نشـر دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، ط1، 1408ه/1988م.
36ـ بشارة المصطفى’ لشيعة المرتضى× عماد الدين أبي جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري (ت 525هـ)، تحقيق: جواد القيومي الأصفهاني، نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرَّفة ـ إيران، ط1، 1420ه.
37ـ بغية الطلب في تاريخ حلب، عمر بن أحمد العقيلي الحلبي المعروف بابن العديم (ت 660هـ) حقّقه وقدّم له: الدكتور سهيل زكار، دمشق، مؤسسة البلاغ، بيروت ـ لبنان، 1408هـ/1988م.
38ـ البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي الجاحظ (ت255هـ)، حقّقه وقدّم له المحامي فوزي عطوي، نشـر المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط1، 1345هـ/1926م.
(ت)
39ـ تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضـى الزبيدي (ت1205هـ)، تحقيق علي شيري، نشـر دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، 1994م/ 1414ه.
40ـ تاج المواليد في مواليد الأئمّة ووفياتهم، الشيخ أحمد بن علي الطبرسي (ت548هـ)، نشر مكتبة آية الله المرعشي، قم المقدّسة ـ إيران.
41ـ تاريخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون (ت 808هـ)، نشـر دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، ط4.
42ـ تاريخ ابن معين ، يحيى بن معين (233هـ)، تحقيق: الدكتور أحمد محمد نور سيف، دار المأمون للتراث، دمشق ـ سوريا.
43ـ تاريخ أبي زرعة الدمشقي، عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري المشهور بأبي زرعة الدمشقي (ت 281 هـ) رواية: أبي الميمون بن راشد، تحقيق ودراسة شكر الله نعمة الله القوجاني، نشر مجمع اللغة العربية، دمشق ـ سوريا.
44ـ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، محمد بن أحمد الذهبي (ت748هـ)، تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، ط2، 1409ه/1998م.
45ـ تاريخ الأُمم والملوك، محمد بن جرير الطبري (ت310 هـ)، قوبلت هذه الطبعة على النسخة المطبوعة بمطبعة (بريل) بمدينة ليدن في سنة 1879م، راجعه وصحّحه وضبطه نخبة من العلماء الأجلّاء.
46ـ تاريخ الخلفاء، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ)، تحقيق لجنة من الأدباء، نشر دار التعاون، مكّة المكرّمة ـ السعودية.
47ـ التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري، (ت256هـ)، نشر المكتبة الإسلامية، ديار بكر ـ تركيا.
48ـ تاريخ الكوفة، السيد البراقي (ت1332هـ)، تحقيق ماجد أحمد العطية، استدراكات السيد محمد صادق آل بحر العلوم المتوفي 1399ه، انتشارات المكتبة الحيدرية، ط1، 1424هـ.ق/1382هـ.ش.
49ـ تاريخ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب المعروف باليعقوبي (ت284هـ)، دار صادر، بيروت ـ لبنان.
50ـ تاريخ خليفة بن خياط العصفري (ت240ه)، تحقيق وتقديم الأستاذ الدكتور سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان.
51ـ تاريخ مدينة دمشق، علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر (ت571هـ)، تحقيق علي شيري، دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، 1415ه /1995م.
52ـ تجارب الأُمم، أحمد بن محمد مسكويه الرازي (ت421هـ)، تحقيق الدكتور أبو القاسم إمامي، دار سروش للطباعة والنشر، ط2، 1422/2001م.
53ـ تذكرة الخواص، سبط بن الجوزي (ت 654هـ)، تقديم العلامة الكبير السيد محمد صادق بحر العلوم، إصدار مكتبة نينوى الحديثة، طهران ـ إيران. ونشر دار العلوم للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان، ط1، 1425هـ/2004م.
54ـ ترتيب الأمالي الخميسية للشجري، يحيى بن الحسين بن إسماعيل بن زيد الحسني الشجري الجرجاني (المتوفى ٤٩٩ هـ)، رتّبها: القاضي محيي الدين محمد بن أحمد القرشي العبشمي (ت٦١٠هـ)، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط1، ١٤٢٢ هـ/٢٠٠١م.
55ـ ترجمة الإمام الحسين× (من طبقات ابن سعد)، محمد بن سعد (ت230هـ)، مخطوط، تهذيب وتحقيق السيّد عبد العزيز الطباطبائي، الهدف للإعلام والنشر، ط1.
56ـ ترجمة ريحانة رسول الله| الإمام الحسين× من تاريخ مدينة دمشق، علي بن الحسن المعروف بابن عساكر (ت571هـ)، تحقيق محمد باقر المحمودي، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، قم ـ إيران، ط2، 1414ه.
57ـ تسمية مَن قتل مع الحسين بن علي÷ (المطبوع ضمن موسوعة المقاتل الحسينية)، تحقيق: لجنة التحقيق في مؤسسة وارث الأنبياء، مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية، النجف ـ العراق، ط1، 1441هـ/2019م.
58ـ تظلم الزهراء‘ من إهراق دماء آل العباء، الشهيد رضي بن نبي القزويني (من أعلام القرن الثاني عشر)، تحقيق مهدي الرجائي، انتشارات الشريف الرضي، قم ـ إيران، ط1، 1417هـ/1996م.
59ـ التعديل والتجريح، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي المالكي (ت474هـ)، تحقيق الأُستاذ أحمد البزار، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مراكش ـ المغرب.
60ـ تفسير القمّي، علي بن إبراهيم القمّي (ت326هـ)، صحّحه وعلّق عليه وقدّم له طيب الموسوي الجزائري، مؤسّسة دار الكتاب للطباعة والنشـر، قم ـ إيران، ط3، 1404هـ.
61ـ تفسير يحيى بن سلام، يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة، البصري ثم الإفريقي القيرواني (ت ٢٠٠هـ)، تقديم وتحقيق: الدكتورة هند شلبي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط1، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م.
62ـ تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، نشـر دار المكتبة العلمية، بيروت ـ لبنان، ط2، 1415ه/1995م.
63ـ تكملة أمل الآمل، السيد حسن الصدر، (ت1354هـ)، تحقيق السيد أحمد الحسيني، نشر مكتبة آية الله المرعشي، قم ـ إيران، 1406هـ.
64ـ التنبيه والإشراف، علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت346هـ)، دار صعب، بيروت ـ لبنان.
65ـ تنزيه الأنبياء^، الشريف المرتضى(ت436هـ)، دار الأضواء، بيروت ـ لبنان، ط2، 1409/1989م.
66ـ تنقيح المقال، عبد الله المامقاني، تحقيق واستدراك: محي الدين المامقاني، مؤسّسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم ـ إيران، 1428 هـ.
67ـ تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي(ت460هـ)، تحقيق وتعليق السيد حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلامية، طهران ـ إيران، ط3، 1364هـ.ش.
68ـ تهذيب التهذيب، شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، ط1، 1404هـ/1984م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان.
69ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال، جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي (ت742هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، ط4، 1406هـ/1985م.
(ث)
70ـ الثقات، محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم (ت354هـ)، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن الهند، ط1، 1393ه/1973م.
71ـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، الشيخ محمد بن علي الصدوق (ت381 هـ)، منشورات الرضى، قم ـ إيران، ط2، 1368ه.ش.
(ج)
72ـ الجرح والتعديل، الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي (ت 327هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، ط1، 1271ه /1952م.
73ـ الجمل، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالمفيد (ت413هـ)، مكتبة الداوري، قم ـ إيران.
74ـ جمهرة الأمثال، أبو هلال العسكري (ت395هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، عبد المجيد قطامش، دار الجيل، بيروت ـ لبنان، ط2، صفر 1384هـ/يونيه 1964م.
75ـ جمهرة أنساب العرب، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت456هـ)، تحقيق لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط1، 1403هـ/1983م.
76ـ جُنة الأمان الواقية وجَنة الإيمان الباقية، المشتهر بالمصباح، الشيخ إبراهيم بن علي الحسن بن محمد بن صالح العاملي الكفعمي (ت 905هـ)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، ط3، 1403هـ/1983م.
77ـ جهاد الإمام السجاد، محمد رضا الحسيني الجلالي (معاصر)، نشر: دار الحديث، ط1.
78ـ جواهر التاريخ، علي الكوراني العاملي (معاصر)، نشر باقيات، قم المشرّفة ـ إيران، ط1، 1430هـ.
79ـ الجوهرة في نسب الإمام علي وآله، محمد بن أبي بكر الأنصاري التاهساني المعروف بالبري (ت 645هـ)، تحقيق د. محمد التونجي، مكتبة النوري، دمشق ـ سوريا، ط1، 1402هـ.
(ح)
80ـ الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة، عبد الرزاق بن أحمد الشيباني البغدادي المعروف بابن الفوطي (ت723هـ)، تحقيق: مهدي النجم، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط1، 1424هـ/2003م.
81ـ حياة الإمام الحسين بن علي÷، باقر شريف القرشي، (1433هـ)، مطبعة الآداب، النجف الأشرف ـ العراق، ط1، 1398ه/1974م.
82ـ حياة الحيوان الكبرى، كمال الدين دميري (808 ه)، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط2، 1424هـ.
83ـ معالي السبطين، محمد مهدي الحائري (1358هـ)، المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف ـ العراق، ط1، 1432هـ/2011م.
(خ)
84ـ خاتمة المستدرك، ميرزا حسين النوري الطبرسي(ت 1320هـ)، تحقيق: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، نشر مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم ـ إيران، ط1، 1415هـ.
85ـ الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي (ت 573هـ)، تحقيق: مؤسّسة الإمام المهدي، مؤسّسة الإمام المهدي، قم المقدّسة ـ إيران، ط1، 1409هـ.
86ـ خزانة الأدب، عبد القادر بن عمر البغدادي (ت1093هـ)، تحقيق: محمد نبيل طريفي، وإميل بديع اليعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط1، 1998م.
87ـ الخصال، الشيخ الصدوق (ت381هـ)، تحقيق وتصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشـر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم المشرَّفة ـ إيران، 1403هـ/1362ش.
88ـ خلاصة الأقوال، أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي المعروف بالعلّامة الحلي (ت726هـ)، تحقيق الشيخ جواد القيومي، مؤسسة نشر الفقاهة، قم ـ إيران، ط1، 1417هـ.
(د)
89ـ دائرة المعارف الحسينية، محمد صادق الكرباسي (معاصر)، نشر المركز الحسيني للدراسات، لندن ـ المملكة المتحدة، ط1، 1432هـ 2011م.
90ـ الدرّ النظيم، يوسف بن حاتم الشامي المشغري العاملي (ت664هـ)، نشـر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّسين، قم المشرَّفة ـ إيران.
91ـ درب زبيدة، الدكتور سعد عبد العزيز سعد الراشد (معاصر)، نشر دار الوطن للنشر والإعلام، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط1، 1414هـ/1993م.
92ـ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة، السيد علي خان المدني الشيرازي (1120هـ)، تحقيق وتقديم : السيد محمد صادق بحر العلوم، منشورات مكتبة بصيرتي ـ قم ـ إيران، 1397هـ.
93ـ دلائل الإمامة، محمد بن جرير الطبري (الشيعي)، (من أعلام القرن الرابع)، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية مؤسّسة البعثة، مؤسّسة البعثة، قم المقدّسة ـ إيران، ط1، 1413هـ.
(ذ)
94ـ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، أحمد بن عبد الله الطبري (ت694هـ)، نشر مكتبة القدسي، القاهرة ـ مصر، 1356هـ.
95ـ ذوب النضار، جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله المعروف بابن نما الحلي (ت645هـ)، تحقيق فارس حسون كريم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّسين، قم المشرَّفة ـ إيران، ط1، 1416هـ.
(ر)
96ـ رجال الشيعة في أسانيد السنة، محمد جعفر الطبسي(معاصر)، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم ـ ايران، ط1، 1420ه.
97ـ رحلة ابن بطوطة، محمد بن عبد الله المعروف بابن بطوطة، (ت 779هـ)، دار التراث، بيروت ـ لبنان، 1388هـ/1968م.
98ـ رحلة بنيامين التطيلي، الرابي بنيامين بن الرابي يونة التطيلي النباري الإسباني اليهودي (ت ٥٦٩هـ)، المجمع الثقافي، أبو ظبي ـ الإمارات، ط1، 2002م.
99ـ رسائل الشريف المرتضى، الشريف المرتضى (ت436هـ)، تقديم السيد أحمد الحسيني، دار القرآن الكريم، قم ـ إيران، 1405 هـ.
100ـ روضة الواعظين، محمد بن الفتال النيسابوري (ت508هـ)، قدّم له العلّامة الجليل السيّد محمد مهدى السيد حسن الخرسان، منشورات الشريف الرضي، قم ـ إيران.
101ـ الرياض النضرة في مناقب العشرة، أبو جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبري(ت694هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
(ز)
102ـ الزاهر في معاني كلمات الناس، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ابن الأنباري (328هـ)، تحقيق: الدكتور يحيى مراد، منشورات محمد علي بيضون ـ دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط1، 1424هـ ـ 2004م.
103ـ زهر الآداب وثمر الألباب، إبراهيم بن علي الحصـري القيرواني (ت453هـ)، تحقيق مفصّل ومضبوط ومشروح بقلم: المرحوم د. زكي مبارك، حقّقه وزاد في تفصيله وضبطه وشرحه محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة المحتسب، عَمّان ـ الأردن، ط4، 1972م.
104ـ الزهرة، محمد بن داود بن علي بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي الظاهري (ت 297 هـ)، طُبِع ما وجد من الكتاب لأول مرة برعاية المعهد الشرقي في جامعة شيكاغو، سنة 1932م وبعناية د. لويس نيكل والشاعر إبراهيم طوقان. وكانت نسخة كاملة من الكتاب قد تملكها الأب أنستانس الكرملي قبل الحرب العالمية الأولى.
105ـ زينب الكبرى من المهد إلى اللحد، محمد كاظم القزويني (1994م)، تحقيق السيد مصطفى القزويني، دار الغدير، قم ـ إيران.
(س)
106ـ سلسلة القبائل العربية في العراق ـ قبيلة تغلب، علي الكوراني العاملي وعبد الهادي الربيعي (معاصران)، ط1، 1431هـ/2010م.
107ـ سلسلة القبائل العربية في العراق ـ قبيلة حمير القحطانية، الشيخ علي الكوراني العاملي وعبد الهادي الربيعي، ط1، 1431هـ/2010م.
108ـ سؤالات الآجري لأبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني (275هـ)، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة دار الاستقامة، السعودية، ومؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، ط1، 1418/1997م.
109ـ سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت748هـ)، تحقيق شعيب الأرنؤوط، نشـر مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، ط9، 1413هـ/1993م.
(ش)
110ـ الشافي في الإمامة، الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي+(ت436ه)، حقّقه وعلّق عليه السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب، راجعه السيد فاضل الميلاني، مؤسسة الصادق×، طهران ـ إيران، ط2، 1410هـ.
111ـ شرح إحقاق الحق، السيد شهاب الدين المرعشي، (ت 1411هـ)، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم ـ ايران.
112ـ شرح أصول الكافي، مولي محمد صالح المازندراني (ت1081هـ)، تحقيق: الميرزا أبو الحسن الشعراني، ضبط وتصحيح: السيد علي عاشور، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، ط1، 1421هـ/2000م.
113ـ شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار، القاضي النعمان بن محمد المغربي (ت363هـ)، تحقيق السيّد محمد الحسيني الجلالي، نشـر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّسين، قم المشرّفة ـ إيران، ط2، 1414هـ.
114ـ شرح شافية أبي فراس في مناقب آل الرسول ومثالب بني العباس، محمد بن أمير الحاج الحسيني (ت1180هـ)، تحقيق: صفاء الدين البصري، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران ـ إيران، ط1، 1416هـ.
115ـ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد (ت656هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ـ مصر، 1378هـ/1959م.
116ـ شرف المصطفى، عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي، (ت: 407 هـ)، دار البشائر الإسلامية، مكة ـ المملكة العربية السعودية، ط1، 1424 ه.
117ـ الشـريعة، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُري البغدادي (ت360هـ)، تحقيق: د. عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن، الرياض ـ السعودية، ط2، 1420ه/ 1999م.
118ـ
شعب المقال في درجات الرجال، ميرزا أبو القاسم
النراقي
(ت 1319هـ)، تحقيق: الشيخ محسن الأحمدي، مؤتمر المحقق النراقي، ط2، 1422هـ.
119ـ الشعر والشعراء، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي المعروف بابن قتيبة الدينوري (ت 276هـ)، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة ـ مصر، 1427هـ/ 2006 م.
120ـ شهداء أهل البيت^، حسين الشاكري (1430هـ)، ط1، 1420هـ.
(ص)
121ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري (ت393هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، القاهرة، نشر دار العلم للملايين، بيروت ـ لبنان ط1، 1376ه/1956م. ط4، 1407هـ/ 1987م.
122ـ صحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، 1401ه/1981م،.
123ـ الصحيح من سيرة النبي الأعظم’، السيد جعفر مرتضى العاملي (1441هـ)، دار الحديث للطباعة والنشر، قم ـ إيران ، ط1، 1426هـ/ 1385ش.
124ـ صلح الحسن×، الشيخ راضي آل ياسين (1372هـ)، تحقيق: عبد الصاحب الموسوي الهاشمي، المكتبة الحيدرية، قم ـ إيران، ط1، 1393هـ.
125ـ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، أحمد بن حجر الهيثمي المكي (ت974هـ)، خرّج أحاديثه وعلّق حواشيه وقدّم له عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة القاهرة، القاهرة ـ مصر ، ط2، 1385هـ/1965م.
(ط)
126ـ الطبقات الكبرى، محمد بن سعد (ت230هـ)، دار صادر، بيروت ـ لبنان.
127ـ طبقات خليفة، خليفة بن خياط العصفري (ت240هـ)، تحقيق د. سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، 1414هـ/ 1993م.
128ـ طوعة في التاريخ، كريم جهاد الحسّاني، نشر مسجد الكوفة والمزارات الملحقة به، الكوفة ـ العراق، ط1، 1434هـ/2013م.
(ع)
129ـ العقد الفريد، ابن عبد ربه (ت 328هـ)، طبع دار الكتاب العربي.
130ـ علل الشرائع، محمد بن علي الصدوق (ت381هـ)، تحقيق وتقديم السيّد محمد صادق بحر العلوم، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها، النجف الأشرف ـ العراق، 1385هـ/1966م.
131ـ عليّ الأكبر×، عبد الرزاق المقرّم، انتشارات المكتبة الحيدرية، قم ـ إيران.
132ـ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، أحمد بن علي الحسيني، المعروف بابن عنبة (828هـ)، تحقيق وتصحيح: محمد حسن آل الطالقاني، منشورات المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف ـ العراق، ط2، 1380هـ/1961م.
133ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، محمود بن أحمد العيني (ت 855هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان.
134ـ العمدة في محاسن الشعر وآدابه، الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي (ت463 هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت ـ لبنان، ط5، 1401 ه/1981م.
135ـ العوالم، الإمام الحسين×، الشيخ عبد الله البحراني (ت 1130هـ)، تحقيق مدرسة الإمام المهدي×، مدرسة الإمام المهدي# بالحوزة العلمية، قم المقدسة ـ إيران، ط1، 1407هـ.ق/1365هـ.ش.
136ـ عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور الأحسائي (ت880هـ)، قدّم له السيد شهاب الدين النجفي المرعشي&، تحقيق الحاج آقا مجتبى العراقي، قم ـ إيران، ط1، 1403هـ/1983م.
137ـ عين العبرة في غبن العترة، السيد أحمد آل طاووس (ت677هـ)، منشورات الشهاب، قم ـ ايران.
138ـ العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت175هـ)، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي، مؤسسة دار الهجرة، قم المشرّفة ـ إيران، ط2، 1409ه.
139ـ عيون الأخبار، ابن قتيبة الدينوري (ت276هـ)، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط3، 1424هـ/ 2003م.
(غ)
140ـ الغارات، إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي (ت283هـ)، تحقيق: السيّد جلال الدين المحدّث، أفسيت في مطابع بهمن.
141ـ الغدير في الكتاب والسنّة والأدب، الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي (ت1392هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، ط4، 1397هـ/1977م.
(ف)
142ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، نشر دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان، ط2.
143ـ فتوح البلدان، أحمد بن يحيى بن جابر المعروف بالبلاذري (ت279هـ)، تحقيق صلاح الدين المنجد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ـ مصر، 1956م.
144ـ الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي (ت314هـ)، تحقيق: على شيري، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، ط1، 1411ه/1991م.
145ـ فرسان الهيجاء في تراجم أصحاب سيّد الشّهداء×، ذبيح الله المحلاتيّ (ت1405هـ)، تحقيق وتعريب: محمد شعاع فاخر، المكتبة الحيدرية، قم المقدسة ـ إيران، ط1، 1428.
146ـ الفروق اللغوية أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري (395هـ)، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المشرّفة ـ إيران، ط1، شوال المكرم 1412هـ.
147ـ الفِصَل في الملل والأهواء والنحل، علي بن أحمد بن حزم (ت 456هـ)، دار الصادر، بيروت ـ لبنان، ط1، 1320هـ.
148ـ الفصول المختارة، محمد بن محمد بن النعمان المفيد (ت 413هـ)، تحقيق: السيد نور الدين جعفريان الأصبهاني، الشيخ يعقوب الجعفري، الشيخ محسن الأحمدي، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، ط2، 1414هـ/1993م.
149ـ الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة، عليّ بن محمّد بن أحمد المالكي المكّي المعروف بابن الصباغ (ت855هـ)، تحقيق: سامي الغريري، مؤسسة دار الحديث الثقافيّة، قم ـ إيران، ط1، 1422هـ.
150ـ فلاح السائل، السيد ابن طاووس (ت664هـ)، بدون معلومات اضافية.
151ـ الفهرست، شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 460هـ)، تحقيق: الشيخ جواد القيومي، مؤسسة نشر الفقاهة، قم ـ إيران، ط1، شعبان المعظم 1417هـ.
152ـ فوات الوفيات، محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي (ت764هـ)، تحقيق علي محمد بن يعوض الله/عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنا ن، ط1، 2000 م.
153ـ الفوائد الرجالية، السيّد مهدي بحر العلوم (ت1212هـ)، حقّقه وعلّقه عليه محمد صادق بحر العلوم، وحسين بحر العلوم ، مكتبة العلمين الطوسي وبحر العلوم، النجف الأشرف ـ العراق، ط1، 1363هـ.ش.
154ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، محمد عبد الرؤوف المناوي (ت1031هـ)، ضبطه وصحّحه: أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط1، 1415ه/1994م.
(ق)
155ـ قادتنا كيف نعرفهم؟، السيد محمد هادي الميلاني (ت 1395هـ)، تحقيق وتعليق: السيد محمد علي الميلاني، مراجعة وإشراف: السيد علي الحسينى الميلاني، قم ـ إيران، ط1، 1426هـ.
156ـ قاموس الرجال، الشيخ محمد تقي التستري (1415هـ ـ 1995م)، تحقيق: مؤسسة النشـر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّسين، قم المشرّفة ـ إيران، ط1، 1422هـ.
157ـ القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي مجد الدين (ت817هـ).
158ـ قرب الإسناد، عبد الله بن جعفر الحميري (ت 304هـ)، تحقيق مؤسسة آل البيت× لإحياء التراث، مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم ـ إيران، ط1، 1413هـ.
(ك)
159ـ الكافي، محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني (ت 328/329 هـ)، صحّحه وقابله وعلّق عليه: علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران ـ إيران، ط2، 1389ه.
160ـ كامل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه (ت367هـ)، تحقيق: الشيخ جواد القيومي، لجنة التحقيق، مؤسسة النشـر الإسلامي، مؤسسة نشر الفقاهة، قم ـ إيران، ط1، 1417هـ.
161ـ الكامل في التاريخ، علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير (ت630هـ)، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان، 1385ه /1965م.
162ـ كتاب سليم بن قيس، سليم بن قيس الهلالي الكوفي (ت القرن الأول)، تحقيق: محمد باقر الأنصاري الزنجاني ، انتشارات دليل ما، قم ـ إيران، ط1، 1422هـ.ق/1380هـ.ش.
163ـ كشف الغمة في معرفة الأئمّة، علي بن أبي الفتح الإربلي (ت693هـ) ، دار الأضواء، بيروت ـ لبنان، ط2، 1405هـ/1985م.
164ـ كفاية الأثر في النصّ على الأئمّة الاثني عشر، علي بن محمد بن علي الخزاز القمّي الرازي (من أعلام القرن الرابع)، حقّقه العلم الحجّة السيّد عبد اللطيف الحسيني الكوه كمري الخوئي بيدار، قم المقدّسة ـ إيران، 1401هـ.
165ـ كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ محمد بن علي الصدوق (ت381 هـ)، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدّرسين، قم المقدّسة ـ إيران، 1405هـ.ق/1363ش.
166ـ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري (ت975هـ)، ضبطه وفسّر غريبه وصحّحه ووضع فهارسه ومفتاحه: الشيخ صفوة السفا، مؤسّسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، 1409ه/ 1989م.
167ـ كنوز الذهب في تاريخ حلب، أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل العجمي (ت 884 هـ)، دار القلم، حلب ـ سوريا، ط1، 1417هـ.
168ـ الكنى والألقاب، الشيخ عباس القمي (ت1359هـ)، مكتبة الصدر، طهران ـ إيران.
(ل)
169ـ لبّ اللباب في تحرير الأنساب، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت911هـ)، دار صادر. بيروت ـ لبنان.
170ـ لباب الأنساب والألقاب والأعقاب، علي بن أبي القاسم بن زيد البيهقي الشهير بابن فندمة (ت565هـ)، تحقيق مهدي الرجائي، ومحمود المرعشـي، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي الكبرى، قم ـ إيران، ط2، 2007م.
171ـ اللباب في تهذيب الأنساب، علي بن أبي الكرم (ابن الأثير) (ت630هـ)، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت ـ لبنان.
172ـ لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور المصـري (ت711هـ)، أدب الحوزة، قم ـ إيران ، 1405ه/1363ش.
173ـ لسان الميزان، شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852هـ)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، ط2، 1971م/1390ه.
174ـ لواعج الأشجان في مقتل الحسين×، السيِّد محسن الأمين العاملي (ت1371هـ)، مكتبة بصيرتي، قم المشرَّفة ـ إيران، 1331هـ.
175ـ لؤلؤة البحرين، يوسف بن أحمد البحراني (ت 1186هـ)، تحقيق السيّد محمّد صادق بحر العلوم، مكتبة فخراوي، المنامة ـ البحرين، ط1، 1429هـ/2008م.
(م)
176ـ الإمام المهدي×، السيد علي الحسيني الميلاني (معاصر) ، مركز الأبحاث العقائدية، قم ـ إيران، ط1، 1420هـ.
177ـ مثير الأحزان، نجم الدين محمد بن جعفر المعروف بابن نما الحلي (ت645هـ)، منشورات المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف ـ العراق، 1369ه/1950م.
178ـ المجازات النبوية، محمد بن الحسين المعروف بالشريف الرضي (406هـ)، تحقيق: طه محمد الزيتي، منشورات مكتبة بصيرتي، قم ـ إيران.
179ـ المجدي في أنساب الطالبيين، النسابة علي بن أبي الغنائم العمري الشهير بابن الصوفي (ت 709هـ)، تحقيق: الشيخ أحمد المهدوي الدامغاني، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة، قم المقدسة ـ إيران، ط1، 1409هـ.
180ـ مجمع الأمثال، حمد بن محمد النيسابوري المعروف بالميداني (ت518هـ)، مؤسّسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضوية المقدّسة، مشهد المقدسة ـ إيران، 1366هـ.ش.
181ـ مجمع البحرين، الشيخ فخر الدين الطريحي (ت 1085هـ)، تحقيق السيّد أحمد الحسيني ، انتشارات مرتضوي، طهران ـ إيران، ط2، 1362 هـ ش.
182ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت807هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان ، 1408ه/1988م.
183ـ المجموع (شرح المهذب)، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت676ه)، دار الفكر، بيروت ـ لبنان.
184ـ المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقي(ت274هـ)، تحقيق السيد جلال الدين الحسيني (المحدث)، دار الكتب الإسلامية، طهران ـ إيران، 1370هـ/1330ش.
185ـ المحبر، محمد بن حبيب البغدادي، (ت 245هـ)، مطبعة الدائرة، حيدر آباد، شهر ذي القعدة 1361هـ.
186ـ المحن، أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي المغربي الأفريقي (ت333هـ)، تحقيق د. عمر سليمان العقيلي، دار العلوم، الرياض ـ السعودية ، ط1، 1404هـ/1984م.
187ـ مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي (ت721هـ)، تحقيق وضبط وتصحيح أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط1، 1415هـ/1994م.
188ـ المختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي الفداء)، عماد الدين إسماعيل أبو الفدا (ت732هـ)، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان.
189ـ المخصص، ابن سيده (ت458هـ)، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان.
190ـ مدينة المعاجز، السيّد هاشم البحراني (ت1107هـ)، تحقيق: الشيخ عزة الله المولائي الهمداني، مؤسّسة المعارف الإسلامية، قم ـ إيران، ط1، 1413هـ.
191ـ مراصد الاطّلاع على أسماء الأمكنة البقاع، عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي صفي الدين (ت 739هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، نشر الحلبي، تصوير دار المعرفة، 1373هـ.ش/1954م.
192ـ مرقد الإمام الحسين× عبر التاريخ، السيد تحسين آل شبيب الموسوي (معاصر)، مؤسّسة الفقه للطباعة والنشر، قم ـ إيران، ط1، 1421ه.
193ـ مروج الذّهب ومعادن الجوهر، علي بن الحسين بن علي (ت 346هـ)، دققها ووضعها وضبطها: الأستاذ يوسف أسعد داغر أمين، دار الكتب اللبنانية سابقاً، بيروت ـ لبنان، ط1، 1385هـ/1965م. ودار الهجرة، قم ـ إيران، ط2، 1404هـ/1363ش/1984م.
194ـ المزار، محمد بن جعفر المشهدي (من أعلام القرن السادس)، تحقيق: جواد القيومي الأصفهاني، مؤسسة النشر الإسلامي، نشر القيوم، قم ـ إيران، ط1، 1419هـ.
195ـ مستدرك سفينة البحار علي النمازي الشاهرودي (ت 1405 ه)، تحقيق وتصحيح: حسن بن علي النمازي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المشرفة ـ إيران، ط 3، 1418هـ.
196ـ المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ المعروف بالحاكم النيسابوري (ت405هـ)، طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث الشريفة بإشراف: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان.
197ـ المستدرك على الصحيحين، الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بالحاكم النيسابوري (ت405هـ)، (تعليق: الذهبي)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط1، 1411هـ/1990م.
198ـ مستدركات أعيان الشيعة، حسن الأمين (ت 1399هـ)، نشر دار التعارف للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، ط1، 1408هـ/1987م.
199ـ مستدركات علم رجال الحديث، الشيخ علي النمازي الشاهرودي (ت1405هـ)، ابن المؤلف، على نفقة حسينيّة عماد زاده، أصفهان ـ إيران، ط1، 1412ه.
200ـ المستقصى في أمثال العرب، محمود بن عمرو الزمخشري (ت538 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط2، 1987 م.
201ـ مسند أحمد، أحمد بن حنبل (ت241هـ)، دار صادر، بيروت ـ لبنان.
202ـ مسند زيد بن علي، زيد بن علي (ت122هـ)، دار مكتبة الحياة، بيروت ـ لبنان.
203ـ مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار، محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (ت354هـ)، حقّقه ووثّقه وعلّق عليه: مرزوق على إبراهيم، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة ـ مصر، ط1، 1411ه /1991م.
204ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد المقري الفيومي (ت770 هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان.
205ـ المصطلحات، إعداد مركز المعجم الفقهي.
206ـ مطالب السؤول في مناقب آل الرسول’، محمد بن طلحة الشافعي (ت652هـ)، تحقيق: ماجد بن أحمد العطية.
207ـ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن بن أحمد التويجري، نشر دار العاصمة، دار الغيث، الرياض ـ السعودية، ط1، 1419ه/1998م.
208ـ مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة، نجم الدين الطبسي (معاصر)، مركز الدراسات الإسلامية، قم ـ إيران ، ط3، 1428هـ.
209ـ معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول، محمد بن يوسف الزرندي(ت750 ه)، تحقيق: ماجد بن أحمد العطية، بدون معلومات إضافية.
210ـ المعارف، ابن قتيبة الدينوري (ت276هـ)، تحقيق دكتور ثروت عكاشة، دار المعارف، القاهرة ـ مصر، ط2، 1969هـ.
211ـ معجم الأفعال المتعدية بحرف، موسى بن محمد الملياني الأحمدي الجزائري (ت 1999م)، ط1، 1410 ه ـ 1369ش.
212ـ معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي (ت626هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، 1399ه/1979م.
213ـ معجم الشعراء، أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني (ت384 هـ)، تحقيق وتصحيح وتعليق: الأُستاذ الدكتور ف.كرنكو، مكتبة القدسي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط2، 1402ه/1982م.
214ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني (ت360هـ)، حقّقه وخرَّج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، ط2.
215ـ معجم اللغة العربية المعاصرة، الدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت 1424 هـ) بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب، ط 1، 1429 هـ/2008 م.
216ـ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ـ الإدارة العامّة للمعجمات وإحياء التّراث، جمهورية مصر العربية، مكتبة الشّروق الدّولية، ط4، 2003م.
217ـ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي (ت1413هـ)، ط5، 1413ه /1992م.
218ـ معجم قبائل العرب، عمر كحالة، دار العلم للملايين، بيروت ـ لبنان، ط2، 1388هـ ـ 1968م.
219ـ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (ت 487هـ)، تحقيق مصطفى السقا، نشر عالم الكتب، بيروت، ط3، 1403ه/1983م.
220ـ معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت 395هـ)، منشورات مكتب الإعلام الإسلامي، قم ـ إيران، جمادي الآخرة 1404هـ.
221ـ معرفة الصحابة، أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني (ت430هـ)، تحقيق: عادل بن يوسف الغرازي، نشر دار الوطن للنشر، الرياض، ط1، 1419هـ/1998.
222ـ المفيد من معجم رجال الحديث، محمد الجواهري، المحلاتي، ط2، 1424ه.
223ـ مقاتل الطالبيين، علي بن الحسين أبو الفرج الأصفهاني (ت356 هـ)، نشر مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر، قم ـ إيران، ط2، 1385هـ/1965م.
224ـ مقتل الحسين× المسمّى باللهوف في قتلى الطفوف، علي بن موسى بن جعفر (ت664هـ)، أنوار الهدى، قم ـ إيران.
225ـ مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وأصحابه في كربلاء المشتهر بـ(مقتل أبي مخنف) (ت157هـ)، نشر مكتبة الألفين، الكويت، ط2، 1408هـ/ 1987م.
226ـ مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وأصحابه في كربلاء، المشتهر بـ(مقتل أبي مخنف) (ت157هـ) ، انتشارات المكتبة الحيدرية، قم ـ إيران، ط4، 1428 هـ ـ 1386ش.
227ـ مقتل الحسين×، أبو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن سليم الأزدي الغامدي (ت157هـ)، تحقيق وتعليق: حسين الغفاري، مطبعة العلمية، قم ـ إيران.
228ـ مقتل الحسين×، الموفق محمد بن أحمد الخوارزمي (ت568هـ)، تحقيق: الشيخ محمد السماوي، دار أنوار الهدى، قم ـ إيران، ط5، 1431هـ/2010م.
229ـ مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب×، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد المعروف بابن أبي الدنيا (ت 281 هـ)، تحقيق: إبراهيم صالح، دار البشائر، دمشق ـ سوريا، ط1، 1422هـ/2001م.
230ـ الملل والنحل، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، (ت 548هـ)، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان.
231ـ من اسمه عمرو من الشعراء، أبو عبد الله محمد بن داود بن الجراح (ت٢٩٦هـ)، المكتبة الشاملة، ٨ ذو الحجة ١٤٣١هـ.
232ـ من كربلاء إلى دمشق، محمد عبد الغني السعيدي، (معاصر)، دار الأضواء، بيروت ـ لبنان، ط1، 1435هـ/2014هـ.
233ـ مناقب آل أبي طالب، الحافظ مشير الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن شهر آشوب (ت 588هـ)، قام بتصحيحه وشرحه ومقابلته على عدّة نسخ خطّية: لجنة من أساتذة النجف الأشرف، المكتبة الحيدرية للحاج محمد كاظم الكتبي، النجف الأشرف ـ العراق، 1376ه /1956م.
234ـ مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب×، الحافظ محمد بن سليمان الكوفي القاضي (من أعلام القرن الثالث)، تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، قم ـ إيران، ط1، 1412هـ.
235ـ مناقب أهل البيت×، المولى حيدر الشيرواني (ت ق 12هـ)، تحقيق: الشيخ محمد الحسون، مطبعة المنشورات الإسلامية، 1414هـ.
236ـ مناقب علي بن أبي طالب×، علي بن محمد بن محمد الواسطي الجلابي الشافعي الشهير بابن المغازلي (ت483هـ)، انتشارات سبط النبي، قم ـ إيران، ط1، 1384ه.ش/1426هـ.ق.
237ـ المناقب، الموفق محمد بن أحمد الخوارزمي (ت568هـ)، تحقيق: الشيخ مالك المحمودي، مؤسسة النشـر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم ـ إيران، ط2، 1414هـ.
238ـ المنتخب في جمع المراثي والخطب، المشتهر بالفخري، فخر الدين الطريحي النجفي (ت 1085هـ)، (طبعة قديمة)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان.
239ـ منتخب مسند عبد بن حميد، عبد بن حميد بن نصر الكسي (ت 249هـ) تحقيق: السيد صبحي البدري السامرائي، محمود محمد خليل الصعيدي، نشر مكتبة النهضة العربية، ط1، 1408 هـ/1988م.
240ـ المنتظم في تاريخ الملوك والأُمم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت597ه)، دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا، راجعه: مصطفى عبد القادر عطا، وصححه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط1، 1412ه/1992م.
241ـ المنتقى من كتاب الطبقات، أبو عروبة الحسين بن محمد بن أبي معشر مودود السُّلَمي الجَزَري الحرَّاني (ت ٣١٨هـ)، تحقيق: إبراهيم صالح، دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ـ سوريا، ط1، ١٩٩٤م.
242ـ المنقري، نصر بن مزاحم (212هـ)، مقتل الحسين بن علي (نسخة خطية)، نسخة دار الكتب المصرية والوثائق الرسمية في القاهرة، رقم 2461، تسلسل 153.
243ـ المنمق في أخبار قريش، محمد بن حبيب البغدادي ( 245 ه / 859م)، صحّحه وعلّق عليه: خورشيد أحمد فاروق، عالم الكتب.
244ـ موسوعة الإمام الحسين× في الكتاب والسنة والتاريخ، محمد الريشهري (ت 2022م)، تحقيق: مركز بحوث دار الحديث، دار الحديث للطباعة والنشر، قم المشرّفة ـ إيران، ط 1، 1431هـ.
245ـ الموسوعة الحرة ويكيبيديا.
246ـ موسوعة طبقات الفقهاء، اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق× (معاصرين)، تحقيق وإشراف: جعفر السبحاني، مؤسسة الإمام الصادق×، ط1، 1418هـ.
247ـ موسوعة كلمات الإمام الحسين×، لجنة الحديث في معهد باقر العلوم×، دار المعروف للطباعة والنشر، قم ـ إيران، ط3، 1416هـ/1995م.
(ن)
248ـ ناسخ التواريخ، القسم المتعلّق بحياة الإمام الحسين×، ميرزا محمّد تقي سِپِهْر، المعروف بـ(لسان المُلْك) (ت1297هـ)، ترجمه وحقّقه: سيد علي جمال أشرف ، انتشارات مَديَن، قم ـ ايران، ط1، 1477 هـ /2007 م.
249ـ النجم الثاقب، ميرزا حسين النوري الطبرسي(ت1320هـ)، تحقيق: السيد ياسين الموسوي، أنوار الهدى، قم ـ إيران، ط1، 1415هـ.
250ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، يوسف بن تغري بردي الأتابكي (ت874هـ)، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر.
251ـ نساء حول الحسين×، سعيد رشيد زميزم (معاصر)، مراجعة وتحقيق: الشيخ محمد صادق تاج، دار الجوادين، ط1، 1432هـ/2011م.
252ـ نسب قريش، مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري (ت236 هـ)، تحقيق ومراجعة: ليفي بروفسال نشر دار المعارف، القاهرة ـ مصر.
253ـ نسب معد واليمن الكبير، هشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت 204 هـ)، تحقيق: الدكتور ناجي حسن، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، ط1، 1408 ه/1988م.
254ـ نظام الحكومة النبوية، المسمّى التراتيب الإدارية، عبد الحي الإدريسي الكتاني الفاسي(ت 1383هـ)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان.
255ـ نظم درر السمطين، محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي الحنفي المدني (ت750 هـ)، مكتبة الإمام أمير المؤمنين× العامّة، النجف الأشرف ـ العراق، ط1، 1377هـ/1958م.
256ـ نفس المهموم في مصيبة سيدنا الحسين المظلوم، الشيخ عباس القمي، المكتبة الحيدرية، قم ـ إيران، ط1، 1421هـ.
257ـ نقد الرجال، السيّد مصطفى بن الحسين الحسيني التفرشي (من أعلام القرن الحادي عشر)، تحقيق: مؤسسة آل البيت^لإحياء التراث، مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم المشرّفة ـ إيران، ط1، 1418هـ.
258ـ نهاية الأرب في فنون الأدب، أحمد بن عبد الوهاب النويريّ (ت733هـ)، نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصـرية العامّة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر.
259ـ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، المؤلف: أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي (ت ٨٢١هـ)، تحقق: إبراهيم الإبياري ، دار الكتاب اللبناني، بيروت ـ لبنان، ط2، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.
260ـ النهاية في غريب الحديث والأثر، المبارك بن محمد مجد الدين ابن الأثير (ت606هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، نشر مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع، قم ـ إيران، ط4، 1364ش.
261ـ نور البراهين، السيد نعمة الله الجزائري (1112هـ)، تحقيق: السيد مهدي الرجائي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ط1، 1417هـ.
262ـ نور العين في مشهد الحسين (رضي الله عنه)، إبراهيم بن محمد الإسفرائيني(ت418هـ)، نسخة حجرية مطبوعة بالمطبعة العامرة العثمانية والموجودة في قصرحارة الفراخة بباب الشعرية في سنة 1303هـ، القاهرة ـ مصر.
263ـ نور القبس، أبو المحاسن يوسف بن أحمد بن محمود اليغموري (ت 673هـ)، بدون هوية.
(هـ)
264ـ الهداية الكبرى، الحسين بن حمدان الخصيبي (ت334هـ)، مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، ط4، 1411هـ/1991م.
(و)
265ـ الوافي بالوفيات، الصلاح الصفدي (ت 764هـ)، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت ـ لبنان، 1420هـ/2000م.
266ـ وسائل الشيعة (آل البيت)، محمد بن الحسن الحر العاملي(ت1104هـ)، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم ـ إيران، ط2، 1414هـ.
267ـ وسيلة الدارين في أنصار الحسين×، إبراهيم الموسوي الزنجاني (معاصر)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، ط1، 1395هـ/1975م.
268ـ وفيات الأئمة، مجموعة من علماء البحرين والقطيف (معاصر) ، دار البلاغة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، ط1، 1412هـ/1991م.
269ـ وقعة صفّين، ابن مزاحم المنقري (ت212هـ)، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشـر والتوزيع، القاهرة ـ مصر، ط2، 1382هـ.
(ي)
270ـ ينابيع المودّة لذوي القربى، سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي (ت1294هـ)، تحقيق: سيّد علي جمال أشرف الحسيني، دار الأُسوة للطباعة والنشر، قم ـ إيران، ط1، 1416هـ.
[1] البقرة: آية31.
[2] المجادلة: آية11.
[4] آل عمران: آية164.
[5] الكفعمي، إبراهيم، المصباح: ص280.
[6] البقرة: آية253.
[7] اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج5، ص2147.
[8] اُنظر: البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين: ص229ـ230.
[9] البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين: ص231.
[10] الطبرسي، ميرزا حسين، خاتمة المستدرك: ج2، ص460.
[11] ابن طاووس، علي بن موسى، فلاح السائل: ص73.
[12] ابن الفوطي، عبد الرزاق بن أحمد، الحوادث الجامعة والتجارب النافعة: ج1، ص255.
[13] لمشاهدة الصورة اضغط على الرابط التالي :
https://admin.warithanbia.com/files/images/965935956_1696138368.png
[14] لمشاهدة الصورة اضغط على الرابط التالي
https://admin.warithanbia.com/files/images/748045163_1696138439.png
[15] لمشاهدة الصورة اضغط على الرابط التالي https://admin.warithanbia.com/files/images/246041748_1696138513.png
[16] هكذا في الأصل، والصحيح (قدّر).
[17] هكذا في الأصل، والصحيح هو (صائرة). وهناك موارد كثيرة مثلها كُتِبت بالياء بدلاً عن الهمزة، لا نشير إليها، وإنّما نكتفي بالإشارة هنا؛ اختصاراً.
[18] هكذا في الأصل، والصحيح (والأنبياء)، وسيأتي مثله كثير، لا نشير إليها اختصاراً.
[19] هكذا في الأصل، والصحيح (والمرسلون والأولياء الصالحون).
[20] هكذا وردت العبارة في الأصل.
[21] هكذا في الأصل، وفي مقدّمة اللهوف (رزؤها).
[22] في مقدّمة اللهوف: (والبلية التي سلبت نفوس خير الآل، والشماتة التي ركست أسود الرجال، والفجيعة التي بلغ رزؤها إلى جبرائيل، والفظيعة التي عظمت على الرب الجليل).
[23] هكذا في الأصل، وفي مقدّمة اللهوف (مجرّداً). وجرجر الشيء: جرّه عنوة. أحمد مختار، عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة: ج1، ص358، (جرجر).
[24] هكذا في الأصل، وفي مقدّمة اللهوف (السائق).
[25] هكذا في الأصل، وفي مقدّمة اللهوف (وتلك الأبدان المعظّمة عارية من الثياب)، ولعلّه الصحيح.
[26] في مقدّمة اللهوف:
|
(مصائب بددت شمل النبي ففي سرت عليه بنار الحزن والأسف). |
[27] فاطمة الزهراء‘، بنت النبي محمد’، أُمّها خديجة بنت خويلد، وُلِدت في السنة الخامسة بعد البعثة النبويّة، سمّاها الله فاطمة؛ لأنّه فطمها ومحبّيها عن النار، ألقابها كثيرة، منها: الزهراء، والبتول، والحوراء الأنسية، والصدّيقة. قال النبي’: إنّما أنا بشرٌ مثلكم، أتزوّج فيكم وأُزوّجكم، إلّا فاطمة؛ فإنّ تزويجها نزل من السماء، فزوّجها من أمير المؤمنين علي× بعد واقعة بدر بأيام. وكان عمرها‘ مع أبيها’ بمكة ثمانية سنين، وهاجرت إلى المدينة، وأقامت معه فيها عشـر سنين. اختُلف في مدّة بقائها بعد وفاة أبيها، فقيل: (40) يوماً. وقِيل: (75) يوماً. وقِيل: (95) يوماً، وغير ذلك. وكان سبب وفاتها أنّ عمر أمر مولاه قنفذاً بضـربها، فضـربها، وأسقطت مُحسناً، ومرضت بعد ذلك مرضاً شديداً، ولم تدَع أحداً ممَّن آذاها يدخل عليها، ووجدت عليهم إلى أن تُوفّيت، وكان لها من العمر آنذاك (18) سنة. اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج5، ص568. ابن عبد البر، يوسف عبد الله، الاستيعاب: ج4، ص1893ـ1899. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج43، ص134، وص197، وما بعدها.
[28] هكذا في الأصل، والصحيح (أبيها).
[29] هكذا في الأصل، ويقال: طابق بين قميصين: لبس أحدهما على الآخر. وهو كناية ومبالغة عن شدة كفر هؤلاء. اُنظر: الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط: ج3، ص256، (طبق).
[30] في مقدّمة اللهوف: (فيا ليت لفاطمة وأبيها عيناً تنظر إلى بناتها، وبنيها ما بين مسلوب وجريح ومسحوب وذبيح).
[31] هكذا في الأصل، والصحيح (مشقّقات) كما في مقدّمة اللهوف.
[32] هكذا في الأصل، وفي مقدّمة اللهوف (وبارزات من الخدور).
[33] هكذا في الأصل، والثانية زائدة.
[34] في مقدّمة اللهوف: (وبنات النبوة مشقّقات الجيوب، ومفجوعات بفقد المحبوب، وناشرات للشعور، وبارزات من الخدور، ولاطمات للخدود، وعادمات للجدود، ومبديات للنياحة والعويل، وفاقدات للمحامي والكفيل).
[35] هكذا في الأصل، وفي مقدّمة اللهوف: (... ويا ذوي النواظر والأفهام).
[36] هكذا في الأصل، والصحيح (هؤلاء)، وستأتي مثلها في موارد كثيرة.
[37] الرزية: المصيبة. اُنظر: الجوهريّ، إسماعيل بن حمّاد، الصحاح: ج1، ص53، (رزأ).
[38] في مقدّمة اللهوف: (حدّثوا أنفسكم بمصارع هاتيك العترة، ونوحوا بالله لتلك الوحدة والكثرة، وساعدوهم بموالاة الوجد والعبرة، وتأسّفوا على فوات تلك النصرة).
[39] هكذا في الأصل، وفي مقدّمة اللهوف (ودائع).
[40] هكذا في الأصل، وفي بقية الموارد الآتية أيضاً، والصحيح (فؤاد).
[41] رشف الماء ونحوه: مصَّه بشفتيه. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج4، ص1364، (رشف).
[42] ثَنايا الإِنسان في فمه الأَربعُ التي في مقدّم فمه. ثِنْتانِ من فوق، وثِنْتانِ من أَسفل. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج14، ص123، (ثنى).
[43] هكذا في الأصل، والصحيح (شعراً)، وسيأتي مثله في موارد كثيرة، لا نشير إليها اختصاراً. وما ذكره المؤلف لعلّه إشارة إلى قول رسول الله’: «يا معاشر المسلمين هل أدلّكم على خير الناس جداً وجدة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: عليكم بالحسن والحسين؛ فإنّ جدهما محمد’ وجدتهما خديجة بنت خويلد سيدة نساء أهل الجنة، وأوّل من سارعت إلى تصديق ما أُنزِل الله على نبيه وإلى الإيمان بالله وبرسوله، ثم قال: يا معاشر المسلمين هل أدلّكم على خير الناس أباً وأمّاً؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: عليكم بالحسن والحسين؛ فإنّ أباهما علي بن أبي طالب يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله، وأمهما فاطمة بنت رسول الله’، فقد شرّفهما الله في سماواته وأرضه. ثم قال: أيا معشر المسلمين، وهل أدلّكم على خير الناس خالاً وخالة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليكم بالحسن والحسين؛ فإنّ خالهما القاسم ابن رسول الله’، وخالتهما زينب بنت رسول الله’. ثم قال: يا معاشر المسلمين، هل أدلّكم على خير الناس عمّاً وعمّة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: عليكم بالحسن والحسين؛ فإنّ عمّهما جعفر ذو الجناحين الطيار مع الملائكة في الجنة، وعمّتهما أم هاني بنت أبي طالب. ثم قال: اللهم إنّك تعلم أنّ الحسن والحسين في الجنة، وجدهما في الجنة، وجدتهما في الجنة، وأباهما في الجنة، وأمّهما في الجنة، وعمّهما في الجنة، وعمّتهما في الجنة، وخالهما في الجنة، وخالتهما في الجنة، ومن يحبّهما في الجنة، ومن يبغضهما في النار». اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص522. الخوارزمي، الموفق بن أحمد، المناقب: ص289.
[44] هكذا في الأصل، وفي مقدّمة اللهوف (سنن الرسول ومحكم التنزيل).
[45] هكذا في الأصل، والصحيح (شاهد) كما في مقدّمة اللهوف.
[46] هكذا في الأصل، والصحيح (فضلهم على التفضيل).
[47] هكذا في الأصل، وفي مقدّمة اللهوف (لذوي الحجى... وبيان فضلهم على التفضيل).
[48] هكذا في الأصل، وفي مقدّمة اللهوف (ووصية سبقت لأحمد فيهم).
[49] هكذا في الأصل، والصحيح (جاءت)، وكذا في بقية الموارد.
[50] هكذا في الأصل، وفي مقدّمة اللهوف (مع تداني الأزمان بمقابلة إحسان جدّهم بالكفران).
[51] في مقدّمة اللهوف: (وتكدير عيشه بتعذيب ثمرة فؤاده، وتصغير قدره بإراقة دماء أولاده).
[52] هكذا في الأصل، والصحيح (سؤاله)، ومثله موارد كثيرة.
[53] هكذا في الأصل، والصحيح (محمداً).
[54] في مقدّمة اللهوف (ألم يعلموا أنّ محمداً’ موتور وجيع. وحبيبه مقهور صريع. والملائكة يعزّونه على جليل مصابه. والأنبياء يشاركونه في أحزانه وأوصابه).
[55] هكذا في الأصل، والصحيح (التي).
[56] في مقدّمة اللهوف: (فيا أهل الوفاء لخاتم الأنبياء، علام لا تواسونه في البكاء! بالله عليك أيّها المحبّ لوالد الزهراء، نُح معها على المنبوذين بالعراء، وجُد ـ ويحك ـ بالدموع السجام. وابكِ على ملوك الإسلام، لعلّك تحوز ثواب المواسي في المصاب، وتفوز وبالسعادة يوم الحساب).
[57] الإمام أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب^. لقّبه النبيّ’ بـ(الباقر) ؛ لأنّه يبقر العلم بقراً، أي يشقّه شقّاً، ويظهره إظهاراً. أمّه السيدة أم عبد الله فاطمة بنت الحسن المجتبى÷، قال عنها الإمام الصادق×: «كانت صديقةٌ لم يُدرَكْ في آلِ الحسنِ مثلُها». خامس أئمّة أهل البيت^، وُلِد بالمدينة المنوّرة غرة رجب، وقيل: الثالث من صفر، سنة 56هـ، وقيل: 57هـ. كان إليه منتهى فروع العلم على اختلاف أصنافه وأنواعه. جاء عن جابر بن عبد الله الأنصاري&، أنّ رسول الله’ قال له: «يا جابر، إنّك ستبقى حتى تلقى ولدي محمدَ بنَ عليٍّ بنِ الحسينِ بنِ عليٍّ بنِ أبي طالب، المعروف في التوراة بالباقر، فإذا لقيتَه فاقرأه منِّي السلام». قال عبد الله بن عطاء المكي: ما رأيتُ العلماءَ عند أحدٍ قط أصغرَ منهم عند أبي جعفر محمد بن علي. وقد حفظت لنا موسوعات المسلمين الحديثية ـ لا سيما الشيعي منها ـ تراثه وعلمه. استُشهد× في ذي الحجة، وقيل: في ربيع الأول، سنة 114هـ، ودُفن في البقيع إلى جنب جدّه المجتبى×، وأبيه السجاد×. اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، علل الشرائع: ج1، ص233. الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص434. الخصيبي، الحسين بن حمدان، الهداية الكبرى: ص237ـ238. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص157. الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج6، ص77. القاضي المغربي، النعمان، شرح الأخبار: ج3، ص276. الطبري (الشيعي)، محمد بن جرير، دلائل الإمامة: ص217. الفتال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص202. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج46، ص212، ص215.
[58] الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب^، كنيته أبو الحسن، وأبو محمد. وقد اُختلِف في أُمّه، فقيل: أم ولد سندية، يقال لها: سلافة، وقيل: اسمها غزالة، وقيل: شاه زنان بنت كسـرى يزدجرد. ويُقال: إنَّ اسمها كان شهربانويه، ويُقال: شاه زنان بنت شيرويه بن كسرى أبرويز. ألقابه كثيرة، أشهرها: سيّد العابدين، وزين العابدين، والسجّاد، وذو الثفِنات، وإنّما لُقِّب بذلك؛ لأنّ موضع السجود منه كان كثَفنَة البعير من كثرة السجود عليه. وُلِد في الخامس من شعبان من سنة (38هـ)، وقيل: في النصف من جمادى الأولى سنة (36 هـ)، في المدينة المنوّرة. رابع أئمّة أهل البيت^. كان إماماً في الدين ومناراً في العلم. شهد وقعة الطفّ بمشاهدها المروِّعة مع أبيه السبط الشهيد، وكان في ذلك الزمن مريضاً؛ لم يشترك في ميدان الحرب، إلّا أنّ الفضيل بن الزبير ـ وهو من أصحاب الإمامين الباقر والصادق÷ ـ ذكر ما نصّه: وكان علي ابن الحسين× عليلاً، وارتثّ [من كثرة الجراح] يومئذٍ، وقد حضر بعض القتال فدفع الله عنه. استُشهد× سنة (92 هـ) وقيل (94 هـ) وقيل (95هـ)، ودُفن في البقيع. اُنظر: الأسدي، الفضيل بن الزبير، تسمية من قُتِل مع الحسين بن علي÷ (المطبوع ضمن موسوعة المقاتل الحسينية: ج2، ص27. ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج5، ص211. ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم، المعارف: ص214. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص135ـ137. الشجري، يحيى بن الحسين، ترتيب الأمالي الخميسية: ج1، ص225. الفتال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص201. ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج3، ص156. الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج4، ص399. ابن الصباغ، علي بن محمد، الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة: ج2، ص874. الميلاني، محمد هادي، قادتنا كيف نعرفهم: ج4، ص7ـ10. الجلالي، محمد رضا، جهاد الإمام السجاد×: ص43.
[59] «يقال: ذرفت عينه، إذا سال منها الدمع». الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج4، ص1361، (ذرف).
[60] غُرفاً: جمع غُرفة وهي العِلِّيّةُ، أي الغرفة فوق البناء. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج9، ص264، (غرف). وج15، ص86.
[61] اُنظر أيضاً: القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي: ج2، ص291. ابن قولويه القمي، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص201، ح285. الصدوق، محمد بن علي، ثواب الأعمال: ص83. ابن نما الحلّي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص5. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص9. وفيه: (رُوِى عن مولانا الباقر× أنّه قال: كان زين العابدين× يقول: أيّما مؤمن زرفت عيناه لقتل الحسين× حتى تسيل على خدّه بوّأه الله غرفاً في الجنة يسكنها أحقاباً، وأيما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خده فيما مسنا من الأذى من عدونا في الدنيا بوّأه الله منزل صدق، وأيّما مؤمن مسّه أذى فينا صرف الله عن وجهه الأذى وآمنه يوم القيامة من سخط النار).
[62] الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله، المُلقَّب بالصادق×، سادس أئمّة أهل البيت^، وُلِد سنة: 83 هـ، واستُشهد سنة: 148هـ، وإليه يُنسب أتباع أهل البيت^ حينما يُلقّبون بالجعفرية. عُرف بالعلم الغزير حتى قصده القاصي والداني في شتى العلوم، وقد تتلمذ على يديه أغلب علماء الإسلام في زمانه، فبلغ من عُرف منهم أربعة آلاف أو يزيدون، منهم أئمة المذاهب الأربعة. وقد اشتهر عن أبي حنيفة قوله: لولا السنّتان لهلك النعمان. يعني السنّتين اللتين تتلمذ فيهما على يد الإمام الصادق×. وكان قد استغلّ الاضطراب السياسي لنـشر العلوم وبثها، حيث عاصر فترة انتهاء الخلافة الأُموية وبداية الخلافة العباسية؛ فكانت السلطات آنذاك منشغلة عنه. اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص179. المظفر، محمد حسن، الإمام الصادق: ج1، ص139.
[63] اُنظر أيضاً: البرقي، أحمد بن محمد بن خالد، المحاسن: ج1، ص63. الحميري القمي، عبد الله ابن جعفر، قرب الإسناد: ص36. ابن قولويه القمي، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص207. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص10.
[64] هكذا في الأصل، والصحيح (بكى)، سيأتي مثله في موارد كثيرة.
[65] هكذا في الأصل، وفي اللهوف (رُوِى عن آل الرسول^ أنّهم قالوا: مَن بكى أو أبكى فينا مائة ضمنّا له على الله الجنة، ومَن بكى أو أبكى خمسين فله الجنة، ومَن بكى أو أبكى ثلاثين فله الجنة، ومَن بكى أو أبكى عشرة فله الجنة، ومَن بكى أو أبكى واحداً فله الجنة، ومَن تباكى فله الجنة). وفي مثير الأحزان (عن الأئمة الصادقين^ قالوا: مَن بكى أو أبكى غيره ـ ولو واحداً ـ ضمنّا له على الله الجنة، ومَن لم يتأتِ له البكاء فتباكى فله الجنة). ابن نما الحلّي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص5.
[66] المُسمَّى بـ(المصرع الشين في مقتل الحسين×).
[67] لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم الأزدي الغامدي، أبو مخنف. استُشهد جدّه ـ مخنف بن سليم ـ مع أمير المؤمنين× في معركة الجمل، كان حامل راية الأزد يومئذ. يُعدّ أبو مخنف من كبار المؤرخين. عالم بالسير والأخبار، إمامي، من أهل الكوفة، له تصانيف كثيرة في تاريخ عصره، وما كان قبله بيسير، منها: فتوح الشام، والردة، وفتوح العراق، والجمل، وصفين، والنهروان، والأزارقة، والخوارج والمهلب، ومقتل أمير المؤمنين×، وأخبار المختار&، وغيرها. أهمّ مصنّفاته مقتل الإمام الحسين× وهو مطبوع، اعتمد عليه علماء السنّة في النقل عنه، كالطبري، وابن الأثير، وغيرهما، توفّي سنة (157هـ). وقد كتب الشيخ عامر الجابري& دراسة وافية فيه وفي مقتله في كتابه أصول المقتل الحسيني، والذي طُبِع فيما بعد في المجلد الأول من موسوعة المقاتل الحسينية، فراجع. اُنظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج4، ص1476. الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست: ص204. القمي، عباس، الكنى والألقاب: ج1، ص155. الزركلي، خير الدين بن محمود، الأعلام: ج5، ص245.
[68] هكذا في الأصل، والصحيح (رحمة). وسيأتي مثله في موارد كثيرة كتابة التاء المربوطة من نقاط، نكتفي بالإشارة هنا للاختصار.
[69] الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، وُلِد داخل الكعبة المشرفة سنة (23) قبل الهجرة. أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم. أوّل من آمن برسول الله’. شهد معه جميع مشاهده. آخاه النبي وزوّجه ابنته الزهراء‘، ونصبه خليفة من بعده في حادثة الغدير المشهورة وبويع له بالخلافة، فنكث بعض المسلمين بيعته بعد رحيل النبي’، ثم اجتمعت الأمة على بيعته بعد مقتل عثمان بن عفان. نزل الكوفة في الرحبة التي يقال لها رحبة عليّ في أخصاص كانت فيها والخص: البيت الذي يسقف عليه بخشبة على هيئة الأزج، سمي بذلك لأنّه يرى ما فيه لوجود التفاريج الضيقة، ولم ينزل القصر الذي كانت تنزله الولاة قبله. استشهد ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة أربعين متأثراً بضربة عبد الرحمن بن ملجم (لعنه الله)، فجر يوم التاسع عشر من شهر رمضان، وقيل السابع عشر منه. دُفِن بظهر الكوفة وقبره يُقصَد من الآفاق. اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج6، ص12. الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص195. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، أُسد الغابة: ج4، ص16. ابن منظور، محمد ابن مكرم، لسان العرب: ج7، ص26. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج4، ص295.
[70] هكذا في الأصل، والصحيح (ابن)، وستأتي في موارد كثيرة هكذا، وكذا العكس، فقد يثبت الألف مع وجوب حذفها، نكتفي بالإشارة لها هنا؛ رعاية للاختصار.
[71] عبد الرحمن بن ملجم التجوبي الحميري لعنه الله. من اليمن، سكن أجداده مع بني مراد قرب نجران ونُسِبوا إليهم، ثم هاجر ابن ملجم لعنه الله إلى المدينة، وتعلّم القرآن عند معاذ بن جبل المعادي لعلي بن أبي طالب، ثم شهد فتح مصر، واستقرّ بها. فكتب عمر بن الخطاب إلى واليه في مصر عمرو بن العاص لعنه الله أن يقرّبه ويوسّع داره، ويجعلها قرب المسجد ليتعلّم الناس منه القرآن. ثم جاء الكوفة أيام صفين، فصار مع الخوارج. ولكنّ الإعلام الأموي والعباسي لا يفتأ يتهم شيعة الكوفة، فصوّر للأذهان أنّ ابن ملجم من شيعة الكوفة. اُنظر: السمعاني، عبد الكريم بن محمد التميمي، الأنساب: ج1، ص451. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، اللباب في تهذيب الأنساب: ج1، ص209. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، لسان الميزان: ج3، ص440. الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: ج1، ص320. العاملي، جعفر مرتضى، الصحيح من سيرة النبي الأعظم’: ج23، ص216. الكوراني، علي، مع عبد الهادي الربيعي، قبيلة حمير القحطانية: ج9، ص7.
[72] الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب÷، كنيته أبو محمد. ثاني أئمة أهل البيت^، وأوّل السبطين وسيدي شباب أهل الجنة وريحانتي المصطفى، وأحد الخمسة أصحاب العبا. أمه سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله’. وُلِد بالمدينة المنورة في النصف من شهر رمضان سنة (3 هـ)، وقيل: في النصف من شعبان، وقيل: بعد الهجرة بـ 4 سنوات و9 أشهر ونصف، أي في نهاية ذي الحجة. أعبد أهل زمانه وأزهدهم وأفضلهم، وكان إذا حج حجّ ماشياً وربما مشى حافياً. تسلّم الخلافة بعد استشهاد أبيه الإمام علي× سار فيها لحرب أهل الشام، ثم هادن معاوية لأسباب عديدة، وعقد معه عقداً على أن تكون الخلافة له بعد موت معاوية. وقد بحثها مفصَّلاً صاحب كتاب الإمام الحسن× في مواجهة الانشقاق الأموي. استُشهد مسموماً على يد زوجته جعدة بنت الأشعث بأمر معاوية سنة (50 هـ)، ودُفِن بالبقيع عند جدته فاطمة بنت أسد بعد اعتراض عائشة ومنعها من دفنه عند جده رسول الله’. اُنظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج13، ص163. المزي، يوسف، تهذيب الكمال: ج6، ص220، وص222. الأمين، محسن بن عبد الكريم، أعيان الشيعة: ج1، ص562 و ص568 و ص576. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج2، ص199.
[73] هكذا في الأصل، والصحيح (أبو).
[74] قيس بن سعيد أو سعد بن عبادة الأنصاري. كان شجاعاً بطلاً كريماً سخياً حمل لواء رسول الله’ في بعض مغازيه، وولاه أمير المؤمنين× إمارة مصر، وحضر معه حرب الخوارج بالنهروان. وكان مع الإمام الحسن بن علي× على مقدمته بالمدائن. تُوفي بالمدينة في آخر أيام معاوية. اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الأبواب (رجال الطوسي) : ص95. المزي، يوسف، تهذيب الكمال: ج6، ص244. القمي، عباس، الكُنى والألقاب: ج3، ص174.
[75] الخوارج: قوم مبتدعون سُمُّوا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين. وأول من خرج على أمير المؤمنين علي× جماعة ممّن كان معه في حرب صفين. ويُلقَّبون أيضاً بالحرورية والشراة والمحكمة والمارقة. اُنظر: الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل: ج1، ص114ـ115. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري: ج12، ص250.
[76] وهذا وهم كبير؛ فإنّ قيس بن سعد بقي إلى ما بعد الصلح، بل تُوفي بعد شهادة الإمام الحسن×، كما تقدّم في ترجمته.
[77] يقال له: (جراح بن سنان الأسدي)، كما ورد في المناقب. اُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص195.
وهو الجرّاح بن سنان الأسدي (لعنه الله). من الخوارج. طعن الإمام الحسن× في فخذه بمعول كان في يده ـ وقيل: مغول، وهو سيف دقيق ـ في مظلم ساباط عند مروره بها، بعد إعلانه× الصلح مع معاوية، فوثب إليه رجل من شيعة الإمام الحسن×، فانتزع المعول من يده وخضخض به جوفه، وأكبّ عليه آخر فقطع أنفه، فهلك من ذلك. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص35. أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص41. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص12. الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج1، ص569.
[78] كذا رسمت في الأصل.
[79] هكذا في الأصل، والصحيح (قتلتم).
[80] لم يكن قاتل أمير المؤمنين× من الكوفة ولا من الشيعة، كما تقدّم في ترجمة عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله.
[81] اُنظر أيضاً: ابن سمعون، أمالي ابن سمعون: ج1، ص54. الدميري، كمال الدين، حياة الحيوان: ج1، ص88.
[82] معاوية بن أبي سفيان ـ صخر ـ بن حرب بن أُميّة، وُلِد قبل الهجرة بخمس وعشـرين سنة، حارب رسول الله’ مع أبيه أبي سفيان في حروبه، ثمّ أسلم مع أبيه عام الفتح، سنة ثمانية من الهجرة، فجعله النبي’ وأباه مع المؤلّفة قلوبهم، وهما من الطلقاء، ولّاه عمر على الشام، وأبقاه عليها عثمان. أستنجد به عثمان لما حُوصِر فتأخر ولم ينصره؛ ليدعو إلى نفسه بعد مقتل الخليفة. فطالب بدمه أميرَ المؤمنين علياً×، وحاربه على ذلك في صفّين، ثمّ حارب الإمام الحسن× حتّى حصلت الهدنة بينهما سنة (41هـ)، وتربع على عرش السلطة حتى هلك في رجب سنة (60هـ)، وهو ابن خمس وثمانين عاماً. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص239ـ240. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج3، ص1416. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، أُسد الغابة: ج4، ص385. ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج16، ص154.
[83] هكذا في الأصل، والصحيح (ألفا).
[84] اُنظر أيضاً: ابن سمعون، أمالي ابن سمعون: ج1، ص54. الدميري، كمال الدين، حياة الحيوان: ج1، ص89.
نقول: الوارد في كتب التاريخ أنّ الإمام الحسن× بعدما اضطرّ للصلح، بعث له معاوية صحيفة بيضاء، وقال للإمام اكتب فيها ما شئتَ، فاشترط الإمام× أن يُسلّم إليه ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيها بكتاب الله وسنة نبيه، وأنّه ليس لمعاوية أن يعهد لأحد من بعده، بل يكون الأمر بعده للحسن، فإن لم يكن فللحسين÷، وأنّ الناس آمنون حيث كانوا على أنفسهم وأموالهم وذراريهم، وعلى أن لا يبغي للحسن بن علي غائلةً سرّاً ولا علانيةً، وأن لا يخيف أحداً من أصحابه، وأن يترك ما في بيت المال الكوفة للإمام الحسن×، وأن يحمل إلى الحسين كلّ عام ألفي ألف درهم ، وأن يفضّل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس ، وأن يفرّق في أولاد الشهداء مع أمير المؤمنين× يوم الجمل وصفين ألف ألف درهم، وأن يجعل ذلك من خراج دار ابجرد. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص42. آل ياسين، راضي، صلح الحسن×: ص395ـ398. ويمكن للقارئ الرجوع إلى ما كتبه العلامة السيد سامي البدري حول مسألة الصلح، حيث كتب دراسة جديدة في طرحها ومضمونها، استعرض فيها مسألة الصلح مفصّلاً بعد أن تعرّض لجميع الدراسات التي سبقته، وناقشها، وأثبت أنّ الإمام× صالح عن قوة، لا عن ضعف، كجدّه’ يوم صالح المشركين في الحديبية، وأبطل فرية خيانة الشيعة لإمامهم×. فمن أراد التفصيل فليراجع كتاب: الإمام الحسن× في مواجهة الانشقاق الأموي للسيد سامي البدري.
[85] عتب عليه: لامَهُ مَلامةً. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص581، (عتب).
[86] الوارد في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (... بعثه الله معهم يوم القيامة، وأنتم معنا وفي زمرتنا لا تفارقونا ولا نفارقكم).
[87] اُنظر أيضاً: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص49، مع اختلاف في العبارة. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج4، ص295. الشـريف المرتضـى، علي بن الحسين، تنزيه الأنبياء^: ص223ـ224. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص29ـ30.
[88] في مقتل أبي مخنف مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته (من).
[89] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (فرأى في وجوهنا الكآبة والحزن...).
[90] الأنفال: آية 42، و44.
[91] إشارة إلى الآية المباركة (وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا) سورة الاحزاب: 38. وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (الحمد لله كما هو أهله، إنّ أمر الله كان مفعولاً، وإنّ أمر الله كان قدراً مقدوراً، وإنّه كان امراً مقضياً).
[92] هكذا في الأصل، والصحيح (أمر).
[93] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (والله لو اجتمعت الإنس والجن على الذي كان أن يكون لما استطاعوا...).
[94] اُنظر ايضاً: لجنة الحديث في معهد باقر العلوم×، موسوعة كلمات الإمام الحسين×: ص294. وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (وناشدني في الله أن لا اُنفذ أمراً، ولا اُحرّك ساكناً، فأطعتُه، وكأنّما يجدع جادع أنفى بالسكاكين أو يشرح لحمي بالمناشير، فاطعته كرهاً...).
[95] البقرة: آية216.
[96] هكذا في الأصل، الصحيح (تنظروا).
[97] ضامَهُِ ضَيْماً: ظَلَمَهُ. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج5، ص1973 (ضام).
[98] وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (والآن كان صلحاً وكانت بيعة، ولننظر ما دام هذا الرجل حياً، فإذا مات نظرنا ونظرتم. فقلنا: والله يا أبا عبد الله، ما نحزن إلّا لكم أن تُضَاموا في حقّكم. ونحن أنصاركم ومحبّوكم، فمتى دعوتمونا أجبنا، ومتى أمرتمونا أطعناكم).
[99] هكذا في الأصل، والصحيح (دير هند). وهو دير هند الكبرى: ويُسمّى كذلك دير هند الأقدم، هو دير بنته هند بنت الحارث بن عمرو الكندي، أم عمرو بن المنذر، بالحيرة. وروى ياقوت عن عبد الله بن مالك الخزاعي أنّ يحيى بن خالد البرمكي خرج مع الرشيد إلى الحيرة لمشاهدة آثار قبر النعمان، فطالعا كتابة على أحد جدران الدير نصّها:
|
إنّ بني المنذر عام انقضوا |
اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج2، ص541ـ54. الموسوعة الحرة ويكيبيديا.
[100] هكذا في الأصل، والصحيح (قلى).
[101] هكذا في الأصل، والصحيح (المانعون).
[102] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته:
|
(فلا عن قلًى فارقتُ دار معاشر |
[103] هكذا في الأصل، وفي المطبوع، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (قضا)، والصحيح (قضاء).
[104] هكذا في الأصل، والصحيح (قرار).
[105] اُنظر أيضاً: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص150. ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج16، ص16. وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته:
|
(ولكن قضا
الرحمن في الخلق واقع |
[106] حُجر بن عدي بن معاوية بن جبلة، أبو عبد الرحمن الكندي، المعروف بحُجر الخير، أدرك النبي’، وهو من الذين شهد لهم النبي’ بأنّهم عصابةٌ من المؤمنين. صحب أمير المؤمنين×، وكان من أبرز شيعته، وشارك في جميع حروبه. وكان معاوية وعمّاله يسبّون علياً× على المنابر، وكان من عادة حجر بن عدي إذا سبّوا علياً عارضهم، وأثنى عليه. ففعل كذلك في إمرة زياد بالكوفة فأمسكه وأرسل به مع جماعة من أصحابه إلى معاوية، فأمر بقتله وثمانية من جماعته، فقُتِلوا بقرية عذراء سنة (51هـ)، ودُفِنوا فيها، وكان حجر هو الذي افتتحها. اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، الإصابة: ج2، ص32. القمي، عباس، الكنى والألقاب: ج1، ص304.
[107] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (وكان أول من لاقى الحسين× وندبه إلى القتال حجر بن عدي&، وذلك أنّه حضر عند الحسين× ذات يوم وأنشأ يقول:
|
أتاني رسول القوم من أرض آل مسكن يقول إمام الحق
أضحى مسالما |
[108] نسب البعض مطلع الأبيات إلى قيس بن سعد الأنصاري، ونسبها البلاذري لشاعر من همدان. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص70. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج4، ص292. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص196.
[109] الدهش: الذهول والوله والتحيّر. اُنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج3، ص398. وكأنّ مراده أنّه في الحرب التي يُذهَل فيها الورى لشدتها، بينما هو يطاعن برمحه الفرسان؛ كناية عن شجاعته وعدم اكتراثه بالحرب.
[110] هكذا في الأصل، والصحيح (سلمٌ).
[111] كذا الأصل، ولعل الصحيح (الغداة).
[112] اُنظر أيضاً: مجموعة من العلماء الأعلام (من علماء البحرين والقطيف)، وفيات الأئمة: ص109، وفيه:
|
(ونحن لمن
سالمت سلم ومن يكن |
[113] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (قال حجر: والله رأيتُ الإمام× قد أشرق نوره ثم قال: إنّ الناس ليس مثلك، ولا يحبّون ما تحبّ).
[114] هكذا في الأصل، والصحيح (ما).
[115] هكذا في الأصل، والصحيح (إليهم). وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (وخرج حجر من عند الحسين فاجتمع نفر من أهل الكوفة، ووجوه الشيعة، وكتبوا إلى الحسين× يعزّونه على مصابه بأخيه، فاجتمعوا في دار سليمان بن صُرد الخزاعي وكتبوا إليه كتاباً اوله...).
[116] سليمان بن صُرد بن الجون بن أبي الجون عبد العزّى بن منقذ السلولي الخزاعي، أبو مُطَرّف. كان اسمه في الجاهلية يسار، فسمّاه رسول الله’ سليمان. صحابي روى عن رسول الله’، وقيل: من كبار التابعين. من زعماء الشيعة وأجلائهم في الكوفة، شهد الجمل، وكان صاحب الراية في صفّين مع الإمام علي×، وقيل لم يشهد الجمل. كاتب الإمام الحسين×، وبايع مسلم بن عقيل، فلمّا علم ابن زياد بالمكاتبة سجنه مع جماعة من الشيعة، قيل كان عددهم أربعة آلاف أو أكثر؛ ولذا لم يشهد واقعة كربلاء. فلمّا سمعوا بهلاك يزيد كسروا السجن وخرجوا. وهو أوّل مَن نهض للأخذ بثأر الإمام الحسين×، وترأس التوّابين. استُشهد سنة 65هـ بعين الوردة، وهو ابن 93 سنة، قتله يزيد بن الحصين. اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج4، ص22. المفيد، محمد بن محمد، الجمل: ص52. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج2، ص649ـ650. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، أسد الغابة: ج2، ص351. ابن نما الحلي، جعفر بن محمد، ذوب النضار: ص73. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص152. النراقي، أبو القاسم، شعب المقال في درجات الرجال: ص273. المامقاني، عبد الله، تنقيح المقال: ج33، ص188ـ189. النمازي الشاهرودي، علي، مستدركات علم رجال الحديث: ج4، ص137. الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج9، ص283. القرشي، باقر شريف، حياة الإمام الحسين×: ج2، ص416. الطبسي، محمد جعفر، رجال الشيعة في أسانيد السنة: ص156.
[117] هكذا في الأصل، والصحيح (بنو).
[118] بنو جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي، وأُمّ جعدة هي أُمّ هانىء بنت أبي طالب. البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص151.
[119] هكذا في الأصل، ومثله في بقية الموارد والصحيح (أمةً).
[120] هكذا في الأصل، والصحيح (رُزِئوا به الرزء).
[121] هكذا في الأصل، والصحيح (الجليلة).
[122] هكذا في الأصل. والمُرجَأ: من رَجأ بمعنى أخّر، فيكون المعنى المؤخّر لإقامة الدين. ولعلّ المراد (والمرجوّ لإقامة الدين) من الرجاء. اُنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج6، ص174. ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة: ج2، ص494.
[123] آل عمران: آية186.
[124] هكذا في الأصل، والصحيح (خلفاً).
[125] هكذا في الأصل، والصحيح (المحزونون).
[126] هكذا في الأصل، والصحيح (المسرورون بسرورك).
[127] اُنظر أيضاً: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص151ـ152. اليعقوبي، أحمد ابن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص228. وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (إلى الحسين بن علي بن أبي طالب× من شيعته وشيعة أبيه×، أمّا بعد فإنّا نحمد الله الذي لا إله إلّا هو، ونسأله أن يصلي على محمد وآل محمد، وقد بلغنا وفاة أخيك الحسن×، فرحمه الله يوم وُلِد ويوم يموت ويوم يُبعَث حياً، وغفر الله له وضاعف حسناته، وعظّم الله له الأجر، وألحقه بدرجة جدّه وأبيه’، وضاعف لك الأجر بالمصاب، وجبر مصيبتك من بعده. فعند الله نحتسبه، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون ممّا أُصيبت به هذه الأمة عامّاً، وما رُزِيتَ به خاصة. ولقد رُزِئتَ بالرزء العظيم، وأُصبتَ بالمصاب الجليل، فاصبر يا أبا عبد الله على ما أصابك؛ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمورِ، وإنّك، والحمد لله، خلفٌ لمن قبلك، والله تعالى يُعطِي رشده لمن سلك سبيلك، ويهتدي بهدايتك. ونحن شيعتك المصابون بمصيبتك، المحزونون بحزنك، المسرورون بسرورك، المنتظرون لأمرك. شرح الله صدرك، وأعلا شأنك، ورفع قدرك، وردّ عليك حقَّك. والسلام ورحمة الله وبركاته).
[128] هكذا في الأصل، والصحيح (يختلف).
[129] هكذا في الأصل، والصحيح (صفقة يمينه).
[130] هكذا في الأصل، والصحيح (تلمني).
[131] هكذا في الأصل، والصحيح (فتصير).
[132] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (من معاوية بن أبي سفيان، أمّا بعد فقد بلغني عنك أمور وأسباب قد انتهت إليَّ، وأظنّها باطلة، ولعمري أنّه إن كان ما بلغني عنك كما طننتُ فأنت بذلك أسعد وبعهد الله أوفى، فلا تحملني على أن أقطعك؛ فإنّك متى تكدني أكدك، ومتى تكرمني أكرمك، ولا تشق عصى هذه الأمة، فقد خبرتَهم وبلوتَهم. فانظر لنفسك ولدينك، ولا يستخفنّك السفهاء الذين لا يعلمون. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته).
[133] هكذا في الأصل، والصحيح (السيئات).
[134] يقال: رَقَى: تملّق. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص367، (رقا).
[135] هكذا في الأصل، والصحيح (المشاؤون).
[136] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (أمّا بعد فقد وصلني كتابك، وفهمتُ ما ذكرتَ، ومعاذ الله أن أنقص عهداً عهده إليك أخي الحسن×. وأمّا ما ذكرتَ من الكلام فإنّه أوصله إليك الوشاة الملقون بالنمائم، والمفرّقون بين الجماعات؛ فإنّهم والله يكذبون).
[137] هكذا في الأصل، وفي المطبوع المتداول: (سوى)، وهو الصحيح.
[138] اُنظر أيضاً: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص155. الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّـي): ج1، ص252. الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص22.
[139] محمد بن السائب الكوفي الكلبي النسابة المعروف المتوفى سنة (146 هـ). اُنظر: القمي، عباس، الكُنى والألقاب: ج3، ص117. وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (الكليني).
[140] يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، أُمّه ميسون بنت بجدل ـ أو بحدل ـ الكلبيّة. وُلد سنة 25 أو 26 للهجرة. وكان شديد الأدمة، بوجهه أثر جدري. بويع له بعد هلاك أبيه في النصف من رجب أو قبله بيوم سنة 60 للهجرة، وهلك في النصف من ربيع الأول سنة 64هـ. وصفه سيد الشهداء× بأنّه: رجل فاسق، شارب الخمر، قاتل النفس المحترمة، مُعلن بالفسق. حكم ثلاث سنين وثمانية أشهر، وقيل: ثلاث سنين وستة أشهر، أو شهرين، ارتكب فيها أبشع الجرائم، فالأولى: جريمة قتل الإمام الحسين× وأهل بيته وأصحابه، وأخذ عياله سبايا تتقدّمهم رؤوس الشهداء. والثانية: واقعة الحرّة، حيث أمر جيشه باحتلال مدينة النبي’ وقتل مَن فيها من الصحابة والتابعين وغيرهم ممَّن لا يقرّ له بالطاعة، فأُبيحت المدينة لجيشه ثلاثة أيام. والثالثة: انتهاك حرمة مكّة المكرمة ورمي الكعبة المشـرفة بالمنجنيق وإحراقها. هلك سنة (64هـ)، وعُمره ثمان وثلاثون سنة، وانتهى حُكم آل أبي سفيان بعد هلاكه بمدة قصيرة. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص250، وص383. الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج4، ص37ـ38، وص40. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص255، وص258. ولشمس الدين بن طولون الدمشقي كتابٌ جمع فيه أخباره، سمّاه: قيد الشـريد من أخبار يزيد. وهو مطبوع.
[141] هكذا في الأصل، والصحيح (غائباً).
[142] حمص ـ بالكسر، ثمّ السكون والصاد مهملة ـ: مدينة سورية تعد ثالث مدينة بعد دمشق وحلب من حيث عدد السكان تقع على نهر العاصي. تبعد عن العاصمة من جهة الشمال حوالي (162كم). وهي منطقة زراعية وسياحية وأثرية مهمة، يقول عنها الحموي: (بلدٌ مشهور، قديمٌ كبير، مسوّر، وفي طرفه القبلي قلعة حصينة، على تلٍّ عالٍ كبيرة، وهي بين دمشق وحلب في نصف الطريق، يُذكّر ويُؤنّث، بناه رجلٌ يُقال له: حمص بن المهر بن جان بن مكنف). اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج2، ص302. السعيدي، محمد عبد الغني، من كربلاء إلى دمشق: ص485 وما بعدها.
[143] يقال أصيب بالنُفاثة، وهي ما ينفثه أي يلقيه المصدور، أي مَن به علة في صدره. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص241. الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: ج3، ص272، (نفث).
[144] هكذا في الأصل، وكذا في الموارد الآتية، والصحيح (الأشياء)، ونكتفي بالإشارة هنا اختصاراً.
[145] حريّ بالذكر: جدير بِأن يُذكَرَ. اُنظر: أحمد مختار، عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة: ج1، ص484، (حري).
[146] الرحمن: آية26ـ27.
[147] هكذا في الأصل، والصحيح (جاءني).
[148] هكذا في الأصل، والصحيح (بعهدي).
[149] كذا رسمت في الأصل.
[150] دَهَمَكَ أمر: غشيك أو فاجأك. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج12، ص211، ص212(دهم).
[151] هكذا في الأصل، والصحيح (بلادهم).
[152] هكذا في الأصل، والصحيح (لئلّا يتخلّقوا بأخلاقهم).
[153] هكذا في الأصل، والصحيح (عاملاً).
[154] وطّأتُ لك الأمر، إذا هيّأتُه. الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج7، ص467، (الوطء).
[155] هكذا في الأصل، والصحيح (رقاب).
[156] هكذا في الأصل، والصحيح (أربعة نفر).
[157] هكذا في الأصل، والصحيح (لا يبايعونك).
[158] عبد الرحمن بن أبي بكر، يُكنّى أبا عبد الله، شهد بدراً وأُحداً مع قومه كافراً، وقيل إنّه هو الذي قال لأبويه لما طلبا منه أن يسلم: «أحيوا لي عبد الله بن جدعان وعامر بن كعب ومشايخ قريش حتى أسئلهم عمّا يقولون»، فنزل فيه قوله تعالى: (ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) الأحقاف: الآية17. وقيل: بل نزلت في عبد الله بن عمر. اشترك في الهجوم على بيت الزهراء‘ بعد رسول الله’. خرج على أمير المؤمنين× في معركة الجَمَل مع أُخته عائشة. طلب منه معاوية أن يبايع يزيد فأبى، وخرج إلى مكّة، فمات بها قبل أن تتمّ البيعة ليزيد بن معاوية في سنة (53هـ)، أو (55هـ)؛ فذكره ـ هنا ـ في وصية معاوية حين هلاكه ليس بصحيح. اُنظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج2، ص824. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج35، ص36 – ص42. آل طاووس، أحمد بن سعد، عين العبرة في غبن العترة: ص51. الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج4، ص380.
[159] عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن، وُلِد قبل البعثة، أسلم ولم يشهد بدراً ولا أحداً، تخلف عن بيعة أمير المؤمنين علي×، ثم صار إلى معاوية فكان معه، قال لمعاوية لمّا قاتل أمير المؤمنين×: إنّي معكم ولستُ أُقاتل. بايع يزيد بن معاوية، ولم يخلعه لمّا خلعه أهل المدينة. طرق باب الحجاج لیلاً لیبایع لعبد الملك بن مروان، وقائلاً: سمعتُ رسول الله يقول: «مَن مات ولا إمام له مات ميتةً جاهلية»، لكنّ الحجاج احتقره، ومدّ له رجله فبایعه. مات بمكة سنة 73هـ، وعمره (86) سنة. اُنظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج8، ص99. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج3، ص950. أبو الفدا، إسماعيل، المختصر في أخبار البشر: ج1، ص171. القمي، عباس، الكُنى والألقاب: ج1، ص363. الميلاني، علي الحسيني، الإمام المهدي×: ص14.
[160] هكذا في الأصل، والصحيح (قراءة أو قرآن).
[161] عبد الله بن الزبير بن العوّام بن خويلد، أبو بكر، أُمّه أسماء بنت أبي بكر، وُلِد في السنة الأُولى للهجرة، وهو الكبش الذي بسببه استُبِيحت الكعبة ـ كما أخبر رسول الله’ ـ وكان بخيلاً، ضيّق العطاء، سيّء الخُلق، حسوداً، كثير الخلاف. شهد الجمل ضدّ أمير المؤمنين× مع أبيه وخالته عائشة. بُويع له بعد موت يزيد بن معاوية سنة (64هـ)، وقد سيطر على مصـر، والحجاز، واليمن، والعراق، وخراسان، وأكثرُ الشام. وعاصمة حكمه مكّة، وكانت له مع الأُمويين معارك كثيرة. وقد حبس محمد بن الحنفية، وعبد الله بن عباس بعد رفضهما البيعة له وهمّ بقتلهما، فأنجدهما جيش المختار. وانتهى أمره مقتولاً سنة (73هـ)، قتله الحجاج الثقفي. اُنظر: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج5، ص56. ابن حبّان، محمد، مشاهير علماء الأمصار: ص55. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج3، ص905. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج4، ص87.
[162] أغار إغارة الثعلب: إذا أسرع ودفع في عدوه. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج2، ص775، (غور).
[163] هكذا في الأصل، والصحيح (تطعه).
[164] هكذا في الأصل، والصحيح (تخرجه) أو (يخرجونه).
[165] اُنظر أيضاً: الدينوري، أحمد بن داوود، الأخبار الطوال: ص226. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص238ـ239. ابن عبد ربّه الأندلسي، أحمد بن محمد، العقد الفريد: ج4، ص175. ابن الأثير، عليّ بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص6. مع اختلاف يسير بينها.
[166] هكذا في الأصل، والصحيح (خير) وكذا المورد الذي بعده.
[167] يوجد سقط في هذا الموضع، وهو بحسب السياق كلمة (خالك).
[168] هكذا في الأصل، والصحيح (أبو).
[169] عمر، والمشهور: عمرو بن العاص بن وائل، أمّه ليلى المعروفة بالنابغة، أشهر بغي بمكة وأرخصهن أجرة، ولما وضعته ادّعاه ستة من كبار قريش كلهم أتوها، غير أنّ ليلى ألحقته بالعاص؛ لكونه أقرب شبهاً به، وأكثر نفقة عليها. وكان أبوه (العاص) من المستهزئين بالنبي’، وفيه نزلت: (ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ). أحد دُهاة العرب، ومن أشد الناس عداوة لآل بيت النبي’. بايع معاوية على قتال أمير المؤمنين× على أن يوليه مصـر. كشف عورته ليحقن دمه لما برز له أمير المؤمنين×، وله خدعة التحكيم في صفين، وهو المسؤول عن مقتل محمد بن أبي بكر رضوان الله عليه، وقد أُحرِق أمام عينيه. هلك سنة اثنتين ـ أو ثلاث ـ وأربعين، في خلافة معاوية؛ فذكره في وصية معاوية لعنه الله، وأن تُؤخَذ منه البيعة بعد الدفن ليس بصحيح؛ لعدم انسجامه مع تاريخ وفاته. اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج7، ص494. الثقفي، إبراهيم بن محمد، الغارات: ج1، ص272، وص284. ابن حبّان، محمد، الثقات: ج3، ص266. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، الإصابة: ج4، ص540. الأميني، عبد الحسين بن أحمد، الغدير: ج2، ص120ـ121.
[170] جاءت وصية معاوية لولده يزيد لعنهما الله في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، مع اختلاف كبير بينهما في الألفاظ والمضمون.
[171] هكذا في الأصل، والصحيح (أخصّائه).
[172] الضحّاك بن قيس بن خالد الفهري، أبو أنيس ـ ويُقال: أبو أُميّة ـ من أعداء أمير المؤمنين×، شهد صفين مع معاوية، وكان على أهل دمشق ـ وهم القلب ـ كان على شرطة معاوية، وقد أغار على سواد العراق، وأقام بهيت ثم عاد. وبعد أن حكم معاوية العراق ولّاه الكوفة سنة 53هـ، وهو الذي صلّى على معاوية. ولما مات يزيد بن معاوية دعا الضحاك أهل الشام لعبد الله بن الزبير؛ فكتب إليه عبد الله بن الزبير بولايته على الشام. ولمّا بويع لمروان بن الحكم سار إليه، فالتقوا بمرج راهط فاقتتلوا فقُتل الضحاك سنة 65هـ، وقيل: 64 هـ. اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج7، ص411. الكوفي، إبراهيم بن محمد، الغارات: ج2، ص421ـ422. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج24، ص280. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج3، ص214.
[173] أي مسرعاً. اُنظر: ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج1، ص244، (جدد).
[174] دِمَشق: تعتبر من أقدم المدن المأهولة في العالم حتى الآن وهي عاصمة قديماً وحديثاً وتعتبر أكبر المدن السورية مساحةً، وثاني مدينة بعد حلب من حيث عدد السكان؛ فعدد سكانها أكثر من مليوني نسمة في آخر إحصاء. واحتلّت دمشق منذ القدم مكانة مرموقة في مجال العلم والثقافة والأدب وغيرها. تضمّ العديد من المعالم القديمة الإسلامية وغير الإسلامية. أشهر معالمها المسجد الأموي الكبير، يقول عنها الحموي: «البلدة المشهورة قصبة الشام، وهي جنة الأرض بلا خلاف؛ لحسن عمارةٍ، ونضارة بقعةٍ، وكثرة فاكهةٍ، ونزاهة رقعةٍ، وكثرة مياهٍ، ووجود مآزب. قيل: سُمِّيت بذلك لأنّهم دمشقوا في بنائها أي أسرعوا». اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج2، ص463. السعيدي، محمد عبد الغني، من كربلاء إلى دمشق: ص598 وما بعدها.
[175] هكذا في الأصل، والصحيح (ميت).
[176] اُنظر أيضاً: الدينوري، أحمد بن داوود، الأخبار الطوال: ص226. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص242. ابن الأثير، عليّ بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص8ـ9.
[177] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (وطوى الكتاب وسلّمه للضحاك بن قيس الفهري وأمره أن يسلّمه إلى ولده، ثم أنّه لم يلبث حتى هلك، وذلك ليلة النصف من رجب سنة ستين من الهجرة، وضجت دمشق لموته. وخرج الضحاك بن قيس وكان صاحب جيشه ومعه أكفانه، فصعد المنبر خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبي فصلى عليه، ثم قال: أيّها الناس إنّ معاوية كان عبد الله فنصره على عدوّه، وفتح به بلاده. وقد دعاه إليه فأجابه. وهذه أكفانه وها نحن مدرجوه فيها ومدخلوه قبره، ثم ننصرف عنه ونخلي بينه وبين ربه، فمن أحب أن يشاهد فليحضر وقت الظهر).
[178] البريد: الرّسول. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حمّاد، الصحاح: ج2، ص447، (برد)
[179] «يحثّ: يسرع». المصدر السابق: ج1، ص278، (حثّ).
[180] مدنفاً: الدّنف: المرض الملازم. اُنظر: المصدر السابق: ج4، ص1361، (دنف)
[181] تبيد: أي تهلك. الطريحي، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين: ج3، ص18، (بيد).
[182] هكذا في الأصل، في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته:
|
(فمادت الأرض أو كادت تميد بنا |
أي تحرّكت أو تمايلت. اُنظر: الطريحي، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين: ج2، ص541، (ماد)
[183] هكذا في الأصل، والصحيح (أتيت). ولعلّه من وثب بمعنى طفر. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج1، ص231.
[184] هكذا في الأصل، والصحیح (ومَن طلعا).
[185] هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، كانت هند زوجة الفاكه بن المغيرة، فاتّهمها بالزنا وطلّقها، ثمّ تزوّجت من بعده أبا سفيان، وكانت تأخذ المال من جيبه بدون إذنه. شهدت أُحداً كافرةً، ولمّا استشهد حمزة بن عبد المطلب وثبت عليه، فمثّلت به، وشقّت بطنه، واستخرجت كبده، فشوت منه وأكلت، تُوفيت في خلافة عمر. اُنظر: الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج25، ص69ـ72. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج4، ص1922.
[186] اُنظر أيضاً: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج5، ص155ـ156. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص242. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص6ـ7. ابن الأثير، عليّ بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص9. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص153. والأبيات تختلف لفظاً وعدداً.
[187] هكذا في الأصل، والصحيح (يقضِ).
[188] اُختُلِف في أنّ يزيد رجع من غيبته قبل هلاك أبيه لعنهما الله، كما تقدّم في رواية الكلبي، أو أنّ رجوعه كان بعد هلاك أبيه كما ذكره هنا عن أبي مخنف. اُنظر: ابن خياط، خليفة، تاريخ خليفة ابن خياط: ص172. الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج4، ص37.
[189] هكذا في الأصل، وفي بقية الموارد الآتية، والصحيح (فسار).
[190] هكذا في الأصل، والصحيح (كسيرتهم).
[191] ومن عجيب أمره، وشدّة عداوته وحسده أنّه لم يشر في كلامه هذا إلى ولاية أمير المؤمنين×، مع أنّه سيدهم، بل ليس الوليّ غيره بعد رسول الله’.
[192] هكذا في الأصل، والصحيح (أبو).
[193] هكذا في الأصل، والصحيح (ويؤسس).
[194] هكذا في الأصل.
[195] استوسق به الأمر: أي اجتمع واستقر الأمر والملك بسببه وبواسطته. ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج5، ص185، (وسق).
[196] أَشْعَثُ الشَّعْرِ: مُغْبَرٌّ، مُتَلَبِّدٌ. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج2، ص160، (غبر).
[197] الغُبْرَة: لَوْنُ الغُبار؛ والأَغْبَرُ هو اغْبِرار اللوْن يَغْبَرُّ للهمِّ ونحوه. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج5، ص5، (غبر).
[198] هكذا في الأصل، والصحيح (فرقى) بمعنى صعد. الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج5، ص211، (رقي).
[199] هكذا في الأصل، والصحيح (مآثره)
[200] هكذا في الأصل، والصحيح (مسيئكم).
[201] هكذا في الأصل، والصحيح (مجرمكم).
[202] هكذا في الأصل، والصحيح (معتذراً).
[203] هكذا في الأصل، والصحيح (متحيرين).
[204] عبد الله بن همام بن نبيشة بن رياح السلولي، من شعراء الدولة الأموية، وكان يقال له العطّار لحسن شعره. بقي إلى أيام سليمان بن عبد الملك، أو بعده. اُنظر: الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج4، ص143.
[205] أجزل له العطاء، أي أكثر. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج4، ص1655، (جزل).
[206] السنية: الرفيعة. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج6ص2384، (سنا).
[207] هكذا في الأصل، والصحيح (اكتفِ).
[208] هكذا في الأصل، وفي العبارة سقط، والصحيح (السلام عليك).
[209] هكذا في الأصل، والصحيح (افظع). يقال: أَفْظَعَ الأَمرُ: اشتَدَّ وشَنُعَ وجاوز المِقدارَ. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج8، ص254، (فظع).
[210] هكذا في الأصل، وفي مروج الذهب (مقة) وفي أنساب الاشراف والفتوح (ثقة)، وسيأتي تخريج مصادرها.
[211] هكذا في الأصل، والصحيح (حباء). أي عَطاء بلا مَنٍّ ولا جَزاءٍ. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج14، ص162(حبا).
[212] هكذا في الأصل، والصحيح (لا رزء أعظم)، كما ذكره ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء. اُنظر: ابن قتيبة الدينوري، أحمد بن داود، الشعر والشعراء: ج2، ص638.
[213] هكذا في الأصل، والصحيح (عقبى)، وسيأتي مثله في موارد كثيرة يكتب الألف الممدودة مكان الألف المقصورة وبالعكس.
[214] هكذا في الأصل، والصحيح (معاوية الباقي)، كما في سائر المصادر. اُنظر: الجاحظ، عمرو بن بحر، البيان والتبيين: ص281. القيرواني الأزدي، الحسن بن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه: ج2، ص155.
وهو معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، أبو ليلى. أخذ له أبوه البيعة من الناس، فأقرّ عمّال أبيه، ولم يولِّ أحداً، وكانت مدة بقائه بعد أبيه أربعين ليلةً. ولم يزل مريضاً حتى مات، وهو ابن إحدى وعشـرين سنة، ويُقال: عشرين سنة، أو ثمان عشرة سنة. صلّى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان. وقد ذهب بعض المحققين إلى أنّه رفض الخلافة، وأنه لمّا ولي الخلافة صعد المنبر، فقال: (إنّ هذه الخلافة حبل الله، وإنّ جدّي معاوية نازع الأمر أهله، ومن هو أحق به منه عليّ بن أبي طالب×، وركب بكم ما تعلمون، حتى أتته منيته فصار في قبره رهيناً بذنوبه، ثم قلّد أبي الأمر، وكان غير أهل له، ونازع ابن بنت رسول الله’ فقُصِف عمره، وانبتر عقبه، وصار في قبره رهيناً بذنوبه. ثم بكى، وقال: من أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه، وبؤس منقلبه، وقد قتل عترة رسول الله’، وأباح الخمر، وخرب الكعبة، ولم أذق حلاوة الخلافة فلا أتقلّد مرارتها، فشأنكم أمركم. والله لئن كانت الدنيا خيراً فقد نلنا منها حظاً، ولئن كانت شراً، فكفى ذرية أبي سفيان ما أصابوا منها. قال ابن حجر: ثم تغيّب في منزله حتى مات بعد أربعين يوماً). وقيل: إنّه قُتِل، كما قُتِل معلّمُه؛ لاتهامه بتعليمه الزهد بالدنيا. اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج4، ص169. العصفري، خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط: ص196. ابن حجر الهيتمي، أحمد، الصواعق المحرقة: ص224. البياتي، جعفر، الأخلاق الحسينية: ص159. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب (معاوية الثاني) للمحقق جعفر البياتي، ومقال (تنازل معاوية الثاني عن السلطة أسبابه وتداعياته) للدكتور جابر رزاق غازي، مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد السادس عشر، 2010م.
[215] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته:
|
(اصبر يزيد لقد
لاقيتَ نازلة |
[216] هكذا في الأصل، والصحيح (بايعه الناس)، وسيأتي مثله.
[217] العُنُق: الجماعة الكثيرة من الناس. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج10، ص273، (عنق).
[218] اُنظر أيضاً: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج5، ص156ـ157. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص9. ابن عبد ربّه الأندلسي، أحمد بن محمد، العقد الفريد: ج4، ص175ـ176. المسعوديّ، عليّ بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر: ج3، ص65ـ66. الحصري القيرواني، إبراهيم بن علي، زهر الآداب وثمر الألباب: ج1، ص91. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج46، ص246.
[219] مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية. أبوه الحكم ـ عم عثمان بن عفان ـ من المؤلّفة قلوبهم. جدته لأبيه الزرقاء بنت موهب، من ذوات الرايات التي يُستدلّ بها على ثبوت البغاء؛ فلهذا كانوا يُذمّون بها. ولد بعد الهجرة بسنتين وقيل بأربع. طرده رسول الله’ وأباه من المدينة إلى الطائف. رَوى الحاكم: بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف، قال: كان لا يُولد لأحدٍ مولود إلا أُتى به النبيَّ’ فدعا له، فأُدخل عليه مروان بن الحكم، فقال: هو الوزغ ابن الوزغ، الملعون ابن الملعُون. كتب لعثمان، وولِي إمرة المدينة أيام معاوية. بُوِيع له بالخلافة بعد موت معاوية الثاني. تزوّج من امرأة يزيد بن معاوية آمنة بنت سعيد بن العاص، أُمّ خالد بن يزيد، فلمّا عرّض بولدها خالد قتلته خنقاً، بمعونة إمائها في رمضان سنة (65هـ)، وكانت ولايته تسعة أشهر. اُنظر: الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك: ج4، ص479. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج1، ص359. ابن عساكر، علي بن الحسن، ترجمة الإمام الحسين×: ج57، ص275. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص194. ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج6، ص148. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج10، ص82
[220] الصحيح أنّ معاوية عزل مروان بن الحكم عن ولاية المدينة سنة 57هـ، ونصب مكانه ابن أخيه الوليد بن عتبة، فبقي عليها حتى مات معاوية، وبُوِيع ليزيد. اُنظر: العصفري، خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط: ص170. ابن عساكر، الحسن بن علي، تاريخ مدينة دمشق: ج57، ص242.
[221] الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان بن حرب الأُموي، من رجالات بني أُميّة، وَليَ لعمّه مُعاوية المدينة سنة (57هـ)، وبعد موت مُعاوية كتب إليه يزيد أن يأخذ البيعة له من الإمام الحسين×؛ ما اضطرّ الإمام للخروج من المدينة. عزله يزيد لعنه الله لتفريطه في أخذ البيعة من الإمام الحسين×. أراده أهلُ الشام للخلافة بعد وفاة معاوية الثاني، فتقدّم ليصلي على جنازته فطُعِن بعد التكبيرة الثانية، ومات، وقيل: هلك بالطاعون سنة (64هـ). وقد ذكره ابن عبد البر باسم: الوليد بن عقبة. اُنظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج3، ص1388. الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص73، وص534. الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: ج5، ص267. ابن خلدون، عبد الرحمن، تاريخ ابن خلدون: ج3، ص21.
[222] هكذا في الأصل، والصحيح (سعيد).
[223] عمر ـ والصحيح: عمرو ـ بن سعيد بن العاص بن أُميّة، الأُموي، أبو أُميّة ـ المعروف بالأشدق ـ كان والي مكة والمدينة لمعاوية وابنه يزيد. أحد جبابرة بني أُميّة، ورد في حقّه حديث رسول الله’ الذي رواه أبو هريرة: ليرعفنّ على منبرى جبّارٌ من جبابرة بنى أُميّة يسيل رعافه. قال: فحدّثني مَن رأى عمرو بن سعيد بن العاص رعف على منبر رسول الله’، حتّى سال رعافه، هلك سنة (70هـ). اُنظر: ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج2، ص522. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج5، ص78.
[224] النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي، وُلِد سنة (2هـ)، تخلّف عن بيعة الإمام علي× بعد عثمان. قدِم على أهل الشام بقميص عثمان الذي قُتِل فيه مخضّباً بدمه. بقي عند معاوية، فكان معه في صفّين. ولّاه معاوية الكوفة سنة (59هـ)، وبقيَ عليها حتى هلك معاوية، ثمّ صار والياً عليها ليزيد. عزله يزيد واستخلف مكانه عبيد الله بن زياد قُبيل مجيء الإمام الحسين×، ثم صار والياً على حمص، ولمّا هلك يزيد صار زُبَيرياً، فدعا أهل حمص لخلافة عبد الله بن الزبير، فلمّا بلغه هزيمة الزبيريين في وقعة راهط؛ خرج عن حمص هارباً فاتّبعه خالد بن عدي الكلابي فيمن خفّ معه من أهل حمص، وقتله سنة (64هـ)، وبعث برأسه إلى مروان. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج3، ص561، وج4، ص233، وص265. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج4، ص1499.
[225] الرَّيّ: مدينة تاريخية مشهورة من أمهات البلاد، تقع بالقرب من طهران في إيران. وهي أكبر من أصفهان بكثير، تفانى أهلها بالقتال فى عصبية المذاهب حتى صارت كأحد البلدان، وهي اليوم جزء من طهران. ينسب إليها عدد من علماء المسلمين ومنهم فخر الدين الرازي التيمي البكري، صاحب التفسير الكبير، والكيميائي محمد بن زكريا الرازي. اُنظر: البغدادي، عبد المؤمن، مراصد الاطّلاع: ج2، ص651. الموسوعة الحرة ويكيبيديا.
[226] عمر بن سعد بن أبي وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي، وأمه مارية بنت قيس بن معدي كرب بن أبي الكيسم بن السمط بن أمرئ القيس من كندة. سيّره عبيد الله بن زياد على أربعة آلاف لقتال الدّيلم، وكتب له عهداً بولاية الرّي، ولمّا علم ابن زياد أنّ الإمام الحسين× متّجهاً نحو الكوفة كاتب ابن سعد وأمره بالرّجوع، فامتثل وقاد الجيش لمحاربة الإمام الحسين×، وارتكب أبشع الجرائم في تلك الواقعة. وصفه أمير المؤمنين× ـ وهو طفل ـ بأنّه السخل الذي يقتل الحسين×. ذبحه أصحاب المختار على فراشه سنة (66 هـ)، وبذلك تحقّقت دعوة الإمام الحسين× حيث قال: (قطع الله رحمك، وسلّط عليك من يذبحك على فراشك). اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج5، ص168. البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج6، ص406. المزي، يوسف، تهذيب الكمال: ج21، ص356. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج5، ص47.
[227] عبيد الله بن زياد بن أبيه، وابن مرجانة، قبيح الـسريرة، وكان غلاماً جباناً سفيهاً، سفك الدماء سفكاً شديداً، ولِيَ البصرة لمعاوية سنة 55 هـ، وله ثنتان وعشـرون سنة، ثمّ ولي الكوفة ليزيد سنة 60 هـ، وقد أقدم على جريمة قتل الإمام الحسين× وأهل بيته وأصحابه. قتل في يوم العاشر من المحرم سنة 67 هـ بالموصل، وهو اليوم الذي استشهد في الإمام الحسين×، ضربه إبراهيم بن مالك الأشتر فقدّه نصفين وهو لا يعرفه، وأنفذ برأسه ورؤوس قادته إلى المختار. وصح من حديث عمارة بن عمير، قال: جيء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه، فأتيناهم وهم يقولون: قد جاءت قد جاءت، فإذا حية تخلل الرؤوس حتى دخلت في منخر عبيد الله، فمكثت هنية، ثم خرجت، وغابت، ثم قالوا: قد جاءت، قد جاءت، ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثاً. اُنظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص264. الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص546 وص549.
[228] هكذا في الأصل، والصحيح (فبايعه).
[229] هكذا في الأصل، والصحيح (خلا).
[230] هكذا في الأصل، والصحيح (هؤلاء).
[231] لم يذكر الرابع، وهو عبد الرحمن بن أبي بكر، كما صرّح به المؤلف فيما سبق، وقد أشرنا فيما تقدّم إلى أنّ عبد الرحمن مات قبل موت معاوية بخمس سنوات أو أكثر.
[232] هكذا في الأصل، والصحيح (فاضرب).
[233] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (فأنفذ الكتاب مع رجل من أصحابه). وفي عبارة المتن تشويش، والصحيح (ودفعه يزيد مع عبد الله بن عمرو بن أويس العامري ـ عامر بن لؤي ـ)، كما في غيره من المصادر. وقوله (عامر بن لؤي) توضيح للعامري، أي نسبة لعامر بن لؤي القرشي. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج5، ص299. ابن عساكر، الحسن بن علي، تاريخ مدينة دمشق: ج28، ص211. وج31، ص235. المزي، تهذيب الكمال: ج6، ص414.
[234] جَدّ في السير: إذا اهتم به وأسرع فيه. ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج1، ص244، (جدد).
[235] الثابت عند المؤرخين أنّ قدوم كتاب يزيد لعنه الله إلى المدينة كان قبل ذلك؛ لأنّ خروج الإمام الحسين× من المدينة إلى مكة كان في ليلة الثامن والعشرين من رجب، ودخوله مكة في الثالث من شعبان. وكان خروج ابن الزبير لعنه الله ليلة السابع والعشرين من رجب. وهذا يعني أنّ وصول الكتاب كان قبل هذا التاريخ، أي في اليوم السادس والعشرين من رجب أو قبله. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص160. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص286. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج1، ص396.
[236] فضّ الكتاب: فتحه. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص692، (فضض).
[237] هكذا في الأصل، والصحيح (وقرأه).
[238] هكذا في الأصل، والصحيح (وأنفذ) أو (فأنفذ).
[239] هكذا في الأصل، والصحيح (واستدعى).
[240] اُنظر ايضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص17ـ18. البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج5، ص299ـ300. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص250ـ251. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الملوك والأُمم: ج5، ص322ـ323.
[241] هكذا في الأصل، والمراد (ما أقبح).
[242] هكذا في الأصل، والصحيح (أحدٌ).
[243] هكذا في الأصل، والصحيح (فتًى).
[244] هكذا في الأصل، والصحيح (فرجى).
[245] هكذا في الأصل، والصحيح (الرأي).
[246] هكذا في الأصل، والصحيح (فعلوا).
[247] هكذا في الأصل، والصحيح (تؤخّرهم).
[248] هكذا في الأصل، والصحيح (رقاب).
[249] هكذا في الأصل، والصحيح (أصبحوا).
[250] هكذا في الأصل، والصحيح (أحد خبراً).
[251] الوارد في كتب التاريخ أنّ الإمام الحسين× لم يعده بالبيعة، وإنّما قال له بأنّ مثله لا يبايع سراً، ولا تُقبَل منه، وطلب منه أن يدعوهم مع الناس. وهذا الكلام لا يعني أنّه× سيبايع. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص250. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص14ـ15. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص33ـ34.
[252] الظاهر بحسب السياق أنّ المراد به أبو مخنف.
[253] نقول: في رواية الطبري كان خروج ابن الزبير إلى مكة قبل الإمام الحسين× بليلة، حيث قال: وخرج ابن الزُّبير مِن تحت الليل، فأَخذ طريق الْفُرْع هو وأخوه جعفر ليس معهما ثالث، وتجنَّب الطَّريق الأَعظم؛ مخافة الطَّلب، وتوجَّه نحو مكَّة...). ثم قال: (فخرج حسين مِن تحت ليلته، وهي ليلة الأَحد ليومين بقيا من رجب سنة ستين، وكان مخرج ابن الزُّبير قبله بليلة...). الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص252.
[254] هكذا في الأصل، والصحيح (متوجّهون).
[255] هكذا في الأصل، والصحيح (فبايع).
[256] اُنظر أيضاً: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص254. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص17. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص158.
[257] عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو العباس، الصحابي الجليل، وُلِد بمكة، ونشأ في بدء عصر النبوّة ملازماً لرسول الله’، فأكثر عنه حفظ الأحاديث وروايتها، وشَهِد مع أمير المؤمنين× الجمل وصفّين والنهروان، وكفّ بصـره آخر عمره، سكن الطائف بعد أن همّ بقتله ابن الزبير بمكة، وتُوفّي بها سنة (68هـ). اُنظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج3، ص933. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج4، ص95.
[258] جابر بن عبد الله الأنصاري السلمي المدني، كُنيته أبو عبد الله، أمه نسيبة بنت عقبة، وُلِد سنة (16) قبل الهجرة، كان هو وأبوه من السبعين الذين شهدوا بيعة العَقَبة الثانية، وشهد مع رسول الله’ (19) غزوة، وكان من المنقطعين إلى أهل البيت^. روى عن الصدّيقة الزهراء‘ حديث اللَّوح الذي حمل أسماء الأئمّة^ تعييناً من الله تبارك وتعالى، نزل به جبرئيل× على النبيّ’. قيل: إنّه أوّل مَن زار قبر أبي عبد الله الحسين× بعد شهادته. تُوفِّي سنة (78هـ)، عن عمرٍ بلغ (94) سنة، وكان آخر مَن تُوفّي من الصحابة في المدينة. اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص527. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج1، ص219ـ220. الباجي المالكي، سليمان بن خلف، التعديل والتجريح: ج1، ص455. الطبري، محمد بن أبي القاسم، بشارة المصطفى: ص125. الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج4، ص46. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج2، ص104.
[259] هكذا في الأصل، والصحيح (راضٍ).
[260] هكذا في الأصل، والصحيح (فبايع).
[261] هكذا في الأصل، والصحيح (المسوَّر).
[262] هكذا في الأصل، والصحيح: المسوّر بن مخرمة الزهري، ابن أخت عبد الرحمن بن عوف. وُلِد بمكة بعد الهجرة بسنتين. وكان فقيهاً من أهل العلم والدين، وكان هواه في الشورى مع الإمام علي×. أقام بالمدينة إلى أن قُتل عثمان، ثمّ سار إلى مكة، فلم يزل بها حتى مات معاوية، وكره بيعة يزيد، قُتل المسور وهو يُصلّي في الحِجر إسماعيل بعد أن أصابه حجر منجنيق رماه جيش ابن النمير، سنة 64هـ. اُنظر: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، أُسد الغابة: ج4، ص365. المزي، يوسف، تهذيب الكمال: ج27، ص583. الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص391. وفي رواية الطبري أنّ الذي بايع بعد ابن عمر هو ابن عباس، ولم يذكر غيره. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص254.
[263] هكذا في الأصل، والصحيح (جاء).
[264] هكذا في الأصل، والصحيح (مجتمعون).
[265] هكذا في الأصل، والصحيح (مقبلاً).
[266] هكذا في الأصل، والصحيح (قائلون).
[267] تقدّم أنّ عبد الرحمن قد مات في أيام معاوية.
[268] هكذا في الأصل، ولعل الصحيح (فأدخل).
[269] هكذا في الأصل، والثانية زائدة.
[270] هكذا في الأصل، والصحيح (قال).
[271] هكذا في الأصل، والصحيح (أن أدخل).
[272] هكذا في الأصل، والصحيح (ورمى).
[273] يقال جلد به: أي رمي به إلى الأرض، وضرب به الأرض. اُنظر: ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج1، ص285، (جلد). الأحمدي، موسى بن محمد، معجم الأفعال المتعدية بحرف: ص36.
[274] هكذا في الأصل، والصحيح (فقال له).
[275] «الزرقاء بنت موهب، جدّة مروان بن الحكم لأبيه، وكانت من ذوات الرايات التي يُستدلّ بها على ثبوت البغاء؛ فلهذا كانوا يُذمّون بها». ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص194.
[276] هكذا في الأصل، والصحيح (كاذب).
[277] هكذا في الأصل، والصحيح (خصميَّ).
[278] الوَيْلُ: كلمة عذاب. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج5، ص1846، (ويل).
[279] ورد في مثير الأحزان أنّ الإمام الحسين× أجاب مروان بقوله: (ويلي عليك يا بن الزرقاء، أنت تأمر بضرب عنقي! كذبتَ ولؤمتَ. نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، ويزيد فاسق، شارب الخمر، وقاتل النفس. ومثلي لا يبايع لمثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أيّنا أحق بالخلافة والبيعة...). ابن نما الحلّي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص14. وقريب منه ما في اللهوف. اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص17.
[280] «هنات وهنات: أي شدائد وأمور عظام». ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج5، ص279، (هنا).
[281] هكذا في الأصل، والصحيح (رؤوس).
[282] هكذا في الأصل، والصحيح (علا).
[283] هكذا في الأصل، والصحيح (فسمع أهله..).
[284] اُنظر أيضاً: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص251.
[285] علي الأكبر، ابن الحسين بن علي بن أبي طالب^، كنيته: أبو الحسن، وُلِد في خلافة عثمان، أو في سنة: 33هـ، فيكون عمره حين استشهد ثمان وعشـرون سنة. كان من أعظم شخصيات أهل البيت^، وكان كريماً سخياً، يقصده الناس من كلّ مكان، ذاع صيته في أرجاء بلاد المسلمين؛ حتى أنّ معاوية يرى أنّه أولى منه بالخلافة في حادثة مفصّلة. وكان أشبه الناس بجدِّه رسول الله’ خَلقاً وخُلقاً ومنطقاً ـ كما قال أبوه سيد الشهداء× ـ . قيل: إنّه أوّل شهيد من بني هاشم في عاشوراء بعد الحملة الأولى. واختُلِف في كونه أكبر أبناء الإمام الحسين× أم الإمام السجاد×، فقيل: إنّه الأكبر، وهو قول علماء ومؤرخي العامة، ووافقهم من علماء الإمامية ومحققيهم: ابن إدريس الحلي، ابن شهرآشوب، النسّابة المعروف السيد المرعـشي النجفي، السيد عبد الرزاق المقرم، الشيخ السند، وغيرهم. وقد أحصى المقرم في كتابه (علي الأكبر) ثمانية وعشـرين مصدراً من مصادر الفريقين ينصّ على أنّ المقتول في كربلاء هو الأكبر سناً.
وقيل: إنّ الأكبر هو زين العابدين×. وهو قول أغلب علماء الإمامية. اُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، علی بن الحسین، مقاتل الطالبيين: ص52. القاضي المغربي، النعمان بن محمد، شرح الأخبار: ج3، ص154. الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص226. الخزاز القمي، علی بن محمد، كفاية الأثر: ص234. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص114. الطوسي، محمد بن الحسن، الأبواب (رجال الطوسي) : ص102. الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعلام الورى: ج1، ص470. المازندراني، محمد صالح، شرح أصول الكافي: ج6، ص318. السماوي، محمد بن طاهر، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص49. المقرم، عبد الرزاق، علي الأكبر: ص22ـ28. المرعشي، شهاب الدين، شرح إحقاق الحق: ج27، ص466. ج33، ص664. الكرباسي، محمد صادق، دائرةالمعارف الحسينية (معجم أنصار الحسين ـ النساء) : ج3، ص145 وما بعدها.
[286] تقدّمت ترجمته وهو الإمام علي بن الحسين زين العابدين× في ص45.
[287] العباس بن علي بن أبي طالب×، من أعظم شخصيات أهل البيت^، وُلِد سنة ست وعشـرين من الهجرة، وأُمّه أُمّ البنين فاطمة بنت حزام، ويُكنّى بأبي الفضل، عاش مع أبيه أربع عشـرة سنة، ومع أخيه الإمام الحسن× أربعاً وعشـرين سنة، ومع أخيه الإمام الحسين× أربعاً وثلاثين سنة، وذلك مدّة عمره، وكان× شجاعاً فارساً، وسيماً جسيماً. قال فيه الإمام زين العابدين×:... وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. وقال الإمام الصادق×: كان عمّنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أخيه الحسين×، وأبلى بلاء حسناً ومضـى شهيداً. له أبناء وذرية. اُنظر: السماوي، محمد بن طاهر، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص56. الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج10، ص255.
[288] يحيى بن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين× أمه أسماء بنت عميس. لا عقب له، وقيل إنّه مات في حياة أمير المؤمنين×. اُنظر: الزبيري، أبو عبد الله، نسب قريش: ج1، ص44. ابن فندمه، علي ابن زيد البيهقي، لباب الأنساب والألقاب والأعقاب: ج1، ص19. الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج8، ص220، عنه.
[289] هكذا في الأصل، والصحيح (أبا).
[290] أبو بكر بن علي بن أبي طالب×، واسمه عبد الله أو عبيد الله أو محمد الأصغر، وقيل لا يعرف اسمه، وأُمّه ليلى بنت مسعود النهشلية التميمية. وذكر الشيخ المفيد أنّه أخو عبد الله بن عليّ÷، وأمهما ليلى بنت مسعود الثقفية. أول مَن برز من أخوة الإمام الحسين×، قتله زحر ابن بدر النخعي، وقيل عبد الله بن عقبة الغنوي، أو رجل من همدان. ورود ذكره في الزيارة المروية عن السيد المرتضى&: (السلام عليك يا أبا بكر بن علي بن أبي طالب× ورحمة الله وبركاته، ما أحسن بلاءك، وأزكى سعيك، وأسعدك بما نلت من الشرف، وفزت به من الشهادة، فواسيت أخاك وإمامك، ومضيت على يقينك حتى لقيت ربك صلوات الله عليك وضاعف الله ما أحسن به إليك)، وقيل شُكّ في قتله. اُنظر: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص112. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص125. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص36، وج98، ص245. السماوي، محمد ابن طاهر، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص70. الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج1، ص608. وج2، ص302. شمس الدين، محمد مهدي، أنصار الحسين: ص136.
[291] إبراهيم بن علي بن أبي طالب^. ذكره أبو العرب في المحن وأبو الفرج في مقاتل الطالبيين وغيرهما: واللفظ للثاني عن المدائني... عن علي بن أبي حمزة قال: أنّه قتل يومئذ إبراهيم بن علي ابن أبي طالب×وأمه أم ولد. وما سمعتُ بهذا من غيره، ولا رأيتُ لإبراهيم في شيء من كتب الأنساب ذِكْراً. أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص57. واُنظر أيضاً: أبو العرب، محمد بن أحمد، المحن: ج1، ص155. ابن عبد ربّه الأندلسي، أحمد بن محمد، العقد الفريد: ج5، ص134. الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص53.
[292] لم نعثر له على ترجمة.
[293] جعفر بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب^، أُمّه فاطمة أُمّ البنين. ورد اسمه والسلام عليه في زيارة الشهداء الصادرة عن الناحية المقدّسة «السلام على جعفر بن أمير المؤمنين، الصابر بنفسه محتسباً، والنائي عن الأوطان مغترباً، المستسلم للقتال، المستقدم للنزال، المكثور بالرجال، لعن الله قاتله هاني بن ثبيت الحضرمي»، وكذا في الزيارة الرجبية التي رواها السيد ابن طاووس. استُشهِد وعمره إحدى وعشـرون سنة. وقيل: تسع عشـرة سنة. ولا عقب له. وقد اختُلف فيمَن قتله، فقيل: خولي بن يزيد الأصبحي، وقيل: هاني بن ثبيت الحضـرمي (لعنهما الله). اُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص54. ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج3، ص74، وص343. السماوي، محمد بن طاهر، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص69. الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم الرجال: ج2، ص172.
[294] عمر بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب^، أمه الصهباء التغلبية، وقيل: ليلى بنت مسعود النهشلية. روى عن أبيه×. من حواريّ أخيه الحسين×. اختُلف فيه، فقِيل: أنّه قُتِل مع مصعب بن الزبير أيام المختار الثقفي. والصحيح أنّ الذي قُتِل مع مصعب هو أخوه عبيد الله ابن علي×، كما تقدّم في ترجمة عبد الله بن علي÷. وقيل: أنّه استُشهد في كربلاء، بعد أن قتل زحرَ بن قيس، قاتلَ أخيه أبي بكر بن علي، وذكروا له أرجوزة، يقول فيها:
|
أضربكم ولا أرى
فيكم زحر |
وقال أيضاً:
|
خلّوا عداة الله خلّوا عن عمر خلّوا عن الليث العبوس المكفهر |
وقيل: أنّه بقي بعد واقعة الطف، ونازع الإمام السجاد× على الصدقات عند عبد الملك. وقيل: إنّ لأمير المؤمنين× ابنين باسم عمر، فاُستُشهِد أحدهما في كربلاء، ولعلّه الأصغر. اُنظر: الدينوري، أحمد بن داود، الأخبار الطوال: ص306. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص112. الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص33، وص53. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج45، ص304. الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: ج6، ص163. النراقي، أبو القاسم، شعب المقال في درجات الرجال: ص111. النمازي الشاهرودي، علي، مستدركات علم رجال الحديث: ج6، ص102. الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج14، ص51. شمس الدين، محمد مهدي، أنصار الحسين×: ص136.
[295] لم نعثر له على ترجمة.
[296] القاسم بن الحسن المجتبى×، وأُمّه أُمّ ولد اسمها رملة. كان جميلاً كأنّ وجهه شقّة قمر، استُشهد يوم عاشوراء ولم يبلغ الحلم. استأذن من الإمام الحسين× النزول إلى ساحة المعركة، فلم يأذن له؛ ولعلّ السبب هو صغر سنّه، إلّا أنّ القاسم أصرّ كثيراً، وقبّل يدي ورجلي الإمام×، حتى أذِن له، وحمل على صفوف العدو. ورد في الزيارة المقدّسة للشهداء بما يزيد عن النصف صفحة في ذكره والسلام عليه، منها: السلام على القاسم بن الحسن بن علي. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص341. ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج3، ص75. السماوي، محمد بن طاهر، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص72.
[297] محمد بن عبد الله بن جعفر الطيار، أُمّه الخوصاء بنت خصفة (ويقال: حفصة) ابن ثقيف. جاء في الزيارة المقدّسة: السلام على محمد بن عبد الله بن جعفر، الشاهد مكان أبيه، والتالي لأخيه، وواقيه ببدنه، لعن الله قاتله عامر بن نهشل التميمي. اُنظر: المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص491. السماوي، محمد بن طاهر، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص77.
[298] عون بن عبد الله بن جعفر الطيار. كان لعبد الله بن جعفر ابنان باسم (عون)، أحدهما: عون الأكبر، والآخر: عون الأصغر، وكانت أُمّ أحدهما السيّدة زينب‘، والآخر أُمّه جمانة بنت المسيب، واختلف المؤرِّخون في الذي استُشهد في كربلاء مَن هي أُمّه، لكنّ المذكور في كتب الأنساب والمقاتل أنّ عوناً المقتول في كربلاء هو عون الأكبر، وأُمّه العقيلة زينب بنت الإمام علي×. ورد اسمه والسلام عليه في زيارة الشهداء الواردة عن الناحية المقدّسة: «السلام على عون بن عبد الله بن جعفر الطيّار في الجنان»، وأمّا عون بن جمانة هذه، فهو عون الأصغر، لم يحضر واقعة الطفّ. اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج2، ص311. أبو الفرج الأصفهاني، حسين بن علي، مقاتل الطالبيين: ص60. المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص491. السماوي، محمد بن طاهر، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص75. الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج1، ص608. النمازي، علي، مستدركات علم رجال الحديث: ج6، ص143.
[299] محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب× لم تتوفّر معلومات عن شخصيته في كتب التراجم والأنساب. نعم ذكروا أنّه روى عن أبيه الإمام الحسن×. اُنظر: الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج12، ص241، ح1. الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج7، ص35.
[300] عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب^، أُمّه بنت الشليل بن عبد الله البجلي، وقيل: أُمّه أُمّ ولد. كان عمره حين استُشهد إحدى عشـرة سنة. ضربه بحر بن كعب على يده فقطعها، ثمّ رماه حرملة بن كاهل الأسدي بسهم فذبحه في حجر عمّه الإمام الحسين× وهو صريع. وقد نسب البعض له حادثة مقتل أخيه القاسم× خطأً. ورد السلام عليه في زيارة الشهداء الواردة عن الناحية المقدسة. اُنظر: المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص490. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص53. السماوي، محمد، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص73. الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج11، ص175.
[301] مسلم بن عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب، الهاشمي القرشي. أمه عليّة أو حلية أو خليلة. تابعيٌّ من ذوي الرأي والعلم والشجاعة، بل قيل أشجع بني عقيل. تزوج رقية بنت أمير المؤمنين÷، فولدت له أولاداً، منهم: عبد الله ـ استُشهِد في الطف ـ وعلياً ومحمداً وحميدة. اشترك في صفين، وكان على الميمنة مع الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر. انتدبه الإمام الحسين×؛ ليتعرّف له على حال أهل الكوفة حين وردت عليه كتبهم، فرحل إليها وأخذ البيعة من أهلها، وطلبه بعدها ابن زياد بعد أن علم مكانه، فامتنع وقاتلهم قتالاً شديداً، وقتل منهم مقتلة عظمية، ثم قُبِض عليه، وقُتِل يوم التروية في الثامن من ذي الحجة سنة (60هـ). اُنظر: البغدادي، محمد بن حبيب، المنمق: ص402. ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم، المعارف: ص204. البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج2، ص70، وص77. وج3، ص224. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص258. أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص52. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج2، ص352. الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج3، ص484. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج7، ص222. الشاكري، حسين، شهداء أهل البيت^: ق2، ص5 وما بعدها.
[302] عبد الله بن عقيل بن أبي طالب، وأُمّه أُمّ ولد، تزوج من أم هاني بنت أمير المؤمنين×. رماه عمرو بن صبيح الصدائي فقتله، وقيل: رماه بشر بن حوط، أو عثمان بن خالد. قيل: إنّه تابعي، روى عن أمير المؤمنين×، وسمع جابر. وقيل: إنّه من أصحاب الإمام علي بن الحسين÷ والإمام الباقر×، ومعناه أنّه لم يٌقتَل بالطف. وذكر البعض أنّ لعقيل ولدين باسم عبد الله، الأكبر والأصغر. وجزم البعض بأنّ الذي يروِي عن أمير المؤمنين× استُشهد في كربلاء، والآخر مجهول. اُنظر: البغدادي، محمد بن حبيب، المحبر: ص56. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص359. الطوسي، محمد بن الحسن، الأبواب (رجال الطوسي) : ص117. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص254. البحراني، عبد الله، العوالم (الإمام الحسين×) : ص277. التفرشي، مصطفى بن الحسين، نقد الرجال: ج3، ص123. النمازي الشاهرودي، علي، مستدركات علم رجال الحديث: ج5، ص56. شمس الدين، محمد مهدي، أنصار الحسين×: ص134. الجواهري، محمد، المفيد من معجم رجال الحديث: ص340.
[303] عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب، أُمّه أُمّ ولد. وزوجته خديجة بنت أمير المؤمنين×. كان طويل القامة، كان يتقدّم حملة آل أبي طالب، وهو يقول:
|
أبي عقيلٌ
فاعرفوا مكاني |
وسيّد الشيب مع الشبّان
فقتل سبعة عشر فارساً. استُشهِد وعمره (35) سنة، ورد اسمه في الزيارة المقدّسة. اُنظر: ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم، المعارف: ص205. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص359. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص254. ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج3، ص76. الريشهري، محمد، موسوعة الإمام الحسين×: ج4، ص370ـ371.
[304] محمد بن عقيل بن أبي طالب، ابن أخي أمير المؤمنين× وزوج ابنته زينب الصغرى. استُشهِد مع الإمام الحسين×، قتله لقيط بن ناشر الجهني. اُنظر: الدينوري، أحمد بن داود، الأخبار الطوال: ص257. ابن أبي الدنيا، عبد الله بن محمد، مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب×: ج1، ص106. الخوارزمي، أحمد بن محمد، مقتل الحسين×: ج2، ص53. الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج7، ص209.
[305] لم نعثر على من صرّح بأسماء من اصطحبهم الإمام الحسين× معه حين دعاه والي المدينة الوليد لعنه الله.
[306] سكّنه: أي أوقفه: اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1ص440، (سكن)
[307] حبَسَ الشَّخصَ: منَعَه وأمسَكَه وأخّره. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص152، (حبس).
[308] هكذا في الأصل، والصحيح (يسيء).
[309] كذا رسمت في الأصل.
[310] هكذا في الأصل، والصحيح (لا يفنى وأَبُوءُ) بَاءَ إليه: رَجَعَ، وباؤُوا بغَضَبٍ من اللَّه: رَجَعُوا به أَي صارَ عليهم. اُنظر: الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: ج1، ص116، (بوأ).
[311] هكذا في الأصل، والصحيح (مولاى).
[312] هكذا في الأصل، والصحيح (بنو).
[313] تقدّمت الإشارة إلى تاريخ خروج الإمام الحسين× من المدينة ووصوله إلى مكة.
[314] الإهراع: الإسراع. يهرعون إليه، أي يستحثون إليه، كأنّه يحث بعضهم بعضاً. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج3، ص1306، (هرع).
[315] فجّ: جمعه الفجاج، وهو الطريق الواسع. اُنظر: ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج3، ص412، (فجج).
[316] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص18ـ20. المسعوديّ، عليّ بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر: ج3، ص55ـ56. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص36. ابن مسكويه الرازي، أحمد بن محمد، تجارب الأُمم: ج2، ص38.
[317] هكذا في الأصل، والصحيح (استدعى).
[318] هكذا في الأصل، والصحيح (بيضاء). وهو القرطاس.
[319] هكذا في الأصل، والصحيح (كتاباً).
[320] هكذا في الأصل، والصحيح أنّ أحد الكلمتين زائدة.
[321] هكذا في الأصل، والصحيح (ابن عمك).
[322] لَوَى عن الأمر والْتَوى: تثاقَل. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج15، ص263، (لوى).
[323] هكذا في الأصل، والصحيح (معرضي).
[324] هكذا في الأصل، والصحيح (حسين).
[325] هكذا في الأصل، والصحيح (نتائج).
[326] هكذا في الأصل، والصحيح (حسين).
[327] هكذا في الأصل، والصحيح (بتّه)، والبتّ بمعنى القطع. اُنظر: الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح: ص29.
[328] هكذا في الأصل، والصحيح (فاتقِ).
[329] هكذا في الأصل، والصحيح (بانقضاء).
[330] كأس أنف: لم يشرب بها قبل. وهي كناية عن نهاية عمره ودهره. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص30، (أنف).
[331] هكذا في الأصل، والصحيح (وخرج).
[332] هكذا في الأصل، والصحيح (دماء).
[333] هكذا في الأصل، والصحيح (آناء).
[334] هكذا في الأصل، وليس لها معنى محصل، ولعل الصحيح (تباشير) وتباشير الصبح: أوائله. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج2، ص591، (بشر).
[335] هكذا في الأصل، والصحيح (يكفك).
[336] هكذا في الأصل، والصحيح (ترض).
[337] شعب الشَّيْء: فرّقه، وَاسْتُعْمِل فِي الضِّدّ، فَقيل: شعب الصدع، أي لمّه وَأَصْلحهُ. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص483، (شعب).
[338] هكذا في الأصل، والصحيح (يلمّ) يقال: تلم بها شعثي، أي تجمع بها ما تفرّق من أمرى. ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج2، ص478، (شعث).
[339] هكذا في الأصل، والصحيح (بكل ما).
[340] اُنظر أيضاً: ابن الشجري، يحيى بن الحسين، الأمالي الخميسية: ج1، ص238. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص210. سبط ابن الجوزي، أبو المظفر بن فرغلي، تذكرة الخواص: ص305ـ306، وفيه أنّ الوعظ الوارد في نهاية الكتاب هو من جواب عبد الله بن عباس على كتاب يزيد لعنه الله.
[341] في اللهوف (ص22ـ23) : قال: (وسمع أهل الكوفة بوصول الحسين× إلى مكة وامتناعه من البيعة ليزيد، فاجتمعوا في منزل سليمان بن صرد الخزاعي. فلمّا تكاملوا قام سليمان بن صرد فيهم خطيباً، وقال في آخر خطبته: يا معشر الشيعة إنّكم قد علمتم بأنّ معاوية قد هلك وصار إلى ربّه، وقدم على عمله، وقد قعد في موضعه ابنُه يزيد. وهذا الحسين بن علي÷ قد خالفه وصار إلى مكة هارباً من طواغيت آل أبي سفيان، وأنتم شيعته وشيعة أبيه من قبله. وقد احتاج إلى نصرتكم اليوم فإن كنتم تعلمون أنّكم ناصروه ومجاهدو عدوِّه، فاكتبوا إليه، وإن خفتم الوهن والفشل فلا تغروا الرجل من نفسه...).
[342] هكذا في الأصل، والصحيح (يزل).
[343] الهرج والمرج: الفتنة والاختلاط والاضطراب. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج1، ص350، (هرج). ص341، (مرج).
[344] هكذا في الأصل، والصحيح (رئيسهم).
[345] هكذا في الأصل، وكذا بقية الموارد، والصحيح (المذحجي). وهو هانئ بن عروة المذحجي المرادي، أدرك الجاهلية. وكان من خواصّ أمير المؤمنين علي×، وشهد معه حرب الجمل وصفين، وكان شيخ مراد وزعيمها، يركب في أربعة آلاف دارع وثمانية آلاف راجل، فإذا أجابتها أحلافها من كندة كانوا في ثلاثين ألف دارع، استُشهد& في اليوم الثامن من ذي الحجّة سنة (60هـ)، وعمره 90 سنة. اُنظر: المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر: ج3، ص59. المنقري، نصـر بن مزاحم، وقعة صفّين: ص137. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج2، ص345. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج8، ص68.
[346] هكذا في الأصل، والصحيح (وقد).
[347] هكذا في الأصل، والصحيح (لهم).
[348] هكذا في الأصل، والصحيح (تسألونه).
[349] هكذا في الأصل، والصحيح (اجتمع رؤساء).
[350] هكذا في الأصل، والصحيح (وسر).
[351] «الذَّبُّ: الدَّفْعُ والمَنْعُ». ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج1، ص380، (ذبب).
[352] هكذا في الأصل، والصحيح (وإن لم تقدر على مجيئك).
[353] هكذا في الأصل، والصحيح (أبيك).
[354] «الوحا الوحا: أي السرعة السرعة». ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج5، ص163، (وحا).
[355] هكذا في الأصل، ولعلّ الصحيح (حتى ورد إليه في ذلك اليوم ستمائة كتاب. وتواترت الكتب حتى اجتمع عنده منها في نوب متفرقة اثنا عشر ألف كتاب)، كما في اللهوف. اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص24.
وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (فلمّا بلغ أهل الكوفة وفاة معاوية امتنعوا من البيعة ليزيد، وقالوا: لقد امتنع الحسين× من البیعة لیزید، وقد لحق بمکة، ولسنا نبایع یزید.
قال أبو مخنف: وکان عامل الکوفة یومئذ النعمان بن بشير الأنصاري. فاجتمع من الشيعة جماعة إلى منزل سلیمان بن صرد الخزاعي، وقالوا نکتب إلى الحسين×. فقال لهم: يا معشر الناس إنّ معاوية قد هلك وقد امتنع الحسين× من البيعة ونحن شيعته، وأنصاره، فإن کنتم تعلمون أنّکم تنصرونه وتجاهدون بين يديه فافعلوا، وإن خفتم الوهن والتخاذل فلا تغروا الرجل. فقالوا بل نقاتل عدوّه. فقال: اكتبوا على اسم الله تعالى، فكتبوا كتاب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم إلى الحسين بن علي بن أبي طالب× من سلیمان بن صرد الخزاعي والمسیب بن نجیة ورفاعة بن شداد البجلي وحبيب بن مظاهر الأسدي ومن معه من المسلمين، سلام عليك ورحمة الله وبركاته. أمّا بعد فإنّا نحمد الله الذي لا اله إلّا هو ونصلّي على محمد وآل محمد. واعلم یا بن محمد المصطفی وابن علی المرتضی أن ليس لنا إمام غیرك، فأقدم إلینا، لنا ما لك وعليك ما علينا؛ فلعلّ الله أن يجمعنا بك على الحق والهدى. واعلم أنّك تقدّم على جنود مجندة وأنهار متدفقة وعيون جارية، فإن لم تقدّم على ذلك فابعث إلينا أحداً من أهل بیتك يحکم بیننا بحکم الله تعالى وسنة جدك رسول الله’. واعلم أنّ النعمان بن بشير في قصر الإمارة، ولسنا نشهد معه جمعة ولا جماعة، ولو أنّك أقبلتَ إلینا لکنّا أخرجناه إلى الشام، والسلام. وبعثوا الكتاب مع عمر بن نافذ التميمي وعبد الله بن السبیع الهمداني، فخرجا مسرعین حتى قدما علی الحسين×، ومعهما خمسون صحيفة ولبثوا یومین آخرین، وبعثوا إلیه مسهر الأنصاري ومعه کتاب فیه: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى الحسين بن علي بن أبي طالب×، أمّا بعد فإنّه لا إمام غيرك لنا يا بن رسول الله’ العجل العجل. ثم لبثوا يومين آخرين وكتبوا كتاباً يقولون فيه: بسم الله الرحمن الرحیم، قد أینعت الثمار فأقدم إلينا يا بن بنت رسول الله (صلی الله عليه واله) مسرعاً.
قال أبو مخنف: وتواترت الكتب إليه فسأل الرسل عن أمر الناس، فقالوا: إنّهم كلهم معك. ثم کتبوا مع هاني بن هاني وسعید بن عبد الله الحنفي وكانا آخر الرسل من أهل الكوفة، فلمّا قرأ الكتب جميعاً كتب الجواب في كتاب أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي× إلى الملأ من المؤمنين، أمّا بعد فإنّ هانياً وسعيداً قدما إلي بكتبكم، وكانا آخر من قدما إلي من رسلكم. وقد فهمتُ ما ذكرتموه أنّه ليس لكم إمام غيري، وتسألوني القدوم إلیکم لعلّ الله يجمعکم على الحقّ والهدى. وإنّي باعث إليكم أخي وابن عمّي، المفضَّل عندي من أهل بيتي، مسلم بن عقیل×، وقد أمرتُه أن يكتب إلي بحسن رأيكم وما أنتم عليه. وأنا أقدم إليكم إن شاء الله تعالى. ثم دعا بمسلم بن عقیل ووجّه معه قیس بن مسهّر الصيداوي وعمارة بن عبد الله السلولي، وأمره بتقوى الله واللطف بالناس. فإن رأى الناس مجتمعين علی رأیه یعجِّل له بالخبر. فأقبل مسلم بن عقیل×. ودعا الحسین بدلیلین یدلّانِه علی الطریق).
[356] عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي، أبو عبد الرحمن. وُلِد في بغداد سنة (213هـ) من الحفاظ له كتاب (الزوائد) و(زوائد المسند) زاد به على مسند أبيه. تُوفي سنة (290هـ). اُنظر: الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج4، ص65.
[357] همام بن غالب بن صعصعة، أبو فراس، الشاعر المعروف بالفرزدق، التميمي البصـري. من أصحاب الإمام علي بن الحسين×، وله قصيدة ميميّة مشهورة في مدحه×، حُبس الفرزدق على إثرها. كان أشعر أهل عصـره، عظيم الأثر في اللغة، وكان يُقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. وشعره محفوظٌ مدوّن، قارب عمره المائة، مات سنة: 110 هـ. اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال (رجال الكشـي) : ج1، ص343. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج8، ص93.
[358] ذات عِرق: سُمِّيت بذلك لأنّ فيه عِرقاً، وهو الجبل الصغير. وتُسمَّى اليوم (الضريبة)، وهي اليوم مهجورة؛ لعدم وجود طرق إليها. تقع في طريق العراق المعروف بالطريق الشرقي، وهي ميقات أهل الشرق قاطبةً عند العامة. تبعد عن مكة (100كم)، وعن عرفة (120كم) بجوارها وادي العقيق بمسافة (20كم). قال عنها الحموي: سهل أهل العراق، وهو الحد بين نجد وتهامة. أحتمل البعض أنّ الإمام الحسين× وصلها يوم الخميس التاسع من شهر ذي الحجة (يوم عرفة) لسنة (60هـ). اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله، معجم البلدان: ج4، ص107. الربيعي، عباس، أطلس الحسين: ص140ـ143.
[359] هكذا في الأصل، والصحيح (استدعى).
[360] هكذا في الأصل، والصحيح هو مسلم بن عقيل، كما سيأتي منه أيضاً.
[361] المصير: ما ينتهى إليه الأمر. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص531، (مصر).
[362] هكذا في الأصل، والصحيح (بما أراد).
[363] هكذا في الأصل، والصحيح (استدعى دليلين).
[364] هكذا في الأصل، والصحيح (عبد الله بن أحمد).
[365] هكذا في الأصل، والصحيح (طريق الأدلاء).
[366] هكذا في الأصل، والصحيح (عطش شديد).
[367] الجادة: وسط الطريق والطريق الأعظم الذي يجمع الطرق. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص109، (جدد).
[368] هكذا في الأصل، والصحيح (يومين).
[369] هكذا في الأصل، والصحيح (شيئاً)، وكذا في المورد الآتي.
[370] هكذا في الأصل، والصحيح (بقينا يومين).
[371] المعروف والمشهور عند المؤرّخين أنّ رسالة مسلم بن عقيل وصلت للإمام الحسين× بيد قيس ابن مسهر الصيداوي، وبعضها لم تصرح باسم حامل الكتاب. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص263. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص40.
[372] هكذا في الأصل، والصحيح (فأخذ).
[373] التطيّر: التشاؤم. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج4، ص511، (طير).
[374] لم نعثر على الحديث عن النبي’. نعم ورد مضمونه عن أمير المؤمنين× في حديث طويل مع أم كلثوم قال لها: (يا بنية ما منا أهل البيت من يَتطيّر ولا يُتطيَّر به). المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج42، ص278.
[375] هكذا في الأصل، ويبدو أنها زائدة.
[376] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص32.
[377] اُنظر: المصدر السابق.
[378] هكذا في الأصل، والصحيح (وفي).
[379] هكذا في الأصل، والصحيح (أبي عبيد). وهو الـمُختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي، أبو إسحاق، وُلِد عام الهجرة. كان والده أبو عبيد أميراً في زمن عمر بن الخطاب. يُعدّ المختار من كبراء ثقيف، وذوي الرأي والفصاحة، والشجاعة والدهاء. وهو من الزعماء الثائرين على بني أُميّة، وأحد الشجعان الأفذاذ، كان مُنقطعاً لبني هاشم، وكان شغله الشاغل الأخذ بثأر الإمام الحسين×. قَتل الكثير من أعداء أهل البيت^، منهم: عبيد الله بن زياد، وعمر بن سعد، وحرملة بن كاهل، وحصين بن نمير. أخبره المنهال أنّ الإمام زين العابدين× دعا بأربع دعوات، وقد استجابها الله على يديه، فنزل المختار من على جواده وصلّى ركعتين لله شكراً، ولمـّا دعاه المنهال إلى مأدبة قال: يا منهال، تُعْلِمُني أنّ عليّ بن الحسين دعا بأربع دعوات فأجابه الله على يديَّ، ثمّ تأمرني أن آكل!! هذا يومُ صومٍ شكراً لله} على ما فعلتُه بتوفيقه. استُشهد سنة (67هـ) على يدي مصعب بن الزُّبير. اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص239. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج4، ص1465. الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص538. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج7، ص192.
[380] اُنظر أيضاً: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص264. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص32ـ33. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص41. الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج1، ص286، نقلاً عن ابن أعثم. ابن شهر آشوب، محمد ابن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص242. ابن الأثير، علي ابن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص22.
[381] في اللهوف: (فسار مسلم بالكتاب حتى دخل إلى الكوفة، فلمّا وقفوا على كتابه كثُر استبشارهم بإتيانه إليهم، ثم أنزلوه في دار المختار بن أبي عبيدة الثقفي، وصارت الشيعة تختلف إليه، فلمّا اجتمع إليه منهم جماعة قرأ عليهم كتاب الحسين×، وهم يبكون حتى بايعه منهم ثمانية عشر ألفاً).
[382] هكذا في الأصل، والمعروف هو عابس بن أبي شبيب ـ ويقال ابن شبيب ـ بن شاكر الشاكري الهمداني. من رجال الشيعة، شجاعاً، خطيباً، ناسكاً متهجّداً، وكانت بنو شاكر من المخلصين بولائهم لأمير المؤمنين×، وفيهم يقول يوم صفّين: لو تمّت عدّتهم ألفاً، لعُبِد الله حقّ عبادته. ورد ذكره في الزيارة باسم عابس بن شبيب. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص97. ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ص79. السماوي، محمد بن طاهر، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص126.
[383] هكذا في الأصل، والصحيح (ألقى).
[384] حبيب بن مظاهر ـ ويُقال: مُظهّر، أو مطهّر ـ بن رئاب بن الأشتر الأسدي الكندي. أدرك النبي’، من خواصّ الإمام أمير المؤمنين×، شهد حروبه جميعاً، ومن أصحاب الإمام الحسين×، ومن القادة الشجعان، وله رتبةٌ علميّة ساميّة، ورد في زيارته: السلام عليك أيّها العبد الصالح المطيع لله ورسوله ولأمير المؤمنين. كما ورد اسمه والسلام عليه في زيارة الشهداء الواردة عن الناحية المقدسة. اُنظر: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص59. المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص493. العلّامة الحلي، الحسن بن يوسف، خلاصة الأقوال: ص132. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، الإصابة: ج2، ص142. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج2، ص166.
[385] اُنظر أيضاً: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص264. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص34.
[386] لم نجد من المؤرخين مَن ذكر أنّ المبايعين كانوا ثمانين ألف رجل. نعم هناك أقوال في عدد مَن بايع الإمام الحسين×، وهي: 1ـ أربعون ألفاً. 2ـ ثلاثون ألفاً، ومن بينهم حاكم الكوفة النعمان بن بشير. 3ـ ثمانية وعشرون ألفاً. 4ـ ثمانية عشر ألفاً، حسب ما جاء في رسالة مسلم× إلى الإمام الحسين×. 5ـ اثنا عشر ألفاً. اُنظر: الهلالي الكوفي، سليم، كتاب سليم بن قيس: ص188. ابن نما الحلي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص21. المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر: ج3، ص54. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ج5، ص325. القرشي، باقر شريف، حياة الإمام الحسين بن علي÷: ج2، ص347.
[387] القائل هو أبو مخنف كما في مقتل أبي مخنف، مقتل الإمام الحسين× ومصرع أهل بيته.
[388] هكذا في الأصل، والصحيح أنّها زائدة.
[389] هكذا في الأصل، والصحيح (العصا).
[390] هكذا في الأصل، والصحيح (إن صح ذلك عندي على أحد).
[391] هكذا في الأصل، والثانية زائدة.
[392] في تاريخ الطبري (عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرميِّ)، وهو عبد الله ـ أو عبيد الله ـ بن مسلم ابن شعبة الحضرمي، من أتباع بني أمية، جاء اسمه في الشهود على حُجر بن عَدي. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص200. المزي، يوسف، تهذيب الكمال: ج19، ص157.
[393] في العبارة تشويش وسقط، ولعل الصحيح ما في مقتل أبي مخنف، مقتل الإمام الحسين× ومصرع أصحابه: (فقام إليه عبد الله بن شعبة الحضرمي وقال: أيّها الأمير، إنّ هذا الأمر لا يكون إلّا بالغشم والقهر وسفك الدماء. وهذا الذي تكلمتَ به كلام المستضعفين. فقال النعمان: أكون من المستضعفين في ذات الله، ولا أكون من الظالمين. ثم نزل عن المنبر).
[394] وفي مقتل أبي مخنف مقتل الإمام الحسين× ومصرع أصحابه: (فإنّ النعمان ضعیف ویتضاعف. وکان أول من کاتب یزید في حرب الحسين×).
[395] انظر أيضاً: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص264ـ265. المفيد، محمد ابن محمد، الإرشاد: ج2، ص41ـ42. الفتال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص173. ابن الأثير، عليّ بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص22. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص43ـ44.
[396] هكذا في الأصل، والصحيح (مولى).
[397] سرحون أو سرجون بن منصور، أبو منصور الرومي، كاتب معاوية ومولاه، وصاحب أمره في الديوان. من النصارى، يُقال: كانت له كنيسة خارج باب الفراديس في الشام، فأسلم وبقيت الكنيسة، وكان يزيد ينادمه على شرب الخمر، وبقيَ كاتباً لبني أُميّة حتى مات في عهد عبد الملك بن مروان. اُنظر: العصفري، خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط: ص232. البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج5، ص288. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج20، ص161.
[398] هكذا في الأصل، والصحيح (التي).
[399] هكذا في الأصل، والصحيح (المصرين)، وهما الكوفة والبصرة.
[400] في العبارة سقط، والصحيح ـ كما في الطبري ـ: (أمّا بعد فإنّه كتب إليَّ شيعتي من أهل الكوفة يخبرونني). اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص265.
[401] نقضتُ الغزل: حللتُ بَرمتَه. ولعلّه تصحيف (نفضتُ) أي حركتها بقوة لتخرج ما فيها، من قبيل نفضت الثوب. والكنانة: وعاء يُجعل فيها السهام. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حمّاد، الصحاح: ج3، ص1109، (نفض). وج6، ص2189، (كنن). الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير: ص621، (نقض).
[402] هكذا في الأصل، والصحيح (أجرأ).
[403] مسلم بن عمرو الباهلي، أبو قتيبة، كان نديماً ليزيد، يشرب معه ويغنّي له. وهو الذي منع الماء عن مسلم بن عقيل لمّا استسقى بباب القصر. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج5، ص298. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص281.
[404] «تأهّب: استعد». الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج1، ص89، (أهب).
[405] اُنظر أيضاً: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص265. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص36. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص43. الفتال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص174.
[406] يقال له: سلمان، ويقال سليمان أو سليم، أبو رزين، مولى الإمام الحسين×. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص266، وص359. الطوسي، محمد بن الحسن، الأبواب (رجال الطوسي) : ص101. ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج3، ص76. المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص491.
[407] هكذا في الأصل، والصحيح (رؤساء).
[408] الأحنف بن قيس بن معاوية، أبو بحر، التميمي السعدي، اسمه ضحّاك، وقيل: صخر، أسلم في عهد النبي’ ولم يرَه، وشارك مع أمير المؤمنين× في صفّين دون الجمل، وقد رُوِي أنّه: أرسل إلى أمير المؤمنين× في وقعة الجمل: إن شئتَ أتيتُك في مائتي فارس، فكنتُ معك، وإن شئتَ اعتزلتُ ببني سعد، فكففتُ عنك ستة آلاف سيف. فاختار× اعتزاله، وقيل: إنّه كان يرى رأي العلوية. ذكره الشيخ من أصحاب رسول الله’، وأمير المؤمنين×، والحسن×. وقال الكشي: قيل للأحنف: إنّك تطيل الصوم، فقال أعدّه لشر يوم عظيم، ثم قرأ: (يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا)، الإنسان: 7. ورُوِي أنّ الأحنف بن قيس، وحارثة بن قدامة، والحباب (لحتات) بن يزيد، وفدوا على معاوية، فقال معاوية للأحنف: أنت الساعي على أمير المؤمنين عثمان، وخاذل أمَّ المؤمنين عايشة، والوارد الماء على عليّ بصفين؟ فقال: يا أمير المؤمنين، من ذلك ما أعرف ومنه ما أنكر. أمّا أمير المؤمنين عثمان، فأنتم معشر قريش، حصرتموه بالمدينة والدار منا عنه نازحة، وقد حضره المهاجرون والأنصار، ونحن عنه بمعزل وكنتم بين خاذل وقاتل. وأمّا عايشة، فإنّي خذلتُها في طول باع ورحب وشرب؛ وذلك إنّي لم أجد في كتاب الله إلّا أن تقرّ في بيتها، وأمّا ورودي الماء بصفين فإنّي وردتُ حين أردتَ أن تقطع رقابنا عطشاً. تُوفّيَ سنة (72هـ). اُنظر: الثقفي، إبراهيم بن محمد، الغارات: ج2، ص754. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج1، ص276. الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج3، ص166.
[409] لم نعثر له على ترجمة بهذا العنوان.
[410] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (عمر بن الجارود) وهو المنذر بن الجارود بن المعلّى، أبو غياث العبدي، وُلِد في عهد النبي’. استعمله أمير المؤمنين علي× على اصطخر، فكتب إليه الإمام× كتاباً ذمّه فيه بعد أن اتُّهم بأنّه أخذ من بيت المال ثلاثين ألفاً، فعزله الإمام وحبسه، ثم أطلقه بعد أن حلف أنّه لم يأخذ المال الذي اتُّهِم به. وفي أيام خلافة يزيد ولّاه عبيد الله بن زياد الهند، فمات هناك سنة (61هـ)، أو أوّل سنة (62هـ)، وهو يومئذٍ ابن ستّين سنة. اُنظر: الكوفي، إبراهيم بن محمد، الغارات: ج2، ص897. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، الإصابة: ج6، ص209.
[411] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (مسعود بن معمر) وهو مسعود بن عمرو بن عدي بن محارب الأزدي، رئيس الأزد وربيعة في البصـرة، وهو الذي أجار ابن مرجانة ومنعه لّما نبذه الناس. وقام مسعود بن عمرو في البصرة بأمر عبيد الله بن زياد، فقتله بنو تميم وهو على المنبر سنة: (64)، أو (65هـ). اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري: ج13، ص62. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج7، ص219.
[412] عمر بن عبد الله أو عبيد الله بن معمّر التيمي، أبو حفص القرشي، أحد وجوه قريش، من رجال مصعب بن الزبير، كان والياً له على البصرة، ثم توجّه إلى بلاد فارس، فقاتل الأزارقة سنة 68ه وصار والياً عليها. ولما قَتل عبدُ الملك بن مروان مصعبَ بن الزبير قدِم عمر دمشق فبايع عبد الملك بن مروان، ثم أرسله عبد الملك لقتال الخوارج الحرورية سنة (73هـ) ؛ فهزموه شرّ هزيمة. مات بقرية ضمير بدمشق. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج7، ص244. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج45، ص286. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج5، ص54.
[413] لم نعثر على ترجمة له، وفي تاريخ الطبري (قيس بن الهيثم)، وهو قيس بن الهيثم بن أسماء بن الصلت السلمي. قائد مقدّمة جيش عثمان بن عفان لفتح الطبسين (قرب نيسابور). كان من أنصار بني أُميّة. استخلفه عبد الرحمن بن زياد ـ أخو عبيد الله ـ بعد مقتل الإمام الحسين× على خراسان. ثم تحوّل إلى ابن الزبير، فكان على خُمس أهل العالية بالبصـرة مع مصعب بن الزبير لمقاتلة المختار سنة (67هـ). كما كان مع مصعب في مقاتلة عبد الملك بن مروان سنة (71هـ)، وحذّر أهل العراق من خذلان مصعب، تُوفّي في البصـرة. اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج5، ص46. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص234، وص563، وج5، ص3، وص7. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج5، ص209.
[414] هكذا في الأصل، والصحيح (خلقه).
[415] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (قبضه إليه مكرّماً).
[416] هكذا في الأصل، والصحيح (فصلاة الله وسلامه عليه).
[417] هكذا في الأصل، والصحيح (أصفياؤه).
[418] تأمّر فلان علينا: صار أميراً علينا. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص26، (أمر).
[419] هكذا في الأصل، والصحيح (تولّى).
[420] هكذا في الأصل، والصحيح (أهدكم).
[421] اُنظر أيضاً: مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) : ص25ـ26.
[422] هكذا في الأصل، والصحيح (اسم).
[423] هكذا في الأصل، وقد تقدّم في ترجمته أنّه سلمان أو سليمان أو سليم، أبو رزين، مولى للإمام الحسين×. نقول: ولم يثبت أنّ الإمام الحسين× ارتضع من امرأة غير أمّ فاطمة‘، كما لم يثبت أنّ فاطمة‘ أرضعت غير أولادها؛ ولذا فلا يمكن إثبات كون سليمان أو عبد الله بن يقطر أو غيرهما بأنّ أحداً منهم رضيع الإمام الحسين×.
[424] محلة بني سدوس ـ بفتح السين ـ بن ذهل بن شيبان عرفوا بها. اُنظر: القلقشندي، أحمد بن علي، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: ج1، ص283.
[425] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص32ـ37. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص265ـ266. ابن نما الحلي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص17 مختصراً. ابن الأثير، علي ابن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص23. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص170.
[426] هكذا في الأصل، والمراد (تعالى).
[427] في مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) : ص26، قال: (أمّا بعد فوالله ما تقرن بي الصعبة، ولا يقعقع لي بالشنان، وإنّي لنكل لمن عاداني وسم لمن حاربني. أنصف القارة من راماها).
[428] عثمان بن زياد، ذُكر أنّه مات شاباً، وله من السن: ثلاث وثلاثون، في السنة الرابعة عشرة من ولاية مسلمة بن مخلد على مصر، أي في سنة (61هـ). اُنظر: الأتابكي، يوسف بن تغري، النجوم الزاهرة: ج1، ص155.
[429] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته (الإرجاف).
[430] هكذا في الأصل، والصحيح (لئن).
[431] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (ثم إنّ ابن زیاد صعد المنبر، وقال: یا أهل البصرة إنّ يزيد قد ولّاني الكوفة، وقد عزمتُ على السیر إلیها، وقد استخلفتُ علیکم أخي عثمان بن زیاد، فاسمعوا له وأطیعوا، وإیاکم والأراجیف، فوالله إن بلغني أنّ رجلاً منکم خالف أمره لأقتلنّه، ولآخذنّ الأدنی بالأقصی حتی تستقیموا).
[432] في مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) : (واستخلف أخاه عثمان بن زياد).
[433] شريك بن الأعور الحارثي السلمي الدهني المذحجي الهمداني، قوي الإيمان، صُلب اليقين، شديد التشيّع، من خواصّ أمير المؤمنين×، وشهد معه الجمل وصفّين. دخل على معاوية فعيّره باسمه واستهزأ به، فاستصغره شريك وأجابه بجوابٍ لاذع، وأنشأ فيه شِعراً، يقول فيه:
|
أيشتمني معاوية
بن حرب |
ولمّا قدم الكوفة نزل دار هانئ بن عروة عندما أشخصه ابن زياد من البصرة معه، وكان في الدار مسلم بن عقيل، فمرض أو تمأرض ليعوده ابن زياد، وقال لمسلم: أنّه عائدي وإنّي لمطاوله الحديث فاخرج إليه فاقتله، والآية بيني وبينك أن نقول: اسقوني ماء فأجابه مسلم إلى ذلك، ولم يفعل؛ لأنّه حيل بينه وبين ذلك بقضاء الله، تُوفّيَ سنة (60هـ). اُنظر: الثقفي، إبراهيم بن محمد، الغارات: ج2، ص793ـ795. الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم الرجال: ج4، ص209.
وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (... إلّا مالک بن مشیع فإنّه تعذّر عنده، وشکی وجعاً فی خاصرته، وقال: إنّي لاحق بالأمير).
[434] هكذا في الأصل، والصحيح (كلثام).
[435] هكذا في الأصل، والصحيح (ملأ).
[436] هكذا في الأصل، والصحيح (ساءه).
[437] الطلبة: المطلوب والحاجة. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص561، (طلب).
[438] هكذا في الأصل، والصحيح (ورائه).
[439] هكذا في الأصل، والصحيح (مصرك). وفي مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري): ص27: (فقال مسلم بن عمرو ـ لمّا أكثروا ـ: تأخّروا، هذا الأمير عبيد الله بن زياد. فأخذ حين أقبل على الظهر، وإنّما معه بضعة عشر رجلاً، فلمّا دخل القصر، وعلم الناس أنّه عبيد الله بن زياد، دخلهم من ذلك كآبة وحزن شديد، وغاظ عبيد الله ما سمع منهم، وقال: ألا أرى هؤلاء كما أرى).
[440] لم يرد في كتب المقاتل والتاريخ أنّ أهل الكوفة لم يعرفوا ابن زياد لعنه الله حتى صعد المنبر وتكلّم، ثم سألهم عن نفسه، فقالوا له: أنت الحسين. بل الوراد أنّ مسلم بن عمرو الباهلي أخبرهم بذلك قبل دخول ابن زياد قصر الإمارة، وقيل: إنّه لمّا تكلّم مع النعمان بن بشير عرفه بعض من كان خلفه، فرجع وأخبر الناس. وبعض المصادر لم تشر إلى ذلك، بل اكتفت بذكر حزن ابن زياد من تباشرهم بقدوم الأمام الحسين×. وفي مثير الأحزان: (وازدحموا عليه حتى أخذوا بذنب دابته، وظنُّهم أنّه الحسين، فحسر اللثام، وقال: أنا عبيد الله. فتساقط القوم، ووطئ بعضهم بعضاً، ودخل دار الإمارة، وعليه عمامة سوداء). اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج2، ص78. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص44. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص24. ابن نما الحلي، محمد بن جعفر، مثير الأحزان: ص19. إسماعيل، ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص164.
[441] هكذا في الأصل، والصحيح (اعطاء).
[442] هكذا في الأصل، والصحيح (ميسئكم).
[443] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري): ص27. مع اختلاف يسير.
[444] هكذا في الأصل، والصحيح (قبائل).
[445] لمّ الشيء يلمّه: جمعه. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج12، ص548.
[446] هكذا في الأصل، والصحيح (نساءكم). وفي مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) : (ثم نزل فأخذ العرفاء والناس أخذاً شديداً. فقال: اكتبوا إلى الغرباءَ، ومَن فيكم من طلبة أمير المؤمنين، ومَن فيكم من الحرورية، وأهل الريب الذين رأيهم الخلاف والشقاق. فمن كتبهم لنا فبرئ، ومن لم يكتب لنا أحداً فيضمن لنا ما في عرافته ألّا يخالفنا منهم مخالف، ولا يبغي علينا منهم باغ، فمن لم يفعل برئت منه الذمة، وحلال لنا ماله وسفك دمه، وأيّما عريف وُجِد في عرافته من بغية أمير المؤمنين أحدٌ لم يعرّفه إلينا صُلِب على باب داره، وأُلغِيت تلك العرافة من العطاء، وسُيِّر إلى موضع بعمان الزارة).
[447] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (قال أبو مخنف: فلمّا).
[448] هكذا في الأصل، والصحيح (ما لنا به طاقة).
[449] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص37ـ40. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص266ـ 268. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص37ـ38. ابن الأثير، علي ابن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص23.
[450] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (قال أبو مخنف).
[451] المَوْعُوك: المحموم، وقد وَعَكَتْه الحمى تَعِكُه. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج10، ص514، (وعك).
[452] هكذا في الأصل، والصحيح (يصلّ).
[453] هكذا في الأصل، والصحيح (من أهل الكوفة).
[454] اُنظر أيضاً: الحسيني، محمد بن أمير، شرح شافية أبي فراس: ص349. لكنّ المشهور أنّ الذين بايعوه طيلة أقامته في الكوفة 18 ألف أو 12 ألف. اُنظر: الدينوري، أحمد بن داوُد، الأخبار الطوال: ص235. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص258. المفيد، محمد ابن محمد، الإرشاد: ج2، ص41. الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج1، ص437. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص213.
[455] هكذا في الأصل، والصحيح (فعل أهل الكوفة).
[456] الدروب: جمع درب، وهو المدخل والطريق الضيق. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص277، (درب).
[457] بنو خزيمة: يرجعون إلى خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان. اُنظر: ابن حزم، علي بن أحمد، جمهرة أنساب العرب: ص11.
[458] الصياريف: جمع صيْرَف، وهو صَرّافُ الدَّراهِمِ ونقَّادُها. اُنظر: الزبيديّ، محمد مرتضى، تاج العروس: ج12، ص321، (صرف).
[459] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (فوقف هناك بإزاء بيتٍ شاهق).
[460] هكذا في الأصل، والصحيح (فتى).
[461] هكذا في الأصل، والصحيح (ليتحدّثا).
[462] المخدع: هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير. ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج2، ص14، (خدع).
[463] هكذا في الأصل، والصحيح (فدونك).
[464] هكذا في الأصل، والصحيح (أخلع).
[465] هكذا في الأصل، والصحيح (يستجفيه)، بمعنى عدّه جافياً، أي تاركاً للصلة والبر. اُنظر: الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: ج19، ص286.
[466] هكذا في الأصل، والصحيح (رائح).
[467] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (العشاء).
[468] هكذا في الأصل، ولعلّ الثانية زائدة.
[469] هكذا في الأصل، والصحيح (هاني بن عروة).
[470] هكذا في الأصل، والصحيح (يشكو). وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (وهاني يشكو الذي يجده...).
[471] هكذا في الأصل، والصحيح (مسلماً).
[472] هذى فلان هذياً وهذَياناً: تكلّم بشيء غير معقول؛ لمرض أو غيره. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص979، (هذي).
[473] هكذا في الأصل، والصحيح (ليُسمِع مسلماً).
[474] هكذا في الأصل، والصحيح (لسلمى)، وكذا في كلمة (سليما) التي بعدها فالصحيح (سُليمى).
[475] هكذا في الأصل، والصحيح (حيّوا).
[476] هكذا في الأصل، والصحيح (ظمأ).
[477] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته زيادة في الشعر:
|
(فإن أحسّت سُليمى منك داهيةً فلستَ تأمن يوماً من دواهيها). |
[478] هكذا في الأصل، والصحيح (أراه).
[479] هكذا في الأصل، والصحيح (أتى).
[480] هكذا في الأصل، والصحيح (تظفر).
[481] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (عن رسول الله’...).
[482] هكذا في الأصل، والصحيح (لا إيمان).
[483] اُنظر أيضاً: ابن أبي جمهور الإحسائي، محمد بن علي، عوالي اللئالي: ج2، ص241، وفيه: (لا إيمان لمن يقتل مسلماً أو معاهداً). نقول: المشهور أنّ مسلم بن عقيل× استدلّ بقول رسول الله’ (الإيمان قيد الفتك). اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص271. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص43. المرتضى، علي بن الحسين، تنزيه الأنبياء^: ص228. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص27.
[484] في بعض المصادر (كافراً).
[485] اُنظر أيضاً: القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج3، ص56ـ57. ولم يرد فيه قوله: (ولكن خشيتَ أن تقتل به)، ولم نعثر عليها في غيره من المصادر. كما أنّها لا تناسب صدورها من أمثال هانئ&، ولا تناسب مَن قيلت فيه وهو مسلم×.
[486] هكذا في الأصل، والصحيح (مولى).
[487] معقل لم يذكروه، وهو من أهل الشام من مدينة حمص، كان مولى وجاسوساً لعبيد الله بن زياد في الكوفة. ولم يكن من أهل الكوفة، وقد ناقش صاحب كتاب مع الركب الحسيني في تفاصيل خدعة معقل، وانطلائها على مسلم بن عقيل× ومسلم بن عوسجة رضوان الله عليه. أمّا السيد علي جمال أشرف في كتابه: مسلم بن عقيل (قصة معقل)، فقد نفى قصة معقل بتمامها. اُنظر: شمس الدين، محمد مهدي، أنصار الحسين×: ص192. الطبسي، جعفر، مع الركب الحسيني: ج3، ص96.
[488] في مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) : (درهم).
[489] هكذا في الأصل، والصحيح (تستأنس).
[490] هكذا في الأصل، والصحيح (لم يكتموك).
[491] هكذا في الأصل، والصحيح (تغدو).
[492] هكذا في الأصل، والصحيح (تعدو).
[493] هكذا في الأصل، والصحيح (يقفو).
[494] مسلم بن عوسجة، أبو حجل الأسدي السعدي، من أصحاب رسول الله’، وكان رجلاً شجاعاً عابداً، ومن أبطال العرب في صدر الإسلام، شهد بعض الفتوح والمغازي، وله دورٌ قياديٌّ في حركة مسلم بن عقيل في الكوفة، ومن أصحاب الإمام الحسين× البارزين في وقعة كربلاء، أذِن له الإمام بالانصراف، فأجابه: والله لو علمتُ أنّي أُقتَل ثمّ أُحيى ثمّ أُحرَق ثمّ أُحيى ثمّ أُحرَق ثمّ أُذرَّى، يُفعَل بي ذلك سبعين مرّة، ما فارقتُك حتى أَلقَى حمامي دونك. وله زيارة مفصلة ورد فيها: وكنتَ أوّل مَن شرى نفسه، وأوّل شهيد من شهداء الله قضـى نحبه. وهو صريح في أنّه أوّل شهداء عاشوراء. ولـمّا سقط مخضباً بدمه سار إليه الحسين× وبه رمق، فقال له: رحمك الله يا مسلم... عزّ عليَّ مصـرعك يا مسلم، أبشـر بالجنة. اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص103. المشهدي، محمد، المزار: ص491. السماوي، محمد بن طاهر، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص107ـ110. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج7، ص222.
[495] هكذا في الأصل، والصحيح (يا عبد الله)، وكذا في الموارد التالية في خطاب معقل لمسلم& أو بالعكس.
[496] هكذا في الأصل، والصحيح (أنّي رجل من أهل).
[497] هكذا في الأصل، ولعل الصحيح (توقفني).
[498] هكذا في الأصل، والثانية زائدة أو للتأكيد.
[499] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (يا أخ العرب اُعزب عن هذا الكلام...).
[500] هكذا في الأصل، والصحيح (وفيت).
[501] هكذا في الأصل، والصحيح (مؤكدة).
[502] أبو ثمامة، وهو: عمرو بن عبد الله بن كعب، أبو ثمامة الهمداني الصائدي أو الصيداوي، تابعيّ، صحب أمير المؤمنين×، وشهد معه جميع حروبه، وكان من أصحاب الإمام الحسن المجتبى×، ومن الوجوه البارزة في ثورة الإمام الحسين×. من شجعان العرب. أمره مسلم× أن يقبض المال ويشتري السلاح؛ لأنّه بصير بذلك. ولمّا ظهر مسلم× بالسيف عقد له على ربع تميم وهمدان، فحصروا عبيد الله في قصره، فلمّا تفرّق الناس اختفى أبو ثمامة فاشتدّ طلب ابن زياد له، فخرج إلى الحسين× ومعه نافع بن هلال الجملي، فلقياه في الطريق وأتيا معه. فاز بدعاء الإمام× حين ذكر الصلاة، فقال× له: «جعلك الله من المصلّين الذاكرين»، تشـرّف بسلام الناحية المقدّسة. استُشهد يوم العاشر من المحرّم سنة (61هـ) في كربلاء. اُنظر: المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص494. القمي، عباس، الكُنى والألقاب: ج1، ص33. السماوي، محمد بن طاهر، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص119. الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج8، ص349.
[503] لعلّ العبارة فيها شيء من الإرباك؛ فإنّ قوله: (وهو الذي يشتري السلاح والعدة، وكان فارساً من الفرسان) عائد إلى أبي ثمامة، وأمّا قوله (وصار داخلاً...) فعائد إلى معقل.
[504] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص40ـ45. مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص31ـ32، وص34.
[505] هكذا في الأصل، وفيها سقط. وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته (فلمّا صحّ ذلك عند ابن زياد لعنه الله دعا بمحمد).
[506] محمد بن الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث بن معاوية، أبو القاسم الكندي الكوفي. أمّه أم فروة بنت أبي قحافة أخت أبي بكر. من أخبث الناس وأسوئهم صيتاً وعائلة؛ أبوه الأشعث بن قيس الذي خذل أمير المؤمنين×، وألّب عليه الناس في صفّين، حتى اضطرّه لقبول التحكيم. وأُخته جعدة بنت الأشعث التي دسّت السمّ إلى الإمام الحسن×، وأخوه قيس بن الأشعث من قادة جيش ابن زياد في كربلاء. كتب إلى يزيد ابن معاوية يخبره بأنّ الكوفة تحوّلت لمسلم، وطلب منه الإسراع بتدارك الوضع، فكان له دور بارز في إخماد حركة مسلم بن عقيل، وقد أعطاه الأمان ثمّ غدر به، كما أنّه غدر بهانئ بن عروة، وجاء به إلى عبيد الله بن زياد. كان من قادة الجيش في كربلاء، وقد قال فيه الشاعر:
|
وقتلتَ وافد
حزب آل محمد |
مات ـ بدعاء الإمام الحسين× ـ مكشوف العورة أثر لدغة عقرب وهو في خلوته. وقيل: بقي حياً حتى أيام المختار وفرّ إلى مصعب بن الزبير فقُتِل معه سنة 67هـ. ويمكن الجمع بين القولين بأنّ دعاء الإمام× (اللهم أرني فيه هذا اليوم ذلّاً عاجلاً) تحقّق بأن لدغته العقرب، فشاهده الجيش بادي العورة وهو يتقلّب على عذرته، ولكنّه لم يمت، فبقي حياً إلى أيام المختار، حتى فرّ إلى ابن الزبير وقُتِل في جيشه. خصوصاً وأنّ الكثير من المؤرخين ذكروا لدغة العقرب، ولم يذكروا أنّه مات. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج2، ص77. ج6، ص410. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص279. الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص222. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج52، ص124ـ125. النويري، أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج3، ص365. الأمين، محسن، لواعج الأشجان: ص53ـ60، وص68.
[507] هكذا في الأصل، والصحيح (أسماء).
[508] أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر، أبو حسّان، الفزاري الكوفي، من أتباع بني أمية، كان من الذين شهدوا على حُجر بن عدي، وكان هو الذي ذكّر الحجاج بأمر كميل بن زياد النخعي، وعمير الضبابي، وخروجهما على عثمان، فقتلهما الحجاج. هلك سنة (65هـ)، وقِيل: (66هـ). اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج3، ص432، وج4، ص201. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، الإصابة: ج1، ص339.
[509] هكذا في الأصل، والصحيح (الدّيناري)، كما في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته. والمعروف هو: عمرو بن الحجّاج الزبيدي، خبيث ملعون. ممّن كاتب الإمام الحسين×، ثم غدر به، وهو من الذين استدرجوا هاني بن عروة إلى ابن زياد بعد انكشاف أمر مسلم بن عقيل، وكان على ميمنة الجيش الأُموي في كربلاء، وكان على رأس القوّة التي منعت الإمام الحسين× وأصحابه من ماء الفرات، وأحد حملة الرؤوس إلى عبيد الله بن زياد، فُقِد أثره بعد أن طلبه المختار في ثورته، وقيل: أدركوه بعد أن سقط من شدة العطش فذبحوه وأخذوا رأسه. اُنظر: الدينوري، أحمد بن داوود، الأخبار الطوال: ص229. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص272، وص312، وص321. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص81، وص236.
[510] في اللهوف: رويحة بنت عمر بن الحجاج. اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص33. وفي مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص35: (كانت روعة أخت عمرو ابن الحجاج تحت هاني بن عروة، وهي أم يحيى بن هانئ).
[511] هكذا في الأصل، والعبارة فيها سقط وتشويش، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (فانطلقوا إليه، فوجدوه جالساً على باب داره. فقالوا: يا هاني، إنّ الأمير يدعوك. فنهض مع القوم).
[512] هكذا في الأصل، والصحيح (دنا).
[513] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (فأحسّ ببعض الذي كان، فأقبل على أسماء).
[514] تنويه: أي تريده، ولعلّ المراد أنّ نفسه أحسّت ببعض ما يراد بها، لا ما يريده هو. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج15، ص348، (نوي).
[515] هكذا في الأصل، والصحيح (بن)، وفي مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص36: (لحسان بن أسماء بن خارجة).
[516] في مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص36: (عم).
[517] في مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص36: (فدخل القوم على ابن زياد، ودخل معهم. فلمّا طلع، قال عبيد الله: أتتك بخائن رجلاه).
[518] هكذا في الأصل، والصحيح (هانياً).
[519] خبَّى الشَّيءَ: ستره. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج1، ص62، (خبأ).
[520] هكذا في الأصل، والصحيح (دارك).
[521] هكذا في الأصل، ولعل (فقال) الثانية زائدة.
[522] هكذا في الأصل، والصحيح (ما).
[523] هكذا في الأصل، والصحيح (مذحج)، وسيأتي مثله كثير.
[524] هكذا في الأصل، ولعلّها زائدة. وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (فاعترضه معقلُ فقطع وجهَه نصفين)، ولعلّ المراد أنّ هانئاً ضرب معقلاً، فقد جاء في كتاب نور العين في مقتل الحسين× للأسفرائيني: (فاعترضه مَعقِل، فضربه هاني بسيفه قطع رأسه، وعجّل الله بروحه إلى النار). الاسفرائيني، أبو إسحاق، نور العين في مقتل الحسين×: ص26.
[525] هكذا في الأصل، والصحيح (روؤس). اُنظر أيضاً: مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري): ص36ـ38.
[526] شِفار: جمع شَفرة، وهي حدّ السيف. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج4، ص420، (شفر).
[527] الصفاح والصفائح: مفردها صفيحة، وهي السيف العريض. اُنظر: ابن سيده، علي بن إسماعيل، المخصص: ج2، ص24.
[528] هكذا في الأصل، ولعلّ الصحيح (لو أنّ رجلي)، و(لا) زائدة. وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (ويلكم لو كانت...).
[529] هكذا في الأصل، والصحيح أنّ (حتى) الثانية زائدة.
[530] اختلفت المصادر في مقاتلة هانئ& في قصر ابن زياد، فذكر بعضهم أنّه ضرب يده إلى قائم السيف ولكن مانعه الشرطي، وهو المشهور، ونقل البعض أنّ هانئاً تمكّن من أخذ السيف وقتل جماعة، ولم يذكر عدد المقتولين، وصرح البعض بأنّه& قتل خمسة وعشرين رجلاً، وذكر المصنف هنا أنّ القتلى اثنا عشر. اُنظر: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وأصحابه: ص48. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص259. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص48. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص29. الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج1، ص441. القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج3، ص57.
[531] هكذا في الأصل، والصحيح (يعلو).
[532] هكذا في الأصل، والصحيح (فتكاثرت).
[533] هكذا في الأصل، والصحيح (ودارت).
[534] هكذا في الأصل، والصحيح (انقطع).
[535] الجلبة: الصياح والصخب. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص128، (جلب).
[536] هكذا في الأصل، والصحيح (رئيسهم).
[537] هكذا في الأصل، والصحيح (فإنّ هانئاً حيٌ).
[538] هكذا في الأصل، والصحيح (شريحاً). وهو شريح بن الحارث بن قيس الكندي، أبو أُميّة، القاضي، أصله من أولاد الفرس الذين في اليمن. جاء إلى المدينة بعد وفاة النبي’. أدرك الجاهلية. وقد ولي القضاء على الكوفة لعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعُرف بقاضي الكوفة. عزله أمير المؤمنين× في بدايات خلافته، ثمّ أرجعه معاوية، كما وليَ القضاء لعبد الله بن الزبير. ومن نماذج سوء قضائه: أنّه طالب أمير المؤمنين× بالبينة! فلما جاءه بالحسن وقنبر رد شهادة الحسن×وعُرِف أنّه: عثماني، وشهد على حجر بن عدي، ولم يُبلِّغ قبيلة مراد ما قاله رئيسها هانئ بن عروة لـمّا كان في حبس ابن زياد. مات سنة (87 هـ)، وعمره مائة سنة. اُنظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج2، ص701. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج9، ص29. الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج4، ص100. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، تاريخ الخلفاء: ص202. البراقي، حسين بن أحمد، تاريخ الكوفة: ص258.
[539] هكذا في الأصل، والصحيح (هانياً).
[540] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص46ـ49. الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص423ـ425. بحر العلوم، سيد مهدى، الفوائد الرجالية: ج4، ص36ـ39، نقلاً عن مقتل الحسين× للطريحي.
وفي مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص39: (وبلغ عمرو بن الحجاج أنّ هانئاً قد قُتِل، فأقبل في مذحج حتى أحاط بالقصر، ومعه جمع عظيم، ثم نادى: أنا عمرو بن الحجاج، هذه فرسان مذحج ووجوهها، لم تخلع طاعة ولم تفارق جماعة. وقد بلغهم أنّ صاحبهم يقتل فأعظموا ذلك، فقيل لعبيد الله: هذه مذحج بالباب، فقال لشريح القاضي: ادخل على صاحبهم، فانظر إليه ثم اخرج، فأعلمهم أنّه حيّ لم يُقتَل، وأنّك قد رأيتَه. فدخل إليه شريح فنظر إليه).
[541] هكذا في الأصل، والصحيح (أبي عبد الرحمن).
[542] هكذا في الأصل، والصحيح (لعنه الله).
[543] هكذا في الأصل، والصحيح (موضعاً).
[544] هكذا في الأصل، والصحيح (يا بني).
[545] اُنظر أيضاً: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج2، ص86. وفيه: (بعث ابن زياد إلى هانئ، فقال: ائتني بمسلم. فقال: ما لي به علم. قال: فاحلف بالطلاق والعتاق. قال: إنّكم يا بني زياد لا ترضون إلّا بهذه الأيمان الخبيثة!! فأمر مكانه فضرب رأسه، ثم رمى به إلى الناس. وبعث إلى مسلم بن عقيل فجيء به).
[546] ولج يلج ولوجاً: أي دخل. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج1، ص347، (ولج).
[547] هكذا في الأصل، والصحيح (اليوم).
[548] هكذا في الأصل، والصحيح (ألوفٌ).
[549] هكذا في الأصل، والصحيح (يهوى)، كما في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. اُنظر: المزي، يوسف، تهذيب الكمال: ج6، ص423. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج2، ص302.
[550] هكذا في الأصل، والصحيح (يقال).
[551] العبارة فيها سقط وتشويش، وعبارة تهذيب الكمال هكذا: «فلمّا تحدّث أهل الكوفة بقدومه دبّوا إليه، فبايعه منهم اثنا عشر ألفاً، فقام رجل ممّن يهوى يزيد بن معاوية، يقال له: عبيد الله بن مسلم ابن شعبة الحضرمي إلى النعمان بن بشير». المزي، يوسف، تهذيب الكمال: ج6، ص423. واُنظر أيضاً: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج2، ص302.
[552] هكذا في الأصل، ولعلّ الصحيح (المِصر).
[553] هكذا في الأصل، والصحيح (ابن).
[554] العبارة مربكة وغير واضحة، ولعلّ المراد بها: (ثُمّ خرج معقل من عند مسلم بن عقيل (رضى الله عنه) فأخبر ابن زياد بخبر مسلم بن عقيل؛ فطلبه ابن زياد. فخرج مسلم بن عقيل من عند مسلم ابن عوسجه وأتى دار رجل من شيعته).
[555] عبّأتُ الجيش إذا رتّبتُهم في مواضعهم وهيّأتُهم للحرب. اُنظر: ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج3، ص168، (عبأ).
[556] هكذا في الأصل، والصحيح (قلباً).
[557] يُقسّم الجيش إلى خمسة أقسام: مقدِّمة وقلب وميمنة وميسرة وساقة، أو مقدّمة وقلب وجناحين وميمنة وميسرة. ولانقسامه إلى هذه الأقسام الخمسة سُمِّي خميساً. اُنظر: العيني، محمود بن أحمد، عمدة القاري: ج4، ص85. الكتاني الفاسي، عبد الحيّ، نظام الحكومة النبوية المسمّى التراتيب الإدارية: ج1، ص324.
[558] هكذا في الأصل، والصحيح (قصر).
[559] هكذا في الأصل، والصحيح (عبيد الله بن زياد).
[560] هكذا في الأصل، وهي عبارة مشوشة، وفي تاريخ الطبري: «وحبس سائر وجوه النَّاس عنده استيحاشاً إليهم لقلَّة عدد مَن معه مِن النَّاس». اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص276.
[561] هكذا في الأصل، والصحيح (وأصحاب).
[562] في المخطوطة في هذا الموضع لفظة غير واضحة الرسم.
[563] هكذا في الأصل، والصحيح (وانفذ).
[564] اُنظر أيضاً: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص259ـ260. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص58، وص62. المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب ومعاون الجوهر: ج3، ص59. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص63، ص64. ابن نما الحلي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص26. المزي، يوسف، تهذيب الكمال: ج6، ص425ـ426.
[565] هكذا في الأصل، والصحيح (لا أخل بشيء).
[566] في مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص41: (عن عبد الله بن حازم، قال: أنا ـ والله ـ رسول ابن عقيل إلى القصر؛ لأنظر إلى ما صار أمر هانئ، قال: فلمّا ضُرِب وحُبِس ركبتُ فرسي، وكنتُ أوّل أهل الدار دخل على مسلم بن عقيل بالخبر، وإذ نسوة لمراد مجتمعات ينادين يا عثرتاه يا ثكلاه، فدخلتُ على مسلم بن عقيل بالخبر فأمرني أن أنادي في أصحابه، وقد ملأ منهم الدور حوله. وقد بايعه ثمانية عشر ألفاً، وفي الدور أربعة آلاف رجل، فقال لي: نادِ يا منصور أمت. وناديتُ يا منصور أمت، وتنادي أهل الكوفة فاجتمعوا إليه. فعقد مسلم لعبيد الله بن عمرو ابن عزير الكندي على ربع كندة وربيعة، وقال: سِر أمامي في الخيل. ثم عقد لمسلم بن عوسجة الأسدي على ربع مذحج وأسد، وقال: انزل في الرجال فأنت عليهم، وعقد لابن ثمامة الصائد على ربع تميم وهمدان، وعقد لعباس بن جعدة الجدلي على ربع المدينة. ثم أقبل نحو القصر، فلمّا بلغ ابنَ زياد إقبالُه تحرّز في القصر وغلق الأبواب... قال: خرجنا مع ابن عقيل أربعة آلاف، فلمّا بلغنا القصر إلّا ونحن ثلثمأة قال: وأقبل مسلم يسير في الناس من مراد حتى أحاط بالقصر. ثم إنّ الناس تداعوا إلينا واجتمعوا، فوالله ما لبثنا إلّا قليلاً حتى امتلاء المسجد من الناس والسوق، وما زالوا يثوبون حتى المساء، فضاق بعبيد الله ذرعه، وكان كبر أمره أن يتمسّك بباب القصر، وليس معه إلّا ثلاثون رجلاً من الشُرِط، وعشرون رجلاً من أشراف الناس وأهل بيته ومواليه، وأقبل أشراف الناس يأتون ابن زياد من قبل الباب الذي يلي دار الرومين، وجعل من بالقصر مع ابن زياد يشرفون عليهم، فينظرون إليهم فيتّقون أن يرموهم بالحجارة، وأن يشتموهم، وهم لا يفترون على عبيد الله وعلى أبيه...).
[567] في مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص45: (فما زالوا يتفرّقون ويتصدّعون حتى أمسى ابن عقيل وما معه ثلاثون نفساً في المسجد، حتى صليتُ المغرب. فما صلى مع ابن عقيل إلّا ثلاثون نفساً. فلمّا رأى أنّه قد أمسى وليس معه إلّا أولئك النفر خرج متوجهاً نحو أبواب كندة، فلمّا بلغ الأبواب ومعه منهم عشرة، ثم خرج من الباب وإذا ليس معه إنسان، والتفت فإذا هو لا يحسّ أحداً يدلّه على الطريق، ولا يدله على منزل ولا يواسيه بنفسه إن عرض له عدو. فمضى على وجهه يتلدّد في أزقة الكوفة لا يدرى أين يذهب، حتى خرج إلى دور بنى جبلة من كندة).
[568] الحِيرة: مدينة تاريخية قديمة تقع في وسط العراق. عاصمة المناذرة قديماً، قال الحموي: «مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف». تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينتي النجف والكوفة على مسافة (7كم)، ولا يزال جزء من ناحية الحيرة القديمة مأهولاً بالسكان. وهي اليوم تابعة إلى قضاء المناذرة في محافظة النجف الأشرف. اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج2، ص328. السعيدي، محمد عبد الغني، من كربلاء إلى دمشق: ص110.
[569] يقال لها: طوعة لم يذكر التاريخ عنها غير موقفها مع مسلم×، وأنّها أُمّ ولد للأشعث بن قيس، وقِيل: أنّها كانت امرأة قيس الكندي، فتزوّجها أُسيد بن مالك الحضرمي، وقِيل: تزوّجها أسد ابن البطين، فولدت بلالاً. وقصتها في إيواء مسلم بن عقيل× معروفة ومفصّلة. وقد ذكر بعض المعاصرين نسباً لها بقوله: (طوعة بنت عبد الله بن محمد الكندي الكوفي)، من دون أن يذكر مصدراً على مدعاه. وقد ناقشه في ذلك الحساني بكتابه طوعة في التاريخ. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص277. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص50. زميزم، سعيد رشيد، نساء حول الحسين×: ص117. الحسّاني، كريم جهاد، طوعة في التاريخ: ص20.
[570] هكذا في الأصل، والصحيح (محرم).
[571] هكذا في الأصل، والصحيح (شيءٌ).
[572] هكذا في الأصل، والصحيح (قلتِ).
[573] هكذا في الأصل، والصحيح (هممتُ).
[574] هكذا في الأصل، والصحيح (بقية).
[575] هكذا في الأصل، والصحيح (قريش).
[576] لعلّ العبارة فيها تقديم وتأخير؛ فإنّه حينما عرفتْ أنّه من بني عبد المطلب، فقد عرفتْ أنّه من هاشم. فالصحيح في العبارة أن يقال: (فقال: من هاشم. فقالت: من أيّ هاشم؟ فقال: من عبد المطلب. فقالت: من أيّ عبد المطلب؟).
[577] أعزرها: أعظمها. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج2، ص744، (عزر).
[578] الفِجاج: الطرق الواسعة. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص674، (فجج).
[579] هكذا في الأصل، والصحيح (وأضوؤها).
[580] أي أدخل.
[581] هكذا في الأصل، والصحيح (وطّأت).
[582] هكذا في الأصل، والصحيح (أقصى).
[583] هجم الليل: دخل. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج12، ص601، (هجم).
[584] هكذا في الأصل، والصحيح (مالي).
[585] يقال: يسارق النظر إليه، أي: يطلب غفلة لينظر إليه. الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط: ج3، ص245 (سرق).
[586] «غطّ النائم غطيطاً: تردّد نفسه إلى حلقه حتى يسمعه من حوله». الطريحي، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين: ج4، ص262، (غطط).
[587] هكذا في الأصل، والصحيح (يقرأ)، وكذا في الموارد التي بعده.
[588] خاتمة سورة يس(82ـ83) قوله تعالى: (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ).
[589] الفتح: آية 1.
[590] الدِّهْلِيز، بالكسر: ما بين الباب والدار، فارسي معرب، والجمع الدَّهالِيز. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج5، ص349، (دهلز).
[591] هكذا في الأصل، والصحيح (وراءك).
[592] هكذا في الأصل، والصحيح (أبه).
[593] هكذا في الأصل، والصحيح (أعداء).
[594] خلع عليه خلْعة: أعطاه منحةً. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص250، (خلع).
[595] اُنظر أيضاً: مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) : ص45ـ46. وص48.
[596] هكذا في الأصل، والصحيح (استدعى).
[597] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (خمسمائة)، وفي مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص49: (ستين أو سبعين رجلاً كلّهم من قيس).
[598] هكذا في الأصل، والصحيح (وافى).
[599] القعقعة: حكاية صوت السلاح ونحوه. واللجام للدابة: معروف، فارسي معرب، والجمع أَلْجِمة ولُجُم ولُجْم. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج3، ص1269، (قعقع). ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج12، ص534، (لجم).
[600] الوهج (بفتح الواو وسكون الهاء): اتقّاد النار واشتعالها. وإذا كانت بفتح الهاء فبمعنى حرّ النار. وقد يستعار بمعنى التلألؤ. فلعلّ المراد هنا أنّها رأت توهّج النار التي يحملها أفراد الجيش، وقد يراد بها هنا الكناية عن شدة وقوة هجوم القوم على مسلم بن عقيل. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج1، ص348. ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة: ج6، ص147. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج2، ص401، (وهج).
[601] اصطفاق: جمع اصطفق وهو تضارب الرماح بحيث يسمع لها صوت. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص517، (اصطفق).
[602] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (بمنطقته).
[603] هكذا في الأصل، والصحيح (يهجموا).
[604] جديلة: صريعة. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص111، (جدل).
[605] هكذا في الأصل، والصحيح (فيسوؤني).
[606] هكذا في الأصل، والصحيح (يسوؤني).
[607] هكذا في الأصل، والصحيح (ألقى).
[608] هكذا في الأصل، والصحيح (فجزّاها).
[609] في مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص49: (فلمّا سمع وقع حوافر الخيل وأصوات الرجال عرف أنّه قد أُتِى، فخرج إليهم بسيفه، واقتحموا عليه الدار، فشدّ عليهم يضربهم بسيفه حتى أخرجهم من الدار، ثم عادوا إليه فشدّ عليهم كذلك. فاختلف هو وبكير بن حمران الأحمري ضربتين، فضرب بكير فم مسلم فقطع شفته العليا وأشرع السيف في السفلى ونصلت لها ثنيتاه، فضربه مسلم ضربة في رأسه منكرة وثنى بأخرى على حبل العاتق كادت تطلع على جوفه، فلمّا رأوا ذلك أشرفوا عليه من فوق ظهر البيت، فأخذوا يرمونه بالحجارة، ويلهبون النار في أطنان القصب ثم يقبلونها عليه من فوق البيت، فلمّا رأى ذلك خرج عليهم مصلتاً بسيفه في السكة فقاتلهم).
[610] عمد إلى الشيء: قصده. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2ص626، (عمد).
[611] الدسيعة: من الدسع وهو الدفع والقوة. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص283، (دسع).
[612] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (مائة وثمانون فارساً). وفي أسرار الشهادات (مائة وخمسين فارساً).
[613] هكذا في الأصل، والصحيح (عبيد).
[614] هكذا في الأصل، والصحيح (أمدنا).
[615] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (مقتلة عظيمة). اًنظر أيضاً: الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص59، المجلس الثاني.
[616] هكذا في الأصل، والصحيح (يلبثوا).
[617] «أجفل القوم، أي هربوا مسرعين». الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج4، ص1657، (جفل).
[618] هكذا رسمت في الأصل.
[619] هكذا في الأصل، والصحيح (أعطه).
[620] هكذا في الأصل، والصحيح (أفناكم).
[621] هكذا في الأصل، والصحيح (عدمك).
[622] الجرمقاني بفتح القاف واللام: الجرامقة: قوم بالموصل أصلهم من العجم. الجوهري، إسماعيل ابن حماد، الصحاح: ج4، ص1454، (جرامقة).
[623] هنا في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (فأنفذ إليه ابن زياد لعنه الله خمسمائة فارس).
[624] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته:
|
(أقسمتُ لا
أُقتَل إلّا حُرّا |
[625] لعلّ كلمة (شعر) وما شابهها من الناسخ للتوضيح.
[626] تترا: جاؤوا تترا: متواترين، وأصله وترا. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص1010، (وتر). وفي بعض الكتب أنّ الأبيات لحمران بن مالك الخثعمي، تمثّل بها مسلم× وهي تختلف عمّا ذكره هنا.
[627] اُنظر أيضاً: ابن نما الحلي، محمد بن جعفر، مثير الأحزان: ص24. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص34. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص357. الأمين، محسن، لواعج الأشجان: ص59. وفيها جميعاً أنّ الأبيات لحمران بن مالك الخثعمي قالها يوم القرن، وتمثّل بها مسلم×.
[628] محجر العين: ما يبدو من النقاب الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج2، ص624، (حجر).
[629] هكذا في الأصل، والصحيح (فغشى).
[630] الكر: خلاف الفر. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص782، (كرر).
[631] في مقتل أبي مخنف اختلاف كبير وتفصيل لما جرى بين مسلم× وجيش ابن زياد. اُنظر: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري): ص50.
[632] هكذا في الأصل، والصحيح (الدهليز).
[633] كيزان: جمع كوز وهو إناء معروف يجمع فيه الماء. اُنظر: الطريحي، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين: ج4، ص33، (كوز).
[634] هكذا في الأصل، والصحيح (ماء)، وستأتي أمثالها في موارد كثيرة، لا تكتب فيها الهمزة.
[635] هكذا في الأصل، والصحيح (كوزاً).
[636] هكذا في الأصل، والصحيح (فاه) أو (من فيه).
[637] دم عبيط: طري. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص581، (عبط).
[638] هكذا في الأصل، ولعلّ إحدى الكلمتين (عاد دفع) زائدة.
[639] في مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص52: (إنّ مسلم بن عقيل حين انتهى إلى باب القصر فإذا قلة باردة موضوعة على الباب، فقال ابن عقيل: أسقوني من هذا الماء، فقال له مسلم بن عمرو: أتراها ما أبردها، لا والله لا تذوق منها قطرة أبداً حتى تذوق الحميم في نار جهنم. قال له ابن عقيل: ويحك من أنت؟ قال: أنا بن مَن عرف الحق إذا أنكرتَه، ونصح لإمامه إذ غششتَه، وسمع وأطاع إذ عصيتَه وخالفتَ، أنا مسلم بن عمرو الباهلي. فقال ابن عقيل: لأمّك الثكل ما أجفاك! وما أفظك! وأقسى قلبك! وأغلظك! أنت يا بن باهلة أولى بالحميم والخلود في نار جهنم منّي، ثم جلس متسانداً إلى حائط).
[640] إشارة إلى قوله تعالى: (وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى) سورة (طه) آية(47).
[641] هكذا في الأصل، والصحيح (وجهه ضاحك فرح).
[642] هكذا في الأصل، والصحيح (ومقبلاً).
[643] هكذا في الأصل، والصحيح (هلّا سلّمتَ).
[644] هكذا في الأصل، والصحيح (الإمرة).
[645] هكذا في الأصل، والصحيح (علينا).
[646] الحجّامة: التي حرفتها الحجامة، وهي امتصاص الدم بالمحجم. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص158، (حجم).
[647] الأُجاج بالضم: الماء شديد الملوحة. اُنظر: ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج1، ص25، (أجج).
[648] هكذا في الأصل، ولعلّ الصحيح (بالعذب).
[649] قط: بمعنى حسب، تدل على الأبد الماضي. اُنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج5، ص14.
[650] يقال ذوى العود: ذبُل ويبس وضعف. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص318، (ذوي).
[651] هكذا في الأصل، وفي العبارة سقط، والتقدير: (لا عليك)، كما في بعض المصادر. اُنظر: أبو أعثم الكوفي، الفتوح: ج5، ص56. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص35.
[652] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (فقال ابن زياد (لعنه الله) سواء عليك سلّمتَ أو لم تسلّم؛ فإنّك مقتول في هذا اليوم). وفي مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص52: (وأُدخِل مسلم علي ابن زياد، فلم يسلّم عليه بالإمرة، فقال له الحرسي: ألا تسلّم على الأمير؟ فقال له: إن كان يريد قتلى فما سلامي عليه، وإن كان لا يريد قتلى، فلعمري ليكثرَنّ سلامي عليه. فقال له ابن زياد: لعمري لتُقتلَنّ، قال: كذلك؟ قال: نعم).
[653] انزاح عن المكان: زال وتنحّى وتباعد. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص406، (زاح).
[654] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (... وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله وأنّ علياً وليّ الله).
[655] هكذا في الأصل، والصحيح (مصركم).
[656] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (ألف درهم).
[657] هكذا في الأصل، والصحيح (وهي).
[658] هكذا في الأصل، والصحيح (فيصيبه).
[659] بيّت الأمر: دبّره ليلاً. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير: ج1، ص68، (بات).
[660] هكذا في الأصل، وكذا في المورد الآتي والصحيح (ما ذكرتَ).
[661] هكذا في الأصل، ولعل المراد (قضاء).
[662] هكذا في الأصل، والصحيح (أن).
[663] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (فلا بدّ أن يقدم علينا ونذيقه الموت غُصّة بعد غُصّة).
[664] هكذا في الأصل، والظاهر أنّ العبارة فيها سقط.
[665] فَشَتْ أسرارهُ: اِنْتَشَرَتْ، ذَاعَتْ. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج15، ص155، (فشا).
[666] هكذا في الأصل، والصحيح (يخرج). كما في مقتل أبي مخنف المطبوع المتداول.
[667] هكذا في الأصل، والصحيح (أحد).
[668] في مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص53: (قال: فدعني أوصي إلى بعض قومي، فنظر إلى جلساء عبيد الله وفيهم عمر بن سعد، فقال يا عمر: إنّ بيني وبينك قرابة، ولي إليك حاجة، وقد يجب لي عليك نجح حاجتي، وهو سِرّ. فأبى أن يمكّنه من ذكرها، فقال له عبيد الله: لا تمتنع أن تنظر في حاجة ابن عمك، فقام معه فجلس حيث ينظر إليه ابن زياد، فقال له: إنّ علىَّ بالكوفة ديناً استدنتُه منذ قدمتُ الكوفة سبعمأة درهم فاقضها عنّي، وانظر جثّتي فاستوهبها من ابن زياد فوارها، وابعث إلى حسين من يردّه، فإنّي قد كتبتُ إليه أعلمه أنّ الناس معه، ولا أراه إلّا مقبلاً. فقال عمر لابن زياد: أتدري ما قال لي؟ إنّه ذكر كذا وكذا. قال له ابن زياد: إنّه لا يخونك الأمين، ولكن قد يؤتمن الخائن، أمّا مالك فهو لك، ولسنا نمنعك أن تصنع فيه ما أحببتَ، وأمّا حسين فإنّه إن لم يردنا لم نرده، وإن أرادنا لم نكف عنه، وأمّا جثّته فإنّا لن نشفّعك فيها؛ إنّه ليس بأهل منّا لذلك، قد جاهدنا وخالفنا وجهد على هلاكنا. وزعموا أنّه قال: أمّا جئّته فإنّا لا نبالي إذا قتلناه ما صُنِع بها).
[669] لم نعثر على اسمه.
[670] هكذا في الأصل، والصحيح (بكى).
[671] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص356.
[672] هكذا في الأصل، وكذا في المورد الآتي، والصحيح (جزى).
[673] هكذا في الأصل، ولعلّ المراد (أعقّ).
[674] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (راموا).
[675] هكذا في الأصل، والصحيح (نذلّ).
[676] هكذا في الأصل، والصحيح (دماءنا).
[677] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (ذِماماً ولا دَما).
[678] هكذا في الأصل، والصحيح (فيهمُ).
[679] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته:
|
(فنحن بنو المختار لا خلق مثلنا |
[680] وهذا يدلّ على أنّ مجموعة من أنصار مسلم× قد سُجِنوا، ولولا ذلك لكانت النتائج مختلفة. وهذا ما أشار إليه بعض العلماء. اُنظر: النمازي الشاهرودي، علي، مستدركات علم رجال الحديث: ج4، ص138.
[681] اُنظر أيضاً: الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص427ـ428.
[682] هكذا في الأصل، ولعلّ المراد: شجعانهم وفحولهم. اُنظر: الزمخشري، محمود بن عمر، أساس البلاغة: ص300.
[683] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص49ـ58. الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص428. القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة لذوي القربى: ج3، ص57ـ59. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص67، المجلس الثاني.
[684] عبد الله بن الزَّبِير بن الأشْيَم الأَسدي. أبو كثير. كوفي المنشأ والمنزل. وهو شاعر أهل الكوفة. من شيعة بني أميّة اشتهر بالمدح والهجاء معاً. وهو الذي قال لابن الزبير، لمّا منعه العطاء: لعن الله ناقةً حملتني إليك. فقال ابن الزبير: إن، وراكبها. أي نعم وراكبها. مات بالريّ في خلافة عبد الملك بن مروان سنة (75هـ)، وقِيل: مات في زمن الحجّاج بعد أن كُفّ بصره بمدة قصيرة. وله شعر كثير وصل إلينا بعضه. له ديوان مطبوع، جمعه وحققه يحيى الجبوري. اُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، علي ابن الحسين، الأغاني: ج14 ص399. الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص383. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج9، ص96. البغدادي، عبد القاهر بن عمر، خزانة الأدب: ج2، ص233. الزركلي، خير الدين بن محمود، الأعلام: ج4 ص87.
[685] قيل إنّها لسليمان الحنفي. اُنظر: الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص69، المجلس الثاني.
[686] هكذا في الأصل، والصحيح (فانظري * إلى هانئ بالسوق وابن عقيل).
[687] هكذا في الأصل، والصحيح (من طمار). اُنظر: أبو الفرج، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص72.
[688] هكذا في الأصل، والصحيح (فتى كان أحيى من فتاة..) كما في اللهوف.
[689] هكذا في الأصل، والصحيح (أيركب).
[690] الهماليج: جمع هملاج، وهي البراذين أي الخيل الهجين، يُقال فرس هملاج، وهو يهملج براكبه، وخيل هماليج. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج1، ص351، (هملج). الزمخشري، محمود بن عمر، أساس البلاغة: ص1066. النويري، أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج10، ص19.
[691] الذحل: الثأر أو طلب مكافأة بجناية جنيت عليك أو عداوة، أو بمعنى العداوة والحقد. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج11، ص256، (ذحل).
[692] هكذا في الأصل، والصحيح (الثأر).
[693] هكذا في الأصل، وفي اللهوف ومقتل أبي مخنف المتداول (فكونوا بغايا أرضيت بقليل).
[694] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص58ـ59. باختلاف في الأبيات عدداً ولفظاً. أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص65ـ67. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص57ـ65. الفتال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص175ـ177. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص34ـ37. الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص426ـ428. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص355ـ357.
[695] هكذا في الأصل، والصحيح (بن).
[696] هكذا في الأصل، والصحيح (لأخذناه).
[697] هكذا في الأصل، والصحيح أنّها زائدة.
[698] هكذا في الأصل، والصحيح: هاني ـ أو هانئ ـ بن أبي حية الوداعي الهمداني الكلبي. لم يُترجَم له في كتب الرجال. من أعوان ابن زياد. وشَى بالمختار إلى عمرو بن حريث بأنّه ليس مع الناس في حربهم ضد مسلم، فضرب ابن زياد المختار بالقضيب على عينه فشترها، وأمر به إلى السجن. ثم إنّه اعترض على المختار لما التقى به في مكة قبل قيامه بالثورة، وكان يميل إلى ابن الزبير. اُنظر: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل أبي مخنف: ص269. الأمين، حسن، مستدركات أعيان الشيعة: ج4، ص175. الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم الرجال: ج8، ص136.
[699] الزبير بن الأروح أو الأروج التميمي. تابعي من أهل العراق، كان على ميسرة الجيش الذي بعثه الحجاج بقيادة الحارث بن عميرة لقتال الخوارج في الموصل سنة (76هـ). اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج8، ص9. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج18ص306.
[700] هكذا في الأصل، والصحيح (أيّها) كما في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته.
[701] هكذا في الأصل، والصحيح (برأسيهما).
[702] هكذا في الأصل، وقد تقدّم منه (حبة)، والصحيح (حية).
[703] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري): (فإنّ عندهما علماً وصدقاً، وفهماً وورعاً، والسلام).
[704] هكذا في الأصل، وفي الإرشاد وغيره: (عملتَ عمل الحازم). اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج2، ص85. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص65.
[705] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري): ص60. مع اختلاف يسير.
[706] هكذا في الأصل، والصحيح أنّه عبيدة بن عمرو البدي الكندي. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج2، ص86. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص212.
[707] هكذا في الأصل، والصحيح (أسلمتَ عمَّك لم تقاتل دونه).
[708] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص60. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص212ـ213. المسعوديّ، عليّ بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر: ج3، ص59.
[709] هكذا في الأصل، والصحيح (مخنف).
[710] نقول: ما ذكره المؤلف هنا مخالف لما هو المعروف المشهور بين المؤرخين من أنّ الإمام الحسين× خرج من مكة متوجهاً إلى الكوفة في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو اليوم الذي اُستُشهِد فيه مسلم بن عقيل× أو بعده بيوم. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص286. المسعوديّ، عليّ بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر: ج3، ص54.
[711] هكذا في الأصل، والصحيح (بكى بكاءً)، وستأتي مثلها في موارد كثيرة، وقد أشرنا له هنا فقط اختصاراً.
[712] هكذا في الأصل، والصحيح (أقدم على أبيك وأخيك)، ويُحتمَل هكذا (قدِمَ عليَّ أبوك وأخوك...).
[713] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص61. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص19. الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص216ـ217. القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة لذوي القربى: ج3، ص54. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج2، ص248.
[714] هكذا في الأصل، والصحيح كما في الطبري وغيره: (قال هشام عن أبي مخنف حدثني الصقعب ابن زهير عن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي. قال لما قدمت كتب أهل العراق إلى الحسين وتهيّأ للمسير إلى العراق أتيتُه فدخلتُ عليه وهو بمكة). اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص286. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص64. النويري، أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص406.
[715] هكذا في الأصل، والصحيح (أمراء).
[716] هكذا في الأصل، والصحيح (يقاتل).
[717] هكذا في الأصل، والصحيح (عم).
[718] الحارث بن خلف بن العياض: لم نعثر عليه. وفي تاريخ الطبري (فدخلت على الحارث بن خالد ابن العاص بن هشام). وهو الحارث بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي القريشي. أخو عكرمة المحدث المعروف. جدّه العاص بن هشام قتله أمير المؤمنين× يوم بدر. وكان الحارث من شعراء الغزل، من أهل مكة. نشأ في أواخر أيام عمر بن أبي ربيعة. وكان ذا خطر وقدر ومنظر في قريش، ولّاه يزيد بن معاوية إمارة مكة، فظهرت دعوة عبد الله بن الزبير، فاستتر الحارث خوفاً، ثم رحل إلى دمشق وافداً على عبد الملك بن مروان، فلم ير عنده ما يحب، فعاد إلى مكة، وتوفي بها سنة(80هـ). جمع الدكتور يحيى الجبوري ما وجد من شعره في كتاب (شعر الحارث بن خالد المخزومي) مطبوع. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص287. أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين، الأغاني: ج3، ص217. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج2، ص154.
[719] هكذا في الأصل، والصحيح (أشرتَ).
[720] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري): ص63. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص64. ابن الأثير، عليّ بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص37. وفي مقتل أبي مخنف والكامل في التاريخ أنّ الإمام الحسين× ـ مضافاً لما في المتن ـ قال له: (ومهما يقض من أمر يكن، أخذتُ برأيك أو تركتُه)، وفي الفتوح قريب منها.
[721] هكذا في الأصل، والصحيح (الفظيع)، ومعنى الفظيع: الشديد الشنيع. اُنظر: الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: ج11، ص347، (فظع).
[722] في مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص64: (عن عتبة بن سمعان أنّ حسيناً لمّا أجمع المسير إلى الكوفة أتاه عبد الله بن عباس، فقال: يا بن عم إنّك قد أرجف الناس، إنّك سائر إلى العراق، فبيّن لي ما أنت صانع؟ قال: إنّي قد أجمعتُ المسير في أحد يومي هذين إن شاء الله تعالى. فقال له ابن عباس: فإنّي أعيذك بالله من ذلك. أخبرني ـ رحمك الله ـ أتسير إلى قوم قد قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم؟ فإن كانوا قد فعلوا ذلك، فسر إليهم، وإن كانوا إنّما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم، وعمّاله تجبى بلادهم، فإنّهم إنّما دعوك إلى الحرب والقتال، ولا آمن عليك أن يغروك ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك، وأن يستنفروا إليك فيكونوا أشد الناس عليك. فقال له حسين: وإنّي أستخير الله، وأنظر ما يكون؟ قال: فخرج ابن عباس من عنده).
[723] هكذا في الأصل، والصحيح (قام).
[724] هكذا في الأصل، والصحيح (وأراد خروجي).
[725] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (إلى الحجاز أو اليمن). واليَمَن: دولة عربية موغلة في القدم، يحدها من الشمال المملكة السعودية ومن الشرق سلطنة عمان، لها ساحل جنوبي على بحر العرب (جزء من المحيط الهندي)، وساحل غربي على البحر الأحمر. يرجع تاريخها إلى ما قبل الميلاد حيث قامت فيها مملكة سبأ ومَعين وقتبان وحضرموت وحِمير. قيل: إنّها سُمِّيت باليمن لتيامنهم إليها لمّا تفرّقت العرب عن مكة، كما سُمِّيت الشام لأخذها الشمال. وُصِفت بالخضراء؛ لكثرة أشجارها وثمارها وزروعها. تقع اليوم على الخريطة جنوب غرب شبه الجزيرة العربية في غربي آسيا. اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله، معجم البدان: ج5، ص447. الموسوعة الحرة ويكيبيديا.
[726] الشِّعب: الطريق في الجبل. والجمع الشعاب. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج1، ص156، (شعب).
[727] في مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص65: (ولأبيك بها شيعة).
[728] هكذا في الأصل، والصحيح (أرجو).
[729] النُّصح بمعنى: خلص، أي: دونما غش. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص925، (نصح).
[730] صاحب هذه الأبيات: هو طرفة بن العبد الشّاعر. اُنظر: الميداني، أحمد بن محمد، مجمع الأمثال: ج1، ص239، رقم1268
[731] هكذا في الأصل، والمشهور (يا لك من قنبرة)، وهو الصحيح. والقُنْبَرة أو القبّرة: نوع من العصافير، صغير يُشبه الحُمّرة. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج4، ص215، (قبر)
[732] هكذا في الأصل، والصحيح: (ونقّري).
[733] هكذا في الأصل، ولعل الصحيح (هذا)، كما في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته.
[734] هكذا في الأصل، والصحيح (راحلٌ).
[735] الظفَر بالفتح: الفوز. وقد ظفر بعدوه أي فاز عليه. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج2، ص730، (ظفر).
[736] اُنظر أيضاً: الدينوري، أحمد بن داوود، الأخبار الطوال: ص244. المسعوديّ، عليّ بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر: ج3، ص54ـ55. أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص72ـ73. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الملوك والأُمم: ج5، ص328. وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته:
|
يا لك من قنبرة بمعمر |
أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص61ـ64.
[737] هكذا في الأصل، والصحيح (فقال له: يا ابن الزبير)، كما يدلّ عليه سياق الكلام.
[738] هكذا في الأصل، والصحيح (سائراً).
[739] هكذا في الأصل، والصحيح (تضحك).
[740] الشماتة: الفرح ببلية العدو. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج1، ص255، (شمت).
[741] هكذا في الأصل، والصحيح (فتنة).
[742] هكذا في الأصل، والصحيح (حبيبا).
[743] لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ، ومضمونه ورد عند الفريقين.
[744] هكذا في الأصل، والصحيح (لم يسر).
[745] كتب مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين× كتاباً، يقول فيه: «أمّا بعد فإنّ الرائد لا يكذب أهله، وأنّ جميع أهل الكوفة معك. وقد بايعني منهم ثمانية عشر ألفاً؛ فعجِّل الإقبال حين تقرأ كتابي، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته». ابن نما الحلّي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص21. واُنظر أيضاً: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص281.
[746] اُنظر أيضاً: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص167. ابن مسكويه الرازي، أحمد بن محمد، تجارب الأُمم: ج2، ص60. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص181.
[747] هكذا في الأصل، والصحيح (لأبي).
[748] هكذا في الأصل، والصحيح (مشتاقون)
[749] هكذا في الأصل، والصحيح (الحسين).
[750] هكذا في الأصل، والصحيح (باكٍ).
[751] تقدّم تخريج الحديث في ص140ـ 141، فراجع.
[752] محمد بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب^، المعروف بابن الحنفية، أبو القاسم، أُمّه خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية، وُلِد سنة ثلاث عشرة، وقيل: إحدى وعشرين من الهجرة، وكان مع أبيه الإمام علي× في معركة الجمل فأعطاه الراية، وأمره أن يحمل، فحمل وحمل الناس، فانهزم أهل البصـرة، واشترك في معركة صفّين. أقام بمكة هو وابن عباس، فدعاهما عبدُ الله بن الزبير للبيعة، فأبيا فأراد أن يحرقهما مع باقي بني هاشم بعد أن حاصرهم في شعب أبي طالب، وقيل حبسهم في سجن عارم، فخلّصهم جيش المختار والتجئا إلى الطائف، وبقيا فيها حتى تُوفّي ابن الحنفية هناك، وكانت وفاته سنة (84 هـ)، وقيل: سنة (81هـ)، وقيل: في غرة محرم سنة (82هـ)، وقيل غير ذلك. صلّى عليه ابن عباس. وقد رُوِي أنّ إمامنا الباقر× كان فيمن عاده في مرضه وغمّضه وأدخله حفرته وزوّج نساءه، وقسّم ميراثه. وهذا يدلّ على أنّ الإمام الباقر× عاده في أيام إمامة أبيه زين العابدين×؛ لأنّ شهادة الإمام السجاد× سنة 95. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج2، ص241. الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين وتمام النعمة: ص36. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج54، ص357ـ358. الطبرسي، الميرزا حسين النوري، النجم الثاقب: ج1، ص351. القمي، عباس، الكنى والألقاب: ج1، ص112. الشاهرودي، علي النمازي، مستدرك سفينة البحار: ج5، ص216. اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق، موسوعة طبقات الفقهاء: ج1، ص518.
[753] هكذا في الأصل، والصحيح (درعٌ).
[754] يقال: أنته: حسده. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج1، ص242، (أنت).
[755] هكذا في الأصل، ولعلّ المراد (ولا أشك).
[756] هكذا في الأصل، والصحيح (تمضِ).
[757] هكذا في الأصل، والصحيح (أعواناً).
[758] لم يحدَّثنا التاريخ بوجود أعوان أو أنصار أو شيعة للإمام الحسين× أو لأهل البيت^ في مكة المكرمة.
[759] هكذا في الأصل، والصحيح (يُبِقِ).
[760] هكذا في الأصل، والصحيح (أتلهّى) بمعنى انشغل به عن همّي.
[761] هكذا في الأصل، والصحيح (أجلو).
[762] هكذا في الأصل، ولعلّ المراد (أودّ).
[763] لهذم: السيف الحاد. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج12، ص556، (لهذم).
[764] المِخْذَمُ: السيف القاطع. المصدر السابق: ج12، ص169، (خدم).
[765] هكذا في الأصل، والصحيح (ماء وهواء).
[766] هكذا في الأصل، والصحيح (أُغمِي).
[767] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص61ـ62. الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص435. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص119ـ120، المجلس الرابع. لجنة الحديث في معهد باقر العلوم×، موسوعة كلمات الإمام الحسين×: ص406.
[768] في مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص70: (قال: أقبل الحسين بن علي بأهله من مكة، ومحمد ابن الحنفية بالمدينة، قال: فبلغه خبره، وهو يتوضأ في طست، فبكى حتى سمعتُ وكف دموعه في الطست).
[769] هكذا في الأصل، والصحيح (سائر).
[770] المنايا: جمع منية، وهي الموت. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج6، ص2497، (منا).
[771] المعروف والمشهور أنّ الإمام الحسين× سمع الهاتف في رؤية رآها في طريقه من مكة إلى كربلاء. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص308. أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص74. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص82. ابن نما الحلّي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص34. ابن الأثير، عليّ بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص51. الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص298. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص188. القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج3، ص61ـ62.
[772] هكذا في الأصل، والصحيح (وواسى).
[773] لم أبل: للتخفيف وهي (لم أبال) أي لا أهتمّ به، ولا أكترث له. اُنظر: الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير: ج1، ص62، (بلي). وفي الفتوح (لم ألم). وفي غيره (اندم). اُنظر: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص79. ابن قولويه القمي، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص194. الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص219.
[774] اُنظر أيضاً: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص81. الفتال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص180.
نقول: تمثّل الإمام الحسين× بهذه الأبيات ـ المنسوبة إلى أخي الأوس ـ لمّا واجهه الحر بن يزيد في العراق. نعم صاحب تذكرة الخواص نقلها عنه قبل أن يخرج الإمام× من مكة. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص171. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص305. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص81. الفتال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص179. سبط ابن الجوزي، أبو المظفر بن فرغلي، تذكرة الخواص: ص308.
[775] عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي، كنيته أبو جعفر، أمه أسماء بنت عميس الخثعمية رضوان الله عليها، وهو أوّل مولود وُلِد في الإسلام بأرض الحبشة. عاد مع أبويه إلى المدينة المنورة في السنة السابعة للهجرة، ثم استُشهد أبوه في معركة مؤتة سنة 8هـ فتكفّله النبيّ’ مع أخويه محمد وعون. من أصحاب رسول الله’ وأمير المؤمنين والحسن والحسين^. له كلمات في مدح أمير المؤمنين والحسنين^ والدفاع عنهم في محضر معاوية وأعوانه. وكان حليماً ظريفاً عفيفاً، وقد عُرِف بالجود والكرم، وقيل: لم يكن في الإسلام أسخى منه. روى عن النبي’، وكان أحد الأُمراء في جيش الإمام علي× يوم صفّين. زوّجه عمّه أمير المؤمنين× من ابنته السيدة زينب الكبرى‘. وجلالة قدره أشهر من أن تذكر فقد كان أمير المؤمنين× يتحفّظ عليه من القتل كما كان يتحفظ على الحسن والحسين÷ ومحمد بن الحنفية. تزوّج من ليلى بنت مسعود النهشلية. وقيل: إنّه بعد وفاة السيدة زينب تزوج من أختها أم كلثوم. استُشهد ولداه محمد وعون مع الحسين× في كربلاء. دعا له النبيّ’ بقوله: اللهم بارك له في صفقة يمينه. فكان يقال: ما اشترى شيئاً قط إلّا ربح فيه. اختُلف في سنة وفاته، والمشهور أنّه تُوفّي سنة (80هـ)، بالمدينة. اُنظر: الثقفي، إبراهيم بن محمد، الغارات: ج2، ص694. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج3، ص881. الكتبي، محمد شاكر، فوات الوفيات: ج1، ص530. التفرشي، مصطفى بن الحسين، نقد الرجال: ج2، ص92. المدني، علي، الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: ص168. النمازي، علي، مستدركات علم رجال الحديث: ج4، ص500. الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج11، ص146ـ147.
[776] وفي الفتوح: (فكتب إليه الحسين بن عليّ: أمّا بعدُ، فإنّ كتابك ورد عليّ فقرأتُه، وفهمتُ ما ذكرتُ، وأُعلمك أنّي رأيتُ جدّي رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) في منامي، فخبّرني بأمرٍ وأنا ماضٍ له؛ ليَ كان أو عليَّ. والله يا بن عمّي، لو كنتُ في جحر هامّةٍ من هوامّ الأرض، لاستخرجوني يقتلوني. والله يا بن عمّي، لَيعدينّ عليَّ كما عَدت اليهود على السّبت، والسّلام). ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص67.
[777] هكذا في الأصل، والصحيح (وأخوه).
[778] هكذا في الأصل، والصحيح (أولاد عبد الله بن جعفر).
[779] هكذا في الأصل، والصحيح (إذا المرء).
[780] هكذا في الأصل، والصحيح (لم يحم).
[781] هكذا في الأصل، والصحيح (اللئيم).
[782] هكذا في الأصل، وورد أيضاً (غداً) ولعله الصحيح. اُنظر: القرشي، باقر شريف، حياة الإمام الحسين×: ج2، ص306.
[783] هكذا في الأصل، وورد أيضاً (نخوض بحار الموت..).
[784] هكذا في الأصل، وورد أيضاً (إذا ما رآه ضيغم فر مهرباً). واُنظر أيضاً: الميلاني، محمد هادي، قادتنا كيف نعرفهم: ج3، ص591 نقلاً عن أبي مخنف. القرشي، باقر شريف، حياة الإمام الحسين×: ج2، ص306. لجنة الحديث في معهد باقر العلوم×، موسوعة كلمات الإمام الحسين×: ص364.
[785] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (فنزل ذات عرق).
[786] الحصين بن نمير بن نائل ـ ويقال: فاتك ـ بن لبيد بن جعفر بن الحارث بن سلمة بن شكامة. الكندي السكوني، وقيل: التميمي. شامي من أهل حمص. خرج مع معاوية في صفين. وولي الصائفة ليزيد بن معاوية، وكان أميراً على جند حمص. كان على شرطة ابن زياد في الكوفة، فسلّطه على سككها ودورها، فدخل الدور يبحث عن مسلم بن عقيل×. أخذ رسول الإمام الحسين× إلى أهل الكوفة قيس بن مسهّر، في منطقة القادسية، وسلّمه لابن زياد. وجّه الحر الرياحي في ألف فارس لاعتراض الإمام الحسين×. من قادة جيش ابن سعد في كربلاء. قتل حبيب بن مظاهر&، وعلّق رأسه في عنق فرسه. أمر أفراده برشق أصحاب الإمام الحسين× بالسهام. رمى الإمام الحسين× بسهم، في فمه، فحال بينه وبين شرب الماء . كان على مقدمة تميم في حمل سبعة عشر من رؤوس أصحاب الإمام الحسين×؛ وهذا يقوّي القول بأنّه من تميم، كما صرّح بذلك المفيد في الإرشاد. قاد الجيش الذي وجّهه يزيد إلى المدينة في وقعة الحرّة، بعد هلاك مسلم بن عقبة، وقاتل ابن الزبير بمكة، ورمى الكعبة بالمنجنيق. خرج مع ابن زياد في معركة الخازر فقتله شريك بن خزيم التغلبي من أصحاب إبراهيم بن الأشتر، ثم أحرقوه مع ابن زياد، وبعثوا برأسيهما للمختار سنة 66هـ، أو سنة 67هـ. اُنظر: الدينوري، أحمد بن داوُد، الأخبار الطوال: ص254، وص258ـ259. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص297. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص57، وص69، وص104. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص382ـ389. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص252. الصفدي، خليل بن أيبك، الوافي بالوفيات: ج13، ص57ـ58. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج2، ص172. الكوراني، علي، سلسلة القبائل العربية في العراق (قبيلة تغلب): ج8، ص46.
نقول: لم نجد ما يُفرِّقه عن حصين بن تميم لعنه الله، بل كلّ ما نُسِب إليه في بعض
الكتب أو المصادر قد نُسِب إلى ابن تميم في مصادر أخرى، فيمكن اتحادهما. اُنظر:
ابن سعد، محمد، ترجمة الإمام الحسين× من الطبقات الكبرى: ص68. البلاذري، أحمد بن
يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص167، 178، 194، 201. وج12، ص142. الطبري، محمد بن جرير،
تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص330ـ335. ابن مسكويه الرازي، أحمد بن محمد، تجارب
الأُمم: ج2، ص60. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص32. ابن
نما الحلي، جعفر ابن محمد، مثير الأحزان: ص30. المشغري، يوسف بن حاتم، الدر
النظيم: ص550ـ554. النويري، أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20،
ص399. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص55.
[787] القادسية: منطقة كبيرة في العراق قرب الكوفة تقع إلى الجنوب منها من جهة البر، عندها كانت الوقعة العظمى بين المسلمين والفرس، قُتِل فيها أهل فارس، وفُتِحت بلادهم على يد المسلمين، وهي منطقة عامرة بالمياه والمزارع بينها وبين حدود الكوفة حوالي(30 كم). وهي اليوم ناحية تابعة لمحافظة النجف. اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج4، ص291. البغدادي، عبد المؤمن بن عبد الحق، مراصد الاطّلاع: ص1054. الراشد، سعد عبد العزيز، درب زبيدة: ص125.
[788] القطقطانية: وهي القُطْقُطانة: القطقط لغةً أصغر المطر وتسمى اليوم (الحياضية) وهي إحدى عيون الطف قريبة من الكوفة من جهة البرية. كانت محطة للرصد في معركة ذي قار سنة (2هـ) تبعد القطقطانة عن موقع (عرب الرهيمة) الحالي 18كم إلى الشمال الغربي. اُنظر: الحمويّ، ياقوت بن عبدالله، معجم البلدان: ج4، ص374. الربيعي، عباس، أطلس الحسين: ص274.
[789] هكذا في الأصل، وفي غيره (الحاجر أو الحاجز)، وسيأتي مثله. اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص70. الفتال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص177.
والحاجر: وادي معروف يسمى اليوم (البعائث) يقع على طريق مكة. كان محطة استراحة لأهل البصرة إذا أرادوا السفر إلى المدينة، تجتمع فيه أهل الكوفة والبصرة يقع جنوب غرب بلدة سميراء على مسافة (60كم). يقال إنّ الإمام الحسين× وصل الحاجر يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة لسنة (60هـ). اُنظر: الربيعي، عباس، أطلس الحسين: ص174 وما بعدها.
[790] هكذا في الأصل، ولعله (بطن الرُّمّة) : وهي منزل لأهل البصرة إذا أرادوا المدينة بها يجتمع أهل الكوفة والبصرة ومنه إلى العُسَيلة. اُنظر: الحمويّ، ياقوت بن عبدالله، معجم البلدان: ج3، ص72.
[791] هكذا في الأصل، والمعروف (مسهّر). وهو قيس بن مسهّر بن خالد بن جُندب الصيداوي الأسدي. رجل شريف شجاع مخلص في محبّة أهل البيت^، من أصحاب الإمام الحسين×، كان له دورٌ كبير في نهضة الكوفة، وحمل الكتب والرسائل ما بين أهل الكوفة والإمام×، ثم حمل هو وعابس الشاكري رضوان الله عليهما رسالة مسلم× للإمام الحسين× التي ذكر فيها مسلم أنّ الرائد لا يكذب أهله، وأنّه بايعه ثمانية عشر ألف. وبقي مع الإمام×، وصحبه من مكة، فلمّا قرب من الكوفة أرسله الإمام إلى شيعته في الكوفة، فأسره الحصين بن نمير أو ابن تميم في القادسية وأرسله إلى ابن زياد، وبعد كلام دار بينهما ينمّ عن شجاعته واستبساله في الحق؛ أمر عبيد الله بقتله فأُلقي من فوق القصـر فمات. ولمّا وصل خبره للإمام الحسين× استرجع واستعبر باكياً، وقال: جعل الله له الجنّة ثواباً وردّ السلام عليه في الزيارة الرجبية وزيارة الشهداء الواردة عن الناحية المقدسة. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص167. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص297. المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص493. ابن نما الحلي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص21، وص30. السماوي، محمد بن طاهر، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص112. المحلّاتي، ذبيح الله، فرسان الهيجاء في تراجم أصحاب سيّد الشهداء: ج2، ص68. شمس الدين، محمد مهدي، أنصار الحسين×: ص123.
[792] هكذا في الأصل، والصحيح (كتاباً).
[793] هكذا في الأصل، والصحيح (يثيبكم)
[794] هكذا في الأصل، والصحيح (طالباً).
[795] هكذا في الأصل، والصحيح (ويلك).
[796] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (المنبر).
[797] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (الحاجز).
[798] هكذا في الأصل، والصحيح (زياد) وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (سبّ يزيد لعنه الله وابن زياد لعنه الله).
[799] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (وعلى أبيه وجدّه).
[800] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص64ـ65. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص71. الفتال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص178، ابن نما الحلي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص31. ابن الأثير، علي ابن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص41، ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص182. الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص437.
[801] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (حرملة).
[802] الوارد في المصادر أنّ عدي بن حرملة روى هذه الحادثة عن عبد الله بن سليم والمذري بن المشمعل الأسديين. وأمّا عبد ربه، فلم يذكر المؤرخون في أصحاب الإمام الحسين× من هو بهذا الاسم. نعم ذكروا عبد الرحمن بن عبد ربّه من شهداء الطف، ولم يذكروه في هذه الحادثة. اُنظر: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري): ص75. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص299. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص73. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص182. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، 372.
[803] في مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) 75: (بُكير بن المثعبة). وفي الإرشاد والبحار: (بكر بن فلان). لم نعثر على ترجمة له. اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص74. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص373.
[804] هكذا في الأصل، والصحيح (ما)، وفي رواية الطبري: (لم أخرج من الكوفة..). اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص299.
[805] هكذا في الأصل، والصحيح (ساءلناه).
[806] هكذا في الأصل، والصحيح (مسألته).
[807] هكذا في الأصل، والصحيح (كفيناك).
[808] البقرة: آية 156.
[809] هكذا في الأصل، والصحيح (يكون).
[810] هكذا في الأصل، والصحيح (أبونا). وفي مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص78: (إنّ بني عقيل قالوا: لا والله، لا نبرح حتى ندرك ثأرنا أو نذوق ما ذاق أخونا).
[811] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص66. البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ح3، ص168. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص73ـ75. الفتال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص178. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص182.
[812] زبالة: منطقة أثرية قديمة فيها قصر أثري تقع في شمال السعودية. سُمِّيت بذلك نسبة إلى (زبالة بنت مسعود). واليوم تقع على مسافة (20كم) جنوب محافظة رفحاء، وعن الكوفة (305كم). وهي منزلٌ معروفٌ على طريق الحج من الكوفة إلى مكّة المكرمة. يقال: إنّ الإمام الحسين× وصلها يوم الأثنين 27/ذي الحجة/60هـ. اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله، معجم البدان: ج3، ص129. الربيعي، عباس، أطلس الحسين: ص211 وما بعدها.
[813] في مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص78 عن الأسديين: (قالا: فعلمنا أنّه قد عزم له رأيه على المسير، قالا: فقلنا: خار الله لك، قالا: فقال: رحمكما الله قالا: فقال له بعض أصحابه: إنّك ـ والله ـ ما أنت مثل مسلم بن عقيل، ولو قدمتَ الكوفة لكان الناس إليك أسرع. قال الأسديان: ثم انتظر حتى إذا كان السحر قال لفتيانه وغلمانه: أكثروا من الماء فاستقوا وأكثروا ثم ارتحلوا، وساروا حتى انتهوا إلى زبالة). ثم يروي: (عن بكر بن مصعب المزني قال: كان الحسين لا يمر بأهل ماء إلّا اتبعوه حتى انتهى إلى زبالة)، ثم يورد قصة عبد الله بن بقطر&.
[814] هكذا في الأصل، والصحيح (فظيع).
[815] عبارة (خذلتنا شيعتنا) لم ترد في بعض المصادر، وفي بعض المصادر ورد ذكرها من دون نسبة الخذلان إلى الشيعة، فقد ورد فيها (وما أرى القوم إلا سيخذلوننا). ولعلّ نسبتها إلى الشيعة من إضافة بعض الأقلام التي ما فتئت تدسّ في كلام أهل البيت^، الذم لشيعتهم وتصويرهم أهل غدر وخيانة على طول التاريخ. اُنظر: ابن سعد، محمد، ترجمة الإمام الحسين: ص67. الدينوري، أحمد بن داوود، الأخبار الطوال: ص247. الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص300. الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: ج5، ص11.
[816] الهَواجِر: جمع هاجِرة، وهو نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر، وقيل في كلّ ذلك: إنّه شدة الحر. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج5، ص254، (هجر).
[817] الصوارِمُ: جمع صارِم، وهو السَّيفُ القَاطِع. اُنظر: الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: ج17ص408، (صرم).
[818] قال السيد ابن طاووس في اللهوف في هذا الموضع: (فتفرّق عنه أهل الأطماع والارتياب، وبقي معه أهله وخيار الأصحاب). ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص45. واُنظر أيضاً: الحسيني، محمد بن أمير، شرح شافية أبي فراس: ص350.
[819] هكذا في الأصل، والصحيح (نيف وسبعين).
[820] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (الناس).
[821] هكذا في الأصل، والصحيح (استقامت).
[822] في مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص79 (بطن العقبة)، ولعلّه الصحيح؛ لأنّه ذكر سابقاً أنّ الإمام كان في زبالة، ثم سار عنها، ولا يصح أنّ يصل بعد زبالة إلى الثعلبية، لأنّها سابقة عليها للذاهب باتجاه الكوفة. أمّا بطن الرمة فهي بعد زبالة باتجاه الكوفة.
[823] الثعلبية: وتسمى أحياناً الثعلبة نسبةً إلى ثعلبة بن دودان بن أسد كما عن البكري، وقيل غير ذلك. وهي أول محطة في طريق الحج بين الكوفة ومكة في حدود منطقة الحائل للقادم من العراق، تُعرَف اليوم باسم (البدع أو بدع الخضراء) يقول عنها الحموي: «من منازل طريق مكة من الكوفة، بعد الشقوق وقبل الخزيمية». وهي منطقة كبيرة ذات شأن في العصور الإسلامية المبكرة، أرضها منخفضة تصل إليها مياه الأمطار من الوديان والمنحدرات، تبعد عن زرود (60كم)، يقال: إنّ الإمام الحسين× وصل الثعلبية يوم الجمعة المصادف 24/ذي الحجة/60هـ. اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج2، ص78. الربيعي، عباس، أطلس الحسين: ص211 وما بعدها. وقد رُوِي أنّه في هذا الموضع اعترض الحر بن يزيد ركب الإمام الحسين×، وكان مع الحر أربعة آلاف فارس قادماً من منطقة القادسية. اُنظر: الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص438.
[824] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص67. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص123. المجلس الرابع.
[825] هكذا في الأصل، والصحيح (فيد)، وكذا في المورد التالي. وهي بُليدة في نصف طريق مكة من الكوفة. في وسطها حصن عليه باب حديد، وعليها سور دائر، وهى بقرب أجأ ـ أحد جبلى طيىء ـ كان الناس يودّعون فيها فواضل أزوادهم إلى حين رجوعهم وما يثقل من أمتعتهم، وكانوا يجمعون العلف طول سنتهم ليبيعوه على الحاج إذا وصلوا إليهم. اُنظر: البغدادي، عبد المؤمن، مراصد الاطّلاع: ج3، ص1049.
[826] هكذا في الأصل، والصحيح (رواية).
[827] لم نجد مَن ذكر أنّ أصحاب الإمام الحسين× كان عددهم خمسين ألفاً أو ثمانية وسبعين أو ما يقرب من ذلك. نعم ذكر المنقري في مقتل الحسين بن علي المنسوب إليه، أنّه كان مع الإمام الحسين× خمسة وعشرون ألف فارس من جياد العرب وصناديدها وفرسانها، وذكر المسعودي أنّهم كانوا خمسمائة فارس، ومائة راجل، وفي تاريخ الطبري أنّهم كانوا خمسة وأربعين فارساً، ومائة راجل، ولم يذكر كثير من المؤرخين ـ أمثال الدينوري ـ عدد مَن كان معه× قبل وصوله كربلاء، وإنّما أشار إلى انسحاب البعض حين سمع بتغيّر الأوضاع. اُنظر: المنقري، نصر ابن مزاحم، مقتل الحسين بن علي (نسخة خطية) : ص45. الدينوري، أحمد بن داوود، الأخبار الطوال: ص243. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص292. المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب ومعدن الجوهر: ج3، ص61.
[828] علي بن الفارضية: لم نعثر له على ترجمة.
[829] هكذا في الأصل، والصحيح (مقطوعين).
[830] الكراع: اسم يجمع الخيل نفسها. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج3، ص1276، (كرع).
[831] هكذا في الأصل، والصحيح (الفارضية) كما تقدّم من المصنف.
[832] هكذا في الأصل، وفي العبارة سقط، وهي كلمة (فقال).
[833] تصدّع القوم: تفرّقوا. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج3، ص1242، (صدع).
[834] اُنظر أيضاً: الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص438.
[835] هكذا في الأصل، والصحيح (اثنان وسبعون).
[836] اُنظر أيضاً: الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص132، المجلس الرابع.
[837] هكذا في الأصل، والصحيح (فارساً).
[838] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص292.
[839] هكذا في الأصل، والصحيح (عاتٍ).
[840] عرِّجوا: أي مِيلوا وانحرِفوا عن المسير. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج1، ص328، (عرج).
[841] يزيد بن الحصين: لم نجده عند غير المؤلف. وفي تاريخ الطبري أنّ الذي جاء مع الحر بن يزيد لمنع الإمام الحسين× من المسير نحو الكوفة هو علي بن الطعان المحاربي. وقد التقوا بالإمام× عند جبل ذي حسم. وفي رواية أخرى أنّه الحصين بن تميم. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص169ـ170. مقتل أبي مخنف برواية الطبري: ص81.
[842] هكذا في الأصل، والصحيح (بن) وهو الحر بن يزيد بن ناجية بن سعيد الرياحي، أحد وجهاء قبيلة بني تميم، كان شريفاً في قومه، ورئيساً في الكوفة، ندبه ابن زياد لمعارضة الإمام الحسين×، فخرج في ألف فارس، وبعد أن علم أنّهم مصـرّون على قتل الإمام× تحوّل إلى عسكره، ولمّا استُشهد أتاه الإمام الحسين×، ودمه يشخب، فقال: بخ بخ يا حُر، أنت حُرّ كما سُمِّيت في الدنيا والآخرة. ثمّ أنشأ×:
|
لنعم الحرّ حرّ
بنى رياح |
ورد اسمه والسلام عليه في الزيارة الشـريفة. له مزار كبير منفرد يبعد عن مرقد الإمام الحسين× 5 كم تقريباً. اُنظر: المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص493. السماوي، محمد، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص203.
[843] هكذا في الأصل، والصحيح (فسقى).
[844] نقول: إنّ الفقرات التي ذكرها الامام× في خطبته مرويّة عن الإمام زين العابدين× لمّا خطب في الشام في مجلس يزيد ومعه الأسرى من أهل بيته. اُنظر: الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص76ـ78.
وفي مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص83: (قال: فلم يزل موافقاً حسيناً حتى حضرت الصلاة، صلاة الظهر، فأمر الحسين الحجاج بن مسروق الجعفي أن يؤذّن فأذّن، فلمّا حضرت الإقامة خرج الحسين في إزار ورداء ونعلين، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيّها الناس، إنّها معذرة إلى الله} وإليكم، إنّي لم آتكم حتى أتتني كتبكم، وقدِمت علىَّ رسلكم أن أقدم علينا؛ فإنّه ليس لنا إمام لعل الله يجمعنا بك على الهدى. فإن كنتم على ذلك فقد جئتُكم، فإن تعطوني ما أطمئنّ إليه من عهودكم ومواثيقكم أقدم مصركم، وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين انصرفتُ عنكم إلى المكان الذي أقبلتُ منه إليكم. قال: فسكتوا عنه، وقالوا للمؤذن: أقم، فأقام الصلاة، فقال الحسين× للحر أتريد أن تصلى بأصحابك؟ قال: لا، بلى تصلى أنت ونصلي بصلاتك، قال: فصلى بهم الحسين). ثم يكمل الرواية، ويقول: (فلمّا كان وقت العصر أمر الحسين أن يتهيئوا للرحيل، ثم إنّه خرج فأمر مناديه فنادى بالعصر، وأقام فاستقدم الحسين، فصلى بالقوم، ثم سلّم، وانصرف إلى القوم بوجهه، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أمّا بعد، أيّها الناس فإنّكم إن تتقوا وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله. ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدّعين ما ليس لهم، والسائرين فيكم بالجور والعدوان. وإن أنتم كرهتمونا، وجعلتم حقّنا، وكان رأيكم غير ما أتتني كتبكم، وقدِمت به علىَّ رسلكم انصرفتُ عنكم. فقال له الحر بن يزيد: إنّا ـ والله ـ ما ندري ما هذه الكتب التي تذكر. فقال الحسين: يا عقبة بن سمعان، أخرج الخرجين الذين فيهما كتبهم إلىَّ، فأخرج خرجين مملؤين صحفاً، فنشرها بين أيديهم. فقال الحر: فإنّا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك، وقد أُمِرنا إذا نحن لقيناك ألّا نفارقك حتى نُقدِمك على عبيد الله بن زياد. فقال له الحسين: الموت أدنى إليك من ذلك).
[845] هكذا في الأصل، والصحيح (أُعرّفه).
[846] هكذا في الأصل، والصحيح (أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن خديجة الكبرى).
[847] زَمزَم: البئر المباركة المشهورة بالمسجد الحرام بمكة، وقد كانت في زمن إسماعيل× وطوتها السيول وتطاول عليها الأيام، فلم يبق لها أثر، فرأى عبد المطلب× من يأمره في المنام بحفرها، ودُلّ على موضعها؛ فاستخرجها وبقيت لسقاية الحاج، واختص بها العباس بن عبد المطلب. وهي إلى اليوم موجودة عامرة يستقى منها الحجاج والمعتمرين. اُنظر: البغدادي، عبد المؤمن بن عبد الحق، مراصد الاطّلاع: ج2، ص669ـ670.
والصَّفا: مكان مرتفع من جبل أبي قبيس بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي، إذا وقف الواقف عليه. كان حذاء الحَجَر الأسوَد، ومنه يبتدئ السَّعيُ الواجب في الحج والعمرة حيث يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة بسبعة أشواط. ويقع المسعى في الجزء الشرقي من المسجد الحرام، ويبلغ طوله 375 متراً ويبلغ عرضه 40 متر. اُنظر: البغدادي، عبد المؤمن بن عبد الحق، مراصد الاطّلاع: ص843. الموسوعة الحرة ويكيبيديا.
[848] هكذا في الأصل، والصحيح (أنا).
[849] هكذا في الأصل، ولعل الصحيح (قبيس وحراء). وقبيس هو جبل أبي قبيس المشرف على مكة من غربيها، وجهه إلى قعيقعان ومكة بينهما. وكان يسمى في الجاهلية الأمين؛ لأنّه استُودِع فيه الحجر أيام الطوفان. و(جبل حِرَاء) بالكسر والتخفيف والمد: جبل من جبال مكة، على ثلاثة أميال، وفيه غار حِراء الذي كان يتعبد به النبيّ’، وبعد نزول الوحي سُمِّي بجبل النور. اُنظر: الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط: ج2، ص149. البغدادي، عبد المؤمن بن عبد الحق، مراصد الاطّلاع: ج1، ص20، وص388. ويكيبيديا.
[850] المعروف أنّ هذه العبارة للفرزدق، قالها للإمام الحسين× حين لقيه خارجاً من مكة. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص165. ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج7، ص249. المشغري، يوسف بن حاتم، الدر النظيم: ص514.
[851] هكذا في الأصل، والصحيح (عدو).
[852] هكذا في الأصل، والصحيح (أين).
[853] الاشعث بن واثلة الكندي. لم نعثر عليه من غيره.
[854] هكذا في الأصل، والصحيح (الطرماح بن عدي)، وهو الطّرمّاح بن عدي بن عبد الله بن خيبري الطائي، الشاعر. من أصحاب الإمام أمير المؤمنين علي×، ورسوله إلى معاوية، له حوار معه ينم عن شجاعته وتقواه. ومن أصحاب الإمام الحسين×، خرج من الكوفة ومعه نفرٌ لنصرة الإمام الحسين×، وكان دليلهم، فلقيَ الإمام الحسين× وأصحابه في عذيب الهجانات. قِيل: أنّه استأذن الإمام لإيصال نفقة عياله وطعامهم، ثمّ يعود إليه، وعند عودته بلغه خبر شهادته× في الطريق. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص305ـ307. الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج10، ص175.
[855] هكذا في الأصل، والصحيح (محبوك).
[856] هكذا في الأصل، والصحيح (فخلّى).
[857] ورد في بعض المصادر أنّ الحر بن يزيد قال: إنّ هؤلاء النفر من أهل الكوفة ليسوا ممّن أقبل معك، وأنا حابسهم أو رادّهم. فقال له الحسين: لأمنعنّهم ممّا أمنع منه نفسي، إنّما هؤلاء أنصاري وأعواني، وقد كنتَ أعطيتَني ألّا تعرّض لي بشيء حتى يأتيَك كتاب من ابن زياد. فقال: أجل، لكن لم يأتوا معك. قال: هم أصحابي وهم بمنزلة من جاء معي، فإن تمّمتَ على ما كان بيني وبينك، وإلّا ناجزتُك. قال: فكف عنهم الحر. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص172. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص187ـ188. النويري، أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص420ـ421.
[858] قصر مقاتل: من القصور التاريخية، منسوب إلى مقاتل بن حسان بن ثعلبة. يسميه البعض قصر مقاتل والبعض الآخر يسمونه قصر بني مقاتل؛ ولعله سمي بذلك نسبة إلى أولاد مقاتل وأحفاده. يقع بين عين التمر والشام. وقِيل: يقع بين القريات والقطقطانة كما ذكره الحموي. واليوم عين التمر قضاء تابع لمحافظة كربلاء يبعد عن مركز المحافظة (63كم). ويقع القصر حالياً شرقي الأخيضر، وهنا يطرح سؤال هل قصر الأخيضر هو قصر بني مقاتل أو غيره؟ البعض يقول هو نفسه والبعض الآخر نفاه، والمسألة غير محسومة تحتاج إلى مزيد تحقيق وأثبات. اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج4، ص364. الربيعي، عباس، أطلس الحسين: ص277، وما بعدها.
[859] المضرب: الفسطاط العظيم. الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط: ج1، ص95، (ضرب).
[860] هكذا في الأصل، والصحيح (لرجل).
[861] عبد الله أو عبيد الله بن الحر بن عمرو الجعفي. كوفي، من بني سعد العشيرة، كان عثمانياً، فلمّا قُتل عثمان انحاز إلى معاوية، وشهِد معه صفّين، هو ومالك بن مسمع. وكان له زوجة بالكوفة، فلمّا طالت غيبته زوجها أخوها رجلاً، يُقال له: عكرمة، وبلغ ذلك عبيد الله، فأقبل من الشام فخاصم عكرمة إلى الإمام علي×، فقال له: ظاهرتَ علينا عدوَّنا فغلتَ! فقال له: أيمنعني ذلك من عدلك؟! قال: لا، وبعد استشهاد الإمام علي× عاد إلى الكوفة. غزا أطراف الكوفة زمن ابن الزبير. مات غرقاً سنة (68هـ). اُنظر: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص287. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج4، ص192.
[862] هكذا في الأصل، ولعل الصحيح (الحجّاج بن مسروق الجعفيّ) كما في الفتوح. نُعِت بالجعفي نسبةً إلى جعفي بن سعد العشيرة من مذحج، خرج من الكوفة إلى مكة، فلحِق بالإمام الحسين× فيها، وصحبه منها إلى كربلاء، أمره الإمام الحسين× بأن يؤذّن لصلاة الظهر عند اللقاء مع الحر بن يزيد؛ فوُصِف في بعض المصادر بأنّه: (مؤذِّن الحسين). استُشهد مع الإمام الحسين×، ووقع التسليم عليه في زيارتي الناحية المقدسة والرجبية. اُنظر: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص73. ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج3، ص79. الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج5، ص214. شمس الدين، محمد مهدي، أنصار الحسين×: ص83.
[863] هكذا في الأصل، والصحيح (تلقاه).
[864] هكذا في الأصل، والصحيح (لقائه).
[865] هكذا في الأصل، والصحيح (حاربتُك).
[866] هنا فوق كلمة (خصمي) توجد كلمة غير واضحة الرسم.
[867] هكذا في الأصل، والصحيح (أخس).
[868] هكذا في الأصل، والصحيح (وأمضي إلى).
[869] فرس لاحقُ: إذا ضمرت بطنه. اُنظر: الزمخشري، محمود بن عمر، أساس البلاغة: ص849. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج10 ص328، (لحق).
[870] هكذا في الأصل، والصحيح (استعن).
[871] هكذا في الأصل، والصحيح (المحذور).
[872] النَّوَالُ: النَّصِيب والعطاءُ. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص964، (نال).
[873] هكذا في الأصل، والصحيح (راغبون).
[874] العقبى: الآخرة أو المرجع إلى الله. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص613، (عقب).
[875] هكذا في الأصل، والصحيح (زاهدون).
[876] هكذا في الأصل، والصحيح (على ناقة)
[877] التوبة: آية 51. وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وأسرار الشهادات ـ واللفظ للأول ـ قوله تعالى: (ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) الكهف: (51). ولقد سمعت جدّي رسول الله’، يقول: من سمع واعيتنا أهل البيت أكبّه الله على منخريه في النار يوم القيامة.
[878] هكذا في الأصل، والصحيح (وخاب الآخرون أولو النفاق).
[879] هكذا في الأصل، والصحيح (التراقي). والتراقي جمع ترقوة وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج1، ص187، (ترق).
[880] هكذا في الأصل، والصحيح (يدعو).
[881] هكذا في الأصل، والصحيح (التلاقي). ويوم التلاقي: يوم القيامة لتلاقي الخلق فيه. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص836، (لقيه).
[882] هكذا في الأصل، وكأنّ مراده: رجعت عن نصرة ابن فاطمة، ولم أنصره.
[883] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص73ـ74. باختلاف في بعض الأبيات. ابن سعد، محمد، ترجمة الإمام الحسين× (من طبقاته) : ص94. الدينوري، أحمد بن داوود، الأخبار الطوال: ص262. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص73ـ75. البغدادي، عبد القادر بن عمر، خزانة الأدب: ج2، ص137ـ140. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص140، المجلس الرابع.
[884] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (سبعة).
[885] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (تنبعث). واُنظر أيضاً: الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص439. الحسيني، محمد بن أمير، شرح شافية أبي فراس: ص351.
لا ينحث: لا يجري، ولا يتحرك. اُنظر: الجوهري، حماد بن إسماعيل، الصحاح: ج1، ص278. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص155، (حثه).
[886] الصعيد: التراب. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج2، ص498، (صعد).
[887] هكذا في الأصل، والصحيح (نينوى) وهي منطقة قديمة تابعة إلى أرض بابل، منها كربلاء. ويعتقد البعض أنّها من أمهات المدن الواقعة على ضفاف نهر الفرات، وقد كثُرت حولها المقابر، فيها عيون كثيرة. كانت عامرة وقت نزول الإمام الحسين× بكربلاء. قال عنها الحموي: (ناحية بسواد الكوفة، منها كربلاء التي قُتل بها الحسين)، قيل: إنّها قرية من القرى المجاورة للحائر الحسيني، وقيل: إنّها تقع شرقي كربلاء، وهي اليوم عبارة عن سلسلة تلال أثرية ممتدة من جنوب سدة الهندية إلى مصب نهر العلقمي في الأهوار. وتعرف بتلول نينوى المعروفة (العسافيات)، ويقال: إنّها فيما بعد أصبحت مركزاً لتجمع الزوار، وكانت المسافة بينها وبين مصرع الإمام الحسين× (1600م). اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله، معجم البلدان: ج5، ص339. الربيعي، عباس، أطلس الحسين: ص295 وما بعدها.
[888] هكذا في الأصل، والصحيح (هل لها اسم غيره؟).
[889] الغاضرية: منسوبة إلى امرأة تسمّى غاضرة من بني أسد، وهي أرض يسكنها بنو أسد. قال الحموي: (هي قرية من نواحي الكوفة قريبة من كربلاء). نزلها الإمام الحسين× في الثاني من شهر محرم لسنة (61هـ). واليوم آثار الغاضرية قاربت على الاندثار بسبب التوسعة والعمران. وموقعها في الشمال الشرقي من مقام جعفر الصادق×، يقول بعض المحققين: إنّها تمتد من سور كربلاء من الباب المعروف بباب الحسينية إلى قرب مرقد عون أو ما يسمّى خان العطيشي. وجزم عباس الربيعي بأنّها (الحنقنة) فما دونها إلى بلدة كربلاء. اُنظر: الحموي، ياقوت، معجم البدان: ج4، ص183. الربيعي، عباس، أطلس الحسين: ص298، وما بعدها.
[890] هكذا في الأصل، والصحيح (الفرات).
[891] نهر العلقمي: وقع الخلاف في سبب تسميته وتحديده، فذكر المسعودي أنّ الفرات إذا تجاوز هيت والأنبار انقسم قسمين، قسم يأخذ نحو المغرب قليلاً المسمّى (بالعلقمي) إلى أن يصير إلى الكوفة. وآثاره باقية فإنّه ينتهي إلى شمال ضريح عون ثم إلى الجنوب. تقع الغاضرية على ضفته الشرقية، وشريعة الإمام جعفر على الشاطئ الغربي من العلقمي، بينهما قنطرة تسمى قنطرة الغاضرية. ولتفاصيل الكلام عنه راجع كتاب بغية النبلاء في تاريخ كربلاء، عبد الحسين الكليدار آل طعمة: ص82ـ84.
[892] هكذا في الأصل، والصحيح (لهذه).
[893] تغرغرت عيناه: تردد فيهما الدمع. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص650، (غرر).
[894] يقال تنفس الصعداء: أي تنفس نفساً ممدوداً أو مع توجع. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص514، (صعد).
[895] هكذا في الأصل، والصحيح (أُفٍ).
[896] اُنظر ايضاً: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص84. الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص439.
نقول: الوارد في أكثر المصادر أنّ الإمام× قال هذه الأبيات ليلة العاشر من المحرم. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص185. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص319. أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص75. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص93. الفتال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص184.
[897] هكذا في الأصل، والصحيح (هرثمة) وهو ابن أبي مسلم أو ابن سلمى. وفي بعض المصادر (أبو هرثم) وفي بعضها (ابن هرثم الضبي). لم نعثر على ترجمة له. اُنظر: ابن سعد، محمد، ترجمة الإمام الحسين× (من طبقاته): ص49. الكوفي، محمد بن سليمان، مناقب الإمام أمير المؤمنين×: ج2، ص26. الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص199. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص198. ابن حجر، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج2، ص301. وفيها جميعاً أنّ الذي كان مع أمير المؤمنين× في صفين هو أبو هرثمة أو هرثم، وأنه زوج جرداء.
[898] لم نعثر عليه.
[899] حردا أو حرداء ـ ويقال لها: خرداء أو جرداء ـ بنت سمين. شديدة الولاء والحب لأمير المؤمنين×. اُنظر: الكوفي، محمد بن سليمان، مناقب الإمام أمير المؤمنين×: ج2، ص26. القاضي المغربي، النعمان بن محمد، شرح الأخبار: ج3، ص540. المزي، يوسف، تهذيب الكمال: ج6، ص410.
[900] صِفِّين: موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات، شرق سورية، على حدودها مع العراق. فيها وقعة صفّين بين الإمام علي×، ومعاوية في سنة (37هـ). اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج2، ص409. الموسوعة الحرة ويكيبيديا.
وحرب صفِّين: وهي من الحروب العظيمة التي وقعت في الإسلام بين أمير المؤمنين علي× وبين معاوية (لعنه الله). وعن المسعودي أنّه اختُلِف في مقدار ما كان مع علي من الجيش وما كان مع معاوية، فمكثر ومقل، والمتّفق عليه من قول الجميع أنّه كان مع علي تسعون ألفاً، ومع معاوية خمسة وثمانون ألفاً. قُتِل فيها من الفريقين مائة وعشرة آلاف على الأكثر، وسبعون ألفاً على الأقل. ابتدأت من ذي الحجة سنة (36هـ)، وانتهت في 13صفر سنة (37هـ). وقيل: إنّ مقامهم بصفِّين كان مائة وعشرة أيام، كان فيها نحو تسعين أو سبعين وقعة. اُنظر: المسعودي، علي بن الحسين، التنبيه والإشراف: ص256. الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج1، ص465.
[901] هكذا في الأصل، والصحيح (صلّى)، وكذا في بقية الموارد.
[902] أغْلِمَة: جمع غُلاَم. اُنظر: ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج3، ص382، (غلم).
[903] غِلْمة: جمع غُلاَم. اُنظر: المصدر السابق.
[904] هكذا في الأصل، والصحيح (سمعتُه).
[905] هكذا في الأصل، ولعلّ الصحيح (انجُ؛ لئلا ترى).
[906] هكذا في الأصل، والصحيح (يرى).
[907] هكذا في الأصل، والصحيح (أحد).
[908] الثانية زائدة.
[909] اُنظر أيضاً: القاضي المغربي، النعمان بن محمد، شرح الأخبار: ج3، ص141ـ142. الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص199ـ200. ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج3، ص169ـ170.
[910] هكذا في الأصل، وهي زائدة.
[911] هكذا في الأصل، والصحيح (أحد سواداً).
[912] أخرج الشيخ الصدوق في كتاب الخصال وغيره مثل هذا المضمون من الروايات في حديث طويل عن أبي عبد الله× عن آبائه ^:... من شهدنا في حربنا، وسمع واعيتنا فلم ينصرنا أكبّه الله على منخريه في النار. وجاء أيضاً في حادثة ابن الحر الجعفي عن الإمام الحسين×... فإنّه مَن سمع واعيتنا أهل البيت ثمّ لم يجبنا كبّه الله على وجهه في نار جهنم. الصدوق، محمد بن علي، الخصال: ص625، ح10. اُنظر: الصدوق، محمد بن عليّ، الأمالي: ص219.
[913] هكذا في الأصل، والصحيح (يا حصين).
[914] هكذا في الأصل، والصحيح (أنزل).
[915] الغبراء: الأرض. ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج3، ص337، (غبر). ويقصد هنا بها الأرض القفراء التي لا شيء فيها.
[916] هكذا في الأصل، والصحيح (لا ماء ولا مرعى). والمَرْعَى: موضع الماشية من العُشب والكلأ. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج6، ص2349، (رعي).
[917] هكذا في الأصل، والصحيح (مضرباً).
[918] هكذا في الأصل، والصحيح (خندق).
[919] هكذا في الأصل، والصحيح (ويضرم).
[920] هكذا في الأصل، والصحيح (استدعى).
[921] دَواة: مِحْبَرة، وعاء الحبر. أحمد مختار، عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة: ج1، ص435، (حبر).
[922] هكذا في الأصل، والصحيح (وبياضاً). البَياض الورق. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص79، (بيض).
[923] هكذا في الأصل، والصحيح (اثنان وسبعون).
[924] هكذا في الأصل، والصحيح (لا ماء ولا مرعى).
[925] هكذا في الأصل، والصحيح (أحدٌ).
[926] هكذا في الأصل، والصحيح (دعا)، وكذا في المورد الآتي.
[927] لم نعرفه ولم نجد له ترجمة.
[928] القنطرة: وهي قنطرة الكوفة المعروفة، التي أحدث ابن هبيرة. وتُعرَف باسم (كنيدرة)، في الجانب الشرقي من جامع الكوفة. وأصلحها من بعده الأمير خالد القسري، وقيل: أُنشِئت قبل الإسلام. اُنظر: البراقي، حسين بن أحمد، تاريخ الكوفة: ص164.
[929] هكذا في الأصل، والصحيح (ودعا)، وسيأتي مثله كثير، نكتفي بالإشارة لها هنا اختصاراً.
[930] عمرو بن حريث، أبو سعيد المخزومي القرشي، وُلِد في عهد النبي’. نزل الكوفة وسكنها، كان عثمانياً ومن أعوان بني أمية. شهد على حجر بن عدي الكندي وأصحابه. خرج من الكوفة مع سبعة من أصحابه، فاصطادوا ضبّاً فقال عمرو: هذا أمير المؤمنين!! مدّوا أيديكم فبايعوه، فبايَعوا!! فأخبرهم أمير المؤمنين× بأنّهم سيُحشرون يوم القيامة وإمامهم ضبّ. مات بالكوفة سنة (85هـ). اُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين، الأغاني: ج17، ص97. المفيد، محمد بن محمد، الاختصاص: ص287. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، أُسد الغابة: ج4، ص97.
[931] هكذا في الأصل، والصحيح (أحدٌ).
[932] نسبة إلى أبي تراب: كنية أمير المؤمنين علي×، كنّاه بها رسول الله’، فقد روى عبد العزيز بن حازم، عن أبيه: «أنّ رجلاً جاء إلى سهل بن سعد، فقال: هذا فلان (لأمير المدينة) يدعو علياً عند المنبر. قال: فيقول: ماذا قال؟ يقول له: أبو تراب. فضحك، قال: والله، ما سمّاه إلّا النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، وما كان له اسم أحبّ إليه منه. فاستطعمتُ الحديث سهلاً، وقلتُ: يا أبا عبّاس كيف؟ قال: دخل عليّ على فاطمة ثمّ خرج، فاضطجع في المسجد، فقال النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : أين ابنُ عمّكِ؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه، فوجد رداءه قد سقط عن ظهره، وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره، فيقول: اجلس يا أبا تراب». اُنظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج4، ص207.
[933] لم نجد هذا الخبر عند غير المؤلف، ولم يرد شيء منه في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته.
[934] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (وله ملك الرّي عشر سنين).
[935] هكذا في الأصل، والصحيح (أحدٌ)، وكذا في المورد الذي بعده.
[936] هكذا في الأصل، والصحيح (الريّ).
[937] هكذا في الأصل، والصحيح (شأفته)، والشأفة: قرحة تخرج في أسفل القدم، تُكوَى فتزول. تُستعمل للكناية عن الإزالة من الأصل، يقال: استأصل الله شأفته، أي أذهبه الله كما تذهب القرحة من القدم. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج4، ص1379.
[938] هذا يدلّ بوضوح على أنّ القوم قد قصدوا استئصال الإمام الحسين× وأهل بيته وأصحابه، ومحو آثارهم من الوجود.
[939] هكذا في الأصل، والصحيح (اثنان وسبعون).
[940] هكذا في الأصل، ولعل الصحيح (اعفني من هذا)، فسقطت كلمة (اعفني).
[941] هكذا في الأصل، والصحيح (وأضيف).
[942] طَبَرِسْتَانَ: هو إقليم عرفه العرب والفرس باسمه منذ القرون القديمة، وهو يَقع اليوم في شمال دولة إيران. ويَمتد في مُعظمه على الساحل الجنوبي لبحر قزوين عبر سلسلة جبال ضخمة. فيه بلاد واسعة ومدن كثيرة؛ يشملها هذا الاسم. يغلب عليها الجبال. تسمى اليوم بمازندران، مجاورة لجيلان وديلمان، وتُعدّ فيما مضى من الرى وقومس. اُنظر: البغدادي، عبد المؤمن، مراصد الاطّلاع: ج2، ص878. الموسوعة الحرة ويكيبيديا.
[943] قاشان: مدينة كبيرة وسط إيران تقع بالقرب من مدينة قم، بينها وبين أصفهان. منها يجلب الغضائر القاشانى. وتبعد عن مدينة قم بحوالي 90 كم، وعن أصفهان بحوالي 150 كم. اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج4، ص296ـ297. الموسوعة الحرة ويكيبيديا.
[944] الشِّقْوة، بالكسر بمعنى الشقاء، وهي ضد السعادة، وتعني الضلال. والشقيّ: الضالّ. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص490، (شقا).
[945] هكذا في الأصل، والصحيح (تؤجّلني).
[946] النحس: خلاف السعد، وهو المشؤوم. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج6، ص227، (نحس).
[947] هكذا في الأصل، والصحيح (أولاد).
[948] هكذا في الأصل، والصحيح (الليلة).
[949] المِهادُ: الفِراش. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج3، ص410، (مهد).
[950] اللب: العقل. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج1، ص216، (لبب).
[951] هكذا في الأصل، والصحيح (ابن عمّي).
[952] هكذا في الأصل، والصحيح (الوجود).
[953] هكذا في الأصل، والصحيح أنّها زائدة.
[954] الحجلين: من الحَجَلة، وهي بيت للعروس يُزيّن بالثياب والأسرة والستور، جمعه حجال. وكأنّه استعاره ـ هنا ـ للتعبير عن السعادة ورفاهة السكن. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج4، ص1667. الكرباسي، محمد صادق، دائرة المعارف الحسينية (ديوان القرن الأول): ج2، ص293.
[955] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص78ـ79. الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج1، ص351. الإربلي، علي بن أبي الفتح، كشف الغمّة في معرفة الأئمّة: ج2، ص259.
[956] في شرح شافية أبي فراس ص353 (أربعة)، ثم يقول: (ثم دعا ابن زياد بعروة بن قيس وعقد له راية على أربعة آلاف فارس).
[958] شمر بن ذي الجوشن بن شرحبيل ـ ويقال: قرط ـ بن الأعور بن عمر بن معاوية، أبو سابغة الضبابي العامري الكلابي. وقد اختلفوا في اسم ذي الجوشن، فقيل: اسمه شرحبيل، وقيل: عثمان بن نوفل، وقيل: أوس. وقيل: إنّ شرحبيل أو أوس جدّه. كان في معسكر الإمام علي× في صفّين، ثمّ صار أُمويّاً. قبيح المنظر والفِعال: شهد على حجر بن عدي، له دورٌ رئيس في جرائم واقعة الطفّ، حرّض ابن زياد على قتل الإمام الحسين×. قائد الميمنة لجيش ابن سعد، طعن فسطاط الإمام الحسين×، وأحرق الخباء على أهله، أراد قتل الإمام زين العابدين×، فمنعه الناس، وقِيل: هو الذي حزّ الرأس الشـريف. قتله أصحاب المختار في قرية يقال لها الكلتانية. اُنظر: المنقري، نصـر بن مزاحم، وقعة صفّين: ص268. الدينوري، أحمد بن داود، الأخبار الطوال: ص255ـ256. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص201، وص313، وص334، وص525. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص112. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج2، ص468. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج23، ص186. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، أسد الغابة: ج2، ص138.
[959] هكذا في الأصل، والصحيح (دعا)، وستأتي هكذا في موارد كثيرة، واكتفينا بالإشارة لها هنا للاختصار.
[960] سنان بن أنس بن عمرو النخعي لعنه الله، أقدم على أكبر جريمة عرفها التاريخ، ألا وهي قتل سيد الشهداء×، طعنه برمحه مرتين، ثم ضربه بالسيف. والمشهور أنّه هو الذي احتزّ الرأس الشـريف، وهو يقول: والله إنّي لأجتز رأسك وأعلم أنّك ابن رسول الله، وخير الناس أباً وأمّا. وقد رُوِِي أنّ المختار أخذه فقطع أنامله أنملة أنملة، ثمّ قطع يديه ورجليه وأغلى له قدراً فيها زيت، ورماه فيها وهو يضطرب. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص346، وص535. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص232. ابن نما الحلي، جعفر بن محمد، ذوب النضّار: ص120. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص55.
[961] في شرح شافية أبي فراس: ص353 (عشرة).
[962] القشعم بن عمرو بن نذير ـ أو يزيد ـ الجعفي (لعنه الله، ) ممّن اعتزل الإمام عليّ×، شارك في معركة كربلاء، ومن العشرة الذين هجموا على الإمام الحسين×. اُنظر: الكلبي، أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب، نسب معد واليمن الكبير: ج1، ص313. البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج2، ص298.
[963] هكذا في الأصل، والصحيح خولي بن يزيد الأصبحي الأيادي الدارمي، أحد جنود عمر بن سعد، رمى عثمان بن أمير المؤمنين× بالسهم، وكان له الدور المباشر في استشهاد الإمام الحسين×، وقطع الرأس الشريف، ونقله إلى عبيد الله بن زياد في الكوفة، وفي ثورة المختار اختفى، وأُلقي القبض عليه بعد ذلك، فأمرهم المختار أن يقتلوه في داره، وبعد مقتله حرقه إلى أن صار رماداً. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص531. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج1، ص393. الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص244. المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص489.
[964] في شرح شافية أبي فراس ص353، (عشرة)
[965] وفي شرح شافية أبي فراس ص353: (خمسون ألف فارس)، وفي أسرار الشهادات (ج2، ص149) عن أبي مخنف: كانت أول راية سارت إلى حرب الحسين× راية عمر بن سعد (لعنه الله)، ودعى من بعده بعروة بن قيس (لعنه الله)، وضم إليه ألفين فارس وأمره بالمسير، ودعى من بعده سنان بن أنس النخعي (لعنه الله)، ودعى من بعده بالشمر بن ذي الجوشن الضبابي (لعنه الله)، وعقد له راية على أربعة آلاف فارس، وعقد راية سادسة إلى خولي بن يزيد الأصبحي، وضم إليه ثلاثة آلاف فارس، وسار إلى حرب الحسين×، وعقد راية سابعة وسلّمها إلى القشعم (لعنه الله)، وضم إليه بثلاثة آلاف فارس، وسار إلى حرب الحسين×، وعقد راية ثامنة وسلّمها إلى الحصين بن نمير، وضم إليه ثمانية آلاف فارس، وسار إلى حرب الحسين×، وعقد راية تاسعة وسلّمها إلى أبي قرار الباهلي (لعنه الله)، وضم إليه تسعة آلاف فارس، وسار إلى حرب الحسين×، وعقد راية عاشرة وسلّمها إلى عامر بن صريمة التميمي، وضم إليه ستة آلاف فارس، وسار إلى حرب الحسين×،... وسار القوم حتى نزلوا على الحسين× في خمسين ألف فارس وراجل، ليس فيهم شامي ولا حجازي وجميع القوم من أهل الكوفة. وفي بعض النسخ لأبي مخنف: نزلوا على الحسين وهم في سبعين ألف فارس وراجل وليس فيهم شامي ولا حجازي ولا بصري، وكلّهم من أهل الكوفة. ومعهم السيوف الهندية والرماح الخطية والحراب المجلية). وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (ثم دعى بشبث بن ربعي لعنه الله وعقد له راية، وضمّ إليه أربعة آلاف فارس، ثم دعى بعروة ابن قيس لعنه الله وعقد له راية أربعة آلاف فارس، ثم دعى بسنان بن أنس وعقد له راية على أربعة آلاف فارس. قال: تكاملوا ثمانون ألف فارس).
[966] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (حجازي).
[967] هكذا في الأصل، والصحيح (بإزا)، وستأتي في موارد أخرى.
[968] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (ونادى: يا حسين× ما الذي جاء بك الينا وأقدمك علينا؟ فقال: أتعرفون هذا الرجل؟).
[969] هكذا في الأصل، والصحيح (أتعرفون هؤلاء).
[970] كثير بن شهاب بن الحصين، أبو عبد الله، الحارثيّ الكوفيّ، كان عثمانيّاً، يقع في الإمام علي×. ممَّن شهد على حجر بن عدي، وأرسله زياد بن أبيه بحجر وأصحابه إلى معاوية. ولّاه معاوية الرّي، وهو ممَّن أخرجه ابن زياد لتخذيل الناس عن مسلم بن عقيل، وقد أشرف من أعلى القصر وفي الطرقات يخذّل النّاس عن مسلم×. اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج6، ص149. البلاذري، أحمد بن يحيى، فتوح البلدان: ج2، ص378. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص200، وص276.
[971] لم نعثر علي شيء عنه.
[972] فِيمَ: أداة استفهام مركّبة من حرف الجرّ (في)، و(ما) الاستفهاميّة وقد حُذفت ألفها لدخول حرف الجرّ عليها.
[973] هكذا في الأصل، والصحيح (أقدَمَك).
[974] أَخْفَرَ الذمة: لم يَفِ بها. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج4 ص253، (خفر).
[975] يقال جالد بالسيف: إذا ضارب صاحبه بالسيف، واشتدّ عليه. اُنظر: أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله، الفروق اللغوية: ص164. ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج1، ص285، (جلد)
[976] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص80ـ83. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص154ـ155، المجلس الخامس.
[977] هكذا في الأصل، والصحيح (يُبسَط له بساطٌ وللحسين بساطٌ).
[978] عامَّة الليل: أكثره. اُنظر: الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: ج13، ص413 (عمم).
[979] نقل المؤلف الحادثة هنا مختصرة، بينما وردت في مقتل أبي مخنف بشكل مفصّل. اُنظر: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري): ص99ـ102.
[980] هكذا في الأصل، والصحيح (الأصبحي).
[981] يقال: صبا إلى الشئ: إذا حنّ ومال. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج14، ص451، (صبا).
[982] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، وأسرار الشهادات، واللفظ للأول: (فأمره أن ينزل عن حکمك، وتصير الأمر إليَّ وأنا أکفيك أمره).
[983] هكذا في الأصل، والصحيح (واأْمرْه).
[984] هكذا في الأصل، والصحيح (ماء).
[985] هكذا في الأصل، والصحيح (للكلاب). وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته (ص56): (حللتُه على اليهود والنصارى، وحرمتُه عليه وعلى أهل بيته)، وفي أسرار الشهادات (ج2، ص153): (على الكلاب والخنازير).
[986] اُنظر أيضاً: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص87 و88. الفتال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص182. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج45، ص51. ابن الأثير، علي ابن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص55 وص56.
[987] هكذا في الأصل، والصحيح (دعا).
[988] شبيب أو شَبَث بن ربعي اليربوعي التميمي، كان مؤذّن سجاح التي أدّعت النبوّة، ثمّ أسلم. وكان ممَّن أعان على عثمان، وشهد صفّين في معسكر الإمام علي×، ثمّ صار مع الخوارج بعد التحكيم، أعان على قتل الإمام الحسين× وكان على الرجالة. ولّاه ابن الزبير على الكوفة قبل أن يغلب عليها المختار، ثم اشترك في حرب ابن الزبير ضدّ المختار، ومات في الكوفة سنة (70هـ)، أو (80هـ). اُنظر: المزي، يوسف، تهذيب الكمال: ج12، ص351. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، الإصابة: ج3، ص303.
[989] هكذا في الأصل، والصحيح (نينوى).
[990] هكذا في الأصل، والصحيح (أربعة آلاف).
[991] هكذا في الأصل، وفي تاريخ الطبري (خمس مائة فارس).
[992] هكذا في الأصل، والصحيح (الغاضرية).
[993] في أسرار الشهادات (ج2، ص157) : (فلمّا قرأه ابن سعد دعى بحجر بن الحر وعقد له راية على ألفين فارس، وأمره أن ينزل على شرعة الماء، ويمنع الحسين وأصحابه من شرب الماء. ودعي شبث بن ربعي، وعقد له راية على أربعة آلاف فارس، وأمره أن ينزل على المشرعة، ويضيّق على الحسين وأصحابه). اُنظر أيضاً: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص311ـ312. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص86. الفتال النيسابوري، محمد ابن الحسن، روضة الواعظين: ص182. النويري، أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص428. وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (حجر بن الحرّ وعقد له راية على أربعة آلاف فارس، وأمره أن ينزل مشرعة الغاضريّة ويمنع الحسين× من شرب الماء، ثم دعى بشبث بن ربعي، وعقد له راية على ألف فارس، وأمره أن ينزل على مشرعة الغاضرية، ويمنع الحسين× من شرب الماء فنزلا جميعاً على المشرعة).
[994] هكذا في الأصل، والصحيح (وأقبل).
[995] هكذا في الأصل، والصحيح (محتاجون).
[996] هكذا في الأصل، والصحيح (بئراً).
[997] هكذا في الأصل، والصحيح (كظّهم). يقال: كظّه الأَمرُ: بهَظَه وكرَبَه وجهَدَه. ابن منظور، محمد ابن مكرم، لسان العرب: ج7 ص457، (كظظ).
[998] الظاهر أنّه اشتباه من المؤلف أو الناسخ؛ لأنّ القدر المتيقن أنّ العباس× أكبر سناً من بقية إخوته من أمّه. وكان عمره في معركة الطف بكربلاء أربع وثلاثون سنة. اُنظر: السماوي، محمد ابن طاهر، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص56. الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج10، ص255.
[999] هكذا في الأصل، والصحيح (أخي).
[1000] هكذا في الأصل، والصحيح (أما ترى).
[1001] هكذا في الأصل ولعل الصحيح (يتضوّون).
[1002] لم نعثر على هذه العبارة في غير هذا الكتاب.
|
نحن بنو أُمّ البنين الأربعة |
الضاربون الهام وسط المجمعة
كانت شاعرة فصيحة، وكانت تخرج كلّ يوم إلى البقيع، ومعها عبيد الله ابن ولدها العباس، فتندب أولادها الأربعة، خصوصاً العباس أشجى ندبه، فيجتمع الناس يسمعون بكاءها وندبتها، فكان مروان بن الحكم ـ على شدة عداوته لبني هاشم ـ يجئ فيمن يجئ، فلا يزال يسمع ندبتها ويبكي. فمن ذلك قولها:
|
يا من رأى العباس كرّ |
وقولها في رثاء أولادها الأربعة:
|
لا تدعونّي ويك أم البنين قد واصلوا الموتَ بقطع الوتين |
اُنظر: ابن عنبة، أحمد بن علي الحسيني، عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: ص357. السماوي، محمد بن طاهر، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص56. الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج7، ص49. وج8، ص389.
[1004] هكذا في الأصل، والصحيح (ثلاثين).
[1005] القربة: ظرف من جلد يخرز من جانب واحد وتستعمل لحفظ الماء أو اللبن ونحوهما. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص723، (قرب).
[1006] هكذا في الأصل، الصحيح (فأحسّ).
[1007] هكذا في الأصل، الصحيح (فقال).
[1008] هكذا في الأصل، الصحيح (فقالوا).
[1009] عبد الرحمن بن دحيه: لم نعثر على ترجمته.
[1010] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (كظّنا).
[1011] هكذا في الأصل، والصحيح (وافى). وافَيْتُ القَوْمَ: أَتَيْتُهُم. الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: ج20، ص302، (وفى).
[1012] هكذا في الأصل، والصحيح أنّ (نفر) زائدة.
[1013] هكذا في الأصل، والصحيح (عطاشى).
[1014] أَفْرَجُوا عن المكانِ: تَرَكُوه. اُنظر: الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: ج3، ص454، (فرج).
[1015] هكذا في الأصل، والصحيح (ماءاً).
[1016] هكذا في الأصل، والصحيح (عطاشى).
[1017] هكذا في الأصل، والصحيح (فكأنّ).
[1018] هكذا في الأصل، الصحيح (ما يأتون الماء إلّا نهاراً).
[1019] هكذا في الأصل، الصحيح (شديداً)
[1020] هكذا في الأصل، الصحيح (الثلاثون فارساً) لأنّها (الثلاثون) فاعل لقاتلت.
[1021] هكذا في الأصل، الصحيح (أربعة آلاف)، كما تقدّم من أنّ الذين على المشرعة هم أربعة آلاف.
[1022] هكذا في الأصل الصحيح (الأربعة آلاف فارس).
[1023] الأبراد الكلبي: لم نعثر على ترجمة له.
[1024] لعلّ هناك سقط في العبارة، والمراد بني زهرة. ولم نقف على معنى محصل لنسبة العباس× لبني زهرة من جهة الأم؛ فإنّ أمّه كلابية ـ كما تقدّم في ترجمتها ـ ترجع إلى هوازن، أمّا بنو زهرة فقبيلة قرشية. اُنظر: كحالة، عمر، معجم قبائل العرب: ج2، ص482. وج3، ص989.
[1025] هكذا في الأصل، والصحيح (أن يفرجوا). فَرَجَ القومُ له: أَوْسَعُوا له. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج 2، ص678، (فرج).
[1026] هكذا في الأصل، والصحيح (السقاء) وهو ظرف الماء من الجلد، ويجمع على أسقية. ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب لحديث والأثر: ج2، ص381، (سقى).
[1027] هكذا في الأصل، والصحيح (ماءاً).
[1028] هكذا في الأصل، الصحيح (الفرات).
[1029] هكذا في الأصل، وفي بعض المصادر (زَقَا) بمعنى (صاح). مقتل أبي مخنف برواية الطبري (تحقيق الغفاري): ص179. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج6، ص2368. السماوي، محمد، إبصار العين في أنصار الحسين: ص62.
[1030] هكذا في الأصل، والصحيح (أواري).
[1031] المصاليت: السيوف الصقيلة، ويقال جمع مصلات وهو الرجل الماضي في الأمور. المصاليت: جمع صلت ورجلٌ أَصْلَتِيٌّ: سريعٌ مُتَشمِّرٌ، وهو من مَصالِيتِ الرِّجال. اُنظر: ابن منظور، محمد ابن مكرم، لسان العرب: ج2، ص53. الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: ج3، ص84، (صلت).
[1032] هكذا في الأصل، والصحيح (لِقَى).
[1033] هكذا في الأصل، والصحيح (الطهر).
[1034] هكذا في الأصل، والصحيح (أغدو).
[1035] هكذا في الأصل، والصحيح (الشر).
[1036] هكذا في الأصل، والصحيح (المُلتقى)
[1037] اُنظر أيضاً: مقتل أبي مخنف برواية الطبري (تحقيق الغفاري): ص179. ابن شهر آشوب، محمد ابن عليّ، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص256. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص40. السماوي، محمد، إبصار العين في أنصار الحسين: ص62. ولم يرد فيها جميعاً المصرع الأخير.
وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وأسرار الشهادات، واللفظ للأول:
|
لا أرهب الموت
إذ الموت رقا |
[1038] هكذا في الأصل، والصحيح (نار).
[1039] الوارد في المصادر أنّ قائل هذه الأبيات هو الإمام الحسين× بعد مصرع أخيه العباس×، أو بعد مصرعه وبعد وعظه للقوم، وهو الموافق لمضمون الأبيات. اُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن عليّ، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص256. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص41. القندوزي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة: ج3، ص69.
[1040] هكذا في الأصل، والصحيح (خلقاً كثيراً).
[1041] هكذا في الأصل، والصحيح (وارد).
[1042] هكذا في الاصل، والصحيح (المنون): وهو الموت. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص889، (من)
[1043] هكذا في الأصل، والصحيح (ربي).
[1044] اُنظر أيضاً: مقتل أبي مخنف برواية الطبري: ص179. أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص90ـ91. القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة لذوي القربى: ج3، ص67. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص406، المجلس العاشر. ولم يرد فيها جميعاً البيت الأخير.
[1045] الأبرد بن شتوي الجهني: لم نجد له ترجمة، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (أبرص بن شيبان). وفي ينابيع المودة (الأبرد بن شيبان). اُنظر: القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة لذوي القربى: ج3، ص68.
[1046] هكذا في الأصل، والصحيح (سبط النبي).
[1047] عبد الله الشهباني: لم نجد له ذكر. وفي ينابيع المودة (عبد الله بن يزيد). اُنظر: القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة لذوي القربى: ج3، ص68.
[1048] هكذا في الأصل، والصحيح (صحبة).
[1049] في هامش الأصل: (الفجار).
[1050] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص92ـ93. ابن شهر آشوب، محمد بن عليّ، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص256. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص40ـ41. القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة لذوي القربى: ج3، ص68. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص407، المجلس العاشر.
[1051] الصَّدْم: ضَرْب شَيء صُلْب بِمِثْله، ويقال: اْصْطَدَم الفَحْلان إذا صَدَم الواحِدُ الآخَر. الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: ج17، ص407، (صدم).
[1052] هكذا في الأصل، ولعلّ المراد ضعُفت أو (قُتِلت). والثاني أقرب بقرينة ما بعده.
[1053] هكذا في الأصل، والصحيح (واعترته الكآبة).
[1054] يقال: أجرى فرسه: أي جعله يعدو. اُنظر: أحمد مختار، عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة: ج1، ص367، (جرى).
[1055] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص93. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص407، المجلس العاشر.
[1056] هكذا في الأصل، والصحيح (فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) الاحزاب: آية 23.
نقول: روى المؤلف عن أبي مخنف أنّ العباس× استُشهِد قبل يوم عاشوراء، وسيأتي منه في الحديث (34) أنّ شهادته في اليوم التاسع. وهو مخالف لما رواه الطبري في تاريخه عن أبي مخنف من عدة جهات: 1ـ أنّ الطبري روى هذه الحادثة عن أبي مخنف ولم يذكر فيها شهادة العباس×، بل ذكر أنّهم أخذوا الماء وانصرفوا إلى الخيام سالمين. 2ـ روى عن أبي مخنف محادثة شمر لعنه الله لأبناء أمير المؤمنين× من أم البنين‘ يعطيهم الأمان، في عصر يوم تاسوعاء، وردّهم عليه، وكان في مقدمتهم العباس×. 3ـ روى عن أبي مخنف أنّ العباس× هو الذي طلب من القوم تأجيل الحرب إلى صبيحة اليوم العاشر بأمر من الإمام الحسين×. 4ـ روى عنه أحداث ليلة العاشر وإذن الإمام الحسين× لأصحابه بالانصراف، وجوابهم له، وكان العباس× أول من ابتدأ الكلام من بني هاشم^، فقال: ولِمَ نفعل ذلك؟! لنبقى بعدك؟! لا أرانا الله ذلك أبداً. 5ـ روى عنه أنّ الإمام الحسين× لمّا صفّ أصحابه للحرب صبيحة يوم عاشوراء أعطى رايته أخاه العباس. 6ـ روى الطبري عن أبي مخنف أنّ الإمام الحسين× خطب القوم صبيحة عاشوراء، بعد أن هجم شمر ورأى الخندق يضطرب بالنار فقال: استعجلت بالنار. فلمّا سمعت بنات الرسالة كلام الإمام الحسين× بكين وارتفعت أصواتهنّ، فبعث إليهنّ أخاه العباس وولده علي الأكبر. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص315ـ318، وص320، وص322.
[1057] هكذا في الأصل، والصحيح (أبي عبد الرحمن).
[1058] بنو ضبة: يرجعون إلى ضبة بن طابخة بن إلياس بن مضر، عم تميم بن مر بن أد. والنسبة إليه يُسمّى الضَبّي. ويُنسَب إليهم خلق كثير، وكانت ديارهم جوار بنى تميم أخوتهم بالناحية الشمالية التهامية من نجد، ثم انتقلوا في الإسلام إلى العراق بجهة النعمانية. اُنظر: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، اللباب في تهذيب الأنساب: ج2، ص261. ابن خلدون، عبد الرحمن، تاريخ ابن خلدون: ج2، ق1، ص319.
[1059] هكذا في الأصل، والصحيح (ليلة).
[1060] هكذا في الأصل، والصحيح (تنحّى) أي ابتعد، أو صار في ناحية. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج15، ص312، (نحا). مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص908، (نحا).
[1061] هكذا في الأصل، والصحيح (أحدٌ).
[1062] اُنظر أيضاً: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج1، ص332. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، المطالب العالية: ص1433. البوصيري، أحمد بن أبي بكر، إتحاف الخيرة المهرة: ص2841.
وذكر ابن سعد في طبقاته وغيره بسنده عن أبى عبد الله الضبّي، قال: دخلنا على أبي هرثمة الضبّي حين أقبل من صفّين، وهو مع عليٍّ، وهو جالس على دكّان، وله امرأة يقال لها: حردا، هي أشدّ حباً لعليٍّ، وأشدّ لقوله تصديقاً، فجاءت شاة فبعرت، فقال: لقد ذكّرني بعرُ هذه الشاة حديثاً لعليّ. قالوا: وما علم عليّ بهذا؟ قال: أقبلنا ـ مرجعنا من صفّين ـ فنزلنا كربلاء، فصلّى بنا عليٌّ صلاة الفجر بين شجرات ودوحات حرمل، ثم أخذ كفاً من بعر الغزلان فشمّه، ثم قال: أوه، أوه، يُقتَل بهذا الغائط قوم يدخلون الجنة بغير حساب...). ابن سعد، محمد، ترجمة الإمام الحسين× (من الطبقات الكبرى) : ص49. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص198.
[1063] هكذا في الأصل، والصحيح (وإشارة يده).
[1064] هكذا في الأصل، والصحيح (وا حبذا).
[1065] هكذا في الأصل، والصحيح (عندي عيال، وعليَّ دَين).
[1066] البارقة: السيوف؛ تُسمّى بذلك لبياضها أو لمعانها. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج10، ص15، (برق).
[1067] هكذا في الأصل، والصحيح (أحدٌ)، وكذا ما بعده.
[1068] الواعية: الصُّراخ على الميّت، وليس له فعل. اُنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج2، ص272.
[1069] هكذا في الأصل، والصحيح (رجلاً).
[1070] هكذا في الأصل، والصحيح (أنس)، وهو أنس بن الحارث (الكاهلي)، ويُقال: أنس بن كاهل الأسدي، وأنس بن هزلة، ومالك بن أنس الكاهلي (الباهلي)، عُدّ أنس بن الحارث في عداد الكوفيين، وهو من جملة صحابة النبي’، شهد معه بدراً وحُنيناً. روى أشعث بن سحيم، عن أبيه، عن أنس&، أنّه سمع النبي’ يقول: إنّ ابني هذا ـ يعني الحسين ـ يُقتَل بأرضٍ من أرض العراق، فمَن أدركه فلينصـره. ورد ذكره في زيارة الشهداء الواردة عن الناحية المقدّسة بعنوان: (أنس بن كاهل الأسدي). اُنظر: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص107. الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص224. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، أُسد الغابة: ج1، ص123. المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص493.
[1071] هكذا في الأصل، والصحيح (عسى).
[1072] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (يا أخا كاهل).
[1073] «نكس الشيء: قلبه، ونكس رأسه أي طأطأ به. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج3، ص986، (نكس).
[1074] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص96. الإربلي، علي بن أبي الفتح، كشف الغمّة في معرفة الأئمّة: ج2، ص258. الشافعي، محمد بن طلحة، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول|: ص401، وفيهما (يزيد بن حصين الهمداني). القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة لذوي القربى: ج3، ص69، وفيهما(أنس). الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص238ـ239، وفيه (برير). الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص219ـ220، المجلس السابع.
[1075] هكذا في الأصل، والصحيح (أبو).
[1076] الطلِبَة: الحاجة. ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج3، ص131، (طلب).
[1077] هكذا في الأصل، والصحيح (فأجابه).
[1078] هكذا في الأصل، والصحيح (بنو).
[1079] هكذا في الأصل، والصحيح (إياي).
[1080] زهير بن القين بن قيس الأنماري البجلي، من أصحاب الإمام الحسين× البارزين، كان رجلاً شريفاً في قومه، نازلاً فيهم بالكوفة، وله في المغازي مواقف مشهورة، ومواطن مشهودة، وكان على الميمنة في عسكر الإمام الحسين×. وقف بين يدي الإمام× قائلاً: والله، لَوددتُ أنّي قُتِلتُ، ثمّ نُشِرتُ، ثمّ قُتِلتُ، حتى أُقتَل هكذا ألف مرّة، وأنّ الله تعالى يدفع بذلك القتل عن نفسك، وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك. وعندما خرّ صريعاً، قال الإمام× مخاطباً إيّاه: لا يبعدك الله يا زهير، ولعن قاتلك لعْن الذين مُسِخوا قردةً وخنازير. قتله كثير بن عبد الله، والمهاجر بن أوس. اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص92. السماوي، محمد ابن طاهر، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص161.
[1081] هكذا في الأصل، والصحيح (نصير).
[1082] هكذا في الأصل، والصحيح (وحديثاً).
[1083] هكذا في الأصل، والصحيح (ابن بنت).
[1084] هكذا في الأصل، والصحيح (أشفيتم).
[1085] هكذا في الأصل، والصحيح (أعداءه).
[1086] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري): ص109ـ 110. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص95. الفتال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص183. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص57. وفيها جميعاً ـ عدا أبي مخنف ـ أنّ مقولة الإمام الحسين× لأصحابه كان قبل بدء المعركة وقبل شهادة العباس×.
[1087] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص130. القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة لذوي القربى: ج3، ص79. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص227، المجلس السابع. أوردا الأبيات بعد مقتل الطفل الرضيع.
[1088] تقدّم من المؤلف مرتين أنّ الإمام الحسين× بعد مقتل مسلم وهانئ رضوان الله عليهما، لمّا ورد المدينة وقد غابت عنه أخبر مسلم×، رأى جدّه’ في المنام، فقال له: الوحا الوحا، ولعلّ الرؤيا تكرّرت للإمام× مراراً.
[1089] هكذا في الأصل، والصحيح (باكٍ).
[1090] زينب بنت علي بن أبي طالب÷، أُمّها فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليهما. وُلِدت في الخامس من جمادى الأُوّلى من السنة السادسة للهجرة. تُكنّى أُمّ الحسن أو أُمّ كلثوم، وتُلقّب بالعقيلة. تزوّجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فولدت له: علياً، وعوناً الأكبر، وعباساً، ومحمداً، وأُمّ كلثوم. لها دورٌ بارزٌ ومهمٌّ بعد مقتل الحسين×. وهي زينب الكبرى، وقيل هي نفسها أم كلثوم، وليس لأمير المؤمنين× من فاطمة‘ بنت غيرها، وقيل: بل هما اثنان، وإنّ أم كلثوم هي زينب الصغرى أو رقية. واختُلف في وفاتها ومدفنها، فقِيل: سنة (62هـ). وقِيل: (65هـ). قِيل: أنّها دُفنت في مصر في القاهرة. بينما ذكر كثيرٌ من المؤرِّخين أنّها تُوفّيت ودُفنت في دمشق. اُنظر: الطبرسي، الفضل بن الحسن، تاج المواليد: ص18. ابن حجر العسقلاني، أحمد ابن علي، الإصابة: ج8، ص166. المقريزي، أحمد بن علي بن عبد القادر، إمتاع الأسماع: ج5، ص371. القندوزي، ، ينابيع المودة: ج3، ص147. القزويني، محمد كاظم، زينب الكبرى من المهد إلى اللحد: ص31، وص37، وص591، وص595.
[1091] هكذا في الأصل، والصحيح (فخيراً)، وكذا ما بعده.
[1092] هكذا في الأصل، والصحيح (تكره).
[1093] هكذا في الأصل، والصحيح (يا أختي).
[1094] هكذا في الأصل، والصحيح (فبكت).
[1095] هكذا في الأصل، والصحيح (وبمهجتي من الأسواء).
[1096] هكذا في الأصل رسمها.
[1097] هكذا في الأصل، والصحيح (أهبتكم).
[1098] هكذا في الأصل، والصحيح (وقلباً).
[1099] هكذا في الأصل، والصحيح (الضبابي).
[1100] عَبَّى الجيش: أَصْلَحه وهَيّأَه، فيقال: عَبَّأْتُ الجيشَ، أَي رَتَّبْتُهم في مَواضِعهم وهَيَّأْتُهم للحَرْب. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج1، ص118، (عبا).
[1101] النواجذ: هي الأسنان التي تسمى بالضواحك، لأنّها تبدو عند الضحك. اُنظر: ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج5، ص20، (نجذ).
[1102] كَلَّ: تعب وأَعْيا. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج11، ص591، (كلل)
[1103] كذا في الأصل، والصحيح (وتبثَّ). بَثَّ الشي: فَرَّقه فتَفَرَّقَ ويقال: باثَهُ بدّده وفرٌقه. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج2، ص114، (بثث).
[1104] قيس بن مشروق العبسي: لم نعثر على شيء يخصه.
[1105] نافع بن هلال بن نافع بن جمل بن سعد العشيرة بن مذحج، المذحجي الجملي، كان سيِّداً شريفاً، سريّاً شجاعاً، قارئاً كاتباً، من حَمَلة الحديث، ومن أصحاب أمير المؤمنين×، شهد معه الجمل وصفين والنهروان. خرج إلى الإمام الحسين× مع أبي ثمامة الصائدي، فلقِيَه في الطريق، فالتحق به واستُشهد بين يديه. له كلام مع الإمام الحسين× ينمّ عن قوة إيمانه، وشدة بصيرته ومعرفته: (يا بن رسول الله، أنت تعلم أنّ جدَّك رسول الله’ لم يقدر أن يُشرِب الناسَ محبتَه، ولا أن يرجعوا إلى أمره ما أحب، وقد كان منهم منافقون يَعِدونه بالنصر، ويضمرون له الغدر، يلقونه بأحلى من العسل، ويخلفونه بأمرّ من الحنظل حتى قبضه الله إليه. وأنّ أباك علياً قد كان في مثل ذلك، فقومٌ قد أجمعوا على نصرِهِ، وقاتلوا معه الناكثين والقاسطين والمارقين، وقومٌ خالفوه، حتى أتاه أجلُه، ومضى إلى رحمة الله ورضوانه، وأنت اليوم عندنا في مثل تلك الحالة، فمن نكث عهدَه وخلع نيتَه فلن يضرَّ إلّا نفسَه، واللهُ مغنٍ عنه. فسِر بنا راشداً معافى، مشرِّقاً إن شئتَ، وإن شئتَ مغرِّباً، فواللهِ ما أشفقنا من قدر اللهِ، ولا كرهنا لقاءَ ربِّنا، فإنّا على نياتنا وبصائرنا، نوالي من والاك ونعادي من عاداك). ورد السلام عليه في زيارة الشهداء الواردة عن الناحية المقدسة، والزيارة الرجبية. واشتبه البعض وأسماه (هلال بن نافع)، والصحيح أنّ هلال بن نافع من جيش عمر بن سعد. اُنظر: المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص493. ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج3، ص344. ابن نما الحلي، محمد بن جعفر، مثير الأحزان: ص57. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص75. السماوي، محمد بن طاهر، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص147، وص150.
[1106] سعد بن مالك النخعي لم نعثر على شيء يخصه.
[1107] الساقَةُ من الجيش: مؤخَّرُهُ. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص464، (سوق).
[1108] اُنظر أيضاً: الدينوري، أحمد بن داوود، الاخبار الطوال: ص265. البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ح3، ص187. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص95. الطبرسي، الحسن بن علي، إعلام الورى بأعلام الهوى: ح1، ص457ـ458.
[1109] اُنظر أيضاً: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص333.
[1110] الأوَابِدِ: الوحْوشُ التي قد تأبّدت، أي توحّشت ونفرت من الإنس. اُنظر: ابن الأثير، المبارك ابن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج1، ص13، (أبد).
[1111] هكذا في الأصل، والصحيح (عاودوا).
[1112] اُنظر أيضاً: لجنة الحديث في معهد باقر العلوم×، موسوعة كلمات الإمام الحسين×: ص552. والجلايد لعلّه تصحيف، والصحيح (الجلامد). الجَلْمَدُ والجُلْمود: الصخر، وقيل: الجَلْمَد والجُلْمُود أَصغر من الجَنْدل قدر ما يرمى بالقَذَّاف. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج3، ص129، (جلمد).
[1113] جويزة، ويقال عبد الله بن حوزة التميمي، أو ابن حُويزة، ويقال حُويزة بن بدر التميمي. وضبطه ابن ماكولا باسم (ابن حويزة). رسول ابن زياد إلى عمر بن سعد يتوعّده بالقتل إذا لم يقاتل الإمام الحسين×. وقف أمام الإمام الحسين× يوم عاشوراء ـ حينما رأى النيران تضطرم وراء خيام الإمام الحسين×، وأدرك أنّه لا يمكن الهجوم على الخيام من ورائها ـ فناداه بكلّ وقاحةٍ قائلاً: (أبشر بالنار) فقال الإمام الحسين× لأصحابه: من هذا؟ قيل: هذا ابن حوزة، قال: اللهم حزه إلى النار. فجال به فرسُه فسقط عنه اللعين، وبقيت رجلُه معلّقةً بالركاب فاضطرب الفرس هائجاً، ورأس اللعين يُضرب بالأرض إلى أن هلك لعنه الله. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص327، وص328. الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص117. ابن ماكولا، علي بن هبة الله، إكمال الكمال: ج2، ص571. أبو زرعة الدمشقي، عبد الرحمن بن عمرو، تاريخ أبي زرعة الدمشقي: ج1، ص627.
[1114] أي الإمام الحسين×.
[1115] الركاب للسرج ما توضع فيه القدم. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص368، (ركب). واُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص99ـ100. البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص191. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص101ـ102. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص66. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص196. النويري، أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص448.
[1116] علقمة بن واثلة لم نعثر على شيء يخصه. نعم ورد الخبر في مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص126: عن مسروق بن وائل قال: كنتُ في أوائل الخيل ممَّن سار إلى الحسين، فقلتُ: أكون في أوائلها لعلّي أصيب رأسَ الحسين؛ فأصيب به منزلة عند عبيد الله بن زياد. قال: فلمّا انتهينا إلى حسين تقدّم رجل من القوم يقال له ابن حوزة، فقال: أفيكم حسين؟ قال: فسكت حسين. فقالها ثانية، فسكت. حتى إذا كانت الثالثة قال: قولوا له: نعم هذا حسين، فما حاجتك؟ قال: يا حسين أبشر بالنار. قال: كذبتَ، بل أُقدِم على ربّ غفور وشفيع مطاع، فمَن أنت؟ قال: ابن حوزة، قال: فرفع الحسين يديه حتى رأينا بياض إبطيه من فوق الثياب. ثم قال: اللهم حزه إلى النار. قال: فغضب ابن حوزة، فذهب ليقحم إليه الفرس، وبينه وبينه نهر. قال: فعلقت قدمه بالركاب، وجالت به الفرس، فسقط عنها. قال: فانقطعت قدمه وساقه وفخذه، وبقى جانبه الآخر متعلقاً بالركاب. قال: فرجع مسروق وترك الخيل من ورائه، قال: فسئلتُه، فقال: لقد رأيتُ من أهل هذا البيت شيئاً، لا أقاتلهم أبداً. قال: ونشب القتال).
[1117] هكذا في الأصل، والصحيح (حسين).
[1118] هكذا في الأصل، والصحيح (حسينُ).
[1119] هكذا في الأصل، والصحيح (حزه).
[1120] اُنظر أيضاً أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص99ـ100.
[1121] محمد بن سيرين البصري (صاحب تفسير الأحلام)، كنيته أبو بكر. مولى أنس بن مالك. من سبي عين التمر. وُلِد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان ـ اي سنة ٣٣ هـ ـ وكان به صمم. تُوفّي سنة (110هـ). اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج7، ص193. العيني، محمود بن أحمد، عمدة القاري: ج15، ص49 . القمي، عباس، الكُنى والألقاب: ج1، ص319.
[1122] كذا رسمت في الأصل، وفي بعض المصادر (قمتَ مقاماً).
[1123] اُنظر أيضاً: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج45، ص49. ابن الأثير، عليّ بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص242. ابن نما الحلّي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص36. المزّي، يوسف، تهذيب الكمال: ج21، ص359. الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: ج5، ص195. المتقي الهندي، علي بن حسام، كنز العمال: ج13، ص674.
[1124] أنس بن مالك الأنصاري، أبو حمزة. من الصحابة الذين انحرفوا عن أمير المؤمنين×، بقول السوء فيه، وكتمان مناقبه؛ فإنّه كتم منقبة غدير خمّ، فدعا أمير المؤمنين× عليه: اللهم إن كان كاذباً؛ فسلّط عليه بيضاء لا تواريها العمامة. فأُصيب بالبرص؛ فآلا على نفسه أن لا يكتم منقبة لآل البيت. ورُوِي عن الإمام الصادق× أنّه كان يقول: ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله’: أبو هريرة، وأنس بن مالك، وامرأة. مات سنة: (91هـ)، وقِيل: (92هـ)، وقِيل: (93هـ)، وبلغ عمره فوق المائة. اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، الخِصال: ص190. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج1، ص110. ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج4، ص74.
[1125] هكذا في الأصل، والصحيح (سيدا شباب).
[1126] هكذا في الأصل، والصحيح (سيدة).
[1127] هكذا في الأصل، والصحيح (أبغضهم).
[1128] اُنظر أيضاً: أبو نعيم، أحمد بن عبد الله، معرفة الصحابة: ج2، ص665. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص135. وفيهما سيدا... ولم يذكرا قوله (فمن أحبّهم فقد أحبّني ومن أبغضهم فقد أبغضني). المتقي الهندي، علي بن حسام، كنز العمال: ج13، ص661. ورد عن أنس بن مالك صدر الحديث، ولم نعثر على ذيله منه. نعم ورد عن غيره مضمون الحديث عند الفريقين.
[1129] هكذا في الأصل، والصحيح أنّها زائدة.
[1130] هكذا في الأصل، والصحيح (أكلم).
[1131] التكاثر: آية 3ـ4.
[1132] الجاثية: آية 21.
[1133] هكذا في الأصل، والصحيح (خارجياً).
[1134] لم نعثر على هذه الخطبة، وإنّما المنقول عنه كما في مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) : ص119، أنّه قال: (كثير بن عبد الله الشعبي، قال: لمّا زحفنا قِبَل الحسين، خرج إلينا زهيرُ بن القين، على فرس له ذنوب شاك في السلاح، فقال: يا أهلَ الكوفةِ نَذارِ لَكُمْ مِن عذابِ الله، إنَّ حقَّاً على المسلمِ نصيحةُ أخيهِ المسلمِ، ونحنُ حتَّى الآنَ إخوةٌ وعلى دينٍ واحدٍ، ما لم يقعْ بينَنا وبينَكمُ السيفُ. وأنتُم للنصيحةِ منَّا أهلٌ، فإذا وقعَ السيفُ انقطَعَتْ العِصْمَةُ، وكُنَّا أمَّةً وأنتُم أمَّة. إنَّ اللهَ قدِ ابتلانا وإيَّاكُمْ بذُريَّةِ نبيِّهِ محمّدٍ’؛ لينظُرَ ما نحنُ وأنتُمْ عاملونَ. إنَّا ندْعُوكُمْ إلى نصرِهِم وخِذْلانِ [يَزيدَ وَ] الطاغيةِ عُبَيدِ اللهِ بْنِ زيادٍ؛ فإنَّكُمْ لا تُدْرِكُونَ مِنْهما إلَّا سُوءَ عُمْرِ سُلطانهما كلِّهِ؛ ليسملانِ أعينَكم ويقطعانِ أيديَكم وأرجلَكم، ويمثّلانِ بكم، ويرقعانِكم [ويرفعانِكم] على جذوعِ النخلِ، ويقتلانِ أماثلَكم وقرّاءَكم، أمثالَ حُجرِ بنِ عدي وأصحابِهِ، وهاني بنِ عروةَ وأشباهِهِ. قال: فَسبُّوهُ، وأثْنَوْا على عُبيدِ اللهِ بنِ زيادٍ، ودعَوْا لهُ، وقالُوا: واللهِ، لا نَبْرَحُ حتَّى نقتُلَ صاحبَكَ ومَنْ مَعَهُ أوْ نَبْعَثَ بهِ وبأصحابِهِ إلى الأميرِ عُبيدِ اللهِ سِلْمَاً. فقالَ لهُمْ: عِبادَ اللهِ إنَّ وُلْدَ فاطمةَ رضوانُ اللهِ علَيْها أحقُّ بالوُدِّ والنَّصْرِ منِ ابن سُميَّةَ، فإنْ لم تنْصُروهُمْ فأُعيذُكُم باللهِ أنْ تقتُلُوهُم، فخلّوا بين هذا الرجل وبين ابن عمه يزيد بن معاوية؛ فلعمري أنّ يزيد ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين. قال: فرماه شمر بن ذي الجوشن بسَهمٍ، وقال: اسكُتْ أسكَت اللهُ نأمتك، أبرمتَنا بكثرةِ كلامِكَ. فقال له زهيرٌ: يا بن البوّالِ على عقبيه، ما إيّاك أخاطب، إنّما أنتَ بهيمة، واللهِ، ما أظنُّك تُحكِمُ من كِتابِ اللهِ آيتينِ. فأبشرْ بالخِزي يومَ القيامةِ والعذابِ الأليمِ. فقالَ لهُ شِمر: إنّ اللهَ قاتلُك وصاحبَك عن ساعة. قال: أفبالموتِ تخوفُنِي؟! فوالله للمَوتِ معَهُ أحبُّ إليَّ مِن الخُلدِ معكُم. قال: ثُمّ أقبلَ على النّاسِِ رافعاً صوتَه، فقال: عبادَ اللهِ، لا يغرّنَّكم مِن دينِكم هذا الجلفُ الخافي [الجافي] وأشباهه، فواللهِ، لا تَنالُ شفاعةُ محمدٍ’ قوماً هراقوا دِماءَ ذريتِهِ وأهلِ بيتِهِ، وقتلُوا مَن نصرَهُم، وذبَّ عن حريمِهم. قالَ: فناداهُ رجلٌ، فقال له: إنّ أبا عبدِ اللهِ يقولُ لكَ أقبلْ، فلعمري لَئنْ كانَ مؤمنُ آلِ فرعونَ نصحَ لقومِهِ، وأبلغَ في الدُّعاءِ لقد نصحتَ لهؤلاءِ، وأبلغتَ لو نفع النصحُ والإبلاغُ). اُنظر أيضاً: ابن الأثير، عليّ بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص63. النويري، أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص442ـ443.
[1135] هكذا في الأصل، والصحيح (يحرقونها).
[1136] هكذا في الأصل، والصحيح (احرقوا).
[1137] في مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص140، (قال: وقاتلوهم حتى انتصف النهار أشدّ قتال خلقه الله، وأخذوا لا يقدرون على أن يأتوهم إلّا من وجه واحد؛ لاجتماع أبنيتهم، وتقارب بعضها من بعض. قال: فلمّا روى [رأى] ذلك عمر بن سعد أرسل رجالاً يقوّضونها عن أيمانهم وعن شمائلهم؛ ليحيطوا بهم. قال: فأخذ الثلاثةُ والأربعةُ من أصحاب الحسين يتخلّلون البيوت، فيشدّون على الرجل، وهو يقوّض وينتهب، فيقتلونه ويرمونه من قريب ويعقرونه، فأمر بها عمر بن سعد عند ذلك، فقال: أحرقوها بالنار، ولا تدخلوا بيتاً، ولا تقوضوه. فجاءوا بالنار فأخذوا يحرقون. فقال حسين: دعوهم فليحرقوها فإنّهم لو قد حرقوها لم يستطيعوا أن يجوزوا إليكم منها، وكان ذلك كذلك. وأخذوا لا يقاتلونهم إلّا وجه واحد).
[1138] هكذا في الأصل، والصحيح (شمراً).
[1139] هكذا في الأصل، والصحيح (عليهم).
[1140] ضَيع: بالفتح، هالك، يقال: ضاعَ الشيءُ: هلك. ولعلّه تصحيف (صريع). اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج8، ص231، (ضيع)
[1141] اُنظر أيضاً: الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص16. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص69. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص261، المجلس الثامن.
[1142] هكذا في الأصل، والصحيح (رأى أبو).
[1143] هكذا في الأصل، والصحيح (يا بن ابن عم رسول الله) أو (ابن بنت رسول الله).
[1144] هكذا في الأصل، والصحيح (حضرت).
[1145] هكذا في الأصل، والصحيح (فصلِّ).
[1146] هكذا في الأصل، والصحيح (نادى).
[1147] في تاريخ الطبري: (الحصين بن تميم).
[1148] هكذا في الأصل، والصحيح (صلًّ).
[1149] هكذا في الأصل، والصحيح (واقفاً)
[1150] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، وإكسير العبادات في أسرار الشهادات: (الخّمارة). وفي تاريخ الطبري: (يا حمار).
[1151] هكذا في الأصل، والصحيح (حبيبُ).
[1152] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (يا مولاي إنّي أحبّ أن أُتمّ صلاتي في الجنّة، وأقرأ...).
[1153] هكذا في الأصل، والصحيح (أُقرئ).
[1154] هكذا في الأصل، والصحيح: (وأخاك).
[1155] جاءت القافية في الأصل رائية منصوبة، والصحيح أنّها بضم الراء؛ لأنّ جميع الكلمات جاءت مرفوعة، وكما هو المروي في مصادر أخرى. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص195. الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص224. ابن شهر آشوب، محمد ابن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص252. ابن نما الحلي، محمد بن جعفر، مثير الأحزان: ص46. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص26. البحراني، عبد الله، العوالم: ص270. القندوزي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة: ج3، ص71.
[1156] قسور: الشديد. ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج4، ص63، (قسور).
[1157] هكذا في الأصل، والصحيح (للإمام).
[1158] هكذا في الأصل، والصحيح (بالإله).
[1159] هكذا في الأصل، والصحيح (الورى).
[1160] الخيشوم: أقصى الأنف. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص236، (خشم).
[1161] هكذا في الأصل، والصحيح (يعلو).
[1162] هكذا في الأصل، والصحيح (فحامى).
[1163] اُنظر أيضاً: الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص262ـ263، المجلس الثامن.
[1164] يقال له: (بديل بن صريم من بنى عقفان). الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص335.
[1165] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (خمسة وثلاثين فارساً).
[1166] (عليه) الثانية زائدة.
[1167] هكذا في الأصل، والصحيح (مولاي).
[1168] هكذا في الأصل، والصحيح (فقال له) أو (قال).
[1169] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (وأنا ابن القين)
[1170] هكذا في الأصل، والصحيح (الحسينِ).
[1171] الأسمر: الرمح. اُنظر: الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط: ج2، ص51، (سمر).
[1172] رديني: نوع من الرماح تنسب إلى امرأة بخط هجر كانت تسوّيها تسمّى ردينة، وخط هجر موضع باليمامة تنسب إليه الرماح الخطية. وقيل: الرديني نسبة إلى رجل كان يثقف الرماح، اسمه ردين. أو منسوبة إلى قرية ردينة. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج3، ص1123. وج5، ص2122. الحموي، ياقوت، معجم البلدان: ج3، ص41.
[1173] هكذا في الأصل، والصحيح: (فقتل منهم عشرين رجلاً). وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (خمسين فارساً).
[1174] اُنظر أيضاً: الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص265، المجلس الثامن.
[1175] هكذا في الأصل، والصحيح: (نلقى).
[1176] هكذا في الأصل، والصحيح: (المرتضى).
[1177] في شرح شافية أبي فراس(ص360): (اثنين وثمانين).
[1178] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص101ـ107. البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص195ـ196. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص336. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص199. القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة لذوي القربى: ج3، ص72. ونسب ابن شهر آشوب الرجز إلى الحجاج بن مسروق الجعفي مؤذن الإمام الحسين×. اُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن عليّ، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص252.
[1179] يزيد بن زياد بن المهاجر ـ ويُقال: المهاصر ـ (أبو الشعثاء) الكندي، كان رجلاً شريفاً، شجاعاً، خرج من الكوفة إلى الإمام الحسين×، قبل أن يصل الحر بن يزيد الرياحي وجيشه، ردّ على رسول ابن زياد عندما جاء بكتاب التضييق على الإمام الحسين×، قائلاً: عصيتَ ربَّك، وأطعتَ إمامك في هلاك نفسك، وكسبتَ العار والنار، وبئس الإمام إمامك... كان يوم عاشوراء يرمي بالسهام، فيقول الإمام الحسين×: اللهمّ سدّد رميته، واجعل ثوابه الجنّة. ثمّ خرج يقاتل بسيفه حتى استُشهد. وقع التسليم عليه في زيارة الشهداء الواردة عن الناحية المقدّسة. اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج3، ص79. السماوي، محمد بن طاهر، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص171.
[1180] هكذا في الأصل، والصحيح (الورى).
[1181] هكذا في الأصل، والصحيح (ولابن).
[1182] الذابل: يقال رمح ذابل دقيق. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص309، (ذبل).
[1183] الباتر: السيف القاطع يجمع بواتر. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص37، (بتر).
[1184] هكذا في الأصل، والصحيح (نيّفاً) والنيّف: هو كلّ ما زاد على العَقْد، فهو نيّف، بالتشديد، وقد يخفف حتى يبلغ العَقْد الثاني، انظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج9، ص342، (نوف).
[1185] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص103. وفيه (قتل خمسين فارساً). ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص108. ابن الأثير، علي ابن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص73. المجلسي، محمد باقر، بحار الانوار: ج45، ص30. الحسيني، محمد بن أمير، شرح شافية أبي فراس: ص360.
وفي مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص158: (قال أبو مخنف: حدثني فضيل بن خديج الكندي أنّ يزيد بن زياد ـ وهو أبو الشعثاء ـ الكندي، من بني بهدلة جثى على ركبتيه بين يدي الحسين، فرمى بمائة سهم، ما سقط منها خمسة أسهم. وكان رامياً، وكان كلمّا رمى قال: أنا ابن بهدلة فرسان العرجلة، ويقول حسين: اللهم سدّد رميته، واجعل ثوابه الجنة، فلمّا رمى بها قام فقال: ما سقط منها إلّا خمسة أسهم. ولقد تبيّن لي أنّي قد قتلتُ خمسة نفر، وكان في أوّل من قُتِل، وكان رجزه يومئذ:
|
أنا يزيد وأبي
مهاصر |
وكان يزيد بن زياد بن المهاصر ممّن خرج مع عمر بن سعد إلى الحسين، فلمّا ردّوا الشروط على الحسين مال إليه، فقاتل معه حتى قُتِل).
[1186] يحيى بن كثير الأنصاري ـ ذكره أبو فراس في شرح الشافية وصاحب ناسخ التواريخ ـ وكان معروفاً بالشجاعة والبسالة والشهامة، حتى حيّر العقول، وقد قتل خمسين فارساً، وقيل: أربعين فارساً. اُنظر: الحسيني، محمد بن أمير، شرح شافية أبي فراس: ص360. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج2، ص399ـ400. المحلّاتي، ذبيح الله، فرسان الهيجاء: ج2، ص189ـ190.
[1187] نسب ابن أعثم الكوفي والعلامة المجلسي هذه الأبيات إلى عمرو بن جنادة. اُنظر: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص110. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص28.
[1188] هكذا في الأصل، والصحيح (رماحهم). وخضب الثوب بالدم: لطخه به. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص239، (خضب).
[1189] العجاج والعجاجة: الغبار. وهو كناية عن اشتداد القتال وارتفاع الغبرة. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص584، (عج).
[1190] هكذا في الأصل، والصحيح (دم).
[1191] هكذا في الأصل، والصحيح (الحوادث).
[1192] خطر السيف والرمح: هزه، والخطار: الرمح. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج2، ص648، (خطر).
[1193] في ناسخ التواريخ (بنِ الأوس).
[1194] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته (خمسين فارساً)، وفي أسرار الشهادات (خمسمائة مبارزاً).
[1195] اُنظر أيضاً: الحسيني، محمد بن أمير، شرح شافية أبي فراس: ص360.
[1196] هكذا في الأصل، والصحيح (نافع بن هلال)، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك في ترجمته ص199.
[1197] هكذا في الأصل، والصحيح (بالشجاعة).
[1198] فوق السهم: الوتر والجمع أفواق. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج4، ص1546، (فوق).
[1199] الإخفاق: الاضطراب. اُنظر: ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج2، ص56، (خفق).
[1200] هكذا في الأصل، والصحيح (لأملأن..).
[1201] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (لأملئنّ الأرض من إطلاقها... فالنفس لا ينفعها إشفاقها).
[1202] في شرح شافية أبي فراس، ص360: (خمسة وعشرين رجلاً).
[1203] اُنظر أيضاً: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج 5، ص109ـ110. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص27.
[1204] إبراهيم بن الحسين بن علي بن أبي طالب^. ذكره ابن شهرآشوب في المناقب في أصحاب الإمام الحسين× حينما عدّ المقتولين من أهل البيت^، فقال: (وستة من بني الحسين مع اختلاف فيهم) وعدّ منهم إبراهيم. وقد يكون المراد به إبراهيم بن الحصين الأسدي، وهو من الشجعان، وقاتل قتالاً شديداً حتى قتل منهم خمسين رجلاً أو أربعة وثمانين، ثم استُشهِد. وهو من الذين ذكرهم الحسين× حين الاستنصار، فقال : يا أسد الكلبي، يا إبراهيم بن الحصين، وقد ذكرت له أبيات غير هذه، وهي:
|
أضرب منكم
مفصلاً وساقا |
اُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص253، وص259. النمازي، علي، مستدركات علم رجال الحديث: ج1، ص 140. الكرباسي، محمد صادق، دائرة المعارف الحسينية (ديوان القرن الأول) : ج1، ص121.
[1205] هكذا في الأصل، والصحيح (أقدم).
[1206] هكذا في الأصل، والصحيح (تلقى).
[1207] هكذا في الأصل، والصحيح (ذاك).
[1208] ذو الجناحين: هو جعفر الطيار الذي استُشهد بغزوة مؤتة في سنة 8 هـ بعدما قُطِعت يداه، فقال الرسول’: «إنّ الله أبدله بيديه جناحينِ يطير بهما في الجنّة». فاشتهر بالطيار وذي الجناحين. والحليف: الملازم، المتعاهد على التناصر. اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج22، ص276. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص192، (حلف).
[1209] حمزة بن عبد المطلب بن هاشم، سيد الشهداء، عم الرسول’. شهد بدراً وأُحداً واستُشهد فيها، ومُثِّل بجسده الشـريف؛ فحزن عليه رسول الله’ حزناًً شديداً، حتى رُوِي عن السجاد× أنّه قال: ما من يوم أشدّ على رسول الله’ من يوم أُحد، قُتِل فيه عمه حمزة بن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسوله. وقد رُوِي في فضله أنّه: أوحى الله إلى نبيه’: أنّي فضلتُ حمزة بسبعين تكبيرة، لِعِظَمه عندي وكرامته عليَّ. اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص547. النوري، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل: ج2، ص258.
[1210] الكَمِيّ: الشجاع. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج6، ص2477، (كمي).
[1211] علي بن مظاهر ـ ويقال مظهّر أو مطهّر ـ الأسدي. لم يذكروه. من شهداء الطف. واحتمل البعض أنّه أخو حبيب بن مظاهر&؛ لتشابه اسم أبيهما واللقب. لم يرد اسمه في كتب الرجال، ولا المصادر التاريخية سوى بعض المتأخرين، ونسبوا له الأبيات التي رواها الطبري عن حبيب ابن مظاهر. يقال إنّه برز فقتل خمسين فارساً، وقيل: سبعين فارساً، ثم قُتِل&. وقيل: إنّ زوجته كانت معه في كربلاء، فلمّا أمرهم الحسين× بإخراج نسائهم لئلّا يصيبها ما يصيب بنات الرسالة من السبي، قام ليردّها فأبت، وفضّلت مواساة نساء الحسين× ومشاركتهن في محنة السبي والأسر. اُنظر: الحسيني، محمد بن أمير، شرح شافية أبي فراس: ص360. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج2، ص410. الحائري، محمد مهدي، معالي السبطين: ج1، ص342. الشاهرودي النمازي، علي، مستدركات علم رجال الحديث: ج5، ص480.
[1212] روى الطبري هذه الأبيات هكذا:
|
أقسم لو كنّا لكم أعدادا |
يا شر قوم حسباً وآدا
ونسبها لحبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه. وكذا في البحار. وفي ينابيع المودة: (ثم برز حنظلة وهو يقول:
|
يا شر قوم حسباً وزادا وكم ترومون لنا
العنادا |
والظاهر مراده حنظلة بن سعد الشبامي. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص334. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص26. القندوزي الحنفي، سليمان ابن إبراهيم، ينابيع المودة: ج3، ص72.
[1213] نكد الرجل: عسر حاله واشتدّ، والجمع أنكاد. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج2، ص545.
[1214] هكذا في الأصل، وفي ينابيع المودة (وزادا)، وفي مقتل أبي مخنف، (تعليق حسن الغفاري) ص145: (وآدا). والآد الأصلاب التي يرجعون إليها أو بمعنى القوة. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج2، ص443. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج3، ص76.
[1215] الزاد: أصله ما يتخذ من الطعام للسفر ثم أستعمل في أعم من ذلك، ومنه زاد الآخرة. اُنظر: الطريحي، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين: ج3، ص58، (زود).
[1216] اُنظر: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص110. اُنظر أيضاً: الحسيني، محمد بن أمير، شرح شافية أبي فراس: ص360 وفيه (خمسين رجلاً). المحلّاتي، ذبيح الله، فرسان الهيجاء: ج1، ص364ـ365، عن ناسخ التواريخ.
[1217] المعلا بن العلي ـ أو علي ـ الذهلي: ذكره في شرح الشافية وناسخ التواريخ في تعداد الشهداء وصاحب فرسان الهيجاء عن ناسخ التواريخ: أنّه قاتل قتال الأبطال حتى قتل منهم أربعاً وستّين شخصاً، ثم وقع في هوّة، فحملوا عليه يطعنونه برماحهم ويضربونه بسيوفهم حتى أثخنوه وأخذوه أسيراً لابن سعد. اُنظر: الحسيني، محمد بن أمير، شرح شافية أبي فراس: ص360. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج2، ص410. المحلّاتي، ذبيح الله، فرسان الهيجاء: ج2، ص160ـ161.
[1218] اُنظر أيضاً: الحسيني، محمد بن أمير، شرح شافية أبي فراس: ص360. وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (خمسين فارساً)، وفي ناسخ التواريخ (أربعة وستين)، كما تقدّم في ترجمته.
[1219] هكذا في الأصل، والصحيح (لله درك).
[1220] هكذا في الأصل، ولعلّه تصحيف (جوين). وهو: جون بن حوي أوحُوَيّ، أو جوين&. مولى أبي ذر الغفاري&، كان عبداً للفضل بن عباس بن عبد المطلب&،اشتراه أمير المؤمنين× ووهبه لأبي ذر الغفاري ليخدمه، وقد نُفِي مع أبي ذر الى الربذة، وبعد وفاته انضم إلى أمير المؤمنين×، ومن ثَم كان مع الإمام الحسن×، ثمّ الإمام الحسين×. وصَحِبه في مسيره من المدينة إلى مكة المكرّمة، ثمّ كربلاء. كان شيخاً كبيراً أسود اللون. دعا له الإمام الحسين× بعد استشهاده بقوله: «اللهم بيِّضْ وجهَه، وطيِّبْ ريحَه، واحشُـرْه مع الأبرار». ورد السلام عليه في الزيارة الرجبية. وقد خلط البعض بينه وبين الشهيد حوي بن مالك الضبعي& الذي كان مع ابن سعد ثم تحوّل لمعسكر الإمام الحسين×، وقُتِل في الحملة الأولى. اُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص251. المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص494. السماوي، محمد بن طاهر، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص176. الشاهرودي، علي النمازي، مستدرك سفينة البحار: ج2، ص138. شمس الدين، محمد مهدي، أنصار الحسين×: ص80.
[1221] هكذا في الأصل، والصحيح (أرجو... الموعدِ).
[1222] اُنظر أيضاً: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص196. ابن شهر آشوب، محمد ابن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص252. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص23. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج2، ص402.
[1223] هكذا في الأصل، والصحيح (رجلا ً). وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (خمسين رجلاً). وفي شرح شافية أبي فراس (عشرين رجلاً)، وفي أسرار الشهادات أنّ اسمه حرز وقد قتل من القوم ثلاثمائة مبارز. اُنظر: الحسيني، محمد بن أمير، شرح شافية أبي فراس: ص361. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص230، المجلس السابع.
[1224] عمر ـ أو عمرو ـ بن مطاوع أو مطاع الجعفي. وفي مقتل أبي مخنف: عمير: وعده ممّن ذكرهم الحسين× حين الاستنصار. لم يذكروه. ويعتقد البعض أنّه متحد مع زيد بن معقل الجعفي باعتبار أنّ المصادر ذكرت رجزاً واحداً لهما لما برز للقتال، وإن اختلفت ببعض الألفاظ. اُنظر: الكلبي، هشام بن محمد بن السائب، نسب معد واليمن الكبير: ج1، ص316. الطوسي، محمد ابن الحسن، الأبواب (رجال الطوسي) : ص101. الخوارزمي، أحمد بن محمد، مقتل الحسين×: ج2، ص22. الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم الرجال: ج6، ص115.
[1225] القراع: المُقارَعة: المضاربة بالسيوف، بأن يَقْرَعَ الأبطالُ بعضُهم بعضاً، أي يُضارِب بعضهم بعضاً بالسيوفِ في الحربِ. اُنظر: الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: ج11، ص367، (قرع).
[1226] هكذا في الأصل، والصحيح (ولم يزل يقاتل).
[1227] في أسرار الشهادات (خمسين فارساً).
[1228] اُنظر أيضاً: الحسيني، محمد بن أمير، شرح شافية أبي فراس: ص361 وفيه (محمد بن مطاع).
[1229] نقول: قد اختلف المؤرخون وأرباب المقاتل في هذا اختلافاً شديداً، فقد ذكر الطريحي اثنين باسم (وهب) يوم الطف أحدهما (وهب بن وهب) النصراني، وكانت أمّه معه. وأسلم على يد الإمام الحسين×، واستُشهِد معه في كربلاء. والآخر (وهب بن عبد الله الكلبي)، وذكره القندوزي باسم المعلا بن العلاء. وبعضهم قال غير ذلك، وهناك أيضاً اختلاف في المقطوعات الرجزية بحسب الروايات. اُنظر: لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج2، ص386. القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج3، ص72. الزنجاني، إبراهيم، وسيلة الدارين: ص201. الكرباسي، محمد صادق، دائرة المعارف الحسينية (ديوان القرن الاول) : ج1، ص59 وما بعدها.
[1230] عبل الذراعين، أي ضخمهما. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج5، ص1756، (عبل).
[1231] وقت الكرب: أراد به يوم الحساب عند يوم القيامة.
[1232] كذا في الأصل، والصحيح (نيّفاً وعشرين).
[1233] وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (أربعين)، وفي شرح شافية أبي فراس: (نيّفاً وعشرين راجلاً واثني عشر فارساً).
[1234] هكذا في الأصل، والصحيح (سبعون).
[1235] هكذا في الأصل، والصحيح (ضربوه).
[1236] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (واحتزُّوا).
[1237] لحا: قشّر، ولحاكم الله، أي أهلككم. وفي ناسخ التواريخ (الحكم الله...). اُنظر: ابن الأنباري، محمد بن القاسم، الزاهر في معاني كلمات الناس: ص405.
[1238] هكذا في الأصل، والصحيح (يا أمة).
[1239] بِيَعٌ: جمع (بِيعةُ) : وهي كَنِيسةُ النصارى. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج8، ص26، (بيع).
[1240] هكذا في الأصل، والصحيح (خيرٌ).
[1241] اُنظر أيضاً: الحسيني، محمد بن أمير، شرح شافية أبي فراس: ص361. وفي ينابيع المودة: (ثم برز المعلا بن العلا وهو يقول:
|
لا تنكروني
فأنا ابن الكلب |
ولم يزل يقاتل حتى قتل من القوم عشرين فارساً، وأصابت جسده سبعين طعنة ورمية، وصار جلده كالقنفذ، فاجتزوا رأسه ورموه نحو الحسين، فأخذته أمه وتقول: الحمد لله، قُتِلت يا ولدي بين يدي ابن رسول الله’. ثم قالت: يا أمة السوء أشهد أنّ اليهود والنصارى خير منكم). القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج3، ص72ـ73.
وفي ناسخ التواريخ: ج2، ص387: (ثم أُخِذ أسيراً فأُتِي به عمر بن سعد، فقال: ما أشدّ صولتك؟ ثم أمر فضرب عنقه، ورمي براسه إلى عسكر الحسين×، فأخذت أمّه الرأس فقبّلته، وقالت: الحمد لله الذي بيّض وجهي بشهادتك بين يدي أبي عبد الله. ثم قالت: الحكم لله، يا أمّة السوء، أشهد أنّ النصاري في بِيَعها والمجوس في كنائسها خيرٌ منكم. ثم رمت بالرأس إلى عسكر ابن سعد، فأصابت به صدر قاتله فقتله).
[1242] هكذا في الأصل، والصحيح (الطرماح) كما تقدّم.
[1243] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، وشرح شافية أبي فراس، وناسخ التواريخ، واللفظ للأول: (وبرز من بعده الطّرماح، وهو يقول:
|
أنا الطّرماح
شديد الضّـرب |
ثم حمل على القوم، ولم يزل يقاتل حتى قتل سبعين فارساً وكبا به جواده فأرداه إلى الأرض صريعاً، فأحاطت به القوم واحتزّوا رأسه). وفي إكسير العبادات في أسرار الشهادات: (وبرز الطرماح بن عدي، وهو يقول:
|
أنا الطرماح
أرميكم بصاعقة |
ثم حمل على القوم، ولم يزل يقاتل حتى قتل من القوم ثلاثين مبارزاً).
[1244] العلا بن حنظله الغفاري. لم نعثر على ترجمته.
[1245] هكذا في الأصل، ولعل العبارة (حتى الرمح فجعل يقاتل) زائدة.
[1246] كَلَّ: تعب وأَعْيا. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج11، ص591، (كلل).
[1247] كبا: إذا سقط. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج6، ص2471، (كبا).
[1248] في إكسير العبادات في أسرار الشهادات: (ثم برز المعلّى بن حنظلة الغفاري، وجعل يقاتل حتى انكسر رمحه في يده، فانتضى سيفه، وجعل يضاربهم حتى كلّ ساعده، وقتل منهم مقتلة عظيمة، فكبى به جواده، فرماه على وجهه إلى الأرض، فداروا به من كلّ جانب ومكان، وقتلوه ضرباً وطعناً، رحمة الله عليه).
[1249] عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب، أُمّه رقية بنت أمير المؤمنين علي×، من أصحاب الإمام الحسين×، له كلام ليلة عاشوراء ينم عن صلب إيمانه واستماتته في نصرة سيد الشهداء×، حيث قال ـ لمّا طلب الإمام× من أصحابه الانصراف ليلة عاشوراء ـ: يا بن رسول الله، ماذا يقول لنا الناس إن نحن خذلنا شيخنا، وكبيرنا، وسيّدنا، وابن سيّد الأعمام، وابن نبيّنا سيّد الأنبياء؟! لم نضرب معه بسيف، ولم نقاتل معه برمح؟! لا والله، أو نَرِد موردك، ونجعل أنفسنا دون نفسك، ودماءنا دون دمك، فإذا نحن فعلنا ذلك فقد قضينا ما علينا، وخرجنا ممّا لزمنا. استُشهد وعمره (26) سنة، ورد اسمه في زيارة الشهداء الواردة عن الناحية المقدّسة «السلام على القتيل بن القتيل: عبد الله بن مسلم بن عقيل، ولعن الله قاتله عامر بن صعصعة».. اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص220. الطوسي، محمد بن الحسن، الأبواب (رجال الطوسي) : ص103. المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص491.
[1250] هكذا في الأصل، والصحيح (فوقف).
[1251] هكذا في الأصل، والصحيح (كفى).
[1252] نقول: إنّ الّذين استشهدوا من بني عقيل مع سيّد الشهداء× هم: مسلم في الكوفة، وجعفر وعبد الرحمن ومحمد وعبد الله الأكبر وعلي وعون وموسى، أبناء عقيل، ومحمّد بن مسلم وعبد الله بن مسلم وجعفر بن محمّد بن عقيل ومحمّد بن أبي سعيد بن عقيل، فيكون المجموع اثني عشر. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص341، وص359. أبو الفرج، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص62. الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص220. الخوارزمي، أحمد بن محمد، مقتل الحسين×: ج2، ص53. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص254، وص259. العمري، علي بن محمد، المجدي في أنساب الطالبيين: ص18، وص307. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص62. الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج7، ص209. الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج18، ص370.
[1253] هكذا في الأصل، والصحيح (يا عم).
[1254] هكذا في الأصل، والصحيح (ألقى).
[1255] هكذا في الأصل، والصحيح (سلمتُ).
[1256] هكذا في الأصل، ولعلّ الصحيح (معكم).
[1257] هكذا في الأصل، والصحيح (بنو).
[1258] هكذا في الأصل، والصحيح (رهط).
[1259] في الفتوح والمناقب الرجز غير ما ذُكِر هنا، فقد قال ابن أعثم: (كان أول من خرج منهم عبد الله ابن مسلم بن عقيل بن أبي طالب وهو يقول:
|
اليوم ألقى
مسلماً وهو أبي |
من هاشم السّادات أهل الحسب).
ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص110. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص254. ثم قال ابن شهر آشوب: (فقاتل حتى قتل ثمانية وتسعين رجلاً بثلاث حملات، ثم قتله عمرو بن صبيح الصيداوي وأسد بن مالك). وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، وإكسير العبادات في أسرار الشهادات: (وبرز عبد الله بن مسلم ابن عقیل×، ووقف بإزاء الحسين وقال: يا مولاي أتأذن لي بالبراز؟
فقال له الحسين: يا بني كفاك وأهلك القتل. فقال: یا عم بماذا ألقی جدّك محمداً’ وقد تركتُك؟ يا سيدي، والله لا كان ذلك أبداً، بل أُقتَلُ دونك حتى ألقى اللهَ بذلك. ثم برز الغلام، وحسر عن ذراعيه، وهو يرتجز ويقول:
|
نحن بنو هاشم
الكرام |
[1260] يقال له: أسيد بن مالك الحضرمي (لعنه الله). اُنظر: ابن نما الحلّي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص59.
[1261] اُنظر أيضاً: الدينوري، أحمد بن داوود، الأخبار الطوال: ص257. الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص31. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص74. ابن العديم، عمر بن أحمد، بغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2628.
وفي مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص165: (قال: ثم إنّ عمرو بن صبيح الصدائي رمى عبد الله بن مسلم بن عقيل بسهم، فوضع كفّه على جبهته فأخذ لا يستطيع أن يحرك كفّيه ثم انتحى له بسهم آخر ففلق قلبه، فاعتورهم الناس من كلّ جانب).
[1262] وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وأسرار الشهادات واللفظ للاول: (ثم حمل على القوم، ولم يزل يقاتل حتى قتل تسعين فارساً، ورماه ملعون بسهم فوقع في لبته، فخر صريعاً ينادي: وا ابتاه! وا انقطاع ظاهراه! فلمّا نظر الحسين إليه وقد صُرِع قال: اللهم اقتل قاتل آل عقيل، ثم قال: إنا لله وإنا اليه راجعون).
[1263] هكذا في الأصل وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته (انقطاع المنّه).
[1264] هكذا في الأصل، وهي زائدة.
[1265] هكذا في الأصل، والصحيح (واحداً).
[1266] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (ثمانين فارساً).
[1267] اُنظر أيضاً: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص200. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص74. النويري، أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص456. من دون ذكر الرجز قتله: (عبد الله بن قطبة الطائي). وفي مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص165: (فحمل عبد الله بن قطبة الطائي ثم النبهاني على عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فقتله). وفي أسرار الشهادات وناسخ التواريخ ص419، واللفظ للاول: (ثم خرج عون بن عبد الله بن جعفر وهو يقول:
|
إن تنكروني فأنا ابن جعفر شهيد صدق في
الجنان أزهر |
ثم قاتل حتى قتل من القوم ثلاثة فوارس وثمانية عشر راجلاً، ثم قتله عبد الله بن بطّة الطائي). الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص271، المجلس الثامن.
[1268] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (جابر بن عروة الغفاري)، والمعروف هوعبد الله بن عروة بن حراق الغفاري، وأخوه عبد الرحمن بن عروة بن حراق الغفاري، كانا من أشراف الكوفة، وشجعانها، وذوي الموالاة. كان جدّهما حراق من أصحاب أمير المؤمنين×، وممَّن حارب معه في حروبه الثلاث. قال أحدهما:
|
قد علمت حقّاً بنو غفار لنضـربنَّ معشـر الفجّار |
اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص337. ابن نما الحلي، محمد بن جعفر، مثير الأحزان: ص43. المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص493. السماوي، محمد بن طاهر، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص175.
[1269] هكذا في الأصل، والصحيح (شيخاً).
[1270] بدر اسم بئر مشهورة تقع بين مكة والمدينة المنورة فسُمِّيت المنطقة به. ومعركة بدر أو غزوة بدر الكبرى سُمِّيت بهذا الاسم نسبةً إلى تلك المنطقة. وقعت في السابع عشر من رمضان في العام الثاني من الهجرة بين المسلمين بقيادة رسول الإسلام محمد’، والكفار من قريش ومن حالفها من العرب وتُعد غزوةُ بدر أولَ معركةٍ من معارك الإسلام الفاصلة، وانتهت بانتصار المسلمين على قريش، وقُتِل أغلب القادة ومعهم سبعين رجلاً غير الأسرى. اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج2، ص11وما بعدها.
[1271] غزوة حُنين وقعت بعد فتح مكّة مباشرة، وذلك في السنة الثامنة للهجرة في منطقة حُنين، بين جيش المسلمين بقيادة النبي الأكرم’ من جهة وبين المشركين من قبيلتي هوازِن وثقيف ـ الساكنين في منطقة الطائف ـ من جهة أخرى. حيث مالت كفّة الحرب في بدايتها لصالح المشركين بسبب الخطة التي اعتمدها المشركون وحضور المسلمين الجدد في المعركة، والتي كادت أن تعصف بجيش المسلمين وتنتهي بمقتل النبي الأكرم’، إلّا أنّ المسلمين أعادوا تنظيم صفوفهم ورجعوا مرّة أخرى إلى المعركة بقوّة ليكون النصر حليفاً لهم في نهاية المطاف، مستولين على كثير من الغنائم والأسرى. اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج2، ص149 وما بعدها.
[1272] هكذا في الأصل، والصحيح (الحسين).
[1273] هكذا في الأصل، والصحيح (بنو)، وكذا في الموردين اللذين بعده.
[1274] هكذا في الأصل، والصحيح (خندف) و«خندف: في الأصل لقب ليلى بنت عمران بن إلحاف ابن قضاعة، سُمِّيت بها القبيلة». ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج2، ص82، (خندف)
[1275] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (ثمانين فارساً)، وفي المناقب: (ثمانية وستين رجلاً). وفي ينابيع المودة: (خمسة وعشرين فارساً).
[1276] اُنظر أيضاً: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص106. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص251، وفيهما (قرة بن أبي قرة الغفاري). القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج3، ص74. وفيه (عروة الغفاري).
[1277] مالك بن داوود، وفي نفس المهموم: مالك بن دودان. ذكره في شرح الشافية، وذكر أنّه قتل خمسة عشر رجلاً، وفي ناسخ التواريخ أنّه قتل ستّين فارساً، وكذا في فرسان الهيجاء. اُنظر: الحسيني، محمد بن أمير، شرح شافية أبي فراس: ص362. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج2، ص412. المحلّاتي، ذبيح الله، فرسان الهيجاء: ج2، ص74. القمي، عباس، نفس المهموم: ص266.
[1278] هكذا في الأصل، والصحيح (أنشد).
[1279] هكذا في الأصل، والصحيح (إليكمُ).
[1280] هكذا في الأصل، والصحيح (فتىً)
[1281] هكذا في الأصل، والصحيح (يرجو).
[1282] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (ستّين فارساً)، وفي أسرار الشهادات (خمسين مبارزاً).
[1283] موسى بن عقيل بن أبي طالب^ أُمّه أُمّ البنين بنت أبي بكر بن كلاب العامري. إلّا أنّ المحقق التستري& شكّك في ذلك؛ لأنّه لم يُذكَر في كتب الأنساب والتاريخ لعقيل ولد مسمّى بموسى، فضلاً عن كونه من شهداء الطفّ. اُنظر: الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج5، ص255ـج8، ص23. التستري، محمد تقي، قاموس الرجال: ج10، ص288.
[1284] الكهول: جمع كهل، وهو من جاوز الثلاثين وخطّه الشيب، وقيل: من جاوز الأربعين. والشبان جمع شاب، وهو مَن كان في سن البلوغ إلى ما دون سن الثلاثين. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج5، ص1813، (كهل). وج1، ص151. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير: ج2، ص543. الطريحي، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين: ج2، ص85. (شبب).
[1285] هكذا في الأصل، والصحيح (دونكمُ).
[1286] السنان: نصل الرمح. الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط: ج4، ص238، (سنن).
[1287] هكذا في الأصل، والصحيح (الغفران).
[1289] وفي إكسير العبادات في أسرار الشهادات: (وبرز موسى بن عقيل أخو مسلم بن عقيل، وأنشأ يقول:
|
إليكم معشـر
الكفّار ضرباً |
قال: ولم يزل يقاتل حتى قتل من القوم خمسين مبارزاً). الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص228، المجلس السابع.
[1290] هكذا في الأصل، والصحيح (عشرين)، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (سبعين فارساً).
[1291] اُنظر أيضاً: القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة لذوي القربى: ج3، ص74، وفيه أنّه قتل ستين فارساً.
[1292] هكذا في الأصل، والصحيح (بعده).
[1293] أحمد بن محمد الهاشمي ذكره ابن شهر آشوب، ولعلّه متحد مع أحمد بن محمد بن عقيل. وقد ذكره ناسخ التواريخ وذكر رجزه وأنّه قتل ثمانين رجلاً. اُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص254. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج2، ص419. المحلّاتي، ذبيح الله، فرسان الهيجاء: ج1، ص55.
[1294] هكذا في الأصل، والصحيح (أبلو).
[1295] هكذا في الأصل، والصحيح (الورى).
[1296] هكذا في الأصل، والصحيح (الهدى).
[1297] وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته:
|
(اليوم أتلو
حسبي وديني |
[1298] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (ثمانين فارساً).
[1299] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص108ـ117.
[1300] هكذا في الأصل، والصحيح (فبكى وجعل).
[1301] هكذا في الأصل، والصحيح (وا محمداه).
[1302] هكذا في الأصل، والصحيح (وا أبتاه).
[1303] هكذا في الأصل، والصحيح (وا جعفراه).
[1304] هكذا في الأصل، ولعلّ الصحيح في العبارة (وا عمّاه! وا جعفراه! وا حمزتاه! وا أخاه! وا عباساه).
[1305] هكذا في الأصل، والصحيح (أما).
[1306] هكذا في الأصل، والصحيح (يعيننا).
[1307] اُنظر أيضاً: القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج3، ص75.
[1308] هكذا في الأصل، والصحيح (مفخراً).
[1309] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (بنا بيّن الله الهدى عن ضلالة)، وفي أسرار الشهادات (بنا ظهر الإسلام بعد خموده).
[1310] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص118. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص116ـ117. الطبرسي، أحمد بن عليّ، الاحتجاج: ج2، ص26. ابن شهر آشوب، محمد بن عليّ، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص234. الشافعي، محمد ابن طلحة، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول|: ص384. وفي ينابيع المودة زاد على هذه الأبيات:
|
(بنا بيّن الله
الهدى عن ضلاله |
[1311] وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (على ابن أخيه قرّة).
[1312] مرّة أو قُرَّة بن قيس الحنظلي التميمي، كان في جيش عمر بن سعد في واقعة كربلاء، ومن رواة أحداثها. نقل قصة انضمام الحر إلى الإمام الحسين× ووَصَف مشهد سبايا أهل البيت الأليم ومرورهن بأجساد الشهداء، وكذلك رثاء زينب بنت علي× ونَدبها للحسين×. أوشك قرة على الالتحاق بالحسين× بحسب خبره مع الحرّ، وكذلك مع حبيب بن مظاهر حين قام قرة بإيصال رسالة ابن سعد إلى الحسين× فاستغرب حبيب حضور مثله في جيش عمر بن سعد وهو يعرفه بحسن الرأي، إلّا أنّ قرة كانت عاقبته عدم نصرة الإمام الحسين× وكُتِب في زمرة المخالفين. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص311، وص325، وص348. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص87. السّماويّ، محمد بن طاهر، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص103.
[1313] هكذا في الأصل، والصحيح (ألا تنظر إلى الحسين)
[1314] هكذا في الأصل، والصحيح (فلعلّنا).
[1315] هكذا في الأصل، والصحيح (لا حاجة).
[1316] جاء في تاريخ الطبري: (قال: ثمَّ إنَّ الحرَّ بن يزيد لمَّا زحف عمر بن سعد إلى الحسين، أتى عمر ابن سعد فقال له: أصلحك الله! أمقاتل أنت هذا الرُّجل؟ قال: إي والله، قتالاً أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي. قال: أفما لكم في واحدة من الخصال التي عرض عليكم رضى؟ قال عمر بن سعد: أما والله لو كان الأمر إليَّ لفعلتُ، ولكنَّ أميرك قد أبى ذلك. قال: فأقبل حتَّى وقف النَّاس موقفاً، ومعه رجل من قومه يقال له قرَّة بن قيس، فقال: يا قرة! هل سقيت فرسك اليوم؟ قال: لا. قال: أفما تريد أن تسقيَه؟ قال: فظننتُ ـ والله ـ أنّه يريد أن يتنحَّى فلا يشهد القتال، وكره أن أراه حين صنع ذلك، فيخاف أن أرفعه عليه، فقلتُ له: لم أسقه وأنا منطلق فساقيه. قال: فاعتزلتُ ذلك المكان الذي كان فيه. قال: فوالله لو أنّه يُطلعني على الذي يريد لخرجتُ معه إلى الحسين. قال: فأخذ يدنو من حسين قليلاً قليلاً... قال: إنّي والله أُخيِّر نفسي بين الجنَّة والنَّار، ووالله لا أختار على الجنَّة شيئاً ولو قُطّعتُ وحُرّقتُ، قال ثمَّ ضرب فرسه فلحِق بحسين×). الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص325.
[1317] هكذا في الأصل، والصحيح (ولا).
[1318] هكذا في الأصل، والصحيح (محمداً).
[1319] هكذا في الأصل، والصحيح (ولده).
[1320] هكذا في الأصل، والصحيح (جبلان).
[1321] هكذا في الأصل، والصحيح (يقاتلان).
[1322] هكذا في الأصل، والصحيح (مواسيك).
[1323] جاء في تاريخ الطبري: (فقال له: جعلني الله فداك يا ابن رسول الله! أنا صاحبك الذي حبستُك عن الرُّجوع، وسايرتُك في الطَّريق، وجَعْجَعتُ بك في هذا المكان. والله الذي لا إله إلاَّ هو ما ظننتُ أنَّ القوم يردُّون عليك ما عرضتَ عليهم أبداً، ولا يبلغون منك هذه المنزلة. فقلتُ في نفسي لا أبالي أن أطيع القوم في بعض أمرهم، ولا يرون أنّي خرجتُ من طاعتهم، وأمَّا هم فسيقبلون من حسين هذه الخصال التي يعرض عليهم. ووالله لو ظننتُ أنّهم لا يقبلونها منك ما ركبتُها منك، وإنّي قد جئتُك تائباً ممَّا كان منّي إلى ربي، ومواسياً لك بنفسي حتَّى أموت بين يديك، أفترى ذلك لي توبة؟ قال: نعم، يتوب الله عليك، ويغفر لك، ما اسمك؟ قال: أنا الحرُّ بن يزيد، قال: أنت الحرُّ كما سمتك أمُّك، أنت الحرُّ إن شاء الله في الدُّنيا والآخرة، انزل، قال: أنا لك فارساً خيرٌ منّي راجلاً، أقاتلهم عَلى فرسي ساعة، وإلى النُّزول ما يصير آخر أمري. قال الحسين: فاصنع يرحمك الله ما بدا لك). الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص325.
[1324] يقال اسمه بكير بن الحر، وفي ناسخ التواريخ (عليّ). عُرِف بالبسالة والشجاعة. حمل على العدو حملة منكرة حتى قتل منهم سبعين رجلاً، ثم استُشهد بين يدي الإمام الحسين×، فسُرَّ الحر بشهادة ولده سروراً عظيماً، فلمّا وقف الحر على جثمان ولده، قال: الحمد لله الذي ختم لك بالشهادة بين يدي الإمام×. اُنظر: المحلّاتي، ذبيح الله، فرسان الهيجاء: ج1، ص75.
[1325] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (سبعين فارساً).
[1326] اُنظر أيضاً: الحسيني، محمد بن أمير، شرح شافية أبي فراس: ص360.
[1327] المعروف بين المؤرخين أنّ هذه الأبيات منسوبة إلى عبيد الله بن الحر الجعفي، قالها على مصرع شهداء كربلاء، وقد رواها البعض باختلاف في بعض الألفاظ. اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج37، ص420ـ421. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص288ـ289. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص229. البغدادي، عبد القادر بن عمر، خزانة الأدب: ج2، ص141.
[1328] هكذا في الأصل، والصحيح (قد نصرتُه).
[1329] الجحفل: الجيش الكثير. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج11، ص102، (جحفل).
[1330] هكذا في الأصل، والصحيح (فئة).
[1331] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (زرتكم بكتائب).
[1332] هكذا في الأصل، والصحيح (زحوف)، وهو جمع زحف وهو الجيش الكثير يزحف إلى العدو.
[1333] الدَّيلَم أو الديالمة: جيل سمّوا بأرضهم، وهم أحد الشعوب الإيرانية التي عاشت في شمال الهضبة الإيرانية قرب جبال جيلان. يتحدّثون لغة من فروع اللغات الإيرانية الشمالية الغربية. أسلموا مبكراً، وحسُن إسلامهم، وشاركوا مع المسلمين العرب في قتال الفرس. توجد العديد من النظريات حول ما انتهى به أبناء هذا الشعب، قيل بأن شعب الجيلانين هم أحفاد شعب الديلم حيث إنّ الإيرانين يسمون الجيلانين الديلمي. اُنظر: البغدادي، عبد المؤمن بن عبد الحق، مراصد الاطّلاع: ص581. الكرباسي، دائرة المعارف الحسينية (ديوان القرن الاول) : ج2، ص238. الموسوعة الحرة ويكيبيديا.
[1334] هكذا في الأصل، والصحيح (أكن قد)
[1335] هكذا في الأصل، والصحيح (ما أن).
[1336] هكذا في الأصل، والصحيح (سقى)
[1337] هكذا في الأصل، والصحيح (تآزروا) وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (توازروا). وآزره على الأمر: عاونه وقوّاه. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج4، ص17، (أزر).
[1338] هكذا في الأصل، والصحيح (الحشا ينفض والعين ساجمه). وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وناسخ التواريخ: (ينفتّ). وسجم الدمع: أي سال قليلاً أو كثيراً وانصب. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج5، ص1947، (سجم).
[1339] هكذا في الأصل، والصحيح (الوغى).
[1340] في ناسخ التواريخ (سراعاً إلى الهيجا ليوث ضراغمه) والهيجا: الحرب. يجوز فيها المدّ والقصر. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج1، ص352، (هيج). ضراغمة: مفردها ضرغام، وهو الأسد. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج5، ص1972، (ضرغم). وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته نقل الأبيات بشكل آخر: قال: (فبرز الحر وهو يقول:
|
أکون أمیراً غادراً وابن غادر فکاد الحشی ینفت والعین ساجمة لعمري لقد
کانوا مصاليت في الوغی سراعاً إلى الهيجا ليوث ضراغمه تواسوا علی
نصـر ابن بنت نبيّهم بأسیافهم أساد خیل قشاعمه |
[1341] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (فقتل رجالاً، ونكّس أبطالاً، حتى قتل مائة فارس)، وفي شرح شافية أبي فراس: ص360 (مائة رجل).
[1342] هكذا في الأصل، والصحيح (قوم).
[1343] شرع الشيء: رفعه جداً، والشارع: الطريق النافذ الذي يسلكه جميع الناس. وهو كناية عن بقاء الدين رغم ما ارتكبه الظلمة والطغاة. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج8، ص176، 178(شرع).
[1344] في أسرار الشهادات زاد بيتاً علي ما ذكره المؤلف:
|
(عجبتُ لقوم أسخطوا الله ربَّهم وأرضوا يزيداً ذا الخنا والبدائع). |
[1345] هكذا في الأصل، والصحيح (جاءكم عدوتم).
[1346] هكذا في الأصل، والصحيح (تشربه) أو (تشرب منه).
[1347] هكذا في الأصل، والصحيح (فبئس).
[1348] هكذا في الأصل، والصحيح (الظمأ).
[1349] اُنظر أيضاً: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص189. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص325ـ326. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص100ـ101. الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج1، ص460ـ461. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص64. العاملي، يوسف بن حاتم، الدرّ النظيم: ص553ـ554.
[1350] غشيه بالسوط: ضربه. الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط: ج4، ص370، (غشي).
[1351] هكذا في الأصل وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (لم يخف من حيف).
[1352] هكذا في الأصل، والصحيح (الخيف). وهو ما ارتفع عن موضع مجرى المسيل. وخيف موضع في مكة بمنى الذي ينسب إليه مسجد الخيف. اُنظر: البغدادي، عبد المؤمن بن عبد الحق، مراصد الاطّلاع: ج1، ص495.
[1353] هكذا في الأصل، والصحيح (مقري). والقرى هو الكرم والضيافة. اُنظر: الجوهري، إسماعيل ابن حماد، الصحاح: ج6، ص2461، (قرا).
[1354] في ناسخ التاريخ:
|
أضرب في أعناقكم بالسيف |
وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وأسرار الشهادات، واللفظ للأول:
|
إنّي أنا الحر ومأوى الضیف |
ثم يضيف صاحب إكسير العبادات في أسرار الشهادات:
|
(ابن علي الطهر المقري الضيف |
[1355] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (نيفاً وثمانين فارساً).
[1356] هكذا في الأصل، والصحيح (رموا به). وفي مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص147، (قال: وأخذ الحر يرتجز ويقول:
|
آليتُ لا
أُقتَلُ حتى أَقتُلا |
وأخذ يقول أيضاً:
|
أضرب في أعراضهم بالسيف عن خير من حلّ مني والخيف |
فقاتل هو وزهير بن القين قتالاً شديداً، فكان إذا شدّ أحدهما فإن استلحم شدّ الآخر حتى يخلّصه، ففعلا ذلك ساعة. ثم إنّ رجالة شدّت على الحر بن يزيد فقُتِل).
في ناسخ التواريخ: (وعقروا فرسه فقاتل راجلاً حتى صُرِع فاحتمله أصحاب الحسين× حتى وضعوه بين يدي الحسين×، وبه رمق). لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج2، ص381. وفي أسرار الشهادات: (قال فضرب فيهم في السيف حتى تكاثروا عليه. وشرك في قتله رجل اسمه مسرخ ورجل من فرسان أهل الكوفة، فقتلوه واحتزوا راسه، ورموا به إلى عسكر الحسين×، فأخذه الإمام× ووضعه في حجره). الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص211.
[1357] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (وجعل يمسح الدم عن وجهه وثناياه).
[1358] هكذا في الأصل، والصحيح (أخطأت).
[1359] هكذا في الأصل، والصحيح أنّ كلمة (أمّك) زائدة.
[1360] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، وناسخ التواريخ، وأسرا ر الشهادة (الحر حر بني الرياح).
[1361] هكذا في الأصل، والصحيح (ناجى).
[1362] هكذا في الأصل، والصحيح (رهج) كما في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، وهو الغبار؛ كناية عن الحرب. اُنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج3، ص389، (رهج).
[1363] الصفاح: مفرده الصفيحة وهو السيف العريض. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج2، ص513، (صفح)
[1364] هكذا في الأصل، والصحيح (الأُلى).
[1365] اُنظر أيضاً: الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص219. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج2، ص384.
[1366] مُسعِد: من أسعده يُسعِده، بمعنى أعانه. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج2، ص487، (سعد).
[1367] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (قال: فنظر الحسين يميناً وشمالاً، فلم ير له ناصراً ولا معيناً، فجعل ينادي: واغربتاه! واعطشاه! واقلة ناصراه! أما من معين یعیننا؟ أما من ناصر ینصرنا؟ أما من مجیر يجیرنا؟ أما من محامي يحامي عن حرم رسول الله’؟
[1368] أحمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب^. ذكره ابن شهر آشوب وغيره في جملة أولاد الإمام الحسن×، ولم نجد مَن صرّح به في عداد شهداء كربلاء غير رواية أبي مخنف المتقدّمة. وذكر بعض المعاصرين أنّه خرج مع عمّه الحسين× هو وأمّه ـ أم بشر بنت أبي مسعود الأنصاري ـ، وأخوه القاسم وأختاه أم الحسن وأم الخير. مع أنّ المذكور أنّ أولاد الحسن× من أم بشير بنت أبي مسعود الخزرجية هم زيد وأم الحسن وأم الحسين، ولم يذكروا معهم أحمد. اُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص192. ابن الصباغ، علي بن محمد، الفصول المهمة في معرفة الأئمة: ج2، ص745. الزنجاني، إبراهيم، وسيلة الدارين: ص247. الأمين، محسن بن عبد الكريم، أعيان الشيعة: ج3، ص216.
[1369] هكذا في الأصل، والصحيح (القاسم)، كما سيأتي من المؤلف. وقد تقدّمت ترجمته.
[1370] هكذا في الأصل، والصحيح (ولدا).
[1371] هكذا في الأصل، والصحيح (اُأْمرنا) أو (مُرنا).
[1372] هكذا في الأصل، والصحيح (تحاميان) أو (حاميا).
[1373] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (فقال لهما: احملا فحامیا عن حرم جدّکما، ما أبقی الدهر غیرَکما، بارك الله فیکما).
[1374] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (وله من العمر أربعة عشر سنة)، وفي ناسخ التواريخ عن أبي مخنف: (وكان شجاعاً، قويَّ القلب، سمح الطبع، صبيح الوجه، لم يُرَ مثله في جماله).
[1375] هكذا في الأصل، والصحيح (حمل على القوم).
[1376] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (سبعين فارساً).
[1377] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (ملعون).
[1378] هكذا في الأصل، والصحيح (فبكى)، وكذا في المورد التالي.
[1379] الشِيَع: الفرق، أي يجعلكم فرقاً مختلفين. ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج2، ص520، (شيع).
[1380] الطرائق: الطبقات بعضها فوق بعض والفرق المختلفة الأهواء. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص556، (طرق).
[1381] قدداً: أي فرقاً. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج2، ص522، (قدد).
[1382] هكذا في الأصل، والصحيح (لا ترض). وفي بعض المصادر (ولا ترضِ الولاة عنهم). ابن سعد، محمد، ترجمة الإمام الحسين× (من الطبقات الكبرى): ص73. ابن أعثم الكوفي، الفتوح: ج5، ص114. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص111. الأمين، محسن، لواعج الأشجان: ص169. إلّا أنّ الطبري نقل عن حُميد بن مسلم دعاء الإمام الحسين× هذا لمّا بقي وحيداً، بينما رواه ابن أعثم لمّا تقدّم عليّ الأكبر× للقتال. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4 ص344. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص114.
[1383] بحسب رواية الطبري، قال الإمام هذا الكلام بعد شهادة عبد الله الرضيع، قال: عن عقبة بن بشير الأسدي، قال لي أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين: (إنّ لنا فيكم ـ يا بنى أسد ـ دماً. قال قلت: فما ذنبي أنا في ذلك رحمك الله يا أبا جعفر؟! وما ذلك؟ قال: أُتِيَ الحسين بصبيٍ له، فهو في حِجره، إذ رماه أحدكم يا بني أسد بسهمٍ فذبحه، فتلقَّى الحسين دمه، فلمَّا ملأ كفيه صبَّه في الأرض ثمَّ قال: ربِّ إنْ تكُ حبستَ عنَّا النَّصر من السَّماء، فاجعل ذلك لما هو خير، وانتقم لنا من هؤلاء الظَّالمين). الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص342. واُنظر أيضاً: الدينوري، أحمد بن داوود، الأخبار الطوال: ص258. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص108. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص75. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص203.
[1384] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (قلّ ناصره وكثر واتره).
[1385] هكذا في الأصل، والصحيح (راجعون).
[1386] هكذا في الأصل، والصحيح (القتلى).
[1387] اُنظر ايضاً: أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص58. القاضي المغربي، النعمان بن محمد، شرح الأخبار: ج3، ص179ـ180. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص107ـ108. ابن نما الحلي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص52. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص75. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص303، المجلس التاسع. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج2، ص423ـ424.
وفي مقتل أبي
مخنف (تعليق الغفاري) ص169، عن حميد بن مسلم (قال: خرج إلينا غلام كأنّ وجهه شقة
قمر، في يده السيف، عليه قميص وإزار ونعلان. قد انقطع شسع أحدهما، ما أنسى أنّها
اليسرى. فقال لي عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي، والله لأشدنّ عليه، فقلتُ له: سبحان
الله! وما تريد إلى ذلك؟ يكفيك قتل هؤلاء الذين تراهم قد احتولوهم (قد احتوشوه).
قال: فقال: والله، لأشدنّ عليه. فشدّ عليه فما ولّى حتى ضرب رأسه بالسيف، فوقع
الغلام لوجهه، فقال: يا عمّاه. قال: فجلى الحسين كما يجلي الصقر، ثم شدّ شدّة ليث
أغضب، فضرب عمراً (عمروا) بالسيف، فاتقاه بالساعد، فأطنّها من لدن المرفق، فصاح ثم
تنحّى عنه، وحملت خيلٌ لأهل الكوفة ليستنقذوا عمراً من حسين، فاستقبلت عمراً
بصدورها، فحرّكت حوافرها، وجالت الخيل بفرسانها عليه فتوطّأته حتى مات. وانجلت
الغبرة فإذا أنا بالحسين قائم على رأس الغلام، والغلام يفحص برجليه. وحسين يقول:
بُعداً لقوم قتلوك، ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدّك. ثم قال: عزّ ـ والله ـ
على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك ثم لا ينفعك. صوت
ـ والله ـ كثر واتره وقلّ ناصره. ثم
احتمله، فكأنّي أنظر إلى رجلي الغلام يخطان في الأرض، وقد وضع حسين صدره على صدره.
قال: فقلتُ في نفسي: ما يصنع به؟ فجاء به حتى ألقاه مع ابنه علي بن الحسين وقتلى
قد قُتِلت حوله من أهل بيته. فسألتُ عن الغلام، فقيل: هو القاسم بن الحسن بن علي
بن أبي طالب).
[1388] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (ستّة عشر سنة).
[1389] وقد ذكرت مثلها تقريباً منسوبة إلى علي الأكبر كما سيأتي، واُنظر: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص127.
[1390] هكذا في الأصل، والصحيح (أضربكم).
[1391] القَسْطَل: الغُبار الساطِع في الحرب. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج11، ص557، (قسطل).
[1392] هكذا في الأصل، والصحيح (أطعنكم).
[1393] في أسرار الشهادات: ج2، ص292، وناسخ التواريخ: ج2، ص425، واللفظ للاول: (وذكر جمع من أصحاب المقاتل: ثم برز أحمد بن الحسن ـ أخو القاسم ـ وله من العمر ستة عشر سنة، وهو يقول:
|
إنّي أنا نجل
الإمام ابن علي أضربكم بالسيف
حتى يلتوي |
[1394] هكذا في الأصل، والصحيح (غارت).
[1395] هكذا في الأصل، والصحيح (فنادى) كما في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته.
[1396] هكذا في الأصل، والصحيح (أتقوّى).
[1397] هكذا في الأصل، والصحيح (تلقى).
[1398] هكذا في الأصل، والصحيح (أبداً).
[1399] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وأسرار الشهادات وناسخ التواريخ (فالمُنى).
[1400] انكمش الرجل: أسرع، وهي كناية عن رغبته في الجهاد والشهادة. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج6، ص343، (كمش).
[1401] فحش: أي جاوز حدّه. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج3، ص1014، (فحش).
[1402] رعش: رجف وأخذته الرعدة. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص354، (رعش)
[1403] كذا رسمت في الأصل.
[1404] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وناسخ التواريخ: (خمسين فارساً).
[1405] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (عضب قطيع). والمهند الطبيع هو السيف المطبوع من حديد. اُنظر: الجوهري، أسماعيل بن حماد، الصحاح: ج2، ص557.
[1406] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وناسخ التواريخ: (ثم حمل على القوم فقتل منهم ستين فارساً).
[1407] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص117ـ127. الحسيني، محمد بن أمير، شرح شافية أبي فراس: ص369ـ370. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص303ـ304، المجلس التاسع. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ، ج2، ص425ـ426.
[1408] هكذا في الأصل، والصحيح (علي بن الحسين).
[1409] المعروف بين المؤرخين أنّ أول من برز من أهل بيت الحسين× هو علي بن الحسين الأكبر أو عبد الله بن مسلم بن عقيل، وقد اختلفت رواية أبي مخنف في ذلك ففي مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) وكذا بحسب نقل الطبري عنه أنّ أول قتيل هو الأكبر×، بينما بحسب الموجود في مقتل الحسين ومصرع أهل بيته فهو موافق لما ذكره ابن طاووس هنا من كون أول من تقدّم من بني هاشم هو غلامان للإمام الحسن×، ثم برز من بعدهما علي الأكبر×. اُنظر: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين(تحقيق الغفاري): ص164. الدينوري، أحمد بن داود، الأخبار الطوال: ص257. البلاذري، أحمد بن يحىي، أنساب الأشراف: ج3، ص200. الطبري، محمد ابن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص340. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص110. الصدوق، محمد بن علي، الامالي: ص225. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص107. النيسابوري، محمد بن الفتال، رواضة الواعظين: ص188.
[1410] يفلل: يثُلم. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج11، ص530، (فلل).
[1411] هكذا في الأصل، والصحيح (ظهر).
[1412] هكذا في الأصل، والصحيح (يا أبتاه) كما في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته.
[1413] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته (جدتي).
[1414] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (و برز من بعده علي بن الحسين وهو يقول:
|
أنا عليّ بن
الحسين بن علي |
أطعنكم بالرمح وسط القسطل
قال: وحمل على القوم المارقين، ولم يزل يقاتل حتى قتل مائة وثمانين فارساً، فكمن له ملعون، فضربه بعمود من حديد على اُم رأسه، فانجدل صريعاً إلى الأرض، واستوى جالساً وهو ينادي: يا أبتاه عليك منّي السلام، فهذا جدّي محمد’، وهذا أبي عليّ×، وهذه جدّتي فاطمة. وهم يقولون لك: العجل العجل. وهم مشتاقون إليك. وقضى نحبه).
[1415] هكذا في الأصل، والصحيح (صرخت).
[1416] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (قال: ثم دعى ببردة رسول الله’ فلبسها، وأفرغ على نفسه درعه الفاضل، وتعمّم بعمامته السحاب، وتقلد بسيفه ذي الفقار، واستوى على ظهر جواده...).
[1417] هكذا في الأصل، والصحيح (قوماً).
[1418] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (وجعل يمسح الدم والتراب عن وجهه، ويقول: يا بُنِي لعن الله قاتلك، ما أجرئهم على الله ورسوله. وهملت عيناه بالدموع حزناً لمصابه).
[1419] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (قال عمارة بن سلمان عن حميد بن مسلم لعنه الله).
[1420] هكذا في الأصل، والصحيح (ابنة).
[1421] هكذا في الأصل، والصحيح (ثم قال).
[1422] هكذا في الأصل، والصحيح (وريحان).
[1423] في إكسير العبادات في أسرار الشهادات: (أو ثمان).
[1424] أي دفعته. اُنظر: الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح: ص114.
[1425] هكذا في الأصل، والصحيح (فوقع).
[1426] لم نعثر له على ترجمة. ولعلّ صاحب هذا القول اشتبه عليه الأمر بسبب ما ورد في رواية الإمام الباقر× التي نقلناها قبل قليل عن عقبة بن بشير الأسدي من أنّه قال: قال لي أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين: إنّ لنا فيكم ـ يا بنى أسد ـ دماً. قال قلت: فما ذنبي أنا في ذلك رحمك الله يا أبا جعفر؟! وما ذلك؟ قال: أُتِيَ الحسين بصبيٍ له، فهو في حِجره، إذ رماه أحدكم يا بني أسد بسهمٍ فذبحه...، وجاء في مصرع أبي بكر بن الحسن÷ أنّ قاتله هو عبد الله بن عقبة. فمن المحتمل أنّ القائل أو الناسخ خلط بين الاسمين فتوهم أنّ قاتل عبد الله الرضيع هو عقبة.
ومن الواضح أنّ الراوي هو عقبة بن بشير الأسدي، وليس القاتل. وهو من أصحاب إمامنا السجاد والباقر÷. ولا ربط له بحوادث عاشوراء، وإنّما وجّه الإمام× الخطاب له ليشير إلى الجريمة التي ارتكبها بعض رجالات بني أسد، وهو حرملة بن كاهل الأسدي كما هو المذكور في كتب التاريخ. فلعلّ عدم الدقة في قراءة الرواية هو سبب الذهاب إلى هذا القول. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص201. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4 ص342. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص109. الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج12، ص165.
[1427] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته (قُديمه العامري)، ولم نجد له ترجمة.
[1428] هكذا في الأصل، والصحيح (الهواء). وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته (السماء).
[1429] هكذا في الأصل، والصحيح (أحداً).
[1430] القاع: المستوى من الأرض. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج3، ص1274، (قوع).
[1431] هكذا في الأصل، والصحيح (نادى).
[1432] في العبارة سقط، كما سيأتي نقله عن مقتل أبي مخنف.
[1433] هكذا في الأصل، والصحيح (فكيف لا يستسلم).
[1434] هكذا في الأصل، والصحيح (ردّنا).
[1435] نقول: المعروف والمشهور أنّ الإمام الحسين× قال هذه الأبيات في طريقه إلى العراق، وقيل عند ملاقاته الفرزدق الشاعر في الطريق. اُنظر: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص72. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص246. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص45. الإربلي، علي بن أبي الفتح، كشف الغمّة في معرفة الأئمّة: ج2، ص238. الشافعي، محمد بن طلحة، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول|: ص390. ابن الصباغ، علي بن محمد، الفصول المهمة في معرفة الأئمة: ج2، ص774.
نعم ذكر القندوزي أنّ الإمام الحسين× يوم عاشوراء بعدما أقحم فرسه في الماء واغترف الماء ليشرب، صاح بعضهم: يا حسين أدرك خيمة النساء فإنّها هُتِكت، فرمى الماء وأسرع نحو خيامه فوجدها سالمة، عند ذلك قال هذه الأبيات. اُنظر: القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج3، ص81.
[1436] هكذا في الأصل، والصحيح كما هو المشهور (فان تكن الدنيا تعد نفيسة).
[1437] هكذا في الأصل، والصحيح (فقلة).
[1438] هكذا في الأصل، والصحيح (المرء).
[1439] هكذا في الأصل، والصحيح (أُنشِئت).
[1440] هكذا في الأصل، والصحيح كما هو المشهور (أفضل).
[1441] هكذا في الأصل، والصحيح (عنكمُ).
[1442] هكذا في الأصل، والصحيح (فناءنا).
[1443] هكذا في الأصل، والصحيح (ويرجو).
[1444] هكذا في الأصل، والصحيح (الإله).
[1445] اُنظر أيضاً: القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج3، ص81. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص11.
[1446] هكذا في الأصل، والصحيح (فقلبها).
[1447] هكذا في الأصل، والصحيح (خلقاً كثيراً).
[1448] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (ثلاث فرق: فرقة بالنبال والسهام، وفرقة بالسيوف والرماح، وفرقة بالنار والحجارة؛ ونعجل عليه).
[1449] هكذا في الأصل، والصحيح (وجعلوا).
[1450] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري): ص190ـ192. وفيه تفاصيل كثيرة لم تُذكر هنا. الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص463. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص14، المجلس الثالث عشر. وص58، المجلس الرابع عشر. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج2، ص454.
[1451] هكذا في الأصل، والصحيح (خولي).
[1452] اللّبَّة: موضعُ الذَّبْح. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج1، ص734، (لبب).
[1453] أرداه عن فرسه: أسقطه. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص340، (ردى).
[1454] خار الرجل يخور: ضعف. الطريحي، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين: ج3، ص293، (خور).
[1455] اُنظر أيضاً: الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص463.
[1456] «المِفرَق: وسط الرأس، وهو الذي يفرق فيه الشعر». الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج4، ص1541، (فرق).
[1457] الشجّ: الجرح في الرأس خاصة. اُنظر: ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج2، ص445، (شجج).
[1458] البيضاء هي البَيْضة: وهي الخُوذةَ التي يلبسها المقاتل على رأسه وهي من السلاح. سُمِّيت بذلك لأنّها على شكل بَيْضة النعام. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج7 ص125، (بيض)
[1459] هكذا في الأصل، والصحيح (مضى).
[1460] هكذا في الأصل، والصحيح (لا).
[1461] الصحيح أنّ الثانية زائدة.
[1462] حادت: مالت وعدلت عن الهدف. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج2، ص467، (حدد).
[1463] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص140ـ142. الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص463ـ464. الحسيني، محمد بن أمير، شرح شافية أبي فراس: ص375. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج2، ص454ـ455.
[1464] في الأصل سقط، والمراد (الأرض).
[1465] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (أربعون رجلاً کل منهم یرید حزّ نحره).
[1466] هكذا في الأصل، والمعروف (شبث) كما تقدّم في ترجمته.
[1467] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وأسرار الشهادات، واللفظ للأول: (وبیده السيف فدنا منه ليحتزّ رأسه فرمقه الحسين بطرفه).
[1468] هكذا في الأصل، والصحيح (فرمى).
[1469] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وأسرار الشهادات، واللفظ للأول: (وهو يقول: ويحك یا بن سعد! ترید أن تکون بریئاً من قتل الحسین× وإهراق دمه، وأکون أنا مطالب به! معاذ الله أن ألقی الله بدمک یا حسین).
وفي مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص200: (قال: ولقد مكث طويلاً من النهار، ولو شاء الناس أن يقتلوه لفعلوا، ولكنّهم كان يتقّى بعضهم ببعض، ويحب هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء. قال: فنادى شمر في الناس: ويحكم ماذا تنظرون بالرجل؟! اقتلوه ثكلتكم أمهاتكم. قال: فحُمِل عليه من كلّ جانب، فضُرِبت كفّه اليسرى ضربة؛ ضربها زرعة بن شريك التميمي، وضُرِب على عاتقه، ثم انصرفوا وهو ينوء ويكبو. قال: وحمل عليه في تلك الحال سنان بن أنس ابن عمرو النخعي فطعنه بالرمح فوقع، ثم قال لخولي بن يزيد الأصبحي: احتز رأسه، فأراد أن يفعل فضعف وأرعد، فقال له سنان بن أنس: فتّ الله عضُديك وأبان يديك، فنزل إليه فذبحه واحتزّ رأسه، ثم دفع إلى خولي بن يزيد. وقد ضُرِب قبل ذلك بالسيوف).
[1470] الكَوْسَجُ: النَّاقصُ الأسنان. الزبيديّ، محمد مرتضى، تاج العروس: ج3، ص467، (كوسج).
[1471] هكذا في الأصل، والمراد (أبشر).
[1472] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، وإكسير العبادات في أسرار الشهادات: (يا ويلك).
[1473] هكذا في الأصل، والصحيح (يعلو).
[1474] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، وأسرار الشهادات، واللفظ للأول: (فوالله ما أحد أحق منّي بدم الحسين× إنّي لأقتله سواء شبه المصطفى أو علي المرتضى، فأخذ السيف من يده، وركب صدر الحسين× فلم يرهب منه...).
[1475] في ناسخ التواريخ: (وركب صدر الحسين× فلم يرهب منه، وقال: لا تظنّ أنّي كمَن أتاك، فلستُ أردّ عن قتلك يا حسين).
[1476] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، وأسرار الشهادات، واللفظ للأول: (فقال له الحسين: مَن أنت ویلك؟ فلقد ارتقیتَ مرتقی صعباً، طالما قبّله النبيّ).
[1477] هكذا في الأصل، والصحيح (بلى).
[1478] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، وأسرار الشهادات، وناسخ التواريخ: (وجدتك خديجة الکبری).
[1479] الدانق: سدس الدرهم. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج4 ص1477، (دنق).
[1480] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وأسرار الشهادات وناسخ التواريخ واللفظ للأول: (فقال: هیهات هیهات والله ما تذوق الماء أو تذوق الموت غصة بعد غصة وجرعة بعد جرعة. ثم قال: يا بن أبي تراب ألستَ تزعم أنّ أباك على الحوض يسقي من أحبّ؟ اصبر قليلاً حتى يسقيك أبوك).
[1481] هكذا في الأصل والثانية زائدة.
[1482] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (شعر كشعر الخنزير)، وفي إكسير العبادات في أسرار الشهادات: (نقر كنقر الخنزير). وكذا في المورد التالي.
[1483] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (يحز) وفي إكسير العبادات في أسرار الشهادات: (يهبر).
[1484] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته:
|
(أقتُلُك
اليومَ ونفسـي تعلمُ |
وفي أسرار الشهادات وناسخ التواريخ زيادة على ذلك:
|
(أفيض دمك بالتراب بغصّة ولا لأولاد النبي أرحم). |
[1485] هكذا في الأصل، والصحيح (وا أبتاه).
[1486] هكذا في الأصل، والصحيح (وا غربتاه).
[1487] هكذا في الأصل، والصحيح (لم يرتع).
[1488] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (قال: وكُلّما قطع منه عضواً نادى الحسين×: وا محمداه! وا علياه! وا حسناه! وا جعفرا! وا حمزتاه! وا عقيلاه! وا عباساه! وا قتيلاه! وا قلّة ناصراه! واغُربتاه!).
[1489] هكذا في الأصل، والصحيح (نادى).
[1490] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (شُرِح).
[1491] هكذا في الأصل، والصحيح (أحدى وستين) كما هو المشهور عند علماء المسلمين.
[1492] اُنظر أيضاً: الحسيني، محمد بن أمير، شرح شافية أبي فراس: ص373. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج2، ص456ـ457.
[1493] هكذا في الأصل، والصحيح (يسلبونه).
[1494] هكذا في الأصل، والصحيح (قيس بن الأشعث بن قيس).
[1495] هكذا في الأصل، والصحيح (القتلى).
[1496] وفي المنتخب: (... وأخذ عمامته أحبش بن يزيد، وأخذ سيفه رجل من بني دارم...). وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (فأخذ سراويلَه أبحر بن كعب لعنه الله، وأخذ قميصَهُ الأشعث بن قيس لعنه الله، وأخذ سيفه رجل من بني وُهَيبَة، وأخذ تكّته الأسودُ بن ودّ لعنه الله، ومالُوا على سلب القتلى). وفي مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص200: (قال: وسلب الحسين ما كان عليه، فأخذ سراويله بحر بن كعب، أخذ قيس بن الأشعث قطيفته، وكانت من خزّ، وكان يسمى ـ بعدُ ـ قيس قطيفة، وأخذ نعليه رجل من بني أود يقال له الأسود، وأخذ سيفه رجل من بني نهشل بن دارم، فوقع بعد ذلك إلى أهل حبيب بن بديل. قال: ومال الناس على الورس والحلل والإبل وانتهبوها. قال: ومال الناس على نساء الحسين وثقله ومتاعه فإن كانت المرأة لَتُنازَع ثوبها عن ظهرها حتى تُغلَب عليه، فيذهب به منها). ثم قال: (قال: ثم إنّ عمر بن سعد نادى في أصحابه: مَن ينتدب للحسين ويوطئه فرسه؟ فانتدب عشرة، منهم إسحاق بن حياة الحضرمي، وهو الذي سلب قميص الحسين فبرص بعد، وأحبش بن مرثد بن علقمة بن سلامة الحضرمي. فأتوا فداسوا الحسين بخيولهم حتى رضوا ظهره وصدره، فبلغني أنّ أحبش بن مرثد بعد ذلك بزمان أتاه سهم غرب، وهو واقف في قتال ففلق قلبه فمات).
[1497] هكذا في الأصل، والصحيح (جثة).
[1498] هكذا في الأصل، والصحيح (سعد) كما تقدّم في ترجمته.
[1499] «الكدم: العض بأدنى الفم». الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج5، ص2019، (كدم).
[1500] هكذا في الأصل، والصحيح (أحد).
[1501] حفوا حوله: أي أطافوا به واستداروا. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج4، ص1345، (حفف).
[1502] وفي نور العين: (ثمّ إنّ جواد الحسين رضي الله عنه جعل يُهَمْهِم، ويتخطّى القتلى في المعركة قتيلاً بعد قتيل، حتى وقف على الجسد الشريف، فوجده بلا رأس، فجعل يدور حوله ويمرّغ ناصيته في دمه، فلمّا نظر إليه عمر بن سعد لعنه الله، قال للقوم: ويلكم، ايتوني به. فركبوا خلفه ـ وكان من جياد خيل رسول الله (صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم)، والأصحّ أنّه الميمون ـ فلمّا أحسّ الميمون بذلك جعل يمانع عن نفسه، ويلطم بفيه ويضرب برجليه حتى قتل منهم ستّة وعشرين فارساً وتسعةً من الخيل، فصاح عمر بن سعد: «ويلكم، اتركوه لأنظر ما يصنع». فبعدوا عنه، فلمّا رأى الناسَ تفرَّقت عنه أمنَ ورجع إلى الجسد الشريف، وجعل يمرّغ وجهه ويقبِّله بعينيه، ويصهل حتى ملأ البرية من صهيله. ثمّ قصد إلى خيمة النساء، فلمّا سمعن صهيله أقبلت زينب على سكينة، وقالت: «قد جاء الماء فاخرجن إليه لتشربن». فخرجت فوجدت السرج خالياً، والجواد يصهل وينعى، فصاحت: «وا قتيلاه وا غريباه وا حسيناه، هذا الحسين بين العدا مسلوب العمامة والردا، بدنه بالأرض ورأسه منقطعة، واليوم يصير ماله وعياله بين العدا، أوّاه من نار البلايا، غريباً لا يُرتجا، وجريحاً لا يُداوا»). الاسفرائيني، إبراهيم بن محمد، نور العين في مشهد الحسين×: ص29.
[1503] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص143ـ148. الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص465. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص3ـ4.
[1504] الضحاك بن عبد الله المشرقي، من رواة واقعة كربلاء، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام السجاد×. طلب منه الإمام الحسين× النصرة، فشرط على الإمام أن يدافع عنه ما دام الدفاع عنه نافعاً، فلمّا رأى خيل أصحابه تعقر أدخل فرسه في الفسطاط، وقاتل بين يدي الإمام مع الأصحاب، وقتل مجموعة من الأعداء، فلمّا رأى أنّ أصحاب الإمام قُتِلوا، ويئس من حياة الإمام الحسين× استأذن من الإمام× وهرب من المعركة. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص197. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص339. الطوسي، محمد بن الحسن، الأبواب (رجال الطوسي): ص116. الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج4، ص276ـ277.
[1505] هكذا في الأصل، والصحيح (فأتى).
[1506] «المَتْنُ: الظَّهْرُ، والجمع مُتونٌ». ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج13، ص398، (متن).
[1507] هكذا في الأصل، والظاهر أنّها زائدة.
[1508] هكذا في الأصل، والصحيح (وعشرون).
[1509] هكذا في الأصل، والصحيح (الزهراء).
[1510] «أساطين: جمع أسطوانة وهي العمود والسارية». مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص17، (سطن).
[1511] هكذا في الأصل، والصحيح (رخام) والرخام: «حجر أبيض رخو». الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج5، ص1930، (رخم).
[1512] هكذا في الأصل، والثانية زائدة.
[1513] هكذا في الأصل، والصحيح (الفئة).
[1514] «الشَّعْبُ: التَّفْريقُ». ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج1، ص497، (شعب).
[1515] هكذا في الأصل، والصحيح (أتى إلى).
[1516] هكذا في الأصل، والصحيح (آيس).
[1517] هكذا في الأصل، والصحيح (لا أبكى الله لك عيناً).
[1518] هكذا في الأصل، والصحيح (توقّفْ).
[1519] هكذا في الأصل، والصحيح (هذا).
[1520] هكذا في الأصل، والصحيح (بعده).
[1521] هكذا في الأصل، والصحيح (بإزاء الخباء).
[1522] ذكر صاحب الاحتجاج (ج2، ص25ـ26)، والفتوح (ج5، ص115) روايةً في ذلك، واللفظ للأول، حيث قال: (لمّا قُتِل أصحاب الحسين× وأقاربه، وبقي فريداً ليس معه إلّا ابنه عليٌّ زين العابدين×، وابنٌ آخر في الرضاع اسمه عبد الله، فتقدّم الحسين× إلى باب الخيمة، فقال: ناولوني ذلك الطفل حتى أودعه! فناولوه الصبيّ، جعل يقبله، وهو يقول: يا بني ويل لهؤلاء القوم إذا كان خصمهم محمد’، قيل: فإذا بسهم قد أقبل حتى وقع في لبة الصبي فقتله، فنزل الحسين عن فرسه، وحفر للصبي بجفن سيفه، ورمّله بدمه ودفنه، ثم وثب قائماً، وهو يقول:
|
كفر القوم
وقدماً رغبوا بجنود كوكوف الهاطلين لا لشـيء كان
مني قبل ذا غير فخري بضياء الفرقدين بعليّ الخير من
بعد النبي والنبي القرشي الوالدين خيرة الله من
الخلق أبي ثم أمي فأنا ابن الخيرتين فضة قد خُلِقت
من ذهب فأنا الفضة وابن الذهبين من له جدّ
كجدّي في الورى أو كشيخي فأنا ابن القمرين فاطمُ الزهراء
أمي وأبي قاصم الكفر ببدر وحنين عروة الدين
عليُّ المرتضـى هادم الجيش مصلي القبلتين وله في يوم أحد
وقعة شفت الغل بقبض العسكرين ثم بالأحزاب
والفتح معاً كان فيها حتف أهل القبلتين في سبيل الله
ماذا صنعت أمة السوء معاً بالعترتين عترة البر
التقي المصطفى وعلى القرم يوم الجحفلين عبدَ الله
غلاماً يافعاً وقريش يعبدون الوثنين وقلى الأوثانَ
لم يسجد لها مع قريش لا ولا طرفة عين طعن الأبطال
لمّا برزوا يوم بدر وتبوك وحنين |
[1523] هكذا في الأصل، والصحيح (الخيرتينِ).
[1524] هكذا في الأصل، والصحيح (وابن).
[1525] هكذا في الأصل، والصحيح (فاطمُ)
[1526] هكذا في الأصل، والصحيح (وحنين).
[1527] هكذا في الأصل، والصحيح (يعبدون).
[1528] هكذا في الأصل، والصحيح أن تكون في الشطر الأول.
[1529] هكذا في الأصل، والصحيح (بالحسنيين).
[1530] في الأصل الكلمة غير منقطة، ولكن أثبتنا ما هو الصحيح.
[1531] هكذا في الأصل، والصحيح (وابن القمرين).
[1532] هكذا في الأصل، والصحيح (وأبي).
[1533] هكذا في الأصل، والصحيح (بطل).
[1534] القَرْمُ من الرجال: السيد المعظم. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج12، ص473، (قرم).
[1535] الهِزْبْرُ والضَّيْغَم: من أسماء الأَسد. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج5، ص263، (هزبر). وج12، ص357، (ضغم).
[1536] «رجل ماجد: مفضال كثير الخير شريف». ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج4 ص298، (مجد)
[1537] هكذا في الأصل، والصحيح (مذ).
[1538] إشارة إلى يوم تصدّق أمير المؤمنين عليّ× بخاتمه، فنزل فيه قوله تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) المائدة: 55.
[1539] هكذا في الأصل، والصحيح (أردى جيوشاً).
[1540] هكذا في الأصل، والصحيح (يوم حنين).
[1541] هكذا في الأصل، والصحيح (بارزهم).
[1542] هكذا في الأصل، والصحيح (الصفان).
[1543] هكذا في الأصل، والصحيح (طيبوا).
[1544] هكذا في الأصل، والصحيح (ففضة).
[1545] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته ص95: (فغداً تسقون من حوض اللجين).
[1546] هكذا في الأصل، والصحيح (إنّنا).
[1547] هذه الرواية لم ترد في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته. نعم قريب منها في الاحتجاج كما تقدّم، وأيضاً ذكر الأبيات ابن شهر آشوب والفتال النيسابوري. اُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص233ـ234. الفتال النيسابوري، محمد ابن الحسن، روضة الواعظين: ص155. الشافعي، محمد بن طلحة، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول|: ص389ـ390. الإربلي، علي بن أبي الفتح، كشف الغمّة في معرفة الأئمّة: ج2، ص237. الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين في مشهد الحسين×: ص26. الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص452. القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج3، ص80ـ81، نقلاً عن أبي مخنف. وذكر الخوارزمي بعض منها في مقتله. ج2، ص37.
[1548] هكذا في الأصل، والصحيح (فأقلبها).
[1549] هكذا في الأصل، والصحيح (نيفاً وأربعين).
[1550] المعروف والمشهور أنّ هذه الأبيات قالها الإمام الحسين× عشية عاشوراء، فقد رُوِي عن الإمام علي بن الحسين× أنّه قال: بينما أنا جالس في تلك العشية التي قُتِل في صبيحتها أبي، وعندي عمتي زينب بنت علي÷ تمرضني إذا أعتزل أبي في خباء له وعنده فلان مولى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو يعالج سيفه ويصلحه وأبي يقول:...) وذكر الأبيات. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص185. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4 ص318ـ319. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص93. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص249. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4 ص58. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8 ص191. بينما ذكر آخرون يظهر منهم أنّه قالها قبل ذلك. اُنظر: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص84. ابن نما الحلّي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص35. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص49. القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج3، ص63.
[1551] هكذا في الأصل، والصحيح (النصر).
[1552] هكذا في الأصل، والصحيح (تبق).
[1553] ورد قريب من هذه الخطبة عن الإمام× بعد أن استُشهد القاسم بن الحسن×، حيث قال الإمام الحسين×: (اللهم أنت تعلم أنّهم دعونا لينصرونا فخذلونا وأعانوا علينا. اللهم احبس عنهم قطر السماء، واحرمهم بركاتك. اللهم لا ترض عنهم أبداً، اللهم إنّك إن كنتَ حبستَ عنّا النصر في الدنيا فاجعله لنا ذخراً في الآخرة، وانتقم لنا من القوم الظالمين). القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج3، ص77.
[1554] هكذا في الأصل، والصحيح (حملات).
[1555] هكذا في الأصل، والصحيح (المشرعة).
[1556] هكذا في الأصل، والصحيح (وأبي).
[1557] أبو الأعور الأسلمي، وفي بعض المصادر: (الأعور السلمي). لم نعثر على ترجمة له. ولم يذكره أحد في مَن شارك في كربلاء. نعم ذكر ابن شهر آشوب في المناقب أنّ الإمام الحسين× حمل على المشرعة، وكان عليها الأعور السلمي وعمرو بن الحجاج الزبيدي. اُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص215. البحراني، هاشم، مدينة المعاجز: ج3، ص505. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص51.
نقول: سيأتي من المؤلف ذكر أبو الأعور السلمي من قيادات الجيش الإسلامي في فتوحات الخلفاء، ومن أبرز قادة جيش معاوية في صفين، وسنذكر ترجمته هناك. إلّا أنّه من المستبعد جداً أن يكون متحداً مع المذكور هنا، بل هو مجرد تشابه اسمي بينهما؛ وذلك لعدة أمور، منها: 1. أنّ المؤرخين ينصّون على أنّ المذكور في صفين ممّن أدرك الجاهلية، بمعنى أنّه كان مميِّزاً قبل مجيء الإسلام، فيكون عمره في واقعة الطف يقرب من 80 سنة، فهو ممّن لا يشترك بحرب عادة إلّا لضرورة. 2. لو كان حاضراً مع جيش ابن سعد لكان من أصحاب المناصب والقيادة في الجيش، بل لكان هو قائد الجيش، لكونه أبرز من كان حاضراً في جيش ابن سعد، حيث كان قائداً مقرباً ومبرزاً في زمن معاوية. 3. لو حضر في كربلاء لم يخف مكانه، ولذكره جميع من أرّخ للمعركة، كما ذكروا ابن سعد وشمر وابني الأشعث وابن الحجاج وشبث وأمثالهم. اُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص215.
[1558] أَقْحَمَ فرسَه النهرَ: أدخَله. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج12، ص464، (قحم).
[1559] نَغَّصَ عليه: أَي قطع عليه. اُنظر: المصدر السابق: ج7 ص99، (نغص).
[1560] هكذا في الأصل، والصحيح (ذقتُ).
[1561] هكذا في الأصل، والصحيح (لئن).
[1562] هكذا في الأصل، والصحيح (يبق).
[1563] هكذا في الأصل، والصحيح (ونادى يا أبا).
[1564] هكذا في الأصل، والصحيح (فرمى).
[1565] هكذا في الأصل، والصحيح (أحد)، ونقل ابن شهر آشوب (ج3، ص215) عن أبي مخنف عن الجلودي أنّ الحسين حمل على الأعور السلمي وعمرو بن الحجاج الزبيدي، وكانا في أربعة آلاف رجل على الشريعة وأقحم الفرس على الفرات فلما أولع الفرس برأسه ليشرب قال×: أنت عطشان وأنا عطشان، والله لا أذوق الماء حتى تشرب، فلمّا سمع الفرس كلام الحسين شال رأسه، ولم يشرب؛ كأنّه فهم الكلام. فقال الحسين: اشرب فأنا أشرب، فمدّ الحسين يده فغرف من الماء، فقال فارس: يا أبا عبد الله تلذذ بشرب الماء وقد هتكت حرمتك؟! فنفض الماء من يده، وحمل على القوم فكشفهم فإذا الخيمة سالمة).
[1566] هكذا في الأصل.
[1567] تضمّخ بالدم: تلطخ به. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج1، ص426، (ضمخ).
[1568] هكذا في الأصل، والصحيح (رجلاً شديداً).
[1569] هكذا في الأصل، والظاهر أنّها بمعنى بَيّنٌ.
[1570] هكذا في الأصل، والصحيح (يدنو).
[1571] هكذا في الأصل، والصحيح (ما انتظاركم).
[1572] «الحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل». ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج1، ص436، (حمحم).
[1573] تَخَمَّرَتِ الْمَرْأَةُ: لَبِسَتِ الخِمَارَ، أي الحِجَابَ. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص255، (خمر).
[1574] هكذا في الأصل، والصحيح (فنظرت).
[1575] هكذا في الأصل، والصحيح (وا وحدتاه).
[1576] هكذا في الأصل، والصحيح (وا سوء).
[1577] ماطَ الشيءُ: ذهب. وأمَاطَتِ الْمَرْأةُ اللِّثَامَ عَنْ وَجْهِهَا: أزَالَتْهُ، أسْفَرَتْ. اُنظر: ابن منظور، محمد ابن مكرم، لسان العرب: ج7 ص410، (ميط).
[1578] وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، وأسرار الشهادات، وناسخ التواريخ في الأبيات زيادة عمّا ذكره المؤلف، حيث قال ـ واللفظ للأول ـ: (ثم بكت [سكينة] بكاء شديداً وأنشأت تقول:
|
مات الفخار
ومات الجود والكرم |
وفي شرح إحقاق الحقّ نسبها للسيدة زينب‘. اُنظر: الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص101، المجلس السادس عشر. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص4. المرعـشي، شهاب الدين، شرح إحقاق الحق: ج33، ص757.
[1579] يخترم: أي يهلك بأن يموت أو يقتل. الطريحي، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين: ج6، ص56، (خرم).
[1580] هكذا في الأصل، والصحيح (وأُبرِزنا).
[1581] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وناسخ التواريخ: (أمّ كلثوم). وفي أسرار الشهادات قال: (فلمّا سمعت زينب شعرها خرجت صارخة، وهي تنشد وتقول:...).
[1582] هكذا في الأصل، ولعلّه تصحيف (أسرفتُ)، وفي بعض المصادر (شرّفتُ)، كما سيأتي الإشارة إليها. وأَشْرَفَ الشيءُ: علا وارتفع. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج9، ص171، (شرف).
[1583] هكذا في الأصل، والصحيح (شخصٌ).
[1584] مبلبل من البَلْبلة، وهي شدَّة الهم والوَسْواس في الصدور وحديث النفس. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج11، ص69، (بلبل).
[1585] لم نجده عند غيره.
[1586] لحاه الله، أي قبّحه ولعنه. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج6، ص2481، (لحى).
[1587] هكذا في الأصل، والصحيح (الضيغم).
[1588] هكذا في الأصل، والصحيح (سارِ).
نقول: وردت الأبيات في بعض المصادر مع اختلاف في بعض ألفاظها:
|
مصيبتي فوق أن أرثي بأشعاري وكنتُ من قبل أرعى كلّ ذي جار أن لا يُجدَّل دون الضيغم الضاري |
أُنظر: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص150ـ151. وكذا راجع المصادر التي سنذكرها بعد قليل.
[1589] هكذا في الأصل، والصحيح (وا علياه).
[1590] هكذا في الأصل، والصحيح (وا حسيناه).
[1591] هكذا في الأصل، والصحيح (محمد).
[1592] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص150ـ151. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص102، المجلس السادس عشر. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص4. القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج3، ص85 ذكر منها ثلاثة أبيات. المرعـشي، شهاب الدين، شرح إحقاق الحق: ج33، ص757، لم يذكرها كاملة.
[1593] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وناسخ التواريخ: (أمّ كلثوم).
[1594] هكذا في الأصل وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (وجار) وفي غيره (أخنى). اُنظر: المرعـشي، شهاب الدين، شرح إحقاق الحق: ج33، ص757.
[1595] هكذا في الأصل، والصحيح (الإله).
[1596] هكذا في الأصل، والصحيح (رضوى).
[1597] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وأسرار الشهادات وناسخ التواريخ: (مغيب).
[1598] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وناسخ التواريخ: (ألوذ).
[1599] أُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص151ـ152. نسبها إلى أم كلثوم. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص103، المجلس السادس عشر. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص5. نسبها إلى أم كلثوم. القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج3، ص86، ذكر منها أربعة أبيات. والاسفرائيني في نور العين: ص33، نسبها إلى السيدة زينب الكبرى‘.
[1600] وفي مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، لأبي مخنف: (عبد الله بن قيس).
[1601] هكذا في الأصل، والصحيح (الفرات)، وكذا في بقية الموارد.
[1602] أُنظر أيضاً: الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص30. القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج3، ص86.
[1603] هكذا في الأصل، والصحيح (أبو الأعور السلمي). وهو أبو الأعور عمرو بن سفيان ـ ويقال: ابن عبد الله بن سفيان ـ بن عبد شمس بن سعد بن قائف بن الأوقص السلميّ، الشاميّ لعنه الله. أمّه قريبة بنت بشر بن عبد بن سعد بن سهم، وأمّها أروى بنت أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، فبنو أمية أخوال أمّه. غلبت كنيته على اسمه، فعُرِف بها. أدرك الجاهلية، ولم تثبت له صحبة للنبي’. حليف أبي سفيان لعنه الله. كان أبوه في معركة أحد مع المشركين، فقَتل عبدَ الله بن عمرو بن حرام؛ أول قتيل من المسلمين. كما كان أبو الأعور من قادة المشركين في الأحزاب وحنين، وقيل: أسلم بعدها. ممّن غدر برسول الله’ فلعنه ودعا عليه في قنوته شهراً. كان عامل معاوية على الأردن أيام عثمان بن عفان. شارك في صفين مع معاوية، وهو أشد أصحابه على أمير المؤمنين×. وقف في خمسة آلاف مقاتل على المشرعة ومنع أهل العراق من الماء، فكشفهم أصحاب أمير المؤمنين×. من جملة شهود أهل الشام العشرة على كتاب التحكيم في صفّين. كان أمير المؤمنين× يدعو عليه ويلعنه في الصلاة، اشترك في معركة اليرموك، ومعركة عمورية، وقبرص، وطبرية والأردن. وهو الذي حمل كتاب عثمان بن عفان إلى والي مصر ـ عبد الله بن سعد بن أبي سرح ـ بقتل بعض من ثار عليه وعقوبة البعض الآخر، فلمّا فتشوه ووجدوا الكتاب معه رجعوا إلى المدينة وجرت بينهم وبين عثمان أحداث انتهت بقتل عثمان. وهو الذي تولّى قتل حُجر بن عدي رضوان الله عليه. قيل: كان حياً سنة 65هـ؛ حيث قدِم فيها إلى مصر مع مروان بن الحكم، وقيل: مات في أيام معاوية. اُنظر: القيرواني، يحيى بن سلام، تفسير يحيى بن سلام: ج2، ص703. ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج3، ص562. ابن معين، يحيى، تاريخ ابن معين: ج1، ص38. العصفري، خليفة بن خياط ، تاريخ خليفة بن خياط: ص145. الآجري، سليمان بن الأشعث، سؤالات الآجري: ج1، ص331. ابن الجراح، محمد بن داود، مَن اسمه عمرو من الشعراء (المكتبة الشاملة): ص19. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج3، ص401، وص446. الجزري، الحسين ابن محمد، المنتقى من كتاب الطبقات: ص35. ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج6، ص234. ابن حبان، محمد، الثقات: ج2، ص294. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج3، ص1178. وج4، ص1600. ابن عساكر، الحسن بن علي، تاريخ مدينة دمشق: ج46، ص52ـ59. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ج4، ص144. ابن الأثير، محمد بن مكرم، أسد الغابة: ج5، ص138. ابن العديم، عمر بن أحمد، بغية الطلب: ج5، ص2108. الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: ج4، ص130. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، الإصابة: ج4، ص530.
[1604] هكذا في الأصل، والصحيح (خمسمائة).
[1605] أي أمير المؤمنين×. اُنظر: الكرباسي، دائرة المعارف الحسينية (ديوان القرن الاول) : ج1، ص184.
[1606] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص53. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص6. وفيه زيادة بيت:
|
(فما أمر زمان
أغبر وجلا |
[1607] هكذا في الأصل، والصحيح (نساء الحسين).
[1608] «كبسوا دار فلان: أغاروا عليها فجأة». الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج3، ص969، (كبس).
[1609] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (ولما ارتفع صياح النساء صاح ابن سعد (لعنه الله) ويلكم اكبسُوا عليهنّ الخباء واضرموهنّ ناراً فاحرقوها ومن فيها).
[1610] هكذا في الأصل، والصحيح (محمداً).
[1611] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (فقال رجل منهم: ويلك يا بن سعد، أما كفاك قتل الحسين× وأهل بيته وأنصاره عن إحراق أطفاله ونسائه لقد أردتَ أن يخسف الله بنا الأرض).
[1612] هكذا في الأصل، والصحيح (بنت).
[1613] هكذا في الأصل، وهي زائدة.
[1614] هكذا في الأصل، والصحيح (أزرق)، والمراد به خولي لعنه الله، كما سيأتي من المؤلّف.
[1615] النِّطْعُ: بِساطٌ من الأديم مَعْرُوفٌ. اُنظر: الزبيديّ، محمد مرتضى، تاج العروس: ج11، ص482، (نطع).
[1616] هكذا في الأصل، وهي زائدة.
[1617] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص106. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص96.
[1618] هكذا في الأصل، والصحيح (زينب).
[1619] هكذا في الأصل، والصحيح (يد المختار). واُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص154ـ156. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص104ـ105. المجلس السادس عشر.
[1620] الثابت تاريخياً أنّ ولادة الإمام زين العابدين× في سنة (36 أو 38 هـ) فيكون عمره في كربلاء خمس وعشرين سنة أو ثلاث وعشرين سنة، بل ذكر ابن عنبة عن الواقدي أنّه وُلِد سنة 33هـ، فيكون عمره في كربلاء 28 سنة. ومن الثابت أيضاً أنّه كان متزوجاً وقد وُلِد ابنه محمد الباقر×. بل قيل: إنّه أكبر من أخيه المقتول في الطف، كما تقدّم في ترجمة عليّ الأكبر×. اُنظر: الفتال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص201. ابن عنبة، أحمد بن علي، عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: ص193، وص195. السماوي، محمد بن طاهر، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص49.
[1621] هكذا في الأصل، والصحيح (بعضاً).
[1622] في مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص201: (قال أبو مخنف... عن حميد بن مسلم قال: انتهيتُ إلى علي بن الحسين بن علي الأصغر، وهو منبسط على فراش له وهو مريض، وإذا شمر بن ذي الجوشن في رجالة معه يقولون: ألا نقتل هذا. قال: فقلتُ: سبحان الله أنقتل الصبيان !إنّما هذا صبي. قال: فما زال ذلك دأبي أدفع عنه كلّ من جاء حتى جاء عمر بن سعد، فقال: ألا لا يدخلَنَّ بيت هؤلاء النسوة أحد، ولا يعرضَنَّ لهذا الغلام المريض، ومن أخذ من متاعهم شيئاً فليرده عليهم...).
[1623] اختُلِف في نسبة الأبيات إلى قائلها، فبعض نسبها إلى المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب&. من أصحاب أمير المؤمنين× والحسنين÷، وهو الذي قبض على عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله. كان مع الإمام الحسين× إلّا أنّه مرض، فعزم الإمام عليه أن يرجع فامتثل لذلك. ولمّا بلغه مقتل الإمام× رثاه بهذه الأبيات. وأوردها ابن شهر آشوب وغيره منسوبة إلى الكميت بن زيد الأسدي (ت126هـ). مضافاً إلى نسبتها إلى السيدة أم كلثوم‘، كما في المتن. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص221. المرزبان، محمد بن عمران، معجم الشعراء: ج1، ص369. الخزاز القمي، علي بن محمد، كفاية الأثر: ص 248. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص262. ابن عنبة، أحمد بن علي الحسيني، عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: ص61.
[1624] هكذا في الأصل، والصحيح (ذو).
[1625] صرف الدهر وصروفه: نوائبه وحدثانه. اُنظر: الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط: ج3، ص161، (صرف).
[1626] لعله المراد بالتسعة الشهداء من أبناء الامام علي×، كما ورد في الشعر المنسوب لسليمان بن قتة أو غيره. اُنظر: المسعوديّ، عليّ بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر: ج3، ص62. ابن نما الحلّي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص89. ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج15، ص236.
[1627] هكذا في الأصل، والصحيح (ستة).
[1628] هكذا في الأصل، والصحيح (يجارى).
[1629] هكذا في الأصل، والصحيح (بنو).
[1630] جمع مليح. يقال: رَجُلٌ مَلِيحٌ: ذُو مَلاَحَةٍ، وَسيمٌ. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص883، (ملح).
[1631] هكذا في الأصل، وفي دائرة المعارف الحسينية: (والمرءِ عونٍ وأخيه مضى). اُنظر: الكرباسي، محمد صادق، دائرة المعارف الحسينية: ج2، ص252، ديوان القرن الأول.
[1632] هكذا في الأصل، والصحيح (التقى).
[1633] هكذا في الأصل، والصحيح (ضيم).
[1634] في المنتخب وأسرار الشهادات وناسخ التواريخ واللفظ للأول: ص469، قال: فلمّا رأت أم كلثوم ما حلّ بهم بكت وأنشأت:
|
يا سائلي عن فتية صرعوا |
[1635] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (... فابتدر إليه عشرة فوارس فحطّموا صدره وظهره، وجاء خوّلي والشمر وسنان إلى ابن سعد (لعنه الله)، ومعهم رأس الحسين× وهم يفتخرون بقتله).
وفي مقتل أبي مخنف (تعليق الغفاري) ص202: (قال: ثم إنّ عمر بن سعد نادى في أصحابه: من ينتدب للحسين ويوطئه فرسه؟ فانتدب عشرة، منهم إسحاق بن حياة الحضرمي، وهو الذي سلب قميص الحسين فبرص بعد، وأحبش بن مرثد بن علقمة بن سلامة الحضرمي، فأتوا فداسوا الحسين بخيولهم حتى رضوا ظهره وصدره، فبلغني أنّ أحبش بن مرثد بعد ذلك بزمان أتاه سهم غرب وهو واقف في قتال ففلق قلبه فمات).
[1636] هكذا في الأصل، والصحيح (الطرماح) كما تقدّم في ترجمته.
[1637] هكذا في الأصل، والصحيح (قتلى).
[1638] الأذفر: أي طيب الريح. ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج2، ص161، (ذفر).
[1639] هكذا في الأصل، والصحيح (إبراهيم).
[1640] هكذا في الأصل، والصحيح (بذريتي).
[1641] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص108. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص125.
[1642] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (قال أبو مخنف).
[1643] هكذا في الأصل، والصحيح (أقتاب). وأقتاب جمع قتَب وهو الرحل. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج1، ص198، (قتب).
[1644] هكذا في الأصل، والصحيح (القتلى).
[1645] جديلة الأسدي، ويقال أبو جديلة الأسدي وفي بعض النسخ حذيفة: اُنظر: الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص219.
[1646] أي عند منصرفه وخروجه. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص513، (صرف).
[1647] هكذا في الأصل، والصحيح (أحثو). حثاه أي هالَهُ وصَبَّهُ على رأسه. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص156، (حثا).
[1648] هكذا في الأصل، والصحيح (فرأيتُ الفرس عارياً والسرج خالياً)، كما هو في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته أيضاً.
[1649] هكذا في الأصل، والصحيح (لدى).
[1650] هكذا في الأصل رسمها.
[1651] هكذا في الأصل، والصحيح (يسلبوا).
[1652] هكذا في الأصل، والصحيح (الحورا).
[1653] هكذا في الأصل، والصحيح (سراجاً).
[1654] هكذا في الأصل، والصحيح (يستضاء).
[1655] هكذا في الأصل، والصحيح (زورا).
[1656] هكذا في الأصل، والصحيح (الدجى).
[1657] هكذا في الأصل، والصحيح (نورا).
[1658] قلوص: الشابة الأنثى من الإبل من حين تُركَب حتى التاسعة، فإن زادت على التاسعة سُمِّيت ناقة. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج7 ص81، (قلص).
[1659] هكذا في الأصل، والصحيح (الحورا)، وفاعل (يلثم) ضمير مستتر تقديره (هو).
[1660] هكذا في الأصل، والصحيح (دنى).
[1661] هكذا في الأصل، والصحيح (إلى أجل) كما هو في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته.
[1662] هكذا في الأصل، والصحيح (مقدورا).
[1663] هكذا في الأصل، والصحيح (معذورا). وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، وأسرار الشهادات وردت الأبيات هكذا واللفظ للأول:
|
والله ما جئتُکم حتى بصـرتُ به |
[1664] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (قال: وا أسفاه عليك يا أبا عبد الله ثلاث مرات).
[1665] هكذا في الأصل، ولعلها زائدة.
[1666] هكذا في الأصل، والصحيح (يشهرونه).
[1667] مسلم الجصاص: لم نجد له ترجمة سوى ما نُقِل من أنّ ابن زياد دعاه لإصلاح دار الإمارة، ومشاهدته لدخول السبايا والرؤوس إلى الكوفة. ويظهر منه أنّه ليس من الشيعة، ولكنّه محبّ لأهل البيت. اُنظر: الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج7، ص411.
نقول: عبر العلامة المجلسي عن هذا الخبر بقوله المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص114.
[1668] الكناس أو الكُناسة: محلة بالكوفة، تقع بين مسجد السهلة ومسجد الكوفة. عُرِِفت بكناسة أسد، ثم صارت محلة أو سوقاً أو محطة تجارية كبرى للعرب، وهي في الكوفة مثل المربد في البصرة، وموقعها من المدخل الغربي للكوفة. فيها تمركزت الأشغال التجارية مع البلاد العربية. وفي ناحية من نواحيها أسواق البراذين التي تجري فيها المعاملات على الماشية والرقيق، كما كان فيها محل للشنق. اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج4، ص481. البراقي، حسين أحمد، تاريخ الكوفة: ص168.
[1669] هكذا في الأصل، والصحيح (فتصارخت).
[1670] اُنظر أيضاً: الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص32. الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص477. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص114، قال حين نقله: (رأيتُ في بعض الكتب المعتبرة). الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، ص222، المجلس الثاني والعشرون. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص36. القزويني، رضي بن نبي، تظلم الزهراء‘ من إهراق دماء آل العباء: ص299.
وفي نور العين: قال مسلم الجصّاص: «كنتُ في ذلك اليوم دُعيتُ لأُجصّص دار ابن زياد، فبينما أنا اشتغل وإذا بالأصوات قد رُفِعت في جوانب الكوفة، فسألتُ خادماً عن ذلك. فقال: ستأتي إلينا رأس خارجي. فقلتُ: ما اسم الخارجي؟ فقال لي: الحسين. فلمّا سمعتُ ذلك تركتُه حتى خرج، ثمّ لبستُ عمامتي وثيابي بعد أن غسلتُ وجهى ويديّ ورجليّ، وخرجتُ من القصر فوصلتُ الرأس ـ وأنا علا بكا عظيم ـ فرأيتُ أهل الكوفة لابسين الثياب الفاخرة، وهم يرتقبون رأس الحسين عند دخولها، وبعد قليل أقبلت الجمال، وعليها حريم الحسين والشهدا، وهم بغير وطا ولا غطا. وزين العابدين راكب على بعيرـ وهو ضعيف ـ ورأيتُ أفخاذهم تشخب دماً...).
وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وأسرار الشهادات واللفظ للأول: (قال: ودخلوا بحريم إلى الكوفة، وإذ بعليّ بن الحسين× على بعير بغير غطاء ولا وطاء، وفخذاه ينضحان دماً، وهو يبكي ويقول:
|
يا أمة السوء لا سقياً لربعكم يا أمة لم تراعِ جدّنا فينا |
قال: وصار أهل الكوفة يطعمون الأطفال بعض التمر والجوز، فصاحت أم كلثوم‘ وقالت: يا أهل الكوفة الصدقة علينا حرام. وجعلت تأخذه من أيدي الأطفال، وترمي به إلى الأرض، فضجت الناس بالبكاء والنحيب، فقالت أم كلثوم: تقتلنا رجالكم، وتبكينا نساؤكم؟ لقد تعديتم علينا عدواناً وظلماً عظيماً، وجئتم شئياً فرياً تكاد السموات يتفطرن وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدّا. فبينما هي في كلامها وإذا بصيحة عظيمة قد ارتفعت، وإذا برأس الحسين× ومعه ثمانية عشر رأساً من أهل بيته، فلمّا نظرت أم كلثوم إلى رأس أخيها، شقت جيبها وأنشات تقول:
|
ماذا تقولون إذ
قال النبي لكم |
[1671] «اللَّطَفُ: اليسيرُ من الطَّعام والجمع ألطاف». مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص826، (لطف).
[1672] هكذا في الأصل، والصحيح (الأطفال).
[1673] هكذا في الأصل، والصحيح (به).
[1674] اُنظر أيضاً: الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص32. الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص477ـ478. القزويني، رضي بن نبي، تظلم الزهراء‘ من إهراق دماء آل العباء: ص299ـ300. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج2، 223، المجلس الثاني والعشرون. القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج3، ص86.
[1675] هكذا في الأصل، والصحيح (الشعبي عن يحيى بن يعمر) ولم نقف على ترجمته.
[1676] هكذا في الأصل، والصحيح (إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى). الكهف: 13.
[1677] هكذا في الأصل، والصحيح (استطع).
[1678] اُنظر أيضاً: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص218. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص304.
[1679] هكذا في الأصل، والصحيح (تعّ) ويقال تَعْتَعَ في الكَلامِ، إِذا تَرَدَّدَ فيه مِنْ حصرٍ أَوْ عِيٍّ. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج8 ص35، (تعع).
[1680] اُنظر أيضاً: لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص48.
[1681] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وإكسير العبادات في أسرار الشهادات: (سهل الشهرزوري).
[1682] هكذا في الأصل، والصحيح (مقبل).
[1683] هكذا في الأصل، والصحيح (شيخاً).
[1684] تزاور عنه: بمعنى عدل عنه وانحرف. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج2، ص673، (زور).
[1685] هكذا في الأصل، والصحيح (علا).
[1686] هكذا في الأصل، والصحيح (عسكران).
[1687] هكذا في الأصل، والصحيح (أحدهما).
[1688] هكذا في الأصل، والصحيح (بكى). وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وشرح شافية أبي فراس وأسرار الشهادات وناسخ التواريخ واللفظ للأول: (... وقال:
|
مررتُ على
أبيات آل محمدٍ أصاب به يُمنى يديه فشلّت |
قال سهل: فما استتم كلامه حتى سمعتُ البوقات تضرب، والرايات تخفق، وإذا بالعسكر قد دخل الكوفة، وسمعتُ صيحة عظيمة، وإذا براس الحسين× يلوح، والنور يسطع منه، فخنقتني العبرة لمّا رايتُه. ثم أقبلت السبايا يقدمهم علي بن الحسين×، ومن بعده أم كلثوم‘ تنادي: يا أهل الكوفة غضّوا أبصاركم عنّا، أما تستحون من الله ورسوله أن تنظرا إلى حرم رسول الله’ وهنّ حواسر؟!). أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص162 وما بعدها.
[1689] هكذا في الأصل، والصحيح (مغشياً).
[1690] هكذا في الأصل، والصحيح (تلمحون). لمَح إلى الشّخصِ: أبصره بنظرٍ خفيفٍ أو اختلس النَّظَرَ إليه. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج2، ص4 58، (لمح).
[1691] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وأسرار الشهادات واللفظ للأول: (قال: فوقفوا بباب بني خزيمة، والرأس على قناة طويلة، وهو يقرأ سورة الكهف إلى أن بلغ إلى قوله تعالى: (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا)، قال سهل: فبکیتُ، وقلتُ: یا بن رسول الله رأسك أعجب. ثم وقعتُ مغشياً عليَّ، فلم أُفِق حتى ختم السورة). أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص164.
[1692] هكذا في الأصل، والصحيح (فغضَّ).
[1693] في نور العين: (فصار أهل الكوفة يناولون الأطفال الذين في المحافل الخبز، فصاحت أمّ كلثوم: «يا أهل الكوفة، حجر في رأس مَن تصدّق علينا». ثمّ أخذت ما أعطوه للأطفال ورمته عليهم، فعند ذلك ضجّت الناس بالبكاء والنحيب ـ وهم ينظرون إليهم ـ فنظرت إليهم أُمّ كلثوم وقالت: «غضّوا أبصاركم عنّا». فلمّا سمعها النساء في الربوع بكينَ عليهنّ، فقالت: «ويحكنَّ تقتُلنا رجالكم وتبكي علينا عيونكم، الله يحكم بيننا وبينكم. فوالله، ما حُبِستْ عنّا نُصرة الله في الدنيا إلاّ لاكتساب نعيم الآخرة؛ لارتفاع مقامنا في الآخرة، وأنتم سوف تُرَِدُّون إلى جهنّم، يا ويلكم! أتدرون أيَّ دمٍٍ سفكتم وأيَّ لحم قطعتم؟). الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص32.
[1694] هكذا في الأصل، والصحيح (ست). وقد تقدّمت الإشارة إلى الردّ على صغر عمر الإمام السجاد×، مضافاً إلى أنّ المؤلّف نقل فيما سبق أنّ الإمام× كان صبياً لم يبلغ الحلم، ممّا يدلّ على كون عمره قارب الثانية عشر، فكيف يصفه هنا بكون عمره ست سنوات؟!
[1695] هكذا في الأصل، والصحيح (فأعدّ).
[1696] في الأصل بعد كلمة (بإثمك) توجد كلمة غير واضحة.
[1697] آل عمران: آية 185.
[1698] شاط: إذا تلهّب وتحرّق من شدة الغضب. اُنظر: ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج2، ص518، (شيط).
[1699] هكذا في الأصل، والصحيح (تلقّى).
[1700] هكذا في الأصل، والصحيح (إلى شدة تفجّعها).
[1701] هكذا في الأصل، والصحيح (فؤادي).
[1702] هكذا في الأصل، وهي زائدة.
[1703] هكذا في الأصل، والصحيح (إلّا ما كلّمتيني).
[1704] هكذا في الأصل، والصحيح (ها أنا).
[1705] هكذا في الأصل، وفي بقية الموارد الآتية، والصحيح (رأيتِ).
[1706] هكذا في الأصل، والصحيح (كذبتِ).
[1707] هكذا في الأصل، والصحيح (برّدتُ).
[1708] هكذا في الأصل، والصحيح (يابن).
[1709] هكذا في الأصل، والصحيح (أبو مخنف).
[1710] انحاز القوم: تركوا مركزهم ومالوا إلى موضع آخر. اُنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج3، 274.
[1711] هكذا في الأصل، والصحيح (فناداها).
[1712] هكذا في الأصل، والصحيح (ظاهراً).
[1713] «القبس: شعلة من نار». الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج3، ص960، (قبس).
[1714] «الأرومة بوزن الأكولة: الأصل». ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج1، ص41، (ارم).
[1715] الأكرومة: الفعلة الكريمة. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص784، (كرم).
[1716] هكذا في الأصل، والصحيح (محمداً)
[1717] اُنظر أيضاً: القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج3، ص87.
وفي نور العين: (قال: وكانت زينب حاسرة الوجه تختبي؛ لئلا يراها أحد، فنظرها بن زياد ـ زاده الله عذاباً في النار ـ فسأل حاجبه عنها، فقال: هذه زينب أخت الخارجي. فصاح بها: يا زينب، أرأيتِ صنع الله في أخيك، وكيف قطع دابركم؛ لأنّه كان يريد الخلافة ليتم بها آماله، فخيّب الله رجاه وآماله؟. فقالت: يا ابن زياد، إذا كان أخي طلب الخلافة فهي ميراث أبيه وجدّه، وأمّا أنت يا ابن زياد، إذا كان القاضي الله، والحكم جدّي رسول الله، والشهود الملائكة، والسجن جهنّم، وإنّما هؤلاء القوم كتب الله عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم، وغداً يجمع الله بينك وبينهم فتُحاجج وتُخاصم. فقال: قد شُفي قلبي من الحسين وأهل بيته! فقالت: إذا كان قرّة عينك بقتل الحسين، فسوف ترى ممَّن قرت عينه به قبلُ، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبّله ويضعه علا عاتقه. ثمّ بكت). الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص33.
[1718] اختلف المؤرخون في ألفاظ هذه الأبيات، وفي نسبتها إلى قائلها: فقد نسبها البعض إلى زينب بنت عقيل بن أبي طالب. ونسبها آخر إلى زينب بنت علي بن أبي طالب÷. وقيل: أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. وقيل: أم لقمان بنت عقيل بن أبي طالب. وقيل: أسماء بنت عقيل. وقيل: رملة بنت عقيل. وقيل: بنت عقيل بن أبي طالب دون ذكر اسمها. وقيل: امرأة من بنات عبد المطلب. ونسبها البعض للإمام زين العابدين×. وقيل: لأبي الأسود الدؤلي. وقيل: من نوح الجنّ. اُنظر: الزبيري، أبو عبد الله، نسب قريش: ج1، ص84. البغدادي الظاهري محمد بن داود، الزهرة: ج1، ص153. ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، عيون الأخبار: ج1، ص312. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص293. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص131. الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص118. ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص193. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص124. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص262. سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص338. اليغموري، محمد بن عمران، نور القبس: ج1، ص3. المقريزي، تقي الدين، المقفى الكبير: ج3، ص347.
[1719] في بعض المصادر: (بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي). اُنظر: ابن حجر، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج2، ص305. ابن نما الحلي، محمد بن جعفر، مثير الأحزان: ص75.
[1720] هكذا في الأصل، والصحيح (جزائي مذ).
[1721] هكذا في الأصل، ولعل الصحيح (أودى على إرم) والد عادٍ الأولى. وقيل: عادٍ الآخرة. وقيل: بلدتهم التي كانوا فيها. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج12، ص15، (إرم).
[1722] هكذا في الأصل، وهو صحيح؛ لكونه مضارعاً متصلاً بنون التوكيد، والمراد ينظر.
[1723] هكذا في الأصل، والصحيح (الروؤس).
[1724] هكذا في الأصل، والصحيح (حاسرة).
[1725] لعلّه تصحيف (الستر). وأمّا دخول بنات الرسالة إلى المجلس مكشوفات الرأس باديات الشعر، فلم يرد في غيره. مضافاً إلى أنّ الأخبار على خلاف ذلك، كما أشار الدربندي&. اُنظر: الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص261، المجلس الثالث والعشرون.
[1726] هكذا في الأصل، والصحيح (زياد).
[1727] هكذا في الأصل، والصحيح كما في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته (إلى كم تهتك عمتي).
[1728] هكذا في الأصل، والصحيح (دعا).
[1729] هكذا في الأصل، والصحيح (مضـرية)، كما في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وفي أسرار الشهادات (مصرية).
[1730] هكذا في الأصل، والصحيح (أتى).
[1731] هكذا في الأصل، والصحيح (بن علي).
[1732] هكذا في الأصل، والصحيح (محمد).
[1733] هكذا في الأصل، والصحيح (أبى).
[1734] هكذا في الأصل، والصحيح (وتركه).
[1735] هكذا في الأصل، والصحيح (هذا)، وسيأتي مثله في عدة موارد.
[1736] الشعراء: آية 227.
[1737] هكذا في الأصل، والصحيح (دويّاً).
[1738] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص161ـ169. مقتل أبي مخنف (تحقيق الغفاري): ص202. الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص33. الحسيني، محمد بن أمير، شرح شافية أبي فراس: ص380.
[1739] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (أبو مخنف).
[1740] هكذا في الأصل، والصحيح (رقى).
[1741] هكذا في الأصل، والصحيح (عليهم)
[1742] هكذا في الأصل، والصحيح (فقام له من وسط المسجد)
[1743] عبد الله بن عفيف الأزدي، من خيار الشيعة وزُهّادها وشجعانها، وكانت عينه اليسـرى ذهبت يوم الجمل، والأُخرى يوم صفّين، وكان يلازم المسجد الأعظم بالكوفة، فيصلّي فيه إلى الليل. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص351. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص96. الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج5، ص56.
[1744] انكفّ: أي كفّ، بمعنى ذهب بصره. اُنظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ج3، ص192.
[1745] هكذا في الأصل، والصحيح (فضّ).
[1746] أجهد بلاءك، أي زادك مشقة، وفي نهاية ابن الأثير (أعوذ بك من جهد البلاء) أي الحالة الشاقة. ابن الأثير، مجد الدين، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج1، ص320.
[1747] هكذا في الأصل، والصحيح (ورجليك)، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، ص69: (صه، فضّ الله فاك، ولعن جدّك وأباك، وعذّبك وأخزاك، وجعل النار مثويك...).
[1748] هكذا في الأصل، والصحيح (صعدت).
[1749] قول النبيّ’ (من سبّ علياً فقد سبّني) من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها جماعة كثيرون، وصرّحوا بصحة سنده. أمثال الحاكم في مستدركه والبيهقي والنسائي في الخصائص وأحمد وغيرهم، بأسانيد مختلفة وألفاظ متعددة. وعلّق عليه المناوي بقوله: (وفيه إشارة إلى كمال الاتحاد بين المصطفى والمرتضى بحيث إنّ محبة الواحد توجب محبّة الآخر، وبغضه يوجب بغضه). اُنظر: الآجري، محمد بن الحسين، الشريعة: ص582. القاضي المغربي، النعمان بن محمد، شرح الأخبار: ج1، ص439. النيسابوري الخركوشي، عبد الملك بن محمد، شرف المصطفى: ج5، ص502. الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك: ج3، ص130. المحب الطبري، أحمد بن عبد الله، الرياض النضرة في مناقب العشـرة: ج3، ص122. وكذا في ذخائر: ص66. الإحسائي، محمد بن علي، عوالي اللئالي: ج4، ص87. الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج9، ص129ـ130. المناوي، محمد عبد الرؤوف، فيض القدير: ج6، ص190.
[1750] هكذا في الأصل، والصحيح (ابن زياد).
[1751] هكذا في الأصل، والصحيح (فمنعه).
[1752] «الأتان: الحمار يقع على الذكر والأنثى». ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج1، ص21، (أتن).
[1753] «عسعس الليل: إذا أقبل ظلامه». الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج3، ص949، (عسس).
[1754] هكذا في الأصل، والصحيح (دعا).
[1755] هكذا في الأصل، والصحيح (يا أبة).
[1756] هكذا في الأصل، والصحيح (أنتِ).
[1757] «المَضِيقُ: ما ضاقَ من الأَماكن والأُمور». ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج10، ص209، (ضيق).
[1758] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (خمسين فارساً). وفي أسرار الشهادات وناسخ التواريخ: (ثلاثة وعشرون رجلاً أو راجلاً وخمسين فارساً).
[1759] هنا زيادة في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وأسرار الشهادات، واللفظ للأول: (وهو يصلي على النبي وآله وهو يرتجز ويقول:
|
والله لو يكشف
لي عن بصـري |
أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص170.
[1760] هكذا في الأصل، والصحيح (ابن عفيف)، وكذا في المورد التالي.
[1761] هكذا في الأصل، والصحيح (أعمى).
[1762] هكذا في الأصل، والصحيح (إن لم).
[1763] وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (فضحك عبد الله، وقال له: قد ذهبت عيناي يوم صفّين مع أمير المؤمنين×...).
[1764] هكذا في الأصل، والصحيح (بكى).
[1765] هكذا في الأصل، والصحيح (صحوتُ) كما في مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته.
[1766] الصّبا: الشوق. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص507، (صبا).
[1767] الغَوانيا: جمع غانِيَةُ وهي الشابَّة المُتَزَوّجة؛ لأنّها استغنت بزوجها. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج15، ص138، (غني).
[1768] لبيك: إقامة على طاعتك بعد إقامة، وإجابة بعد إجابة. وتكراره للتوكيد. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص811، (لبيك).
[1769] هكذا في الأصل، والصحيح (امرئ).
[1770] هكذا في الأصل، والصحيح (امرئ يُجزى).
[1771] قاد الدابة: مشى أمامها آخذاً بقيادها. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص765، (قود).
[1772] مضمر أي ضامر، وهو البطن اللطيف الجسم. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص543، (ضمر).
[1773] لحق الشيء يلحقه لُحوقاً ولحاقاً: بمعنى أدركه، والملحاق السريع الذي لا يكاد يفوته شيء، كما صرّح أرباب اللغة. فكأنّ لَحوق صيغة مبالغة على فَعول كناية عن السرعة. اُنظر: الفراهيدي، خليل بن أحمد، العين: ج3، ص48. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج10، ص327.
[1774] سبْح الفرس: جريه، وفرس سابح، بمعنى يسبح بيديه في جريه، فهو حسن مد اليدين في الجرى. اُنظر: ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج2، ص332. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج1، ص372.
[1775] المتالي : إمّا بمعنى المتبوع، فهو كناية عن تقدمها على غيرها في الجري؛ لأنّ الجميع متأخر عنها فهو تابعها، وإمّا بمعنى الذي يراسل المغنى بصوت رفيع، أي يباريه في غنائه كناية عن حسن صهيلها. اُنظر: الفراهيدي، خليل بن أحمد، العين: ج8، ص134. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج6، 2290. الزمخشري، محمود بن عمر، أساس البلاغة: ص339.
[1776] البيض: بالكسر جمع الأبيض، وهو السيف. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج3، ص1067، (بيض).
[1777] «القنا: الرمح». ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج15، ص203، (قنو).
[1778] المواضي: جمع ماضي وهي السيوف الحادة القاطعة. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص875، (مضى).
[1779] العوالي جمع عالية، وهي أعلى الرمح ورأسه. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج15، ص87، (علا).
[1780] هكذا في الأصل، والصحيح (التّقى).
[1781] هكذا في الأصل، والصحيح (كالئاً) : اي حافظاً. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج1، ص69، (كلأ).
[1782]جاء في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، وأسرار الشهادات، وناسخ التواريخ، تتمة لهذه الأبيات، وهي:
|
(لحى الله قوماً كاتبوه لغدرهم وضاربتُ عنه الفاسقين مُفاديا |
|
ودافعتُ عنه ما استطعتُ مجاهداً وقد زالت الأطواد من عظم قتله وأضحت له الآفاق جهراً بواكيا أنيبوا فإنّ الله في الحكم
عاليا وتوبوا إلى التوّاب من سوء فعلكم وإن لم تتوبوا تدركون المخازيا وكونوا ضراباً بالسيوف وبالقنا تفوز كما فاز الذي كان ساعيا وإخواننا كانوا إذا الليل جنّهم تلوا طوله القران ثم المثانيا أصابهم أهل الشقاوة والغوى فحتى متى لا يبعث الجيش عاديا عليهم سلام الله ما هبّت الصبا وما لاح نجم أو تحدّر هاديا) |
أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص172. اُنظر أيضاً: الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص256. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص45.
والصحيح أنّها لعبد الله بن عوف بن الأحمر الأزدي، قالها حين خرج الناس مع سليمان بن صرد& لطلب ثأر الحسين×. اُنظر: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج6، ص211. المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب: ج3، ص93. الأمين، محسن، أصدق الأخبار: ص8.
[1783] هكذا في الأصل، وهي زائدة.
[1784] اُنظر أيضاً: الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص33ـ34.
[1785] هكذا في الأصل، والصحيح (دعا).
[1786] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (جابر).
[1787] لم نعثر على ترجمته، وفي بقية المصادر أنّ الذي قوّر الرأس الشريف هو الحجّام طارق بن المبارك. اُنظر: الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص58. النويري، أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20 ص476.
[1788] «قوّرتُ الشيء تقويراً: قطعتُ من وسطه خرقاً مستديراً كما يُقوَّر البطيخ». الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير: ج2، ص519، (قور)
[1789] هكذا في الأصل، والصحيح (يحشى). ويقال: حشا الوسادة ونحوها حشواً ملأها بالقطن ونحو. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص177، (حشا)
[1790] الصبر، بكسر الباء: دواء مُرّ. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج2، ص707، (صبر).
وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (ورُوِي عن زيد بن أرقم قال: مرّ بي رأس الحسين× وأنا جالس في غرفة وهو على رمح طويل فسمعتُه يقرأ: (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا) فقفّ شعري وجلدي وناديتُ: يا بن رسول الله، رأسك أعجب). أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص175.
[1791] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، وناسخ التواريخ واللفظ للأول: (ثم دعا ابن زياد برأس الحسين وسلمه إلى عمر بن جابر المخزومي، وأمره أن يدور به في سکك الکوفة). أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص175. وفي إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص292: (ثم دعا ابن زیاد برأس الحسين فأُحضِر بين يديه، وطيبّه بالمسك والعنبر الهندي). وفي نور العين: (ثمّ لمّا أن طافوا بالرأس جميع الكوفة، سلّموها إلى عمر المخزوميّ وأمروه أن يحشوها مسكاً وكافوراً، ففعل ذلك فما أتمّ فعله حتى بليت يده ووقعت بها الآكلة وتهرّت). الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص34.
[1792] هكذا في الأصل، والصحيح (إليهما).
[1793] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وأسرار الشهادات: (ألفاً وخمسمائة فارس). وفي المنتخب، وتظلم الزهراء‘، وينابيع المودة: (ألف فارس).
[1794] هكذا في الأصل، والصحيح (الرؤوس).
[1795] هكذا في الأصل، والصحيح (يشهروه).
[1796] اُنظر أيضاً: الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص300، المجلس السابع والعشرون، نقل الرواية عن الشعبي.
وفي نور العين: (فساروا بهم كما تسير سبايا الروم، وهم على أقتاب الجمال بلا وطاء ولا غطا، وهم باكون ذليلون، والرؤوس على الرماح مرتفعات). الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص34.
[1797] هكذا في الأصل، والصحيح (ماتت).
[1798] هكذا في الأصل، والصحيح (صال).
[1799] هكذا في الأصل، والصحيح (يعزّ).
[1800] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص169ـ176. وفيه زيادة بيت:
|
(كفرتم برسول
الله ويلكم |
الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص34ـ35. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص292، المجلس السابع والعشرون. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص64.
[1801] اُم سلمة: هند بنت أبي أمية بن المغيرة، ويقال: بنت الحارث. وأمها عاتكة بنت عبد المطلب، وقيل: أمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة الكنانية، من ولد جذل الطعان. وأمّا عاتكة بنت عبد المطلب فهي أم أخوتها. أفضل نساء النبيّ’ بعد خديجة. وكانت قبل زواجها من رسول الله عند عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة، فلمّا استُشهد يوم أحد وانقضت عدّتها، تزوّجها رسول الله’. روت عن رسول الله’. وهي من رواة قول النبي’: من كنتُ مولاه فعلي مولاه. شهد لها رسول الله’ في حادثة الكساء بأنّها على خير وإلى خير. بعثت ابنها عمر مع أمير المؤمنين علي× لمّا خرج لقتال أصحاب الجمل، وقالت: «قد دفعتُه إليك وهو أعزّ عليّ من نفسي،...، فلولا مخالفة رسول الله’ لخرجتُ معك كما خرجت عائشة مع طلحة والزبير». عاشت إلى ما بعد عاشوراء سنة 61هـ، وهو المشهور، وقيل: إنّها توفيت في شهر رمضان أو شوال عام 59هـ. وقد ردّ هذا القول ابن حجر في فتح الباري بقوله: (إنّ أم سلمة عاشت إلى قتل الحسين بن علي وكان قتله يوم عاشوراء سنة إحدى وستين)، ودُفِنت بالبقيع. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج1، ص88، وص429، وص431. ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري، ج9، ص98. الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج8، ص554. الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج24، ص203ـ204.
[1802] هكذا في الأصل، والصحيح (يقال لها).
[1803] هكذا في الأصل، والصحيح (يا رسول الله).
[1804] اُنظر أيضاً: الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص337. القزويني، رضي بن نبي، تظلم الزهراء‘ من إهراق دماء آل العباء: ص149.
[1805] هكذا في الأصل، والثانية زائدة.
[1806] هكذا في الأصل، والصحيح (لجاريتي).
[1807] «الهَدّةُ صوتُ وقوع الشَّيء الثقيل». مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص976، (هدد).
[1808] هكذا في الأصل، والصحيح (تجول).
[1809] «الوَغْدُ: الخفِيف الأَحمقُ الضعيفُ العقْلِ الرذلُ الدنيءُ». ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج3، ص464، (وغد)
[1810] هكذا في الأصل، والصحيح أن تكون في بداية الشطر الثاني من البيت.
[1811] هكذا في الأصل، والصحيح (زحفوا).
[1812] هكذا في الأصل، والصحيح (شر)، وأن تكون في بداية الشطر الثاني من البيت.
[1813] هكذا في الأصل، والصحيح (ويلهم).
[1814] اُنظر أيضاً: القاضي المغربي، النعمان بن محمد، شرح الأخبار: ج3، ص167. الفتال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص170. ولم يوردا الأبيات الأربعة الأخيرة. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص51. القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج3، ص89. أوردها لمّا وصلت سبايا أهل البيت^ إلى وادي النحلة.
[1815] هكذا في الأصل، وهي زائدة.
[1816] هكذا في الأصل، والصحيح (وا حسيناه).
[1817] كانت أم سلمة ملازمة لركب أهل البيت^، وكانت راسخة القدم في موقفها منهم. يذكر المؤرخون بأنّها كانت بعد وفاة النبي’ من أشدّ المدافعين عن أهل البيت^ عامة، وعن السيدة فاطمة‘خاصة، ودفاعها عنها عندما أنكر أبو بكر ميراثها من النبي’ في قضية فدك، حيث خاطبت القوم قائلة: ألمثل فاطمة‘ يقال هذا، وهي الحوراء بين الإنس! أتزعمون أنّ رسول الله’ حرّم عليها ميراثه، ولم يُعلِمها، وقد قال الله له (ﭿ ﮀ ﮁ) وهي خيرة النساء. فحُرِمت أم سلمة تلك السنة عطاءها. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، دلائل الإمامة: ص124.
[1818] هكذا في الأصل، والصحيح (حثوا).
[1819] هكذا في الأصل، والصحيح (رؤوسهم).
[1820] اُنظر ايضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص177ـ180. الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص315. الطبري، محمد بن جرير، دلائل الإمامة: ص180.
[1821] أسماء بنت عميس بن النعمان بن كعب بن مالك بن قحافة الخثعمية. وأمها هند بنت عوف الجرشية. أختها لأبيها وأمها سلمى بنت عميس زوجة حمزة بن عبد المطلب÷، وأخواتها لأمها: ميمونة بنت الحارث، وزينب بنت خزيمة زوجتا رسول الله’، ولبابة الكبرى بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب رضوان الله عليه. تزوجها جعفر الطيار بن أبي طالب÷، وهاجرت معه إلى الحبشة، فولدت له عبدَ الله ومحمد وعون؛ فهي أول مسلمة ولدت في أرض الحبشة. فلمّا استُشهد في معركة مؤتة سنة 8هـ، تزوجها أبو بكر فولدت له محمداً&، وبعد موت أبي بكر تزوجها أمير المؤمنين×، فولدت له يحيى وعون رضوان الله عليهما، قُتِلا مع أخيهما الإمام الحسين×. وقال النبي’ لها: يا أسماء، أما أنّكِ ستزوّجين بهذا الغلام ـ أي: أمير المؤمنين× ـ وتلدين له غلاماً. وكان ابنها محمد بن أبي بكر ربيب أمير المؤمنين× نشأ في بيته، وكان معه في الجمل وصفين، ثم ولّاه مصر. فلمّا جاءها نبأ قتله في مصر كظمت حزنها وقامت في مصلاها حتى شخبت ثدياها دماً. ومن نسلها أمّ الإمام الصادق× السيدة أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر. روت عن رسول الله’ بعض الأحاديث. كانت تشارك النبي’ في غزواته، وتهتم بمداوات الجرحى. حضرت عند السيّدة فاطمة الزهراء‘ حين وفاتها وغسلها، وأعانت أمير المؤمنين× في ذلك، وهي التي صنعت النعش لها. كما حضرت وفاة أمّها السيدة خديجة‘. من النساء المؤمنات، جليلة القدر، قال الإمام الباقر×: رحم الله الأخوات من أهل الجنّة. فسمّى منهنّ: أسماء بنت عميس. اُنظر: الكوفي، إبراهيم بن محمد الثقفي، الغارات: ج2، ص694. وص757ـ758. الكوفي، محمد ابن سليمان، مناقب الإمام أمير المؤمنين×: ج2، ص49. الباجي، سليمان بن خلف، التعديل والتجريح: ج2، ص944. ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج6، ص53. المزي، يوسف، تهذيب الكمال: ج15، ص82. وج35، ص128. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج43، ص214. الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج8، ص546ـ548. الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج22، ص203. وج24، ص194.
[1822] هكذا في الأصل، والصحيح (تقتله الفئة).
[1823] هكذا في الأصل، وفي البحار: (بولادته). اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج43، ص239.
[1824] اُنظر: الطبري، أحمد بن عبد الله، ذخائر العقبى: ص119. اُنظر أيضاً: زيد بن علي، مسند زيد بن علي: ص468. الفتال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص154. الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج1، ص427. القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج2، ص200.
[1825] هكذا في الأصل، والصحيح (قلتُ).
[1826] اُنظر أيضاً: الكِسّي، عبد بن حميد، منتخب مسند عبد بن حميد: ص442. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14 ص194. ابن العديم، عمر بن أحمد، بُغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2599. البوصيري، أحمد بن أبي بكر، إتحاف الخيرة المهرة: ص2644، قال البوصيري: (رواه عبد بن حميد بسند صحيح).
[1827] هكذا في الأصل، والصحيح (قالت).
[1828] هكذا في الأصل، والصحيح (فأراه)، أي جبرائيلُ أرى النبيَّ’ تربةَ كربلاء، وأطلعه عليها.
[1829] اُنظر أيضاً: ابن العديم، عمر بن أحمد، بُغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2597ـ2598. العاملي، يوسف بن حاتم، الدرّ النظيم: ص536. الزرندي، محمد بن يوسف، نظم درر السمطين: ص215. الزرندي، محمد بن يوسف، معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول^: ص94.
[1830] هكذا في الأصل، والصحيح (رسول الله).
[1831] هكذا في الأصل، والثانية زائدة.
[1832] هكذا في الأصل، والصحيح (فابشروا).
[1833] اُنظر أيضاً: الزرندي، محمد بن يوسف، نظم درر السمطين: ص217. الزرندي، محمد بن يوسف، معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول^: ص99ـ100. الهيتمي، أحمد بن حجر، الصواعق المحرقة: ص193. الشيرواني، المولى حيدر، مناقب أهل البيت^: ص246. وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته (ص224) نسب الأبيات لأم لقمان بنت عقیل بن أبي طالب تندب قتلاها بالطف وترثيهم وهي في المدينة. وقال بعضهم: سمع أهل المدينة في جوف الليل منادياً ينادى يسمعون صوته، ولا يرون شخصه. اُنظر: مقتل أبي مخنف برواية الطبري (الغفاري) ص231. ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص196. الفتال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص193. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص99. وفي المنتخب أنّهم سمعوا الهاتف يقرأ هذه الأبيات لمّا وصل سبايا أهل البيت ^ بعض المنازل الخربة في العراق قرب مدينة تكريت. اُنظر: الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص481.
[1834] هكذا في الأصل والظاهر زائدة.
[1835] اُنظر: ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج1، ص242. الكِسّي، عبد بن حميد، منتخب مسند عبد بن حميد: ص235. واُنظر أيضاً: الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص110. القاضي المغربي، النعمان بن محمد، شرح الأخبار: ج3، ص168. ابن المغازلي، علي بن محمد، مناقب علي بن أبي طالب×: ص317. الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك: ج4، ص398. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص237. السبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص339.
[1836] وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته (ص180) : (قال أبو مخنف: وساروا بالسبايا والرؤوس إلى شرقي الجصاصة).
[1837] هكذا في الأصل، والصحيح (تكريت)، وكذا في بقية الموارد. وتكريت: بفتح التاء، والعامة يكسرونها: بلدة مشهورة بين بغداد والموصل، وهي إلى بغداد أقرب، بينها وبين بغداد ثلاثون فرسخا (165كم)، ولها قلعة حصينة في طرفها الأعلى راكبة على دجلة، وهي غربي دجلة. قيل: سُمِّيت بتكريت نسبة إلى تكريت بنت وائل أخت بكر بن وائل. وقرب تكريت يشتق نهر الدجيل الذي يسقي سواد سامراء إلى قرب بغداد. اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج2، ص38. البغدادي، عبد المؤمن بن عبد الحق، مراصد الاطّلاع: ج1، ص268. السعيدي، محمد عبد الغني، من كربلاء إلى دمشق: ص220ـ221.
[1838] هكذا في الأصل، والظاهر أن هاتين الكلمتين زائدتان.
[1839] هكذا في الأصل، والصحيح (وتداع).
[1840] وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته(ص180) : (خرج على يزيد لعنه الله).
[1841] وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (رجل نصراني). المصدر السابق.
[1842] هكذا في الأصل، والصحيح (هو)، وكذا في موارد كثيرة يؤنث لفظة الرأس، والصحيح تذكيرها.
[1843] هكذا في الأصل، والصحيح (بن علي).
[1844] النواقيس: جمع ناقوس، وهو الذي تضرب به النصارى لأوقات الصلاة. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج3، ص985، (نقس).
[1845] بِيَعٌ: جمع بيعة وهي كنيسة النصارى. اُنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج2، ص265، (بيع).
[1846] دير عروة: الظاهر هو دير الجاثليق: وهو دير قديم البناء، رحب الفناء، من طسوج مسكن (ناحية)، قرب بغداد في غربي دجلة، في عرض حربي، وهو في رأس الحد بين السواد وأرض تكريت من نواحي دجيل، على غربيه، على علو عنده. وعنده كانت الحرب بين عبد الملك بن مروان ومصعب ابن الزبير، وقُتِل مصعب ودُفِن بقربه. اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج2، ص503. البغدادي، عبد المؤمن بن عبد الحق، مراصد الاطّلاع: ج2، ص555.
[1847] وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (صَليَتا) لم نعثر عليها.
[1848] وادي النخلة أو نخلا: هي ناحية من نواحي الموصل الشرقية قرب الخازر، وهو اسم الكورة التي يسقيها الخازر. ورجّح البعض أنّ (وادي الفَرَس) الذي يلي تكريت مطابق لوادي النخلة؛ إذ لم يُذكَر وادٍ غيرهما بين تكريت والموصل. اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج5، ص276. السعيدي، محمد عبد الغني، من كربلاء إلى دمشق: ص224.
[1849] هكذا في الأصل، والصحيح (ويُولولن) وهو الدعاء بالويل.
[1850] في المنتخب وينابيع المودة واللفظ للأول:
|
(مسح النبيّ
جبينه |
وأخرى تقول:
|
ألا يا عين
جودي فوق خدي |
الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص481.
[1851] هكذا في الأصل، والصحيح ما في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته:
|
(نساء الجن اسعدن نساء الهاشميات). |
[1852] هكذا في الأصل، والصحيح (يُولولن).
[1853] هكذا في الأصل، والصحيح (المصيبات).
[1854] القفرات: جمع قفر وهي الأرض الخالية التي لا ماء فيها ولا كلأ ولا ناس. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص750، (قفر).
[1855] هكذا في الأصل، وفي المنتخب وينابيع المودة وتظلم الزهراء‘ من إهراق دماء آل العباء: (مرشاد)، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (لينا)، ولعلّه الصحيح؛ لأنّ المؤلف سيقول بعد قليل: ثم رحلوا من وادي لينا.
[1856] هكذا في الأصل، والصحيح (نفذوا).
[1857] هكذا في الأصل، وفي الناسخ (لبا): وهو بين بلد والعقر من أرض الموصل. الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج5، ص9.
[1858] جُهينة أو أجهينة: بلفظ التصغير، قرية كبيرة من نواحي الموصل على دجلة، وهي أول منزل لمن يريد بغداد من الموصل، وعندها مرج، يقال له مرج جهينة، وهي قريبة من القيارة. اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج2، ص194. السعيدي، محمد عبد الغني، من كربلاء إلى دمشق: ص243.
[1859] هكذا في الأصل، والصحيح (وأنفذوا).
[1860] الموصل: مركز محافظة نينوى تقع في شمال العراق، وهي ثاني أكبر مدينة في العراق. سُمِّيت بـالموصل لأنّها توصل بين الشام وخوزستان قديماً، وتُعرَف باسم (مووسل) بالكردية، كما تُسمَّى بـ(الحدباء) و(أم الربيعين). فيها آثار تاريخية وإسلامية، منها مسجد النبيّ يونس× ومنارة الحدباء. هناك عدة مدن تنضم إلى الموصل إدارياً في الوقت الحاضر. يبلغ سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة. اُنظر: السعيدي، محمد عبد الغني، من كربلاء إلى دمشق: ص237ـ241.
[1861] هكذا في الأصل، والصحيح (أمير).
[1862] هكذا في الأصل، والصحيح (يقال له).
[1863] خالد بن النشيط: لم نعثر على ترجمته.
[1864] هكذا في الأصل، والصحيح (تداعى).
[1865] أي ما يقارب عشر كيلو مترات.
[1866] هكذا في الأصل، والصحيح (تداعوا).
[1867] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (أربعين ألف).
[1868] الأوس والخزرج قبيلتان من قبائل غسّان بن الأزد الكهلانية القحطانية، هاجرت إبان انهيار سدّ مأرب لتستوطن يثرب أو ما يعرف اليوم بالمدينة المنورة في الحجاز بجانب الخزرج. وقد اشتهرت هاتان القبيلتان بالأنصار إلى يومنا هذا؛ لأنّهم نصروا رسول الله محمد’، وقد قام الرسول بالمؤاخاة بينهم وبين المهاجرين.
[1869] هكذا في الأصل، والصحيح (محمد)، ويمكن تصحيح قراءة النصب على القطع عن التبعية بتقدير (أعني).
[1870] هكذا في الأصل، والصحيح (يأخذوا).
[1871] اُنظر ايضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص180ـ183. الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص35. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص293، المجلس السابع والعشرون. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص66ـ67.
[1872] هكذا في الأصل، والصحيح (ثلاثين).
[1873] هكذا في الأصل، والصحيح (يدخلوها).
[1874] تل أعفر: هكذا تقول عامة الناس، وأما خواصهم فيقولون تل يعفر، وقيل إنّما أصله التل الأعفر للونه فغير بكثرة الاستعمال وطلب الخفة. وهي مدينة عراقية، من أكبر المدن التابعة لمحافظة نينوى شمال العراق، تقع غربي الموصل، بينها وبين سنجار، بالقرب من الحدود السورية والتركية. تبعد عن سنجار (50كم)، وعن الموصل (70كم)، جميع سكانها مسلمون، أغلبهم من التركمان. فيها قلعة تلعفر وسُمّيت بها. في وسطه واد فيه نهر جاري على تل منفرد، حصينة محكمة، وفي مائها عذوبة، وبها نخيل كثيرة يُجلَب رطبه إلى الموصل. يرجع تاريخها إلى العصر الحجري (6000 ق . م). اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج2، ص39. السعيدي، محمد عبد الغني، من كربلاء إلى دمشق: ص249. الموسوعة الحرة ويكيبيديا.
[1875] نَصِيبين: يقول الحموي: «هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادّة القوافل من الموصل إلى الشام، وفيها وفي قراها ـ على ما يذكر أهلها ـ أربعون ألف بستان، بينها وبين سنجار تسعة فراسخ، وبينها وبين الموصل ستّة أيّام». وهي مدينة تاريخية تقع في الجزيرة الفراتية العليا تقع حالياً ضمن الحدود التركية تابعة لمحافظة (ماردين) على مسافة (61كم) جنوب شرق. تقع بين نهري دجلة والفرات ملاصقة لمدينة القامشلي. تُعدّ من المدن السياحية الهامة في جنوب شرق تركيا. اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج5، ص288. السعيدي، محمد عبد الغني، من كربلاء إلى دمشق: ص299.
[1876] شهّر بفلان: فضحه وجعله شهرة. العنوة: أخذ الشـيء قهراً وقسـراً. اُنظر: الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: ج7 ص68، (شهر) ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج15، ص101، (عنا).
[1877] هكذا في الأصل، والصحيح (يجئكم).
[1878] هكذا في الأصل، والصحيح (إلهٍ).
[1879] هكذا في الأصل، والصحيح (لظى).
[1880] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص183ـ184. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص294، المجلس السابع والعشرون. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص67.
[1881] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، وأسرار الشهادات، وناسخ التواريخ، واللفظ للأول: (قال أبو مخنف&: وجعلوا يسيرون إلى عين الوردة، وأتوا إلى قريب دعوات، وكتبوا إلى عاملها أن تلقّانا فإنّ معنا رأس الحسين×...). أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص184.
[1882] حَلَب: بالتحريك: مدينة عظيمة مشهورة بالشام، واسعة كثيرة الخيرات طيبة الهواء صحيحة الأديم والماء، وهي قصبة جند قنسرين في أيامنا هذه. ويقال سُمِّيت حلب لأنّ إبراهيم×، كان يحلب فيها غنمه في الجمعات ويتصدّق به فيقول الفقراء: حلب حلب، فسُمِّي به. وقال آخرون: إنّ حلب وحمص وبرذعة كانوا إخوة من بني عمليق فبنى كلّ واحد منهم مدينة فسُمِّيت به. وفيها مجموعة من الأبواب لكل باب اسم. واليوم تقع شمال سوريا وهي أكبر مدينة فيها من حيث عدد السكان. اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج2، ص282. السعيدي، محمد عبد الغني، من كربلاء إلى دمشق: ص374 وما بعدها.
[1883] باب الأربعين: أحد أبواب حلب المشهورة، وهو مدخل أهل العراق. اختُلِف في تسميته بهذا الاسم، فقيل: إنّه خرج منه مرة أربعون ألفاً فلم يعودوا. وقيل: إنّما سُمِّي بذلك لأنّه كان بالمسجد الذي داخله أربعون من العبّاد يتعبدون فيه، وكان الباب مسدوداً. وقيل: أربعون محدّثاً. وقيل: كان به أربعون شريفاً، وإلى جانب أعلى مسجد الأشراف مقبرة. اُنظر: سبط ابن العجمي، أحمد بن إبراهيم، كنوز الذهب في تاريخ حلب: ج1، ص557.
[1884] إكسير العبادات في أسرار الشهادات: (الدّلاّلين)
[1885] وفي نور العين قال: (ولم يزالوا سائرين حتى أقبلوا على كفر نوبة، وكتبوا إلى صاحب حلب: تلقّانا فإنّ معنا رأس خارجي. فلمّا وصله الكتاب فرح فرحاً شديداً، وأمر بنشر الأعلام وأخذ قومه وخرجوا لمقابلتهم من نحو ثلاثة أميال، وأنزلهم عنده وأقاموا ثلاثة أيّام وأكرمهم غاية الإكرام). الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص35.
وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، وأسرار الشهادات وناسخ التواريخ واللفظ للأول: (وجعلوا يسيرون إلى عين الورد، وأتوا إلى قريب دعوات، وکتبوا إلى عاملها أن تلقّانا؛ فإنّ معنا رأس الحسين. فلمّا قرأ الكتاب أمر بضرب البوقات، وخرج يتلقّاهم، فشهروا الرأس ودخلوا من باب الأربعين، فنصبوا رأس الحسين في الرحبة من زوال الشمس إلى العصر. وأهلها طائفة يبكون وطائفة یضحکون). أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص183. اُنظر أيضاً: الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص311ـ312. وفيه رواية طويلة وتفاصيل أكثر، ينقلها عن كتاب أبي مخنف الكبير.
[1886] هكذا في الأصل، والصحيح (التي).
[1887] هكذا في الأصل، والصحيح (رأس الحسين).
[1888] أُنظر أيضاً: الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص312، المجلس الثامن والعشرون. بينما روى صاحب الناسخ الخبر بالعكس تماماً حيث قال: (وفي الخبر أنّ تلك الرحبة التي نُصِب فيها رأس الحسين× لا يجتاز فيها أحدٌ إلّا وتُقضَى حاجته إلى يوم القيامة). لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص68.
[1889] الثمِل: بكسر الميم، الذي أثّر فيه الشراب. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج4، ص1649، (ثمل).
[1890] الدّياجي: جمع دجية وهي الظلمة. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج6 ص2334، (دجا).
[1891] الأعلاج والعلوج: جمع علج، وهو الرجل من كفّار العجم، ويطلق على الذي فيه غلظة، كما يطلقونه على حمار الوحش. اُنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج1، ص228، (علج). الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج1، ص330، (علج).
[1892] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص184ـ185. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص294، المجلس السابع والعشرون. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص67.
[1893] هكذا في الأصل، والصحيح (قِنَّسرين) : يقال سُمِّيت بذلك لأنّ ميسرة بن مسروق العبسي مرّ عليها فلما نظر إليها قال: ما هذه؟ فسُمِّيت له بالرومية. فقال: والله لكأنّها قِنّ نسرٍ، فسُمِّيت قِنّسرين، أو من القنسري أي الشيخ المسن. وهي من المدن السورية الأثرية القديمة. بينها وبين حلب مسافة (40كم)، يقول البغدادي: (مدينة بينها وبين حلب مرحلة، كانت عامرة آهلة، فلمّا غلب الروم على حلب في سنة إحدى وخمسين وثلثمائة خاف أهل قِنّسرين وجلوا عنها وتفرّقوا في البلاد، ولم يبقَ بها إلّا خان تنزله القوافل). اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج4، ص404. البغدادي، عبد المؤمن بن عبد الحق، مراصد الاطّلاع: ج3، ص1126. السعيدي، محمد عبد الغني، من كربلاء إلى دمشق: ص420.
[1894] هكذا في الأصل، والصحيح (السور).
[1895] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، وأسرار الشهادات، وناسخ التواريخ. واللفظ للأول: (... وجعلوا يلعنونهم ويرمونهم بالحجارة، ويقولون: يا فجرة، يا قتلة أولاد الأنبياء، والله لا دخلتم بلدنا ولو قُتِلنا عن آخرنا). أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص185. وفي رواية أخرى في إكسير العبادات: (فلمّا أحسّوا بمجيئهم أغلقوا الباب فناداهم خولي ألستُم تحت الطاعة؟ فقالوا: نعم، ولكن لو قُتِل كبيرُنا وصغيرُنا ما عبر رأس الحسين ابن بنت رسول الله من وسط بلدنا). الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص312، المجلس الثامن والعشرون. وفي نور العين: (ثمّ ارتحلوا على قِنّسرين، فلمّا وصلوها، وبلغ أهلها خبرهم أغلقوا الأبواب في وجوههم، وقالوا: لا يمرّون في بلدنا). الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص35ـ36.
[1896] القصد: استقامة الطريق، ومنه قوله تعالى: (ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)النحل/9، فأرادت بذلك أنّ النبي’ بيّن الطريق المستقيم المؤدّي إلى الرشد. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج3، ص353، (قصد).
[1897] هكذا في الأصل، والصحيح (يا أمة).
[1898] هكذا في الأصل، والصحيح (السوء).
[1899] لا سقىاً لريعكم: صيغة دعاء عليهم، والتقدير لا سقى الله ريعكم.
[1900] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، وأسرار الشهادات، وناسخ التواريخ، واللفظ للأول:
|
(يا أمة السوء لا سقياً لربعكم إلّا العذاب الذي أخنى على لُبد). |
أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص186.
[1901] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (أتوا مَعَرّة النعمان). سُمِّيت بذلك لأنّ النعمان بن بشير مرّ بها فمات له بها ولدٌ فدفنه فيها، وأقام عليه مدة، فسُمِّيت به. وفي جانب سورها من قبل البلد قبر يوشع بن نون×، في برية فيما قيل، وفيها أيضا قبر عبد الله بن عمار بن ياسر الصحابي. وهي مدينة كبيرة قديمة مشهورة بين حلب وحماة. بها الزيتون الكثير والتين ومنها كان أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري. وهي اليوم مدينة تقع جنوبي إدلب في سوريا تبعد عن حلب (84كم)، وعن حماة (60كم). اُنظر: الحموي، ياقوت ابن عبد الله، معجم البلدان: ج5، ص156. السعيدي، محمد عبد الغني، من كربلاء إلى دمشق: ص229
[1902] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (شيرز).
[1903] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وأسرار الشهادات وناسخ التواريخ: (وكان فيها شيخ كبير فقال).
[1904] في ناسخ التواريخ: (يا قوم، هذا رأس الحسين× بن علي المرتضى وفلذة كبد فاطمة الزهراء فلا تُدخِلوهم بلدكم فتفارقوا طريق محمد وآل محمد إلى الأبد...). لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص69.
[1905] هكذا في الأصل، والصحيح (فأمر).
[1906] الناظر: المتولي إدارة أمر، ويطلق على الوزير. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص932، (نظر).
[1907] هكذا في الأصل، والصحيح (وإزالة).
[1908] كفر طاب: بلدة بين المعرة ومدينة حلب، في برية معطشة ليس لهم شرب إلّا ما يجمعونه من مياه الأمطار في الصهاريج. تبعد عن مدينة حماة (35كم)، وعن مدينة حلب (100كم)، وعن مدينة إدلب (70كم). تقع اليوم على الطريق الدولي بين حلب ودمشق. لم يبق منها شيء، وأقرب نقطة لها هي (خان شيخون) السورية على مقربة (3كم). اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج4، ص470. السعيدي، محمد عبد الغني، من كربلاء إلى دمشق: ص437ـ439.
[1909] هكذا في الأصل وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته (سيبور). وعند الحموي: شَيزر: بتقديم الزاي على الراء، وفتح أوله: قلعة قديمة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة، بينها وبين حماة يوم. تعد في كورة حمص. وهي اليوم تابعة لمحافظة حماة تقع على نهر العاصي تبعد عن مدينة حماة السورية (30كم)، وأهم معالمها قلعة (شيزر). اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج3، ص383. السعيدي، محمد عبد الغني، من كربلاء إلى دمشق: ص445ـ447.
[1910] وفي مقتل المنقري: (وآل سفيان تجري تحتها النجب). المنقري، نصر بن مزاحم، مقتل الحسين×، نسخة خطية، تحت التحقيق في مؤسسة وارث الأنبياء×.
[1911] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص186. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص295، المجلس السابع والعشرون، لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص69، وفيها ـ واللفظ للأول ـ بعد الأبيات (قال: وكان فيها شيخ كبير وقد شهد عثمان بن عفان فجمع أهل سيبور المشايخ والشبان منهم، فقال: يا قوم هذا رأس الحسين×، قتلته هؤلاء اللعناء. فقالوا: والله ما يجوز في مدينتنا).
[1912] هكذا في الأصل، لم نعثر عليها، ولعلّ المراد (شيرز) التي تقدّم قوله عنها (فأجازوه إلى شيرز).
[1913] هكذا في الأصل، والصحيح (نظر).
[1914] هكذا في الأصل، ولعلّ المراد (شدّوا) أو (لبسوا).
[1915] هكذا في الأصل، والصحيح (وثمانون).
[1916] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (ستمائة فارس).
[1917] في رواية إكسير العبادات في أسرار الشهادات: (فقتلوا من أصحابه أربعين رجلاً وقتل من أهل شيزر تسعة رجال).
[1918] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (سيبور).
[1919] في نور العين: (وارتحلوا إلى شيراز فتقلّد أهلها السيوف وركبوا القنطرة، فلمّا وصلوا إليهم قال لهم خولي: لا تفعلوا ذلك يا أهل شيراز. فلم يلتفتوا إليه بل حملوا عليهم وقاتلوهم حتى قتلوا منهم ستة وثمانين فارساً، وقُتل منهم خمسة رجالٍ، فعند ذلك قالت أُمّ كلثوم: «ما يقال لهذه المدينة؟». فقالوا: شيراز. فقالت: أعذب الله ماءها، وأرخص أسعارها، ورفع أيدي الظالمين عنها). الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص36.
[1920] في الأصل بياض، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (حما)، وفي نور العين: (طريق آخر واحتملوا إلى حماة).
[1921] حماة: مدينة قديمة يرجع تاريخها إلى ما قبل الميلاد. وصفها الحموي بأنّها «مدينةٌ كبيرةٌ عظيمة، كثيرة الخيرات، رخيصة الأسعار، واسعة الرقعة، حَفِلة الأسواق. يحيط بها سورٌ محكم، وبظاهر السور حاضرٌ كبيرٌ جداً، فيه أسواقٌ كثيرة، وجامعٌ مفرد، مشرفٌ على نهرها المعروف بالعاصي»، وهي اليوم من المدن السورية الكبيرة الجميلة، تبعد عن العاصمة دمشق (210كم) وعن مدينة حلب (135كم). اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج2، ص300. السعيدي، محمد عبد الغني، من كربلاء إلى دمشق: ص467.
[1922] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وإكسير العبادات في أسرار الشهادات: (الستور)، وفي الناسخ (السّور).
[1923] هكذا في الأصل، والصحيح (والله).
[1924] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وأسرار الشهادات وناسخ التواريخ واللفظ للأول: (والله لا تدخلن بلدنا ولو قتلنا عن آخرنا). أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص187. وفي نور العين: (فغلق أهلها الأبواب في وجوههم، فقالت أُمّ كلثوم رضي الله عنها: «ما يقال لهذه المدينة؟». فقالوا: حماة. فقالت: «حماها الله من كلّ ظالم») الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص36.
[1925] في إكسير العبادات في أسرار الشهادات: (الرستن) والرقتان: تثنية الرقة أظنهم ثنوا الرقة والرافقة، كما قالوا العراقان للبصرة والكوفة. والرَقَّة: جمعها رقاق وهي الأرض التي ينصب عليها الماء. مدينة مشهورة على الفرات من جانبها الشرقي، بينها وبين حران ثلاثة أيام. وهي اليوم محافظة في شمال سوريا تقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات، على بعد حوالي (200 كم) شرق مدينة حلب. فيها آثار قديمة وأضرحة لبعض الصحابة منهم الصحابي الجليل عمار بن ياسر وأويس القرني. اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج3، ص57ـ58. السعيدي، محمد عبد الغني، من كربلاء إلى دمشق: ص347.
[1926] هكذا في الأصل، والصحيح (أخا)، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وأسرار الشهادات وناسخ التواريخ: (أميرها خالد بن النشيط).
[1927] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (أمر بأعلام فنُشِرت، والمدينة فزُيِّنت، وتداعى الناس من كلّ جانب ومكان).
[1928] هكذا في الأصل، والصحيح (فازدحم).
[1929] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (فارساً).
[1930] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، وناسخ التواريخ: (يا قوم، أكفر بعد إيمان، وضلال بعد هدى).
[1931] تدمر: مدينة قديمة بالبرية في سوريا، على طريق الشام. يقال إنّ الجن بنتها لسليمان×. اُنظر: البكري الأندلسي، عبد الله، معجم ما استعجم: ج1، ص306.
[1932] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وأسرار الشهادات، وناسخ التواريخ: (قِسّيس).
[1933] هكذا في الأصل، وفي العبارة سقط.
[1934] هكذا في الأصل، والصحيح (خولياً وشمراً).
[1935] هكذا في الأصل، والصحيح (لعنهما).
[1936] هكذا في الأصل، والصحيح (يدخلوها).
[1937] بَعلَبكّ: مدينة قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور على أساطين الرخام، لا نظير لها في الدنيا. بينها وبين دمشق ثلاثة أيام. مدينة لبنانية تقع في البقاع الغربي، وهي أكبر الأقضية في لبنان مساحة، تحدها من الشمال والشرق الحدود السورية. اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج1، ص453. السعيدي، محمد عبد الغني، من كربلاء إلى دمشق: ص549ـ550.
[1938] هكذا في الأصل، والصحيح (القنا).
[1939] هكذا في الأصل، والصحيح (وتلقّوهم).
[1940] خلوق: نوع من الطيب معروف، مركب من الزعفران وغيره، تغلب عليه الصفرة والحمرة. اُنظر: ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج3، ص71. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص252، (خلق).
[1941] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، وأسرار الشهادات، وناسخ التواريخ: (أباد الله خضراءهم).
[1942] اُنظر أيضاً: الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص317، المجلس الثامن والعشرون.
[1943] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (قالوا).
[1944] هكذا في الأصل، والصحيح (نالهم).
[1945] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (صومعة راهب) والصومعة: مَنارة الراهِبِ يترهّب فيها. والمتصمّع كلّ منضم، والأصمع الملتصق الأذنين بالرأس. وسُمِّت الصومعة بذلك لانضمام الراهب إليها. اُنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج1، ص316. ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة: ج3، ص310. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج8، ص208، (صمع)
[1946] هكذا في الأصل، والصحيح (تهدأ).
[1947] العيس: الإبل تضرب لونها إلى الصفرة. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج3، ص954، (عيس).
[1948] هكذا في الأصل، والصحيح (تحمى).
[1949] الغارب: الكاهل وأعلى كلّ شيء. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص647، (غرب).
[1950] هكذا في الأصل، والصحيح (أسارى).
[1951] هكذا في الأصل، والصحيح (المختار)، وهو الرسول الأكرم محمد’.
[1952] هكذا في الأصل، والصحيح (سمع).
[1953] هكذا في الأصل، والصحيح (فرأوا).
[1954] هكذا في الأصل، والصحيح (كتائب)؛ ممنوع من الصرف.
[1955] هكذا في الأصل، والصحيح (على ابن).
[1956] هكذا في الأصل، والصحيح (فزعاً).
[1957] هكذا في الأصل، والصحيح (ناداهم).
[1958] هكذا في الأصل، والصحيح (لعنهما).
[1959] هكذا في الأصل، والصحيح (وصُيِّر).
[1960] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وأسرار الشهادات وناسخ التواريخ: (إذا قُتِل هذا الرّجل تمطُرُ السّماء دماً ولا يكون هذا إلّا بقتل نبيّ أو وصي نبيّ).
[1961] حرفا استفهام: الهمزة وهل.
[1962] هكذا في الأصل، والصحيح (يا أبا).
[1963] هكذا في الأصل، والصحيح (ألّا أكون)، فتكون (أن) هذه زائدة.
[1964] هكذا في الأصل، والصحيح (فأقرءه).
[1965] هكذا في الأصل، والصحيح (واشهد).
[1966] هكذا في الأصل، والصحيح (فظيع). والفظيع: الأمر العظيم. اُنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج2، ص89.
[1967] نقول: إنّ قصة إسلام الراهب ومعجزة الرأس المقدس مسطورة في كتب المؤرخين والمحدثين السنة والشيعة المعتبرة باختلاف يسير. اُنظر: لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص71.
[1968] هكذا في الأصل، والصحيح (أترجو).
[1969] هكذا في الأصل، والصحيح (يخشوه).
[1970] هكذا في الأصل، والصحيح (في يوم المآبِ).
[1971] اُنظر أيضاً: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص187ـ193. الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص36. الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص482ـ483. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص296ـ298، المجلس السابع والعشرون. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص70ـ72. القزويني، رضي بن نبي، تظلم الزهراء‘ من إهراق دماء آل العباء: ص310ـ311. القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج3، ص89ـ90. وفيه: (قال أبو مخنف: نصبوا الرمح الذي عليه الرأس الشريف المبارك المكرم إلى جانب صومعة الراهب فسمعوا صوت هاتف ينشد ويقول:
|
والله ما جئتكم
حتى بصـرت به مات الحسين
غريب الدار منفرداً |
تقدّم قريب من هذه الأبيات من المؤلف لما كان سبايا أهل البيت في الكوفة. فسمعت أم كلثوم هاتفاً يسمع صوتهُ ولا يرى شخصهُ.
[1972] هكذا في الأصل، والظاهر أن عبارة (من تحتها) زائدة.
[1973] هكذا في الأصل، وفي مدينة المعاجز: (وأقبلت الرايات من تحتها التكبير والتهليل، وإذا من تحتها هاتف يقول). البحراني، هاشم بن سليمان، مدينة المعاجز: ج4 ص108. وفي اللهوف: (فرُوِي أنّ بعض فضلاء التابعين لما شاهدا رأس الحسين× بالشام أخفى نفسه شهراً من جميع أصحابه فلمّا وجدوه بعد إذ فقدوه سألوه عن سبب ذلك فقال ألا ترون ما نزل بنا وأنشأ يقول...). ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص102.
[1974] هكذا في الأصل، والصحيح (جاؤوا).
[1975] متزمّل بدمائه: أي مغطى ومدثّر بها. اُنظر: ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج2، ص313 (زمل).
[1976] هكذا في الأصل، والصحيح (فكأنّما).
[1977] هكذا في الأصل، والصحيح (عامدين).
[1978] هكذا في الأصل، والصحيح (بأن).
[1979] اُنظر أيضاً: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج16، ص181، وقد نسب الأبيات لخالد بن غفران. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص263، وقد نسبها لخالد بن معدان. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص102. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج6 ص261. البحراني، هاشم بن سليمان، مدينة المعاجز: ج4 ص108. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص326، المجلس التاسع والعشرون. الصدر، حسن، تكملة أمل الآمل: ص261، وقد نسبها إلى ديك الجن الشامي العاملي.
[1980] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته وأسرار الشهادات (ثمانية عشر رأساً).
[1981] هكذا في الأصل، والصحيح (فيها).
[1982] هكذا في الأصل، والصحيح (عبيد الله).
[1983] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (القشعم الجعفي)، وقد تقدّمت ترجمته في ص180.
[1984] عون بن علي بن أبي طالب^. أمّه أسماء بنت عميس الخثعمية. عدّه المؤلف والمامقاني وناسخ التواريخ من شهداء كربلاء مع أخيه الإمام الحسين×، ولكنّ مشهور المؤريخين لم يذكروه من الشهداء، بل حتى المؤلف في اللهوف لم يذكره من جملة الشهداء، كما أنّ صاحب ناسخ التواريخ ذكر أنّه لم يجد ذكر شهادته عند المؤرخين، وإنّما ذكر قصة استئذانه للقتال وشهادته اعتماداً على صاحب روضة الأحباب، وقد وصفه بأنّه من أجلة علماء أهل السنة والجماعة. اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج8، ص285. البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج1، ص447. الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج2، ص286. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج7، ص353. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج2، ص430. التستري، محمد تقي، قاموس الرجال: ج8، ص287.
[1985] هكذا في الأصل، والصحيح (وتسيير).
[1986] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (قال سهل: ودخل الناس من باب الخيزران فدخلتُ في جملتهم، وإذا قد أقبل ثمانية عشر رأساً، وإذا السبايا على المطايا بغير وطاء، ورأس الحسين× بيد شمر لعنه الله، وهو يقول: أنا صاحب الرمح الطويل، أنا قاتل ذي الدين الأصيل، أنا قتلتُ ابن سيد الوصيين، وأتيتُ برأسه إلى أمير المؤمنين. فقالت له أم كلثوم‘: كذبتَ يا لعين بن اللعين، ألا لعنة الله على القوم الظالمين. يا ويلك! تفتخر بقتل مَن ناغاه في المهد جبرئيل ومكائيل، ومَن اسمه مكتوب على سرادق عرش ربّ العالمين، ومَن ختم الله بجدّه المرسلين، وقمع بأبيه المشركين؟! فمن أين مثل جدّي محمد المصطفى’، وأبي علي المرتضى×، وأمي فاطمة الزهراء‘؟! فأقبل عليها خولي لعنه الله، وقال: تأبين الشجاعة وأنت بنت الشجاع. قال: وأقبل من بعده رأس الحر بن يزيد الرياحي، وأقبل من بعده رأس العباس×، يحمله قشعم الجعفي لعنه الله، وأقبل من بعده رأس عون× يحمله سنان بن أنس لعنه الله، وأقبلت الرؤوس على أثرهم).
[1987] هكذا في الأصل، والصحيح (فاستحيى).
[1988] فصد المريض: أخرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص690، (فصد).
[1989] هكذا في الأصل، والصحيح (عضّ على أنامله).
[1990] هكذا في الأصل، والصحيح (إلّا).
[1991] هكذا في الأصل، والصحيح (واستهزأ).
[1992] هكذا في الأصل، والصحيح أنّها زائدة.
[1993] باب جيرون: أحد أبواب الجامع الأموي من جهة الشرق، وهو مشرف على حي النوفرة. له عدة تسميات أشهرها باب جيرون. أختُلف في سبب تسميته بهذا الاسم على أقوال: يقول الحموي عنه: (باب جيرون، وفيه فوارة ينزل عليها بدرج كثيرة في حوض من رخام وقبة خشب يعلو ماؤها نحو الرمح). والباب ضخم على جانبيه بابان صغيران. وسُمِّي باب جيرون بباب الساعات أيضاً. اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج2، ص199. السعيدي، محمد عبد الغني، من كربلاء إلى دمشق: ص629.
[1994] باب تُوماء أو تُوما: سُمِّي بهذا الاسم نسبةً للقدّيس (توما) المسيحي أحد رسل المسيح الإثني عشر إلى دمشق، وهو أحد أبواب مدينة دمشق، عليه مئذنة. يقع في الجهة الشمالية الشرقية من سور مدينة دمشق القديمة. يُعتَبر باب توما اليوم من المنشآت العسكرية الأيوبية، يعلوه قوس وشرفتان بارزتان، لهما دور عسكري وتزييني معاً. اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله، معجم البلدان: ج1، ص307. السعيدي، محمد عبد الغني، من كربلاء إلى دمشق: ص627.
[1995] هكذا في الأصل، والصحيح (يومئذ).
[1996] تعادى القوم: تسابقوا في العدو والركض أي يسرعون. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص589، (عدا).
[1997] هكذا في الأصل، والصحيح (يُجلَس في الأعياد).
[1998] هكذا في الأصل، والصحيح (إنّ عبيد الله) الثانية زائدة.
[1999] هكذا في الأصل، والصحيح (منتظرون).
[2000] هكذا في الأصل، والصحيح (بالرؤوس).
[2001] هكذا في الأصل، والصحيح (وا أبتاه).
[2002] هكذا في الأصل، والصحيح (قال).
[2003] هكذا في الأصل، والصحيح (إليك).
[2004] هكذا في الأصل، والصحيح (ولا خنا). والخنا: الفحش. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج6، ص2332، (خنا).
[2005] هكذا في الأصل، والصحيح (فقالت لي).
[2006] هكذا في الأصل، والصحيح (الشّهرزوري).
[2007] في نور العين: (قال سهيل الشهروزي: «كنتُ حاضراً دخولهم، فنظرتُ إلى السبايا، وإذا فيهم طفلة صغيرة على ناقة، وهي تقول: وا أبتاه، وا حسيناه، وا عطشاه. وهي كأنّها القمر المنير فنظرت إليَّ وقالت: يا هذا أما تستحي من الله، وأنت تنظر إلى حريم رسول الله (صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم)؟ فقلتُ لها: والله، ما نظرتُ لكم نظرةً استوجب بها هذا التوبيخ). الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص37.
[2008] هكذا في الأصل، والصحيح (لو).
[2009] الوَرِقُ: الفضة مضروبة كانت أو غير مضـروبة. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص1026، (ورق).
[2010] هكذا في الأصل، ولعلّ الصحيح (ليجعله).
[2011] في اللهوف وغيره واللفظ لصاحب اللهوف: (قال الراوي: وسار القوم برأس الحسين ونسائه والأسرى من رجاله، فلمّا قربوا من دمشق دنت أم كلثوم من شمر ـ وكان من جملتهم ـ فقالت له: لي إليك حاجة: فقال: ما حاجتُكِ؟ قالت: إذا دخلتَ بنا البلد فاحملنا في درب قليل النظارة، وتقدّم إليهم أن يخرجوا هذه الرؤوس من بين المحامل، وينحّونا عنها؛ فقد خُزِينا من كثرة النظر إلينا، ونحن في هذه الحال. فأمر في جواب سؤالها أن يجعل الرؤوس على الرماح في أوساط المحامل بغياً منه وكفراً، وسلك بهم بين النظارة على تلك الصفة حتى أتى بهم باب دمشق، فوقفوا على درج باب المسجد الجامع حيث يُقام السبي). ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص101ـ102.
[2012] هكذا في الأصل، والصحيح (حشرك الله).
[2013] في نور العين: (فقالت: وإلى أين تريد؟ فقلتُ: أريد الحجّ إلى بيت الله وزيارة رسول الله (صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم). فقالت: إذا وصلتَ إلى قبر جدّنا فأقرئه منّي السلام، وأخبره بخبرنا. فقلتُ: حبّاً وكرامةً، وهل لك حاجة غير هذا؟ فقالت: إن كان معك شيء من الفضّة فأعطِ منه حامل رأس أبي، وأمره أن يتقدّم بالرأس أمامنا؛ حتى تشتغل الناس بالنظر إليها عنّا). الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص37.
[2014] هكذا في الأصل، والصحيح (ذليلاً).
[2015] الزّنج: جيل من السودان يتميز بالجلد الأسود والشعر الجعد والشفة الغليظة والأنف الأفطس. يسكن حول خط الاستواء، وتمتد بلادهم من المغرب إلى الحبشة. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص402، (زنج).
[2016] اُنظر أيضاً: الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص483ـ484. البحراني، هاشم بن سليمان، مدينة المعاجز: ج4، ص109ـ110. البحراني، عبد الله، العوالم (الإمام الحسين×): ص427ـ428. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج2، ص78.
[2017] الروشن: الرف والكوة والشرفة، جمعه رواشن. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص347، (رشن).
[2018] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (ثنايا الحسين×).
[2019] هكذا في الأصل، والصحيح (وهلكت).
[2020] وفي نور العين (الفراديس). وهو باب من أبواب دمشق القديمة. يقع في الجهة الشمالية منها، سُمِّي بباب الفراديس لكثرة وكثافة البساتين المقابلة له قديماً. وهو من الأبواب الأساسية في السور الروماني للمدينة. تمّ تجديد الباب في عدة فترات زمنية مع التطوّر العمراني. يؤدّى باب الفراديس إلى سوق حي العمارة القديم، وكذلك من جهة أخرى إلى حارات حي العمارة، والشوارع المرصوفة بالحجارة والأبنية الأثرية. الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج4، ص242. الموسوعة الحرة ويكيبيديا.
[2021] باب الساعات: هو باب جيرون المتقدّم. قيل: سُمِّي بباب الساعات لوجود ساعة خاصة فوقه يُعلَم بها كلّ ساعة تمضى. وقيل: سُمِّي بذلك لأنّهم وقفوا برأس الإمام الحسين× عنده ثلاث ساعات. اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج2، ص280. ابن بطوطة، محمد بن عبد الله، رحلة ابن بطوطة: ص87. البحراني، هاشم بن سليمان، مدينة المعاجز: ج4، ص109.
[2022] هكذا في الأصل، والصحيح (وربّاه).
[2023] اُنظر أيضاً: الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص37. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص332، المجلس التاسع والعشرون. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص76.
وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته بعد هذا الكلام يقول: (وأقبلوا بالراس إلى يزيد بن معاوية لعنه الله، وأوقفوه ساعة إلى باب الساعات، وأوقفوه هناك ثلاث ساعات من النهار. وكان مروان بن الحكم لعنه الله جالساً إلى جنبه، فسألهم: كيف فعلتم به؟ فقالوا: جائنا في ثمانية عشر من أهل بيته ونيف وخمسين من أنصاره، فقتلناهم عن آخرهم، وهذه رؤوسهم والسبايا على المطايا. فجعل مروان بن الحكم يهزّ أعطافه، وهو ينشد ويقول:
|
يا حبّذا بردك
في اليدين |
قال سهل: فدخلتُ مع مَن دخل؛ لأنظر ما يصنع يزيد ـ لعنه الله ـ بهم، فأمر بحطّ الراس عن الرمح، وأن يوضع في طشت من ذهب، ويُغطَّي بمنديل، ويُدخَل به عليه. فلمّا وضع بين يديه سمع غراباً ينعق فأنشأ يقول:
|
يا غراب البين
ما شئتَ فقل وقتلنا الفارس
الليث البطل وعدلناه ببدر فاعتدل |
[2024] هكذا في الأصل، والصحيح (فاستيقظ).
[2025] هكذا في الأصل، والثانية زائدة.
[2026] نقول: اختُلف في قائل هذه الأبيات، كما اختُلف في المكان الذي قيلت فيه على أقوال. اُنظر: الكرباسي، دائرة المعارف الحسينية (ديوان القرن الاول) : ج1، ص35، وفيه مجمل الأقوال، وأما تفصيل الأقوال فهي:
الأول: إنّ قائلها سنان بن أنس، قالها لمّا وقف على باب فسطاط عمر بن سعد، ويقال: إنّه قالها لمّا دخل على عبيد الله بن زياد، فقال عبيد الله: ما تلقى منّي خيراً، إلّا ألحقتُك به، وأمر بقتله. مع أنّ الثابت تاريخياً أنّ سنان قتله المختار. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص205. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص347. الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص117. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص260. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الملوك والأُمم: ج5، ص341. الأمين، محسن بن عبد الكريم، لواعج الاشجان: ص207.
الثاني: قائلها شمر، قالها لعبيد الله بن زياد. اُنظر: البري، محمد بن أبي بكر، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله: ص44.
الثالث: خولي بن يزيد الأصبحي، قالها لعبيد الله بن زياد. اُنظر: ابن سعد، محمد بن سعد، ترجمة الإمام الحسين×: ص75. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج1، ص393. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص252. ابن الأثير، علي ابن أبي الكرم، أُسد الغابة: ج2، ص21. ابن العديم، عمر بن أحمد، بُغية الطلب في تاريخ حلب في تاريخ حلب: ج6، ص2571. الصفدي، خليل بن أيبك، الوافي بالوفيات: ج13، ص273.
الرابع: قالها قاتل الحسين×، قالها لما دخل على يزيد. اُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص79. الراوندي، سعيد بن هبة الله، الخرائج والجرائح: ج2، ص580.
الخامس: بشر بن مالك قالها لعبيد الله بن زياد، فغضب عبيد الله بن زياد من قوله، ثم قال: إذ علمتَ أنّه كذلك فلم قتلتَه؟! والله لا نلتَ مني خيراً، ولألحقنّك به، ثم قدّمه وضرب عنقه. اُنظر: ابن أعثم الكوفي، أحمد بن اعثم، الفتوح: ج5، ص120. الشافعي، محمد بن طلحة، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول^: ص403. الإربلي، علي بن أبي الفتح، كشف الغمة في معرفة الأئمة: ج2، ص262.
السادس: رجل من مذحج قالها لعبيد الله بن زياد. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4 ص293. المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر: ج3، ص61. المزي، يوسف، تهذيب الكمال: ج6، ص428. الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص309.
[2027] الركاب: ما يوضع على المركوب لحمل الزاد وغيره. اُنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج5، ص364، (ركب).
[2028] جاء في الحديث النبوي الشريف: (علي خير البشر)، كما جاء عنه’ أن ابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. اُنظر: الكوفي، محمد بن سليمان، مناقب الإمام أمير المؤمنين×: ج2، ص523. الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص175.
[2029] أي لو الناس تفاخروا بأنسابهم، فالإمام الحسين× خيرهم في النسب.
[2030] هكذا في الأصل، والصحيح (مذحج).
[2031] هكذا في الأصل، والصحيح (المهذبا).
[2032] هكذا في الأصل، والصحيح (لا أصل له)، كما سيأتي في ذيل الرواية (79). واُنظر أيضاً: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص128. البحراني، عبد الله، العوالم (الإمام الحسين×) : ص428.
[2033] هكذا في الأصل، والصحيح (قتله).
[2034] هكذا في الأصل، والصحيح (عارفاً).
[2035] راجع الوصية في ص64.
[2036] الأحمر بن شمط، ويقال أحمر بن شُمِيط الأحمسي البجلي. أحد قادة جيش المختار الشجعان. شهد أكثر وقائعه ضدّ بني أمية وعبيد الله بن زياد. وجّهه المختار بجيش من الكوفة لقتال مصعب بن الزبير، فتلاقيا في المذار بالقرب من الكوفة، فقتله جيشُ مصعب بن الزبير عام 67هـ، وتفرّق مَن معه. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج6 ص391. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج1، ص276. الأمين، محسن بن عبد الكريم، أعيان الشيعة: ج3، ص221. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج1، ص276.
[2037] هكذا في الأصل، والصحيح (نور ساطع).
[2038] اُنظر أيضاً: الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص37.
[2039] اختلفوا في اسمه، ففي تاريخ الطبري: (الغاز بن ربيعة الجرشي)، وفي مثير الأحزان (العذري بن ربيعة بن عمرو الجرشى)، وفي غيرهما (الغازي بن ربيعة بن عمر الجرشي)، وفي الإرشاد: (عبد الله بن ربيعة الحميري). وهو ابن ربيعة بن عمرو بن عوف الجرشي الحميري من أهل الشام. من الطبقة الثانية، روى عن جماعة من الصحابة، وروى عنه ابنه هشام بن الغاز وأهل الشام. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص351. ابن عبد ربّه الأندلسي، أحمد بن محمد، العقد الفريد: ج5، ص130. ابن حبّان، محمد، الثقات: ج5، ص294. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص118. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج48، ص50. ابن نما الحلّي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص77.
[2040] المعروف والمشهور هو زحر أو زجر بن قيس المذحجي، ويقال الجعفي، وقيل غير ذلك. اُنظر: الري شهري، محمد، موسوعة الإمام الحسين×: ج5، ص225ـ228.
[2041] هكذا في الأصل، والصحيح (عينيك).
[2042] هكذا في الأصل، والصحيح (والظفر).
[2043] هكذا في الأصل، والصحيح (فعرضنا).
[2044] هكذا في الأصل، والصحيح (فأبى).
[2045] الهام: جمع هامة، وهي الرأس. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج5، ص2063، (هيم).
[2046] العقبان: طيور جوارح. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج1، ص621، (عقب).
[2047] الرخمة: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة، والجمع: رخم. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج5، ص1929، (رخم).
[2048] هكذا في الأصل، والصحيح (الذؤبان)، جمع ذِئب. اُنظر: ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج2، ص171، (ذوب).
[2049] هكذا في الأصل، والصحيح (ثانٍ).
[2050] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (قال: ثم سألهم يزيد لعنه الله كيف فعلتم بالحسين؟ فقالوا: جائنا في ثمانية عشر من أهل بيته، ونيف وخمسين من أصحابه وأنصاره. فسألناهم أن ينزلوا على حكم الأمير أو القتال، فاختاروا القتال، فقتلناهم عن آخرهم. وهذه رؤوسهم، وأجسادهم بأرض كربلاء مطرحة، تصهرهم الشموس، وتذري عليهم الرياح، وتزورهم العقبان. فأطرق يزيد رأسه، وقال: كنتُ أرضى بطاعتكم بدون قتل الحسين).
[2051] «اللُّجَيْنُ: الفضة». ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج13، ص379، (لجن).
[2052] حفّ به وحوله: أحاط به واستدار حوله. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج4 ص1345، (حفف).
[2053] اُنظر أيضاً: الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص37. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص346، المجلس الحادي والثلاثون. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص80.
[2054] آل عمران: 169.
[2055] هكذا في الأصل، والصحيح (السُّوء).
[2056] هكذا في الأصل، والصحيح (وضلّ).
[2057] هكذا في الأصل، والصحيح (فأعدّ).
[2058] هكذا في الأصل، والصحيح (يخزيك).
[2059] اُنظر أيضاً: الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص493ـ495. الدربندي، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص361ـ367، المجلس الحادي والثلاثون. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص89ـ90.
وفي اللهوف يروي الخطبة كاملة فيقول السيد: (فقامت زينب بنت علي بن أبي طالب×، فقالت: الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على رسول وآله أجمعين، صدق الله سبحانه، كذلك يقول: (ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) [الروم: 10]، أظننتَ يا يزيد حيث أخذتَ علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نساق كما تساق الأُسراء، أنّ بنا هواناً على الله، وبك عليه كرامة، وأنّ ذلك لعظم خطرك عنده فشمختَ بأنفك، ونظرتَ في عطفك، جذلان مسروراً حين رأيتَ الدنيا لك مستوثقة، والأمور متسقة، وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا. فمهلاً مهلاً، أنسيتَ قول الله تعالى: (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) [آل عمران: 178]....). ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص105ـ106.
[2060] هكذا في الأصل، وسيأتي منه أنّه أبو بريدة. والمعروف والمشهور بين أرباب السير والتاريخ هو أبو برزة الأسلمي، اسمه ضلة بن عبيد بن الحارث، أبو برزة ـ بفتح الباء الموحدة واسكان الراء وبعدها زاي ـ، الأسلمي الخزاعي، صحابي، من أصفياء أمير المؤمنين×. شَهِد فتح مكة وغزا خراسان، ثمّ سكن البصـرة. اعترض على يزيد بقوله: ويحك!! أتنكت بقضيبك ثغر الحسين ابن فاطمة؟! أشهد لقد رأيتُ النبي يرشف ثناياه وثنايا أخيه، ويقول: أنتما سيدا شباب أهل الجنة، فقتل الله قاتلكما، ولعنه وأعدّ له جهنم وساءت مصيراً. فغضب يزيد وأمر بإخراجه سحباً. وروى عن النبيّ’ ذم معاوية وعمرو بن العاص. توفي سنة 64 هـ، وقيل: 60 هـ. اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج4، ص298. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج4، ص1495. الطوسي، محمد بن الحسن، الأبواب (رجال الطوسي) : ص83. النووي، محيي الدين بن شرف، المجموع: ج3، ص37. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، خلاصة الأقوال: ص306. التفرشي، نقد الرجال: ج5، ص15. الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج20، ص176.
[2061] اُنظر أيضاً: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص356. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص119. ابن نما الحلّي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص79. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4 ص85.
[2062] يحيى بن الحكم بن أبي العاص بن أُميّة، وكنيته: أبو مروان، سكن دمشق، وولّاه ابن أخيه عبد الملك المدينة، وكان به حمق، فعزله عنها، ثمّ ولّاه حمص، ثمّ عزله عنها بطلب من أهلها؛ لسفاهته، وكان عبد الملك يستشيره ويخالف رأيه، ويقول: من أراد صواب الرأي؛ فليخالف يحيى بن الحكم فيما يشير به عليه. وكان مبغضاً لأهل البيت^، وكان يسمِّي المدينة المنورة: (الخبيثة) علماً منه أنّ رسول الله أسماها (طيبة)، وكان يقول: والله لأن أموت وأدفن بالشام الأرض المقدسة، أحبّ إلي من أن أدفن بها. اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج5، ص152. البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج2، ص49، وج7، ص87. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج64، ص119.
[2063] هكذا في الأصل، والصحيح (أخا).
[2064] هكذا في الأصل، والصحيح (بأرض الطفّ أدنى).
[2065] اختُلف في نسبة الأبيات إلى قائلها اختلافاً شديداً، كما اختُلِفت ألفاظها ورواياتها، فقد نسبها البعض ليحيى بن الحكم، وقيل: عبد الرحمن بن الحكم (ت70هـ)، وقيل: عبد الرحمن بن أم الحكم بن عبد الله الثقفي(ت66هـ)، وقيل: الحسن المثنى ابن الإمام الحسن× (ت97هـ)، وقيل: الحسن البصرى (ت110هـ). راجع التفاصيل في دائرة المعارف الحسينية ديوان القرن الأول: ج2، ص88.
[2066] هكذا في الأصل، والصحيح (ولداي).
[2067] هكذا في الأصل، والصحيح (أحبّهما)، وكذا ما بعدها (أبغضهما).
[2068] هكذا في الأصل، وفي الموارد الآتية أيضاً، والصحيح (فأغاظه).
[2069] هكذا في الأصل، وكذا المورد الذي يليه، والصحيح (اغتاظ). والغيْظُ: الغَضب، وقيل: هو أَشدُّ من الغضَب. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج7، ص450، (غيظ).
[2070] هكذا في الأصل، والصحيح (مالك).
[2071] روى ابن حبان والطبراني وابن عساكر وغيرهم، عن أنس بن مالك، قال: استأذن ملك القطر ربَّه أن يزور النبيّ’، فأذن له. فكان في يوم أم سلمة، فقال النبي’: احفظي علينا الباب لا يدخل علينا أحد فبينا هي على الباب إذ جاء الحسين بن علي، فظفر فاقتحم، ففتح الباب فدخل، فجعل يتوثّب على ظهر النبي’، وجعل النبي يتلثّمه ويقبله. فقال له الملك: أتحبّه؟ قال: نعم. قال: أما إنّ أمتَك ستقتله إن شئتَ أريتُك المكان الذي يُقتَل فيه؟ قال: نعم. فقبض قبضة من المكان الذي يُقتَل فيه، فأراه إياه، فجاءه بسهلة أو تراب أحمر، فأخذته أم سلمة فجعلته في ثوبها. قال ثابت: كنا نقول إنّها كربلاء. اُنظر: ابن حبان، محمد، صحيح ابن حبان: ج15، ص142. الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص106. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص189.
نقول: لم يتقدّم منه هكذا حديث. نعم تقدّم في ص305 ـ306، الحديث رقم (61 و62) قريب منه، ولكن الملك كان جبرائيل، وليس ملك القطر.
[2072] اُنظر أيضاً: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص129. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص105. الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص37. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص133.
[2073] هكذا في الأصل، والصحيح (سالك). وسلك: أي سار وذهب. اُنظر: أحمد مختار، عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة: ج2، ص1096، (سلك).
[2074] الغراب: طائر أسود معروف تتشاءم منه العرب، البين: الفراق. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج5، ص2082، (بين). مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص647، (غرب).
[2075] في بعض المصادر أنّها ليزيد بن معاوية لعنه الله، وفي بعضها أنّه تمثّل بها، وأنّها لعبد الله بن الزبعرى الشاعر الجاهلي. اُنظر: أبو الفرج، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص80. الفتال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص191. ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص261. الكرباسي، محمد صادق، دائرة المعارف الحسينية: ج2، ص131ـ134، ديوان القرن الاول.
[2076] نَعَبَ الغرابُ: صاحَ وصَوَّتَ. وفي مضارعه لغتان: كسر العين وفتحها. اُنظر: الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير: ص612. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج1، ص764، (نعب).
[2077] هكذا في الأصل، والصحيح أنّ (قد) زائدة.
[2078] هكذا في الأصل، والصحيح (وقع).
[2079] الأسل: الرماح. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج4 ص1622، (أسل).
[2080] هكذا في الأصل، والصحيح كما ورد في المصادر(لأهلّوا).
[2081] هكذا في الأصل، والصحيح (يزيد).
[2082] القَرْم: السيد المعظّم. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج12، ص473، (قرم).
[2083] عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، أبو هند أم معاوية. والوارد والمشهور هو (لستُ من خندف)، وخندف قبيلة كبيرة ترجع إليها عدة قبائل، منها: قريش وكنانة وأسد والقارة وهذيل وتميم ومزينة وخزاعة وأسلم. وذكر ابن أعثم الكوفي أنّ هذا البيت من إضافات يزيد، وليس لابن الزبعرى. اُنظر: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص129. الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج19، ص304. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، تاريخ بن خلدون: ج2، ق1، ص315ـ319.
[2084] وهو صريح بالكفر وإنكار نبوة محمد’.
[2085] هكذا في الأصل، والصحيح (المجتبى).
[2086] هكذا في الأصل، والصحيح (إثماً).
[2087] محقن ـ ويقال: محفز أو محفر ـ بن ثعلبة العائذي، ملعونٌ خبيث، قدِم برأس الإمام الحسين×، وبقية الرؤوس وسبايا آل رسول الله’ إلى الشام، يسير بهم كما يُسار بسبايا الكفار، يتصفّح وجوههنَّ أهل الأقطار، ودخل على يزيد، فقال: أتيتُك يا أمير المؤمنين، برأس أحمق الناس وألأمهم. فقال يزيد: ما ولدت أُمّ محفز أحمق وألأم، وقد نسب الشيخ المفيد هذا القول إلى الإمام علي بن الحسين÷. اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص119. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج57، ص98. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص100. الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص315.
[2088] هكذا في الأصل، والصحيح (ألأم)، كما في بعض المصادر. اُنظر: ابن سعد، محمد، ترجمة الإمام الحسين× (من الطبقات الكبرى) : ص82. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص355.
[2089] هكذا في الأصل، والصحيح (محفز) أو (محقن) كما تقدّم منه.
[2090] اسمها (عمرة)، وقيل: القائلة أبنته أم كلثوم بنت عمرو بن عبد ود هي ترثيه بهذا الشعر. وقيل: لامرأة من العرب غير أخته. وقيل: للخنساء. اُنظر: الشريف المرتضى، علي بن الطاهر، رسائل الشريف المرتضى: ج4، ص119. الشريف المرتضى، علي بن الطاهر، الأمالي: ج3، ص95. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج1، ص17.
[2091] روى كثير من المؤرخين هذه الأبيات عن أخت عمرو، ولم نجد من نقل استشهاد يزيد لعنه الله بها. اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الفصول المختارة: ص292. الشريف المرتضى، علي بن الطاهر، الأمالي: ج3، ص95. الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك: ج3، ص33.
وقال ابن المنظور في (اللسان): (بَيْضةُ البلد: عليُّ بن أَبي طالب، سلام الله عليه، أَي أنّه فَرْدٌ ليس مثله في الشرف كالبَيْضةِ التي هي تَرِيكةٌ وحدها ليس معها غيرُها؛ وإِذا ذُمَّ الرجلُ فقيل هو بَيْضةُ البلدِ أَرادوا هو منفرد لا ناصر له). ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج7، ص127.
[2092] هند بنت عبد الله بن عامر، زوجة يزيد. وقيل: كانت قبله تحت الإمام الحسين×. ولمّا رأت ظلم يزيد على أهل البيت^ خرجت من وراء الستر وشقت الستر وهي حاسرة، ووثبت إلى يزيد. وهي أول من أقام مجلس العزاء على الإمام الحسين× بمشاركة العقيلة زينب‘ وبقية نساء أهل البيت من السبايا. اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسين، تاريخ مدينة دمشق: ج62، ص85. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص143. الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج8، ص602.
[2093] البُرد: جمع بردة، وهي كساء أسود مربع فيه صغر تلبسه الأعراب، ويجمع على برود أيضاً. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج3، ص87، (برد).
[2094] هكذا في الأصل، والصحيح (بالانصراف).
[2095] اُنظر أيضاً: مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: ص200ـ201. الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص485. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص434ـ435. القزويني، رضي بن نبي، تظلم الزهراء‘ من إهراق دماء آل العباء: ص318.
وقريب منها في البحار: (وخرجت هند بنت عبد الله بن عامر بن كريز، امرأة يزيد. وكانت قبل ذلك تحت الحسين× حتى شقت الستر، وهي حاسرة، فوثبت إلى يزيد وهو في مجلس عام، فقالت: يا يزيد أرأس ابن فاطمة بنت رسول الله مصلوب على فناء بابي؟! فوثب إليها يزيد فغطاها، وقال: نعم فأعولي عليه يا هند، وأبكي على ابن بنت رسول الله، وصريخة قريش. عجّلَ عليه ابن زياد لعنه الله فقتله، قتله الله). المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص143.
[2096] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (و دخل علیه شمر، وهو یقول:
|
املأ رکابي فضة
أم ذهباً |
[2097] «نظر إليه شزراً، وهو نظر الغضبان بمؤخّر العين». الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج2، ص696، (شزر).
[2098] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (قال: فنظر إليه شزراً، وقال له: إذا علمتَ أنّه خير الناس أمّاً وأباً فلِمَ قتلتَه، املأ الله ركابك ناراً وحطباً. قال: أطلب منك الجائزة، فلکزه یزید بذبال سیفه. وقال له: لا جائزة لك عندي. فولّى هارباً، فجعل يزيد ينكث ثنايا الحسين، وهو يشرب الخمر ويقول:
|
نفلّق هاماً من
رجال أعزة وأکرم عند الله منّا محلة وأفضل في كلّ
الأمور وأفخر |
[2099] وفي البحار عن سهل أنّ الذي جاء بالرأس الشريف شخص آخر غير شمر، فلمّا قال الأبيات أمر بضرب عنقه. ثم وضع رأس الحسين على طبق من ذهب، وهو يقول: كيف رأيتَ يا حسين؟ اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص128.
[2100] هكذا في الأصل، والمعروف هو (الجالوت). ورأس الجالوت: مقدّم علماء اليهود. وجاء في كتاب رحلة بنيامين أنّ رأس الجالوت مأخوذة من «ريش جالوتا»، وهي كلمة آرامية يهودية، لقب أطلقه اليهود على رئيس الجالية اليهودية والقائم بأمورهم. وتقول التقاليد اليهودية إنّ أول من تقلّد منصب رئاسة الجالوت على يهود العراق هو يكنية ملك يهوذا الذي أسره نبوخذ نصر ـ ملك بابل ـ إلى العراق في حدود سنة 577 ق م. اُنظر: التطيلي، بنيامين، رحلة بنيامين التطيلي: ص384. الجزائريّ، نعمة الله، نور البراهين: ج1، ص431.
[2101] هكذا في الأصل، والصحيح (رأى).
[2102] هكذا في الأصل، والصحيح (سألتُك).
[2103] هكذا في الأصل، والصحيح (محمدٍ).
[2104] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته والمنتخب: (يجعلوه).
[2105] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (فقال: رأس الجالوت ومَن أحق منه بالخلافة، وهو ابن بنت رسول الله’؟! فما أکفرکم!).
[2106] هكذا في الأصل، والصحيح (نيف).
[2107] وفي بعض المصادر (سبعين أباً). اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص110. الصفدي، الخليل بن أيبك، الوافي بالوفيات: ج12، ص265.
[2108] هكذا في الأصل، والصحيح (يمسحون).
[2109] هكذا في الأصل، والصحيح (إلّا برضائي).
[2110] هكذا في الأصل، والصحيح: (شددتم)، كما في المنتخب، بمعنى الحملة في الحرب. وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (وثبتم). اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص475، (شدد).
[2111] في المنتخب: (... وسبيتم حريمه وفرّقتموهم في البراري والقفار...).
[2112] هكذا في الأصل، والصحيح (عن).
[2113] لم نعثر على هذا الحديث، وإنّما الوارد مضمونه، كما نقله كنز العمال: (مَن ظلم معاهداً مقراً بذمته مؤدياً لجزيته كنتُ خصمه يوم القيامة). المتقي الهندي، علي بن حسام، كنز العمال: ج4، ص367.
[2114] هكذا في الأصل، والصحيح (يا أبا عبد الله).
[2115] هكذا في الأصل، والصحيح (برئنا).
[2116] اُنظر أيضاً: الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص38. ابن نما الحلّي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص82. ابن طاووس، عليّ بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص110. الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص486. المجلـسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص141. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص395. المجلس الخامس والثلاثون. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص93.
[2117] هكذا في الأصل، والصحيح (الجاثليق)، بفتح الثاء، وهو: رئيس النصارى في بلاد الإسلام، ولغتهم السريانية. اُنظر: الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين: ج5، ص143، (جثق).
[2118] البيعة: الكنيسة، كما تقدّم بيان معناها.
[2119] أي الرأس الشريف.
[2120] هكذا في الأصل، والصحيح (جئتَ).
[2121] هكذا في الأصل، والصحيح (تخبرنا).
[2122] فَقَرتُ فلاناً: أي كسرتُ فقار ظهره، ومنه سُمِّيت الداهية فاقرة. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج2، ص782. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص697، (فقر).
[2123] هكذا في الأصل، والصحيح (فأخذوه).
[2124] هكذا في الأصل، والصحيح (يسحبونه).
[2125] هكذا في الأصل، والصحيح (ويضربونه).
[2126] الأسياط: جمع سوط، وهو جمع شاذ، والمعروف والمطّرد عند العرب جمعه (سياط أو أسواط). اُنظر: الزبيديّ، محمد مرتضى، تاج العروس: ج10، ص300، (سوط).
[2127] هكذا في الأصل، والصحيح (فنادى).
[2128] هكذا في الأصل، والصحيح (اشهد لي).
[2129] هكذا في الأصل، والصحيح (وتاج).
[2130] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (وتاج من نور).
[2131] هكذا في الأصل، والصحيح (يضربونه).
[2132] اُنظر أيضاً: الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص396، المجلس الخامس والثلاثون. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص93.
[2133] هكذا في الأصل، وفي العبارة سقط، والتقدير (ثم خرجت إليه جاريه من داره).
[2134] هكذا في الأصل، والصحيح (ورجليك).
[2135] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (قبّلهما).
[2136] هكذا في الأصل، والصحيح (مفتوحاً).
[2137] هكذا في الأصل، والصحيح (من نور).
[2138] غلام أمرد: الذي خداه أملسان لا شعر فيهما، أُخِذ من قول العرب: شجرة مرداء، إذا سقط ورقها عنها. ويقال : تمرّد الرجل: إذا أبطأ خروج لحيته بعد إدراكه وبلوغه. وقيل: الأمرد الذي طر شاربه وبلغ خروج لحيته ولم تبد. اُنظر: ابن الأنباري، محمد بن القاسم، الزاهر في معاني كلمات الناس: ص118. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص861، (مرد).
[2139] الزَّبَرْجَدُ والزَّبَرْدَجُ: جَوْهَرٌ معروف، وهو من أَنواع الزُّمُرّد. الزبيديّ، محمد مرتضى، تاج العروس: ج4 ص475، (زبرجد).
[2140] هكذا في الأصل، والصحيح (بأعلى).
[2141] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف المتداول والأسرار: (دُرّيّ). ومعنى: أَدِمَ أَدَماً وأُدْمَةً: اشتدت سُمْرَتُهُ. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص10، (أدم).
[2142] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، وإكسير العبادات: (سام).
[2143] هكذا في الأصل، والصحيح (إسماعيل).
[2144] هكذا في الأصل، والصحيح: (يا أمي حواء).
[2145] هكذا في الأصل، والصحيح (يا أمي).
[2146] هكذا في الأصل.
[2147] هكذا في الأصل، والصحيح (يا أمي).
[2148] هكذا في الأصل والجملة الثانية (وبكا كل) زائدة.
[2149] هكذا في الأصل، والصحيح (زهاء)، و(عن) زائدة. وزهاء الشيء شخصه ومقداره وما يقرب منه. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص405، (زها).
[2150] هكذا في الأصل، والصحيح (هذه).
[2151] هكذا في الأصل، والصحيح (أردتِ).
[2152] وضَع من فلان: أذلّه، حطَّ من قدره وشأنه ودرجته. اُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص1039، (وضع).
[2153] اُنظر أيضاً: الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص432ـ433، المجلس التاسع والثلاثون.
[2154] هكذا في الأصل، والصحيح (استدعى).
[2155] هكذا في الأصل، والصحيح (رأيتِ).
[2156] النكال: العقاب أو النازلة. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص953، (نكل).
[2157] الطلقاء: هم الأسرى الذين خلّى عنهم الرسول’ يوم فتح مكة وأطلقهم ولم يسترقّهم، ومنهم معاوية وأبو سفيان. إعداد مركز المعجم الفقهي، المصطلحات: ص1651.
[2158] هكذا في الأصل، والصحيح (إماؤك).
[2159] عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي، يكنى أبا محمد. وقيل: يكنى أبا عبد الرحمن، والأول أشهر. أمّه ريطة بنت منبه بن الحجاج السهمية. ممّن روى عن النبي’. وهو كأبيه في الرأي والنفاق، من أصحاب معاوية. مات ليالي الحرة في ولاية يزيد بن معاوية، وقيل: بالطائف سنة ست وستين، ويقال: مات سنة تسع وستين، وهو ابن ثنتين وسبعين. اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج4، ص261 وما بعدها. البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير: ج5، ص5. العصفري، خليفة بن خياط، طبقات خليفة: ص550. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج3، ص956ـ957. الطوسي، محمد بن الحسن، الأبواب (رجال الطوسي): ص43. الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج5، ص65.
[2160] هكذا في الأصل، والصحيح (شيئاً).
[2161] هكذا في الأصل، والصحيح (أباكِ).
[2162] هكذا في الأصل، والصحيح (إلى).
[2163] لَخم: إحدى قبائل اليمن نزلت الشام والحيرة، ومنهم آل المنذر ملوك الحيرة. والنسبة إليها (اللَّخمي): بفتح اللام المشددة وسكون الخاء. اُنظر: السمعاني عبد الكريم بن محمد، الأنساب: ج5، ص132. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج12، ص538.
[2164] هكذا في الأصل، والصحيح (خادمةً).
[2165] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (اُم كلثوم).
[2166] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (وقالت: يا عمّتاه، يريد أن تكون بنات الأنبياء خدماً لأولاد الأدعياء).
[2167] هكذا في الأصل، وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (اسکت یا لکع، قطع الله يديك ورجليك، وأخرسك وجعل النار مثواك...).
[2168] هكذا في الأصل، والصحيح (وأعمى عينيك).
[2169] هكذا في الأصل، وفي المنتخب: (إنّ أولاد الأنبياء لا يكونون خدمة لأولاد الأدعياء).
[2170] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (قال: فما استتم كلام الطاهرة حتى صرخ ذلك الملعون وعض على لسأنّه وغلت يداه إلى عنقه).
[2171] اُنظر أيضاً: الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص486. القزويني، رضي بن نبي، تظلم الزهراء‘ من إهراق دماء آل العباء: ص324.
[2172] هكذا في الأصل، والصحيح (يزيد).
[2173] هكذا في الأصل، والصحيح: (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) الحديد: آية 22ـ23.
[2174] الغِلالة بكسر الغين: ثوب رقيق يلبس تحت الثياب ممّا يلي الجلد، جمعه غلائل. وإنّما سُمِّيت غلائل لانغلالها بين الدروع والأجساد. اُنظر: الشريف الرضي، محمد بن الحسين، المجازات النبوية: ص128. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص660، (غلل).
[2175] هكذا رُسِمت في المخطوط.
[2176] هكذا في الأصل، والصحيح (يرتدي).
[2177] نعل صَرّار: النعل التي لها صوت عند المشي. اُنظر: السمعاني، عبد الكريم بن محمد، الأنساب: ج3، ص533. السيوطي، جلال الدين، لب اللباب في تحرير الأنساب: ص161.
[2178] «يقال: اختال فهو مختال. وفيه خيلاء ومخيلة: أي كبر». ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج2، ص93، (خيل)
[2179] «العِطْف: المَنْكِب، وجمعه أَعْطافٌ». ابن سيده، علي بن إسماعيل، المخصص: ج1، ق1(السفر الأول)، ص159.
[2180] هكذا في الأصل، والصحيح (فلذلك) أو (فعند ذلك).
[2181] لقمان: آية 18.
[2182] من التعريض وهو خلاف التصريح، يقال: عَرَّضَ لفلان وبه إِذا قال فيه قولًا وهو يَعِيبُه. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج7، ص183، (عرض).
[2183] هكذا في الأصل، والصحيح (رجلاً).
[2184] هكذا في الأصل، والصحيح (فبكى).
[2185] هكذا في الأصل، والصحيح (بهذا).
[2186] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته:
|
أنادیك یا جداه
یا خیر مرسل |
[2187] هكذا في الأصل، والصحيح (وناديْنَ).
[2188] هكذا في الأصل، والصحيح (وناديْنَ).
[2189] هكذا في الأصل، والصحيح (يا يزيد).
[2190] هكذا في الأصل، والصحيح (فبكى).
[2191] هكذا في الأصل، والصحيح (جلساؤه).
[2192] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (قال: فتصارخن النساء، وبكين حوله. وقالت أم کلثوم‘: یا یزید لقد أرویتَ الأرض من دمائنا، ولم يبقَ غير هذا الصبي، وتعلّقت به النساء جميعاً، وهنّ يندبن: واقلة رجالاه، تقتل الأكابر من رجالنا، وتأسر النساء منّا، ولا ترفع سيفك عن الأصاغر. وا غوثاه! ثم وا غوثاه! یا جبّار السماء، ویا باسط البطحاء. فخشی یزید أن تأخذ الناس الشفقة علیهم، فتشق الفتنة عنده لأجل ضجيج النساء والأطفال، والناس كالجراد حوله ينظرون إلى هذا الأمر الفظيع، ووقع الخوف والرعب في قلب یزید فعفی عنه).
[2193] هكذا في الأصل، والصحيح (هذه).
[2194] هكذا في الأصل، والصحيح (لهم).
[2195] «الذَّرِبُ اللِّسان: الفاحِشُ البَذِيُّ الذي لا يبالي ما قال». ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج1، ص386، (ذرب).
[2196] الجَنَانُ: القلبُ. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج13، ص93، (جنن).
[2197] هكذا في الأصل، والصحيح (الحسين).
[2198] هكذا في الأصل، والصحيح (فصاح).
[2199] هكذا في الأصل، والصحيح (أيّكما).
[2200] هكذا في الأصل، والصحيح (الزهراء).
[2201] هكذا في الأصل، والصحيح (تدعو).
[2202] هكذا في الأصل، والصحيح (أنا ابن خير من حجّ ولبى).
[2203] هكذا في الأصل، والصحيح (أنا ابن خير من طاف وسعى).
[2204] هكذا في الأصل، والصحيح (منى).
[2205] هكذا في الأصل، والصحيح (أنا ابن).
[2206] هكذا في الأصل، والصحيح (أنا ابن من دنا فتدلى).
[2207] هكذا في الأصل، والصحيح (قضى).
[2208] الشورى: آية 23.
[2209] هكذا في الأصل، وفي المنتخب (الاقتراف).
[2210] هكذا في الأصل، والصحيح (أيّها).
[2211] في المنتخب: (أيّها الناس فضّلنا الله بخمس خصال: فينا الشجاعة والسماحة، والهدى والحكم بين الناس بالحق، والحمية في قلوب المؤمنين...).
[2212] في البحار: (ستاً). وهي العلم، والحلم، والسماحة، والفصاحة، والشجاعة، والمحبة في قلوب المؤمنين.
[2213] يقال: يَعُبُّ فيه أَي يَصُبّ فيه. اُنظر: ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج3، ص168، (عبب).
[2214] هكذا في الأصل، والصحيح (لم يصلِِّ).
[2215] اُنظر أيضاً: الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص39ـ40. الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص496. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص100ـ102. القزويني، رضي بن نبي، تظلم الزهراء‘ من إهراق دماء آل العباء: ص317، وص328ـ329.
[2216] هكذا في الأصل، والصحيح (المنهال). وهو المنهال بن عمرو الأسدي، مولى بني أسد. كوفي، أدرك الإمام الحسن×، وروى خطبته عند معاوية. من أصحاب الإمام الحسين×، وولده زين العابدين×. روى عن الإمام السجاد والباقر والصادق^. اُنظر: المغربي، القاضي النعمان، شرح الأخبار: ج2، ص484. الطوسي، محمد بن الحسن، الأبواب (رجال الطوسي): ص306. ابن شهراشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص178. الطبرسي النوري، ميرزا حسين، خاتمة المستدرك: ج9، ص144. الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج20، ص10.
[2217] هكذا في الأصل، والصحيح (كيف حال مَن).
[2218] هكذا في الأصل، والصحيح (أبوه)، وفي المنتخب (أبوه وأهله).
[2219] هكذا في الأصل، والصحيح (نشكو).
[2220] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (فقال له الإمام×: كيف حال مَن أصبح وقد قُتِل أبوه! وقَلّ ناصرُه، وینظر إلى حرم من حوله أُسارى، قد فقدوا الستر والغطاء، وقد أُعدِموا الكافل والحمى! فهل تراني إلّا أسيراً ذليلاً؟! قد عُدِمتُ الناصر والکفیل، قد کُسِیتُ أنا وأهل بیتی ثیاب الأسى، وقد حُرِّم علینا جدید العری، فإن تسأل فها أنا کما ترى، قد شمتت فينا الأعداء ونترقب الموت صباحاً ومساء).
[2221] هكذا في الأصل، والصحيح (مظلومون مقهورون).
[2222] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (قال: فخشِي یزید الفتنة، وقال للذی أصعده المنبر: ويحك أردتَ بصعوده زوال ملکي).
[2223] هكذا في الأصل، والصحيح (العُصَيَّة). وهو مثل يضرب في تشبيه الرجل بأبيه، وأصل المثل: العصية من العصا، أي أنت من أبيك، وقيل: المراد به أنّ الأمر الكبير يكون أوله صغيراً، كما تكون العصا العظيمة من الغصن الدقيق. اُنظر: ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم، غريب الحديث: ج2، ص193. أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله، جمهرة الأمثال: ج2، ص40ـ41.
[2224] وفي مناقب آل أبي طالب: إنّ يزيد لعنه الله طلب من الإمام زين العابدين× مصارعة ولده خالد، فقال له الإمام×: وما تصنع بمصارعتي إياه، اعطني سكيناً ثم أقاتله، فقال يزيد: شنشنة أعرفها من أخزم، ثم قال:
|
هذا من العصا عصية هل تلد الحية إلّا حية |
وقوله: (هل تلد الحية إلّا حية) مثل يضرب للولد الذي يشبه أباه. اُنظر: الزمخشري، محمود بن عمرو، المستقصى في أمثال العرب: ج2، ص390. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص309.
والمشهور أنّ يزيد طلب من عمرو بن الحسن×، وقيل عمر بن الحسين× مبارزة ولده خالد. ولم يطلب من الإمام السجاد×. اُنظر: ابن سعد، محمد، ترجمة الإمام الحسين× (من الطبقات الكبرى): ص84. الدينوري، أحمد بن داوود، الأخبار الطوال: ص261. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص354. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج69، ص177. ابن نما الحلي، محمد بن جعفر، مثير الأحزان: ص84. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص113. ابن كثير، إسماعيل، البداية والنهاية: ج8، ص212. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص143.
[2225] اُنظر أيضاً: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص132ـ133. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص137ـ139.
[2226] هكذا في الأصل، والصحيح (فقام).
[2227] هكذا في الأصل، والصحيح (ابن بنت).
[2228] هكذا في الأصل، والصحيح (أهل).
[2229] هكذا في الأصل، والصحيح (شبَث).
[2230] في أسرار الشهادات (مصابر بن الرهيبة). لم نعثر عليه.
[2231] في أسرار الشهادات (الربيع) وفي نور العين: (الحصين بن نُمير).
[2232] الدَّيبَقيُّ أو الدَّبِيقيُّ: ثيابٌ معروفة، تُنسَب إلى دَبِيق، قرية مصرية بينَ الفَرَمَا وتنِّيس، خَرِبَت ولم يبق منها شيء. والثِّيابُ الدَّبِيقِيَّةُ ثياب رقيقة، تُتَّخَذُ منها العِمامَةُ طُولُها مائةُ ذِراعٍ، وفيها رَقَماتٌ مَنْسُوجَةٌ بالذَّهَبِ، تَبْلُغُ العِمامَةُ من الذهَبِ خَمْسَمائة دينارٍ سَوى الحَرِير والغَزْلِ. اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج2، ص437. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج10، ص95، (دبق). الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين: ج5، ص160. الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: ج13، ص133.
[2233] هكذا في الأصل، والصحيح (يا أبا عبد الله).
[2234] هكذا في الأصل، والصحيح (شيئاً).
[2235] هكذا في الأصل، والصحيح (جمع).
[2236] هكذا في الأصل، والصحيح (أيّهما).
[2237] هكذا في الأصل، والصحيح (المقام).
[2238] هكذا في الأصل، ولعلّ الصحيح (أو).
[2239] القباب: جمع قبة، وهي أشبه بالمظلة تُقَبَّبُ بها الهوادج ونحوها. اُنظر: الطريحي، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين: ج2، ص138، (قبب).
[2240] هكذا في الأصل، والصحيح (الدبيقي) أو (الديبقي).
[2241] «المُلْحَم: جنس من الثياب». ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج12، ص538، (لحم).
[2242] «الأنطاع: جمع نَطْع وهو بساط من الأديم». الطريحي، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين: ج4 ص397، (نطع).
[2243] في المنتخب (حياءك).
[2244] اُنظر أيضاً: الطريحي، فخر الدين بن محمد، المنتخب: ج2، ص496ـ497. الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص444ـ445، المجلس الحادي والأربعون. لسان الملك، محمّد تقي، ناسخ التواريخ: ج3، ص104ـ106. القزويني، رضي بن نبي، تظلم الزهراء‘ من إهراق دماء آل العباء: ص333.
[2245] اُنظر أيضاً: الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص451ـ452، المجلس الثاني والأربعون.
[2246] في بعض المصادر أنّه النعمان بن بشير. اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص122. الفتال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص192. الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج1، ص476. ابن نما الحلي، محمد بن جعفر، مثير الأحزان: ص85.
[2247] في نور العين (ألف).
[2248] اُنظر أيضاً: الأسفراييني، إبراهيم بن محمد، نور العين: ص40ـ41. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج69، ص177. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الملوك والأُمم: ج5، ص344. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص87.
وفي مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: «فسار بهم من دمشق. وكان يقدمهم تارة، ويتأخّر عنهم تارة، وأحسن لهم الصحبة والنصيحة والخدمة اللائقة. قال: فعند ذلك قالوا له: مُرّ بنا على كربلاء. فمر بهم، فوجد جابر بن عبد الله الأنصاري ومعه جماعة، قد أتوا إلى زيارة الحسين×. فعند ذلك نزلوا وجدّدوا الأحزان، وشققوا الجيوب، ونشروا الشعور، وأبدوا ما كان مكتوماً من الأحزان، وأقاموا عنده أياماً، ثم رحلوا قاصدين المدينة».
وفي البحار: «ثم انفصلوا من كربلا طالبين المدينة، قال بشير بن حذلم: فلما قربنا منها نزل علي ابن الحسين÷ فحطّ رحله، وضرب فسطاطه وأنزل نساءه، وقال: يا بشير! رحم الله أباك لقد كان شاعراً، فهل تقدر على شئ منه؟ قلتُ: بلى يا ابن رسول الله، إنّي لشاعر، قال: فادخل المدينة، وانعَ أبا عبد الله. قال بشير: فركبتُ فرسي، وركضتُ حتى دخلتُ المدينة، فلمّا بلغتُ مسجد النبيّ’ رفعتُ صوتي بالبكاء، وأنشأت أقول:
|
یا أهل یثرب لا مقام لکم بها |
المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص147.
[2249] هكذا في الأصل، والصحيح (أنّهنّ).
[2250] هكذا في الأصل، والثانية زائدة.
[2251] هكذا في الأصل، والصحيح (فلقد).
[2252] هكذا في الأصل، والصحيح (سائراً).
[2253] هكذا في الأصل، والصحيح (وجعل الناس يُعزّونها).
[2254] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته: (قال فحنّ القبر حنيناً عالياً، وضجّت الناس بالبكاء والنحيب).
[2255] لعلّ هذا النقل من إضافات الكيسانية الذين يعتقدون بإمامة محمد بن الحنفية، وأنّه الإمام المهدي، وأنّه غائب. اُنظر: المرتضى، علي بن الحسين، الشافي في الإمامة: ج2، ص147. ابن حزم، علي بن أحمد، الفصل في الملل والنحل: ج4، ص167.
[2256] اختُلِف في موضع الرأس الشريف على أقوالٍ، منها:
الأوّل: أنّه دُفِن عند أبيه أمير المؤمنين× بالنجف.
الثاني: أنّه مدفون مع الجسد الشريف. وقال صاحب البحار: إنّه المشهور بين علمائنا الإماميّة، والذي ردّه هو الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين×. وقال صاحب اللهوف: كان عمل الطائفة على هذا. وقال ابن نما: والذي عليه المعوّل من الأقوال أنّه أُعيد إلى الجسد بعد أن طِيف به البلاد ودُفن معه.
الثالث: أنّه مدفونٌ بظهر الكوفة دون قبر أمير المؤمنين×. اُنظر: الطبرسي، الفضل بن الحسن، تاج المواليد: ص33. الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج1، ص477. ابن نما، جعفر بن محمد، مثير الاحزان: ص85. ابن طاووس، عليّ بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص123. المجلسي، محمّد باقر، بحار الانوار: ج45، ص144. الأمين، محسن بن عبد الكريم، لواعج الأشجان: ص248. آل شبيب، تحسين، مرقد الإمام الحسين×: ص172. وراجع بقية الأقوال في كتاب تظلم الزهراء‘ من إهراق دماء آل العباء: ص336 وما بعدها.
[2257] هكذا في الأصل، والصحيح (ومانعيهم).
[2258] في مقتل أبي مخنف، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته، تحت عنوان: (موت یزید): (ثم إنّ یزید بقي بعد الحسین× أياماً قليلة، وخرج ذات يوم إلى الصيد في عسكره، فلاحت له ظبية، فطلبها، وقال لأصحابه: لا یتبعني منکم أحد، فرکض شدیداً حتی وصل إلى مکان لا يهتدى فيه طريقاً، فلقيه أعرابي وقال له: أضالّ فأرشدك أم جائع فأطعمك أم عطشان فأسقیك؟ فقال يزيد: لو عرفتَني لزدتَ کرامتي. فقال الأعرابي: مَن أنت؟ فقال: أنا یزید. فقال الأعرابي: لا مرحباً بك، ولا أهلاً. ما أقبح طلعتك وما أشنع سمعتك. والله لأقتلنّك كما قتلتَ الحسين. وجذب سیفه، وهمّ أن یعلوه، فذعرت فرس یزید من بریق السيف فطرحته تحتها وقطعت أمعاءه. وقال بعضهم: إنّه هلك عطشاً. وقيل: ورد على قليب ماء، وقلبه يلهب عطشاً، وعلى القليب طائر عظيم الجثة فأراد أن يشرب فابتلعه الطيرُ وطار به نحو السماء، ورجع إلى ذلك الماء فتقيأه خلقاً سویاً، فهمّ أن یشرب ثانیة، فأهوی إلیه الطیر فقطعه بمنقاره، ولم يزل يلتقمه ويتقيأه إلى يوم القيامة، ثم الانتقام منه في جهنم، فإنّها مقرّه لعنه الله، ولعنة الله على الظالمين).