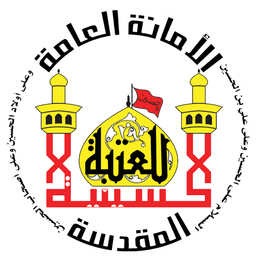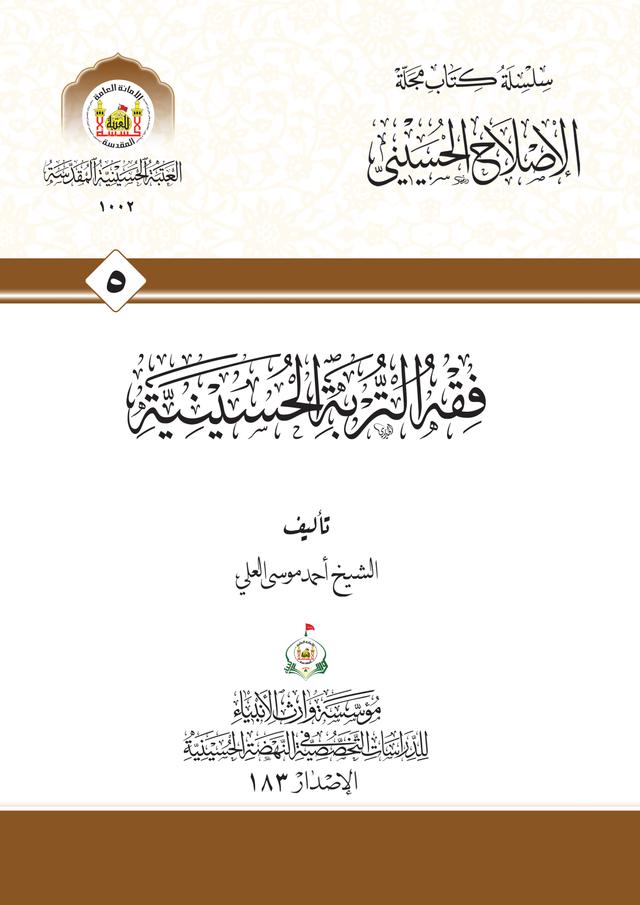بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين.
إنّ العلم والمعرفة مصدر الإشعاع الذي يهدي الإنسان إلى الطريق القويم، ومن خلالهما يمكنه أن يصل إلى غايته الحقيقيّة وسعادته الأبديّة المنشودة، فبهما يتميّز الحقّ من الباطل، وبهما تُحدّد خيارات الإنسان الصحيحة، وفي ضوئهما يسير في سبل الهداية وطريق الرشاد الذي خُلق من أجله، بل على أساس العلم والمعرفة فضّله الله على سائر المخلوقات، واحتجّ عليهم بقوله: (وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)([1])، فبالعلم يرتقي المرء وبالجهل يتسافل، كما بالعلم والمعرفة تتفاوت مقامات البشر، ويتفوّق بعضهم على بعض عند الله ، إذ (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)([2])، وبهما تُسعد المجتمعات، وبهما الإعمار والازدهار، وبهما الخير كلّ الخير.
ومن أجل العلم والمعرفة كانت التضحيات الكبيرة التي قدّمها الأنبياء والأئمّة والأولياء^، تضحيات جسام كان هدفها منع الجهل والظلام والانحراف، تضحيات كانت غايتها إيصال المجتمع الإنساني إلى مبتغاه وهدفه، إلى كماله، إلى حيث يجب أن يصل ويكون، فكان العلم والمعرفة هدف الأنبياء المنشود لمجتمعاتهم، وتوسّلوا إلى الله بغية إرسال الرسل التي تعلّم المجتمعات فقالوا: (وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)([3])، فكانت الإجابة: (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)([4])، ما يعني أنّ دون العلم والمعرفة هو الضلال المبين والخسران العظيم.
بل هو دعاء الأئمّة^ ومبتغاهم من الله لأنفسهم أيضاً، إذ طلبوا منه تعالى بقولهم: «وَاملأ قُلُوبَنا بِالْعِلْمِ وَالمَعْرفَةِ»([5]).
وبالعلم والمعرفة لا بدّ أن تُثمّن تلك التضحيات، وتُقدّس تلك الشخصيّات التي ضحّت بكلّ شيء من أجل الحقّ والحقيقة، من أجل أن نكون على علم وبصيرة، من أجل أن يصل إلينا النور الإلهي، من أجل أن لا يسود الجهل والظلام.
فهذه سيرة الأنبياء والأئمّة^ سيرة الجهاد والنضال والتضحية والإيثار؛ لأجل نشـر العلم والمعرفة في مجتمعاتهم، تلك السيرة الحافلة بالعلم والمعرفة في كلّ جانب من جوانبها، والتي ينهل منها علماؤنا في التصدّي لحلّ مشاكل مجتمعاتهم على مرّ العصور والأزمنة والأمكنة، وفي كافّة المجالات وشؤون البشر.
وهذه القاعدة التي أسّسنا لها لا يُستثنى منها أيّ نبيّ أو وصيّ، فلكلّ منهم^ سيرته العطرة التي ينهل منها البشر للهداية والصلاح، إلّا أنّه يتفاوت الأمر بين أفرادهم من حيث الشدّة والضعف، وهو أمر عائد إلى المهام التي أُنيطت بهم^، كما أخبر بذلك في قوله: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ)([6])، فسيرة النبي الأكرم’ ليست كبقيّة سِيَر الأنبياء^، كما أنّ سيرة الأئمّة^ ليست كبقيّة سِيَر الأوصياء السابقين^، كما أنّ التفاوت في سِيَر الأئمّة^ فيما بينهم ممّا لا شكّ فيه، كما في تفضيل أصحاب الكساء على بقيّة الأئمّة^.
والإمام الحسين تلك الشخصيّة القمّة في العلم والمعرفة والجهاد والتضحية والإيثار، أحد أصحاب الكساء الخمسة الذين دلّت النصوص على فضلهم ومنزلتهم على سائر المخلوقات، الإمام الحسين الذي قدّم كلّ شيء من أجل بقاء النور الربّاني، الذي يأبى الله أن ينطفئ، الإمام الحسين الذي بتضحيته تعلّمنا وعرفنا، فبقينا.
فمن سيرة هذه الشخصيّة العظيمة التي ملأت أركان الوجود، تعلّم الإنسان القيم المثلى التي بها حياته الكريمة، كالإباء والتحمّل والصبر في سبيل الوقوف بوجه الظلم، وغيرها من القيم المعرفيّة والعمليّة، التي كرَّس علماؤنا الأعلام جهودهم وأفنوا أعمارهم من أجل إيصالها إلى مجتمعات كانت ولا زالت بأمسّ الحاجة إلى هذه القيم، وتلك الجهود التي بُذلت من قِبَل الأعلام جديرة بالثناء والتقدير؛ إذ بذلوا ما بوسعهم، وأفنوا أغلى أوقاتهم، وزهرة أعمارهم؛ لأجل هذا الهدف النبيل.
إلّا أنّ هذا لا يعني سدّ أبواب البحث والتنقيب في الكنوز المعرفيّة التي تركها للأجيال اللاحقة ـ فضلاً عن الجوانب المعرفيّة في حياة سائر المعصومين^ ـ إذ بقي منها من الجوانب ما لم يُسلّط الضوء عليه بالمقدار المطلوب، وهي ليست بالقليل، بل لا نجانب الحقيقة فيما لو قلنا: هي أكثر ممّا تناولته أقلام علمائنا بكثير، فلا بدّ لها أن تُعرَف لتُعرَّف، بل لا بدّ من العمل على البحث فيها ودراستها من زوايا متعدّدة، لتكون منهجاً للحياة، وهذا ما يزيد من مسؤوليّة المهتمّين بالشأن الديني، ويحتّم عليهم تحمّل أعباء التصدّي لهذه المهمّة الجسيمة؛ استكمالاً للجهود المباركة التي قدّمها علماء الدين ومراجع الطائفة الحقّة.
ومن هذا المنطلق بادرت الأمانة العامّة للعتبة الحسينيّة المقدّسة لتخصيص سهم وافر من جهودها ومشاريعها الفكريّة والعلميّة حول شخصيّة الإمام الحسين ونهضته المباركة؛ إذ إنّها المعنيّة بالدرجة الأولى وبالأساس بمسك هذا الملف التخصّصي، فعمدت إلى زرع بذرة ضمن أروقتها القدسيّة، فكانت نتيجة هذه البذرة المباركة إنشاء مؤسّسة وارث الأنبياء للدراسات التخصّصيّة في النهضة الحسينيّة، التابعة للعتبة الحسينيّة المقدّسة، حيث أخذت على عاتقها مهمّة تسليط الضوء ـ بالبحث والتحقيق العلميّين ـ على شخصيّة الإمام الحسين، ونهضته المباركة، وسيرته العطرة، وكلماته الهادية، وفق خطّة مبرمجة، وآليّة متقنة، تمّت دراستها وعرضها على المختصّين في هذا الشأن؛ ليتمّ اعتمادها والعمل عليها ضمن مجموعة من المشاريع العلميّة التخصّصيّة، فكان كلّ مشروع من تلك المشاريع متكفِّلاً بجانب من الجوانب المهمّة في النهضة الحسينيّة المقدّسة.
كما ليس لنا أن ندّعي ـ ولم يدّعِ غيرنا من قبل ـ الإلمام والإحاطة بتمام جوانب شخصيّة الإمام العظيم ونهضته المباركة، إلّا أنّنا قد أخذنا على أنفسنا بذل قصارى جهدنا، وتقديم ما بوسعنا من إمكانات في سبيل خدمة سيّد الشهداء، وإيصال أهدافه السامية إلى الأجيال اللاحقة.
المشاريع العلميّة في المؤسّسة
بعد الدراسة المتواصلة التي قامت بها مؤسّسة وارث الأنبياء حول المشاريع العلميّة في المجال الحسيني، تمّ تحديد مجموعة كبيرة من المشاريع التي لم يُسلَّط الضوء عليها كما يُراد لها، وهي مشاريع كثيرة وكبيرة في نفس الوقت، ولكلٍّ منها أهميّته القصوى، ووفقاً لجدول الأولويّات المعتمد في المؤسّسة تمّ اختيار المشاريع العلميّة الأكثر أهميّة، والتي يُعتبر العمل عليها إسهاماً في تحقيق نقلة نوعيّة للتراث والفكر الحسيني، وهذه المشاريع هي:
الأوّل: قسم التأليف والتحقيق
إنّ العمل في هذا القسم على مستويين:
أ ـ التأليف
ويُعنَى هذا القسم بالكتابة في العناوين الحسينيّة التي لم يتمّ تناولها بالبحث والتنقيب، أو التي لم تُعطَ حقّها من ذلك. كما يتمُّ استقبال النتاجات القيِّمة التي أُلِّفت من قبل العلماء والباحثين في هذا القسم؛ ليتمَّ إخضاعها للتحكيم العلمي، وبعد إبداء الملاحظات العلميّة وإجراء التعديلات اللازمة بالتوافق مع مؤلِّفيها، يتمّ طباعتها ونشرها.
ب ـ التحقيق
والعمل فيه قائم على جمع وتحقيق وتنظيم التراث الحسيني، وقد تمّ العمل على نحوين:
الأوّل: التحقيق في المقاتل الحسينيّة، ويشمل جميع الكتب في هذا المجال، سواء التي كانت بكتابٍ مستقلٍّ أو ضمن كتاب، وذلك تحت عنوان: (موسوعة المقاتل الحسينيّة). وكذا العمل جارٍ في هذا القسم على رصد المخطوطات الحسينيّة التي لم تُطبع إلى الآن؛ وقد قمنا بجمع عدد كبير من المخطوطات القيّمة، التي لم يطبع كثير منها، ولم يصل إلى أيدي القرّاء إلى الآن.
الثاني: استقبال الكتب التي تمّ تحقيقها خارج المؤسّسة، لغرض طباعتها ونشرها بعد إخضاعها للتقويم العلمي من قبل اللجنة العلميّة في المؤسّسة، وبعد إدخال التعديلات اللازمة عليها، وتأييد صلاحيتها للنشر، تقوم المؤسّسة بطباعتها.
الثاني: قسم مجلّة الإصلاح الحسيني
وهي مجلّة فصليّة متخصّصة في النهضة الحسينيّة، تهتمّ بنشـر معالم وآفاق الفكر الحسيني، وتسلِّط الضوء على تاريخ النهضة الحسينيّة وتراثها، وكذلك إبراز الجوانب الإنسانيّة والاجتماعيّة والفقهيّة والأدبيّة في تلك النهضة المباركة، وقد قطعت شوطاً كبيراً في مجالها، واحتلّت الصدارة بين المجلّات العلميّة الرصينة في مجالها، وأسهمت في إثراء واقعنا الفكري بالبحوث العلميّة الرصينة.
الثالث: قسم ردّ الشُّبُهات عن النهضة الحسينيّة
إنّ العمل في هذا القسم قائم على جمع الشُّبُهات المثارة حول الإمام الحسين ونهضته المباركة، وذلك من خلال تتبّع مظانّ تلك الشُّبُهات من كتب قديمة أو حديثة، ومقالات وبحوث وندوات وبرامج تلفزيونيّة، وما إلى ذلك، ثُمَّ يتمُّ فرزها وتبويبها وعنونتها ضمن جدول موضوعي، ثمّ يتمُّ الردُّ عليها بأُسلوب علمي تحقيقي في عدَّة مستويات.
الرابع: قسم الموسوعة العلميّة من كلمات الإمام الحسين
وهي موسوعة علميّة تخصّصيّة مستخرَجة من كلمات الإمام الحسين في مختلف العلوم وفروع المعرفة، ويكون العمل فيها من خلال جمع كلمات الإمام الحسين من المصادر المعتبرة، ثمّ تبويبها حسب التخصّصات العلميّة، والعمل على دراسة هذه الكلمات المباركة؛ لاستخراج نظريّات علميّة تمازج بين كلمات الإمام والواقع العلمي. وقد تمّ العمل فيه على تأليف موسوعتين في آن واحد باللغتين العربيّة والفارسيّة.
الخامس: قسم دائرة المعارف الحسينيّة الألفبائيّة
وهي موسوعة تشتمل على كلّ ما يرتبط بالإمام الحسين ونهضته المباركة من أحداث، ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، وأعلام، وبلدان، وأماكن، وكتب، وغير ذلك، مرتّبة حسب الحروف الألفبائيّة، كما هو معمول به في دوائر المعارف والموسوعات، وعلى شكل مقالات علميّة رصينة، تُراعَى فيها كلّ شروط المقالة العلميّة، مكتوبة بلغةٍ عصـريّة وأُسلوبٍ حديث، وقد أُحصي آلاف المداخل، يقوم الكادر العلمي في هذا القسم بالكتابة عنها، أو وضعها بين يدي الكُتّاب والباحثين حسب تخصّصاتهم؛ ليقوموا بالكتابة عنها وإدراجها في الموسوعة بعد تقييمها وإجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل اللجنة العلميّة.
السادس: قسم الرسائل والأطاريح الجامعيّة
يتمّ العمل في هذا القسم على مستويين: الأوّل: إحصاء الرسائل والأطاريح الجامعيّة التي كُتبتْ حول النهضة الحسينيّة، ومتابعتها من قبل لجنة علميّة متخصّصة؛ لرفع النواقص العلميّة وإدخال التعديلات أو الإضافات المناسبة، وتهيئتها للطباعة والنشر. الثاني: إعداد موضوعات حسينيّة ـ يضمّ العنوان وخطّة بحث تفصيليّة ـ من قبل اللجنة العلميّة في هذا القسم، تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعيّة، وتوضع في متناول طلّاب الدراسات العليا.
السابع: قسم الترجمة
الهدف من إنشاء هذا القسم إثراء الساحة العلميّة بالتراث الحسيني عبر ترجمة ما كتب منه بلغات أخرى إلى اللغة العربيّة، ونقل ما كتب باللغة العربيّة إلى اللغات الأخرى، ويكون ذلك من خلال إقرار صلاحيّة النتاجات للترجمة، ثمَّ ترجمته أو الإشراف على ذلك إذا كانت الترجمة خارج القسم.
الثامن: قسم الرَّصَد والإحصاء
يتمُّ في هذا القسم رصد جميع القضايا الحسينيّة المطروحة في جميع الوسائل المتّبعة في نشر العلم والثقافة، كالفضائيّات، والمواقع الإلكترونيّة، والكتب، والمجلّات والنشريّات، وغيرها؛ ممّا يعطي رؤية واضحة حول أهمّ الأُمور المرتبطة بالقضيّة الحسينيّة بمختلف أبعادها، وهذا بدوره يكون مؤثّراً جدّاً في رسم السياسات العامّة للمؤسّسة، ورفد بقيّة الأقسام فيها، وكذا بقيّة المؤسّسات والمراكز العلميّة في شتّى المجالات. ويقوم هذا القسم بإصدار مجلّة شهريّة إخباريّة تسلّط الضوء على أبرز النشاطات والأحداث الحسينيّة محليّاً وعالميّاً في كلِّ شهر، بعنوان: مجلّة الراصد الحسيني.
التاسع: قسم المؤتمرات والندوات والملتقيات العلميّة
يعمل هذا القسم على إقامة مؤتمرات وملتقيات وندوات علميّة فكريّة متخصّصة في النهضة الحسينيّة، لغرض الإفادة من الأقلام الرائدة والإمكانات الواعدة، ليتمّ طرحها في جوٍّ علمي بمحضر الأساتذة والباحثين والمحقّقين من ذوي الاختصاص، وتتمّ دعوة العلماء والمفكِّرين؛ لطرح أفكارهم ورؤاهم القيِّمة على الكوادر العلميّة في المؤسّسة، وكذا سائر الباحثين والمحقّقين، وكلّ من لديه اهتمام بالشأن الحسيني، للاستفادة من طرق قراءتهم للنصوص الحسينيّة وفق الأدوات الاستنباطيّة المعتمَدة لديهم.
العاشر: قسم المكتبة الحسينيّة التخصّصيّة
يضمّ هذا القسم مكتبة حسينيّة تخصّصيّة تعمل على رفد القرّاء والباحثين في المجال الحسيني على مستويين:
أ ـ المكتبة الحسينيّة التخصّصيّة، والتي تجمع التراث الحسيني المخطوط والمطبوع، أنشأتها مؤسّسة وارث الأنبياء، وهي تجمع آلاف الكتب المهمّة في مجال تخصّصها.
ب ـ المجال الإلكتروني، إذ قامت المؤسّسة بإعداد مكتبة إلكترونيّة حسينيّة يصل العدد فيها إلى أكثر من ثمانية آلاف عنوان بين كتب ومجلّات وبحوث.
الحادي عشر: قسم الإعلام الحسيني
يتوزّع العمل في هذا القسم على عدّة جهات:
الأُولى: إطلاع العلماء والباحثين والقرّاء الكرام على نتاجات المؤسّسة وإصداراتها، ونشر أخبار نشاطات المؤسّسة وفعّاليّاتها بمختلف القنوات الإعلاميّة ووسائل التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع.
الثانية: إنشاء القنوات الإعلاميّة، والصفحات والمجموعات الإلكترونيّة في وسائل التواصل الاجتماعي كافّة.
الثالثة: العمل على إنتاج مقاطع مرئيّة في الموضوعات الحسينيّة المختلفة، مختصرة ومطوّلة، وبصورة حلقات مفردة ومتسلسلة، فرديّة وحواريّة.
الرابعة: إعداد وطباعة نصوص حسينيّة وملصقات إعلانيّة، ومنشورات حسينيّة علميّة وثقافيّة.
الخامسة: التواصل مع أكبر عدد ممكن من القنوات الإعلاميّة والصفحات والمجموعات الإلكترونيّة في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتزويدها بأنواع المعلومات من مقاطع مرئيّة ومنشورات وملصقات في الموضوعات الحسينيّة المختلفة الشاملة للتاريخ، والسيرة، والفقه، والأخلاق، وردّ الشبهات، والمفاهيم، والشخصيّات.
الثاني عشر:قسم الموقع الإلكتروني
وهو موقع إلكتروني متخصّص، يقوم بنشر إصدارات وفعاليّات مؤسّسة وارث الأنبياء، وعرض كتبها ومجلّاتها، والترويج لنتاجات أقسامها ونشاطاتها، وعرض الندوات والمؤتمرات والملتقيات التي تقيمها، وكذا يسلِّط الضوء على أخبار المؤسّسة، ومجمل فعّاليّاتها العلميّة والإعلاميّة. بالإضافة إلى ترويج المعلومة الحسينيّة والثقافة العاشورائيّة عبر نشر المقالات المختلفة، وإنشاء المسابقات الحسينيّة، والإجابة عن التساؤلات والشبهات.
الثالث عشر: قسم إقامة الدورات وإعداد المناهج
يتكفّل هذا القسم بإعداد الدورات الحسينيّة في المباحث العقديّة والتاريخيّة والأخلاقيّة، ولمختلف الشرائح والمستويات العلميّة، وكذلك إقامة دورات تعليميّة ومنهجيّة في الخطابة الحسينيّة، كما يضطلع هذا القسم بمهمّة كبيرة، وهي إعداد مناهج حسينيّة تعليميّة وتثقيفيّة لمختلف الفئات وعلى عدّة مستويات:
الأوّل: إعداد مناهج تعليميّة للدراسات الجامعيّة الأوّليّة والدراسات العليا.
الثاني: إعداد مناهج تعليميّة في الخطابة الحسينيّة.
الثالث: إعداد مناهج تعليميّة عامّة لمختلف شرائح المجتمع.
الرابع: إعداد مناهج تثقيفيّة عامّة.
الرابع عشر: القسم النسوي
يعمل هذا القسم من خلال كادر علمي متخصّص وبأقلام علميّة نسويّة في الجانب الديني والأكاديمي على تفعيل دور المرأة المسلمة في الفكر الحسيني، ورفد أقسام المؤسّسة بالنتاجات النسويّة، كما يقوم بتأهيل الباحثات والكاتبات ضمن ورشات عمل تدريبيّة، وفق الأساليب المعاصرة في التأليف والكتابة.
الخامس عشر: القسم الفنّي
إنّ العمل في هذا القسم قائم على طباعة وإخراج النتاجات الحسينيّة التي تصدر عن المؤسّسة، من خلال برامج إلكترونيّة متطوِّرة، يُشرف عليها كادر فنّي متخصّص، يعمل على تصميم أغلفة الكتب والإصدارات، والملصقات الإعلانيّة، والمطويّات العلميّة والثقافيّة، وعمل واجهات الصفحات الإلكترونيّة، وبرمجة الإعلانات المرئيّة والمسموعة وغيرهما، وسائر الأمور الفنيّة الأخرى التي تحتاجها أقسام المؤسّسة كافّة.
وهناك مشاريع أُخرى سيتمّ العمل عليها إن شاء الله تعالى. هذا، وإنّ من أبرز المشاريع التي أنشأتها هذه المؤسسة المباركة هو إصدار مجلّة فصلية متخصصة في النهضة الحسينية، تحمل عنوان (الإصلاح الحسيني)، وقد صدرت تحت عنوانها مجموعة من الأعداد احتوت علىٰ مقالات علمية تحقيقية رصينة، وما زال العمل مستمرّاً في هذا المشروع بعون الله تعالى، وقد اتفقت مجموعة من المقالات على موضوع واحد تمّ تناوله من حيثيات مختلفة، أو في أبحاث متسلسلة، فكان من المناسب ـ بل والضروري ـ أن تُجمع أبحاث كهذه في كتاب مستقل كي تُلملم أطراف البحث الواحد وتعمّ الفائدة المطلوبة، فكان من الأُمور المهمّة التي عمل عليها قسم مجلّة الإصلاح الحسيني هو إصدار سلسلة مؤلّفات بعنوان كتاب المجلة، وهي كالتالي:
1ـ زيارة الإمام الحسين.. بحث استدلالي في روايات الوجوب، تأليف: الشيخ رافد التميمي.
2ـ أُصول المقتل الحسيني.. دراسة تسلّط الضوء على الأُصول الكوفية للمقتل الحسيني، تأليف: الشيخ عامر الجابري.
3ـ الأهداف والمبادئ السياسية لنهضة الإمام الحسين، تأليف: الشيخ قيصر التميمي.
4ـ فقه الإعلام.. المنبر الحسيني أنموذجاً، تأليف: السيد محمود المقدّس الغريفي.
وهذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ هو الكتاب الخامس من هذه السلسلة، والذي يحمل عنوان: (فقه التربة الحسينيّة)، تأليف: سماحة الشيخ أحمد موسى العلي، وقد نُشرت بحوثه في أعداد سابقة من المجلّة مع إجراء مجموعة من التعديلات والإضافات الجديدة التي تفضّل بها الكاتب مشكوراً.
وقد تناول الكتاب جانباً مهماً من جوانب النهضة الحسينيّة المباركة؛ إذ سلّط الضوء علىٰ جانبٍ فقهي منها، وهو الجانب المعني بدراسة فقه أحكام التربة الحسينيّة المقدّسة. فبحث ما اختصّت به التربة المباركة من أحكام معنوية وتشريف إلهي، ميّزها عن سائر التُرب. وكلّ ما يتعلّق بها على المستوى الروائي.
كما تناول أيضاً ما اختصّت به النهضة الحسينيّة من أحكام فقهية عديدة، ميّزتها عن غيرها. وبحثها بحثاً فقهياً ضمن مجموعة من الأبحاث، استوعبت كلّ ما يختصّ بالتربة من أحكام.
وقد اتبع المؤلِّف في ذلك طريقة فقهائنا الإمامية في مسائل التربة الحسينيّة، إذ بدأ بكتاب الطهارة وما يتعلّق به من مسائل تختصّ بتلك التربة، ثُمّ سائر الكتب، وصولاً إلىٰ كتاب الديّات، مستوعباً كلّ المسائل التي لها دخلٌ من الناحية الفقهية في التربة المباركة.
وفي الختام نسأل الله تعالى للمؤلِّف دوام السَّداد والتوفيق لخدمة القضية الحسينيّة، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا، إنّه سميعٌ مجيبٌ.
اللجنة العلمية في
مؤسسة وارث الأنبياء
للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية
ما زالت كثير من المسائل الفقهية ـ محلّ الابتلاء ـ طيّ النسيان، ولا وجود لها في كتاباتنا الحديثة، سواء علىٰ مستوىٰ الكتاب أو المجلة أو غيرها، وينحصر وجودها في الموسوعات الفقهية، التي كُتبت بعبارات علميّة تخصّصية، يصعب علىٰ أكثر القرّاء معرفتها، هذا من جانب.
ومن جانب آخر نجد أنّ معظم مسائل الموضوع الواحد منثورة وموزعة علىٰ الأبواب الفقهية؛ ممّا يشكّل صعوبة أُخرىٰ في الاطّلاع عليها.
نعم، توجد هناك مشاريع جديدة قد عالجت هذه المعضلة، ولكن بعضها ما زال في بداية التأسيس، وبعضاً آخر منها في منتصف الطريق، مع خلوّ بعضها من المباحث المهمّة، ومن هذه المشاريع: (موسوعة الفقه الإسلامي)، و(موسوعة الفقه الإسلامي المقارن)، و(دائرة المعارف ـ فقه مقارن) باللغة الفارسية.
ومن تلك البحوث المنسيّة هي: (فقه التربة الحسينيّة المباركة).
ونحاول هنا ـ وبقدر ما نمتلك من إمكانية ـ أن نسلِّط الضوء علىٰ جانبٍ فقهي من جوانب النهضة الحسينيّة المباركة، وهو الجانب المعني بدراسة فقه أحكام التربة الحسينيّة المقدّسة.
إنّ هذه التربة المقدّسة اختصّت:
أولاً: بأحكام معنوية وتشريف إلهي، ميَّزها عن سائر التُرب.
و ثانياً: بأحكام فقهية عديدة، ميّزتها عن غيرها.
ونعرض في بداية البحث ما يتعلّق بالجانب الأوّل، ولو علىٰ مستوىٰ الروايات، ثمّ نبحث الجانب الثاني بحثاً فقهياً قد يطول نسبياً، نستوعب من خلاله كلّ ما يختصّ بهذه التربة من أحكام.
ونودّ التنبيه علىٰ أنّ المستوىٰ المعروض في هذه البحوث هو وسط من الناحية الفقهية والأدبية، فتحاشينا البحوث الفقهية المعمّقة جداً، والبحوث المُغرَقة بالأدب، وحاولنا قدر الإمكان التوفيق بين المستويين.
وبعد متابعة مُضنية في جميع أبواب الفقه الإسلامي الإمامي حصلنا علىٰ أحكام ومسائل وبحوث عدّة تتعلّق بالتربة الحسينيّة، منها بحوث أصليّة، ومنها فرعية لها اتّصال بما نحن فيه.
وفيما يأتي فهرست أوليٌّ بمسائلها وأحكامها، وهي:
1ـ حرمة الاستنجاء بالتربة المباركة؛ ويتفرّع عليها فروع عدّة، هي:
أ ـ كفر مَن تعمَّد الاستنجاء بالتربة بقصد الإهانة.
ب ـ حكم الاستنجاء بالتربة مع الشكّ فيها.
ج ـ حكم طهارة الموضع مع الاستنجاء بالتربة المباركة.
2ـ حرمة تنجيس التربة ووجوب إزالة النجاسة عنها؛ ويتفرّع عليها فروع عدّة هي:
أ ـ الحكم بكفر مَنْ هتك حرمة التربة الحسينيّة.
ب ـ وجوب إزالة النجاسة عن التّربة فوري.
ج ـ وجوب الإزالة كفائي لا عيني.
3ـ حكم وقوع التربة الحسينيّة المباركة في بيت الخلاء.
4ـ حكم اصطحاب التربة الحسينيّة إلىٰ بيت الخلاء.
5ـ حكم تجهيز الميت بالتربة الحسينيّة؛ وفيه فروع عدّة، هي:
أـ حكم وضع تربة الحسينيّة مع حنوط الميت.
ب ـ الكتابة بالتربة الحسينيّة علىٰ الكفن.
ج ـ وضع التربة الحسينيّة مع الميت في القبر.
6ـ حكم السجود علىٰ التربة الحسينيّة.
7ـ التحرّز بالتربة الحسينيّة.
8 ـ التسبيح بالتربة الحسينيّة.
9ـ حكم الإفطار يوم العيد علىٰ التربة الحسينيّة.
10ـ حكم وجوب الخمس في التربة الحسينيّة.
11ـ حكم الاستشفاء بتربة الإمام الحسين.
12ـ حكم بيع وشراء التربة الحسينيّة.
13ـ حكم تحنيك المولود بالتربة الحسينيّة.
14ـ مسائل وردود حول التربة الحسينيّة.
وهذا ما سيتم تناوله ـ إن شاء الله ـ في هذه الدراسة الفقهية معتمدين على المصادر الأصيلة في الاستدلال الفقهي، وعلى آراء علمائنا الأعلام (رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين).
ونسأل الله تعالى أن يتقبّل ذلك بلطفه وينفعنا به.. والحمد لله ربّ العالمين.
الجانب المعنوي للتربة الحسينيّة
لقد ورد عن الإمامين الباقر والصادق÷ وغيرهما من أنّ للإمام الحسين فضائل ومميّزات انفرد بها عن غيره من جميع الخلق، مع ما له من الفضائل الأُخرىٰ المشتركة ممّا يصعب عدها، حيث عوّضه الله بها مقابل تضحيته وشهادته وما لاقاه في ثورته المباركة.
فعن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر، وجعفر بن محمد÷ يقولان: «إنّ الله عوّض الحسين من قتله أنّ الإمامة من ذرّيته، والشفاء في تربته، وإجابة الدعاء عند قبره، ولا تعدّ أيام زائريه جائياً وراجعاً من عمره»([7]).
وعن ابن عباس ـ كما في كفاية الأثر ـ قال: «دخلت علىٰ النبي’ والحسن علىٰ عاتقه، والحسين علىٰ فخذه، يلثمهما ويقبّلهما، ويقول: اللّهمَّ والِ مَن والاهما، وعادِ مَن عاداهما، ثمّ قال: يا بن عباس، كانّي به وقد خُضِّبت شيبته من دمه، يدعو فلا يُجاب، ويستنصر فلا يُنصر، قلت: مَن يفعل ذلك يا رسول الله؟ قال: شرار أُمّتي، ما لهم لا أنالهم الله شفاعتي. ثمّ قال: يا بن عباس، مَنْ زاره عارفاً بحقِّه، كُتِب له ثواب ألف حجّة، وألف عمرة، أَلا ومَن زاره فكأنّما زارني، ومَن زارني فكأنّما زار الله، وحقّ الزائر علىٰ الله أن لا يعذِّبه بالنار، أَلا وإنّ الإجابة تحت قبّته، والشفاء في تربته، والأئمّة من وُلده...»([8]).
وأمّا الروايات التي وردت في خصوص تربة الحسين وذكر فضلها، وما لها من خصائص وأحكام، وفي مختلف الأبواب تصل إلىٰ حدِّ التواتر، وما ورد في مصادر السُّنة قد يكون أكثر ممّا ورد في مصادر الشيعة.
فإنّه لو رجعنا إلىٰ كتب الحديث والتاريخ والتراجم لنستجلي فيها حقيقة التربة الحسينيّة، فإنّا سنجد فيها من دلائل البينات ـ ولا أقول: إنّها إشارات ـ بمنزلة إرهاصات بما سيكون لهذه التربة من شأن، وما سيجري عليها من أحداث، وذلك يؤكِّد أنّ ما ورد فيها عن النبي’ من بالغ الاهتمام لم يكن قد صدر اعتباطاً، أو لمجرّد عاطفة، بل ثمّة وحيٌّ منزَل، علىٰ لسان مَلَك مرسل، إلىٰ النبي الممثّل، في شخص سبطه المؤهّل للقيام بدوره لوحده، في إقامة شرع جدّه، فالإسلام محمّدي الحدوث حسيني البقاء، لذلك كان النبي’ ينوّه بابنه الحسين وفضل تربته، وينشر حديثها في أُمّته قبل ولادته.
لذلك كان لتربة الإمام الحسين من الفضل والشأن ما لم يكن لغيرها من سائر الترب، وما يدرينا فلعلّ الله تعالىٰ قد أودع في طبيعة تكوينها الجيولوجي خاصيّة، حتىٰ صارت شفاءً من كلّ داء إلّا السامّ. فهي أرض ولكن ليست كسائر الأرضين، مضافاً إلىٰ خصوصيّة مَن احتضنته، وسعدت برمسه([9]).
وسوف نحاول استجلاء كلّ ما تقدّم من خلال الأحاديث النبويّة في خصوص التربة الحسينيّة، ونذكر جملة العناوين التي ورد فيها مدح هذه التربة، وعدد الرواة من الصحابة، وعدد ما رواه كلّ صحابي، مقتصرين علىٰ ذكر رواية واحدة تحت كلّ عنوان.
الروايات الواردة في خصوص تربة الحسين
1ـ الروح الأمين يحمل تربة الإمام الحسين
وفي ذلك مجموعة من الأحاديث، عن:
أ ـ الإمام علي بن أبي طالب، حيث نقل عنه عدّة من الرواة وبنقلين قد يختلف لسانهما.
ب ـ حَبر الأُمّة عبد الله بن عباس، حيث نقل عنه الحديث عدّة من الرواة.
ج ـ أُمُّ سلمة، ولها خمسة أحاديث.
د ـ عائشة، ولها أربعة أحاديث.
هـ ـ زينب بنت جحش، ولها حديث واحد.
وـ أُمُّ الفضل بنت الحارث، ولها حديث واحد.
زـ سعيد بن جمهان، وله حديث واحد.
ح ـ أبو أُمامة، وله حديث واحد.
فقد جاء عن نجيّ الحضرمي: «أنّه سار مع عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ـ وكان صاحب مطهرته ـ فلمّا حاذىٰ نينوىٰ، وهو منطلق إلىٰ صفِّين، فنادىٰ علي رضي الله عنه: اصبر أبا عبد الله بشطِّ الفرات. قلت: وما ذلك؟ قال: دخلت علىٰ النبي’ ذات يوم، وإذا عيناه تفيضان، قلت: يا نبي الله، أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: بل قام من عندي جبرئيل قبلُ، فحدَّثني أنّ الحسين يُقتل بشط الفرات. قال: فقال: هل لك إلىٰ أن أُشمّك من تربته؟ قال: قلت: نعم. فمدّ يده، فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عينيّ أن فاضتا»([10]).
وهذا الحديث أخرجه أحمد والطبراني وسعيد بن منصور والخوارزمي وابن عساكر وأبو يعلىٰ والبزار عن نجيّ الحضرمي، وليس في أسانيدهم أيّ جهالة، بل قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) ـ بعد الحديث بلفظه المتقدّم ـ: رواه أحمد وأبو يعلىٰ والبزار والطبري، ورجاله ثقات، ولم ينفرد نجيّ بهذا.
2ـ مَلَك القطر والمطر يحمل تربة الحسين
لقد أخرج حديث نزول مَلَك القطر والمطر إلىٰ النبي| جمعٌ كثير من الحفّاظ وأئمّة السنن والتاريخ، ممَّن لا يرقىٰ الشك إلىٰ روايتهم لهذا الحديث، وقد رواه أنس بن مالك، وأبو الطفيل وربما غيرهما.
وروىٰ حديث أنس أكثر من خمسة عشر مُحدِّثاً كأحمد بن حنبل وغيره.
قال الهيثمي: «رواه أحمد وأبو يعلىٰ والبزار والطبراني بأسانيد، وفيها عمارة بن زاذان، وثّقهُ جماعة وفيه ضعف، وبقيّة رجال أبي يعلىٰ رجال الصحيح»([11]).
أخرج ابن عساكر في تاريخه بأسانيده عن ثابت البناتي عن أنس بن مالك، قال: «استأذن مَلَك القطر والمطر ربَّه أن يزور النّبي[’] فأَذن له، وكان في يوم أُمِّ سلمة، فقال النبي[’]: يا أُمّ سلمة احفظي علينا الباب لا يدخل علينا أحد. قال: فبينما هي علىٰ الباب إذ جاء الحسين بن عليّ فاقتحم [ففتح] الباب، فدخل، فجعل النبي[’] يلثمه ويُقبّله، فقال المَلَك: أَتحبه؟ قال: نعم. قال: إنّ أُمّتك ستقتله، إن شئت أريتك المكان الذي يُقتل فيه؟ قال: نعم. قال: فقبض قبضة من المكان الذي قُتل فيه فأراه، فجاء بسهلة أو تراب أحمر، فأخذته أُمُّ سلمة، فجعلته في ثوبها. قال ثابت فكنّا نقول: إنّها كربلاء»([12]).
وقريب من لفظ هذا الحديث ما رواه أبو الطفيل، حيث أخرج حديثه مضافاً إلىٰ الطبراني غيره، منهم الهيثمي الذي وصف رواية الطبراني لهذه الحديث بقوله: «وإسناده حسن»([13]).
وجاء في آخره: «فأخذت أُمُّ سلمة التراب: فصرَّته في خمارها، فكانوا يرون أنّ ذلك التراب من كربلاء»([14]).
3ـ مَلَك من الصفيح الأعلى لم ينزل من قبلُ يحمل تربة الحسين× إلى النبي’
روىٰ هذا الحديث جماعة من الصحابة، منهم اثنتان من أزواج النبي| ـ هما: أُمُّ سلمة، وعائشة ـ والمسوّر بن محزمة وحديثه فيه تفصيل أكثر إلّا ذكر التربة.
أخرج ابن عساكر في تاريخه بإسناده عن وكيع قال: «حدّثني عبد الله بن سعيد عن أبيه عن عائشة أو أُمِّ سلمة ـ قال وكيع: شك هو (يعني عبد الله بن سعيد) ـ أنّ النبي[’] قال لإحداهما: لقد دخل عليّ البيت مَلَك لم يدخل عليّ قبلها: فقال لي: إنّ ابنك هذا حسين مقتول، وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يُقتل بها، قال: فأخرج تربة حمراء»([15]).
وقد أخرج هذا الحديث أكثر من ثمانية من المحدِّثين، قال الذهبي: «رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند مثله، إلّا أنّه قال: (أُمُّ سلمة) ولم يشك، وإسناده صحيح، رواه أحمد والناس، ورُوي عن شهر بن حوشب وأبي وائل كلاهما عن أُمِّ سلمة نحوه»([16]).
وأخرج حديث المسوّر بن حزمة المفصّل الخطيب الخوارزمي في مقتل الحسين نقلاً عن تاريخ ابن أعثم بأسانيد كثيرة([17]).
4ـ مَلَك البحار يحمل تربة الإمام الحسين× إلى النبي’
أخرج هذا الحديث الموفّق محمد بن أحمد الخوارزمي في مقتله نقلاً عن تاريخ ابن أعثم الكوفي، وقال: ذكره بأسانيد كثيرة عن رسول الله|([18]).
«قال شرحبيل ابن أبي عون: إنّ المَلَك الذي جاء إلى النبي’ إنّما كان ملك البحار، وذلك أنّ مَلَكاً من ملائكة الفراديس نزل إلىٰ البحر، ثمّ نشر أجنحته عليه، وصاح صيحةً قال فيها: يا أهل البحار، البسوا ثياب الحزن، فإنّ فرخ محمد مقتولٌ مذبوح. ثمّ جاء إلىٰ النبي[’] فقال: يا حبيب الله، تُقتتل علىٰ هذه الأرض فرقتان من أُمّتك، إحداهما ظالمة متعدِّية فاسقة، تقتل فرخك الحسين ابن ابنتك بأرض كرب وبلاء، وهذه التربة عندك. وناوله قبضة من أرض كربلاء، وقال له: تكون هذه التربة عندك حتىٰ ترىٰ علامة ذلك، ثمّ حمل ذلك المَلَك من تربة الحسين في بعض أجنحته، فلم يبقَ مَلك في سماء الدنيا إلّا شمّ تلك التربة، وصار له عنده أثر وخبر.
قال: ثمّ أخذ النبي[’] تلك القبضة التي أتاه بها المَلَك، فجعل يشمّها ويبكي، ويقول في بكائه: اللّهمّ لا تبارك في قاتل ولدي، واصله نار جهنّم، ثمّ دفع تلك القبضة إلىٰ أُمِّ سلمة وأخبرها بقتل الحسين بشاطئ الفرات، وقال: يا أُمَّ سلمة، خذي هذه التربة إليك، فإنّها إذا تغيّرت وتحوّلت دماً عبيطاً فعند ذلك يُقتل ولدي الحسين»([19]).
5ـ جميع ملائكة السماوات يحملون تربة الإمام الحسين× إلى النبي’
أخرج هذا الحديث الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين أيضاً في حديث طويل، ذكر أنّه أخرجه ابن أعثم الكوفي في تاريخه بأسانيد كثيرة.
وقد ورد فيه أنّ النبي’ ذكر أنّ قاتل الحسين هو يزيد لا بارك الله فيه، وقد جاء ذلك في حديث لمعاذ بن جبل، رواه عن النبي’، قال السيّد الخرسان بشأنه: «وإن صدق ظنّي فإنّ بعض أسانيد ابن أعثم لرواية الحديث السابق كانت تنتهي إلىٰ معاذ»([20])، ثم أشار إلى ما رواه الطبراني مسنداً([21]).
هذا، وقد ذُكِرَ أنّ حديث معاذ هذا حديث موضوع، على الرغم من أنّ جماعة من الحفّاظ وأرباب الحديث غير الطبراني قد أخرجوا هذا الحديث أيضاً، وهم: الهيثمي في (مجمع الزوائد)، والسيوطي في (الجامع الكبير)، والمتقي الهندي في (كنز العمال) نقلاً عن الديلمي([22])، وغيرهم.
ومن هنا؛ يرى بعض المحقّقين بأنّ السبب في ذلك ليس هو ذكر ابن الجوزي له في (الموضوعات)، وليس أيضاً ذكر ابن عراق الكناني له في (تنزيه الشريعة)، بل إنّ الآفة الوحيدة التي فيه هو أنّ من رجال إسناده الحسن بن عباس الرازي وهو إمامي، وقالوا فيه: إنّه كان يضع الحديث؛ وبناءً على ذلك ـ حسب رأيهم ـ تخريج هذا الحديث من قِبل جميع أصحاب الصحاح والسنن فيما لو أخرجوه.
والأشدّ من كلّ ذلك ـ بحسب ما ذكره بعضٌ ـ هو أنّ متنه يمسّ قدسية الساسة، ويدنّس قداسة السياسة ([23]).
وأمّا لفظ الحديث فهو: «فلمّا أتىٰ علىٰ الحسين من ولادته سنه كاملة هبط علىٰ رسول الله اثنا عشر ملكاً ـ ثمّ ذكر صورهم ـ محمّرة وجوههم، قد نشروا أجنحتهم وهم يقولون: يا محمد، سينزل بولدك الحسين ما نزل بهابيل من قابيل، وسيُعطىٰ مثل أجر هابيل، ويحمل علىٰ قاتله مثل وزر قابيل.
قال: ولم يبقَ في السماء مَلَك إلّا ونزل علىٰ النبي[’] يعزّيه بالحسين، ويُخبره بثواب ما يُعطىٰ، ويعرض عليه تربته، والنبي[’] يقول: اللّهمَّ اخذل مَن خذله، واقتل مَن قتله، ولا تمتعه بما طلبه.
قال المسوّر بن مخرمة [في حديث وارد في الصدد نفسه]:... ولـمّا أتت علىٰ الحسين من مولده سنتان كاملتان خرج النبي[’] في سفر، فلمّا كان في بعض الطريق وقف فاسترجع ودمعت عيناه، فسُئِل عن ذلك؟ فقال: هذا جبرئيل يُخبرني عن أرض بشاطئ الفرات يقال لها: كربلاء، يُقتل فيها ولدي الحسين بن فاطمة، فقيل: مَنْ يقتله يا رسول الله؟ فقال: رجل يقال له: يزيد، لا بارك الله في نفسه، وكأنّي أنظر إلىٰٰ منصرفه ومدفنه بها، وقد أُهدي رأسه، والله ما ينظر أحد إلىٰ رأس ولدي الحسين فيفرح إلّا خالف الله بين قلبه ولسانه. يعني ليس في قلبه ما يكون بلسانه من الشهادة.
قال: ثمّ رجع النبي[’] من سفره ذلك مغموماً، فصعد المنبر فخطب ووعظ، والحسين بين يديه مع الحسن، فلمّا فرغ من خطبته وضع يده اليمنىٰ علىٰ رأس الحسين، ورفع رأسه إلىٰ السماء، وقال: اللّهمَّ إنّي محمد عبدك ونبيّك، وهذان أطائب عترتي، وخيار ذرّيتي وأُرومتي، ومَن أخلفهما في أُمتي، اللّهمَّ وقد أخبرني جبرئيل بأنّ ولدي هذا مقتول مخذول، اللّهمَّ فبارك لي في قتله، واجعله من سادات الشهداء، إنّك علىٰ كلّ شيء قدير، اللّهمَّ ولا تبارك في قاتله وخاذله.
قال: فضجّ الناس في المسجد بالبكاء، فقال النبي[’]: أَتبكون ولا تنصرونه اللّهمَّ فكن له أنت وليّاً وناصراً»([24]).
6ـ الروايات المروية عن أهل البيت^ في فضل التربة الحسينيّة
إنّ أكثر الروايات الواردة في هذا الشأن جاءت عن الإمام الصادق جعفر بن محمد÷، وخصوصاً في فضل السجود عليها واتّخاذ السبحة منها.
أـ روىٰ الشيخ الطوسي عن معاوية بن عمّار قال: «كان لأبي عبد الله ـ يعني الصادق ـ خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله الحسين فكان إذا حضرته الصلاة صبّه علىٰ سجادته وسجد عليه، ثمّ قال: إنّ السجود علىٰ تربة أبي عبد الله يُغرق [يخرق] الحجب السبع»([25]).
ب ـ وروىٰ الحسن بن محمد الديلمي في كتابه إرشاد القلوب، قال: «كان الصادق لا يسجد إلّا علىٰ تربة الحسين تذلّلاً لله واستكانة إليه»([26]).
ج ـ روىٰ الصدوق في كتابه (مَن لا يحضره الفقيه) قال: قال الصادق: «السجود علىٰ طين قبر الحسين يُنوّر إلىٰ الأرض السابعة»([27]).
د ـ وروىٰ الحسن بن محبوب في كتابه: «أنّ أبا عبد الله سُئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة وقبر الحسين والتفاضل بينهما، فقال: السبحة التي من طين قبر الحسين تسبِّح بيد الرجل من غير أن يسبِّح»([28]). إلىٰ غير ذلك من الروايات الكثيرة.
خلاصة ما تدلّ عليه الأحاديث المتقدّمة
من خلال التدبّر في جملة الأحاديث المتقدِّمة وغيرها نجد أنّها تدلّ علىٰ أُمور عدّة، هي:
الأوّل: دلالة هذه الروايات علىٰ مدىٰ اهتمام النبي’ بهذه التربة، وعلىٰ شرف التربة وعظيم فضلها، والخصائص التي تحويها من شفاء المرضىٰ، مضافاً إلى ما لها من الجانب المعنوي ومضاعفة الأجر عند استعمالها في السجود عليها، والتسبيح بها.
فهل يُلام مَن حمل منها شيئاً ليتّخذه مسجداً له يسجد لله تعالىٰ عليه في صلاته؟
وهل من عَجب لو ورد في فضل السجود عليها بأنّه يخرق الحُجب السبع؟
وهل من غرابة لو أودع الله تعالىٰ فيها خصائص من رحمته فجعل فيها الشفاء؟
فلماذا ـ إذاً ـ التهريج والتهريف، والافتراء والتخريف علىٰ مَن رأىٰ فيها ولها غاية التعظيم؟
الثاني: دلالة الأحاديث علىٰ وقوع الحادثة في الجملة بغضّ النظر عن تفاصيل الحادثة، ممّا يجعل الإخبارات الواردة في المقام من علامات النبوّة ودلائلها؛ إذ إنّ صدور هذه الأحاديث كان قبل حدوث الواقعة بعقود عدّة.
الثالث: دلالة الأحاديث علىٰ شرعية هذه الثورة المباركة، وأنّ النبي’ في مقام الحثّ علىٰ نصرته والوعيد بمعاقبة مَن تخلّف عنه. وهذا بحدّ ذاته سيكون ردّاً علىٰ دعاة السلفية من الوهابية وغيرهم القائلين بأنّ الحسين خرج علىٰ إمام زمانه.
الرابع: إنّ أكثر تفاصيل واقعة كربلاء وردت في الأحاديث التي روتها مصادر أهل السنّة، ولا تختصّ بمصادر الشيعة، وهي بذلك تدلّ علىٰ نحو القطع علىٰ ما تقدَّم في النقاط الثلاث، وكذلك تدلّ علىٰ صحّة ما تدعيه الشيعة، بخصوص هذه الواقعة، والشعائر التي تقيمها، من الحزن والبكاء والرثاء والزيارة وغيرها.
حكم تنجيس التربة الحسينيّة وإزالة النجاسة عنها
المبحث الأوّل: حكم تنجيس التربة الحسينيّة
المبحث الثاني: حكم إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة
ملحق (1): حرمة الاستنجاء بالتربة الحسينيّة
ملحق (2): حكم حمل التربة المباركة إلى بيت الخلاء ووقوعها فيه
إنّ الشرائع السماويّة علىٰ تنوّعها ترتكز في كثير من اعتقاداتها وما تؤمن به علىٰ التقديس والاحترام، سواء بالنسبة إلىٰ الكتب التي تؤمن بها، أو علىٰ مستوىٰ الأنبياء وأوصيائهم، وما يتّصل بذلك، كالكتب المتضمّنة لأقوالهم وأفعالهم، أو الأشياء المادّية التي كانوا يستعملونها، أو أضرحتهم والأبنية التي دُفنوا فيها، أو المساجد والمعابد التي بُنيت لكي يُتقرّب بها إلىٰ الله تعالىٰ.
ولعلّ التعبير المتعارف لبعض هذه الأشياء هو مصطلح: (المحترمات)، والتي منها القرآن الكريم، والمساجد، وأضرحة الأولياء، حتىٰ كُتبت قاعدة باسم: (قاعدة حرمة إهانة المحترمات)، وحكمت كلّ الشرائع بوجوب احترامها بما للكلمة من معنىٰ، وبأشكال الاحترام كافّة. وهذه القداسة استُمدّت من مبدأ أعلىٰ، اتّصلت به هذه الأشياء، وهو الحقّ تعالىٰ.
ولا شكّ في أنّه يُحرم فعل كلّ ما استلزم الهتك والتوهين لشيءٍ من المقدّسات، لو وقع بذلك العنوان، فالمساجد التي من الأرضين لـمّا طرأ عليها عنوان (المسجديّة) أضفىٰ عليها لوناً من القداسة؛ أوجب لها مزيداً من الفضل علىٰ غيرها، فجعلت لها أحكاماً خاصّة أوجبها الشارع المقدّس.
وكذلك المصحف الشريف، فأوراقه وجلده قبل أن يُكتب عليها، ويُحفظ بين دفّتيه، لم يكن لها من القداسة، كما هو الحال بعدها، من حرمة التنجيس والتلويث بما يستلزم هتك الحرمة.
وتربة سيّد الشهداء من القبر الشريف أو ما لامسه كذلك؛ لأنّها من تلك المقدّسات التي أصبح لها من الحرمة بعد مقتل الحسين ما لم يكن لها قبل ذلك.
وقد ورد عن أئمّة أهل البيت^ في تقديسها ما أوجب لها مزيداً من الفضل، فحرُم تنجيسها، ووجب تطهيرها لو تنجّست، بل وتجنيبها كلّ ما يستوجب الاستخفاف بها؛ لأنّه مستلزم للاستخفاف بصاحبها، فشأنها شأن سائر المقدّسات المحترمة، الإسلامية والإيمانية([29]).
هذا، وتتّضح المسائل في المقام من خلال مبحثين:
الأوّل: في حرمة تنجيس التربة الحسينيّة.
والثاني: في وجوب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة، ولكن بعد ذكر المعنىٰ اللغوي والاصطلاحي للفظ (النجاسة) أو (التنجيس).
لكنّه قبل الدخول في تفاصيل الحديث المتعلّق بالمبحثين المزبورين نحتاج إلى التطرّق إلى نقطتين مهمّتين، هما:
النقطة الأُولى: التعريف بمعنى النجاسة
«نجس: النون والجيم
والسين أصلٌ صحيح، يدلّ علىٰ خلاف الطهارة، وشيء نجِسٌ ونجَس: قذر... وليس ببعيد
أن يكون منه قولهم: الناجس: الداء لا دواء له...
وأمّا التنجيس، فشيء كانت العرب تفعله، كانوا يعلّقون علىٰ الصبي شيئاً يعوّذونه
من الجن، ولعلّ ذلك عظمٌ أو ما أشبه؛ فلذلك سُمّي تنجيساً»([30]).
«والنّجِس: الشيء القذر حتىٰ من الناس، وكلّ شيءٍ قذّرته فهو نجس»([31]).
وقال الصغاني: «النجس ضدّ الطهارة... شيء كانت العرب تفعله علىٰ الذي يخاف عليه ولوغ الجن، وهو القذر، نحو خرقة الحائض، وعظام الموتىٰ... ويُقال: تنجّس الثوب: إذا أصابته نجاسة. والتركيب ـ نجس ـ يدل علىٰ خلاف الطهارة»([32]).
قال الهمداني: «إنّ القذارة في عُرف المتشرِّعة هي: قذارة خاصّة مجهولة الكُنه لدينا، اقتضت وجوب هجرها في أُمور مخصوصة، فكلّ جسم خلا عن تلك القذارة، فهو نظيف شرعاً»([33]). وكذا عرّفها الأنصاري([34]).
والمتحصّل من المعنىٰ اللغوي والاصطلاحي: أنّ النجاسة هي القذارة، وفي عُرف الشرع: هي قذارة مخصوصة معدودة بعدد معيّن، حسب الاستقراء ـ كما سيأتي ذكرها ـ وأنّ التنجيس يعني: ملاقاة تلك القذارة لجسمٍ ما، وقد يكون هذا الجسم طاهراً.
النقطة الثانية: النجاسات في الفقه الإمامي
حكم الشارع المقدّس علىٰ بعض الأشياء بأنّها من النجاسات التي يجب الاجتناب عنها في بعض الموارد، كالأكل والشرب والصلاة، أو تنجيس القرآن والمسجد وغيرهما بها، وهذه النجاسات معدودة ومحددة في الشريعة. نعم، قد يُختلف في سعتها وضيقها، أو قُل: بعددها؛ لعدم ثبوت هذا الفرد منها أو ذاك.
وحاصل ما ذكروه في باب النجاسات ما يأتي:
1ـ البول.
2ـ الغائط: وهما نجسان من الحيوان الذي لا يُؤكل لحمه وله نفس سائلة.
والنفس السائلة: الدم الشاخب من الحيوان عند الذبح، كما في الشاة مثلاً.
نعم، وقع الكلام في نجاسة بول الرضيع قبل أن يأكل اللحم، وفي بول وخرء الطير من غير المأكول وله نفس سائلة، وفي بول ورجيع ما ليس له نفس سائلة([35]).
3ـ المنيّ: وهو نجس إذا كان من حيوان ذي نفس سائلة حلّ أكله أو حرُم.
نعم، وقع الكلام في نجاسة منيّ ما ليس له نفس سائلة.
4ـ الميتة: وهي نجسة إذا كانت من حيوان ذي نفس سائلة، وأمّا ميتة ما ليس له نفس سائلة من الحيوانات فليست نجسة.
5ـ الدم (الدماء): وهي نجسة من ذي النفس السائلة من الحيوانات.
6ـ الكلب البرّي.
7ـ الخنزير البرّي.
8ـ الـمُسكرات: وقع خلاف في نجاسة بعض مصاديقها.
9ـ الفقاع.
10ـ الكافر([36]).
عرض الفقهاء هذه المسألة تحت عنوان كلّي وهو: (الأُمور التي يجب إزالة النجاسة عنها، أو حرمة تنجيسها)، وعدّوا منها المساجد والمشاهد المشرّفة، والتربة الحسينيّة، وغيرها.
وبعد تتبّع مضنٍ في الكتب الفقهية ـ الاستدلالية منها، أو الفتوائية ـ لم أجد مَن خالف في حرمة تنجيس التربة المقدّسة، نعم إذا كان هناك خلاف فهو في سعة انطباق التربة علىٰ بعض مصاديقها أو عدم انطباقها، أو في الشروط التي يجب توافرها في التربة؛ كي تُنسب إلىٰ صاحبها (عليه وعلىٰ آبائه آلاف التحية والسلام).
فالفتوىٰ السائدة بين القدماء والمعاصرين هي حرمة التنجيس المستلزم منه إهانة التربة والاستخفاف بها، بل الظاهر من السيّد الحكيم عدم الخلاف ظاهراً؛ إذ عطف سائر ما يتعلّق بالأضرحة من حرمة التنجيس علىٰ الأضرحة والمشاهد المشرّفة.
وتسهيلاً علىٰ القارئ الكريم نوضّح المُراد من خلال نقاط عدّة:
النقطة الأُولىٰ: كلمات الفقهاء في المسألة.
النقطة الثانية: أدلّة حرمة تنجيس التربة الحسينيّة.
النقطة الثالثة: توقّف تحقق الإهانة بالتنجيس علىٰ القصد.
النقطة الرابعة: تحديد المصاديق التي يحرُم تنجيسها، والضابطة في ذلك.
النقطة الخامسة: كيفية إثبات أنّ هذه التربة هي من التربة الحسينيّة.
النقطة الأُولى: كلمات الفقهاء في المسألة
يظهر أنّ هذه المسألة لم تُطرح بهذا الشكل، وبهذا التفصيل في بعض فروعها، وخصوصاً تحديد مكان التربة، قبل ابن فهد الحلي في: (المهذّب البارع)([37])، والشهيد الثاني في: (الروضة البهية)([38])، وهو ما صرّح به السيّد العاملي في: (مفتاح الكرامة)([39])، نعم، هذان الكتابان وما قارب عصرهما فيهما نوعٌ من الاختصار؛ إذ اكتفيا بذكر الفتوىٰ وبعض الفروع من دون التطرّق بشكل واضح إلىٰ منشأ ودليل الفتوىٰ، ولا إلىٰ التفاصيل الأُخرىٰ التي تتعلّق بالتربة.
وإليك بعض الكلمات:
قال ابن فهد الحلي: «الاحترام للتربة الموجب لتجنبها عن النجاسات، ما أُخذ من الضريح المقدَّس، وكذا لو أُخذ من خارج ووُضع عليه، ثبت الحرمة، لا ما أُخذ من باقي الحرم، اللّهمَّ إلّا أن يأخذ بالدعاء وتختم». وقال أيضاً: «إنّ التربة محترمة لا يجوز تقريبها من النجاسة، وليس كذلك الأرمني([40])»([41]).
وقال الشهيد الثاني: «والمُراد بطين القبر الشريف تربة ما جاوره من الأرض عُرفاً... وليس كذلك التربة المحترمة منها؛ فإنّها مشروطة بأخذها من الضريح المقدّس... ولو وُجد تربة منسوبة إليه حُكِم باحترامها حملاً علىٰ المعهود»([42]).
وكذلك فرّق الصيمري بين الطين الأرمني والتربة الحسينيّة في الاحترام وعدمه، والمحترم من التربة ما أُخذ من الضريح، وحكم بعدم جواز تقريبها من النجاسة([43]).
وبعد أن أشار إلىٰ الأفراد التي يحرُم الاستنجاء بها، ذكر البحراني أنّ تحريم الاستنجاء بتلك الأشياء المحترمة إنّما جاء من حيث إهانتها بالإيقاع بالنجاسة، فيحرُم تنجيسها مطلقاً([44]).
وذكر الشيخ كاشف الغطاء جملة من أحكام النجاسات الأصلية، ومنها حرمة تلويث المحترمات بها، ووجوب إخراجها منها لو وقعت فيها مع عدم استحالتها، وإزالتها عنها ـ عيناً وحكماً ـ لو وقعت عليها. وتجري هذه الأحكام علىٰ ما انفصل من هذه المحترمات مع ملاحظة أصله لشفاء أو مدخليّة في عبادة، كتربة سيّد الشهداء([45]).
وأدخل صاحب الجواهر التربة الحسينيّة والسبحة، وما أُخذ من طين القبر للاستشفاء والتبرّك به، ككتابة الكفن ونحوها تحت عنوان: ما عُلم من الشريعة وجوب تعظيمه وحرمة إهانته وتحقيره، فيجب إزالة النجاسة عنه، كما يحرُم تلويثه([46]).
وقال اليزدي في (العروة الوثقىٰ) ـ وقد وافقه كلّ مَن علّق علىٰ متنه، مستدلاً أيضاً علىٰ حرمة التنجيس ـ: «يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة^ المأخوذة من قبورهم، ويحرُم تنجيسها، ولا فرق في التربة الحسينيّة بين المأخوذة من القبر الشريف، أو من الخارج، إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء، وكذا السبحة، والتربة المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة»([47]).
النقطة الثانية: أدلّة حرمة تنجيس التربة الحسينيّة
تنحصر الأدلّة علىٰ حرمة التنجيس بدليل أو دليلين، بإضافة سيرة المتشرّعة، وأهمّها الاعتماد علىٰ قاعدة: حرمة إهانة المحترمات في الدين. وقاعدة: وجوب تعظيم شعائر الدين. ويُستفاد من كلام صاحب الجواهر: أنّهما عمدة الدليل علىٰ حرمة تنجيس المحترمات، بل صرّح بأنّه لا دليل لذلك غيرهما([48]).
ودمج بعض الفقهاء بين القاعدتين ـ والظاهر لتقاربهما أو لرجوعهما إلىٰ شيء واحد ـ وعبّر عنهما بـ(حرمة هتك ما هو من حرمات الله وشعائر الدين). ونحن نقتفي أثره؛ لاتّحاد الأدلّة وتقاربها.
الدليل الأوّل: قاعدة حرمة هتك ما هو من حرمات الله وشعائر الدين
لأهمية هذا الدليل وما يترتب عليه من فوائد لا بدّ من بحثه ولو بشكل مختصر؛ إذ يُعدّ أساساً لكثير من المسائل الفقهية التي هي مورد النظر، مثل: مسألة حرمة الاستنجاء بالتربة وحرمة تنجيسها، ووجوب إزالة النجاسة عنها، ووجوب تقديسها وغيرها. ونستوعب البحث من خلال مقدِّمات:
المقدِّمة الأُولى: مفاد القاعدة
إنّ المقصود من المحترمات في الدين هو كلّ ما هي من مقدَّسات الشريعة ومعالم الدين، وما كان من مجعولات الشرع، وما ورد أمر الشارع باحترامه وتعظيم شأنه، كالكعبة، والمساجد الأربعة، وسائر المساجد، وقبر النبي’، وقبور الأئمّة^، وسائر المشاهد المشرّفة والقرآن، والكتب الروائية، والتربة الحسينيّة، وفقهاء أهل البيت^، وقبورهم، بل المؤمنين كلّهم، حيِّهم وميِّتهم، ونحو ذلك ممّا هو متعلّق بالدين، ومنتسبٌ إلىٰ الشريعة بنحوٍ، ويُعبّر عنها بشعائر الله وشعائر الدين.
والنسبة بين المحترمات والشعائر هي أنّ الشعائر كلّها من المحترمات، ولكن ليس كلّ ما هو محترم في الدين من شعائر الله، كالمتّخذ بقصد الشفاء، وقبور المؤمنين، وفقراء المؤمنين وأمواتهم.
والـمُراد بشعائر الدين: معالم الدين، وعلائم الشريعة وآثارها، ومتعبّدات الله، وكلّ ما يُعبد الله فيه من الأماكن المقدَّسة والمشاهد المشرَّفة، أو يُعبد الله بتعاليمه وهديه، كالأنبياء، والأئمّة، والكتب السماوية، وكتب الأحاديث؛ حيث يُطاع الله ويُعبد بطاعة الأوامر والنواهي الصادرة عن الأنبياء والأولياء، وامتثال ما ورد من أحكام القرآن وكتب الأحاديث([49]).
المقدِّمة الثانية: أدلّة القاعدة
صرّح بعضٌ بأنّ حرمة تنجيس المساجد والمشاهد المشرّفة الأُخرىٰ وغيرها داخلة في كُبرىٰ كلّية مسلَّمة لدىٰ الجميع، بل لا يبعد أن تُعدّ من ضروريات المذهب، بل من ضروريات الدين الإسلامي؛ لتضافر الآيات وتواتر الأخبار عليها، وهي لزوم احترام الثقلين: الكتاب المقدَّس، والعترة الطاهرة، وحرمة توهينهما، والحطّ من كرامتهما، وهو أمر واضحٌ عند الفريقين([50]). والأدلّة المذكورة علىٰ ذلك ما يأتي:
أولاً: حكم العقل بقبح إهانة ما هو محترم عند المولى
يقبح بحكم العقل إهانة كلّ محترم عند الله (عزَّ وجلَّ) واحتقار ما هو معظَّم عنده، ويرجع ذلك إلىٰ الاستخفاف بالمولىٰ سبحانه؛ وبه يستحق الذم والعقاب، وهو من اللوازم التي لا تنفكّ عن فعل الحرام، أو ترك الواجب الذي هو حرام أيضاً.
فكلّ فعل كان موجباً لاستحقاق العقاب، فلا محالة يُستكشف منه أنّه حرام؛ وذلك ببرهان الإن، أي: اكتشاف العلّة من وجود المعلول والملزوم من اللازم([51]).
فيما يتعلّق بالضرورة فإنّ حرمة ذلك من المسلّمات عند الفريقين، وقد أشرنا إلىٰ ذلك في أوّل البحث.
وأمّا الإجماع، فلاتّفاق جميع العلماء علىٰ حرمة إهانة مقدَّسات الشريعة، ولم يستدلّوا لإثبات القاعدة بنصٍّ من الكتاب والسنّة في كلماتهم ليكون مدركياً، ولا يُحتمل استنادهم إلىٰ نصّ خاصّ في ذلك، وإلّا لأُشير إلىٰ ذلك في كلام واحدٍ منهم([52]).
هناك ارتكاز عند المتشرِّعة قاطبةً علىٰ عدم جواز هتك حرمة هذه الأُمور وإهانتها واحتقارها، ويعترضون علىٰ مَن يُهينها ويحتقرها، وينكرون عليه أشدّ الإنكار ـ وإن كان بعض منهم قد يُفرِّطون في هذا الأمر ـ ولا شكّ في أنّ أحداً لو قام بالتدخين في حرم أحد الأئمّة^، أو دخل إلىٰ أحد الأضرحة بحذائه، أو نجّس بعض التربة المنسوبة إليهم، وغيرها من الأُمور، لأنكروا عليه أشدّ الإنكار.
ولا يمكن أن يُنكر ثبوت مثل هذا الارتكاز في أذهان المتشرّعة، ولا يمكن أيضاً إنكار أنّ هذا الارتكاز كاشف عن ثبوت هذا الحكم في الشريعة، فـ«أصل الإنكار ثابتٌ بالنسبة إلىٰ إهانة المحترمات في الدين، وإن كانت مراتبه مختلفة بالنسبة إلىٰ مراتب المحترمات»([53]).
دلّت علىٰ حرمة إهانة المحترمات في الشريعة آيات عدّة، كقوله تعالىٰ: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾([54]).
وقوله تعالىٰ: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾([55]). وهاتان الآيتان نازلتان في تعظيم شعائر الله تعالىٰ.
تقريب الاستدلال
إنّ الذي يظهر من الآيات المتقدِّمة ـ وأشباهها من سائر الآيات والروايات ـ أنّ تعظيم الشعائر والحرمات واجبة طبعاً، ما لم تُعارضها جهة أقوىٰ منها ظاهراً، ولا ريب في أنّه إذا وجب تعظيمها، فتحرُم أيضاً إهانتها، بل إهانتها أسوأ من عدم تعظيمها؛ ولذا تُستفاد حرمتها من وجوبه بالأولوية القطعية.
إشكال ودفع
أفاد البجنوردي في قواعده بأنّ المراد بالشعائر في هذه الآية هي شعائر الحج ومناسكه لا مطلق المحترمات في الدين، فلا دلالة في هذه الآية علىٰ حرمة إهانة مطلق ما هو محترم في الدين([56]).
ويمكن دفع إشكاله& بما يلي:
أوّلاً: إنّ الشعائر جمع محلّىٰ باللام، وهو يفيد العموم، ومن الواضح عند جميع الأُصوليين أنّ المورد لا يكون مخصّصاً للعموم.
ثانياً: جعلت الآية في سورة الحج: ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾([57]). والبدن مصداق وفرد لكلّي شعائر الله تعالىٰ، ولا دليل أصلاً علىٰ أنّ شعائر الله تختصّ بالحج، بل مقتضىٰ مفهومها أنّها تشمل غيره، كالصلاة، والقرآن والمسجد، والنبي’، بل حتىٰ الأذان وشبهه ممّا تكون له خصوصية في الدين وللدين، كما أُشير إليها وإلىٰ نظائرها في الروايات.
لقد وردت نصوص كثيرة متعرِّضة لكُبرىٰ هذه القاعدة بألسنة وتعابير مختلفة، نقتصر علىٰ إيراد ثلاث طوائف منها، ذاكرين لكلّ طائفة مثالاً أو مثالين:
الطائفة الأُولىٰ: وهي التي علّل فيها تحريم بعض الكبائر بكُبرىٰ: إهانة المحرّمات، كما في رواية الصدوق بإسناده عن أبي الحسن الرضا، قال: «حرّم الله الفرار من الزحف؛ لما فيه من الوهن في الدين، والاستخفاف بالرسل والأئمّة العادلة»([58]).
استدلّ الفقهاء علىٰ تحريم الفرار من الزحف بما فيه من الوهن في الدين، والاستخفاف بالرسل، بعد الفراغ عن كبرىٰ حرمة كلّ موجب للوهن في الدين، والاستخفاف بالرسل، وهذه الكبرىٰ هي مفاد هذه القاعدة.
الطائفة الثانية: وهي التي علّلت حرمة بعض الأفعال لأجل ثبوت الحرمة للشخص، أو الشيء الذي يقع ذلك الفعل عليه أو فيه، كما في الرواية التي علّل فيها حرمة قطع العضو من الميت، أو كسر عظمه، بأنّ حرمة الميت كحرمة الحي، بل إنّ حرمته ميّتاً أعظم من حرمته وهو حيّ، ففي صحيح مسمع كردين أنّه قال: سألت أبا عبد الله عن رجل كسر عظم ميت؟ فقال: «حرمته ميتاً أعظم من حرمته وهو حيّ»([59]).
الطائفة الثالثة: وهي التي دلّت علىٰ المنع والنهي عن كلّ ما يُستخف بموجبه في دين الله تعالىٰ، كما في الرواية التي رواها الصدوق بإسناده عن علي بن أبي طالب، قال: «سمعت رسول الله’، يقول: إنّي أخاف عليكم استخفافاً بالدين»([60]).
فقد دلّ الحديث علىٰ حرمة كلّ قولٍ وفعلٍ موجب للاستهانة والاستخفاف بدين الله تعالىٰ، وإلّا لم يكن محلّ خوف، ومن أبرز مصاديقه الهتك والإهانة لما هو محترم في الدين.
ومن لطيف الروايات التي دلّت علىٰ حرمة إهانة الشعائر والمحرَّمات، هي رواية أبي الصباح الكناني، قال: «قلت لأبي عبد الله: ما تقول فيمَن أحدث في المسجد الحرام متعمّداً؟ قال: قلت: يُضرب ضرباً شديداً؟ قال: أصبت، فما تقول فيمَن أحدث في الكعبة متعمِّداً؟ قلت: يُقتل؟ قال: أصبت»([61]).
وفي رواية هشام عن الصادق، قال: «إنّ علياً رأىٰ قاصّاً في المسجد، فضربه بالدرّة وطرده»([62]).
المقدِّمة الثالثة: إثبات أنّ التربة الحسينيّة من المحترمات
للتربة الحسينيّة عند الرسول’، وأهل البيت^، وشيعتهم حرمة عظيمة، ومنزلة رفيعة، وقداسة خاصّة؛ لما بذله الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه في سبيل الله تعالىٰ من كلّ غالٍ ونفيس، وعلىٰ تلك التربة أُريقت دماؤهم الطاهرة، حتىٰ دم الطفل الرضيع، الذي لم يتجاوز عمره الستة أشهر؛ ولأجل هذه التضحية العظيمة اتّسمت هذه التربة بالعظمة والاحترام، الذي لم تنَله سائر التُرَب، حتىٰ تُرَب بقيّة الأئمّة^([63]).
وتُشير بعض الروايات إلىٰ أنّ الله تعالىٰ عوّض الحسين الشهيد من قتلِه بأربع خصال: جعل الله الشفاء في تربته، وإجابة الدعاء تحت قبّته، والأئمّة من ذرّيته، وأنّ لا يعدّ أيام زائريه من أعمارهم([64]).
وأشار إلىٰ هذه الحقيقة مجموعة من علماء الإمامية، كالسيوري في قوله: «إنّه ورد متواتراً أنّ الشفاء في تربته، وكثرة الثواب بالتسبيح بها، والسجود عليها، ووجوب تعظيمها، وكونها دافعة للعذاب عن الميت، وأماناً من المخاوف، وأنّ الاستنجاء بها حرام»([65]). وهو عين ما قاله السيّد الحكيم+([66]).
وقال صاحب مفتاح الكرامة بعد أن أورد كلام السيوري معلِّقاً عليه: «فقد نَقَل التواتر علىٰ وجوب تعظيمها ـ أي: تربة الحسين ـ من دون تخصيص بأحد الثلاثة، ومن تقييد بقصد التعظيم، يقضي باحترام آجُرها وأباريقها وغيرها، ولعلّه إلىٰ ذلك كان ينظر الأُستاذ& [أراد به كاشف الغطاء الكبير] ـ حيث كان ينهىٰ عن إخراج تلك الأواني إلىٰ غير كربلاء كراهة أو تحريماً»([67]).
وذهب البحراني& إلىٰ أنّ المحترم كالتربة المشرَّفة، لا ريب في وجوب إكرامها، وتحريم إهانتها من جهة أنّها تربته، بل لم يستبعد الحكم بكفر المستعمل لها من تلك الحيثية، وأسند هذا الحكم إلىٰ بعض علمائنا أيضاً([68]).
وعلّق السيّد السبزواري علىٰ حكم صاحب العروة بوجوب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة بأنّ هذه كلّها من المقدّسات المذهبية، بل الدينيّة في الجملة؛ فيحرم هتكها وإهانتها؛ لقداستها([69]).
وأمّا الروايات فهي كثيرة، بل متواترة، كما أشار إليها السيوري آنفاً، فعن إسحاق ابن عمّار، قال: «سمعت أبا عبد الله يقول: إنّ لموضع قبر الحسين حرمة معروفة، مَن عرفها واستجار بها أُجير...»([70]).
وعن أبي يعفور، عن أبي عبد الله أنّه قال: «إنّ الله سبحانه اتّخذ كربلاء حرماً آمناً مباركاً قبل أن يتّخذ مكّة حرماً»([71]).
وبهذا يثبت علىٰ نحو الجزم والقطع بأنّ تربة الإمام الحسين من حُرمات الشريعة التي يجب احترامها؛ تبعاً لاحترام مَن انتسبت إليه، وهو سيّد الشهداء، فلا خلاف في وجوب تعظيمها في الجملة([72]).
المقدِّمة الرابعة: إنّ تنجيس التربة الحسينيّة إهانة لها
أثبتنا في النقاط الثلاثة السابقة وجوب احترام هذه التربة الشريفة، وبقيَ علينا أن نُثبت صغرىٰ هذه الكبرىٰ، وهي كون التنجيس للتربة يُعدُّ إهانة لها، وعدم احترامٍ وتقديس لها، وهذا لا إشكال فيه بالنسبة إلىٰ القذارة الظاهرية، كتنجيسها بفضلات الإنسان وأمثالها؛ لأنّ العُرف يرىٰ أنّ هذا من المصاديق والأفراد البارزة للإهانة، بل قد يُعدّ الفرد الأوّل لها؛ ولذا يُستنكر أشدّ الاستنكار علىٰ مَن أهان شخصاً ـ ولو من الأشخاص العاديين ـ بأمثال هذه النجاسات.
وأمّا القذارة المعنوية كصبّ الخمر المعطّر عليها، فذلك أيضاً توهين لها بحكم الشرع، والعرف بعد اطّلاعه علىٰ حكم الشارع، فإنّه لا محالة يعترف بقذارة الخمر في الإسلام، غاية الأمر أنّ المسلم يُصَدِّق بذلك، والكافر لا يصدِّق، فالمسلم يرىٰ بأنّ صبّه عليها كصبّ البول في كونه موجباً للإهانة، فإذا تمّ فيجب التطهير فوراً؛ إذ كما أنّ التنجيس إهانة فبقاء النجاسة أيضاً إهانة، كما سوف يأتي شرحه مفصَّلاً([73]).
يستخلص من الدليل الأوّل النقاط الآتية:
أ ـ إنّ المحترمات والمقدَّسات والشعائر يحرُم إهانتها، ويجب احترامها وتقديسها.
ب ـ إنّ التربة الحسينيّة تعدُّ أحد أفراد المحترمات والمقدَّسات؛ وبالتالي يجب احترامها ويحرُم إهانتها.
ج ـ إنّ تنجيس هذه التربة يُعدُّ إهانة لها ويخالف احترامها.
د ـ النتيجة المأخوذة هي ثبوت الحرمة والقدسية لهذه التربة الشريفة، وعدم جواز تنجيسها ووجوب حفظها عن كلّ ما يُهينها، شأنها شأن كلّ ما عُلم من الشريعة وجوب تعظيمه، وحرمة إهانته.
لعلّ هذا الدليل لم يُذكر إلّا في كلمات السيّد السبزواري+، والشيخ عبد النبي النجفي؛ إذ قرّرا: بأنّ مقتضىٰ سيرة المتدينين خلفاً عن سلف حرمة تنجيس التربة الشريفة، ووجوب التطهير حتىٰ مع عدم الهتك والإهانة، وقد ذُكرت لها آداب خاصّة ـ هذا إذا أُخذت لأجل التبرّك والصلاة ـ.
وهذه السيرة علىٰ الظاهر من السير الثابتة ـ خصوصاً مع ملاحظة كلمات الفقهاء، التي تقدّم قسم منها ـ جيلاً بعد جيل، وفي أبواب مختلفة، والبارز منها هو باب حرمة الاستنجاء، والذي يرجع بوجه من الوجوه إلىٰ حرمة تنجيسها([74]).
وهذه السيرة علىٰ الظاهر ممتدّة إلىٰ زمن المعصوم.
النقطة الثالثة: توقّف الإهانة بالتنجيس على القصد
إنّ الإهانة للمحترمات في الشريعة لها حالتان:
أ ـ إنّ الإهانة قد تتحقّق بالفعل الصادر من المكلَّف بقصد الإهانة منه لهذا الشيء المحترم، ولو لم يكن الفعل بنفسه مصداقاً للإهانة، كتخريب المسجد بقصد الإهانة لا بقصد التعمير، وكقطع عضو الميت لا بقصد إنجاء نفس محترمة بترقيع العضو المقطوع من الميت، وكوضع النجاسة علىٰ التربة المباركة بقصد إهانتها، ففي جميع هذه الأمثلة وغيرها يصدق عليها عنوان الإهانة وتكون محرَّمة بالنسبة إلىٰ المكلَّف.
ب ـ إنّ الإهانة قد تتحقّق بالفعل نفسه، وإن لم يقصد به الإهانة، وذلك في الأفعال التي تُعدّ بنفسها من مصاديق الإهانة والهتك، إلّا مع قيام القرينة القطعية علىٰ كون صدورها من غير جهة الهتك، كتخريب المسجد للتعمير، أو مسح الظهر بالضرائح المقدّسة لأجل الاستشفاء، أو كسر التربة الحسينيّة لأجل إعادة صناعتها، وهكذا.
ومن الواضح أنّ تنجيس التربة الحسينيّة بالنجاسات المتعارفة ـ وخصوصاً المستقذرة منها، كالعذرة وأمثالها ـ يصدق علىٰ الفاعل أنّه أهان واستخفّ بالتربة المنسوبة إلىٰ سيّد الشهداء، وإن لم يقصد الإهانة لها؛ كلّ ذلك لأنّ العرف يرىٰ بذوقه العرفي أنّ هذه إهانة لها.
وأمّا كون الإهانة والهتك من العناوين القصدية لا ينافي كون بعض الأفعال بذاته من مصاديق الهتك عرفاً؛ إذ من الواضح أنّه لا دخل لقصد الهتك في صدق الإهانة والهتك علىٰ الأفعال المتمحِّضة في الهتك في نظر أهل العرف، فإنّهم يحكمون بصدق الإهانة بمجرّد صدور هذه الأفعال من أيّ فاعل، من غير انتظارهم لإحراز قصد الهتك من فاعلها.
وهذا بخلاف الأفعال غير المتمحِّضة في الهتك؛ إذ لا يحكمون بصدق الإهانة، ما لم يحرزوا صدورها بقصد الإهانة والهتك([75]).
والمتحصّل من جميع ما تقدّم: أنّ تنجيس التربة سواء بقصد الهتك والإهانة، أو بدون القصد ـ وإنّما صدر من الفاعل الفعلُ نفسه فقط، وهو تنجيسها ـ يصدق عليه إهانة، ويندرج الفاعل في سلك مَن فعل المحرّم.
بل ذهب بعضٌ إلىٰ حرمة التنجيس، حتىٰ ولو لم تستلزم الإهانة بنظر العرف؛ لأنّ العرف كثيراً ما يجهل موارد التعظيم ولا يدركها، إلّا بعد أمر الشريعة بها، كما في حرمة المكث في المسجد للمُحدِث بالأكبر، وحرمة مسّ كتابة القرآن للمُحدِث بالأصغر، فإنّهما محرّمان رغم عدم درك العرف بأنّ ترك المكث تعظيم للمسجد، وترك المسّ تعظيم للقرآن([76]).
هذا، ولكن ذهب بعضٌ من فقهائنا إلىٰ اختصاص حرمة تنجيس التربة بصورة صدق الإهانة فقط، فمع عدم صدقها لا تثبت الحرمة، كما لو كانت النجاسة يسيرة؛ إذ لا دليل علىٰ وجوب تعظيمها مطلقاً، وإنّما دلّ ارتكاز المتشرِّعة علىٰ حرمة إهانتها، وهي بحسب الفرض غير صادقة([77]).
فالمتحصّل من كلماتهم: أنّه لا إشكال في حرمة تنجيسها إذا استلزم الهتك أو كان بقصد الإهانة، وأمّا مع عدم الهتك وقصد الإهانة، فالظاهر عند بعضٍ حرمة التنجيس؛ لمنافاتها مع تعظيمها، لكن وجوب تعظيمها بجميع مراتب التعظيم مشكل؛ لعدم الدليل عليه، والقدر المتيقّن الـمُستفاد من الأخبار حرمة هتكها وإهانتها([78]).
النقطة الرابعة: تحديد التربة التي يحرُم تنجيسها
قبل البدء بذكر حدود التربة الحسينيّة التي يحرُم تنجيسها، لا بدّ من الإشارة إلىٰ ما وقع به بعض المحقّقين والكتّاب من عدم التمييز في موضوع الأحكام التي تخصّ التربة المباركة.
فالظاهر من كلامه أنّه لا فرق بين حدود التربة بالنسبة لتلك الأحكام، فلا فرق عنده بين حدود التربة التي يترتّب عليها الاستشفاء، وبين حدود التربة التي يحرُم تنجيسها، وبين الحدود التي يتخيّر فيها المصلِّي بين القصر والتمام، مع أنّ تصريح جماعة من الفقهاء وظاهر آخرين أنّ هناك فرقاً بين موضوعات تلك الأحكام من حيث الضيق والسعة، وبهذا صرّح الشهيد الثاني& بقوله ـ عند الكلام عن أكل الطين أيضاً ـ: «والمراد بطين القبر الشريف تربة ما جاوره من الأرض عرفاً، ورُوي إلىٰ أربعة فراسخ، ورُوي ثمانية، وكلّما قرب منه كان أفضل، وليس كذلك التربة المحترمة منها، فإنّها مشروطة بأخذها من الضريح المقدّس، أو خارجه.. مع وضعها عليه، أو أخذها بالدعاء»([79]).
وأمّا حدود التربة التي يحرُم تنجيسها، ففيه أقوال عديدة:
الأوّل: المراد بالتربة هي طين مكان الجسد الشريف
وهذا علىٰ القول: بأنّ جسد المعصوم يبلىٰ بعد مدّة، حاله حال سائر الأجساد، وهو أحد الأقوال الثلاثة في بقاء جسد المعصوم في القبر وعدم بقائه.
الثاني: المراد بالتربة هي ما يلازم الجسد الشريف وما يحيط به من جميع جوانبه
وهو يبتني علىٰ القول بأنّ جسد المعصوم يبقىٰ طريّاً في لحده إلىٰ يوم البعث المعلوم.
ونصّ الفقهاء علىٰ أنّه لا يراد بالتربة هذين القولين.
الثالث: المراد من التربة هي المأخوذة من قبره الشريف بما هو قبر عند العرف
فإنّ ما يُطلق عليه عرفاً قبر يثبت له حكم، يُقال له: حرمة التنجيس.
الرابع: إنّ المراد من التربة هي التربة المأخوذة ممّا يُقال عنه: حَرَم له عرفاً
فكلّ ما يُقال عنه: أنّه حرم الحسين عرفاً، يحرُم تنجيس تربته.
الخامس: إنّ المراد من التربة هي التربة المأخوذة ممّا يُقال له: حَرَم له شرعاً
فكلّ ما يُقال عنه: إنّه حَرَم الحسين بنظر الشرع. يحرُم تنجيس تربته، والذي هو موضوع الحكم في صلاة المسافر، الذي هو التخيير بين القصر والتمام.
السادس: إنّ المراد من التربة هي المأخوذة من القبر الشريف أو مما وضع عليه
فإنّ المراد من التربة هي ما أُخذت من القبر الشريف أو من الخارج إذا وُضعت عليه ـ أي: القبر ـ بقصد التبرّك والاستشفاء، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة؛ إذ إنّ تنجيسها خلاف الغرض المأخوذة له.
ولا بدّ أن يُعلم بأنّ هذا القول هو القول المختار لأكثر المعاصرين، خصوصاً مَن علّق علىٰ العروة الوثقىٰ أو شرحها، ولعلّه لم أجد مَن خالف فيه بهذا المقدار.
نعم، التربة المأخوذة من بلد الإمام لا من قبره ولا لذلك الغرض ـ وهو قصد التبرّك والاستشفاء ـ بل أُخذت للبناء بها أو طم الحفر، أو لصناعة الآجر والخزف وما شابه ذلك من الأعمال، فلا دليل علىٰ عدم جواز تنجيسها، والاحتياط بتعظيم الجميع لا بأس به.
وخالف في ذلك الشيخ كاشف الغطاء الكبير؛ فقد نقل عنه تلميذه السيّد محمد جواد الحسيني العاملي صاحب (مفتاح الكرامة)، أنّه كان ينهىٰ عن إخراج تلك الأواني ـ من الفخار والآجر وغيرها ـ إلىٰ غير كربلاء، والنهي الوارد عنه إمّا نهي كراهتي، أو نهي تحريمي، واحتمل السيّد في (مفتاح الكرامة) أنّ دليل الشيخ& هو ما نُقل متواتراً علىٰ وجوب تعظيمها من دون تخصيص هذه الروايات بأيّ قيد، ومنه قصد التعظيم عند أخذها([80]).
إنّ الـمُراد من التربة التي يجب احترامها هي ثلاثة أشياء لا غير، وهي:
1ـ ما أُخذ من الضريح المقدّس.
2ـ ما وُضع علىٰ الضريح من التراب؛ إمّا مطلق التراب ولو من غير الحرم، وإمّا التراب المأخوذ من الحرم.
3ـ ما أُخذ من باقي الحرم بالدعاء والختم عليه، ـ ولم يُقيّد بعضٌ من الفقهاء القائلين بهذا القول بالختم عليه ـ وصرّح هؤلاء أو هو مقتضىٰ كلامهم بأنّ ما أُخذ للاستشفاء من غير الضريح بدون دعاء وختم لا يجب احترامه.
الثامن: إنّ المراد من التربة هو ما أُخذ من الضريح أو خارجه مطلقاً مع قصد التعظيم
وهو ما ذكره صاحب (مفتاح الكرامة)، ولعلّه أقرب الأقوال في المسألة، وهو: أنّ كلّ ما أُخذ للاستشفاء، أو للحفظ، أو للتسبيح بها والصلاة عليها، أو لكتابة الكفن بها، أو جعلها مع الميت كان محترماً، سواء أُخذت من الضريح أو من خارجه، بالدعاء وبدونه؛ لأنّ كلّ واحدٍ منها لا ينفكّ عن قصد التعظيم، ويصحّ الاستشفاء بجميعها([81]).
اتّضح من عرض الأقوال أنّ للتربة الشريفة حكم مَن انتسبت إليه من جهة الاحترام والإهانة، فما دامت منسوبة إلىٰ الحسين؛ فيجب إزالة النجاسة عنها ويحرُم تنجيسها، ويكفي ترتيب الأحكام عليها صدق اسم التربة عليها؛ إذ الانتساب يدور مدار التسمية، سواء كانت واقعية أو صورية؛ لأنّ الجعل الاعتباري كان لتحقق النسبة، فلو أُتي بها ـ أي: التربة ـ من أبعد البلدان وسمّيت تربة الحسين، والناس يعاملونها معاملة تربة الحسين، فإنّه يترتّب عليها أحكام التربة، سواء كانت من كربلاء أم من بلدٍ آخر.
والسرّ في ذلك صدق العنوان، وكونه رمزاً للشيعة وشعاراً لهم في إظهار المحبّة بالنسبة إلىٰ أهل البيت^، فيتمسّكون بتربتهم؛ استشفاءً وإخلاصاً وإبرازاً لما في قلوبهم من حبِّهم لآل الرسول’، كما أمر الله تعالىٰ.
فالشيء الذي يكون منسوباً إليهم^ وشعاراً لشيعتهم، يجب علىٰ متابعيهم تعظيمه ويحرُم إهانته.
وأمّا الوضع علىٰ القبر الشريف، فإنّما يكون لأجل تحقّق التبرّك والاستشفاء الموجبين لتحقّق النسبة الحسينيّة، التي هي علّة وجوب الاحترام وحرمة الإهانة([82]).
النقطة الخامسة: كيفيّة إثبات أنّ هذه التربة هي من التربة الحسينيّة
إنّ الحكم بحرمة تنجيس المحترمات ومنها التربة الشريفة إنّما يترتب علىٰ كون هذه التربة المعيَّنة هي تربة الحسين، وذكر كاشف الغطاء الكبير بأنّ ذلك لا بدّ أن يثبت بطريقٍ علمي ـ بأن حصل للمكلَّف اليقين بذلك، وذلك من خلال إخبار مجموعة من الناس، أو أن يكون المكلَّف هو الآخذ لها من القبر، وأمثال ذلك ـ أو ما يقوم مقامه من الظنّ الشرعي، كشهادة العدلين، وإخبار صاحب اليد، وفي قبول خبر العدل احتمال قويّ([83]).
فهذه هي الطريقة التي تثبت بها تربة الإمام الحسين.
حكم إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة
ذكر الفقهاء في كتبهم الفقهية ـ الاستدلالية منها أو كتب الرسائل العملية ـ مسألتين متعلِّقتين بالتربة المباركة:
إحداهما: حرمة تنجيسها.
والثانية: وجوب إزالة النجاسة عنها.
وبما أنّ دليل المسألتين واحد ـ بل أشار بعض الفقهاء إلىٰ وجود ملازمة بين حرمة التنجيس ووجوب الإزالة، فكلّ تربة يحرُم تنجيسها يجب إزالة النجاسة عنها ـ نكتفي بما تقدَّم من الأدلة علىٰ وجوب إزالة النجاسة عن كلّ محترم في الشريعة، ومنها التربة الشريفة.
ولا بدّ أن يُعلم بأنّ موضوع وجوب إزالة النجاسة هو بعينه موضوع حرمة التنجيس، وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك مفصَّلاً، وأشرنا إلىٰ ما يحرُم تنجيسه من تلك التربة، فلا حاجة للإعادة.
ولكن يبقىٰ هنا أمران لا بدّ من الإشارة إليهما سريعاً:
الأمر الأوّل: الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء الذين ذكروا هذه المسألة ـ خصوصاً المعاصرين، أو ما قارب عصرنا ـ في وجوب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية المباركة، ونخصّ بالذكر منهم كلّ مَن علّق علىٰ هذه المسألة وهو بصدد عرض مسائل كتاب (العروة الوثقىٰ) للسيّد اليزدي.
الأمر الثاني: إنّ وجوب إزالة النجاسة عن التربة إنّما يُؤمر به المكلَّف إذا استلزم بقاؤها وترك الإزالة هتكاً لها وإهانة.
فترك الإزالة من المكلَّف إذا استلزم منه هتك التربة وإهانتها؛ يترتب عليه وجوب تطهيرها. وهذا لا خلاف فيه من قِبل كلّ مَن تعرّض للمسألة.
آراء الفقهاء في ترك إزالة النجاسة إذا لم يكن موجباً لهتك حرمة التربة
وقع الاختلاف بين الفقهاء فيما إذا لم يكن ترك الإزالة للنجاسة موجباً لهتك حرمة التربة المباركة، علىٰ قولين:
القول الأوّل: وجوب الإزالة في جميع الحالات
اختار بعض الفقهاء التعميم لجميع الحالات، سواء استلزم الإهانة والهتك، أم لم يستلزم([84]).
وحاصل ما يمكن الاستدلال به:
ما ورد من لزوم تعظيم التربة وعدم الاستخفاف بها، كما في رواية أبي حمزة الثمالي عن الإمام الصادق: «...ولقد بلغني أنّ بعض مَن يأخذ من التربة شيئاً يستخفّ به، حتىٰ أنّ بعضهم يضعها في مخلاة البغل والحمار، وفي وعاء الطعام والخرج، فكيف يَستشفي به مَن هذا حاله عنده؟!»([85]).
وفي هذا الحديث دلالة علىٰ وجوب إزالة النجاسة؛ لاستلزام بقائها الاستخفاف وعدم التعظيم([86]).
لقد أُورد علىٰ الدليل المتقدِّم بأنّ المستفاد ـ بقرينة السياق والمقام ـ أنّ عدم الاستخفاف بالتربة إنّما يكون مطلوباً لأجل تحصيل الآثار المترتّبة علىٰ التربة ـ كالاستشفاء بها مثلاً ـ لا أنّه المطلوب علىٰ كلّ حال([87]).
هذا، ولكنّ المستدلّ لا يريد الاستدلال بروايةٍ خاصّة حتىٰ يُورَد عليه بما تقدّم، بل هو ناظر إلىٰ ما ورد متواتراً من لزوم تعظيم التربة، وعدم الاستخفاف بها، وترك إزالة النجاسة ـ علىٰ الظاهر ـ يؤدّي إلىٰ تحقّق هذين العنوانين؛ لأنّه خلاف الاحترام المأُمور به.
وهو المذكور علىٰ لسان السيّد الشهيد محمد باقر الصدر&، ويمكن تقريبه بما يأتي:
إنّ وجوب إزالة النجاسة لـمّا كان حكماً احترامياً، وإنّ المفهوم من أدلة فضيلة التربة الحسينيّة وكون السجود عليها أفضل من السجود علىٰ أرض المسجد نفسها، فسوف يشملها حكم المسجد، وهو وجوب إزالة النجاسة عنها، وذلك بتنقيح المناط، فإنّ مناط وجوب الإزالة واحد وهو الاحترام. وبذلك يثبت وجوب الإزالة للنجاسة عن التربة المباركة([88]).
القول الثاني: عدم وجوب الإزالة
إنّ المختار لدىٰ بعض الفقهاء عدم وجوب الإزالة إذا لم يستلزم الإهانة والهتك للتربة الحسينيّة، نعم، هو المناسب للاحتياط.
وحاصل ما يُستدل به هو: أنّ النصوص التي يمكن العثور عليها، ممّا يضمن الأمر بتعظيمها والنهي عن الاستخفاف بها، ظاهر ـ بقرينة السياق والمقام ـ في اعتبار ذلك الانتفاع بها، للاستشفاء وغيره من فوائدها الجليلة، وليس فيها دلالة علىٰ أنّ ذلك من أحكامها مطلقاً، بحيث يحرُم تنجيسها وإن لم يستلزم الهتك والإهانة([89]).
وقد تقدَّمت المناقشة في هذا الدليل في مناقشة الدليل الأوّل من القول الأوّل([90]).
ويتفرّع علىٰ أصل المسألة بعض الفروع، نُشير إليها إجمالاً:
أ ـ الحكم بكفر مَن هتك التربة الحسينيّة
قال كاشف الغطاء&: «مَن استعمل شيئاً من المحترمات الإسلامية هاتكاً للحرمة خرج عن الإسلام، والمستعمل لشيءٍ من المحترمات الإيمانية بذلك القصد ـ وهو قصد الإهانة والهتك ـ خارج عن الإيمان»([91]).
ب ـ وجوب إزالة النجاسة عن التربة فوري
لا خلاف في أنّ وجوب إزالة النجاسة عن المحترمات ـ ومنها التربة المباركة ـ يكون فورياً، فلا يجوز تأخير الإزالة مع عدم العذر([92]).
ج ـ وجوب الإزالة كفائي لا عيني
لا خلاف بينهم في أنّ وجوب إزالة النجاسة عن التربة وجوب كفائي لا عيني، فإذا قام أحد المكلَّفين بإزالة النجاسة عن التربة المتنجِّسة، سقط عن الآخرين.
حرمة الاستنجاء بالتربة الحسينيّة
الاستنجاء من المسائل الفقهية العملية، والتي تُبحث في باب الطهارة تحت عنوان: (التخلّي)، ولعلّ الشريعة الإسلامية سبقت الحضارة الغربيّة بمئات السنين في التأكيد علىٰ الطهارة والنظافة، بل وتقنينهما.
ولكي تتّضح حرمة الاستنجاء بالتربة الحسينيّة نذكر ـ وكمقدِّمة لما نحن فيه ـ بعض الأُمور المتعلِّقة بالاستنجاء:
الأمر الأوّل: تعريف الاستنجاء لغةً واصطلاحاً
الاستنجاء لغةً مصدر: استنجىٰ، أي: طلب النجو، أو النجوة. ومن معاني النجو: الخلاص والقطع. والنجوة: المكان المرتفع، الذي ينجو فيه الإنسان من السيل([93]).
وعرّفها فقهاء الإمامية: «إزالة ما يبقىٰ من أحد الخبثين ـ بعد خروجهما من المحلّين الأصليين، أو المعتادين العارضين في وجه ـ عن ظاهر الموضع الذي خرجا منه»([94]).
الاستنجاء عند فقهاء الإمامية من الأُمور الواجبة، إلّا أنّهم قيّدوا الوجوب بما إذا وُجد سببه، وهو أمر خارج، والوجوب هنا هو وجوب شرطي لا نفسي، بمعنىٰ أنّ الاستنجاء وإنّ كان مطلوباً في حدِّ ذاته، ومرغوباً فيه، إلّا أنّه لا يجب إلّا لما تُشترط فيه الطهارة من الخبث، كالصلاة دون ما لا تُشترط فيه كالوضوء([95]).
الأمر الثالث: الأشياء التي يُستنجى منها
ذهب فقهاء الإمامية إلىٰ أنّه لا يُستنجىٰ من (المذي والودي)، وأمّا الدم إذا خرج من موضع الغائط أو البول؛ فإنّه يحتاج إلىٰ تطهيره بالماء، ولا يكفي الاستجمار ـ الذي يأتي تفسيره ـ وأمّا الغائط والبول، فيجب الاستنجاء منه بغسله بالماء، ولا يصحّ الاستنجاء بالأحجار في موضع غير الغائط، نعم، يصحّ الاستنجاء بالأحجار في موضع الغائط بالخصوص، وأمّا إذا خرج البول أو الغائط من غير الموضع المعتاد، وأصبح بعد ذلك معتاداً، ففي شمول حكم الاستنجاء له قولان عند الإمامية:
الأوّل: شمول حكم الاستنجاء له.
والثاني: عدم شمول حكم الاستنجاء له([96]).
الأمر الرابع: مصاديق الاستنجاء (ما يُستنجى به)
الاستنجاء يمكن أن يتحقّق بأمرين:
الأوّل: الماء، وهو قابل لتطهير موضع الغائط والبول معاً، بشرط إزالة عين وأثر الغائط في الغائط، والتعدّد في إزالة البول، وهذا لا خلاف فيه عند فقهاء الإمامية، ولا يصحّ الاستنجاء بغير الماء من المائعات، بشرط أن يكون الماء مطلقاً وطاهراً.
الثاني: الجوامد القالعة للنجاسة
المشهور بين الإمامية أنّه يصحّ الاستنجاء بكلّ جسم طاهر قالع للنجاسة ومزيل لها، كالحجر والخرق والخشب ونحوها، عدا ما مُنع الاستنجاء به([97]).
الأمر الخامس: شروط ما يُستنجى به من الجوامد
يُشترط فيما يُستنجىٰ به أُمور، هي:
1ـ الطهارة، فلا يصحّ الاستنجاء بالنجس.
2ـ البكارة، بمعنىٰ: يُشترط أن يكون الشيء الجامد غير مستعمل في إزالة النجاسة سابقاً.
3ـ أن يكون الجسم الجامد جافّاً، وهو مختار بعض فقهاء الإمامية([98]).
الأمر السادس: مقدار ما يُجزي من الأحجار
يكفي في الاستنجاء بالأحجار ثلاثة أحجار، مع تحقّق الإزالة والانتقاء بالمسح بها، ولو لم يتحقّق النقاء بالثلاثة وجب التمسّح بما يحقّق له الإزالة وإن زاد علىٰ الثلاثة([99]).
الأمر السابع: الأشياء التي لا يجوز الاستنجاء بها
ذكر جمعٌ من فقهاء الإمامية بأنّ هناك أُمور عدّة لا يجوز الاستنجاء بها، وهي كالآتي:
1ـ الأعيان النجسة: كالميتة، وتُلحق بها الأعيان المتنجّسة، كالحجر المتنجّس بالاستعمال في الاستنجاء وغيره.
2ـ العظم: وهو يشمل مطلق العظم من جميع الحيوانات حتىٰ الطاهرة.
3ـ الروث.
4ـ المطعوم: وهو كلّ ما كان طعاماً للإنسان.
5ـ المحترمات: وهي كلّ ما كان محترماً في نظر الشارع([100]).
وبما أنّ الذي يهمّنا في بحثنا هذا هو المحترمات، لذلك فلنبسط الكلام فيها بشيء من التفصيل والتوضيح.
عرّف بعض فقهاء الإمامية المحترمات: بأنّها ما أُحرز من الشرع المقدَّس فإنّه يجب احترامه، ويحرم هتكه، مثل القرآن العزيز وكتب الحديث؛ فإنّ هتك ذلك هتك لمحارم الله تعالىٰ([101]).
وعرّفها السيّد الخوئي جواباً عن سؤال وجه إليه: «المقصود منها كلّ ما يجب احترامه ولا يجوز هتكه، مثل كُتب أحاديث الأئمّة^، والكُتب الفقهية، والتربة الحسينيّة، وتربة سائر الأئمّة الأطهار^، وما شاكل ذلك»([102]). والظاهر أنّ مرجع التعريفين إلىٰ أمر واحد.
2ـ التربة الحسينيّة مصداق للمحترمات
قال صاحب الجواهر&: «ثمّ إنّه يُفهم من كثير من الأصحاب ـ بل لم أعثر فيه علىٰ مخالف ـ جريان الحكم في كلّ محترم، كالتربة الحسينيّة وغيرها... بل قد يتمشّىٰ الحكم في المأخوذ من قبور الأئمّة، من تراب أو صدوق أو غيره...»([103]).
وعبارته تدلّ علىٰ أُمور:
أ ـ ذهاب الكثير ـ بل عدم وجود مخالف ـ إلىٰ أنّه لا يصحّ، ويحرُم الاستنجاء بالمحترمات.
ب ـ إنّ المصداق البارز للمحترمات هو تربة الحسين، وهو ما صرّح به كثير من فقهائنا.
ج ـ جريان الحكم علىٰ التراب المأخوذ من قبور الأئمّة^ أيضاً.
وبعد الانتهاء من الحديث عن الأُمور المتقدِّمة ـ التي كانت عبارة عن مقدِّمات للبحث الأساس في المقام ـ فإنّنا سوف نتطرّق إلى بيان مدرك الحكم بحرمة الاستنجاء بالتربة الحسينيّة من خلال نقطتين، هما:
النقطة الأُولى: النصوص الفقهية الواردة في حرمة الاستنجاء بتربة الإمام الحسين×
النصوص الفقهية التي صُرّح فيها بالحرمة بنحو العموم ـ حرمة المحترمات ـ أو بنحو الخصوص كثيرة، نقتصر هنا علىٰ ذكر بعضها:
أ ـ قال الطوسي: «كلّ جسم طاهر مزيل للنجاسة فإنّه جائز؛ للخبر الذي قال فيه: ينقي ما ثَمّة([104])، وهو عامّ في كلّ ما ينقّي، إلّا ما استثناه ممَّا له حرمة»([105]).
ب ـ قال العلّامة: «ألّا يكون ممّا له حرمة، كتربة الحسين، وحجر زمزم، وكتب الأحاديث وورق المصحف العزيز، وكتب الفقه؛ لأنّ فيه هتكاً للشريعة، واستخفافاً لحرمتها، فهو في الحرمة أعظم من الروث والرمّة»([106]).
ج ـ ما قاله البحراني ـ وهو بصدد تعداد المحرّمات ـ: «ومنها: الاستنجاء بالروث والعظم والمطعوم المحترم، ومنه التربة الحسينيّة علىٰ مشرِّفيها أفضل التحية، والقرآن، وما كُتب فيه شيء من علوم الدين، كالحديث والفقه»([107]).
د ـ وقال الفاضل الهندي ـ وهو بصدد تعداد الممنوعات ـ: «... وذي الحرمة، كالمطعوم، وورق المصحف، وشبهه ممَّا كُتب عليه شيء من أسماء الله تعالىٰ، أو الأنبياء، أو الأئمّة^، وتربة الحسين، بل وغيره من النبي| والأئمّة^: وبالجملة ما عُلم من الدين أو المذهب وجوب احترامه، فإنّ في الاستجاء به من الهتك ما لا يوصف»([108]).
يمكن للمتابع لكلمات الفقهاء أن يحصل علىٰ أدلّة عدّة لإثبات الحكم بالحرمة، وهي كما يلي:
أ ـ إنّ المحترمات ـ ومنها التربة الحسينيّة ـ لا ريب ولا شكّ عند الفقهاء في وجوب إكرامها، وقد تقدَّم قسم منها، ويأتي قسم آخر منها ـ إن شاء الله ـ وهذا يستلزم تحريم إهانتها، والاستنجاء بها يمثّل المصداق البارز للإهانة، من حيث كونها تربة الحسين([109]).
ب ـ ما صرّح به صاحب الجواهر من عدم وجود مخالف في الحكم المذكور، وهذا إن ارتقىٰ إلىٰ جعله دليلاً وداعماً للحكم بالحرمة فهو، وإن لم يرقَ إلىٰ ذلك، فهو علىٰ أقلّ تقدير علىٰ حدِّ الشهرة التي يتوقّف الفقهاء في الحكم علىٰ خلافها، بل يحتاطون في مقام الفتوىٰ لأجلها([110]).
ج ـ ما ذكره صاحب الجواهر أيضاً: «أنّه لا يليق بالفقيه الممارس لطريقة الشرع، العارف للسانه، أن يتطلّب [يطلب] الدليل علىٰ كلّ شيء بخصوصه، من رواية خاصّة ونحوها، بل يكتفي بالاستدلال علىٰ جميع ذلك بما دلّ علىٰ تعظيم شعائر الله، وبظاهر طريقة الشرع المعلومة لدىٰ كلّ أحد، أترىٰ أنّه يليق به أن يتطلّب رواية علىٰ عدم جواز الاستنجاء بشيء من كتاب الله تعالىٰ؟!»([111]).
فهو& يُبيّن:
أولاً: بأنّ الدليل العامّ هو أنّ شعائر الله تعالىٰ يجب تعظيمها، وتقديسها والاهتمام بها، وكلّ ما يخالف هذا التعظيم ـ ومنه الاستنجاء بالتربة المقدَّسة ـ يكون منهياً عنه ومحرّماً.
وثانياً: إنّ طريقة الشارع ـ وروح الشريعة المعلومة عند كلّ أحد ـ أنّ هذه المحترمات لا يجوز إهانتها والاستنجاء بها؛ ولذلك نحن لا نحتاج إلىٰ رواية خاصّة تحرّم الاستنجاء بشيء من القرآن الكريم، وكذلك التربة المقدَّسة، بل نكتفي للقول بالحرمة بهذه المسلَّمات والأُمور الكلّية.
د ـ الأولوية المستفادة من حرمة بعض الأشياء التي هي أقلّ شأناً من التربة الحسينيّة؛ فإنّ الدليل الخاصّ دلّ علىٰ حرمة الاستنجاء بالروث والعظم وغيرها، مع أنّها من حيث القداسة والاحترام والأهمية أقلّ بكثير من التربة الحسينيّة، فكيف بالتربة المشار إليها؟!([112]).
هذا، ولا بدّ أن يُعلم أنّ الحرمة المتقدِّمة إنّما تثبت فيما إذا لم تقصد الإهانة للتربة، أمّا إذا قصدت الإهانة، فقد يستلزم منه الحكم بكفر فاعله، كما سوف يأتي.
فائدة: بيان فضيلة من فضائل الإمام الحسين× فيما يتعلّق بالمقام
لا بأس ـ ونحن نتحدّث عن حرمة إهانة هذه التربة المقدَّسة، التي مدحها النبي’ قبل وقوع حادثة كربلاء بعدّة عقود ـ أن نُشير إلىٰ رواية رواها جملة من علمائنا ـ عطّر الله مراقدهم ـ عن الشيخ الطوسي في كتاب الأمالي، تبيّن الأثر الوضعي للاستخفاف بتلك التربة، وقد تُبيّن أيضاً شرف وقداسة تراب قبر الحسين؛ وبالتالي شرف مَن دُفن فيها.
قال& في الأمالي بسنده عن أبي موسىٰ بن عبد العزيز، قال: «لقيني يوحنّا بن سراقيون النصراني، المتطبّب في شارع أبي أحمد، فاستوقفني، وقال لي: بحقّ نبيِّك ودينك، مَن هذا الذي يزور قبره قومٌ منكم بناحية قصر ابن هبيرة؟ مَنْ هو من أصحاب نبيِّكم؟ قلت: ليس هو من أصحابه، هو ابن بنته، فما دعاك إلىٰ المسألة عنه؟ فقال: له عندي حديث طريف. فقلت: حدِّثني به. فقال: وجّه إليّ سابور الكبير الخادم الرشيدي في الليل، فصرت إليه، فقال لي: تعال معي. فمضىٰ وأنا معه، حتّىٰ دخلنا علىٰ موسىٰ بن عيسىٰ الهاشمي، فوجدناه زائل العقل منكبّاً علىٰ وسادة، وإذا بين يديه طشت فيه حشوة جوفه، وكان الرشيد استحضره من الكوفة، فأقبل سابور علىٰ خادم كان من خاصّة موسىٰ، فقال له: ويحك ما خبره؟ فقال: أخبرك أنّه كان من الساعة جالساً وحوله ندماؤه، وهو من أصحّ الناس جسماً وأطيبهم نفساً، إذ جرىٰ ذكر الحسين بن علي÷. قال يوحنّا: هذا الذي سألتك عنه. فقال موسىٰ: إنّ الرافضة لتغلوا فيه، حتّىٰ إنّهم ـ فيما عرفت ـ يجعلون تربته دواءً يتداوون به. فقال له رجل من بني هاشم كان حاضراً: قد كانت بي علّة غليظة، فتعالجت لها بكلّ علاج فما نفعني، حتّىٰ وُصف لي أن آخذ من هذه التربة، فأخذتها، فنفعني الله بها، وزال عنّي ما كنت أجده. قال: فبقي عندك منها شيء؟ قال: نعم. فوجّه، فجاؤوه بقطعة منها، فناولها موسىٰ بن عيسىٰ، فأخذها موسىٰ، فاستدخلها دبره استهزاءً بمَن يتداوىٰ بها، واحتقاراً وتصغيراً لهذا الرجل الذي هذه تربته ـ يعني الحسين ـ فما هو إلّا أن استدخلها دبره، حتّىٰ صاح: النار النار!! الطشت الطشت!! فجئناه بالطشت فأخرج فيه ما ترىٰ، فانصرف الندماء وصار المجلس مأتماً. فأقبل عليّ سابور، فقال: اُنظر هل لك فيه حيلة؟ فدعوت بشمعة، فنظرت فإذا كبده وطحاله ورئته وفؤاده خرج منه في الطشت، فنظرت إلىٰ أمر عظيم، فقلت: لا أجد إلىٰ هذا صنعاً، إلّا أن يكون عيسىٰ الذي كان يحيي الموتىٰ. فقال لي سابور: صدقت، ولكن كن هاهنا في الدار، إلىٰ أن يُتبيّن ما يكون من أمره. فبتُّ عندهم وهو بتلك الحال ما رفع رأسه، فمات في وقت السحر. قال محمد بن موسىٰ: قال لي موسىٰ بن سريع: كان يوحنّا يزور قبر الحسين وهو علىٰ دينه، ثُمّ أسلم بعد هذا وحسن إسلامه»([113]).
يتفرّع علىٰ حرمة الاستنجاء بالتربة المقدَّسة فروع عدّة لا بدّ من الإشارة إليها، وهي محلٌّ للابتلاء:
1ـ الحكم بكفر المُستنجي بالتربة بقصد الإهانة
قد يستغرب بعضٌ من وصول الحكم إلىٰ تكفير مَن استهان بالتربة الحسينيّة عند الاستنجاء بها، والحكم عليه بهذا الحكم القاسي نسبياً، ولكن هذا الاستغراب يزول بملاحظة عشرات الروايات الدالّة علىٰ قداسة التربة، ولزوم احترامها، وبيان الآثار الوضعية فيها، مع تعدّد القائل بها من قِبل جميع المعصومين، كما أنّ هذا الحكم ليس علىٰ إطلاقه، بل هو مقيّد بقصد إهانتها من حيث إنّها تربة الحسين، وهذا ما أشار إليه جملة من فقهاء الإمامية، منهم: الكركي، والبحراني، والشهيد الثاني، والشيخ جعفر كاشف الغطاء، والشيخ محمد حسن صاحب الجواهر، وغيرهم. ولعلّ العبارة الجامعة لهذا الحكم هي ما ذكرها صاحب الجواهره، قائلاً: «ثُمّ ليُعلم أنّ ما ذكرناه من حرمة الاستنجاء بالمحترم، إنّما هو حيث لا يكون مع قصد الإهانة، وإلّا فقد يصل فاعله بالنسبة إلىٰ بعض الأشياء إلىٰ حدِّ الكفر، والعياذ بالله، والضابط أنّ كلّ مُستحِل ممّا عُلم تحريمه من الدين ضرورةً، أو فعله بقصد التكبّر والعناد، أو الفسق، وإن لم يكن مُستحِلاً تحقّق به الكفر؛ فيكون نجساً ذاتياً»([114]).
2ـ حكم الاستنجاء بالمشكوك من التربة بقصد الإهانة
اختلفت كلمات الفقهاء المتأخرين ـ إذ لم أجد مَن صرّح من المتقدِّمين بهذا الفرع ـ في جواز الاستنجاء أو عدم جوازه، فيما لو شكّ المستنجِي بالشيء المستنجَىٰ به، وهل هو من التربة الحسينيّة التي يحرُم الاستنجاء بها، أو هي شيء آخر مما يجوز الاستنجاء به؟
فذهب جماعة منهم السيّد صاحب العروة الوثقىٰ، والسيّد السبزواري، وغيرهما إلىٰ جواز الاستنجاء بما يشكّ في كونه من تربة الحسين.
واستدلّ السيّد السبزواري بأصالة البراءة، التي هي المرجع في جميع الشبهات التحريمية، حكمية كانت أو موضوعية([115]).
وفصَّل بعضٌ آخر بين ما لو شكّ في كونه ممَّا يحرُم الاستنجاء به تكليفاً فيجوز لأصالة الحلّ، وبين ما لو شكّ في كونه ممَّا لا يجوز الاستنجاء به وضعاً، فلا يجوز؛ لاستصحاب النجاسة([116]).
واحتاط بعضٌ آخر من الفقهاء بعدم الجواز، فقال: بأنّ الأوْلىٰ تركه.
وأمّا طهارة المحلِّ بعد الاستنجاء بالشيء المشكوك، ففيه أقوال:
أ ـ طهارة المحلِّ.
ب ـ عدم طهارة المحلِّ.
ج ـ الاستشكال بالطهارة.
ولعلّ الأكثر يذهب إلىٰ القول الأوّل([117]).
3ـ حكم طهارة الموضع بعد الاستنجاء بالتربة الحسينيّة
من الأُمور المترتّبة علىٰ حرمة الاستنجاء بالتربة الحسينيّة ـ بعد القول بالحرمة كما تقدَّم ـ: هو طهارة الموضع (محلِّ الاستنجاء) أو عدم طهارته، بعد أن خالف المكلَّف الحرمة وارتكبها، وقام بالاستنجاء، أم بنجاسته؟
اختلاف الإمامية في هذا الفرع علىٰ قولين:
القول الأوّل: طهارة موضع الغائط بالاستنجاء بالتربة الحسينيّة
وهو ما ذهب إليه جماعة كثيرة من الفقهاء، بل اشتهر بينهم كما صرّح بذلك بعضٌ، وهو القول بطهارة الموضع.
واستدلّوا علىٰ ذلك بدليلين:
الدليل الأوّل: إنّ الاستنجاء بالتربة الحسينيّة وإن كان منهياً عنه ـ بحكم الروايات وعمومات النهي ـ إلّا أنّه لا تنافي بين النهي والقول بالإجزاء وطهارة الموضع في أمثال هذه النواهي؛ لأنّها ليست من الأُمور العبادية التي يستلزم النهي عنها بطلانها؛ لعدم دخول عنصر القربة فيها حتّىٰ يتنافىٰ مع النهي؛ وبالتالي يكون حال المكلَّف في هذا الفرض كحال مَن يستنجي بحجر أو ماء مغصوبين.
الدليل الثاني: إنّ المتفاهم عرفاً في مثل هذه النواهي هو إرادة الحكم التكليفي دون الوضعي، مع أنّ عمدة الدليل هو الإجماع، والمتيقّن منه الحرمة التكليفية؛ لاختلافهم في الحكم الوضعي، والعرف أصدق شاهد؛ فإنّه إذا قيل: لا تستنجِ بمنديلي، فإنّي أمسح به وجهي. أو لا تستنجِ بثوبي، فإنّي ألبسه. فإنّه لا يُتوهّم منه عدم قلع نجاسة المحلِّ به لو استنجىٰ، والأخبار ـ علىٰ فرض اعتبارها ـ لا تدّل علىٰ أزيد من ذلك([118]).
فيكون إطلاق قوله: «ينقّي ما ثَمّة». هو المعوَّل بعد تحقّق النقاء وجداناً.
القول الثاني: عدم طهارة موضع الغائط بالاستنجاء بالتربة الحسينيّة
ما ذهب إليه جماعة من عدم طهارة موضع الغائط بالاستنجاء بالتربة الحسينيّة، بل ظاهر بعضٍ قيام الشهرة عليه، بل عن الغُنية: دعوىٰ الإجماع([119])، وعمدة مَن ذهب إلىٰ هذا القول: الشيخ الطوسي، وتبعه الحلّي وغيره([120])، وعمدة الدليل الذي اعتمده الشيخ، ومَن تبعه، هو كون النهي عن الاستنجاء بالمحترمات، ومنها التربة الحسينيّة، يُوجب الفساد وعدم ترتّب الأثر الوضعي عليه، وهو طهارة المحلِّ([121]).
وقرّب الشيخ الهندي في (كشف اللثام) الدليل: بأنّ الرُّخص (مثل إزالة النجاسة عن الموضع) لا تُناط بالمعاصي (هي الاستنجاء بالتربة الحسينيّة)، المنهي عن أهانتها والأمر باحترامها.
وبعبارةٍ أُخرىٰ: إنّ الأصل والاحتياط يقتضيان بقاء النجاسة، خصوصاً مع بقاء أثرها؛ فلا يُحكم إلّا بطهارة ما علمت طهارته بالنصّ والإجماع، فلا يجزي ما حرّمه الشارع([122]).
واختلفت ـ تبعاً للأدلّة المتقدِّمة وغيرها ـ فتوىٰ المعاصرين، فمنهم مَن منع من حصول الطهارة، ومنهم مَن حكم بالطهارة صراحةً، ومنهم مَن استشكل بالحكم، والظاهر منه الاحتياط وبقاء النجاسة علىٰ حالها.
قال السيّد السبزواري+ تعليقاً علىٰ ما في متن العروة القائل بأنّه: «لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات، ولا بالعظم والروث، ولو استنجىٰ بها عصىٰ ولكن يطهر المحلّ علىٰ الأقوىٰ: أمّا المحترمات فلأنّه هتك، وأيّ هتك أعظم منه؟ بل قد يوجب الكفر»([123]).
وقال الشيخ الفيّاض تعليقاً علىٰ متن العروة المتقدِّم، وهو عدم جواز الاستنجاء بالمحترمات، ما نصّه: «علىٰ الأحوط، ولا يبعد جوازه تكليفاً، وأمّا وضعاً فبناءً علىٰ ما قوّيناه من أنّ الاستنجاء لا بدّ أن يكون بالأحجار والخرق ولا يكفي كلّ جسم قالع فلا يكفي بهما، ومنه يطهر حال الاستنجاء بالمحترمات وضعاً»([124]).
وقال السيّد الخميني+: «يحرُم الاستنجاء بالمحرَّمات وكذا العظم والروث علىٰ الأحوط، ولو فعل فحصول الطهارة محلّ إشكال...»([125]).
وقال السيّد السيستاني: «لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات... ولو استنجىٰ بها عصىٰ لكن يطهر المحلّ علىٰ الأقوىٰ»([126]).
وقال السيّد الخوئي+ تعليقاً علىٰ متن العروة المتقدِّم ذكره: «والاستنجاء بها من المحرَّمات النفسية التكليفية لحرمة هتكها، ومن هنا لو استنجىٰ بها غفلة أو متعمداً طهر به المحلّ لإطلاق الأخبار الدالّة علىٰ كفاية التمسّح وإذهاب الغائط في الاستنجاء، وإن كان أمراً محرَّماً في نفسه، هذا إذا لم يستلزم الاستنجاء بها الكفر والارتداد، وأمّا لو بلغ تلك المرتبة، كما إذا استنجىٰ بالكتاب عامداً، وقلنا إنّه يستلزم الارتداد فلا معنىٰ للبحث عن طهارة المحلِّ بالاستنجاء لتبدّل النجاسة العرضية بالذاتية للارتداد»([127]).
وقال السيّد الروحاني: «ثمّ إنّه لو استنجىٰ بما لا يجوز الاستنجاء به، هل يطهر المحلّ ـ كما عن جماعة كثيرة منهم المصنف& وجمع ممّن تأخّر عنه ـ أم لا، كما عن الشيخ في المسبوط، والمحقّق في المعتبر، وابن إدريس، وغيرهم، أم يُفصَّل بين الموارد؟ وجوه أقوال. وتنقيح القول في المقام: أنّه لو كان دليل التعدّي عن الأُمور المنصوصة إلىٰ غيرها هو الإجماع كان الأقوىٰ القول الثاني [وهو عدم طهارة المحلِّ]، ولكن عرفت أنّ المستند في الأخبار.
وعليه فقد يُتوهّم أظهرية القول الأوّل [وهو طهارة المحلّ] لإطلاق الأدلّة، وعدم دلالة النهي في مثل المقام علىٰ الفساد؛ لكونه من قبيل المعاملات، ولأنّ ظاهر خبر ليث المتقدِّم أنّه لا مانع من الاستنجاء بالعظم والروث إلّا ما يوجب الحرمة التكليفية.
[ثمّ ناقش السيّد الروحاني هذا التوهّم بمناقشين، وتوصّل إلى أنّ الصحيح] هو التفصيل بين ما نُهي عن الاستنجاء به، وبين ما حُرّم ذلك لأجل انطباق عنوان محرَّم عليه، والالتزام بعدم المطهَّرية في الأوّل، والمطهَّرية في الثاني هو الأقوىٰ» ([128]).
حكم حمل التربة المباركة إلى بيت الخلاء ووقوعها فيه
إنّ الشريعة الإسلاميّة المنقولة عن طريق آل البيت^ لم تترك شاردةً ولا واردةً إلّا ذكرت حكمها، بل الروايات في ذلك متضافرة، سواء بنحوٍ كلّي، وذلك من خلال القواعد العامّة التي تنطوي المسألة تحتها، المعبَّر عنها بالأُصول، أم بنحوٍ خاصّ من خلال ورود نصٍّ خاصٍّ يعالج حكم المسألة المعيّنة.
ومن هنا؛ فإنّه وبالاستفادة من الكليات الواردة في معالجة الأحكام يمكن الاستدلال علىٰ كثير من الأحكام المتعلّقة بالتربة الحسينيّة المباركة، إضافةً إلىٰ ورود روايات خاصّة مستفيضة أو متواترة علىٰ بعض أحكامها، ومن تلك الأحكام:
1ـ حكم حمل التربة الحسينيّة إلى بيت الخلاء
ذكرت الشريعة الإسلاميّة آداباً خاصّة للتخلّي، تحت عنوان: (فصلٌ في مستحبّات التخلِّي ومكروهاته)، ولا ننكر أنّ هناك آداباً قد ذكرتها الديانات الأُخرىٰ، ولكن اختصّت الشـريعة الإسلاميّة بالشمولية، بحيث عالجت أدقّ حالات المكلَّف، وقد اكتشف العلم الحديث بعض أسرار هذه الآداب من المستحبات والمكروهات، ممّا يكشف ارتباط هذه الشريعة الغرّاء بمبدأ الغيب، وكونها شريعة إلهية بكلّ تفاصيلها.
ومن تلك المكروهات التي لا بدّ أن يتجنّبها المكلَّف عند دخوله لبيت الخلاء: استقبال الشمس عند قضاء حاجته، واستقبال الريح، والجلوس في الشوارع واصطحاب الدراهم البيض ـ وغير ذلك من المكروهات ـ بل مطلقاً إذا كان عليه اسم الله (تعالىٰ)، أو محترمٍ آخر.
والمراد بها: كلّ ما أُحرز من الشرع المقدَّس أنّه يجب احترامه، ويحرُم هتكه، مثل القرآن العزيز، وكتب الحديث، والتربة الحسينيّة، وأمثالها.
وقد حكم بعض الفقهاء المعاصرين بكراهة اصطحاب المحترمات ـ ومنها تربة الإمام الحسين ـ إلىٰ بيت الخلاء.
وقد أشار إلىٰ هذا القول كلٌّ من السبزواري ـ صاحب (ذخيرة المعاد) ـ وكاشف الغطاء، والسيّد عبد الأعلىٰ السبزواري في (مهذّب الأحكام).
وقد ناقش بعضٌ آخر في أدلّة هؤلاء، وانتهىٰ إلىٰ عدم وجود دليل يدلّ علىٰ الكراهية.
والحاصل من كلماتهم أنّ في المسألة قولين:
القول الأوّل: الحكم بكراهة اصطحاب المحترمات إلى بيت الخلاء([129])
وحاصل الدليل الذي يمكن استفادته من كلماتهم ما يلي:
أ ـ إنّ الروايات دلّت علىٰ النهي من اصطحاب الخاتم وعليه اسم الله إلىٰ بيت الخلاء، وهذا النهي محمولٌ علىٰ الكراهة، كما صرّح به الفقهاء، وقد حمل الفقهاء ذكر الخاتم علىٰ مجرّد المثال ـ فنتعدّىٰ بتنقيح المناط([130]) ـ إلىٰ كلّ شيء فيه علّة التحريم، ونُعطيه حكم الخاتم الذي عليه اسم الله تعالىٰ.
ب ـ إنّ الشارع المقدّس أمر باحترام وتعظيم كلّ ما هو محترم شرعاً، وإدخال مثل هذه الأشياء إلىٰ بيت الخلاء يُنافي الاحترام والتعظيم؛ فلا بدّ من تجنّبه، بما أنّ هذا التنافي لا يصل إلىٰ حدّ الحرمة، فيُحمل علىٰ الكراهة.
وخلاصة الدليل: إنّ الظاهر من الأدلّة أنّ المناط في الكراهة هو التحفّظ علىٰ الاحترام ـ لمثل الخاتم ـ فيصحّ التعدّي إلىٰ كلّ محترم لا بدّ من احترامه شرعاً، وهذا هو الموافق لمرتكزات المتديّنين أيضاً([131]).
وأمّا الروايات التي تدلّ علىٰ كراهة اصطحاب الخاتم المكتوب عليه اسم الله تعالىٰ فهي:
أ ـ رواية أبي أيّوب الخزّاز، قال: «قلت لأبي عبد الله: أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسمٌ من أسماء الله تعالىٰ؟ قال: لا، ولا تُجامع فيه»([132]).
ب ـ وعن معاوية بن عمّار ـ أبو القاسم ـ قال: «قلت له: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالىٰ؟ فقال: ما أحبّ ذلك. قال: فيكون اسم محمد’؟ قال: لا بأس»([133]).
ج ـ وفي موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله (الصادق) أنّه قال: «لا يمسّ الجُنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله تعالىٰ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله، ولا يُجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه»([134]).
د ـ المروي في (قرب الإسناد) عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىٰ بن جعفر÷ أنّه قال: «سألته عن الرجل يجُامع ويدخل الكنيف، وعليه الخاتم فيه ذكر الله، أو الشيء من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال: لا»([135]).
القول الثاني: عدم الكراهة، أو القول باستحباب عدم الاصطحاب
إنّ الفقهاء الذين ناقشوا أدلّة القول الأوّل اتّجهوا إلىٰ اتّجاهين:
الاتّجاه الأوّل: التوقّف بمعنىٰ أنّهم نفوا الكراهة فقط، ولم يصرِّحوا بشيءٍ آخر.
الاتّجاه الثاني: القول باستحباب عدم حمل المحترمات واصطحابها إلىٰ بيت الخلاء، فهم يحكمون بالاستحباب بعد مناقشة دليل الكراهة.
وممّن لم يحكم بالكراهة الشيخ البحراني([136])، والنراقي([137])، والظاهر من السيّد محسن الحكيم([138])، وغيرهم.
وحاصل نقاشهم للروايات السابقة أمران:
الأوّل: ما قاله النراقي بعد نقله لتلك الروايات: «إنّ الروايات كما ترىٰ مختصّة بالخاتم في اليد صريحاً كالأول [إشارة منه إلىٰ الرواية الأُولىٰ المتقدِّمة] وظاهراً كالبواقي [إشارة إلىٰ بقيّة الروايات] فلا يفيد تعميم الكراهة بالنسبة إلىٰ مطلق الاصطحاب كما قد يُذكر، والتعدّي بتنقيح المناط موقوفٌ علىٰ القطع بالعلّة، والتمسّك بمنافاته التعظيم لا يُثبِت إلّا استحباب عدم الاصطحاب بقصد التعظيم، ولا كلام فيه، ولكلّ امرئٍ ما نوىٰ([139])، وفتوىٰ البعض أيضاً [إشارة إلىٰ فتوىٰ الصدوق] لا يُثبِت أزيد من ذلك، فالحكم بالكراهة مطلقاً لذلك لا وجه له»([140]).
الثاني: إنّ القول بالكراهة لأجل التعظيم والاحترام، يُنافي ما في بعض الروايات من الدلالة علىٰ أنّ النبي’ والإمام علي كانا يدخلان بيت الخلاء وكانا يتختمان، وعليهما نقش فيه اسم الله تعالىٰ واسم النبي’([141])، ففي رواية الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الثاني قال: «قلت له: إنّا روينا في الحديث، أنّ رسول الله’ كان يستنجي وخاتمه في إصبعه، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين، وكان نقش خاتم رسول الله’: محمد رسول الله؟ قال: صدقوا. قلت: فينبغي لنا أن نفعل؟ فقال: إنّ أولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنىٰ، وإنّكم أنتم تتختّمون في اليسـرىٰ»([142]). وقريب منها رواية (عيون الأخبار)([143]).
والظاهر عرفاً أنّ اصطحاب التربة المباركة إلىٰ بيت الخلاء ـ خصوصاً إذا كانت في قطعة قماش، أو في الجيب ـ لا يُعدّ خلاف الاحترام والتعظيم.
نعم، قد يُدّعىٰ أنّ عدم اصطحابها من الأُمور المستحبّة؛ للأمر باحترام مثل هذه الأشياء شرعاً، وقد تقدّم من النراقي أنّ هذا لا إشكال فيه.
الأمر الأوّل: ذكر النراقي& أنّ المستفاد من الأخبار أنّ الكراهة إنّما هي عند دخول الخلاء، سواء كان للتغوّط أو البول، فلا كراهة عند البول في غيره، بل ولا عند التغوّط في مثل الصحراء؛ لعدم صدق الخلاء والكنيف، بل ولا المخرج؛ لأنّ الظاهر منها أيضاً البيت الـمُعدّ له([144]).
الأمر الثاني: إنّ القول بالكراهة إنّما يثبت فيما إذا لم تتلوّث التربة وبقيّة المحترمات بالنجاسة، وأمّا إذا أدّىٰ حملها إلىٰ بيت الخلاء إلىٰ تلويثها وتنجيسها ففي هذه الحالة لا إشكال في حرمته، بل يُكفَّر فاعله لو فعله بقصد الإهانة([145]).
2ـ حكم وقوع التربة المباركة في بيت الخلاء
يقع البحث حول هذا الحكم في عدّة نقاط، هي:
النقطة الأُولى: كلمات الفقهاء في المسألة
قال السيّد اليزدي+: «إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته؛ وجب إخراجه ولو بأُجرة، وإن لم يكن فالأحوط والأوْلىٰ سدّ بابه، وترك التخلِّي فيه إلىٰ أن يضمحلّ»([146]).
وجاء في كتاب (صراط النجاة): «س: ما المقصود من المحترمات التي هي غير ورق القرآن، والتي لو وقعت في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجها ولو بأُجرة، وإن لم يمكن سُدَّ بابه وتُرِك التخلِّي فيه إلىٰ أن يضمحلّ؟
الخوئي: المقصود منها: كلّ ما يجب احترامه ولا يجوز هتكه، مثل كتب أحاديث الأئمّة^، والكتب الفقهية، والتربة الحسينيّة، وتربة سائر الأئمّة الأطهار^، وما شاكل ذلك»([147]).
وقد وافق الشيخ جواد التبريزي& السيّد الخوئي& في ذلك.
تنحلّ المسألة إلىٰ فرعين:
الفرع الأوّل: إمكان إخراج التربة الحسينيّة بعد وقوعها في بيت الخلاء
وجوب إخراج التربة الحسينيّة وكلّ محترمٍ إذا وقع في بيت الخلاء، أو بالوعة البيت، ولو بدفع الأُجرة لـمَن يُخرجها.
الفرع الثاني: عدم إمكان إخراج التربة الحسينية بعد وقوعها في بيت الخلاء
وفي حالة عدم إمكان إخراج التربة من بيت الخلاء أو بالوعته، فهنا قولان:
القول الأوّل: وجوب سدّ باب بيت الخلاء إلىٰ أن تضمحلّ وتنتفي تلك التربة، وفي حالة عدم اضمحلال التربة لا يجوز الاستفادة من الخلاء، ولعلّ هذا القول هو مختار أكثر الفقهاء، وخصوصاً المُحدَثين والمعاصرين([148]).
القول الثاني: إنّ سدّ باب الخلاء إنّما هو علىٰ نحو الأحوط والأوْلىٰ، ولا يصل إلىٰ حدّ الوجوب، فيمكن للمكلَّف استعمال الكنيف وإن لم تضمحلّ التربة.
يمكن تقريب دليل وجوب إخراج التربة من بيت الخلاء أو بالوعته بتقريبين:
إنّ إخراج التربة تعدُّ مقدِّمة لإزالة النجاسة عن التربة، وقد تقدَّم مفصَّلاً أنّ إزالة النجاسة عن المحترمات واجب، بل هو من الوجوبات الفورية؛ ولأجل ذلك حُكِم بوجوب الإخراج.
إنّ وجوب الإخراج للتربة المباركة إنّما هو لصدق الهتك والوهن لها، فيجب لذلك الإخراج والمسارعة فيه، لتوقّف رفع الإهانة علىٰ الإخراج.
ولا يخفىٰ أنّ وجوب الإخراج لا يُفرَّق فيه بين عدم صرف المال لذلك وبذل الأُجرة ـ كما لو استطاع الشخص استخراج التربة بنفسه بدون أُجرة ـ وبين بذل الأُجرة لشخص وتوقّف الإخراج علىٰ بذل بعض المال؛ لأنّ الشارع المقدَّس لا يرفع يده عن حرمة هذه المقدَّسات بالضرر المالي ما لم يبلغ إلىٰ درجة الحرج([149]).
ذهب أكثر المعلِّقين والمحشِّين علىٰ متن العروة الوثقىٰ إلىٰ وجوب سدّ باب الخلاء إذا لم يمكن إخراج التربة من البالوعة، واعترضوا علىٰ ما ذهب إليه السيّد اليزدي من الاحتياط الاستحبابي في سدّ بيت الخلاء وعدم التخلِّي فيه.
1ـ دليل مَن ذهب إلى الاحتياط الاستحبابي
استدلّ السيّد الخوئي للقول الثاني الذي ذهب إليه السيّد اليزيدي بقوله: إنّ وجوب إخراج التربة من بيت الخلاء إنّما هو لأجل نجاستها، والتربة ما دامت في النجاسة ـ ولم يمكن إخراجها ـ فيجوز إلقاء النجاسة عليها، بدعوىٰ أنّ المتنجّس لا يتنجّس ثانياً، فالنجاسة الثانية لا تؤثّر شيء جديد في مقابل النجاسة الأُولىٰ.
وأمّا محذور الإهانة والهتك لها ـ بإلقاء النجاسة الثانية عليها ـ فهو غير معلوم؛ لأنّ سدّ الباب ما دام لا يؤثّر في تقليل النجاسة الواقعة، وما دام إخراج التربة وغيرها من المحترمات غير متيسّر؛ فلا يُعلم أنّ مجرّد استعمال تلك البالوعة يكون هتكاً، والشك وعدم العلم يكفي أيضاً لإجراء البراءة؛ لأنّ الشبهة هنا من الشُبه الموضوعية([150])([151]).
2ـ دليل مَن ذهب إلى وجوب سدّ باب بيت الخلاء
إنّ وجوب سدّ الباب ليس لأجل كون المتنجّس لا يتنجّس، بل هو لأجل أمرٍ آخر يقتضي الحكمين المتقدِّمين ـ وهو لزوم الهتك والمهانة من تنجيسها ـ ولا يفرق في ذلك بين طهارة المحترم ونجاسته؛ فإنّ التربة أو الورق بعدما تنجّست بوقوعها في البالوعة إذا أُلقيت عليها النجاسة مرّة أُخرىٰ يُعدّ ذلك هتكاً لحرمتها، وكلّما تكرّر الإلقاء تعدّد الهتك والمهانة، وكلّ فردٍ من الإهانة والهتك حرامٌ في نفسه؛ وعليه فلو أمكن إخراجها من البالوعة وجب ولو ببذل الأُجرة عليه، إلّا أن يكون عَسِراً أو ضررياً، ومع عدم التمكّن من إخراجها فلا طريق إلّا سدّ البالوعة إلىٰ أن تضمحلّ التربة المباركة.
والخلاصة: أنّ وجوب سدّ الباب لأجل كون الاستنجاء مرة أُخرىٰ إهانة جديدة، وهو لا يجوز.
ولا يخفىٰ أنّ فتوىٰ أكثر المتأخّرين ـ أعني المعاصرين ـ هي وجوب سدّ باب الخلاء في حالة عدم إمكان استخراج التربة.
نعم، إذا اضمحلّت التربة، وتلاشت وانعدمت، جاز بعد ذلك استعمال بيت الخلاء؛ لأنّ حرمة التنجيس أو وجوب الإخراج لها إنّما كان مترتّباً علىٰ عنوان التربة الحسينيّة، وفي حال الاضمحلال ينتفي عنوان التربة؛ وتبعاً له ينتفي الحكم الشرعي المترتّب عليه، وهو حرمة التنجيس أو وجوب الإخراج([152]).
حكم السجود على التربة الحسينيّة والتسبيح بها
المبحث الأوّل: حكم السجود على التربة الحسينيّة
المبحث الثاني: حكم التسبيح بالتربة الحسينيّة
حكم السجود على التربة الحسينيّة
أخذت مفردة (الأرض) في القرآن الكريم والسنّة الشريفة مساحة واسعة؛ فقد ورد ذكرها ما يقرب (287) مرّة، ولأهميّتها خصّها الله بحكمين: فهي محلّ طَهُور الناس والمكلَّفين، وهي محلّ السجود.
فهي الصعيد الطيّب الذي جعله الله طهوراً للمؤمنين، قال تعالىٰ: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾([153]).
وهي المكان الذي يسجد عليه الإنسان، قال|: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً»([154]).
وقد منح الله تعالىٰ بعض الأماكن كرامة خاصّة، وحباها ببعض الخصوصيّات، كما في تربة أبي عبد الله الحسين؛ فقد خصّها الباري تعالىٰ باستحباب السجود عليها بين سائر التُّرَب، وقد حظي هذا الحكم بحضور واضح في كتب الفقه الفتوائيّة والاستدلاليّة.
والكلام في هذا الاستحباب يقع في نقاط عدّة:
النقطة الأُولى: السجود أحد أركان الصلاة
أجمع الإماميّة([155]) وفقهاء المذاهب([156]) علىٰ أنّ السجود فرض واجب في كُلّ صلاة، وأنّ مجموع السجدتين يُعدّ ركناً من أركان الصلاة، وتبطُل الصلاة بتركه عمداً وسهواً كما عند الإماميّة، وكذا لو تركه عمداً عند فقهاء المذاهب الأُخرىٰ. وفي حال السهو أو الجهل، فقد اتّفقوا علىٰ وجوب الإتيان به إن أمكن تداركه، وإن لم يمكن تداركه تفسد الصلاة كما عند الحنفيّة، وأمّا جمهورهم فقالوا: تُلغىٰ الركعة التي منها الركن فقط، وذلك إذا كان الركن المتروك غير النية وتكبيرة الإحرام، وإلّا استأنف الصلاة([157]).
واستُدل علىٰ الركنيّة بنصّ الكتاب والسنّة والإجماع([158]).
واتّفقوا علىٰ أنّ الواجب هو السجود علىٰ الجبهة، واختلفوا في بقيّة الأعضاء السِّتة أو السَّبعة ـ علىٰ الخلاف الموجود بينهم ـ التي هي عبارة عن: اليدين والركبتين والقدمين، وطرف الأنف، فقد أوجبه بعض، وجعله بعض من كمال السجود([159]).
النقطة الثانية: السجود على الأرض وما أنبتت (شعار الإمامية)
اتّفق الإمامية وفقهاء المذاهب علىٰ أنّ السجود علىٰ الأرض يتحقّق به الواجب والركن معاً، وتصحّ الصلاة به، وهو القدر المتيقّن لصحّة السجود، واختلفوا فيما عدا ذلك:
فقد أجمع الإماميّة([160]) علىٰ أنّه لا يجوز السجود إلّا علىٰ الأرض وما أنبتت من غير المأكول والملبوس. وقد أصبح هذا شعاراً تُعرَف به الشيعة الإماميّة، وخلافه شعار يُعرَف به أهل السنّة؛ وذلك لأنّ السجود عبادة شرعيّة، فتقف كيفيتها علىٰ نصّ من الشارع، وقد وقع الإجماع ـ من جميع الطوائف ـ علىٰ صحّة وجواز السجود علىٰ الأرض والنابت منها، فيُقتصر عليه.
وقال رسول الله|: «إنّها لا تتمّ صلاة أحدكم حتىٰ يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالىٰ... ثمَّ يسجد ممكِّناً جبهته من الأرض»([161]).
وقال خبّاب: «شكونا إلىٰ رسول الله (صلّىٰ الله عليه وسلّم) حرَّ الرمضاء في جباهنا وأكفِّنا، فلم يُشكِّنا»([162]).
وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق ـ وقد سُئل عن الرجل يُصلِّيِ علىٰ البساط من الشعر والطنافس([163])، فأجاب ـ: «لا تسجد عليه، وإن قمت عليه وسجدت علىٰ الأرض فلا بأس، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت علىٰ الحصير فلا بأس»([164]).
وقال هشام بن الحكم للإمام الصادق: «أخبِرْني عمَّا يَجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز. قال: السجود لا يجوز إلّا علىٰ الأَرض أو علىٰ مَا أَنْبَتَت الأرض»([165]).
وأطبق جمهور فقهاء المذاهب([166]) علىٰ جواز الصلاة علىٰ الجلود، والصوف، والشعر، وأشباهها؛ وذلك لما رُوي عن النبي| أنّه صلّىٰ في نُمرة، ولأنّه بساط طاهر يجوز له الصلاة فيه، فجازت الصلاة عليه كالقطن. وقال الشافعي: والنمرة تُعمل من الصوف([167]).
ولا يخفىٰ بأنّ الرواية ممنوعة، أو محمولة علىٰ أنّه| كان يضع جبهته علىٰ ما يصح السجود عليه، لا علىٰ النمرة نفسها([168]).
هذا كلّه إذا اعتمدنا علىٰ تفسير الشافعي للنُّمرة، وإلّا فإنّ (نمرة) ناحية بعرفات، أو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم علىٰ يمينك خارجاً من المأزمين تريد الموقف([169]). بالإضافة إلىٰ كثرة الروايات الناهية صراحة عن السجود علىٰ هذه الأشياء.
والدليل الأخير باطل أيضاً؛ لأنّه قياس، فقد قاس صحّة الصلاة عليه بصحّة الصلاة فيه، والقياس باطل عندنا وعند جماعة من الجمهور.
وقد صرّح جماعة منهم بأفضلية السجود علىٰ الأرض، رغم ذهابهم إلىٰ جواز السجود علىٰ غيرها([170]).
النقطة الثالثة: استحباب السجود على تربة الحسين× وأقوال الفقهاء فيه
رغم حصر فقهاء الإماميّة جوازَ السجود علىٰ الأرض وما أنبتت فقط، إلّا أنّهم جوّزوا السجود علىٰ مطلق وجه الأرض، سواء الحجر والمدر والتراب والرمل وغيرها، ولم يقيّدوا الجواز بنوع خاصّ، ولكن مع هذا فضّلوا السجود علىٰ التراب وخصوصاً تربة الحسين بن علي÷، فقد صرّحوا باستحباب السجود عليها، وهو المعروف بينهم.
واختصّ الشيعة الإمامية بالقول باستحباب السجود علىٰ تربة قبر الحسين بن علي÷، تبعاً لأئمّتهم، بل اتّباعاً لمنهج رسول الله|؛ لأنّ منهج أهل البيت^ هو منهج الرسول|، لا يخالفونه قيد شعرة أبداً في تكريمه للحسين سيّد الشهداء، وتكريم تربة قبره.
والسجود علىٰ التربة بما فيها تربة الحسين ليس بدعةً في الدين، وليس هو خرقاً لإجماع المسلمين، بل هو الثابت بالأدلّة القرآنية والروائيّة.
وقد أضْفَتْ شهادة الحسين قداسة أُخرىٰ علىٰ هذه التربة المباركة، ومنحها بشهادته مسحة قدسيّة إلهيّة، تمثّلت بمقارعة الطغاة وإرجاع الحقّ إلىٰ أهله.
وعلىٰ هذا؛ فلا معنىٰ لما يرمي به الحمقىٰ والمغفَّلون من جهّال المسلمين ـ وهم ثلّة ـ الشيعةَ بأنّهم يعبدون الحجر، أو يسجدون للحجر. بل إنّهم يعبدون الله تعالىٰ وحده لا شريك له، ويسجدون لله وحده تعالىٰ، علىٰ طبق الشرع وتعاليمه، لم يزيغوا عنها أنملة، ولم يكن في دعوتهم إلىٰ فضل السجود علىٰ التربة الحسينيّة خروجٌ علىٰ قوله’: «جُعلت ليَ الأرض مسجداً وطهوراً»([171])، فالتربة الحسينيّة من الأرض، مع مزيد فضل، وإنّما ورد الندب والاستحباب في السجود عليها لما لها من فضيلة الانتساب، ممّا يزيد الأجر والثواب.
ولـمّا كان السجود أعظم أركان الصلاة، وفي الحديث: «أقرب ما يكون العبد إلىٰ ربِّه حال سجوده»([172])، فإنّه من المناسب أن يتذكّر بوضع جبهته علىٰ تلك التربة الطاهرة أُولئك الذين جعلوا أجسامهم ضحايا للحقّ، وارتفعت أرواحهم إلىٰ الملأ الأعلىٰ ليخشع ويخضع ويتلازم الوضع والرفع، ويحتقر هذه الدنيا الزائفة وزخارفها الزائلة، ولعلّ هذا هو المقصود من أنّ السجود عليها يخرق الحجب السبع ـ الوارد في الخبر ـ فيكون حينئذٍ في السجود سرّ الصعود والعروج من التراب إلىٰ ربِّ الأرباب([173]).
كلمات الفقهاء في استحباب السجود على التربة الحسينيّة
قد أكّد فقهاء الإماميّة علىٰ استحباب السجود علىٰ تربة الإمام الحسين، وذكروه في كتاب الصلاة في باب السجود منه، وإليك جملة من كلماتهم:
قال الديلمي: «وما يُسجد عليه ينقسم [على] أربعة أقسام: إلىٰ ما تجوز الصلاة عليه إباحة، وإلىٰ ما تُكره الصلاة عليه، وإلىٰ ما لا يجوز السجود عليه، وإلىٰ ما يُستحب السجود عليه... الرابع: ما يُستحب السجود عليه، وهو الألواح من التربة المقدَّسة، ومن خشب قبور الأئمّة»([174]).
وقال ابن حمزة: «وما يُسجد عليه أربعة أقسام: إمّا يُستحب، أو يُحرم، أو يُكره، أو يكون السجود عليه مطلقاً. فالأوّل شيئان: الألواح من التربة، وخشب قبور الأئمّة»([175]).
وقال ابن أبي المجد الحلبي: «ولا ينبغي السجود علىٰ المعادن أو ما كان منها، ولا علىٰ ما قلبته النار كالكأس والخزف والجصّ وشبهه، وأفضله علىٰ التربة الحسينيّة»([176]).
وقال صاحب جامع الشرائع: «والسنّة السجود علىٰ الأرض؛ للخبر... ويُستحب السجود علىٰ التربة الحسينيّة»([177]).
وقال الشهيد الأوّل: «البحث الثاني: في مستحبّاته [السجود] وهي: التكبير له قائماً... والسجود علىٰ الأرض، وأفضلها التربة الحسينيّة...»([178]).
وقال المحقّق الكركي: «ويُستحب السجود علىٰ الأرض، وأفضل منه علىٰ التربة الحسينيّة ولو شُويت بالنار»([179]).
وقال الشهيد الثاني ـ وهو بصدد بيان سُنن السجود ـ: «والسجود علىٰ الأرض؛ لأنّه أبلغ في الخشوع وأقوىٰ في الذلّ بين يدي الباري... وخصوصاً التربة الحسينيّة المقدَّسة علىٰ مشرِّفها السلام ولو لوحاً متَّخذاً منها...»([180]).
وقال المحقّق البحراني: «وأفضل أفراد الأرض في السجود التربة الحسينيّة علىٰ مشرِّفها أفضل الصلاة والسلام والتحيّة»([181]).
وقال البهبهاني ـ وهو بصدد تعداد مستحبّات السجود ـ: «ومن الـمُستحب أن يتساوىٰ مساجده جميعاً... وأن يختار الأرض علىٰ النبات؛ لأنّه أبلغ في الخضوع... ثمَّ التربة الحسينيّة؛ لأنّه ينوّر إلىٰ الأرضين السبع، ويخرق الحجب كما في النّصوص»([182]). وقريب منها عبارة الشيخ جعفر كاشف الغطاء([183]).
وقال صاحب الجواهر: «وأفضل الأرض تربة سيِّد الشهداء قطعاً وسيرةً؛ ولذا كان الصادق لا يسجد إلّا عليها؛ تذلّلاً لله واستكانة، كما عن إرشاد الديلمي»([184]).
وقال السيّد اليزدي: «السجود علىٰ الأرض أفضل من النبات والقرطاس، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر، وأفضل من الجميع التربة الحسينيّة؛ فإنّها تخرق الحجب السبع، وتستنير إلىٰ الأرضين السبع»([185]).
النقطة الرابعة: أدلّة استحباب السجود على تربة الإمام الحسين×
يمكن حصر أدلّة القول باستحباب السجود علىٰ تربة سيّد الشهداء بما يلي:
الدليل الأوّل: الروايات التي تؤكّد فضل التربة الحسينيّة
ما ورد في فضلها من روايات كثيرة علىٰ لسان النبي| بنقل أُمّهات المؤمنين ـ أُمّ سلمة، وعائشة، وغيرهما ـ وعلىٰ لسان أهل بيته المعصومين^.
وقد نُقلت هذه الروايات في كتب ومجاميع السنّة قَبْل الشيعة([186])، فإنّ الله تعالىٰ اهتمّ بهذه التربة أشدَّ اهتمام، وأمر باحترامها أجلّ احترام، فقد أرسل رُسُلاً من الملائكة فجاءوا إلىٰ النبي| بقبضة منها، فمن أجل ذلك نلاحظ النبي| يحترمها ويأخذها، فاستفاض النقل بأنّ جبرئيل لـمّا نزل علىٰ رسول الله| بخبر قتل الإمام الحسين أتىٰ بقبضة من تربة مصرعه، وكذا تكرّر هذا الفعل من غير جبرائيل من الملائكة([187]).
الدليل الثاني: الروايات التي تؤكد استحباب السجود على التربة الحسينيّة
فقد وردت روايات كثيرة عن طريق أهل البيت^ تؤكّد استحباب السجود علىٰ التربة الحسينيّة:
منها: ما رواه الشيخ الطوسي في (المصباح) عن معاوية بن عمّار قال: «كان لأبي عبد الله رِيطة ديباج صَفرَاءُ فيها تربةُ أبي عبد الله، فكان إذا حضرتْهُ الصَلاةُ صَبَّهُ عَلَىٰ سجّادته وسجد عليه، ثُمَّ قال: السُّجُودُ عَلَىٰ تُرْبَةِ أبي عبد الله يخرقُ الـحُجُب السَّبْعَ»([188]).
فائدة: تفسير (يَخْرِقُ الحُجُبَ السَّبْعَ)
ويقول السيّد عبد الأعلىٰ السبزواري+ ـ في تعليقه علىٰ قوله: «يخْرِقُ الحُجُبَ السَّبْعَ» ـ: «ولا بُعد في ذلك؛ فإنّ هذه التربة المقدَّسة رمز التفاني في إعلاء كلمة التوحيد وشعار العترة النبويّة في إبقاء الرسالة والنبوّة، ووسام الأُسرة المحمّدية، وإنّها روضة من رياض الجنّة، ومولد عيسىٰ، ومختلف الملائكة، ومجمع أرواح الأنبياء في كلّ ليلة نصف من شعبان».
وقال+: «ثمّ إنّ قوله: (تخرقُ الحُجُب السبع) أي: يقبلها الله تعالىٰ من دون أن يمنع عنه موانع القبول التي هي كثيرة...»([189]).
وقال الخرسان: «لعلّ المراد بخرق الحُجُب السبعة هو صعود الصلاة إلىٰ السماوات السبع، فقد ورد في الحديث الصحيح عن أبي جعفر الباقر قال: إنّ العبد ليُرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، فما يرفع له إلّا ما أقبل عليه منها بقلبه... ([190]). أو لعلّ المراد بالـحُجُب المعاصي السبع التي تمنع قبول الأعمال وهي الكبائر، أو أنّ السجود عليها ينوّر الأرضين السبع»([191]).
ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه عن الإمام الصادق أنّه قال: «السّجود علىٰ طين قَبرِ الحسين ينور إلىٰ الأرضين السّبعة. ومَن كانت معه سبحَةٌ مِنْ طين قَبرِ الحسَينِ كُتِبَ مُسَبِّحاً وإن لم يُسَبِّح بها»([192]).
قال السيّد السبزواري تعليقاً علىٰ هذه الرواية: «قد تكرّر في الكتاب والسنّة استعمال سنخ هذا النور، قال تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾. وقوله تعالىٰ: ﴿ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾. إلىٰ غير ذلك ممّا هو كثير... وهذا النور أجلّ من أن يُدرك بالمشاعر الجسمانيّة التي انحصر شعورهم بدرك الأجسام الكثيفة، ونِعمَ ما قيل:
|
وكيف ترىٰ ليلىٰ بعين ترىٰبها سواها وما طهَّرتها بالمدامع |
كما أنّه أرفع من أن يُرجع في شرحه إلىٰ الكتب اللُّغوية، أو جملة من أقوال المفسِّرين، بل يختصّ درك مثل هذا النور بالإمام المعصوم، والملأ الأعلىٰ، أو
مَنتخلّىٰ عن الرذائل مطلقاً، وتحلّىٰ بالفضائل بجمعها، وقد أشار أمير المؤمنين إلىٰ بعض مقاماتهم في خطبة همام»([193]).
ومنها: ما عن الطبرسي في كتاب (الاحتجاج)، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان#: إنّه كتب إليه يسأله عن السجدة علىٰ لوح من طين القبر هل فيه فضل؟ فأجاب: «يجوز ذلك، وفيه الفضل» [194]).
ومنها: ما رواه الحسن بن محمد الديلمي في كتاب (الإرشاد)، قال: «كان الصّادقُ لا يَسجُدُ إلّا علىٰ تُربَةِ الحسين؛ تذلّلاً لله واسْتِكَانَةً إليه»([195]).
الدليل الثالث: عدم المنع الشرعي من اتخاذ ما يُطمئن بنظافته ونزاهته عند السجود
إنّ اتّخاذ هذه التربة والمحافظة عليها والسجود عليها أوقات الصلاة أسلم من حيث النظافة والنزاهة من السجود علىٰ سائر الأراضي، وما يُطرح عليها من الفرش والبواري والحُصُر الملوّنة والمملوءة غالباً من الغبار والميكروبات الكامنة فيها.
فأيّ مانع من أن يحتاط المسلمُ في دينه، ويتّخذ معه تربةً طاهرة يطمئن بها وبطهارتها، يسجد عليها في صلاته؛ حذراً من السجدة علىٰ النجاسة والأوساخ التي لا يُتقرَّب بها إلىٰ الله قطُّ، ولا تجوّز السنّة السجود عليها؟!
إنّ وضع الجباه علىٰ تربة في طياتها دروس الدفاع عن دين الله ومظاهر قدسه، ومجلىٰ المحاماة عن ناموس الإسلام المقدَّس، أجدر بالتقرُّب إلىٰ الله تعالىٰ، وأقرب الزلفىٰ لديه، وأنسب بالخضوع والخشوع والعبوديّة له تعالىٰ.
أَليس أليق بأسرار السجود علىٰ الأرض السجود علىٰ تربة فيها سرّ المنعة والعظمة والكبرياء لله (عزَّ وجلَّ) ورموز العبوديّة والتصاغر بأجلىٰ مظاهرها وسماتها؟!
أَليس أحقّ بالسجود علىٰ تربة مُزِج فيها التوحيد والتفاني دون الباري تعالىٰ؟!
أَليس الأمثل اتّخاذ المسجد من تربة تفجّرت عليها عيون دماء اصطبغت بصبغة حبّ الله، وصيغت علىٰ سنّة الله وولائه المحض الخالص([196])؟!
الدليل الرابع: دعوى الإجماع على استحباب السجود على التربة الحسينية
يمكن دعوىٰ الإجماع علىٰ استحباب السجود علىٰ تربة أبي عبد الله الحسين، بل ادّعىٰ بعض أنّ الإجماع المنقول والمحصَّل عليه([197]).
فرع: حكم السجود على التربة المطبوخة (المشويّة)
لا خلاف يُعرف بين فقهاء الإماميّة، بل بين المسلمين في جواز السجود علىٰ التربة الحسينيّة سواء شُويت بالنار أم لا.
أمّا فقهاء الإماميّة، فلم نقف ـ كما صرّح الشيخ الكركي ـ علىٰ المنع من السجود لأحد من الفقهاء المعتَبرين، إلّا سلّار في رسالته، فقد حكم بكراهة السجود علىٰ التربة المشويّة.
وأمّا فقهاء المذاهب، فإنّهم يجوّزون السجود علىٰ كُلّ شيء طاهر، وباقي الفقهاء أطلقوا القول بجواز السجود علىٰ الأرض وأجزائها، وبعضهم أطلق القول باستحباب السجود علىٰ التربة الحسينيّة.
القول بجواز السجود على التربة المشوية (الرأي المختار)
فالمذهب هو القول بالجواز لا محالة، والقول بالمنع من التربة المشويّة خارج عن مقالة علماء أهل البيت^.
وأمّا القول بكراهة السجود علىٰ التربة المشويّة، فهو قول ضعيف مرغوب عنه. ولا يخفىٰ أنّ الذي اختار القول بالكراهة هو سلّار والشهيد الثاني.
وقد توقّف الشيخ البحراني في الحكم؛ للشكّ في خروجها عن اسمها بعد طبخها، ثمّ اختار القول بالاحتياط.
أدلّة القول بكراهة السجود على التربة المشوية
واستُدلّ علىٰ القول بالكراهة بأمرين:
أ ـ إنّ التربة المطبوخة إن لم تكن مستحيلة إلىٰ شيء آخر فهي شبيهة بالمستحيل، فيُكره لذلك.
ب ـ إنّ كُلَّ شيء مسّته النّار يُكره السجود عليه.
أدلة القول بجواز السجود على التربة المشوية
إنّ قوّة أدلّة القول الأوّل الآتية وكثرة مَن يذهب إليه تُضعِّف القول بالكراهة.
واستدلّ أصحاب القول الأوّل (بجواز السجود على التربة المشوية) بعدّة أدلّة، نأتي بخلاصتها:
الأوّل: الأصل، فإنّ الأوامر الواردة بالسجود تقتضي جواز السجود علىٰ كُلّ شيء إلّا ما ورد المنع منه شرعاً، ولم يرد في الشريعة نصّ يقتضي المنع من السجود علىٰ التربة المشويّة، فنتمسّك بالأصل الذي يقتضىٰ الجواز.
الثاني: استصحاب الحكم المنصوص؛ إذ إنّ النّصوص وردت بجواز السجود علىٰ التربة الحسينيّة قبل أن تُشوىٰ بالنار، فيجب استصحاب هذا الحكم بعد أن تُشوىٰ؛ لانتفاء الناقل شرعاً، فإنّ الاستصحاب حجّة ما لم يرد من الشرع ناقل.
الثالث: التمسّك بالإجماع من علمائنا، بل من جميع المسلمين علىٰ جواز السجود علىٰ التربة المتنازع فيها (وهي التربة الحسينيّة المشويّة)([198]).
المبحث الثاني
أولتْ الشريعة الإسلامية اهتماماً خاصّاً بالجانب المعنوي، سواء منه الجانب الأخلاقي أو القُرب الإلهي، وتمثّل الجانب الثاني من خلال الحثّ علىٰ الالتزام بأشياء عدّة:
منها: قراءة القرآن.
ومنها: الأدعية بأنواعها كافّة الزمانيّة والمكانيّة.
ومنها: التسبيح والتنزيه بأنواعهما الزمانيّة والمكانيّة، وخصّ بالزمانيّة تعقيبات الصلاة، فقد وردت روايات عدّة عن النبي| وأهل بيته تؤكِّد علىٰ أنواع من تعقيبات الصلاة، عسىٰ أن ترفع من الجانب المعنوي والقُرب الإلهي. وهي كثيرة جدّاً، ولكنّ أفضلها علىٰ الإطلاق هو المسمّىٰ بتسبيح فاطمة الزهراء‘، والذي اتّفق علىٰ نقله العامّة والخاصّة.
نعم، قد لا يصرِّحون بنسبته إلىٰ الزهراء‘، ولكن الروايات المنقولة عن أبي هريرة وغيره من الصحابة أرادته لا غير.
وصرّح علماء الإمامية بأنّه يُستحب أن يكون التسبيح المذكور بسبحة مصنوعة من تربة الإمام الحسين؛ لتضاعف الثواب والأجر بذلك.
هذا، وسنحاول التعرّف على تفاصيل هذه المسألة وذلك من خلال الخوض في نقاط عدّة:
النقطة الأُولى: استحباب التعقيب بتسبيحات فاطمة الزهراء‘
اتّفقت كلمة الفقهاء علىٰ استحباب التعقيب عقب كُلّ صلاة بهذه التسبيحات، والنصوص الواردة فيها مستفيضة في الجملة ومرويّة في كتب الطرفين، وأكّدت أكثر الروايات علىٰ أنّ عدد التسبيحات مائة تسبيحة.
فعن أبي ذرّ، قال: «قلت: يا رسول الله، تسبقنا أصحاب الأموال والدثور سبقاً بيّناً، يصلّون ويصومون كما نصلِّي ونصوم، وعندهم أموال يتصدَّقون بها وليست عندنا أموال. فقال رسول الله|: أَلا أُخبرك بعمل إن أخذت به أدركت مَن كان قبلك، وفُتّ مَن يكون بعدك، إلّا أحد أخذ بمثل عملك؟ تسبّح خلف كُلّ صلاة ثلاثاً وثلاثين، وتحمد ثلاثاً وثلاثين، وتُكبّر أربعاً وثلاثين»([199]).
وروىٰ صالح بن عقبة، عن أبي جعفر محمد الباقر أنّه، قال: «ما عُبِدَ الله بشـيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة÷، ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله| فاطمة÷»([200]).
فائدة: تسبيحات الزهراء ثابتة في غير التعقيب
ولا بدّ أن يُعلم بأنّ جملة من الفقهاء صرّحوا بأنّ استحباب تسبيحات الزهراء‘ لا يختصّ بتعقيبات الصلاة، بل هو مُستحب أيضاً في غير التعقيب، فالاستحباب ثابت في نفسه من دون اعتبار وصف التعقيب ـ وإن زاد الأجر بذلك ـ لإطلاق جملة من الأدلّة بأنّه من الذكر الكثير، وأنّه «ما عُبد الله بشيء من التحميد أفضل منه»، ويظهر من روايات أُخرىٰ الحثّ علىٰ تسبيحات الزهراء‘، والترغيب فيها من دون ذكر التعقيب أو شيء آخر([201]).
النقطة الثانية: ما كانت عليه السيّدة فاطمة الزهراء‘
من المسموعات الواردة عن أبي البركات المشهدي، أنّه روىٰ إبراهيم بن محمد الثقفي: «أنّ فاطمة بنت رسول الله| كانت سبحتها من خيط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات، فكانت÷ تديرها بيدها، تكبِّر وتسبِّح إلىٰ أن قُتِل حمزة بن عبد المطلب (رض) سيِّد الشهداء، فاستعملت تربته وعملت التسابيح، فاستعملها النّاس، فلمّا قُتل الحسين عُدِل بالأمر إليه، فاستعملوا تربته؛ لما فيها من الفضل والمزيّة»([202]).
النقطة الثالثة: استحباب أن يكون التسبيح بتربة الحسين×
ذكر فقهاء الإماميّة ـ من دون نقل خلاف بينهم ـ أنّه يُستحب أن تكون السبحة من طين قبر الحسين.
وقد أشار إلىٰ هذا الاستحباب كُلّ مَن تعرّض إلىٰ أصل القول باستحباب تسبيحة فاطمة الزهراء‘، فقد عقّبوا ـ بعد قولهم باستحبابها ـ بأنّه يُستحب أن تكون هذه التسبيحات بسبحة مصنوعة من تراب قبر الإمام الحسين، بل صرّح في المسالك أنّ الاستحباب هنا استحباب مؤكَّد([203]).
وقد دلّ علىٰ الاستحباب روايا ت عديدة، كما سيأتي ذكرها.
النقطة الرابعة: أدلّة الاستحباب
يدلّ علىٰ استحباب التسبيح بالتربة الحسينيّة روايات عدّة، نأتي عليها تباعاً:
1ـ ما رواه الطبرسي عن كتاب الحسن بن محبوب: أنّ أبا عبد الله سُئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة والحسين÷ والتفاضل بينهما، فقال: «السُّبْحَةُ الَّتِي مِنْ طِينِ قَبْرِ الحُسَيْنِ تُسَبِّحُ بِيَدِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَبِّحَ»([204]).
2ـ ما رواه الطبرسي عن الصادق أنّه قال: «مَنْ أَدَارَ سُبْحَةً مِنْ تُرْبَةِ الحُسَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً بِالاسْتِغْفَارِ أَوْ غَيْرِهِ كَتَبَ الله لَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً، وَأَنَّ السُّجُودَ عَلَيْهَا يَخْرِقُ الحُجُبَ السَّبْعَ»([205]).
3ـ ما رواه الطوسي في (المصباح) عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي الحسن موسىٰ قال: «لَا يَخْلُو المُؤْمِنُ مِنْ خَمْسَةٍ: سِوَاكٍ، وَمُشْطٍ، وَسَجَّادَةٍ، وَسُبْحَةٍ فِيهَا أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ حَبَّةً وَخَاتَمِ عَقِيق»([206]).
4ـ ما رواه الطوسي في (المصباح) عن الصادق، أنّه قال: «إنَّ مَنْ أَدَارَ الحَجَرَ مِنْ تُرْبَةِ الحُسَيْنِ فَاسْتَغْفَرَ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً كَتَبَ الله لَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً، وَإِنْ مَسَكَ السُّبْحَةَ بِيَدِهِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بِهَا فَفِي كُلِّ حَبَّةٍ مِنْهَا سَبْعَ مَرَّات»([207]).
5ـ ما رواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن جعفر الحميري، أنّه كتب إلىٰ صاحب الزمان يسأله: «هل يجوز أن يسبِّح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب: يَجوزُ أَنْ يُسَبِّحَ بِهِ، فَمَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ السُّبَحِ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَمِنْ فَضْلِهِ أَنَّ المُسَبِّحَ يَنْسَىٰ التَّسْبِيحَ وَيُدِيرُ السُّبْحَةَ فَيُكْتَبُ لَهُ التَّسْبِيحُ»، وفي نسخة أُخرىٰ: «يَجُوزُ ذَلِكَ وَفِيهِ الفَضْلُ»([208]).
6ـ ما رواه الطبرسي عن محمّد الثقفي، وقد تقدَّم في أوّل البحث([209]).
7ـ ما رُوي عن جعفر بن محمّد الصادق، أنّه قال: «مَنْ سَبَّحَ بِسُبْحَةٍ مِنْ طِينِ قَبْرِ الحُسَيْنِ تَسْبِيحَةً كَتَبَ الله لَهُ أَرْبَعَمِائَةِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَرْبَعَمِائَةِ سَيِّئَةٍ، وَقُضِيَتْ لَهُ أَرْبَعُمِائَةِ حَاجَةٍ، وَرُفِعَ لَهُ أَرْبَعُمائَةِ دَرَجَةٍ»([210]).
وفي هذه الروايات كفاية لإثبات الحكم بالاستحباب؛ ولذلك صرّح الشهيد الثاني بكون التسبيح بتربة الحسين يُستحب استحباباً مؤكَّداً([211])، وخصوصاً علىٰ القاعدة المعروفة بقاعدة: (التسامح في أدلّة السُّنن).
يتفرّع علىٰ القول باستحباب التسبيح بتربة الإمام الحسين فروع عدّة مهمّة لا بدّ من الإشارة إليها إجمالاً، وهي:
1ـ عدد التسبيحات وآداب التسبيحة
صرّح بعض الفقهاء([212]) بأنّ أصحّ ما رُوي في عدد تسبيحات فاطمة الزهراء‘ هي: أربعة وثلاثون تكبيرة بلفظ (الله أكبر)، وثلاثة وثلاثون تحميدة بلفظ (الحمد لله)، وثلاث وثلاثون تسبيحة بلفظ (سبحان الله). وهذا هو المشهور بين الفقهاء.
وينبغي في التسبيح التمهّل، والتوسّل، والوقف عند كُلّ ذكر منه، والمولاة، ولو طال الفصل بين التسبيحات بوقت طويل خرج عن هيئته، وفات بذلك ما استُحبّ لأجله.
ويدلّ عليه ما رواه الكليني بسنده إلىٰ أبي بصير، عن أبي عبد الله، قال: في تسبيح فاطمة الزهراء: «تبدأ بالتكبير أربعاً وثلاثين، ثمَّ التحميد ثلاثاً وثلاثين، ثمَّ التسبيح ثلاثاً وثلاثين»([213]).
صرّح الشهيد الأوّل بأنّ المستحبّ اتّخاذ سبحة من تربة الحسين بثلاث وثلاثين حبّة، والمذكور في بعض الروايات أربع وثلاثين حبّة، والمعمول به والمتعارف في عصرنا من نظم المائة بخيط واحد، وقد يُشعر هذا بأنّه خلاف الموجود في الروايات.
ولكنّ الأقوىٰ ـ كما صرّح به صاحب الجواهر ـ أنّه لا بأس بالجميع، فيصحّ التسبيح بأيّ عدد من هذه الأعداد([214]).
3ـ التسبيح بالطين المطبوخ (المشوي)
لا فرق عند جملة من الفقهاء في تحقّق الاستحباب والتسبيح بين الطين المشوي (المطبوخ) وغير المشوي، فالاستحباب يتحقّق بمطلق التسبيح، سواء كانت الحبّات المنظومة قد طُبخت بالنار أم لم تُطبخ، كُلّ ذلك لإطلاق الأخبار، وظهور بعضها في ذلك.
فعن الإمام جعفر الصادق أنّه قال: «مَنْ أَدَارَ الحَجَرَ مِنْ تُرْبَةِ الحُسَيْنِ فَاسْتَغْفَرَ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً كَتَبَ الله لَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً»([215]). ولا بدّ أن يُعلم بأنّ ذلك ليس استحالة حتىٰ يخرج عن اسم الطين أو الحجر، مضافاً إلىٰ استصحاب الجواز الثابت قبل الطبخ([216]).
4ـ استحباب اتخاذ السبحة مطلقاً
لقد عمَّم الفقهاء استحباب اتّخاذ السبحة لغير تسبيحة الزهراء‘، فيُستحب اتّخاذ سبحة من تربة الحسين لمطلق التسبيحات، بل يُستحب اتّخاذ مسبحة لكلِّ شخص وإن لم يسبِّح بها، لما فيها من الثواب الجزيل، وذلك لما رواه الطوسي بسنده عن الإمام الكاظم، قال: «قَالَ: لَا يَسْتَغْنِي شِيعَتُنَا عَنْ أَرْبَعٍ: خُمْرَةٍ يُصَلِّي عَلَيْهَا، وَخَاتَمٍ يَتَخَتَّمُ بِهِ، وَسِوَاكٍ يَسْتَاكُ بِهِ، وَسُبْحَةٍ مِنْ طِينِ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ الله، فِيهَا ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حَبَّةً، مَتَىٰ قَلَّبَهَا ذَاكِراً لله كَتَبَ الله لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ أَرْبَعُونَ حَسَنَةً، وَإِذَا قَلَّبَهَا سَاهِياً يَعْبَثُ بِهَا كَتَبَ الله لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً»([217]).
إنّ الثواب والآثار المترتّبة علىٰ تسبيحة السيّدة فاطمة الزهراء‘ بتربة سيّد الشهداء إنّما تترتّب إذا كانت بالكيفيّة السابقة وهي: التكبير (34) مرّة، والتحميد (33) مرّة، والتسبيح (33) مرّة.
وأمّا لو شكّ في عدد التسبيحات زيادة أو نقيصة ففيه قولان:
الأوّل: إنّه لو شكّ في شيء من التسبيح تلافىٰ المشكوك فيه خاصّة، فإذا شكّ هل أنّه أتىٰ بـ (25) تسبيحة أو (24) تسبيحة، فإنّه يبني علىٰ (24) ويأتي بواحدة.
وأمّا إذا شك في الزيادة فإنّه يمضي علىٰ شكّه ولا يراعي شيئاً.
الثاني: الحكم بالإعادة من جديد بحيث يستأنف التسبيح من بدايته، ولا يبني علىٰ ما أتىٰ به بأيّ شكل([218]).
6ـ مقدار الثواب المترتِّب على التسبيحات
يتعدّد الثواب علىٰ لسان الروايات بأنواع عدّة، نأتي علىٰ ذكر فهرساً لها:
أ ـ إنّ حمل السبحة المباركة سبب لكونها تسبِّح عن صاحبها ولو لم يسبِّح، وفي رواية أُخرىٰ: إنّ الاستغفار يُضاعَف سبع مرّات.
ب ـ إنّ مَن أدار السبحة مرّة واحدة بالاستغفار أو غيره ضاعف الله له هذا التسبيح سبعين مرّة.
ج ـ إنّ مَن سبَّح بتربة الحسين كتب الله تعالىٰ له أربعمائة حسنة، ومحا عنه أربعمائة سيئة، وقُضيت له أربعمائة حاجة، ورُفِع له أربعمائة درجة.
حكم الاستشفاء بالتربة الحسينيّة والتحرّز بها
المبحث الأوّل: حكم الاستشفاء بالتربة الحسينيّة
حكم الاستشفاء بتربة الإمام الحسين×
الكلام هنا في موضوع الاستشفاء بتربة الإمام الحسين، فنقول:
اختُصّ الإمام الحسين بأُمور، منها: جَعَل الله تعالىٰ الشفاء في تربته، وهو ما جاء التأكيد عليه بروايات عدّة، وقد يُفسّر ذلك بتفسيرين.
تفسيران للاستشفاء والتداوي بالتربة الحسينية
قد يُفسّر الاستشفاء والتداوي بالتربة المباركة علىٰ أساس أحد أمرين:
الأوّل: الأساس الطبيعي
بأن تكون التربة حاوية لعناصر طبيعية؛ تكون هي السبب في رفع الأمراض والأسقام والداء الذي ابتُلي به المستشفي، حالها ـ من هذه الناحية ـ حال الأدوية الكيمياويّة والنباتيّة والعشبيّة وأمثالها، فالأسبرين له خاصية رفع وجع الرأس تكويناً، وهكذا العسل وغيره من العقاقير.
غاية الأمر، أنّ هناك فرقاً بين تربة الإمام الحسين وسائر الأدوية، فالتربة المباركة ـ مع توفّر جميع الشروط ـ ترفع جميع الأمراض إلّا السّام، أي: الموت، بخلاف سائر الأدوية، فإنّ لها القدرة علىٰ رفع بعض الأمراض والآلام دون بعض آخر؛ وعلىٰ ذلك دلّت الروايات الكثيرة الواردة في فضل تربة الإمام الحسين وجواز الاستشفاء بها، كما في قول الإمام الصادق: «إنّ تربة الحسين من الأدوية المفردة، وإنّها لا تمرّ بداءٍ إلّا هضمته»([219])، فقد عدَّ الإمام التربة دواءً لكلّ داء.
وقول الإمام الباقر في معرض حديثه عن التربة: «وهو أفضل ما استُشفي به، فلا تعدلنّ به، فإنّا نسقيه صبياننا ونساءنا، ونرىٰ فيه كلّ خير»([220])، فقد جعل الإمام الاستشفاء بالتربة أفضل من غيرها من الأدوية.
وقال الإمام الصادق: «إذا تناول التربة فليأخذ بأطراف أصابعه، وقدره مثل الحُمّصة»([221])، فقد حدّد مقدار التربة بقدر حُمّصة، فلا يجوز إذا زادت عن هذا المقدار، حالها حال بقيّة الأدوية التي تؤثِّر علىٰ الجسم سلباً إذا تجاوزت المقدار المحدّد.
الثاني: الأساس الغَيبي الإعجازي
تكريماً للدماء التي أُريقت علىٰ هذه التربة المباركة ـ دفاعاً عن العقيدة ودين الله تعالىٰ ـ عوّض الله تعالىٰ الإمام الحسين بأنْ جعل الشفاء في تربته؛ ويمكن التماس ذلك من بعض الروايات الأُخرىٰ الواردة في فضل هذه التربة، كما عن الإمام الصادق في حديث: «وإنّما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها، وقلّة اليقين لـمَن يعالج بها... ولقد بلغني أنّ بعض مَن يأخذ من التربة شيئاً يستخفّ به، حتّىٰ أنّ بعضهم يضعها في مخلاة البغل والحمار، وفي وعاء الطعام والخرج، فكيف يستشفي به مَن هذا حاله عنده؟!»([222]).
وقد روىٰ ابن قولويه بسنده المتّصل إلىٰ أبي عبد الله الصادق، قال: «لو أنّ مريضاً من المؤمنين يعرف حقّ أبي عبد الله الحسين بن عليّ‘ وحرمته وولايته، أخذ من طين قبر الحسين مثل رأس أنملةٍ؛ كان له دواء»([223]).
وأيضاً يدلّ علىٰ هذا القول ما ورد في بعض الروايات من الأدعية والختم علىٰ التربة، فإنّها تشير ـ ولو من بعيد ـ إلىٰ البُعد الغيبي في مسألة الاستشفاء، وسيأتي ذكرها بالتفصيل.
الأُمور التي يتوقف عليها جواز الاستشفاء بتربة الإمام الحسين×
ومن هنا؛ علينا بحث مسألة (جواز الاستشفاء بتربة الإمام الحسين) لمعرفة الجائز منها، وحدود ذلك، وشروطه، والفروع المترتّبة عليه، والآداب التي ينبغي التأدّب بها عند أخذ التربة وعند تناولها. وجميع ذلك يتوقّف علىٰ ذكر أُمور:
الأمر الأوّل: حُرمة أكل الطين
تعرّض الفقهاء في كتاب (الأطعمة والأشربة) إلىٰ الأشياء التي يجوز أكلها وشربها، وإلىٰ الأشياء التي يحرُم أكلها وشربها، وممّا أكّدوا حرمته حرمةً مغلّظةً هو: أكل الطين؛ واستدلّوا علىٰ ذلك بدليلين مهمّين:
الدليل الأوّل: الإجماع، سَواء منه الإجماع المنقول أم المحصّل، بل المحكي من الإجماع بقسميه إمّا مستفيض أو متواتر، وقد نقله كلّ مَن أشار إلىٰ هذه المسألة([224]).
الدليل الثاني: النصوص الواردة عن طريق أهل بيت النبوّة^، البالغة حدّ الاستفاضة أو التواتر([225])، والمشتملة علىٰ أنّ أكل الطين من مكائد الشيطان، ومصائده الكبار، وأبوابه العظام، وأنّ أكله من الوسواس، ويورث السقم في الجسد، ويورث البواسير، ويهيج داء السوداء، ويذهب بالقوّة من الساقين والقدمين، وأنّه مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، وأنّ مَن أكله ملعون، وأنّ مَن أكله فمات أعان علىٰ نفسه، ولا يُصلّىٰ عليه، وأنّ مَن أكله وضعف عن قوّته التي كانت قبل أن يأكله ـ وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله ـ حوسب علىٰ ما بين ضعفه وقوّته، وعُذِّب عليه، وأنّ الله تعالىٰ شأنه خلق آدم من طين فحرّمه علىٰ ذرّيته([226]).
وعُدّ في بعض الأحاديث أنّه من أكلِ لحوم الناس، وخصوصاً طين الكوفة، لقول الإمام جعفر بن محمد الصادق÷: «مَنْ أكل طينها فقد أكل لحوم الناس؛ لأنّ الكوفة كانت أجمة، ثمّ كانت مقبرةَ ما حولها»([227])، وغير ذلك من الأحاديث.
ومع هذا التشديد والمنع عن أكل الطين إلّا أنّ هناك استثناءات، منها: أكل طين قبر الحسين بقدر معيّن للاستشفاء، ومنها: أكل الطين الأرمني، ومنها: أكل طين قبر الحسين والإفطار عليه تبرّكاً يومي عيد الفطر والأضحىٰ ويوم عاشوراء ظهراً، علىٰ خلاف فيها فيما عدا الأوّل.
وأمّا فقهاء المذاهب ـ الشافعية، والحنفية، والمالكية، والحنابلة ـ فقد اختلفوا في حكم أكل الطين والتراب علىٰ أقوال:
1ـ ذهبت المالكية إلىٰ القول بحرمة أكله، ولهم قول آخر بالكراهة.
2ـ ذهبت الشافعية إلىٰ القول بحرمة أكل الطين والحَجَر علىٰ مَن يضرّانه.
3ـ ذهبت الحنابلة إلىٰ القول بكراهة أكل الفحم والتراب والطين الكثير الذي لا يُتداوىٰ به.
4ـ ذهبت الحنفية إلىٰ القول بكراهة أكل التراب([228]).
الأمر الثاني: أكل طين قبر الحسين ×للاستشفاء
استثنىٰ فقهاء الإمامية من حرمة أكل الطين طين قبر الإمام الحسين، فقد جوّزوا أكله للاستشفاء والتداوي بشروط يأتي ذكرها لاحقاً.
والدالّ علىٰ الجواز ـ بالإضافة إلىٰ الإجماع ـ الروايات الكثيرة، بل المستفيضة، بل المتواترة، وقد أكّدها العلماء بعبارات بعضها متقاربة، وبعضها الأُخرىٰ متفاوتة، وسنُطيل نسبياً في نقلها لتوقّف معرفة الفروع اللاحقة عليها.
منها: ما ذكره السيّد ابن حمزة الحلبي بقوله: «ويحرُم أكل الكلب والخنزير والثعلب... والمثانة، والطين، إلّا اليسير من تربة الحسين»([229]).
ومنها: ما قاله العلّامة الحلّي في (التحرير)، وهو بصدد تعداد ما يحرُم من الأشياء الجامدة: «الرابع: الطين، وكلُّهُ حرام، طاهراً كان أو نجساً، ويجوز أكل الطين الأرمني للمنفعة، وكذا يجوز تناول قدر الحُمّصة من تربة الحسين للاستشفاء»([230]).
وقال في (القواعد): «الطين، ويحرُم قليله وكثيره، عدا تربة الحسين، فإنّه يجوز الاستشفاء باليسير منه، ولا يتجاوز قدر الـحُمّصة»([231]).
ومنها: ما ذكره الشهيد الثاني في (المسالك) ـ بعد ذكره لكلام العلّامة: «وقد استثنىٰ الأصحاب من ذلك تربة الحسين، وهي: تراب ما جاور قبره الشريف عُرْفاً... واحترز المصنِّف& بقوله: (للاستشفاء بها) عن أكلها لمجرّد التبرّك، فإنّه غير جائز علىٰ الأصح...»([232]). وقريب منه ما ذكره في (الروضة البهية)([233]).
ومنها: ما قاله السيوري ـ معلّقاً علىٰ كلام المحقّق: «الرابع: الطين، وهو حرام، إلّا طين قبر الحسين للاستشفاء، ولا يتجاوز قدر الحُمّصة. هنا فوائد:... الثانية: استثنىٰ أصحابنا من ذلك طين قبر الحسين للاستشفاء؛ لما اشتُهر في النقل الشريف أنّ الأئمّة^ من ذرّيته، والإجابة تحت قبّته، والشفاء في تربته»([234]).
ومنها: ما قاله الصيمري، وهو بصدد ذكر الفوارق بين الطين الأرمني وطين قبر الحسين: «الأوّل: التربة يجوز تناولها للاستشفاء وإن لم يصفها الطبيب، بل ولو حذّر منها، والأرمني لا يجوز تناوله إلّا إذا كان موصوفاً. الثاني: التربة لا يجوز أن يُتناول منها أكثر من الحُمّصة، والأرمني لا يتقدّر بقدر، بل هو راجع إلىٰ تقدير الطبيب وإن زاد علىٰ قدر حمّصة»([235]).
ومنها: ما قاله الأردبيلي ـ معلّقاً علىٰ كلام العلّامة: «والطين إلّا بقدر الحُمّصة من تربة الحسين للاستشفاء... الظاهر أنّه لا خلاف في تحريم المستثنىٰ منه وتحليل المستثنىٰ، إنّما الكلام في تحقيقهما...»([236]).
ومنها: ما قاله الهندي ـ وهو بصدد شرح كلام العلّامة مازجاً كلامه بعبارته ـ: «عدا تربة الحسين، فإنّه يجوز الاستشفاء باليسير منه اتّفاقاً، ولكن اختلفت الأخبار في حدّ ما يُؤخذ من التربة...»([237]).
ومنها: ما قاله البحراني: «المقام الثالث: في الكلام علىٰ التربة الحسينيّة (علىٰ مشرِّفها أفضل الصلاة والتحية)، والظاهر اتّفاق الأصحاب (رضوان الله عليهم) علىٰ جواز الأكل منها لقصد الاستشفاء؛ وعليه تدلّ جملة من الأخبار، إنّما الخلاف في الأكل للتبرّك، فظاهر جملة من الأخبار المنع...»([238]).
ومنها: ما قاله الطباطبائي ـ معلِّقاً علىٰ استثناء طين قبر الحسين من حرمة أكل الطين ـ: «وكيف كان، لا خلاف في صحّة الاستثناء، بل عليه وعلىٰ حرمة الطين مطلقاً الإجماع في الغُنية وغيرها، وهو الحجّة، مضافاً إلىٰ النصوص المستفيضة، بل المتواترة جدّاً»([239]).
ومنها: ما قاله النراقي ـ بعد أن استثنىٰ من حرمة الطين طينَ قبر الحسينـ: «فائدة: قد عرفت استثناء طين قبر الحسين وهو أيضاً إجماعي ـ كما أنّ حرمة أكل الطين إجماعي ـ والأخبار به بلغت حدّ التواتر، وقد روي في كامل الزيارة بإسناده المتّصل إلىٰ أبي عبد الله قال: في طين قبر الحسين الشفاء من كلّ داء، وهو الدواء الأكبر»([240]).
ومنها: ما قاله صاحب الجواهر ـ مازجاً عبارته بكلام الماتن ـ: «(لا يحلّ شيء منه)، أي: الطين (عدا) الطين من (تربة الحسين فإنّه يجوز الاستشفاء) به بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه، بل النصوص فيه مستفيضة أو متواترة، وفيها المشتمل علىٰ القَسَم (و) غيره من المؤكّدات»([241]).
ومنها: ما قاله السيّد أبو الحسن الإصفهاني ـ بعد أن ذكر حرمة أكل الطين ـ: «يُستثنىٰ من الطين طين قبر الحسين للاستشفاء، فإنّ في تربته المقدَّسة الشفاء من كلّ داء، وإنّها من الأدوية المفردة، وإنّها لا تمرّ بداء إلّا هضمته، ولا يجوز أكلها لغير الاستشفاء، ولا أكل ما زاد عن قدر الحُمّصة المتوسطة»، ووافقه علىٰ هذا كلُّ مَن علّق علىٰ متن (وسيلة النجاة)، وأخصّ بالذكر منهم: السيّد الخميني+([242])، والسيّد الكلبايكاني+([243]). وقريب منه ما قاله السيّد الخميني+ في (تحرير الوسيلة)([244]).
وقد أجاب السيّد الخوئي+ عن سؤال ورد إليه: علىٰ أيّ أساس يجوز أكل التربة الحسينيّة ـ أعني القليل منها ـ مع العلم أنّ الحرمة لأكل الرمل أو التراب مؤكّدة؟ ولماذا لم ترد الأحاديث بتربة الرسول| أو أمير المؤمنين مثلاً؟
قال+: «يختصّ الجواز في التربة الحسينيّة بما لا يتجاوز قدر الحُمّصة، وبكون الغرض هو الاستشفاء، وهذا الحكم تخصيص لحرمة أكل الطين، واستثناء منها، ويختصّ بتربة الحسين دون سائر المعصومين، والله العالم بأسرار أحكامه»([245]). وقد أيّده علىٰ ذلك الشيخ التبريزي+([246]).
ومنها: ما قاله الشيخ محمد أمين زين الدين+: «يُستثنىٰ من الحكم بحرمة أكل الطين أكلُ يسير من طين تربة الحسين للاستشفاء به من الأمراض، مع مراعاة الشرطين الآتي ذكرهما:
الشرط الأوّل: أن يكون المأخوذ من طين التربة بمقدار الحُمّصة... الشرط الثاني: أن يكون ذلك بقصد الاستشفاء»([247]).
ومنها: ما ذكره الشيخ فاضل اللنكراني+ بقوله: «يحرُم أكل الطين والمـَدَر، وكذا التراب والرمل، ويُستثنىٰ من ذلك اليسير من تربة سيّد الشهداء للاستشفاء، والأحوط الأَوْلىٰ حلّه في الماء وشُربه»([248]).
ومنها: ما قاله السيّد السيستاني (حفظه الله): «ويُستثنىٰ من الطين ـ أي: من حرمة الأكل ـ طين قبر الإمام الحسين للاستشفاء، ولا يجوز أكله لغيره، ولا أكل ما زاد عن قدر الحُمّصة المتوسطة الحجم، ولا يلحق به طين قبر غيره، حتّىٰ قبر النبيّ| والأئمّة^. نعم، لا بأس بأن يُمزج بماء أو مشروب آخر علىٰ نحو يستهلك فيه، والتبرّك بالاستشفاء بذلك الماء، وذلك المشروب»([249]).
ومنها ما ذكره السيّد الخامنئي (حفظه الله) بقوله: «مسألة: لا إشكال في تناول مقدار قليل من تربة سيّد الشهداء للاستشفاء بها»([250]).
ومنها: ما قاله الشيخ الفيّاض (حفظه الله) ـ في معرض الإجابة عن سؤال ورد إليه: وأمّا الأكل من تربة الحسين للاستشفاء بمقدار يسير فهل هو جائز؟ ـ: «والجواب: نعم، إنّه جائز»([251]).
ومنها: ما قاله الشيخ لطف الله الصافي (حفظه الله) في منهاجه، وعبارته مطابقة لعبارة أبي الحسن الإصفهاني([252]).
الأمر الثالث: أدلّة جواز الاستشفاء بتربة الحسين×
تضافرت الأدلّة الدالّة علىٰ جواز التداوي بتربة الإمام الحسين؛ ممّا يستدعي حصول اليقين بصدور هذا الحكم الشرعي، وهي تنحصر بخمسة أدلّة:
الدليل الأوّل: الروايات، إذ دلّت روايات أهل البيت^ علىٰ جواز تناول التربة للاستشفاء، وقد وُصِفَت هذه الروايات تارةً بالكثرة، وتارةً بالاستفاضة، وتارةً بالتواتر، وعلىٰ جميع التقادير لا نحتاج إلىٰ البحث السندي فيها؛ للاطمئنان المعتدّ به ـ أو اليقين ـ بصدور قسم منها عن المعصوم.
ونحاول استيعاب أكبر عدد ممكن من الروايات؛ وإحالة الاستدلال إلىٰ الفروع الآتية بعدها؛ وذلك تجنّباً للتكرار الممل.
1ـ ما رواه الكليني، عن الواسطي، عن الإمام الصادق أنّه قال: «الطين حرام كلّه، كلحم الخنزير، ومَن أكله ثمّ مات فيه لم أُصلِّ عليه، إلّا طين القبر، فإنّ فيه شفاء من كلّ داء، ومَن أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء»([253]). ورواه كلّ من ابن قولويه في (المزار)، والصدوق في (العلل).
2ـ ما رواه الكليني أيضاً، عن سعد بن سعد، قال: سألت أبا الحسن عن الطين؟ فقال: «أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، إلّا طين الحائر، فإنّ فيه شفاء من كلّ داء، وأمناً من كلّ خوف»([254]). ورواه كلٌّ من الطوسي والراوندي بسند آخر.
3ـ ما رواه ابن قولويه بسنده عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد الله في حديث، أنّه سُئل عن طين الحائر، هل فيه شيء من الشفاء؟ فقال: «يُستشفىٰ ما بينه وبين القبر علىٰ رأس أربعة أميال... فخذ منها، فإنّها شفاء من كلّ داء وسقم، وجُنّة ممّا تخاف، ولا يعادلها شيء من الأشياء الذي يُستشفىٰ بها إلّا الدعاء، وإنّما يفسدها ما يخالطها من أوعيه، وقلّة اليقين لـمَن يعالج بها... ولقد بلغني أنّ بعض مَن يأخذ من التربة شيئاً يستخفّ بها، حتّىٰ أنّ بعضهم ليطرحها في مخلاة الإبل والبغل والحمار وفي وعاء الطعام، وما يُمسح به الأيدي من الطعام والخـُرج والجوالق، فكيف يستشفي به مَن هذا حاله عنده؟!»([255]).
4ـ ما قاله ابن قولويه من أنّه روىٰ سماعة
بن مهران، عن أبي عبد الله أنّه
قال: «أكل الطين حرام علىٰ بني آدم، ما خلا طين قبر الحسين، مَن أكله من وجع شفاه
الله»([256]).
5ـ ما رواه الطوسي في (المصباح)، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي عبد الله أنّه قال: «مَنْ أكل من طين قبر الحسين غير مستشفٍ به فكأنّما أكل من لحومنا...»([257]).
6ـ ما رواه الطوسي ـ أيضاً ـ من أنّ رجلاً سأل الصادق، فقال: «إنّي سمعتك تقول: إنّ تربة الحسين من الأدوية المفردة، وأنّها لا تمرّ بداء إلّا هضمتهُ. فقال: قلت ذلك، فما بالك؟ قلتُ: إنّي تناولتها فما انتفعت بها. قال: أما أنّ لها دعاء، فمَن تناولها ولم يدعُ به، واستعملها لم يكد ينتفع بها. قال: فقال له: ما يقول إذا تناولها؟ قال: تُقبِّلها قبل كلّ شيء، وتضعها علىٰ عينيك، ولا تناول منها أكثر من حمّصة، فإنّ مَن تناول منها أكثر من ذلك، فكأنّما أكل من لحومنا ودمائنا...»([258]).
الدليل الثاني: الإجماع، إذ أجمع الإمامية علىٰ جواز الاستشفاء بهذه التربة المقدَّسة، وقد ادّعاه جماعة منهم، وهو ثابت، سواء الإجماع المحصَّل أم المنقول، وصرّح به كلٌّ من: السيوري، والشهيد الثاني، والخوانساري، والأردبيلي، والبحراني، والطباطبائي، والنراقي، وصاحب الجواهر، والسبزواري، وغيرهم، وتقدَّم ذِكرُ قسمٍ من أقوالهم([259]).
الدليل الثالث: سيرة المتشرِّعة، فإنّ المتشرِّعة من الإمامية في جميع الأعصار والأمصار متّفقون علىٰ الاستشفاء بتربة الحسين، من غير إنكار من أحد، بل حتّىٰ عند الذين يلتزمون الاحتياط منهم ـ الذي يؤدّي بهم أحياناً إلىٰ الوسواس ـ فإنّهم يستعملونها للاستشفاء من الأمراض من غير تردّد ولا تأمّل([260]).
وفي بعض الروايات السابقة تصريح بقيام السيرة ومعاصرتها للمعصوم، بل التداوي بها حتّىٰ من قِبَل المعصوم نفسه.
الدليل الرابع: إنّ الاستشفاء بالتربة الشريفة حين تناول المريض لها يوجب رفع المرض الحاصل له، هذا أولاً. وثانياً: إنّ رفع المرض عن الشخص يوجب رفع الضرر الحاصل له، فيكون رفع الضرر جائزاً عقلاً ونقلاً، ومنه قوله تعالىٰ: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)([261])، وقول الرسول’: «لا ضَررَ ولا ضِرار»([262]).
ونتيجة الدليل: جواز تناول التربة المباركة لرفع الضرر([263]).
الدليل الخامس: ما يستفاد من كلمات صاحب (التنقيح الرائع)([264])، فإنّ هذه الإفادة إن لم تصلح أن تكون دليلاً مستقلاً، فهي علىٰ أقل تقدير مؤيدٌ لما تقدّم من الأدلّة وما يأتي بعدها.
ويُقرّب الاستدلال الذي ذكره من خلال مقدِّمتين:
الأُولىٰ: إنّ المعتقدين بإمامة الحسين الشهيد ثبت لهم بالتجربة المفيدة للعلم بأنّ تناول هذه التربة المباركة يفيد الشفاء، ورفع المرض عن كلّ مَن استعملها واستفاد منها، وهذا ثابت خارجاً، ويمكن لكلّ أحد أن يلاحظه. فثبت بالعلم واليقين أنّ كلّ مَن تناول التربة يحدث له الشفاء.
الثانية: إنّ الروايات دلّت علىٰ أنّه: «لا
شفاء في محرّم»([265])، بمعنىٰ أنّ
الشيء الحرام
ـ كالخمور ولحم الخنزير وغيرها ـ لم يجعل الله تعالىٰ فيه الشفاء؛ ومن هنا أفتىٰ
جملة من الفقهاء بحرمة التداوي بالخمور وأمثالها.
ونتيجة هاتين المقدِّمتين هي جواز الاستشفاء بتربة الحسين؛ لأنّه لو كان الاستشفاء بها محرّماً لما جعل الله تعالىٰ فيها ذلك الأثر، وهو رفع الداء.
ويؤيِّد ذلك ما في رواية الجعفي الذي اعترض علىٰ الإمام الباقر من أنّ تربة الحسين لا تشفيه، فناوله الإمام مقدار حبّة، فتناولها؛ فعافاه الله من ساعته([266]).
الأمر الرابع: شروط جواز الاستشفاء بالتربة الحسينيّة([267])
إنّ التداوي بالتربة الحسينيّة لا يصلح بشكلٍ مطلق، وإنّما هناك شروط لجواز التداوي بها، والمهمّ منها ثلاثة، وأمّا الباقي من الضوابط والقيود فسوف نذكرها آخر البحث حول هذا الموضوع، تحت عنوان (فروع المسألة).
الشرط الأوّل: أن يكون التداوي بها بمقدار حُمّصة لا أكثر
فالوارد علىٰ لسان الروايات والفقهاء ـ في
قدر ما يجوز تناوله من التربة الشريفة
أربعة مقادير: (قدر الحُمّصة)، و(اليسير مثل الحُمّصة)، و(الحُمّصة المتوسطة
المعهودة)، و(القليل)، و(مثل رأس أُنمُلة).
والمراد منها جميعاً شيء واحد علىٰ الظاهر، وهو التقدير بـ(الحُمّصة المتوسطة المعهودة)؛ لكونها وسطاً بين الصغير والكبير، وهو المنساق منها عُرفاً عند قولنا: (حُمّصة) أو (الحُمّصة).
ومن هنا؛ صرّح جماعة بهذا التقدير، بل ذكر صاحب الجواهر بأنّه لم يجد خلافاً فيه، بل إنّه يمكن تحصيل الإجماع عليه، وصرّح بالإجماع أيضاً السيّد السبزواري&([268]).
واستدلّوا لهذا الشرط ـ بالإضافة إلىٰ الإجماع ـ بما يلي:
الدليل الأوّل: الروايات، فقد دلّت علىٰ هذا المقدار صراحة، كما في الرواية السادسة المتقدِّمة، فقد شبّه الإمام الآكل للتربة بمقدار أزيد من الحُمّصة بأنّه آكلٌ للحومهم^.
وفي خبر آخر عنهم^: «إنّ الله تعالىٰ خلق آدم من طين، فحرّم الطين علىٰ وُلْده. قال: قلت: فما تقول في طين قبر الحسين بن عليّ÷؟ قال: يحرُم علىٰ الناس أكل لحومهم، ويحلّ لهم أكل لحومنا؟! ولكن اليسير منه مثل الحُمّصة»([269]).
ورُوي عن الإمام الصادق أنّه قال: «ولا تتناول منها أكثر من حُمّصة، فإن تناول منها أكثر [من ذلك] فكأنّما أكل من لحومنا ودمائنا»([270]).
الدليل الثاني: لا إشكال ولا خلاف في حرمة أكل الطين، وقد استُثني من أكل طين قبر الإمام الحسين للاستشفاء، والذي دلّت الروايات عليه.
والظاهر من هذه الروايات أنّ الاسـتثناء إنّما كان للضرورة لأجل الاستشفاء، فلا بدّ من الاقتصار علىٰ قدر ما يندفع به الضرر، ويتحقق به الغرض والشفاء، وهو القدر المتقدِّم ذكره في الروايات وهو (بمقدار الحُمّصة المتوسطة المعروفة)، ويبقىٰ ما سوىٰ ذلك تحت عموم (حرمة أكل الطين)([271]).
واتّفقت أكثر كلمات فقهائنا الـمُحدَثين والمعاصرين علىٰ هذا الشرط، وقد تمّ نقلها نصّاً في الأمر الثاني، فلاحظها.
الشرط الثاني: أن يكون أكل التربة بقصد الاستشفاء لا غير
قيّد فقهاء الإمامية جوازَ أكل طين قبر الحسين بأن يكون بقصد الاستشفاء لا مطلقاً، فكلّ مَن قصد الاستشفاء جاز له أكل طين القبر. وهو ما ذهب إليه جماعة، بل هو الأشهر، بل لا خلاف فيه بينهم، إلّا من الطوسي& في (المصباح)، وقد رجع عنه في بقيّة كتبه جميعاً.
وقد صرّح بعضٌ بدعوىٰ الاتّفاق علىٰ حرمة تناول طين القبر لو لم يكن بقصد الاستشفاء؛ فيحرُم علىٰ هذا تناول التربة إذا كان للتبرّك أو للتلذذ أو غيرها من المقاصد.
نعم، هناك رواية نقلها الشيخ الطوسي& تدلّ بظاهرها علىٰ الجواز إذا كان للتبرّك، ولكن لضعف الرواية سنداً، ومعارضتها للروايات المتواترة الدالّة علىٰ حرمة تناول الطين ـ إلّا ما استُثني ـ فينبغي رفع اليد عنها.
واستدلّ للشرط الثاني بأمرين:
الأوّل: الروايات الكثيرة التي استثنت طين القبر من حرمة تناول الطين، أكّدت علىٰ أن يكون التناول بقصد الاستشفاء لا مطلقاً. منها: خبر سدير بن حنان عن أبي عبد الله أنّه قال: «مَن أكل من طين قبر الحسين غير مستشفٍ به فكأنّما أكل من لحومنا»([272]).
الثاني: الروايات المطلقة الدالّة علىٰ حرمة أكل الطين، واستثناء طين قبر الإمام الحسين؛ معلِّلة ذلك بأنّ فيه شفاءً من كلّ داء، وهذا يدلّ عُرفاً علىٰ أنّ رفع اليد عن حرمة أكل الطين مقيَّدة بقصد الاستشفاء، وهي دائرة ضيِّقة، وقدر متيقّن للحلّية، وما عدا ذلك يبقىٰ تحت إطلاق الروايات المحرِّمة لأكل الطين. ومن هذه الروايات رواية أبي يحيىٰ الواسطي المسندة إلىٰ الإمام جعفر الصادق أنّه قال: «الطين حرام كلّه كلحم الخنزير، ومَن أكله ثمّ مات فيه لم أُصلِّ عليه، إلّا طين القبر، فإنّ فيه شفاء من كلّ داء، ومَن أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء»([273])، وذيل الرواية شاهد لما قلناه.
وقد روىٰ هذه الرواية ـ بالإضافة إلىٰ نقل الكليني ـ ابن قولويه في (المزار)، والصدوق في (العلل)([274]).
الشرط الثالث: اشتراط أخذ التربة الحسينيّة بالدعاء والختم
وقع الكلام بين الفقهاء في اشتراط الدعاء
والختم عند إرادة أكل طين قبر الحسين بقصد الاستشفاء، فإنّ المـُراجِع لكلمات
الفقهاء ـ بخصوص هذا الشرط ـ
لا يجد مَن قيّد جواز الأكل بالدعاء والختم، وإطلاق النصوص والفتاوىٰ يقتضي الجواز
مطلقاً، بل صرّح جماعة منهم بأنّ ذلك ـ أي: اشتراط الدعاء والختم ـ لزيادة الفصل
وسرعة الاستشفاء وتحقّقه، بل صرّح بعضٌ بأنّ عدم الاشتراط هو المشهور بينهم. نعم،
قد ورد في بعض الأخبار اشتراط أخذ التربة بالدعاء والختم.
ويمكن مناقشة القول بالاشتراط بما يلي:
1ـ ضعف الخبر الدالّ علىٰ الاشتراط، وعدم قابليّته لتقييد الروايات الكثيرة المطلقة غير المشترطة لشيءٍ من ذلك.
2ـ دعوىٰ القول بظهور الاتّفاق علىٰ عدم الاشتراط، ولو سُلِّم وجود مخالف فهو في غاية الشذوذ والندرة.
3ـ إنّ اشتراط الدعاء والختم قد يؤدّي إلىٰ العسر والحرج اللذين لا يليقان بمثل هذا المقام.
4ـ لو كان ما ذُكر شرطاً؛ لورد التنبيه عليه في معظم النصوص والفتاوىٰ لتوفّر الدواعي عليه، والتالي باطل قطعاً.
وممّا تقدّم يتّضح أنّ القول بعدم الاشتراط هو الأقوىٰ، ويُحمل ما ذُكر من الروايات علىٰ أنّها شروط كمال لسرعة تأثير التربة في التداوي.
ويمكن أن تُضاف مناقشة خامسة حاصلها: أنّ الثابت في أُصول الفقه أنّ القيود في المندوبات كلّها من باب تعدّد المطلوب ـ إلّا ما خرج بالدليل ـ مع أنّ سياق بعض أخبار المقام ظاهرة في ذلك([275]).
قد يُستَشكل علىٰ ما تقدَّم بأنّ مقتضىٰ أصالة تحريم أكل الطين، إلّا في القدر المتيقّن منه الخارج عن الحرمة، يستدعي أن يكون الدعاء والختم وغيرهما شرطٌ في أصل جواز تناول التربة، لا أنّه شرط كمال، كما قيل.
ولكن اتّضح جواب ذلك ممّا تقدَّم؛ لأنّ الأصل ـ أي: أصالة تحريم أكل الطين ـ محكوم بما تقدَّم من إطلاق الروايات، فليس لنا التمسّك به ـ أي: الأصل ـ فيبقىٰ مجرّد الإطلاق والتقييد الصناعي، ومقتضاه ما ذكرناه من حمل القيد علىٰ تعدّد المطلوب لا أنّه شرط لصحّة التناول([276]). وصرّح بذلك جملة من فقهائنا:
قال السيّد أبو الحسن الإصفهاني&: «لأخذ التربة المقدَّسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعية مذكورة في محالّها، خصوصاً في كتب المزار، ولا سيّما مزار (بحار الأنوار)، لكن الظاهر أنّها كلّها شروط كمال لسرعة تأثيرها، لا أنّها شرط لجواز تناولها»([277]). وأيّده علىٰ ذلك كلّ من السيّد الخميني&، والسيّد الكلبايكاني&([278])، في تعليقتهما علىٰ متن (وسيلة النجاة).
ومنها: ما قاله الشيخ أمين زين الدين+: «وقد ذُكِرت في الأحاديث آداب وأدعية وأعمال مخصوصة لأخذ تربة الشفاء، وهي متعدّدة ومتنوعة، والظاهر من مجموع الأدلّة أنّ المذكورات فيها إنّما هي آداب مخصوصة لكمال العمل، وتحقيق النتيجة من الشفاء المقصود بتناول التربة الشريفة، وليست شروطاً في إباحة أكل المقدار المذكور من التربة... ولذلك فيجوز أكلها مع وجود الشرطين الآنف ذكرهما ـ وهما: أن يكون المأخوذ بقدر الحُمّصة، وأن يكون بقصد الاستشفاء ـ وإن لم تحصل الأعمال التي ذكرتها الروايات، وإن لم تُقرأ الأدعية الواردة فيها»([279]).
ومنها: ما ذكره السيّد السيستاني (حفظه الله): «قد ذُكر لأخذ التربة المقدَّسة وتناولها عند الحاجة آدابٌ وأدعية خاصّة، ولكن الظاهر أنّها شروط كمال لسرعة تأثيرها، لا أنّها شرط لجواز تناولها»([280]).
ومنها: ما ذكره الشيخ الصافي (حفظه الله): «لأخذ التربة المقدَّسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعية مذكورة في محالّها، خصوصاً في كتب المزار، ولا سيّما مزار (بحار الأنوار)، ولكن الظاهر أنّها كلّها شروط كمال لسرعة تأثيرها، لا أنّها شروط لجواز تناولها»([281]).
ومنها: ما قاله السيّد عبد الأعلىٰ السبزواري في (المهذّب) بعبارة تطابق عبارة الشيخ الصافي المتقدِّمة([282]).
الأمر الخامس: المراد من طين قبر الحسين× وترابه
لهذه النقطة من البحث جنبتان:
الجنبة الأُولى: سعة المأخوذ من طين القبر وترابه
هل يختصّ المأخوذ من طين القبر علىٰ نحو التحقيق، أو يشمل القبر العُرْفي، أو أنّ دائرة الجواز أوسع من ذلك؟
لا إشكال ولا ريب في أنّه يجوز تناول التربة المأخوذة من القبر نفسه سواء كان من ظاهره أم من باطنه؛ لأنّه القدر المتيقّن من النصوص والفتاوىٰ.
وهل يجوز تناول غيره من المأخوذ من أرض كربلاء المشرَّفة بقصد الاستشفاء أو لا، بل يجب الاقتصار علىٰ المأخوذ من القبر الشريف، فيحرُم أكل غيره وإن قرب من القبر الشريف؟
اختلف الفقهاء في ذلك علىٰ قولين:
القول الأوّل: إنّه يجب الاقتصار علىٰ المأخوذ من القبر الشريف، وإنّ غيره حرام، وهو ما صرّح به جماعة منهم.
واستدلّ لهذا القول بما يلي: أوّلاً: استدلّ له من خلال التمسّك بالعمومات المانعة من أكل الطين، خرج منها ما يؤخذ من القبر الشريف بالنصوص والفتاوىٰ المصرِّحة بأنّه يحرُم أكل الطين إلّا (طين قبر الحسين) أو (إلّا تربة الحسين)؛ وبحسب الظاهر أنّ هذين اللفظين لا يشملان محلّ البحث لا لغةً ولا عرفاً ولا شرعاً؛ لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه قطعاً، ولصحّة سلب الإسمين عن كلّ ما لم يؤخذ من القبر الشريف كالمأخوذ من البعيد عنه بمقدار ذراع، ولعدم تبادره أو تبادر غيره، ولعدم الاطّراد.
ويؤيد ذلك أُمور عدّة:
1ـ ما صرّح به بعضٌ: بأنّ أكل الطّين حرام إلّا طين قبر الحسين وهي مختصّة بمحلِّ القبر، فإنّ عبارته تدلّ علىٰ ذلك.
2ـ ما قاله بعضٌ آخر: بأنّ المراد بطين القبر الشريف هي تربة ما جاوره من الأرض عرفاً.
3ـ ما قاله ثالث: إنّ مقتضىٰ الأصل ولزوم الاقتصار في الاستثناء المخالف علىٰ المتيقن، وهو ما أُخذ من قبره أو ماجاوره عرفاً.
وثانياً: إنّ التربة الشريفة التي يُستشفىٰ بها يجب تعظيمها ولا يجوز الاستخفاف بها، وما يجوز الاستخفاف به لا يكون من التربة التي يُستشفىٰ بها، فلا يجوز الاستشفاء بما بعُد عن القبر الشريف بمقدار سبعين ذراعاً فضلاً عن أربعة فراسخ أو أربعة أميال.
فهنا مقدِّمتان: الأُولىٰ: إنّ تربة الإمام الحسين التي يُستشفىٰ بها يجب تعظيمها ولا يجوز الاستخفاف بها. والثانية: إنّ ما يجوز الاستخفاف به لا يكون من التربة التي يُستشفىٰ بها.
ويدلّ علىٰ المقدِّمة الأُولىٰ وجوه عدّة:
أ ـ ما صرّح به جماعة من أنّه لا يجوز الاستنجاء بالتربة الحسينيّة وبأنّه يُكَفَّر فاعله.
ب ـ ما قاله الإمام الصادق في آخر خبر أبي حمزة الثّمالي: «ولقد بلغني أنّ بعض مَن يأخذ من التربة شيئاً يستخف به حتّىٰ أنّ بعضهم يضعها في مخلّاة البغل والحمار، وفي وعاء الطّعام فكيف يُستشفىٰ به مَن هذا حاله»([283]).
ج ـ ما رواه في الوسائل عن الإمام الصادق من أنّ رجلاً سأل الصادق فقال: «أنّي سمعتك تقول: إنّ لتربة الحسين من الأدوية المفردة، وأنّها لا تمرّ بداء إلّا هضمته، فقال[]: قد قلت ذلك فما بالك. قلت: إنّي تناولتها فما انتفعت بها، قال[]: أَما إنّ لها دعاء فمَن تناولها ولم يدعُ به واستعملها لم يكد ينتفع. قال: فقال له: ما يقول إذا تناولها؟ قال[]: تُقبّلها قبل كلّ شيء وتضعها علىٰ عينك...»([284]).
د ـ إنّه بحسب حكم العقل من البعيد جدّاً تجويز الشارع الاستشفاء بما يجوز الاستخفاف به، والاستنجاء به وجعله سبياً للشفاء، خصوصاً مع ملاحظة أنّ التربة الحسينيّة الشريفة ليست كسائر الأدوية التي يجوز التداوي بها مع جواز الاستخفاف بها.
أمّا المقدِّمة الثانية فيدلّ عليها أنّ ما بَعُدَ عن القبر الشريف بمقدار ذراع وما زاد يجوز المشي عليه؛ ولذا يمشي عليه الإمامية من العلماء وغيرهم في الحرم الشريف والرواق والصحن، بل إنّ ما خرج عن الصّحن الشريف من الدور والأسواق والطّرق الاستخفاف به أمر ظاهر، فإنّه يُتغوط ويُبال فيه.
والخلاصة: إنّ عدم الاستخفاف منحصر بما علىٰ القبر الشريف خاصّة دون غيره.
القول الثاني: إنّه لا يجب الاقتصار علىٰ المأخوذ من القبر الشريف، بل يجوز الاستشفاء أيضاً بما يؤخذ من أرض كربلاء ممّا بعُد عن القبر الشريف، وهو ما صرّح به جماعة من الفقهاء.
واستدلّوا علىٰ ذلك بروايات عدّة تختلف في تحديد المسافة التي يجوز الأخذ منها([285]).
وسيأتي استعراض جميع الأقوال في هذه المسألة، مع استعراض أدلّة المجوّزين وهم أصحاب القول الثاني، مع مناقشتها، وأخذ النتيجة النهائية منها.
القول الأوّل: إنّ محلّ أخذ التربة ـ التي تكون منشأً لجواز الاستشفاء ـ هو القبر الشريف، وما يقرب منه علىٰ وجه يُلحَق به عُرْفاً، ولعلّ الحائر الحسيني بأجمعه منه؛ وذلك لأنّ هذا هو المتبادر من طين القبر، ولقاعدة الاقتصار علىٰ القدر المتيقّن الذي به يخرج عن إطلاقات حرمة أكل الطين.
فإنّ الروايات الواردة الكثيرة تدلّ علىٰ حرمة أكل الطين مطلقاً، من أيّ مكان، وأيّ قدر منها، ولكن هذه الروايات المطلقة قد خُصِّصت بروايات أُخرىٰ جوّزت أكل طين قبر الحسين، واستثنته من حرمة الأكل، إلّا أنّها مختلفة في تحديد المراد من هذا الطين من حيث السعة، فبعضها عبّرت بطين القبر، وبعضها وسّعته إلىٰ سبعين ذراعاً، وبعضها إلىٰ أكثر من ذلك، والقدر المتيقّن منه الذي نقطع بجواز تناوله هو (طين القبر) وما جاوره عُرفاً، دون غيره، وهذا هو معنىٰ الاقتصار علىٰ القدر المتيقّن.
وفي خبر يونس بن الربيع عن الإمام الصادق، دلالة علىٰ هذا، قال: «إنّ عند رأس الحسين لتربة حمراء فيها شفاء من كلّ داء إلّا السّام»([286]). قال يونس: «فأتيت القبر بعد ما سمعت هذا الحديث، فاحتفرنا عند رأس القبر، فلمّا حفرنا قدر ذراع انحدرت علينا من رأس القبر شبه السهلة حمراء قدر الدرهم، فحملناه إلىٰ الكوفة، فمزجناه وخبيّناه، وأقبلنا نعطي الناس ليتداووا به»([287]).
القول الثاني: إنّ محلّ أخذ التربة هو من عند قبر الحسين إلىٰ سبعين ذراعاً، كما رُوي عن أبي عبد الله قوله: «يؤخذ طين قبر الحسين من عند القبر علىٰ سبعين ذراعاً»([288]). ورواها الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد([289]).
وفي رواية أُخرىٰ: «علىٰ سبعين باعاً»([290]). والباع والبوع: مدّ اليدين وما بينهما من البدن، ويصير بذلك أكثر من ثلاثمائة وخمسين ذراعاً. ويصبح هذا قولاً آخراً.
القول الثالث: إنّ محلّ أخذ التربة هو ما بين قبر الحسين إلىٰ رأس ميل منه، وهذا التحديد ورد في رواية أبي صباح الكناني، عن أبي عبد الله، أنّه قال: «طين قبر الحسين فيه شفاء، وإن أُخذ علىٰ رأس ميل»([291]).
القول الرابع: إنّ محلّ أخذ التربة هو ما بين قبر الحسين إلىٰ أربعة أميال؛ ودلّت علىٰ هذا التحديد رواية الثمالي عن أبي عبد الله الصادق، فقد سُئل الإمام عن طين الحائر: هل فيه شيء من الشفاء؟ فقال: «يُستشفىٰ ما بينه وبين القبر علىٰ رأس أربعة أميال...»([292]).
القول الخامس: إنّ محلّ أخذ التربة هو ما بين قبر الحسين حتّىٰ عشرة أميال، وقد ورد بهذا التحديد خبر الحجال عن أبي عبد الله، قال: «التربة من قبر الحسين بن عليّ علىٰ عشرة أميال»([293]).
القول السادس: إنّ محلّ أخذ التربة هو ما بين قبر الحسين إلىٰ فرسخ؛ وقد دلّت علىٰ هذا التحديد رواية إسماعيل البصري، عن الإمام الصادق، قال: «حَرَمُ الحسين فرسخٌ في فرسخ من أربع جوانب القبر»([294]).
القول السابع: إنّ محلّ أخذ التربة هو ما بين قبر الحسين إلىٰ خمسة فراسخ، وهذا التحديد ورد في خبر منصور بن عبّاس، عن أبي عبد الله، قال: «حَرَمُ الحسين خمس فراسخ من أربع جوانبه»([295]).
وقد أرسل الشهيد الثاني في (المسالك) رواية بأنّ حَرَم الحسين أربعة فراسخ، ولكن هذه الرواية غير متوفّرة في كتب الحديث.
القول الثامن: وهو القول المنسوب إلىٰ مشهور الإمامية مِنْ أنّ المراد بتربة الحسين هو كلّ ما تَصدُق عليه التربة، فالشيء المباح والجائز تناوله من التربة هو كلّ ما صدق عليه أنّه تربة أبي عبد الله الحسين.
ويؤيِّد هذا القول ما تقدَّم من الروايات الوارد فيها (طين الحائر)، أو(أنّه إلىٰ عشرة أميال) وأمثالها، وتُحمل الروايات الدالّة علىٰ التحديد بأقلّ من ذلك علىٰ مراتب الفضل، فكلّ ما قرب من القبر الشريف يكون فضله أكثر، ثمّ الذي بعده في البُعد، وهكذا([296]).
ملاحظات حول الأقوال
1 ـ إنّ أهمّ ثلاثة أقوال ـ بعد إرجاع بعضها إلىٰ بعض ـ هي: القول الأوّل والثاني والثامن.
أمّا الأوّل؛ فلأنّه القدر المتيقّن من جواز أكل الطين المجمع علىٰ حرمته، وهو القدر المتيقّن أيضاً بالنسبة إلىٰ التحديدات المذكورة في المقام مع اختلافها قُرباً وبُعداً؛ ولدلالة جملة من الروايات عليه، علماً بأنّ القائل بهذا القول لا يَشكّ في خروج طين قبر الإمام الحسين عن حرمة أكل الطين.
وأمّا الثاني؛ فلأنّه قدر متيقّن آخر، وهو أضيق دائرة من سائر الأقوال، وبه يخرج عن إطلاق حرمة تناول الطين، خصوصاً إذا لاحظنا بأنّ القول الأوّل لا يمكن تحقّقه خارجاً لضيق المساحة، وتعذّر الحصول علىٰ مثل هذه التربة في الوقت الحاضر.
وأمّا الثامن؛ فلأنّ صاحبه أرجع الضابط فيه إلىٰ صدق التربة الحسينيّة عليه، فكلّ ما صدق عليه أنّه تربة الحسين، تلحقه الأحكام الخاصّة التي منها جواز الأكل. ولعلّ هذا القول هو أوسع الأقوال في المسألة.
2 ـ إنّ الأخبار الدالّة علىٰ بقيّة الأقوال كلّها ضعيفة السند، مع عدم انجبارها بأيّ شيء من الإجماع والشهرة والعمل، فلا يمكن إثبات الحلّية لمثل هذه التحديدات الواسعة جدّاً. وهو ما صرّح به بعض الإمامية.
ولا يقال: أنّ الاعتراف بالقول الثامن هو اعتراف ضمني بالأقوال الأُخرىٰ؛ لأنّ الأقوال الأُخرىٰ يُراد إثباتها بالروايات لا بصدق التربة عليها، مع أنّه لو أخذنا بهذه الأقوال، لا بدّ من إجراء أحكام التربة عليها، وإن لم يصدق عليها عُرْفاً تربة الحسين.
3 ـ إنّ الأقوال التي يمكن الركون إليها اثنان: الأوّل والثامن. والعمل بالاحتياط ـ خوفاً من ارتكاب أكل الطين المحرّم ـ هو الاقتصار علىٰ القول الأوّل دون غيره من الأقوال.
4 ـ إنّ القائلين بالقول الثامن حملوا الروايات المختلفة في التحديد علىٰ درجات الفضل وسرعة التداوي، فكلّما قَرُب الأخذ من قبر الحسين يكون فيه الفضل، ويسرع الاستشفاء به، وهكذا.
5 ـ ذكر جماعة من الفقهاء المعاصرين بأنّ القدر المتيقّن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشريف وما يقرُب منه علىٰ وجهٍ يُلحق به عُرْفاً، ولعلّ هذا يشمل الحائر الحسيني بأجمعه، ثمّ أضافوا ـ بعد الإشارة إلىٰ ما تقدَّم من الأقوال ـ بأنّ الأحوط في جواز تناول التربة الحسينيّة هو الاقتصار علىٰ ما حول القبر إلىٰ سبعين ذراعاً، بحيث لا يجوز للمكلَّف تناول ما زاد علىٰ هذا التحديد؛ لأنّه يدخل في حرمة تناول الطين.
وذكروا بعد ذلك حَلاً لتناول التربة التي تقع ما بعد السبعين ذراعاً، وحاصل الحَلّ هو: أن تُستعمل التربة المباركة ممزوجة بماء، أو تناولها علىٰ نحو لا يصدق عليه الطين، وذلك بأن يُستهلك الطين في ذلك الماء، ثمّ يتناوله بقصد الاستشفاء برجاء المطلوبية؛ فيحصل المراد بذلك إن شاء الله تعالىٰ([297]). كلّ ذلك لعدم إحراز موضوع التربة الجائز أكلُها.
والعمدة في الباب هو اليقين بلطف الله وفضله، والتعلّق الكامل بعظم رحمته، والإخلاص في التوجّه إليه بصاحب التربة وكبير منزلته أن يجعلها شفاءً من كلّ داء، وأمناً من كلّ خوف.
وهناك حلٌّ آخر حاصله: أن تؤخذ التربة، ثمّ توضع علىٰ الضريح، ثمّ يستعملها حيث يشاء، ففي هذه الحالة يقوىٰ احتمال جوازه حينئذٍ([298]).
الجنبة الثانية: المراد من الطين
بعد أن ثبتت حرمة أكل الطين بالنصوص والإجماع، يأتي هذا السؤال: هل الحرمة تختصّ بالطين، أو تعمّ التراب والحجر والمدر والرمل وما شابه ذلك؟ وكذا الحال في المستثنىٰ من الحرمة ـ وهو تربة الإمام الحسين ـ فهل يعمُّ الجوازُ الطينَ والترابَ وما شابه ذلك أو يختصّ بالطين فقط؟
المشهور بين المتفقّهة حرمة أكل التراب والأرض كلّها حتّىٰ الرمل والأحجار، ويُستدل علىٰ ذلك:
1ـ إنّ هذه الأشياء جميعاً تضرّ بالبدن، فلا فرق بين التراب المخلوط بالماء، أو الرمل، أو المدر وأمثالها، ولعلّ علّة حرمة الأكل هي الإضرار بالبدن.
2ـ إنّ المحرَّم هو الطين، وليس فيه إلّا الماء والتراب، هذا أوّلاً. وثانياً: إنّ الماء بما هو ماء غير محرَّم، ولا معنىٰ لتحريم شيء بسبب انضمام شيء محلّل له، فلو لم يكن التراب حراماً لم يكن الطين كذلك، وإنّما التراب جزء الأرض، فتكون هي كلّها حراماً.
وقد يأتي هذا الكلام في جانب المستثنىٰ ـ وهو طين قبر الحسين ـ فيُقال: إنّ الجائز منه يعمّ الطين والتراب وما شابههما، خصوصاً وأنّ القبر قد يشتمل علىٰ الطين الرَطِب أو الجاف، أو المدر، أو التراب، ولا خصوصية لأحدهما، فكلّ ما ضمَّ الجسد الطاهر وما قرب منه يجوز الاستشفاء به.
إضافة إلىٰ ذلك أنّ الأخبار الواردة في جواز أكل طين القبر ـ التي هي في مقام الاستثناء ـ جاءت بلفظ (الطين) كما أنّها جاءت بلفظ (التربة)، وهذا يدلّ علىٰ أنّ المُحلَّل يشمل الطين والتربة معاً.
والبحث في هذا الموضوع واسع جدّاً يحتاج إلىٰ مجال آخر([299]).
الأمر السادس: طريقة تناول التربة
تناول التربة الحسينيّة يمكن أن يكون بإحدىٰ الطرق الآتية:
1ـ أن يكون عن طريق ازدراد وابتلاع التربة، كما هو المتعارف من تناول الأسبرين والكبسول من الأدوية الحديثة.
2ـ أن يكون عن طريق حلِّها في الماء، ثمّ القيام بشربها.
3ـ أن يكون عن طريق مزجها بشربة من الماء وتناولها.
4ـ أن يكون عن طريق مزجها بالطعام، ثمّ تناول المجموع.
5ـ أن يكون عن طريق التمسّح بها علىٰ موضع الوجع، أو ما يُراد علاجه، وغير ذلك من الطرق([300]).
الأمر السابع: فروع المسألة
يلحق بجواز أكل تربة الحسين لأجل الاستشفاء فروع عدّة لا بدّ من استعراضها لأهمّيتها، وتوقّف أصل الجواز عليها، وهي كالآتي:
صرّح بعض فقهاء الإمامية بجواز أكل التربة المطبوخة ـ بعد ثبوت الإجماع علىٰ جواز الاستشفاء بغير المطبوخة ـ ورغم تصريحهم بالجواز قالوا: إنّ الأحوط استحباباً ترك أكلها.
ولم أجد تصريحاً لأغلب مَن تطرّق لهذه المسألة من الفقهاء إلّا من صاحب (المناهل)، فقد ذكر: «بأنّ الأحوط الترك، وإن كان الأقرب جواز الأكل من غير استشفاء»([301]).
والظاهر أنّ التربة التي تُنقل من كربلاء في وقتنا الحاضر لا تُعدّ من التربة المطبوخة؛ لأنّ طريقة عملها هي إضافة مقدار من الماء علىٰ تراب كربلاء، ثمّ تُخلط بحيث يُجعل طيناً، ثمّ يُجعل في قوالب دائرية أو مربعة أو مضلَّعة، ويُترك كيْ يجف، من غير إدخالها في أفران([302]).
الثاني: جواز الاستشفاء مقيّد بوجود المرض
أجمع فقهاء الإمامية علىٰ جواز الاستشفاء بتربة الإمام الحسين من الأمراض الحاصلة والموجودة فعلاً، وهذا لا خلاف ولا إشكال فيه؛ لما تقدَّم من الروايات والإجماعات الدالّة علىٰ الجواز، بل الاستحباب.
ومن هنا؛ صرّح جملة من الفقهاء ـ ولعلَّهم الأكثر ـ بعدم جواز تناول التربة بقصد الاستشفاء لأجل مرض غير حادث فعلاً، متوقّعاً حدوثه عِلماً أو ظنّاً أو احتمالاً؛ وذلك لقيام الإجماع علىٰ حرمة تناول الطين الذي خرج منه تناول التربة للاستشفاء، والقدر المتيقّن من ذلك هو وجود المرض وتحقّقه عند الشخص. وأمّا المرض غير الحادث، فيبقىٰ تناول الطين لأجله تحت عمومات حرمة تناول الطين؛ إذ لا يُقال عُرْفاً للشخص الذي لم يبتلِ بالمرض أنّه استشفىٰ بالتربة.
ولا فرق في جواز التناول بين حالة تعيين المرض بالقصد، وبين قصد الشفاء من جميع الأمراض التي يجدها الشخص في بدنه.
وهل يشترط العلم بالمرض الذي يجوز معه تناول التربة الحسينيّة، أو يكفي ظنّ المرض أو احتماله؟
الأقرب عند بعض الفقهاء هو العلم بحدوث المرض، ولا يكفي الظنّ والاحتمال؛ وذلك للدليل نفسه المتقدِّم آنفاً، وأنّ ذلك هو الموافق للاحتياط في الدين، خصوصاً إذا علمنا بأنّ هناك حرمة مغلَّظة لتناول الطين.
وقد نَسب صاحب (المناهل) إلىٰ (التنقيح) ـ وهو الذي ذهب إليه ابن طي الفقعاني ـ جواز تناول التربة مطلقاً، أي: في صورة حصول المرض فعلاً، أو توقُّع حدوثه بعد ذلك علىٰ نحو العلم أو الظنّ أو الاحتمال.
والظاهر عدم وضوح دليل القول الثاني مع النظر إلىٰ دليل القول الأوّل([303]).
ولا فرق في تناول التربة الحسينيّة بين الأمراض المهلكة وغيرها، ولا بين الشديد من المرض وغيره، فيجوز تناول التربة لجميع ذلك.
ولا يجوز تناولها لحفظ الصحّة، ولا للأمراض الباطنة كالحسد ونحوه، ولا للأُمور الطبيعيّة، كمجرّد ضعف الحافظة وكثرة النسيان والبلاهة وقلّة الفهم.
ويُشْكَل تناولها لمجرّد الهمّ والغمّ والتعب والكسل، ونحوها من الآلام النفسانيّة، والأقرب الجواز إنْ بلغ ذلك حدّاً يصدق معه المرض، كالخارج عن العادة، فإن لم يصل إلىٰ هذه الحالة حَرُم؛ كلّ ذلك لعموم النواهي المؤيّدة بالشهرة، بل دلّت بعض الروايات علىٰ النهي عن بعض الأفراد المتقدِّم ذكرها بالخصوص.
الثالث: تكرار تناول التربة الحسينيّة
صرّحوا بجواز تكرار تناول التربة إذا طال المرض ولم يحصل الشفاء بها في المرّة الأُولىٰ، ولا يجوز الزيادة علىٰ المرّة ـ بأن يتناول مرّتين، كلّ مرّة بقدر الحُمّصة ـ في المرض الواحد.
ويجوز التناول مرّة أُخرىٰ لو تبدّل المرض الأوّل بمرض آخر، وكذا يجوز التناول مرّة ثانية فيما لو كان له أمراض عديدة وأكل بقصد أحدها، فإنّه يجوز أكله بقصد الآخر وهكذا؛ كلّ ذلك لإطلاقات الأدلّة في ذلك([304]). ولم أجد تصريحاً للمعاصرين من الفقهاء، إلّا من الشيخ محمد أمين زين الدين، قال: «ويجوز أكل المقدار المذكور من التربة الشريفة كلّما وجد الحاجة إلىٰ الاستشفاء، كما إذا أكلها للاستشفاء من مرض معيّن، فشفاه الله منه، فإذا أراد أكلها ثانياً للشفاء من مرض آخر يعانيه أيضاً، وكما إذا تجدّد له مرض آخر بعد ذلك وأراد الشفاء منه، وكما إذا أكلها بقصد الشفاء من مرض فلم يُشفَ منه وأراد التكرار مع زيادة في التوسّل إلىٰ الله، وإخلاص في الوجه إليه أن يعجّل له الشفاء من دائه»([305]).
الرابع: عدم توقّف جواز تناول التربة على إذن الطبيب
لا يتوقّف الاستشفاء بالتربة علىٰ إذن الطبيب، ولا علىٰ إذن غيره؛ وهذا ما صرّح به جملة من فقهاء الإمامية، بل قالوا: إنّه يجوز تناول التربة وإن حذّر منها الطبيب أو أنكر التداوي بها؛ ويُستدل لما ذهبوا إليه بالروايات الكثيرة ـ الدالّة علىٰ مضمون (والشفاء في تربته) ـ المطلقة وغير المقيّدة بإذن أحدٍ من الناس ولو كان طبيباً.
وأمّا اشتراط الإذن ـ علىٰ القول به ـ في بقيّة الأدوية؛ فلأجل وجود عناصر مضرَّة وسامّة فيها تؤدي إلىٰ زيادة المرض أو الموت إذا ما أُسيئ استعمالها بدون استشارة الطبيب المختصّ. وهذا بخلافه في التربة المباركة، خصوصاً مع إطلاق (الشفاء) فيها الوارد في الروايات، فلا مرض معها مطلقاً([306]).
الخامس: بماذا تثبت تربة الإمام الحسين×؟
يمكن إثبات كون هذه التربة المعيّنة هي تربة الإمام الحسين من خلال الطرق الآتية:
1ـ أن يأخذ الشخص التربة الحسينيّة بنفسه.
2ـ أن يحصل له علمٌ ويقين بأنّ هذه التربة هي تربة الإمام الحسين.
ولا إشكال في جواز الاعتماد علىٰ الطريقين السابقين لحجيّة اليقين والعلم.
3ـ قيام البيّنة ـ أي: شاهدين عدلين ـ علىٰ أنّ هذه التربة هي تربة قبر الحسين؛ لقيام الدليل علىٰ الأخذ بشهادة البيّنة.
4ـ إخبار العادل ـ بل مطلق الثقة ـ بالتربة المباركة، وهذا الطريق يمكن الأخذ به؛ لاستقرار السيرة علىٰ الاعتماد علىٰ قول الثقة بين المتشرِّعة في نظائر المقام.
وقد استشكل بعض الفقهاء علىٰ ذلك، وقيّد الأخذ بهذا الطريق في حالة حصول الاطمئنان للشخص، لا مطلقاً.
قال السيّد أبو الحسن الإصفهاني: «إذا أخذ التربة بنفسه، أو علم من الخارج بأنّ هذا الطين من تلك التربة المقدَّسة، فلا إشكال، وكذا إذا قامت علىٰ ذلك البيّنة، بل الظاهر كفاية قول عدل واحد، بل شخص ثقة، وهل يكفي إخبار ذي اليد بكونه منها أو بذله لها علىٰ أنّه منها؟ لا يبعد ذلك، وإن كان الأحوط في غير صورة العلم وقيام البيّنة تناولها بالامتزاج بماء أو شربة»([307]).
وعلّق السيّد الخميني علىٰ قوله: «إخبار ذي اليد»ـ بعد أن وافقه في كلّ ما قاله ـ بأنّه محلّ إشكال([308]).
وعلّق السيّد الكلبايكاني علىٰ عبارة: «وإن
كان الأحوط في غير صورة العلم...»
ـ بعد ذكره المسألة ـ قائلاً: «هذا هو مقتضىٰ القاعدة في الشبهة الحُكمية من
الاقتصار علىٰ المتيقَّن ممّا خرج من عمومات حرمة الطين، وأمّا في الشبهة المبتلىٰ
بها كثيراً في هذا الزمن فمقتضىٰ البراءة، وإن كان جواز الأكل ما لم يُعلم
بالحرمة، لكن حيث إنّ الاستشفاء به ينبغي أن يستشفىٰ به بنحو الاستهلاك في الماء
ليسلم عن الاستشفاء بما يحتمل أن يكون حراماً واقعاً، وإن كان حلالاً بحسب
الظاهر»([309]).
وقال السيّد السيستاني (حفظه الله): «إذا أخذ التربة بنفسه، أو علم من الخارج بأنّه من تلك التربة المقدَّسة بالحدِّ المتقدِّم، فلا إشكال، وكذا إذا قامت علىٰ ذلك البيّنة، وفي كفاية قول الثقة، أو ذي اليد إشكال، إلّا أن يورث الاطمئنان، والأحوط وجوباً ـ في صورة غير صورة العلم والاطمئنان وقيام البيّنة ـ تناولها ممزوجاً بماء ونحوه بعد استهلاكها فيه»([310]).
وهذا ما قاله أيضاً الشيخ لطف الله الصافي (حفظه الله)، إلّا أنّه احتاط في الصورة الأخيرة احتياطاً استحبابياً([311]). وهو ما ذكره السيّد السبزواري أيضاً([312]).
5ـ إخبار ذي اليد بتربة الإمام الحسين، فلو كان تحت يد شخص تربة معيّنة، وأخبر بأنّها من تربة الإمام الحسين، فهل يمكن الاعتماد علىٰ إخباره بها، وبالتالي جواز تناولها للاستشفاء؟
للفقهاء في ذلك طريقان:
الأوّل: إمكان الاعتماد علىٰ قول صاحب اليد، وهو ما ذكره جماعة من الفقهاء.
ويمكن الاستدلال عليه بما يلي:
1ـ الاعتماد علىٰ قاعدة: «إنّ كلّ مَنْ استولىٰ علىٰ شيء يكون قوله معتبَراً فيما استولىٰ عليه»، بناءً علىٰ ثبوتها.
2ـ لو قلنا: إنّ إثبات التربة الحسينيّة ينحصر بطُرق تفيد العلم ـ كالخبر المتواتر، أو المشاهدة الحسّية، أو شهادة عدلين ـ فمثل هذا يلزم منه العسر، بل في بعض الأحيان يكون متعذِّراً، فيدور الأمر بين ترك الاستشفاء بها، وبين جواز الاعتماد علىٰ صاحب اليد، ومن المعلوم أنّ الأوّل باطل قطعاً([313])؛ فينحصر الأمر باختيار الطريق الثاني، وهو جواز الاعتماد علىٰ قول صاحب اليد.
3ـ إنّ المستفاد من سيرة المتشرِّعة عدم انحصار إثبات التربة بالأمرين السابقين فقط، بل السيرة قائمة علىٰ جواز الاعتماد علىٰ صاحب اليد.
4ـ إذا كان قول صاحب اليد (المالك) مقبولاً في دعوىٰ الملكية، وكذا قول المرأة في دعوىٰ الخلوّ عن الزوج، فيلزم قبول قول المالك هنا بطريق أَوْلىٰ.
5ـ الاعتماد علىٰ مضمون قول المعصوم: «إنّ كلّ شيء حلال حتّىٰ يعرف الحرام بعينه»([314]). والتربة إذا لم نعلم بكونها حراماً تبقىٰ علىٰ أصل الحلِّية، وهنا أيضاً نحكم علىٰ حلّية المأخوذ من صاحب اليد، إلّا أنّ حرمة أكل الطين متيقّنة ـ وهي من الأمارات القطعية ـ فكيف يقدَّم الأصل عليها؟! نعم، استُثني طين القبر، فلا بدّ من العلم به، فالأصل في المقام الذي دلّت عليه النصوص القطعية هو حرمة كلّ طين، وهو المرجع عند الشك، ولا تجري أصالة الحلِّية في المقام؛ وعليه فلا يمكن الأخذ بهذا الوجه.
اشتراط حصول الظنّ بصدق صاحب اليد
هناك قولان في اشتراط حصول الظنّ بصدق قول صاحب اليد (المالك للتربة): قولٌ بالاشتراط، وقولٌ بعدمه، والثاني أقوىٰ.
وفي الاكتفاء بمطلق الظنّ، أو بظنٍّ خاصٍّ، قولان أيضاً، والقول الأوّل في غاية القوّة.
وفي اشتراط عدالة صاحب اليد وعدم اشتراط ذلك، قولان أيضاً، والقول بعدم الاشتراط في غاية القوّة.
وخلاصة هذا الطريق: إمكان الاعتماد علىٰ قول صاحب اليد في إثبات كون الذي تحت يده من التربة هي من تربة الإمام الحسين، ويكفي لذلك مطلق الظنّ بقوله([315]).
الثاني: عدم إمكان الاعتماد علىٰ إخبار ذي اليد؛ ولعلّه لأجل انتفاء الدليل المعتبَر علىٰ حُجيّة مثل هذا الإخبار، وإمكان المناقشة في أدلّة أصحاب القول الأوّل. ولكن كثرة الأدلّة وصحّة بعضها يكفي في الاعتماد علىٰ إخبار ذي اليد.
ومع الإصرار علىٰ عدم حجيّة صاحب اليد، اقترح الفقهاء طريقة للتخلّص من الحرمة المتوقّعة عند تناول التربة المباركة في حال أخذها ممّن له يد عليها، وكذا في غير حالة حصول العلم وقيام البيّنة، والطريقة هي: أنْ يحلّ التراب في الماء، أو شربة أُخرىٰ، بحيث يخرج عن صدق الطين، ثمّ يشرب منه([316]).
وبما ذكرناه أخيراً احتاط السيّد السيستاني احتياطاً وجوبياً([317]).
الأمر الثامن: آداب أخذ وتناول التربة الحسينيّة
لأخذ التربة المقدَّسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعية مخصوصة، لكن الظاهر أنّها كلّها شروط كمال لسرعة تأثيرها، لا أنّها شروط لجواز تناولها؛ لأنّ القيود ـ كما تقدَّمت الإشارة إلى ذلك ـ كلّها من باب تعدّد المطلوب، إلّا ما خرج بالدليل، وأنّ سياق بعض أخبار المقام ظاهر في ذلك، وقد تقدَّم بعضها.
وحان الوقت لذكر قائمة بهذه الآداب التي أكّدت عليها روايتان وردتا عن طريق أهل البيت^، وهما: رواية (المصباح) ورواية (المزار الكبير) عن جابر الجعفي، مع الإشارة إلىٰ أوجه الاختلاف بينهما، ثمّ نردف ذلك ببعض الأدعية الواردة في خصوص أخذ التربة التي وردت في روايات أُخرىٰ، وهي كالآتي:
1ـ الاغتسال آخر الليل.
2ـ التطيّب بالسعد (نوع من الطيب).
3ـ الوقوف عند رأس الإمام الحسين.
4ـ الصلاة أربع ركعات، كلّ ركعتين منفصلتين عن الأُخرىٰ كصلاة الصبح، وذلك بالكيفية الآتية:
أ ـ تُقرأ في الركعة الأُولىٰ منها (الحمد) مرّة، و(الإخلاص) إحدىٰ عشرة مرّة. وفي الرواية الثانية: (قل يا أيّها الكافرون) إحدىٰ عشرة مرّة.
ب ـ تُقرأ في الركعة الثانية (الحمد) مرّة، و(القدر) إحدىٰ عشرة مرّة. وجاء في الرواية الثانية: أنّه يُستحب أن يقول في قنوته بعد قراءة سورة (القدر): «لا إله إلّا الله حقّاً حقّاً، لا إله إلّا الله عبوديّة ورِقّاً، لا إله إلّا الله وحده وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، سبحان الله مالك السماوات وما فيهنّ وما بينهنّ، سبحان الله ذي العرش العظيم، والحمدُ لله ربّ العالمين»([318]).
ج ـ تُقرأ في الركعة الثالثة (الحمد) مرّة، و(الإخلاص) إحدىٰ عشرة مرّة.
د ـ تُقرأ في الركعة الرابعة (الحمد) مرّة، و(النصر) اثنتي عشرة مرّة.
وجاء في الرواية الثانية: أنّه يُستحب أن يقول في قنوته ما مرّ في القنوت السابق.
5ـ سجود الشكر، ويقول فيه ألف مرّة: (شكراً).
6ـ القيام من السجود والتعلّق (التمسّك) بضريح الإمام الحسين، ثمّ يقول: «يا مولاي يا بن رسول الله، إنّي آخذ من تربتك بإذنك، اللّهمَّ فاجعلها شفاءً من كلّ داء، وعِزّاً من كلِّ ذلّ، وأمناً من كلِّ خوف، وغنىٰ من كلِّ فقر، لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات»([319]).
7ـ أن يأخذ ثلاث مرات من تربة الحسين بثلاث أصابع، ويدعها في خرقة نظيفة، أو في قارورة زجاج ـ كما في الرواية الثانية ـ ثمّ يختمها بخاتم فضّة فصّه عقيق مكتوب عليه: ـ «ما شاء الله، لا قوّة إلّا بالله، استغفر الله».
فإذا علم الله منك صدق النيّة، يصعد معك في الثلاث قبضات سبعة مثاقيل لا تزيد ولا تنقص، ترفعها لكلّ علّة، وتستعمل منها وقت الحاجة مثل الحُمّصة، فإنّك تشفىٰ إن شاء الله تعالىٰ.
وقد رُويت الرواية الثانية أيضاً في (مجمع البحرين في مناقب السبطين)، وجاء فيها دعاء آخر غير ما تقدَّم في دعاء القنوت، وهو: «سبحان الله ملك السماوات السبع والأرضين السّبع، ومَن فيهنّ، ومَن بينهنّ، سبحان الله ربِّ العرش العظيم، وصلّىٰ الله علىٰ محمّد وآله، وسلام علىٰ المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين»([320]).
جاءت في بعض الروايات أدعية خاصّة في أخذ التربة الحسينيّة نذكرها تتميماً للفائدة، وهي إمّا بدل عمّا أُشير إليه في العنوان الأوّل، وإمّا أدعية خاصّة لأخذ التربة، وهي:
الأوّل: إذا أردت أن تأخذ من التربة للعلاج بها والاستشفاء، فتباك وقل: «بسم الله وبالله، بحقِّ هذه التربة المباركة، وبحقِّ الوصي الذي تواريه، وبحقِّ جدِّه وأبيه، وأُمِّه وأخيه، وبحقِّ أولاده الصادقين، وبحقِّ الملائكة المقيمين عند قبره، ينتظرون نصرته، صلِّ عليهم أجمعين، واجعل لي ولأهلي ووِلْدي وإخوتي وأخواتي فيه الشفاء من كلِّ داء، والأمان من كلّ خوف، وأوسع علينا به في أرزاقنا، وصحِّح به أبداننا، إنّك علىٰ كلّ شيء قدير، وأنت أرحم الراحمين، وصلّىٰ الله علىٰ محمد وعلىٰ آله الطيبين وسلَّم تسليماً»([321]).
الثاني: وإن شئت فقل: «اللّهمَّ، إنّي أسألك بحقِّ هذه التربة، وبحقِّ الملك الموكَّل بها، وبحقِّ مَن فيها، وبحقِّ النبي الذي خزنها، أن تصلِّي علىٰ محمد وآل محمد، وأن تجعل هذه التربة أماناً من كلِّ خوف و شفاءً لي من كلِّ داء، وسعةً في الرزق، إنّك علىٰ كلِّ شيء قدير»([322]).
الثالث: وإن شئت فقل: «اللّهمَّ، إنّي أسألك بحقِّ الجناح الذي قبضها، والكفّ الذي قلَّبها، والإمام المدفون فيها، أن تصلِّي علىٰ محمد وآل محمد، وأن تجعل لي فيه الشفاء والأمان من كلّ خوف»([323]).
الرابع: أن يقبِّل التربة ـ قبل كلّ شيء ـ ويضعها علىٰ عينيه، ولا يتناول منها أكثر من حُمّصة، فإذا تناولها فليقل: «اللّهمَّ، إنّي أسألك بحقِّ الملك الذي قبضها، وأسألك بحقِّ النبيّ الذي خزنها، وأسألك بحقِّ الوصي الذي حلَّ فيها، أن تصلِّي علىٰ محمد وآل محمد، وأن تجعله شفاءً من كلِّ داء، وأماناً من كلِّ خوف، وحفظاً من كلِّ سوء». فإذا قلت ذلك فاشددها في شيء وأقرأ عليها سورة(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)، فإنّ الدعاء الذي تقدَّم لأخذها هو استيذان عليها، وقراءة (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ) ختمها([324]).
الخامس: إذا أردت حمل طين قبر الحسين فأقرأ فاتحة الكتاب، والمعوّذتين، و(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)، و(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)، و(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ)، وآية الكرسي، ويس، ثمّ تقول: «اللّهمَّ، بحقِّ محمد عبدك ورسولك، وحبيبك ونبيّك وأمينك، وبحقِّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك، وبحقِّ فاطمة بنت نبيّك وزوجة وليّك، وبحقِّ الحسن والحسين، وبحقِّ الأئمّة الراشدين، وبحقِّ هذه التربة، وبحقِّ الملك الموكّل بها، وبحقِّ الوصي الذي هو فيها [الذي حلّ فيها]، وبحقِّ الجسد الذي ضمّت [الجسد الذي تضمّنت، وبحقِّ السبط الذي ضمّنت]، وبحقِّ جميع ملائكتك وأنبيائك ورسلك، صلِّ علىٰ محمد وآله، واجعل هذا الطين شفاءً لي ولـمَن يُستشفي به من كلّ داء وسقم ومرض، وأماناً من كلّ خوف، اللّهمَّ، بحقِّ محمد وأهل بيته اجعله عِلماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كلّ داء وسقم وآفة وعاهة، ومن جميع الأوجاع كلّها، إنّك علىٰ كلّ شيء قدير». وتقول: «اللّهمَّ، ربَّ هذه التربة المباركة الميمونة، والملك الذي هبط بها، والوصي الذي هو فيها، صلِّ علىٰ محمد وآل محمد، وانفعني بها، إنّك علىٰ كلّ شيء قدير»([325]). وهذه الرواية قد رواها أبو حمزة الثمالي عن الإمام الصادق.
الأمر التاسع: أسباب عدم تأثير التربة الحسينيّة في الشفاء
إنّ العَالَم قائم علىٰ نظام الأسباب والمسبّبات، فإذا وُجِد المقتضي وارتفع المانع يتحقّق المعلول الذي هو من سنخ المقتضي، وتربة الحسين ـ التي دلّ الدليل القطعي علىٰ أنّها سبب في الشفاء ـ لا تخرج عن هذا النظام، ولكن مع ذلك نجد مَن يتناول التربة المباركة ولمرّات عديدة مع بقاء المرض والسقم علىٰ حالهما، فهل هناك أسباب تؤثِّر سلباً في الاستشفاء بتربة الحسين؟
من الواضح أنّ الجواب بالإيجاب لا بالنفي؛ وذلك لوجود أسباب، ولعلّها متعدّدة، تحول بين تأثير التربة ورفع المرض، فالروايات التي تواترت بشأن حصول الشفاء في التربة المباركة، إنّما ذلك من باب الاقتضاء لا العلّية التامّة، فمع فقد الموانع يؤثِّر المقتضي أثره. وموانع تأثيرها كثيرة، خصوصاً في هذا العصر الذي زاد فيه هتك المقدَّسات وقلّة المبالاة بها.
حاصل أسباب عدم التأثير
وحاصل الأسباب ما يلي:
الأوّل: وضع التربة الحسينيّة في مواضع لا تليق بها، والاستخفاف بها؛ ممّا يُفسد التأثير المرجو منها، بحيث لا تؤثِّر في رفع الداء، وفي رواية أبي حمزة عن الإمام الصادق إشارة إلىٰ ذلك، فقد سُئل عن طين الحائر: هل فيه شيء من الشفاء؟ فقال: «يُستشفىٰ ما بينه وبين القبر علىٰ رأس أربعة أميال... فَخُذْ منها، فإنّها شفاء من كلِّ داء وسقم، وجُنّة ممّا تخاف، ولا يعادلها شيء من الأشياء الذي يُستشفى بها إلّا الدعاء، وإنّما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها... ولقد بلغني أنّ بعض مَن يأخذ من التربة شيئاً يستخفّ به، حتّىٰ أنّ بعضهم يضعها في مخلاة البغل والحمار، وفي وعاء الطعام والخرج، فكيف يستشفي به من هذا حاله عنده؟!»([326]).
ومن هنا؛ ورد في بعض الأخبار أنّ ماء الفرات شفاء إن لم يغتسل فيه الجُنب من الحرام، ولولا ما يدخله من الخطائين([327]).
الثاني: تأثير الأرواح الشريرة في إزالة أثر المقدَّسات مهما أمكنهم ذلك، ولا ريب في اهتمامهم بذلك، ولو عن طريق إيحائهم إلىٰ أوليائهم من الأنس بأنحاء التشكيكات فيها، ولعلّ من حِكَم الأدعية والآداب التي وردت عند إرادة الاستفادة منها، دفع تلك الأرواح الخبيثة؛ ولذا ورد في ذيل رواية سابقة أنّ الإمام قال: «وأمّا الشياطين وكفّار الجنّ فإنّهم يحسدون بني آدم عليها فيتمسّحون بها؛ ليذهب عامّة طيبها، ولا يخرج الطين من الحائر إلّا وقد استعدّ له ما لا يُحصىٰ منهم»([328]).
الثالث: أن يكون السبب هو تخلّف بعض شروط تناول التربة المباركة، وتقدَّم أنّه يجوز تناول التربة بشروط، أحدها: أن يكون مقدار التربة بحجم الحُمّصة. وثانيها: أن يكون تناول التربة بقصد الاستشفاء. وثالثها: أن يكون أخذ التربة بالدعاء والختم (علىٰ خلافٍ في هذا الشرط).
وعليه؛ عند تخلّف أحد الشروط ـ بأن تناول أكثر من مقدار حُمّصة، أو تناول التربة لا بقصد الشفاء، أو تناولها بدون الأدعية ـ فسوف لا تؤثِّر التربة أثرها؛ ولذا ورد عن الإمام الصادق قوله: «مَن أكل من طين قبر الحسين غير مستشفٍ به فكأنّما أكل لحومنا»([329]).
وجاء في حَسَنَة سدير عن الصادق: «ولا تناول منها أكثر من حُمّصة، فإن تناول منها أكثر من ذلك، فكأنّما أكل من لحومنا ودمائنا»([330]).
الرابع: ضعف الاعتقاد واليقين بكون تلك التربة سبباً للشفاء. فإنّ العنصر الغَيبي له دور في تحقّق الاستشفاء بتلك التربة المباركة، فمَن اعتقد اعتقاداً يقينيّاً بأنّ هذه التربة لها هذا التأثير، وتناولها بهذه العقيدة ـ اعتماداً منه علىٰ ما تقدَّم من الروايات والإخبارات والإجماع ـ فسوف تؤثِّر أثرها فيه، أمّا مَن تناولها ولم يعتقد بتأثيرها، وكانت عنده بدرجة بعض الأدوية المتعارفة، بل أقلّ منها، فإنّ الأثر المرجو منها سوف يقلّ، بل ينعدم، وكما قيل: «مَن اعتقد بحجرٍ كفاه».
ومن هنا؛ جاءت بعض الأدعية والسور كي تقوّي هذه العقيدة بتلك التربة، وترفع مستوىٰ اليقين والاعتقاد. وجاء في رواية ابن أبي يعفور أنّه قال: قلت لأبي عبد الله الصادق: يأخذ الإنسان من طين قبر الحسين فينتفع به ويأخذ غيره فلا ينتفع به؟ فقال: «لا والله، لا يأخذه أحدٌ وهو يرىٰ أنّ الله ينفعهُ به إلّا نفعه به»([331]).
الخامس: تخلّف شرط صدق التربة الحسينيّة. فقد تكون التربة التي فيها الشفاء محدّدة بحدود القبر وما جاوره، أو محدّدة بالحائر، وأمثال هذه الأقوال التي تحدّد صدق دائرة التربة الحسينيّة في مكان محدود.
وعليه؛ إذا تناول الشخص تربة معيّنة، وقد أُخذت من مسافة خارج الحدود المشار إليها، فقد لا تؤثِّر أثرها المرجو، فإنّ الأثر إنّما يتبع صدق العنوان وواقعيته، والمأخوذ من مثل هذه الأمكنة البعيدة لا ينطبق عليه العنوان المذكور ولا يؤثِّر أثره، بل قد ينطبق عليه حكم الحرمة، وشموله بالحكم الكلّي القائل بحرمة أكل الطين.
الأمر العاشر: الاستشفاء بتربة سائر الأئمّة
طرح الفقهاء في خصوص الاستشفاء بالتربة هذا السؤال:
هو هل يختصّ الاستشفاء بتربة الإمام الحسين أو يعمُّ تربة قبر النبي’ وسائر الأئمّة^ أيضاً؟
المشهور بين الفقهاء اختصاص جواز الاستشفاء بتربة قبر الإمام الحسين دون سائر قبور الأئمّة^([332]).
ويستدل علىٰ قول المشهور بما يأتي:
أ ـ إنّ مقتضىٰ الأصل هو الاقتصار علىٰ تربة قبر الإمام الحسين؛ لأنّ الأصل في أكل الطين أو التراب هو الحرمة، خرج منه طين قبر الإمام الحسين؛ لدلالة الروايات المستفيضة علىٰ الجواز، ويبقىٰ ما عداه علىٰ الحرمة.
ب ـ إنّ الروايات الصحيحة والمستفيضة إنّما خصّت الجواز بطين قبر الإمام الحسين، في حين أنّ ما دلّ علىٰ الجواز في غير تربته فهو ـ علاوةً على قلّته ـ إمّا ضعيف السند وإمّا غير واضح من حيث الدلالة.
ج ـ النهي الوارد في رواية (عيون أخبار الرضا) بسند متّصل إلىٰ الإمام موسىٰ بن جعفر الكاظم قال: «... ولا تأخذوا من تربتي شيئاً لتتبرّكوا به، فإنّ كلّ تربة لنا محرّمة إلّا تربة جدِّي الحسين بن علي‘...الرواية»([333]).
د ـ ما رُوي في (علل الشرائع) من أنّ: «مَن أكل طين الكوفة فقد أكل لحوم النّاس...»([334]).
وفي قبال قول المشهور توجد روايتان قد تدلّان علىٰ الجواز، وهما:
الأُولىٰ: رواية أبي حمزة الثمالي عن الإمام أبي عبد الله الصادق في حديث: «أنّه سُئل عن طين الحائر هل فيه شيء من الشفاء؟ فقال []: يُستشفىٰ ما بينه وبين القبر علىٰ رأس أربعة أميال، وكذلك قبر جدِّي رسول الله’، وكذا طين قبر الحسن وعلي ومحمد، فخذ منها فإنّها شفاء من كلّ داء وسقم وجُنّة ممّا تخاف...»([335]).
الثانية: رواية محمد بن مسلم المروية عن الإمام أبي عبد الله الصادق والوارد فيها: «... يا محمد، إنّ الشراب الذي شربته كان فيه من طين آبائي، وهو أفضل ما نستشفي به فلا تعدل به فإنّا نسقيه صبياننا ونساءنا فنرىٰ منه كلّ خير»([336]).
وتُناقش هاتان الروايتان بما يلي:
أ ـ أنّهما ضعيفتا السند.
ب ـ حمل العلّامة المجلسي الرواية الأُولىٰ علىٰ مجرّد الأخذ والاستصحاب للتربة دون الأكل.
ج ـ إنّ الرواية الثانية لا تدلّ علىٰ جواز أكل الطين، بل الظاهر منها أنّه قد حلّه في شربة، ثمّ بعثه لمحمد بن مسلم ليستشفي به، وهذا لا إشكال به؛ لأنّ الطين قد استهلك وتلاشىٰ في الماء، وهذا هو أحد الحلول المطروحة في جواز تناول مثل هذا الطين.
د ـ بناءً علىٰ أنّ المحرَّم هو خصوص الطين دون التراب، فإنّه يجوز الاستشفاء به ولو كان من غير قبر الحسين، وكذا يجوز استصحاب الطين والطلاء به، أو الضماد به وما شاكل ذلك؛ لأنّ هذا لا يُعدّ من الأكل.
والخلاصة: إنّ أدلّة الحرمة هي الأقوىٰ؛ نظراً لتماميتها وضعف أدلّة الجواز([337]).
حكم الإفطار يوم العيد على التربة الحُسينيّة
أجمعت الإماميّة علىٰ حرمة أكل الطين؛ لما فيه من الإضرار بالبدن، وللإجماع، وللنصوص المستفيضة الواردة عن أهل البيت^ التي تنهىٰ بأشدّ العبارات عن أكله([338]).
منها: ما رُوي عن الواسطي عن أبي عبد الله: «الطين حرام كلّه كلحم الخنزير، ومَن مات فيه لم أصلِّ عليه، إلّا طين القبر، فإنّ فيه شفاء من كُلّ داء، ومَن أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء»([339]).
وقد استثنىٰ فقهاء الإماميّة من هذه الحرمة طين تربة الإمام الحسين؛ للاستشفاء بقدر حُمّصة، وهذا لا إشكال فيه عندهم؛ للأخبار الكثيرة الدالّة عليه.
ومن الأُمور التي استثناها بعض الفقهاء هو الإفطار يوم العيدين علىٰ شيء من التربة الحسينيّة، فقد ذكروا بأنّه يجوز للمكلَّف الصائم قبل الذهاب إلىٰ صلاة العيد أن يتناول شيئاً من التمر أو شيئاً حُلواً كالسكّر([340])، وأضاف إليه الإفطار علىٰ التربة المباركة.
وأيضاً يجوز الإفطار يوم العاشر من الـمُحرّم بعد صومه إلىٰ وقت محدَّد علىٰ تلك التربة المباركة.
وتحقيق المسألة يتوقّف علىٰ ذكر بعض الأُمور:
الأمر الأوّل: القول بالجواز وكلمات الفقهاء فيه
الظاهر أنّ أوّل مَن قال بالجواز هو الشيخ الطوسي في (المصباح)([341])، وقوّىٰ المجلسي في (البحار)([342]) القول بالجواز تبعاً لبعض الروايات، ثمَّ قال: بأنّ الاحتياط يقتضي الترك.
وحدّد السيّد العاملي والأردبيلي([343]) الجواز بقصد الاستشفاء، فمَن تناول شيئاً من التربة المباركة يوم العيد أو يوم عاشوراء بقصد الاستشفاء، فإنّ ذلك جائز له، وإلّا فلا يجوز.
ولم أجد ـ بحدود تتبّعي ـ مَن قال بالجواز غير هذين العلمين، ومنع سائر الفقهاء من تناول التربة بأيّ قصدٍ كان.
ودليلهم علىٰ المنع صنفان:
الأوّل: إنّ الروايات الواردة في القول بالجواز إمّا ضعيفة السند، أو هي من الروايات الشاذّة.
الثاني: إنّ الإجماع من قِبل الإماميّة قائم علىٰ حرمة أكل الطين مطلقاً ـ وفي جميع الحالات ـ إلّا ما خرج بالدليل، والدليل قد دلّ علىٰ جواز تناولها للاستشفاء فقط دون غيره.
الأمر الثاني: أدلّة القائلين بالجواز ومناقشتها
يمكن حصر أدلّة القائلين بالجواز بما يلي:
1ـ الرواية الدالّة علىٰ جواز الأكل تبرّكاً ظهر يوم عاشوراء، وهي ما ذكره الشيخ في (مصباح المتهجِّد) بقوله: «ويُستحب صيام هذا العشـر، فإذا كان يوم عاشوراء أمسك عن الطعام والشـراب إلىٰ بعد العصر، ثمَّ يتناول شيئاً من التربة»([344]).
ولم يذكر الشيخ المجلسي في كتاب (البحار) دليلاً سواها في هذا الحكم([345]).
2ـ ما رواه محمد بن يعقوب الكليني، عن الحسين بن محمد، عن الحرّاني، عن علي ابن محمد النوفلي، قال: قلت لأبي الحسن: إنّي أفطرت يوم الفطر علىٰ طين وتمر، فقال لي: «جمعت بركة وسُنَّة»([346]).
ورواه الشيخ الصدوق باللفظ نفسه بسنده عن علي بن محمد النوفلي([347]).
وكيفيّة الاستدلال هي ما انتصر به البحراني للمجلسي، فقد قال: إنّ روايات المنع من الأكل وإن كانت صحيحة السند ومطلقة، إلّا أنّ أمثال هذه الروايات تكون مخصّصة للإطلاقات الناهية عن أكل مطلق الطين، خصوصاً وأنّ المجلسي حسب طريقته في الأخبار يُلغي أمثال هذه المصطلحات من الضعيف والحسن والصحيح والموثّق، وله طريقته الخاصّة في قبول الروايات.
خالف مشهور الفقهاء([348]) ما عليه الطوسي والمجلسي، وقالوا بالتحريم إلّا مع قصد الاستشفاء، وناقشوا جميع أدلّة القائلين بالجواز، ونكتفي هنا بنقل ثلاثة نصوص تُبيِّن ضعف دليل هؤلاء:
1ـ قال الفاضل الهندي& ـ بعد ذكره رواية النوفلي ـ: «قلتُ: لعلّه [أي: النوفلي الذي سأله الإمام] استشفىٰ بها عن علّة كانت به. ثمَّ قال: وفي السرائر: إنّه روىٰ الإفطار فيه علىٰ التربة المقدَّسة، وأنّ هذه الرواية شاذّة من أضعف أخبار الآحاد؛ لأنّ أكل الطين علىٰ اختلاف ضروبه حرام بالإجماع، إلّا ما خرج بالدليل من أكل التربة الحسينيّة (علىٰ متضمِّنها أفضل السلام) للاستشفاء فحسب ـ القليل منها دون الكثير ـ للأمراض، وما عدا ذلك فهو باقٍ علىٰ أصل التحريم والإجماع»([349]).
وقال صاحب الجواهر: «إنّما يجوز أكل طين القبر للاستشفاء دون غيره، ولو للتبرّك في عصر يوم عاشوراء ويومي عيدي الفطر والأضحىٰ، كما هو صريح بعض وظاهر الباقين، خلافاً للمحكي عن الشيخ في (المصباح)، فجوّزه لذلك في الأوقات الثلاثة ـ المشار إليها ـ لكن لم نقف له علىٰ حجّة، فضلاً عن أن تكون صالحة لمعارضة إطلاق النصّ والفتوىٰ، مضافاً إلىٰ قول الصادق في خبر حنان: مَن أكل طين قبر الحسين غير مستشفٍ به فكأنّما أكل من لحومنا»([350]).
وقال الهمداني: «وأمّا الإفطار بتربة الحسين، فقد دلّ علىٰ استحبابها خبر النوفلي، والمرسل المروي في الرضوي، ولكن حيث دلّت الأدلّة المعتبرة علىٰ حرمة أكلها إلّا للاستشفاء لم يَجُزْ المسامحة فيها، فيشكل حينئذٍ إثبات جواز الإفطار بها بمثل هذه الروايات مع ما في سندها من الضعف، وكونها مرمية بالشذوذ في عبائر كثير منه، واحتمال كون الراوي الذي أجابه الإمام بقوله: جمعت بركة وسنّة. مريضاً قاصداً بالإفطار بها البركة والاستشفاء، فالقول بالمنع عنه ـ كما لعلّه المشهور ـ مع أنّه أحوط لا يخلو من قوّة»([351]).
وخلاصة دليلهم ما يلي:
أ ـ قوّة أدلّة القول بالتحريم لكثرتها وصحّة سندها، وضعف أدلّة القول بالحرمة، بل ورميها بالشذوذ، هذا من حيث السند.
ب ـ ومن حيث الدلالة، يمكن حمل الروايات المجوّزة علىٰ أنّ السائل مريض، ويقصد بتناول التربة الاستشفاء والإمام قد جوّز له ذلك، وهذا لا ضير فيه كما سوف يأتي.
حكم التحرّز بالتُّربة الحسينيّة
يُستحب للمسافر وغيره استصحاب شيء من تربة الحسين التي هي أمان من كُلّ خوف وشفاء من كُلّ داء، وخصوصاً إذا أخذ السبحة من تربته ودعا بدعاء المبيت علىٰ الفراش ثلاث مرات، ثمّ قبّلها ووضعها علىٰ عينه، وقال: «اللّهمَّ، إنّي أسألك بحقّ هذه التربة، وبحقِّ صاحبها، وبحقِّ جدِّه وأبيه، وأُمّه وأخيه، وبحقِّ وُلْده الطاهرين، اجعلها شفاءً من كُلّ داء، وأماناً من كُلّ خوف، وحفظاً من كُلّ سوء، ثمّ وضعها في جيبه، فإنّ مَن فعل ذلك في الغداة لا يزال في أمان الله حتىٰ العشاء، وإن فعل ذلك في العشاء فلا يزال في أمان الله حتىٰ الغداة، وإن خاف من سلطان أو غيره وخرج من منزله واستعمل ذلك كان حرزاً له»([352]).
«ويُستحب جعل تربة الحسين في المتاع لحفظه، وإنّه أمان من كُلّ شرِّ»([353]).
ولا يستبعد الشاك هذه الآثار والأحكام لهذه التربة المباركة؛ وذلك لما حباها الله تعالىٰ، وميَّزها وشرَّفها علىٰ غيرها، وجعل لها خواصاً اختصّت بها دون غيرها.
وممّا يدلّ علىٰ ذلك روايات عدّة:
منها: ما رواه السيّد ابن طاووس في (الأمان من أخطار الأسفار والأزمان) وفي (مصباح الزائرِ) عنِ الصادق: أنّه قيل له: «تربة قبرِ الحسين شفاءٌ من كلّ داءٍ، فهل هي أمان من كلّ خوفٍ؟ فقال: نعم إِذا أراد أحدكم أن يكون آمناً من كلّ خوفٍ فليأخُذ السبحة من تربته، ويدعو بِدعاء المبِيت علىٰ الفراشِ ثلاث مرّاتٍ، ثمّ يُقبِّلها ويضعها علىٰ عينيه...»([354]).
ومنها: ما رواه الشيخ الطوسي في (التهذيب) و(الاستبصار)، عن محمد بن أحمد ابن يحيىٰ، عن محمد بن عيسىٰ اليقطيني، قال: «بعث إليّ أبو الحسن الرضا رزم ثياب وغلماناً وحجّة لي وحجّة لأخي موسىٰ بن عبيد، وحجّة ليونس بن عبد الرحمن، فأمرنا أن نحجّ عنه، فكانت بيننا مائة دينار، أثلاثاً فيما بيننا، فلمّا أردت أن أُعبّي الثياب رأيت في أضعاف الثياب طيناً، فقلت للرسول: ما هذا؟ فقال: ليس يوجّه بمتاع إلّا جعل فيه طيناً من قبر الحسين. ثمّ قال الرسول: قال أبو الحسن: هو أمان بإذن الله»([355]).
ومنها: ما رواه الشيخ الطوسي في (التهذيب) عن محمد بن أحمد بن داوُد، عن الحسن بن محمد بن علان، عن حميد بن زياد، عن عبد الله بن نهيك، عن سعد بن صالح، عن الحسن بن علي، عن أبي المغيرة، عن بعض أصحابنا، قال: «قلت لأبي عبد الله: إنّي رجل كثير العلل والأمراض وما تركت دواءً إلّا تداويت به. فقال لي: وأين أنت عن طين قبر الحسين؟! فإنّ فيه الشفاء من كلِّ داء، والأمن من كلِّ خوف. قلت: قد عرفت الشفاء من كلّ داء، فكيف الأمان من كلِّ خوف؟ قال: إذا خفت سُلطاناً أو غير ذلك فلا تخرج من منزلك إلّا ومعك من طين قبر الحسين، وقل إذا أخذته: اللّهمَّ، إنّ هذه طينة قبر الحسين وليّك وابن وليِّك، أخذتها حرزاً لما أخاف وما لا أخاف...
أخذتها كما قال ليّ؛ فأصحَّ الله بدني، وكان لي أماناً من كلِّ خوف ممّا خفت وما لم أخف، كما قاله. قال: فما رأيت بحمد الله بعدها مكروهاً»([356]).
هذا، وتوجد مسألتان لهما ارتباط بهذا المبحث سوف نقوم بتفصيل الحديث حولهما فيما يلي:
المسألة الأُولى: حكم تجهيز الميت بالتربة الحسينيّة
يُجهّز الميت بالتربة الحسينيّة في مواضع عديدة، نستعرضها ضمن فروع:
الفرع الأوّل: وضع التربة الحسينيّة مع حنوط الميت
امتازت الشريعة الإسلاميّة عن غيرها من الشرائع باحترام الإنسان، سواء أكان حياً أم ميتاً، ولم تفرِّق بين احترامه حياً أو ميتاً، والأحكام التي ترافق الميت من حين احتضاره إلىٰ ما بعد دفنه لا تقلّ أهمية ـ من حيث المضمون والعدد ـ عن الأحكام في حال وجوده في هذه الدنيا، ولعلّ السرَّ في ذلك هو أنّ الموت لا يُعتبر فناءً لهذا الكائن، بل هو مرحلة يمرّ بها، فهو انتقالٌ من دارٍ إلىٰ دارٍ أُخرىٰ، وله نوع تعلّقٍ بالحياة التي فارقها، من ناحية وصول الثواب إليه من ذويه، وزيارته لأهله في كلّ جمعة كما ورد في بعض الروايات، واحتياجه للثواب من أهله، وغير ذلك.
ولذا ورد عنهم^: «إنّ حُرمة الميت كحُرمة الحي»([357]).
ومن الأُمور التي يستفيد منها الميت بعد مفارقته لهذه الحياة تغسيله بعد الموت مباشرةً؛ لذا أوجبت الشريعة الإسلاميّة تغسيل الميت علىٰ نحو الكفاية، وللغسل كيفية خاصّة مذكورة في كتب الرسائل العملية وغيرها، وحكمت الشـريعة أيضاً بوجوب تحنيطه بعد غسله، والمراد بالتحنيط هنا هو: مسح أعضاء السجود السبعة ـ الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين ـ بالكافور، ويجب أن يكون ذلك الكافور مسحوقاً.
ومن مستحبات التحنيط أن يُخلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين، ولمعرفة حكم الاستحباب ودليله لا بدّ من الإشارة إلىٰ ثلاث نقاط:
النقطة الأُولى: القول باستحباب وضع التربة مع الكافور، وكلمات العلماء فيه
قال البحراني& ـ وهو بصدد بيان مستحبات التكفين ـ: «ومنها: وضع التربة الحسينيّة (علىٰ مشرّفها أفضل الصلاة والسلام والتحية) في حنوط الميت...»([358]).
وقال السيّد اليزدي&: «يُستحب خلط الكافور بشيءٍ من تربة الحسين، لكن لا يُمسح به المواضع المنافية للاحترام»([359]).
وقال الشيخ زين الدين&: «يُستحبّ أن يُخلط الحنوط بشـيءٍ من تربة الحسين، علىٰ وجهٍ لا يخرج به عن اسم الكافور، وينبغي أن يتجنّب وضع المخلوط بها علىٰ المواضع التي تُنافي الاحترام، كإبهاميّ الرجلين...»([360]).
وقد وافق عبارة السيّد اليزدي& في (العروة الوثقىٰ) كلّ مَن علّق عليها.
فالحكم بالاستحباب ـ وهو خلط الكافور بتربة الحسين ـ هو المعروف بين المعاصرين ومَن قارب عصرهم، بحيث لم نجد مخالفاً بينهم بحدود اطّلاعنا القاصر([361]).
النقطة الثانية: أدلّة القول بالاستحباب
استُدلّ للقول بالاستحباب بدليلين:
الدليل الأوّل: ما رواه الشيخ الطوسي& في (التهذيب) بسنده عن محمد بن أحمد ابن داوُد، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال: «كتبت إلىٰ الفقيه أسأله عن طين القبر يُوضع مع الميت في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب ـ وقرأت التوقيع ومنه نسخت ـ: توضَع مع الميت في قبره، ويُخلَط بحنوطه، إن شاء الله»([362]).
ورواه الطبرسي& أيضاً في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن صاحب الزمان# مثله([363]).
والمراد بالفقيه في رواية (التهذيب) الإمام المهدي# بقرينة رواية الطبرسي.
والمراد بالطين المذكور في الرواية هو الطين المعهود بالتبرّك، وهو طين قبر الحسين، والقرينة في ذلك ظاهرة، وقد فهم الشيخ الطوسي ذلك أيضاً؛ فقد أورده في جملة أحاديث تربة الحسين([364]).
الدليل الثاني: وهو ما ذكره السيّد السبزواري بقوله: «إنّ تربة قبر الإمام الحسين ممّا يُرجىٰ فيه الأمان؛ فيُستحب وضعها مع الكافور لذلك»([365]).
وبتعبير الشيخ محمد تقي الآملي: «إنّ وضع التربة مع الكافور فيه استشفاع واستدفاع، فيدلّ كلّ ما ورد في الاستشفاع بتربة الحسين الزكية علىٰ رجحانه»([366]).
الأوّل: لا يجوز مسح الكافور المخلوط بتربة الحسين علىٰ مواضع الميت التي تُنافي احترام تلك التربة المباركة، كإبهاميّ الرجلين، وباطن القدمين، وظاهرهما، وأمثال ذلك؛ لأنّ ذلك هو الموافق لمرتكزات المتشرّعة، ولوجوب صون التربة عن كلّ ما ينافي احترامها؛ لورود الأمر بوجوب احترامها وتعظيمها.
الثاني: أن لا يؤدّي خلط التربة الحسينيّة بالكافور إلىٰ خروجه عن إطلاق اسم الكافور عليه، بل يُخلط الكافور بكمّية قليلة من التربة بحيث يبقىٰ معها إطلاق اسم الكافور عليه([367]).
الفرع الثاني: الكتابة بتربة الحسين× على الكفن
من السُّنن والمستحبات في تجهيز الميت أن يُكتب اسم الميت ـ قيل: واسم أبيه أيضاً ـ علىٰ الكفن، وأنّه يشهد الشهادتين، أي: يُكتب علىٰ الأكفان: إنّ فلاناً يشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمداً رسول الله’، وأن يُضيف إليهما كتابة اسم النبي’ وأسماء الأئمّة^، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ، ويدلّ علىٰ ما تقدَّم دعوىٰ الإجماع، والسيرة العملية من المتشـرِّعة، وأنّ ذلك كلّه من طرق التوسّل واستجلاب الخير والبركة.
وزاد بعض الفقهاء استحباب كتابة القرآن ودعاء الجوشن الصغير والكبير، وبعض الكتابات الأُخرىٰ([368]).
ثمّ ذكروا بأنّه يُستحب أن تكون الكتابة علىٰ الكفن بتربة الحسين، ويتّضح الكلام في هذه المسألة من خلال بيان نقاط:
النقطة الأُولى: استحباب الكتابة بتربة الحسين×
القول باستحباب كتابة اسم الميت والأدعية المتقدِّمة علىٰ كفن الميت بتربة الإمام الحسين ذَكَرهُ كلّ من الشيخ المفيد والشيخ الطوسي([369])، وتبعهُ كلّ مَن تطرَّق لهذه المسألة من الفقهاء، ونسبة الحكم إلىٰ الفقهاء صرّح به كلّ من الكركي والهندي، قال الكركي& ـ بعد نقله عبارة العلّامة ـ: «استحباب الكتابة بتربة الحسين ذكره الأصحاب»([370]). وقال الهندي&: «وليكتب بتربة الحسين إن وُجد، ذكره الشيخان وتبعهما الأصحاب، وهو حَسن...»([371]).
وقد وافق عبارة (العروة الوثقىٰ) ـ الآتية في حصول ذلك ـ كلّ المعلِّقين، إمّا بذكر الدليل الذي يُمكن أن يستدلّ علىٰ الاستحباب، وإمّا بالسكوت تأييداً لما ذكره السيّد اليزدي، قال& ـ بعد ذكر ما يُستحب كتابته علىٰ الكفن ـ: «والأَوْلىٰ أن يُكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين، أو يُجعل في المداد شيء منها، أو بتربة سائر الأئمّة»([372]).
وصرّح العلّامة الحلي في المختلف بأنّ هذا الحكم هو المشهور([373]).
النقطة الثانية: مقدار ما يُكتب عليه من الكفن
اختلفت كلمات فقهاء الإمامية في المقدار الذي يُكتب عليه من الأكفان، من الأذكار واسم الميت المتقدِّم ذكرها.
الذي نسبه العلّامة إلىٰ المشهور أنّه يُستحب أن تُكتب تلك الأذكار علىٰ الأكفان والجريدتين، ولعلّ هذا القول هو أوسع الأقوال هنا؛ فقد أطلق لفظ (الأكفان) الذي يشمل جميع قِطَعِه الواجبة والمستحبة.
وذهب جماعة إلىٰ أنّ استحباب الكتابة علىٰ الأكفان يشمل فقط: الحبرة، والقميص، والإزار، والجريدتين، والعمامة. واقتصر جماعة علىٰ الأربعة الأُولىٰ دون العمامة.
وزاد بعض الفقهاء علىٰ ما تقدَّم: العمامة، فجعلها ممّا يُكتب عليه، ولكنّه في الوقت نفسه لم يأتِ علىٰ ذكر الجريدتين.
واقتصر آخر علىٰ ذكر الأكفان دون غيرها.
وذكر بعضٌ أنّ المستحب هو الجريدتان، والقميص، والإزار، والحبرة، والعمامة، دون المواضع التي يستقبحها العقل لسوء الأدب، فلا يُكتب علىٰ المئزر إلّا علىٰ ما يحاذي الصدر والبطن، فالذي يقرب من القُبل والدُّبر تُستثنىٰ من الكتابة عليها.
وقال بعضٌ: إنّه يُكتب علىٰ الجريدتين والحبرة والقميص، وترك الإزار.
وقال آخر: إنّه يُكتب علىٰ الجريدتين والقميص والإزار، وترك الحبرة، وظاهرهُ دعوىٰ الإجماع عليه([374]).
وصرّح الشهيد الثاني بالاستحباب لجميع الأكفان بقوله: «وأضاف الشهيد [أي: الشهيد الأول]: المئزر، والكلّ جائز، بل لو كُتب علىٰ جميع الأقطاع فلا بأس؛ لثبوت أصل المشروعيّة، وليس في زيادتها إلّا زيادة الخير إن شاء الله تعالىٰ»([375]).
والفتوىٰ في الوقت الحاضر ـ وهو المشهور علىٰ ما صرّح به الشيخ الأنصاري ـ هو: «أن يُكتب علىٰ حاشية جميع قطع الكفن من الواجب والمستحب حتىٰ العمامة... والجريدتين»([376]).
النقطة الثالثة: أدلّة القائلين بالاستحباب
إنّ القول باستحباب أن تكون الكتابة علىٰ الكفن بتربة الحسين هو المنسوب إلىٰ الفقهاء، والظاهر منه عدم الخلاف أو الإجماع.
هذا وقد استُدلّ للاستحباب المذكور بأنّ الكتابة بتربة الحسين علىٰ الأكفان ممّا يُرجىٰ فيها الحفظ والأمان، وهي أمانٌ من كلّ خوف كما في الحديث، والكتابة بالتربة يُعدُّ أيضاً من الأُمور التي يُتبرّك بها.
كما أنّ الكتابة بالتربة يُعتبر جمعاً بين مندوبين وهما: الكتابة، وجعل التربة مع الميت.
والمستفاد من المروي في كتاب (الاحتجاج) في التوقيع الخارج عن صاحب الزمان# في جواب مسائل الحميري: فإنّه سأله عن طين القبر يُوضع مع الميت في قبره، هل يجوز ذلك أو لا؟ فأجاب: «يوضَع مع الميت، ويُخلط بحنوطه إن شاء الله»([377]). وعبَّر عنه الشيخ صاحب الجواهر بالصحيح([378]).
وكتب الحميري أيضاً إلىٰ صاحب الزمان#: «رُويَ لنا عن الصادق أنّه كتب علىٰ إزار إسماعيل ابنه: إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا الله. فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ فأجاب: يجوز ذلك»([379]).
النقطة الرابعة: كيفيّة الكتابة بالتربة الحسينيّة
ذكر جملة من الفقهاء ـ تفريعاً علىٰ أصل الكتابة بتربة الحسين علىٰ الكفن ـ أنّه ينبغي أن تُبلّ التربة الحسينيّة بالماء لتكون الكتابة مؤثرة بالكفن، فلكي تؤثّر التربة بالكفن، وتكون الكتابة بارزة وواضحة يُشترط أن تُبلّ بمقدار من الماء؛ لأنّ حقيقة الكتابة لا تتحقّق إلّا بذلك.
والظاهر أنّ مراد جميع الفقهاء ذلك، سواء المصرّح منهم بهذا أو الذين أطلقوا القول؛ للسبب المتقدِّم ذكره([380]).
الفرع الثالث: وضع التربة الحسينيّة مع الميت في القبر
ذكر الفقهاء أنّ من مستحبات تجهيز الميت هو وضع التربة الحسينيّة مع الميت في القبر. وإليك تفاصيل المسألة ضمن نقاط:
النقطة الأُولى: القائلون بالاستحباب في المسألة
إنّ أوّل القائلين بهذه المسألة هما الشيخ المفيد والشيخ الطوسي (رحمهما الله): وهو المشهور بين المتقدِّمين من فقهائنا، بل صرَّح بعضٌ بأنّه لا يوجد خلاف في القول بالاستحباب.
قال الشهيد الأوّل& ـ وهو بصدد ذكر مستحبات كيفية الدفن ـ: «يُستحب وضع التربة معه، قاله الشيخان ـ المفيد والطوسي ـ ولم نعلم مأخذه، والتبرّك بها كافٍ في ذلك، والأحسن جعلها تحت خدّه، كما قاله المفيد في المقنعة»([381]).
وقال الشيخ الطوسي&: «ويُستحبّ أن يجعل معه شيء من تربة الحسين»([382]).
وقال صاحب المدارك& ـ تعليقاً علىٰ كلام العلّامة&: «ويُجعل معهُ شيء من تربة الحسين» ـ: «ذكر ذلك الشيخان، ولم أقف لهما علىٰ مأخذ سوىٰ التبرّك بها، ولعلّه كافٍ في ذلك، واختلف قولهما في موضع جعلها...»([383]).
وقال البحراني& ـ وهو بصدد ذكر مستحبات الدفن ـ: «منها: وضع التربة الحسينيّة (علىٰ مشرِّفها أفضل الصلاة والسلام والتحية) معه، وهذا الحكم مشهور في كلام المتقدِّمين، ولكن مستنده خفيٌّ علىٰ المتأخّرين ومتأخّريهم، قال في المدارك وقبله الشهيد في الذكرىٰ والعلّامة وغيرهما: ذكر ذلك الشيخان...»([384]).
وقال صاحب (مفتاح الكرامة)& ـ تعليقاً علىٰ كلام العلّامة&: «(وجعل شيء من تربة الحسين معه). لا أجد في هذا خلافاً؛ لأنّها أمان من كلّ خوف، وفي المعتبر: ويُحلّ عقد كفنه، ويُجعل معه تربة. وعليه اتفاق الأصحاب، وظاهره دعوىٰ الإجماع علىٰ الأمرين، لكن يظهر من آخر كلامه، حيث يقول: وأمّا وضع التربة ففتوىٰ الشيخين: أنّ الإجماع علىٰ الأوّل، فتأمّل»([385]).
وقال صاحب الجواهر&: «ومنها أن يُجعل معه شيء من تربة الحسين علىٰ ما ذكره الأصحاب من غير خلاف يُعرف فيه، فلعلّ شهرته بينهم، والتبرّك بها، وكونها أماناً من كلّ خوف، وما في الفقه الرضوي... كافٍ في ثبوته، مضافاً إلىٰ الصحيح المروي عن الحميري...»([386]).
والقول بالاستحباب هو الذي أفتىٰ به المعاصرون، كما في رسائلهم العملية، وغيرها من كتب الفتوىٰ([387]).
النقطة الثانية: أدلّة القول بالاستحباب
أدلّة القول باستحباب وضع التربة مع الميت واضحة ومتعدّدة، ولكن رغم ذلك نجد أنّ العاملي في (مدارك الأحكام) ـ بعد أن نسب القول بالاستحباب إلىٰ الشيخين ـ قال: «لم نقف لهما علىٰ مأخذ»([388]). وتبرّع لهم بأنّ المدرك الوحيد هو التبرّك بالتربة، وهذا يكفي لإثبات الاستحباب.
وهذا اعتراف منه بعدم وجود دليل سوىٰ الدليل الذي تبرّع به، ولكنّ هذه الدعوىٰ مجانِبة للحقيقة، فبالإضافة إلىٰ كون الحكم مشهور بين الفقهاء، بل عليه دعوىٰ عدم الخلاف بينهم([389])، ذُكر له أدلّة أُخرىٰ، وهي كالآتي:
1ـ ما رواه الشيخ الطوسي في أبواب المزار من كتاب (التهذيب) في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال: «كتبت إلىٰ الفقيه أسأله عن طين القبر يُوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب ـ وقرأت التوقيع ومنه نسخت ـ: يُوضع مع الميت في قبره ويُخلط بحنوطه إن شاء الله تعالىٰ»([390]).
وقد رواه الطبرسي في (الاحتجاج)([391]) عن محمد بن عبد الله، عن أبيه، عن صاحب الزمان#.
2ـ ما رواه الشيخ الطوسي& في (مصباح المتهجِّد) عن جعفر بن عيسىٰ أنّه سمع أبا الحسن يقول: «ما علىٰ أحدكم إذا دفن الميت ووسّده التراب أن يضع مقابل وجهه لَبِنَة من الطين، ولا يضعها تحت رأسه»([392]).
والظاهر أنّ المراد من (الطين) المذكور في الرواية هو (طين قبر الحسين)، ومن هنا أورده الشيخ الطوسي في جملة أحاديث (تربة الحسين).
ولعلّ اختيار هذه العبارة المجملة من قِبَل الإمام؛ لأجل التقيّة التي كانوا يعيشونها آنذاك، أو لكون هذا الإطلاق علىٰ التربة الحسينيّة كان شائعاً في ذلك الزمان، ومعلومية المراد منه عند السامع([393]).
3ـ النصّ الوارد في (فقه الرضا) قال: «ويجعل معه في أكفانه شيئاً من طين القبر وتربة الحسين بن علي÷»([394]).
4ـ ما رُوي عن (منتهىٰ المطلب) و(تذكرة الفقهاء) و(نهاية الأحكام) قال: «إنّ امرأة كانت تزني وتضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفاً من أهلها، ولم يعلم به غير أُمّها، فلمّا ماتت دُفنت فانكشف التراب عنها، ولم تقبلها الأرض، فنُقلت من ذلك المكان إلىٰ غيره، فجرىٰ لها ذلك، فجاء أهلها إلىٰ الصادق وحكوا له القصة، فقال لأُمّها: ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي؟ فأخبرته بباطن أمرها، فقال الصادق: إنّ الأرض لا تقبل هذه؛ لأنّها كانت تعذِّب خلق الله بعذاب الله، اجعلوا في قبرها شيئاً من تربة الحسين، فَفُعِلَ ذلك بها فسترها الله تعالىٰ»([395]).
وقال الكركي ـ وهو بصدد معالجة سند الرواية ـ: إنّ الرواية الأخيرة مشتهر مضمونها، فتُقبل وإن ضُعِّفت، بل يُقبل الضعيف في روايات السُّنن مطلقاً([396]).
5ـ الروايات الواردة بلسان: إنّ تربة الحسين أمان من كلّ خوف. وهذا يكفي دليلاً للاستحباب، فإنّ الميت بعد انقطاعه عن هذه الدنيا يمرّ بحالات من ظلمة القبر، والوحدة، وضغطة القبر، وغيرها من الأهوال التي يحتاج معها إلىٰ الأمان، والتخفيف من الوحشة والعذاب والحساب، ومن هنا ورد أنّ ابن آدم إذا مات قامت قيامته([397]).
والنصوص الدالّة علىٰ هذه الحقيقة هي ما ورد في كتاب كامل الزيارات، في الباب الثاني والتسعين، تحت عنوان: (إنّ طين قبر الحسين شفاء وأمان)، فعن الإمام الصادق أنّه قال: «إنّ في طين الحائر الذي فيه الحسين شفاءً من كلّ داءٍ وأماناً من كلّ خوفٍ»([398]).
المسألة الثانية: حكم تحنيك المولود بالتربة الحسينيّة
إنّ للشريعة المقدّسة اهتماماً خاصاً بالمولود، فقد شرّعت له سنن وآداب عدّة، بعضها مُستحب، وبعضها واجب، وهي:
1ـ غسل المولود.
2ـ الأذان في أُذنه اليمنىٰ والإقامة في اليسرىٰ.
3ـ أن يُعقّ عنه بشاة.
4ـ حلق رأسه، والتصدّق عنه بما يعادل وزن شعره من الذهب أو الفضة.
5ـ تسميته بالأسماء الحسنة.
6ـ ختانه.
7ـ تحنيكه.
وغيرها من الأُمور المذكورة في الكتب الفقهية([399]).
وقد وردت روايات كثيرة عن الخاصّة والعامّة تؤكّد استحباب هذه السنن، بل توجب بعضاً منها. وأحد هذه السنن هو التحنيك، وهو مورد الكلام في هذه المسألة.
ولكي نستوعب أطراف المسألة لا بدّ من التطرّق إلى نقاط عدّة:
النقطة الأُولى: تعريف التحنيك لغةً واصطلاحاً
قال ابن فارس: «(حنك) الحاء والنون والكاف أصل واحد: وهو عضو من الأعضاء، ثمّ يُحمل عليه ما يقاربه من طريقة الاشتقاق. فأصل الحنك حنك الإنسان: أقصىٰ فمه. يُقال: حنّكت الصبي، إذا مضغت التمر، ثمّ دلكته بحنكه، فهو محنّك، وحنكته فهو محنوك»([400]).
وقال الطريحي: «والحنك: ما تحت الذقن من الإنسان وغيره، أو الأعلىٰ داخل الفم، والأسفل في طرف مقدَّم اللحيين من أسفلها، والجمع أحناك»([401]).
فالتحنيك وإن تردد معناه لغةً بين ذلك أعلىٰ الحلق، أو أسفل الذقنين، إلّا أنّه يتضمَّن دلك حنك الصبي بشيء من التمر ونحوه بعد أن يُليّن.
وأمّا المعنىٰ الاصطلاحي الشرعي، فهو قريب من المعنىٰ اللّغوي؛ إذ عرّفه أكثر الفقهاء بأنّه: «إدخال شيء من التمر ونحوه إلىٰ حنك المولود، وهو أعلىٰ داخل الفم»([402]).
وقيل: «يكفي الدلك بكلٍّ من الحنكين؛ للعموم، وإنّ كان المتبادر من ذلك الأعلىٰ منهما»([403]).
وقيل: «أن يمضغ المُحَنِّك التمر أو نحوه، حتىٰ يصير مائعاً بحيث يُبتلَع، ثمّ يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها جوفه»([404]).
وقيل: «وسُنَّ أن يُحنَّك المولود بتمرة بأن تُمضغ ويُدلك بها داخل فمه، ويفتح فمه حتىٰ ينزل إلىٰ جوفه منها شيء»([405]).
النقطة الثانية: الحكم التكليفي للتحنيك وأدلته
إنّ تحنيك المولود من الأُمور المستحبة شرعاً، وهو مورد اتفاق بين الخاصّة والعامّة([406])، ولم يخالف فيه أحدٌ؛ لورود الأحاديث الكثيرة من الفريقين والدالة علىٰ استحبابه.
وممّن صرّح بالاتفاق النووي، فقد قال: «اتفق العلماء علىٰ استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، فإن تعذّر فما في معناه، وقريب منه من الحلو، فيمضغ المحنِّك التمر حتىٰ تصير مائعة بحيث تُبتلع، ثمّ يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها جوفه»([407]).
واستُدل له ـ بالإضافة إلىٰ اتفاق علماء المسلمين ـ بالروايات المشار إليها، وهي عديدة:
منها: ما رواه الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الصادق، قال: «قال أمير المؤمنين: حنّكوا أولادكم بالتمر، فكذا فعل رسول الله’ بالحسن والحسين»([408]).
ومنها: ما عن علي بن إبراهيم القمي بإسناده عن أبي جعفر الباقر، قال: «يُحنَّك المولود بماء الفرات، ويقام في أُذنه»([409]).
ومنها: ما عن الصدوق بسنده عن علي بن ميثم، عن أبيه، قال: «سمعت أُمّي تقول: سمعت نجمة أُمّ الرضا تقول ـ في حديث ـ: لـمّا وضعتُ ابني علياً، دخل إليّ أبوه موسىٰ بن جعفر، فناولته إيّاه في خرقة بيضاء، فأذّن في أُذنه اليمنىٰ، وأقام في اليسرىٰ، ودعا بماء الفرات فحنّكه به»([410]).
ومنها: ما رُوي في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي بردة، عن أبي موسىٰ، قال: «وُلِدَ لي غلام، فأتيت النبي (صلّى الله عليه وسلّم) فسمّاه إبراهيم، وحنَّكه بتمرة»([411]).
وهناك روايات أُخرىٰ أوردها الفريقان في كتبهم المعتبرة، وهي جميعاً تدلّ علىٰ أصل استحباب تحنيك المولود، نعم قد تختلف في المصداق الذي يُستحب تحنيك المولود به، وهو ما سيأتي الحديث عنه في الأمر الثالث([412]).
النقطة الثالثة: الأشياء التي يُستحب التحنيك بها
ذكر فقهاء الإمامية ـ طبقاً للروايات الواردة عن طريق أهل البيت^ ـ أنّه يُستحب التحنيك بأُمور، هي:
أ ـ تربة الإمام الحسين.
ب ـ ماء الفرات.
ج ـ التمر.
د ـ العسل([413]).
أمّا فقهاء العامّة، فقد ذكروا استحباب التحنيك بأُمور:
أ ـ التمر.
ب ـ إن لم يتيسر التمر فبالرطب.
ج ـ إن لم يتيسر الرطب فبشيء حلو، وعسل النحل أَولىٰ من غيره، ثمّ فيما لم تمسّه النّار([414]).
وسيأتي ذكر بعض الروايات الدالّة علىٰ ذلك.
ويقدَّم عند الإمامية التحنيك بماء الفرات وبتربة الحسين، فإن لم يوجد ماء الفرات، فبماءٍ فرات، وإن لم يوجد إلّا ماء ملح، جُعل فيه شيء من التمر أو العسل، ويراد بـ(ماءٍ فرات) مطلق الماء العذب([415]).
ولا بدّ أن يُعلم بأنّ القول باستحباب التحنيك بتربة الحسين من مختصّات مذهب الإمامية طبقاً للروايات التي وردت عن أهل البيت^.
النقطةالرابعة: القائلون باستحباب التحنيك بالتربة الحسينيّة
ذكر استحباب التحنيك بالتربة الحسينيّة كلّ مَنْ تطرَّق إلىٰ سنن المولود من فقهاء الإمامية، ولم يُنقل الخلاف عن أحدٍ منهم، سواء القدماء منهم أم المتأخرين، وقد أرسلوا الاستحباب إرسال المسلّمات، وكلماتهم في ذلك كثيرة جداً كما سيأتي.
نعم، الموجود في أكثر كلماتهم ـ تبعاً لنص الرواية ـ عطف التربة الحسينيّة علىٰ ماء الفرات وبهذه الصيغة: «ويُستحب أن يُحنّك بماء الفرات وتربة الحسين».
ويحتمل فيه أمران:
الأوّل: أنّ أحد هذين الموردين ـ أي: ماء الفرات والتربة الحسينيّة ـ جزء موضوع الحكم بالاستحباب، فهما معاً مجتمعان مستحبٌ واحد، وهو ما استظهره بعض الفقهاء، ويمكن جعل الرواية شاهداً علىٰ هذا الحمل؛ إذ عطفت التربة الحسينيّة علىٰ ماء الفرات.
الثاني: أنّ تحنيك المولود بماء الفرات أمرٌ مستحب، والتحنيك بتربة الحسين مستحبٌ آخر، وهو المستفاد من بعض الروايات التي اقتصرت علىٰ ذكر أحدهما دون الآخر، فقد ورد استحباب تحنيك المولود بماء الفرات، ولم يذكر معه التربة الحسينيّة، وهو ما صرّح به المحقّق الحلي&([416]).
ولعلّ سبب العطف في الرواية وكلمات الفقهاء؛ لأجل أنّ التربة الحسينيّة كي يمكن التحنيك بها تحتاج إلىٰ مقدار من الماء تُحلُّ فيه ـ وتذاب فيه ـ ثمّ يقوم المُحنِّك بإدخال الخليط في فمِ المولود.
النقطة الخامسة: كلمات القائلين بالاستحباب
وهذه مجموعة من كلمات الفقهاء الذين صرّحوا بالاستحباب، وهي:
1ـ قال ابن البرّاج: «وينبغي أن يُستعمَل في تحنيكه مع الماء شيء من تربة الحسين، إن وُجِد ذلك»([417]).
2ـ قال الشيخ الطوسي: «فإن وُلِد المولود، يُستحب أن يُغسل... ويُحنَّك بماء الفرات إن وُجِد، فإن لم يوجَد، فبماء عذب، فإن لم يوجَد إلّا ماء ملح، مُرِسَ فيه شيء من التمر أو العسل، ثمّ يُحنَّك به، ويُستحب أن يُحنَّك بتربة الحسين»([418]).
3ـ قال المحقّق الحلي: «وتحنيكه بماء الفرات، وبتربة الحسين، فإن لم يوجَد ماء الفرات فبماءٍ فرات، وإن لم يوجَد إلّا ماء ملح، جُعِل فيه شيء من التمر أو العسل»([419]).
4 ـ قال العلّامة الحلي: «وتحنيكه [أي: المولود] بماء الفرات وبتربة الحسين، ولو فقد فبالعذب، ولو فُقِدَ خُلِط بالمالح العسل أو التمر»([420]).
5ـ قال الشهيد الأوّل: «وتحنيكه بتربة الحسين وماء الفرات، وأمّا ماء الفرات ولو بخلطه بالتمر أو العسل»([421]).
6ـ قال الفاضل الهندي: «وتحنيكه [أي: المولود] بماء الفرات وتربة الحسين للأخبار، ويكفي الدلك بكلّ من الحنكين للعموم، وإن كان المتبادر [من] ذلك الأعلىٰ؛ ولذا اقتصر عليه جماعة من العامّة والخاصّة»([422]).
7 ـ قال الكاشاني: «وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين ـ أي: إدخالهما في حنكه، وهو أعلىٰ داخل الفم ـ وبالتمر، بأن يُمضَغ ويُجعَل في فيه، موصلاً بالسبابة إلىٰ حنكه حتىٰ يتخلل في حلقه، وإن لم يوجد الفرات فبماء السماء»([423]).
8 ـ قال البحراني: «ومنها [أي: من سنن الولادة] تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين، قالوا: فإن لم يوجَد ماء الفرات فبماء قراح، ولو لم يوجَد إلّا ماء ملح جُعِل فيه شيء من التمر أو العسل»([424]).
9 ـ قال صاحب الجواهر: «والرابع: (تحنيكه بماء الفرات) الذي هو النهر المعروف، (وبتربة الحسين) للنصوص، (فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء) السماء كما في النص، لكن المصنّف ـ بل قيل: ـ والأصحاب قالوا بماء (فرات)، أي: عذب، ولم يحضرني نصٌّ عليه، وما في كشف اللثام ـ أنّه يمكن فهمه من بعض نصوص ماء الفرات بناءً علىٰ احتمال إضافة العامّ إلىٰ الخاصّ ـ لا يخفىٰ عليك ما فيه، كما لم يحضرني نصٌّ علىٰ ما قالوه أيضاً: فـ(إن لم يوجد إلّا ماء ملح جُعِل فيه شيء من التمر أو العسل). نعم، قد ورد استحباب التحنيك بالتمر نفسه، بل وفي المحكي عن (فقه الرضا) العسل أيضاً، وإن كان لا بأس بخلط شيء من العسل والتمر بماء الفرات أو السماء وتحنيكه به، فإنّ فيه جمعاً بين الجميع»([425]).
10 ـ قال الشيخ اللنكراني: «الثالث: تحنيكه بماء الفرات وتربة سيّد الشهداء، والظاهر أنّهما مستحب واحد، غاية الأمر أنّه إن لم يوجَد ماء الفرات ففي الشرائع (فبماء فرات)، أي: العذب، وإن لم يوجَد إلّا ماء ملح جُعل فيه شيء من التمر أو العسل. ولكن في الوسائل: وقال الكليني: وفي رواية أُخرىٰ: حنّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين، فإن لم يكن فبماء السماء.
والمستفاد من بعض الروايات أنّ التحنيك بماء الفرات أمرٌ، وبتربة قبر الحسين مُستحب آخر؛ كما يدل عليه الاقتصار علىٰ أحدهما في بعض الروايات مثل مرسلة يونس([426])... هذا وفي بعض الروايات التحنيك بالتمرة([427])...»([428]).
11 ـ قال الشيخ محمد أمين: «ويُستحب تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين، فيُخلَط الماء بشيء من التربة ويُدخَل إلىٰ حنكه، وهو أعلىٰ داخل الفم»([429]).
12 ـ قال السيّد السيستاني: «ويُستحب أيضاً تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين»([430]).
النقطة السادسة: ما يدل على استحباب تحنيك المولود بتربة الحسين×
استُدلّ للقول باستحباب تحنيك المولود بتربة الحسين بالروايات الآتية:
1ـ ما رواه الكليني في (الكافي) من قوله: «حنّكوا أولادكم بماء الفرات، وبتربة الحسين، فإن لم يكن فبماء السماء»([431]).
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب مرسلاً([432]). ورواه الطبرسي في (مكارم الأخلاق)، نقلاً عن كتاب (نوادر الحكمة) مرسلاً أيضاً([433]).
2ـ ما رواه ابن قولويه في (كامل الزيارات) عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد الله يقول: «حنِّكوا أولادكم بتربة الحسين فإنّها أمان»([434]).
ورواه الطوسي في (التهذيب) عن ابن قولويه([435])، وكذلك في (مصباح المتهجِّد)([436]) مرسلاً.
ورواه الراوندي في (الدعوات) أيضاً بالألفاظ نفسها([437]).
ورواه الفتّال النيسابوري مرسلاً في (روضة الواعظين)([438]).
النقطة السابعة: الأثر الوضعي للتحنيك بماء الفرات (فائدة التحنيك)
أشارت بعض الروايات إلىٰ الأثر الوضعي للتحنيك بماء الفرات، فإنّ التحنيك به يورث حبّ آل محمد’ في قلب هذا المولود، ويكون من شيعتهم.
ومن تلك الروايات ما يلي:
1ـ عن ابن قولويه، بسنده عن سليمان بن هارون، أنّه سمع أبا عبد الله يقول: «مَن شرب من ماء الفرات، وحُنّك به، فهو محبُّنا أهل البيت»([439]).
2ـ وعنه أيضاً بسنده عن سليمان بن هارون العجلي، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: «ما أظنّ أحداً يُحنّك بماء الفرات إلّا أحبَّنا أهل البيت. وسألني: كم بينك وبين ماء الفرات؟ فأخبرته. فقال: لو كنتُ عنده لأحببت أن آتيه طرفي النهار»([440]).
3ـ وعنه أيضاً بسنده عن الحسين بن عثمان، عن أبي عبد الله، أنّه قال: «ما أظنّ أحداً يُحنَّك بماء الفرات إلّا كان لنا شيعة...»([441]).
4ـ وعنه أيضاً بسنده عن عقبة بن خالد، قال:
ذكر أبو عبد الله الفرات، قال:
«أَما أنّه من شيعة علي، وما حُنِّك به أحد إلّا أحبَّنا أهل البيت»([442]).
5ـ وعنه أيضاً بسنده عن هارون بن خارجة، قال: قال أبو عبد الله: «ما أحد يشرب من الفرات، ويُحنّك به إذا وُلِد ألّا أحبّنا؛ لأنّ الفرات نهرٌ مؤمن»([443]).
حكم الخمس في التربة الحسينيّة وبيعها وشرائها وإهدائها
المبحث الأوّل: حكم الخمس في التربة الحسينيّة
المبحث الثاني: حكم بيع التربة الحسينيّة وشرائها
حكم اصطحاب تربة الإمام الحسين
من كربلاء وإهدائها.
الخُمس حقٌّ ماليٌّ أوجبه الله تعالىٰ في أموال المكلَّفين، وقد اتّفقت كلمة الفقهاء علىٰ وجوبه ـ بشروط خاصّة ـ في الجملة، والقدر المتّفق علىٰ وجوبه هو غنائم دار الحرب.
واختلفوا في وجوبه علىٰ أشياء أُخرىٰ، كالمعدن، والكنز، وما يخرج بالغوص، والفاضل عن مؤنة السنة من أرباح المكاسب، والميراث والهبة، فأوجبه فقهاء الإماميّة في أغلب هذه الأشياء، وخصّه باقي فقهاء المذاهب في أشياء محدودة، وهي: الفيء، والسلب، والركاز علىٰ تفصيل في ذلك([444]).
وينقسم الخُمس عند الإماميّة علىٰ قسمين: حقّ الإمام، وحقّ السادة.
واتفق الإماميّة علىٰ وجوب الخمس في المعدن. وأمّا فقهاء المذاهب، فذهب الحنفيّة إلىٰ وجوب الخمس فيه؛ لأنّه يُعدّ غنيمة، ويجب الخمس في الغنيمة. وأكثر فقهاء المذاهب الأُخرىٰ أوجبوا فيه الزكاة فقط([445]).
اختلف الفقهاء في تفسير المعدن أو الرِّكاز الذي يجب فيه الخمس علىٰ أقوال:
ففسّرها بعض: «بأنّها كُلّ ما خرج من الأرض ممّا يُخلَق فيها من غيرها، ممّا له قيمة كالملح، والنفط، والقير، والكبريت»([446]).
وفسّرها آخر: بأنّه كُلّ ما استُخرج من الأرض ممّا كان أصله منها، ثمَّ اشتمل علىٰ خصوصية يعظم الانتفاع بها، كالجصّ، وطين الغسل، وحجارة الرحىٰ([447]).
وفسّرها ثالث: بأنّ أصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه، ثمَّ اشتُهر في الأجزاء المستقرّة نفسها التي ركّبها الله تعالىٰ في الأرض، حتىٰ صار الانتقال من اللفظ إليه ابتداءً بلا قرينة([448]).
وفسّرها رابع: بأنّه كُلّ ما تولّد في الأرض من غير جنسها ليس نباتاً([449]).
وعلىٰ بعض هذه التفاسير يأتي القول بوجوب الخمس علىٰ التربة المباركة.
القول بوجوب الخمس في التربة الحسينيّة
لعلّ أوّل مَن أشار إلىٰ هذه المسألة هو الشيخ الكبير جعفر كاشف الغطاء في (كشف الغطاء)، بقوله ـ وهو بصدد ذكر بعض مصاديق المعدن ـ: «وفيما يحتاج إلىٰ العمل من التراب ـ كالتُّربة الحسينيّة، والظروف وآلات البناء ـ لوجوب الخمس فيه وجه»([450]).
فالشيخ& استوجه القول بوجوب الخمس في أوّل كلامه، وهو أنّ التربة الحسينيّة بالكيفيّة المطبوخة تحتاج إلىٰ عمل وجهد، وهذا يوجب جعل الخمس عليها، فالظاهر أنّه غير مراد له&.
ولعلّ وجه القول بوجوب الخمس هو: أنّ التربة الحسينيّة المباركة تندرج في المعدن، وتكون أحد مصاديقه، فيجب ـ لذلك ـ الخمس فيها.
وهذا إنّما يتمّ بناءً علىٰ إحدىٰ التفسيرات المتقدِّمة للمعدن، وهو تفسيره: «بكُلّ شيء اشتمل علىٰ خصوصية يعظم الانتفاع بها».
ويُناقش هذا الوجه بأمرين:
الأوّل: إنّه لو عمّمنا تفسير المعدن لكان كُلُّ ما علىٰ الأرض معدناً وهو واضح البطلان.
الثاني: إنّ تفسير المعدن بـ(كلّ ما اشتمل علىٰ خصوصية يعظُم الانتفاع بها) لم يثبت من العُرْف واللغة، وإنّما المعيار والميزان في المعدن هو ما صدق عليه المعدن عرفاً، وفي كُلّ مورد نشكّ في صدق المعدن علىٰ الشيء عرفاً لا يجب فيه الخمس([451]).
ولأجل هذين الوجهين خالف كُلّ مَن جاء بعد الشيخ كاشف الغطاء وتعرَّض لهذه المسألة، كالشيخ صاحب الجواهر وغيره([452]).
الخلاصة: عدم نهوض دليل القول بوجوب الخمس علىٰ التربة الحسينيّة، وعدم إمكان الاعتماد عليه، فالقول بعدم الوجوب هو الأقوىٰ، كما هو واضح.
حكم بيع التربة الحسينيّة وشرائها
تعددت أبعاد الفقه الإسلامي حتىٰ شملت كلّ ما يتعلَّق بالإنسان، سواء أكان الجانب العبادي منه، أم الجانب المعاملاتي، ومن أمثلة الجانب الثاني: صحة البيع والشراء.
ولا شك في مشروعية البيع وجوازه تكليفاً ووضعاً؛ لدلالة الكتاب والسنّة، وحكم العقل، وقيام الإجماع علىٰ ذلك.
فمن القرآن الكريم قوله تعالىٰ: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)([453])؛ فإنّها صريحة في مشروعية البيع.
وأمّا من السنّة الشريفة، فقد وردت المئات من الروايات عن المعصومين^ في بيان أحكام البيع والتجارة، وطلب الرزق، وبيان آدابه؛ وهذه بنفسها دليل علىٰ مشروعية البيع، مضافاً إلىٰ ضمِّ عمل المعصومين^، ومباشرتهم ذلك بأنفسهم، مع تقريرهم للسيرة التي عليها أصحابهم.
وأمّا الإجماع، فهو قائم بين المسلمين علىٰ جواز البيع والشراء إجمالاً.
وليس للبيع حقيقة شرعية ولا متشرعية، بل هو باقٍ علىٰ معناه اللّغوي والعرفي([454])، وللشارع المقدَّس أن يتدخل في النهي عن بعض البيوع، أو اشتراط بعض الشروط في الشيء المباع، أو فيمَن يتولّىٰ عقد البيع، وهكذا([455]).
وممّا ورد النهي عن بيعه هو بيع الأعيان النجسة، وبيع ما لا منفعة فيه، وبيع الثمرة قبل ظهورها.
وممّا ورد فيه النهي أيضاً بيع التربة الحسينيّة المشرَّفة.
ولتسليط الضوء علىٰ هذا الحكم لا بدّ من ذكر بعض النقاط:
النقطة الأُولى: كلمات الفقهاء في المسألة
رغم قلّة التصريح بهذه المسألة في كلمات الفقهاء، إلّا أنّه بعد متابعة مُضنية أمكن الحصول علىٰ بعضٍ منها، وهي:
1ـ ما قاله الشهيد الأوّل& في (الدروس الشرعية): «ويجوز لـمَن حازها [أي: تربة الحسين] بيعها كيلاً ووزناً، ومشاهدةً، سواء كانت تربة مجرّدة أم مشتملة علىٰ هيئات الانتفاع»([456]).
2ـ ما قاله السيّد الطباطبائي& في (المناهل): «الثاني: صرّح في الدروس بأنّه يجوز لـمَن حاز التربة بيعها كيلاً ووزناً ومشاهدة، سواء كانت تربة مجردة أو مشتملة علىٰ هيئات الانتفاع. وما ذكره جيّد؛ للأصل والعمومات الدالة علىٰ صحة البيع، من نحو قوله تعالىٰ: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)، وقوله تعالىٰ: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وقولهم^ في عدّة أخبار معتبرة: المؤمنون عند شروطهم. وقوله’: الناس مسلَّطون علىٰ أموالهم. ولكن الأوْلىٰ ترك البيع لمرفوعة يعقوب بن يزيد، عن الصادق، قال: مَن باع طين قبر الحسين فإنّه يبيع لحم الحسين ويشتريه»([457]).
3ـ ما قاله الشيخ الأنصاري ـ وهو في معرض ذكر أحكام الأرض المفتوحة عنوةً ـ: «ويحتمل كون ذلك [أي: المأخوذ من الأرض] بحكم المباحات؛ لعموم: مَن سبق إلىٰ ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به. ويؤيده ـ بل يدلّ عليه ـ استمرار السيرة خلفاً عن سلف علىٰ بيع الأُمور المعمولة من تربة أرض العراق من الآجر والكوز والأواني، وما عُمل من التربة الحسينيّة، ويقوىٰ هذا الاحتمال بعد انفصال هذه الأجزاء من الأرض»([458]).
4ـ ما قاله الشيخ حسين آل عصفور ـ وهو في معرض الكلام عن الربا ـ: «ويجري الربا في الطين الأرمني، وأمّا الخراساني المأكول، فبيعه للأكل حرام، باعه بخيسه أو غيره، متماثلاً أو متفاضلاً، ولغير الأكل جائز، فإن قضت العادة بكيله أو وزنه كان ربوياً، وإلّا فلا، وأطلق الشيخ وابن البرّاج تحريم بيع الطين المأكول، وجاء في التربة الحسينيّة ـ علىٰ مشرِّفها السلام ـ ما يدل علىٰ المنع من شرائها، كما في مرسل يعقوب بن يزيد المروي في الكامل عن الصادق، وهو يشمل ما كان للأكل وما كان لغيره، سواء أبقي علىٰ أصله أو عُمِل سبحاً وألواحاً، مع أنّه قد نقل في الدروس الإجماع من الإمامية علىٰ جواز بيعها بعد حيازتها، كيلاً ووزناً ومشاهدة، ولعلّ الخبر محمول علىٰ الكراهة لقصور سنده، والاحتياط ممّا لا يخفىٰ»([459]).
5ـ ما ذكره السيّد المروّج في شرح وبيان كلام الأنصاري المتقدِّم ـ أي: قوله&: استمرار السيرة خلفاً عن سلف... ويقوىٰ هذا الاحتمال بعد انفصال هذه الأجزاء من الأرض ـ: «يعني: ويؤيّد احتمال كون الأجزاء المنفصلة عن الأرض بحكم المباحات بعد بقائها بعد انفصالها علىٰ جزئيتها من الأرض»([460]).
6ـ قال الخوانساري ـ وهو في معرض الكلام عن الأراضي التي كانت مواتاً حال الفتح ـ ومنها أرض العراق ـ ثمّ احتُمل تملكها بالإحياء: «وعلىٰ هذا؛ فلا مانع من شراء كلّ ما احتُمل كونه مواتاً حال الفتح، فإنّ يد مَن عليها أمارة علىٰ كونها ملكاً له، ولا يبعد أن يكون منشأ سيرة الخَلف عن السلف علىٰ بيع ما يُصنع من تراب أرض العراق من الآجر والكوز والأواني، والتربة الحسينيّة ـ علىٰ مشرِّفها آلاف التحية ـ عدم إحراز كون هذه الأراضي معمورة حال الفتح، ومجرد العلم الإجمالي بعمارة أغلب أراضي العراق لا أثر له بعد عدم كون جميعها محلاً للابتلاء. نعم، لو أُحرز عمارة أرض خاصّة حال الفتح، ولم يُحتمل عروض الموت عليها، أو استُصحب بقاؤها علىٰ عمارتها إلىٰ الآن، فيجري فيه الاحتمالات ـ بل الأقوال ـ الخمسة، وأوفقها بالقواعد: هو توقف التصرّف في زمان الغيبة علىٰ إذن الفقيه، أو السلطان الجائر الذي حلَّ قبول الخراج والمقاسمة منه؛ بناءً علىٰ ما تقدَّم في كتاب المكاسب: أنّه يستفاد من الأئمّة^ الإذن العام للتصرّف فيما يأخذه الشيعة بإذن سلطان الجور»([461]).
7ـ وقال الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء الكبير& ـ في معرض كلامه عن حكم ما استنبط من الوقف ـ: «أنّ المستنبط من نفس الموقوف قد يُملك بالفصل، مع أنّه كان وقفاً حال الوصل، كالتراب المفصول من أراضي الأوقاف العامّة عدا المساجد، فإنّه يعود ملكاً، ويُباع علىٰ حاله أو بعد صيرورته آجراً أو ظروفاً أو نحوها. فلا بأس ببيع التربة الحسينيّة مع الفصل، حيث نقول: إنّ أرض كربلاء وقف. ولا بملكية الظروف المصنوعة، والآجُر المتّخذ من أرض النجف، وإن صحّ أنّها وقفها الدهاقين. كما أنّه لا بأس بصنيع مثل ذلك من المشتركات، كالطرق النافذة، والأسواق، والمقابر، والأرض المفتوحة عنوةً، فإنّها إذا فُصلت تغيَّر حالها كتغيّر آلات الوقف إذا بطل الانتفاع بها»([462]).
8 ـ وقال الكلباسي: «وتُملك [أي: التربة الحسينيّة] بالحيازة؛ لفحوىٰ ما ورد في الماء والنار والملح، ويجوز بيعها وصلحها كيلاً ووزناً وجزافاً، فيما لو يعلم وقفيتها...»([463]).
هذا ما أمكن تحصيله من كلمات الفقهاء، وهي كما ترىٰ مطبقة علىٰ جواز بيع التربة المقدَّسة.
النقطة الثانية: ما يمكن الاستدلال به لحرمة بيع التربة الشريفة
الدليل الذي يمكن الاستناد إليه للقول بالحرمة منحصر فيما رواه جعفر بن محمد ابن قولويه في كتابه (كامل الزيارات) في الباب (95) تحت عنوان: (إنّ الطين كلّه حرام إلّا طين قبر الحسين فإنّه شفاء)، قال: «ووجدت في حديث الحسين بن مهران الفارسي، عن محمد بن أبي سيّار، عن يعقوب بن يزيد، يرفع الحديث إلىٰ الصادق قال: مَن باع طين قبر الحسين، فإنّه يبيع لحم الحسين ويشتريه»([464]).
ورواه عنه أيضاً الحرّ العاملي في كتابه (وسائل الشيعة) في الباب (95) تحت عنوان: (باب عدم تحريم أكل طين قبر الحسين). نعم، حمله الحرّ العاملي علىٰ محامل غير الحرمة([465]).
ورواه عنه أيضاً العلّامة المجلسي في كتابه (بحار الأنوار)([466]) في باب (تربته صلوات الله عليه وفضلها وآدابها وأحكامها).
ووجه الدلالة علىٰ الحرمة، هو أنّ الإمام الصادق جعل مَن يبيع طين القبر كمَن يبيع لحم الإمام الحسين، ومن المقطوع به أنّ بيع لحم أيّ مسلمٍ من المحرَّمات فكيف بلحم المعصوم؟! فهو من أشنعها.
ولا بدّ أن يُعلم بأنّنا لم نجد من الفقهاء مَن صرَّح بحرمة بيع التربة الحسينيّة.
النقطة الثالثة: مناقشة ما استُدل به للحرمة
إنّ الاستدلال المتقدَّم برواية الإمام الصادق يواجه إشكالات عدّة، بعضها سندية، وبعضٌ آخر دلالية.
1ـ إنّ الراوي الأخير ـ وهو يعقوب بن يزيد ـ يرفع الحديث إلىٰ الإمام الصادق، فأسقط من سنده ما يوصله إلىٰ الإمام؛ فيكون الحديث بهذا داخلاً في أقسام المرسَل، فيسقط حينئذٍ عن الحجيّة والاعتبار.
2ـ إنّ قوله: «ووجدت» متردد بين كونه من كلام مصنِّف الكتاب، وكونه من كلام الراوي سماعة؛ لأنّ راوي الرواية السابقة ـ وهي الرواية الرابعة في الباب ـ هو سماعة بن مهران، وقوله: «ووجدت» يحتمل كونه عطفاً علىٰ الرواية السابقة، وكأنّها من تتمّة كلام سماعة، لكن الظاهر هو الأوّل([467]).
لقد حمل بعض الفقهاء هذه الرواية علىٰ محامل متعددة ـ علىٰ فرض صحة سندها ـ وعلىٰ جميع التقادير لا يصلح أيّ حملٍ منها للاستدلال علىٰ الحرمة المطلقة، وحاصلها:
1ـ إنّ الرواية محمولة علىٰ حرمة بيع تراب القبر نفسه، وأمّا ما عداه فلا دلالة للرواية علىٰ حرمة بيعه، فيبقىٰ علىٰ أصل الحليّة؛ لأنّ الوارد فيها: «مَن باع طين قبر الحسين»؛ فيقتصر في الحرمة علىٰ تربة طين القبر نفسه([468]).
2ـ حمل الرواية علىٰ كراهية بيع تربة الإمام الحسين، واستحباب بذل التربة بغير ثمن؛ لصراحة أدلة جواز بيع ما ينفصل من الأراضي المفتوحة عنوةً، والتي منها أرض العراق، بما فيها أرض كربلاء المقدَّسة، علىٰ تفصيل وكلام في ذلك، يُنظر فيه الكتب المطولة([469]).
3ـ يُحتمل أنّ النهي الوارد في الرواية يُراد به النهي عن بيع التراب غير المملوك، وأمّا التراب المملوك ولو كان من تربة الحسين فلا إشكال في جوازه([470]).
النقطة الرابعة: أدلّة جواز بيع تربة قبر الحسين×
إنّ أدلّة جواز بيع التربة المقدَّسة يمكن حصرها بثلاثة:
الدليل الأوّل: الأصل؛ فإنّه بعد مناقشة الدليل الدال علىٰ الحرمة ـ وهو رواية يعقوب بن يزيد المتقدّمة ـ لا يبقىٰ أيُّ مبرر للحكم بحرمة بيع التربة المباركة، وتدخل تحت العمومات الدالة علىٰ الجواز.
الدليل الثاني: التمسّك بالإجماع الذي يمكن أن يستفاد ممّا في (الدروس)([471]) الدال علىٰ جواز بيعها بعد حيازتها كيلاً ووزناً ومشاهدة. واستفادة الإجماع من عبارة الدروس هو الذي فهمه الشيخ آل عصفور منها([472])، إلّا أنّه بالرجوع إلىٰ نصّ الشهيد الأوّل قد لا يتضح منه دعوىٰ الإجماع؛ فإنّ الإجماع منعقد علىٰ جواز الاستشفاء بتربة الحسين دون غيرها من المسائل المتعلِّقة بتربة الحسين.
وعلىٰ ظهور كلام الدروس في الإجماع يُحمل
الخبر المتقدِّم ـ خبر يعقوب بن يزيد ـ
علىٰ الكراهة؛ لقصوره سنداً، واستحباب الاحتياط؛ لكونه من الأُمور الحسنة علىٰ كلّ
حال.
الدليل الثالث: التمسّك بالسيرة؛ فقد قامت سيرة المتشرعة علىٰ جواز بيع ما في الأراضي المفتوحة عنوةً من الأباريق والجحلات والحبوب([473])، والسبح الحسينيّة، وغير ذلك ممّا يُعمل من ترابها علىٰ مشرِّفها آلاف التحية والسلام([474]).
الدليل الرابع: التمسّك بالأدلة العامّة والمطلقة، وهذه الأدلة علىٰ نوعين: قرآنية، وروائية.
فمن الأوّل قوله تعالىٰ: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)([475])، وقوله: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) ([476]).
ومن الثاني ما ورد عن أهل البيت^ في أخبار معتبرة عدّة كقولهم^:
المؤمنون عند شروطهم»([477]). وقولهم^: «الناس مسلَّطون علىٰ أموالهم»([478]).
وذلك بتقريب: إنّ بيع تربة الإمام الحسين ـ
بعد دفع ما استُدل به علىٰ الحرمة ـ
ينطبق عليه أحد هذه الأدلة العامّة أو المطلقة. وهذا يكفي لتصحيح بيعها.
والخلاصة: إنّ صحة بيع التربة الحسينيّة إذا كانت مملوكة للشخص، أو أُخذت من الأماكن المباحة ـ وخصوصاً إذا فُصِلت عن الأرض ـ ممّا لا إشكال فيه؛ وذلك للأدلة المتقدِّمة. وأمّا القول بحرمة البيع، فليس له مستند إلّا رواية ضعيفة السند،
مع إمكان حملها علىٰ محامل أُخرىٰ.
نعم، يُستحب لمالك التربة التبرّع بها من دون أخذ الثمن عليها، وهو الموافق للاحتياط؛ لمرفوعة يعقوب بن يزيد المتقدِّمة.
ولا فرق في جواز البيع بين كونه بالكيل أو الوزن أو المشاهدة، ولا فرق بين كونها مجرّدة أو مشتملة علىٰ هيئات الانتفاع([479]).
المبحث الثالث حكم اصطحاب تربة الإمام الحسين× من كربلاء وإهدائها
إنّ الروايات الواردة في كتب الحديث، والمروية عن النبي’ وأهل بيته^، أكّدت استحباب إهداء الهدية إلىٰ المسلم ولو نبقاً([480])، وقبول هديته([481])، بل إنّ كتب الفقه خصّصت لهذا الموضوع كتاباً كاملاً اسمته (كتاب الهبات)، وأشارت فيه إلىٰ أحكام شرعية عدّة تخصّ الهبة.
وفائدة الهدية تتجلّىٰ ـ علىٰ لسان الروايات ـ في أُمور عدّة: فهي من حيث الثواب أكثر من الصدقة، وتذهب بالضغائن وتورث بدلها الحبّ، وتذهب بالأحقاد، وتجدّر الأُخوة.
وقسّمت الروايات الهدية علىٰ أقسام عدّة: هدية مكافأة، وهدية مصانعة، وهدية لله تعالىٰ([482]).
فعن الصدوق بسنده إلىٰ الإمام الصادق، أنّه قال: «من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته، ويتحفه بما عنده، ولا يتكلَّف له شيئاً»([483]).
وعنه أيضاً عن أمير المؤمنين، أنّه قال: «لأن أُهدي لأخي المسلم هدية تنفعه، أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثلها»([484]).
وعن جابر، عن أبي جعفر الباقر، قال: «كان رسول الله’ يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ويقول: تهادوا فإنّ الهدية تسلّ السّخائم وتجلي ضغائن العداوة والأحقاد»([485]).
وعن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله، قال: «قال رسول الله’: تهادوا بالنبق، تحيىٰ المودّة والموالاة»([486]).
وعن الخصال، عن أبي عبد الله الصادق، قال: «نِعمَ الشيء الهدية أمام الحاجة. وقال: تهادوا تحابوا، فإنّ الهدية تُذهب بالضغائن»([487]).
وهناك روايات أُخرىٰ أعرضنا عن ذكرها مخافة الإطالة.
وعلىٰ أساس ما تقدَّم في مضمون الروايات صرَّح بعض الفقهاء: أنّ من الأُمور المستحبة أن يستصحب الزائر ـ لضريح الحسين ـ معه التربة المباركة، ليشمل البركة أهله وبلده.
نعم، ذكر بعضٌ منهم ذلك بعنوان الاستحباب، وذكره بعضٌ آخر بعنوان (ينبغي)، والظاهر اختلاف العنوانين لا أنّهما عنوان واحد.
وإليك أوّلاً ما أمكن الحصول عليه من كلماتهم ـ رغم قلّتها ـ ثمّ نذكر ما يمكن الاستدلال به علىٰ الاستحباب.
1 ـ قال ابن فهد الحلي في (المهذّب البارع): «يُستحب للزائر أن يصحب معه منها [أي: تربة الحسين]؛ ليشمل البركة أهله وبلده»([488]).
ولعلّه أوّل مَن ذكر هذه المسألة.
2 ـ قال الشهيد الأوّل في دروسه: «وينبغي للزائر أن يستصحب منها ما أمكن؛ لتعمّ البركة أهله وبلده، فهي شفاء من كلّ داء، وأمان من كلّ خوف»([489]).
3 ـ قال السيّد محمد الطباطبائي: «الثالث: صرّح في الدروس بأنّه ينبغي للزائر أن يستصحب منها ما أمكن؛ ليعمّ البركة أهله وبلده، فهي شفاء من كلّ داء وخوف، وهو جيد»([490]).
4 ـ قال الكلباسي في (منهاج الهداية): «ومنهم مَن عدّ من المستحب أن يصحب الزائر معه منها؛ ليشمل البركة أهله وبلده. ولا بأس به»([491]).
5 ـ قال الحرّ العاملي بعد مناقشة الرواية الدالة علىٰ حرمة بيع تربة الحسين: «هذا محمول علىٰ تراب نفس القبر، ويُحتمل الكراهة، واستحباب بذله بغير ثمن، ويُحتمل الحمل علىٰ ما ليس بمملوك»([492]).
هذا مضافاً إلىٰ أنّ كلّ مَن جوّز بيع التربة قال: إنّ الأفضل إهداؤها من دون مقابل. وقد تقدَّم ذلك في المسألة السابقة.
أدلّة القول بالاستحباب
لا يخفىٰ بأنّ كلّ مَن تعرّض لهذه المسألة لم يأتِ بدليل مباشرٍ عليها، وخصوصاً الأدلة المتعلّقة باستحباب إهدائها وحملها إلىٰ أهله وبلده، إلّا أنّه يمكن التماس دليلين علىٰ هذا الاستحباب:
الأوّل: الروايات المتقدِّم ذكرها الدالة علىٰ استحباب الهدية للمسلم، فهي مطلقة من جهة نوع المهدىٰ، ولم تخصِّصه بشيء، فتشمل التربة الطاهرة، نعم، يخرج عن جواز الإهداء كلّ ما نهىٰ عنه الشارع من الأُمور المحرّم اقتناؤها، أو أكلها، أو شربها.
الثاني: الروايات الكثيرة، بل المتواترة الدالة علىٰ تقديس التربة واحترامها، والدالة علىٰ استحباب السجود عليها، والدالة علىٰ كونها شفاءً لكلّ مَن استشفىٰ بها، وأماناً لكل مَن حملها، فهذا وغيره يدل علىٰ استحباب أو أفضلية حملها من قِبل الزائر لأهله وبلده، وقد تقدَّم جميع ذلك.
ويؤكّد هذا أنّ الشهيد الأوّل، بعد أن صرّح بأنّه ينبغي للزائر حملها، قال: «فهي شفاء من كلّ داء، وأمان من كلّ خوف»([493]).
مسائل وردود حول التربة الحسينيّة
ختاماً لبحث (فقه التربة الحسينيّة) بفصوله الأربعة، نستعرض ـ في هذه الخاتمة ـ جملة من المسائل الفقهية التي تقع محلاً للابتلاء، والتي يكثر السؤال عنها في الوقت الحاضر، ونستعين بإجابة المعاصرين من الفقهاء، أو مَن قارب هذا العصر، وهي:
1ـ سُئل السيّد الخوئي+: علىٰ أيّ أساس يجوز أكل التربة الحسينيّة ـ أعني القليل منها ـ مع العلم أنّ الحرمة لأكل الرمل أو التراب مؤكّدة؟ ولماذا لم ترد الأحاديث بتربة الرسول’، أو أمير المؤمنين مثلاً؟
فأجاب: «يختصّ الجواز في التربة الحسينيّة بما لا يتجاوز قدر الـحُمصة، ويكون الغرض هو الاستشفاء، وهذا الحكم تخصيص لحرمة أكل الطين، واستثناء منها، ويختصّ بتربة الحسين، دون سائر المعصومين، والله العالم بأسرار أحكامه»([494]).
2ـ سُئل الشيخ التبريزي+: التربة الحسينيّة ـ زادها الله عزّاً ـ كثيراً ما نرىٰ مكتوب عليها لفظ الجلالة أو أسماء المعصومين^، فما رأيكم الشريف في السجود عليها، حيث سيكون لفظ الجلالة تحت الجبهة؟
فأجاب: «لا يبعد الجواز، وإن كان الأحوط السجود علىٰ الجهة المخالفة»([495]).
3ـ سُئل الشيخ التبريزي أيضاً: هل التربة الحسينيّة التي لا يجوز تنجيسها هي هذه المتواجدة في الأسواق والمساجد؟.
فأجاب: «كلّ ما كان من تربة كربلاء، فلا يجوز تنجيسه»([496]).
4ـ سُئل السيّد السيستاني (دام ظله): إنّ التربة الحسينيّة، أو تربة سائر الأئمّة^، هل يلحقها حكم المشاهد المشرّفة من حرمة التنجيس، ووجوب إزالة النجاسة عنها؟
فأجاب: «نعم، يلحقها حكمها، فيجب إزالة النجاسة عن تربة الرسول’ وسائر الأئمّة^، المأخوذة من قبورهم بقصد التبرّك، وعن التربة الحسينيّة مطلقاً، ويحرُم تنجيسها، ولا فرق في التربة الحسينيّة بين المأخوذة من القبر الشريف، أو من الخارج، إذا وِضعَت عليه بقصد التبرك والاستشفاء، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة»([497]).
5ـ سُئل السيّد السيستاني أيضاً: هل التربة التي بين أيدينا في هذه الأيام هي عينها التربة الحسينيّة، أي: هي من تراب قبر الحسين؟ وإذا لم تكن كذلك، فهل هي عبارة عن تربة طاهرة، كأيّ تراب يجوز السجود عليه بعد التأكد من طهارته؟
فأجاب: «ليست هذه التربة تربة قبره ـ سلام الله عليه ـ ولا تربة الحائر الشريف، ولكنّها تربة طاهرة إذا لم تتنجس بسبب خارجي»([498]).
6ـ سُئل السيّد السيستاني أيضاً: ما حكم أخذ الأُجرة علىٰ تصليح التربة الحسينيّة؟
فأجاب: «يجوز أخذها»([499]).
7ـ سُئل السيّد السيستاني أيضاً: ما هو مقدار الواجب السجود عليه من التربة الحسينيّة؟
فأجاب: «بمقدار یحقق مسمّىٰ السجدة، كرأس الأنملة»([500]).
8ـ سُئل السيّد السيستاني أيضاً: ما حكم تسنيد التربة الحسينيّة تحت خد الميت؟
فأجاب: «لا بأس بالتبرك به، فهم موضع الرجاء»([501]).
9ـ سُئل السيّد السيستاني أيضاً: ما حكم الأكفان المكتوب عليها دعاء الجوشن الكبير، وآية الكرسي، وسورة ياسين والمعوّذتين، وأسماء الأئمّة، وذلك بالتربة الحسينيّة أو بماء الزعفران؟
فأجاب: «لا إشكال فيها»([502]).
10ـ سُئل السيّد السيستاني أيضاً: هل يجوز أكل بعض أجزاء التربة الحسينيّة بقصد الاستشفاء، وإذا كان الجواب يجوز فما شروط ذلك؟
فأجاب: «لا يجوز إلّا تراب القبر أو الحائر الشريف»([503]).
11ـ سُئل السيّد السيستاني أيضاً: ما المدىٰ المسموح به في السجود علىٰ التربة الحسينيّة التي يوجد عليها:
أـ طبقة نتيجة العرق أو ما شابه.
ب ـ نقش يتضمّن علىٰ سبيل المثال لفظ الجلالة؟
فأجاب: «أ ـ يجوز السجود إلّا إذا تشكّلت طبقة حاجزة ممّا لا يصحّ السجود عليها.
ب ـ لا مانع من السجود عليها»([504]).
12ـ قال السيّد الخامنئي في (منتخب الأحكام): «يجب الحنوط بالكافور، ويُستحب خلطه بشيء من التربة الحسينيّة»([505]).
13ـ قال السيّد كاظم اليزدي: «السجود علىٰ الأرض أفضل من النبات والقرطاس، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر، وأفضل من الجميع التربة الحسينيّة؛ فإنّها تخرق الحجب السبع وتستنير إلىٰ الأرضين السبع»([506]).
14ـ قال الشيخ الصافي، وهو بصدد بيان ما يحرُم تنجيسه كالمساجد: «ويُلحق بها المشاهد المشرَّفة، والضرائح المقدَّسة، وكلّ ما عُلم من الشرع وجوب تعظيمه علىٰ وجه ينافيه التنجيس كتربة الرسول’، وسائر الأئمّة^، خاصّة التربة الحسينيّة»([507]).
15ـ قال الشيخ الصافي أيضاًً: «يُعتبر في مسجد الجبهة مع الاختيار أن يكون أرضاً أو نباتاً، والأفضل التربة الحسينيّة التي تخرق الحجب السبع وتنوّر إلىٰ الأرضين السبع»([508]).
16ـ سُئل الشيخ التبريزي: شخص أثناء سجوده في المسجد لصق بعض من تربة الإمام الحسين في جبهته، والتفت بعد خروجه من المسجد، فهل يجب إرجاعه إلىٰ المسجد؟
فأجاب: «مفروض السؤال لا شيء عليه، والله أعلم»([509]).
17ـ سُئل السيّد السيستاني: ما هي التربة المقصودة بتربة الحسين التي بها الشفاء؟
فأجاب: «تربة القبر وحواليه إلىٰ ما يقرب (5.11) متراً من كلّ جانب»([510]).
18ـ سُئل الشيخ التبريزي: هل ثواب السجود علىٰ تربة سيّد الشهداء مخصوص بالتربة المقدَّسة، أو يشمل تربة كربلاء؟
فأجاب: «كلّما قرب من القبر الشريف يكون أفضل، والله أعلم»([511]).
19ـ سُئل الشيخ التبريزي أيضاً: وجدنا استفتاءً للسيّد الخوئي& بعدم جواز السجود علىٰ التربة المكتوب عليها اسم الله تعالىٰ، أو النبي’ والأئمّة^، أو آية قرآنية، فلا بدّ من السجود علىٰ الجهة التي لا كتابة عليها؟
فأجاب: «إذا كان محلّ الكتابة بارزاً بحيث لا يتحقق المقدار المعتبر في مس الجبهة في السجود، فيجب السجود علىٰ الجهة الأُخرىٰ، وإلّا فلا بأس، ومع الشك في الوصول وعدمه، فالأحوط السجود علىٰ الجهة الأُخرىٰ، والله العالم»([512]).
20ـ قال هاشم الآملي، وهو في صدد تعيين الموضوع لحكم تعظيم التربة الحسينيّة وإزالة النجاسة عنها: «بأنّ مطلق التراب ولو كان علىٰ القبر الشريف، لا يكون حكمه ذلك، فإنّ التراب الذي يجتمع في الحرم الشريف بواسطة العجّة يكنس ويوضع في المزابل، بل الموضوع هو التربة المأخوذة بقصد الاستشفاء، مع شرائطه بقراءة ثلاث مرات سورة القدر والدعاء المأثور، وهذا العمل ممّا يؤكد ربطها به، بحيث توجد فيها خاصية الشفاء؛ ولذا قالوا: بأنّها بعد الدعاء يوضع علىٰ العين ويمسّها بها، وهذا يكون لكسبها الشرف والعظمة بهذا العمل الخاصّ»([513]).
* القرآن الكريم
(أ)
الاحتجاج، أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، تعليق وملاحظات: محمد باقر الخرسان، الناشر: دار النعمان للطباعة والنشر، النجف الأشرف ـ العراق، 1966م.
الأحكام الواضحة، محمد الفاضل اللنكراني، الناشر: مركز فقه الأئمّة الأطهار الطبعة الخامسة، 1424هـ.ق.
إرشاد القلوب، الحسن بن محمد الديلمي، الناشر: انتشارات الشريف الرضي، الطبعة الثانية، 1415هـ.ق/1374هـ.ش.
الاستبصار فيما اختُلف من الأخبار، محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق: حسن الموسوي الخرسان، الناشر: دار الكتب الإسلامية، طهران ـ إيران.
استفتاءات المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني (مُدّ ظله)، بتاريخ: 1/1/2000م.
إشارة السبق، علي بن الحسن بن أبي المجد الحلبي، تحقيق: إبراهيم بهادري، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأولىٰ، 1414هـ.ق.
الأُمّ، محمد بن إدريس بن العباس المطلبي القريشي المكي الشافعي (ت204هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى 1400ه/1980م.
الأمالي، محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية (مؤسسة البعثة)، الناشر: دار الثقافة، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأولىٰ، 1414هـ.ق.
الأمان من أخطار الأسفار والزمان، علي بن موسىٰ بن طاووس، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، الطبعة الأولىٰ، 1409هـ.ق.
الانتصار، الشريف المرتضىٰ علي بن الحسين الموسوي، تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدّسة ـ إيران، 1415هـ.ق.
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف، جعفر السبحاني، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأولىٰ، 1414هـ.ق.
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع، حسين آل عصفور البحراني، تحقيق: الميرزا محسن آل عصفور، الناشر: المحقّق.
(ب)
بحار الأنوار لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، محمد باقر المجلسي، تحقيق: محمد باقر البهبودي، الناشر: مؤسسة الوفاء، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية المصححة، 1403هـ.ق/1983م.
بحوث في شرح العروة الوثقىٰ، محمد باقر الصدر، مطبعة الآداب، النجف الأشرف ـ العراق، الطبعة الأولىٰ، 1391هـ.ق/1971م.
بداية المجتهد ونهاية المقصد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاشاني الحنفي (ملك العلماء)، الناشر: المكتبة الحبيبة، باكستان، الطبعة الأولىٰ، 1409هـ.ق/1989م.
بصائر الدرجات، محمد بن الحسن بن فروخ الصفّار، تصحيح وتعليق وتقديم: الحاج ميرزا حسن كوچه باغي، منشورات الأعلمي، طهران ـ إيران، 1404هـ.ق/1362هـ.ش.
البيان، (الشهيد الأول) محمد بن مكي الجزيشي العاملي، تحقيق: محمد حسّون، الناشر: المحقّق، الطبعة الأولىٰ، 1412هـ.ق.
(ت)
تحرير الأحكام الشرعية، (العلّامة الحلي) الحسن بن يوسف بن المطهر، تحقيق: إبراهيم البهادري، إشراف: جعفر السبحاني، الناشر: مؤسسة الإمام الصادق، الطبعة الأولىٰ، 1420هـ.ق.
تحرير الوسيلة، روح الله الموسوي الخميني، الناشر: دار الكتب العلمية، مطبعة الآداب، النجف الأشرف ـ العراق، الطبعة الثانية، 1390هـ.ق.
تذكرة الفقهاء، الحسن بن يوسف بن المطهّر، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأولىٰ، 1414هـ.ق.
تعاليق مبسوطة، محمد إسحاق الفيّاض، الناشر: انتشارات محلاتي.
تعليقة علىٰ العروة الوثقىٰ، علي الحسيني السيستاني.
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، محمد فاضل اللنكراني، تحقيق ونشر: مركز فقه الأئمّة الأطهار^، الطبعة الأولىٰ، 1421هـ.ق.
تلخيص المرام في معرفة الأحكام، (العلّامة الحلي)الحسن بن يوسف بن المطهّر، تحقيق: هادي القيسي، الناشر: مركز انتشارات دفتر تبليغات إسلامي، الطبعة الأولىٰ، 1421هـ.ق/1379هـ.ش.
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، مقداد بن عبد الله السيوري الحلي، تحقيق: عبد اللطيف الحسيني الكوه كمري، الناشر: مكتبة آية الله العظمىٰ المرعشي النجفي، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأولىٰ، 1404هـ.ق.
التنقيح في شرح العروة، أبوالقاسم الموسوي الخوئي، تقرير: علي الغروي، الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي+، الطبعة الثانية، 1426هـ/2005م.
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق وتعليق: حسن الموسوي الخرسان، الناشر: دار الكتب الإسلامية، طهران ـ إيران، الطبعة الرابعة، 1365هـ.ش.
(ج)
جامع المقاصد، علي بن الحسين الكركي، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، الطبعة الأُولىٰ، 1408هـ.ق.
الجامع للشرائع، يحيىٰ بن سعيد الحلي، تحقيق: جمع من الفضلاء، إشراف: جعفر السبحاني، الناشر: مؤسسة سيّد الشهداء العلمية، 1405هـ.ق.
جواهر الإكليل (شرح مختصر خليل)، صالح عبد السميع الأزهري.
جواهر الكلام، محمد حسن النجفي، تحقيق وتعليق: عباس القوچاني، الناشر: دار الكتب الإسلامية، طهران ـ إيران، الطبعة الثانية، 1365هـ.ش.
(ح)
حاشية الدسوقي علىٰ الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي.
حاشية رد المحتار، محمد أمين (ابن عابدين).
الحدائق الناضرة، يوسف البحراني، حقّقه وعلّق عليه وأشرف علىٰ طبعة: محمد تقي الإيرواني، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدّسة ـ إيران.
الحصون المنيعة (رد علىٰ كتاب حوار هاديء بين السنّة والشيعة)، حسن عبد الله علي، الناشر: مؤسسة عاشوراء، الطبعة الثانية، 1426هـ/2005م.
(خ)
الخلاف، محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق: جماعة من المحقّقين، الناشر: المؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدّسة ـ إيران، 1407هـ.ق.
كتاب (الخمس)، مرتضىٰ الأنصاري، تحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، الناشر: المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرىٰ المئوية الثانية للشيخ الأنصاري، الطبعة الأُولىٰ، 1415هـ.ق.
(د)
الدر المنضود، علي بن محمد بن طي الفقعاني، تحقيق: محمد بركت، الطبعة الناشر: مكتبة إمام العصرية العلمية، شيراز ـ إيران، الأُولىٰ، 1418هـ.ق.
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجة أمين أفندي.
الدروس الشرعية، محمد بن مكي العاملي، تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الثانية، 1417هـ.ق.
دروس في علم الأصول، محمد باقر الصدر (ت1400هـ)، الناشر: دار الكتاب اللبناني، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 1406هـ/1986م.
دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام، النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي، تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي، الناشر: دار المعارف، القاهرة ـ مصر، 1383هـ/1963م.
الدعوات (سلوة الحزين)، سعيد بن الله المشهور بقطب الدين الراوندي، تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي#، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولىٰ، 1407هـ.ق.
دليل العروة الوثقىٰ، حسن سعيد الطهراني، (تقريرات بحث الشيخ حسين الحلي)، مطبعة النجف، 1382هـ.ق.
(ذ)
ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، محمد باقر السبزواري، الناشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، الطبعة الحجرية، قم المقدّسة ـ إيران.
ذكرىٰ الشيعة في أحكام الشريعة، (الشهيد الأول) جمال الدين محمد بن مكي العاملي، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولىٰ، 1419هـ.ق.
(ر)
الرسـائل الرجالية، محمد بن محمد بن إبرهيم الكلـبـاسي، تحقيـق: محمد حسـين الـدرايـتي، الـناشـر: دار الحـديـث، الطبعـة الأُولىٰ، 1422هـ.ق/1380هـ.ش.
رسائل الكركي، علي بن الحسين الكركي، تحقيق: محمد الحسون، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأولىٰ، 1412هـ.ق.
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، (الشهيد الثاني) زين الدين بن علي العاملي، الناشر: منشورات مكتبة الداوري، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأولىٰ، 1410هـ.ق.
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، (الشهيد الثاني) زين الدين بن علي العاملي، تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، الناشر: بوستان كتاب، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأولىٰ، 1422هـ.ق.
روضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيىٰ بن شرف النووي (ت676هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معرض، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
روضة الواعظين، محمد بن الفتّال النيسابوري، تقديم: محمد مهدي السيّد حسن الخرسان، الناشر: الشريف الرضي، قم المقدّسة ـ إيران.
رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل، علي الطباطبائي، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولىٰ، 1412هـ.ق.
(س)
السجود علىٰ الأرض، علي الأحمدي، الناشر: دار التبليغ الإسلامي.
السجود علىٰ التربة الحسينيّة عند الشيعة الإمامية، عبد الحسين الأميني، الناشر: مركز المستبصرين، التابع لمؤسسة الإمام المهدي#.
السجود علىٰ التربة الحسينيّة، محمد مهدي الخرسان، الناشر: قلم شرق، الطبعة الأولىٰ، 1426هـ/2005م.
السجود.. مفهومه وآدابه والتربة الحسينيّة، الناشر: مركز الرسالة، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأولىٰ، 1420هـ.ق.
سداد العباد ورشاد العباد، محمد آل عصفور الدرازي البحراني، تحقيق: محسن آل عصفور، الناشر: المحلاتي، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأولىٰ، 1421هـ.ق/1379هـ.ش.
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوىٰ، محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلي، تحقيق: لجنة التحقيق، الناشر: المؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الثانية، 1410هـ.ق.
سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق وترقيم وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار الفكر.
سنن أبي داوُد، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي الحنبلي، مراجعة وضبط وتعليق: محمد محي الدين عبد الحميد، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
السنن الكبرىٰ، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، نشر: دار الفكر.
(ش)
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، (المحقّق الحلي) جعفر بن الحسن الحلي، تحقيق: عبد الحسين محمد علي البقّال، الناشر: مؤسسة إسماعيليان، الطبعة الثانية، 1408هـ.ق.
شرح الزرقاني علىٰ موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني.
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع، علي محمد علي الطباطبائي الحائري، تحقيق: مهدي الرجائي، إشراف: محمود المرعشي، الناشر: مكتبة آية الله العظمىٰ النجفي المرعشي، الطبعة الأُولىٰ، 1409هـ.ق.
الشرح الكبير، أبو البركات سيّدي أحمد الدردير، الناشر: دار إحياء الكتب العربية (عيسىٰ البابي الحلبي وشركاءه).
شرح صحيح مسلم، يحيىٰ بن شرف بن مري الحزامي الحواربي الشافعي.
(ص)
الصحاح تاج اللغة العربية، إسماعيل بن حمّاد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت ـ لبنان، الطبعة الرابعة، 1407هـ/1987م.
صحيح ابن خزيمة، محمد بن خزيمة السلمي النيسابوري، تحقيق: د.محمد مصطفىٰ الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1412هـ/1992م.
صحيح البخاري، محمد إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي (ت256هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيرت ـ لبنان، 1401ه/1981م.
صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت261هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيرت ـ لبنان.
صراط النجاة مع تعليقات الميرزا جواد التبريزي، أبوالقاسم الخوئي، الناشر: دفتر برگزيدة، قم ـ إيران، الطبعة الأُولىٰ، 1416هـ.ق.
(ط)
كتاب الطهارة، مرتضىٰ الأنصاري، تحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، الناشر: مجمع الفكر الإسلامي، الطبعة الثالثة، 1428هـ.ق.
(ع)
العباب الزاخر واللباب الفاخر، الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمري الصغاني الحنفي.
عدّة الداعي ونجاح الساعي، أحمد بن فهد الحلي، تصحيح وتعليق: أحمد الموحدي القمي، الناشر: مكتبة وجداني، قم المقدّسة ـ إيران.
العروة الوثقىٰ (مع تعليقات)، محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولىٰ، 1417هـ.ق.
العمل الأبقىٰ في شرح العروة الوثقىٰ، علي بن محمد بن شبرالحسيني، الناشر: مطبعة النجف ـ الواق، 1383هـ.ق.
عوائد الأيام، أحمد النراقي، تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأولىٰ، 1417هـ.ق/1375هـ.ش.
كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د.مهدي المخزومي، د.ابراهيم السامرائي، الناشر: مؤسسة دار الهجرة، الطبعة الثانية، 1410هـ.ق.
عيون أخبار الرضا، محمد بن علي الصدوق (381هـ) نشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان.
(غ)
غايـة المـراد في شرح نكت الرشـاد، (الشهيد الأوّل) محمد بن مكي العاملي، تحقيـق: مركز الأبحـاث والدراسات الإسلامية، الـناشر: مركـز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأولىٰ، 1420هـ.ق/1387هـ.ش.
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، مفلح بن الحسين الصيمري، تحقيـق: جعفر الكوثراني العاملي، الناشر: دار الهدىٰ، الطبعة الأولىٰ، 1420هـ.ق/1999م.
غنائم الأيام، الميرزا أبوالقاسم القمي، تحقيق: عباس تبريزيان، الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأولىٰ، 1417هـ.ق/1375هـ.ش.
غنية النزوع إلىٰ علمي الأصول والفروع، حمزة بن علي بن زهرة الحلبي (الجوامع الفقهية ـ الطبعة الحجرية).
(ف)
الفتاوىٰ الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، نظام الدين البلخي وجماعة، الناشر: دار الفكر، 1411هـ.ق/1911م.
فتح الباري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية.
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت1250هـ)، الناشر: عالم الكتب، الرياض.
فقه الصادق، محمد صادق الحسيني الروحاني، الناشر: مؤسسة دار الكتاب، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الثالثة، 1412هـ.ق.
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية، (الشهيد الثاني) زين الدين بن علي العاملي، تحقيق: مركز الأبحاث الإسلامي، الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأُولىٰ، 1420هـ.ق/1387هـ.ش.
(ق)
القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي (ت871هـ).
القواعد الفقهية، محمد حسن البجنوردي، تحقيق: مهدي المهريزي، ومحمد حسن الدرايتي، الناشر: نشر الهادي، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأولىٰ، 1419هـ.ق/1377هـ.ش.
(ك)
الكافي، محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، الناشر: دار الكتب الإسلامية، طهران ـ إيران، الطبعة الخامسة، 1363هـ.ش.
كامل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه القمي، تحقيق: الشيخ جواد القيومي (لجنة التحقيق)، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة، الطبعة الأُولىٰ، 1417هـ.ق.
كشّاف القناع، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت1051هـ)، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، منشورات: محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأُولى، 1418ه/1997م.
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس، مفلح بن الحسن الصميري (الطبعة الحجرية).
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء، جعفر كاشف الغطاء، تحقيق: مكتب الإعلام الإسلامي ـ فرع خراسان، مركز انتشارات دفتر تبليغات (مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلام)، الطبعة الأولىٰ، 1422هـ.ق/1380هـ.ش.
كشف اللئام، (الفاضل الهندي) بهاء الدين محمد بن الحسن الأصفهاني، تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأولىٰ، 1416هـ.ق.
كفاية الأثر، علي بن محمد بن علي الخزاز القمي الزازي، تحقيق: السيّد عبد اللطيف الحسيني الكوه كمري، الناشر: انتشارات بيدار، 1401هـ.ق.
كفاية الفقه، المعروف بـ(كفاية الأحكام)، محمد باقر الموسوي، تحقيق: مرتضىٰ الواعظي الأراكي، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولىٰ، 1423هـ.ق.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعـال، علاء الدين علي المتقي بن حسـام الدين الهندي، ضبط وتفسير: الشيخ بكري حياني، تصحيح وفهرسـة: الشيخ صفوة السقا، الناشر مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، 1409هـ.ق/1989م.
(ل)
لماذا اخترت مذهب أهل البيت، محمد مرعي الأمين الأنطاكي، تحقيق: عبد الكريم العقلي، الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأولىٰ، 1417هـ.ق/1375هـ.ش.
اللمعة الدمشقية، (الشهيد الأول) محمد بن مكي العاملي، الناشر: دار الفكر، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولىٰ، 1411هـ.ق.
لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظور الإفريقي المصري (ت711هـ)، نشر: أدب الحوزة، قم ـ إيران، 1405ه.
(م)
مباني الفقه الفعّال في القواعد الفقهية الأساسية، علي أكبر السيفي المازندراني، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولىٰ، 1425هـ.ق.
المبسوط في فقه الإمامية، محمد بن الحسن بن علي الطوسي، تحقيق وتعليق: محمد تقي الكشفي، الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية، 387هـ.ق.
مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي، تحقيق: أحمد الحسيني، الناشر: مرتضوي، الطبعة الثانية، 1362هـ.ش.
مجمع الزوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 1408هـ.ق/1988م.
مجمع الفائدة والبرهان، المولىٰ أحمد المقدّس الأردبيلي، تحقيق: مجتبىٰ العراقي، وعلي پناه الاشتهاردي، وحسين اليزدي الأصفهاني، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة الأُولىٰ، 1412هـ.ق.
المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي، الناشر: دار الفكر، بيروت ـ لبنان.
المحلىٰ بالآثار، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الناشر: دار الفكر، بيروت ـ لبنان.
مختلف الشيعة، الحسن بن يوسف بن المطهّر المشهور بالعلّامة الحلي، تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الثانية، 1413هـ.ق.
مدارك الأحكام، السيّد محمد بن علي الموسوي العاملي، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، مشهد المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأولىٰ، 1410هـ.ق.
مدارك العروة، علي پناه الاشتهاردي، الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر، الطبعة الأُولىٰ، 1417هـ.ق.
مدارك تحرير الوسيلة، مرتضىٰ بني فضل، تحقيق ونشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني&، الطبعة الأُولىٰ، 1422هـ.ق/1380هـ.ش.
المراسم العلوية، حمزة بن عبد العزيز الديلمي، تحقيق: محسن الحسيني الأميني، الناشر: المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت^، 1414هـ.ق.
المزار، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المشهور بالمفيد، تحقيق: محمد باقر الأبطحي، الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1414هـ.ق/1993م.
المزار، محمد بن جعفر المشهدي، تحقيق: جواد القيومي الإصفهاني، الناشر: القيوم، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولىٰ، 1419هـ.ق.
مسالك الإفهام، زين الدين بن علي العاملي المشهور بالشهيد الثاني، تحقيق ونشر: مؤسسة المعارف الإسلامية، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولىٰ، 1413هـ.ق.
مستدرك أعيان الشيعة، حسن الأمين، الناشر: دار التعارف للمطبوعات، سنة 1409هـ.ق/1989م.
مستدرك الوسائل، حسين النوري الطبرسي، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، الطبعة الثانية، 1408هـ.ق/1988م.
مستمسك العروة الوثقىٰ، محمد محسن الطباطبائي الحكيم، الناشر: مكتبة آية الله العظمىٰ المرعشي النجفي، قم المقدّسة ـ إيران، طبعة أوفست عن الطبعة الرابعة، مطبعة الآداب، النجف الأشرف ـ العراق، 1391هـ.ق.
مستند الشيعة في أحكام الشريعة، أحمد بن محمد النراقي، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، مشهد المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأولىٰ، 1415هـ.ق.
مسند أبي يعلىٰ، أحمد بن علي بن المثنىٰ التميمي (ت307ه)، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق ـ سوريا.
مسند أحمد، أحمد بن حنبل، الناشر: دار صادر، بيروت ـ لبنان.
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع، محمد باقر الوحيد البهبهاني، تحقيق ونشر: مؤسسة العلّامة المجدد الوحيد البهبهاني، الطبعة الأُولىٰ، 1424هـ.ق.
مصباح الفقيه، أغا رضا بن محمد هادي الهمداني، تحقيق: المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث، الناشر: منبع، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأولىٰ، 1422هـ.ق.
مصباح المتهجِّد، محمد بن الحسن بن علي الطوسي، الناشر: مؤسسة فقه الشيعة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولىٰ، 1411هـ/1991م.
المصباح المنير، أحمد بن علي المقري الفيومي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان.
مصباح الهدىٰ في شرح الوثقىٰ، محمد تقي الآملي، الطبعة الأُولىٰ، 1380هـ.ق.
مصطلحات الفقه، علي أكبر المشكيني، الناشر: نشر الهادي، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأولىٰ، 1419هـ.ق.
المعالم الزلفىٰ في شرح العروة الوثقىٰ، عبد النبي النجفي العراقي، 1380هـ.ق/1339هـ.ش.
المعالم المأثورة، محمد علي الإسماعيل پور القمشه اي القمي (تقرير بحث الفقه (الطهارة) للميرزا هاشم الآملي النجفي)، الناشر: المؤلف، الطبعة الأُولىٰ، 1409هـ.ق/1367هـ.ش.
المعتبر، جعفر بن الحسن المشهور بالمحقّق الحلي، تحقيق وتصحيح: عدّة من الأفاضل، بإشراف: ناصر مكارم الشيرازي، الناشر: مؤسسة سيّد الشهداء، قم المقدّسة ـ إيران، 1364 هـ.ش.
معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، 1399هـ/1979م.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري، د.أحمد فتح الله، الطبعة الأولىٰ، 1415هـ/1995م.
معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي، 1404هـ.ق.
مغني المحتاج إلىٰ معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الشربيني الخطيب، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، 1377هـ/1958م.
المغني، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (ت620هـ)، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان.
مفاتيح الشرائع، محمد محسن الفيض الكاشاني، تحقيق: السيّد مهدي الرجائي، الناشر: مجمع الذخائر الإسلامية، 1401هـ.ق.
مفتاح الكرامة، محمد جواد الحسيني العاملي، تحقيق وتعليق: محمد باقر الخالصي، الناشر: مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولىٰ، 1419هـ.ق.
المقاصد العلية، زين الدين بن علي العاملي المشهور بالشهيد الثاني، التحقيق: مركز الأبحاث والدراسـات الإسلامية (محمد الحسون ـ قسم إحياء التراث الإسلامي)، الـناشر: مركز انتشـارات دفتر تبليغـات إسلامي ـ مركز النشـر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأُولىٰ، 1420هـ.ق/1378هـ.ش.
المقنعة، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المشهور بالمفيد، تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الثانية، 1410هـ.ق.
مكارم الأخلاق، الحسن بن الفضل الطبرسي، الناشر: الشريف الرضي، الطبعة السادسة، 1392هـ.ق/1972م.
المكاسب، مرتضىٰ الأنصاري، تحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، الناشر: المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرىٰ المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري، الطبعة الأُولىٰ، 1415هـ.ق.
مَن لا يحضرهُ الفقيه، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، الناشر: مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الثانية.
المناهل، محمد بن علي الطباطبائي، الطبعة الحجرية.
منتخب الأحكام، علي الخامنئي، إعداد: حسن فياض.
منتهىٰ المطلب في تحقيق المذهب، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر، تحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية، الطبعة الأولىٰ، سنة 1412هـ.ق.
منهاج الصالحين، السيّد أبوالقاسم الخوئي، الناشر: مدينة العلم (آية الله العظمىٰ السيّد الخوئي)، الطبعة الثامنة والعشرون، 1410هـ.ق.
منهاج الصالحين، علي الحسيني السيستاني، الناشر: مكتب آية الله السيّد السيستاني، الطبعة الأُولىٰ، 1414هـ.ق.
منهاج الصالحين، محسن الطباطبائي الحكيم، الناشر: دار التعارف للمطبوعات، 1410هـ/1990م.
منهاج الصالحين، محمد إسحاق الفيّاض، الناشر: مكتب سماحة الشيخ محمد إسحاق الفياض، الطبعة الأُولىٰ.
منهاج الصالحين، محمد الحسيني الروحاني، الناشر: مكتبة الألفين، الكويت، الطبعة الثانية، 1414هـ.ق/1994م.
منهاج الصالحين، وحيد الخراساني.
منهاج المؤمنين، شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي، الناشر: مكتبة آية الله العظمىٰ المرعشي، 1406هـ.ق.
منهاج الهداية، إبراهيم الكلباسي (مخطوط).
منية السائل، أبوالقاسم الخوئي، جمعه ورتّبه: موسىٰ مفيد الدين عاصي، 1412هـ/1991م.
مُنية الطالب في شرح المكاسب، موسىٰ بن محمد النجفي الخوانساري (تقريرات الميرزا محمد حسين النائيني)، تحقيق ونشر: مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولىٰ، 1418هـ.ق.
مهذّب الأحكام، عبد الأعلىٰ السبزواري، إخراج: مؤسسة المنار، الطبعة الرابعة، الناشر: مكتب آية الله العظمىٰ السبزواري، 1413هـ.ق.
المهذب البارع، أحمد بن محمد بن فهد الحلي، تحقيق: مجتبىٰ العراقي، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدّسة ـ إيران، 1412هـ.ق.
المهذب، القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي، إعداد مؤسسة سيّد الشهداء، إشراف: جعفر السبحاني، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، 1406هـ.ق.
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، محمد بن محمد عبد الرحمن المغربي.
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت^ تأليف وتحقيق ونشر: مؤسسة دائرة معارف أهل البيت^، الطبقة الأولىٰ، 1423هـ/2002م.
الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية، 1404هـ.ق/1427هـ.ق.
الموسوعة الفقهية الميسرة، محمد علي الأنصاري، الناشر: مجمع الفكر الإسلامي، الطبعة الأُولىٰ، 1420هـ.ق.
(ن)
نكت النهاية، جعفر بن الحسن الحلي المشهر بالمحقّق الحلي، تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولىٰ، 1412هـ.ق.
نهاية المحتاج إلىٰ شرح المنهاج في الفقه علىٰ مذهب الإمام الشافعي، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري الأنصاري (الشافعي الصغير) (ت1004هـ)، دار إحياء التراث العربي - مؤسسة التاريخ العربي، بيروت – لبنان، الطبعة الأُولى، 1412ه/1992م.
النهاية في مجرد الفقه والفتوىٰ، محمد بن الحسن بن علي الطوسي، انتشارات: قدس محمدي، قم المقدّسة ـ إيران.
نيل الأوطار من أحاديث سيّد الأخيار (شرح متقىٰ الأخبار)، محمد بن علي ابن محمد الشوكاني، الناشر: دار الجيل، بيروت ـ لبنان، 1973م.
(هـ)
هداية الأُمّة إلىٰ أحكام الأئمّة، الحرّ العاملي محمد بن الحسن، تحقيق: قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية، الناشر: مجمع البحوث الإسلامية، مشهد المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأولىٰ، 1412هـ.ق،.
هداية العباد، لطف الله الصافي الگلپایگاني، الناشر: مؤسسة السيّدة المعصومة‘، الطبعة الأولىٰ، 1420هـ.ق.
الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي أكبر بن عبد الجليل الفرغاني المرغياني.
هدىٰ الطالب إلىٰ شرح المكاسب، محمد جعفر الجزائري المروّج، الناشر: دار المجتبىٰ، الطبعة الثانية، 1383هـ.ش.
(و)
وسائل الشيعة، الحرّ العاملي محمد بن الحسن، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الثانية، 1414هـ.ق.
وسيلة النجاة مع تعليق: الإمام روح الله الخميني، أبوالحسن الإصفهاني، تحقيق ونشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران ـ إيران، الطبعة الأولىٰ، 1422هـ.ق.
وسيلة النجاة مع تعليق: محمد رضا الموسوي الگلپایگاني، أبوالحسن الإصفهاني، الطبعة الأُولىٰ، سنة 1393هـ.ق.
الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة، محمد علي الطوسي المعروف بابن حمزة، تحقيق: محمد الحسون، إشراف: محمود المرعشي، الناشر مكتبة آية الله العظمىٰ المرعشي النجفي، الطبعة الأولىٰ، 1418هـ.ق.
[1] البقرة: آية31.
[2] المجادلة: آية11.
[3] البقرة: آية129.
[4] آل عمران: آية164.
[[5]][5] الكفعمي، إبراهيم، المصباح: ص280.
[6] البقرة: آية253.
[7] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص423.
[8] الخزاز القمي، محمد بن علي، كفاية الأثر: ص16ـ17.
[9] اُنظر: الخرسان، محمد مهدي، السجود علىٰ التربة الحسينيّة: ص291 ـ 292.
[10] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج2، ص60.
[11] الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج9، ص187.
[12] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ ابن عساكر(ترجمة الإمام الحسين×): ص168 ـ 169.
[13] الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج9، ص190.
[14] المصدر السابق.
[[15]][15] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام الحسين×): ص177.
[16] الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: ج5، ص104.
[17] اُنظر: ابن أعثم الكوفي، أحمد، تاريخ ابن أعثم: ج4، ص215 ـ 216.
[18] اُنظر: الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج1، ص237.
[19] الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج1، ص237.
[20] الخرسان، محمد مهدي، السجود علىٰ تربة الحسينيّة: ص321 ـ 322.
[21] اُنظر: الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج20، ص33.
[22] اُنظر: الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج9، ص190. المتقي الهندي، علي بن حسام، كنز العمال: ج13، ص113.
[23] اُنظر: الخرسان، محمد مهدي، السجود علىٰ التربة الحسينيّة: ص323.
[24] الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج1، ص237 ـ 239.
[25] الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجِّد: ص733 ـ 734.
[26] الديلمي، الحسن بن محمد، إرشاد القلوب: ص115.
[27] الصدوق، محمد بن علي، مَن لايحضره الفقيه: ج1، ص268.
[28] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج9، ص455 ـ 456.
[29] اُنظر: كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء: ج2، ص397. المازندراني، علي أكبر، مباني الفقه الفعّال: ج1، ص147، وما بعدها.
[30] ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة: ج5، ص393 ـ 394.
[31] الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج6، ص55.
[32] الصغاني، الحسن بن محمد، العباب الزاخر: ج1، ص202.
[33] الهمداني، رضا بن محمد، مصباح الفقيه: ج7، ص7.
[34] اُنظر: الأنصاري، مرتضـىٰ، كتاب الطهارة: ج5، ص19ـ 20. المشكيني، علي أكبر، مصطلحات الفقه: ص530.
[[35]][35] اُنظر: فتح الله، أحمد، معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ص427.
[36] اُنظر: النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج5، ص273 ـ 274.
[37] اُنظر: ابن فهد الحلي، أحمد بن محمد، المهذّب البارع: ج4، ص219 ـ 221.
[38] اُنظر: الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية: ج7، ص326 ـ 327.
[39] اُنظر: العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة: ج2، ص100.
[40] ومراده من الأرمني: الطين الأرمني المخصوص المأخوذ من قبر ذي القرنين×. اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجِّد: ص732.
[41] ابن فهد الحلي، أحمد بن محمد، المهذّب البارع: ج4، ص220 ـ 221.
[42] الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية: ج7، ص327.
[43] اُنظر: الصيمري، مفلح بن الحسن، غاية المرام: ج4، ص65.
[44] اُنظر: البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج2، ص48.
[45] اُنظر: كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء: ج2، ص362.
[46] اُنظر: النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج6، ص98.
[47] اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقىٰ: ج1، ص189. اُنظر: الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقىٰ: ج1، ص518. الصدر، محمد باقر، بحوث في شرح العروة الوثقىٰ: ج4، ص320 ـ 321. الغروي، علي، التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ: ج3، ص395. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج1، ص480. زين الدين، محمد أمين، كلمة التقوىٰ: ج1، ص54. السيستاني، علي، منهاج الصالحين: ج1، ص147.
[48] اُنظر: النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج4، ص224.
[49] اُنظر: ابن فهد الحلي، أحمد بن محمد، المهذّب البارع: ج4، ص220. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج2، ص48. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج2، ص51 ـ 52. وج4، ص222 ـ 223. الطهراني، حسن سعيد، دليل العروة الوثقىٰ (تقريرات بحث الشيخ حسين الحلي+): ج2، ص156 ـ 159. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج1، ص480. المازندراني، علي أكبر، مباني الفقه الفعّال: ج1، ص148، وص154 ـ 155. البجنوردي، محمد حسن، القواعد الفقهية: ج5، ص293 ـ 294، وص303.
[50] اُنظر: الطهراني، حسن سعيد، دليل العروة الوثقىٰ (تقريرات بحث الشيخ حسين الحلي+): ج2، ص156.
[51] اُنظر: البجنوردي، محمد حسن، القواعد الفقهية: ج5، ص296. الطهراني، حسن سعيد، دليل العروة الوثقىٰ (تقريرات بحث الشيخ حسين الحلي+): ج2، ص157. المازندراني، علي أكبر، مباني الفقه الفعّال: ج1، ص152.
[52] اُنظر: الطهراني، حسن سعيد، دليل العروة الوثقىٰ (تقريرات بحث الشيخ حسين الحلي+): ج2، ص157 ـ 158. النراقي، أحمد بن محمد مهدي، عوائد الأيّام: ص31.
[53] البجنوردي، محمد حسن، القواعد الفقهية: ج5، ص295 ـ 296.
[54] الحج: آية30.
[55] الحج: آية32.
[56] اُنظر: البجنوردي، محمد حسن، القواعد الفقهية: ج5، ص299.
[57] الحج: آية36.
[58] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج5، ص87.
[59] المصدر السابق: ج29، ص329.
[60] المصدر السابق: ج17، ص308.
[61] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج13، ص290.
[62]المصدر السابق: ج28، ص367 ـ 368، واُنظر ـ لوجه الاستدلال ـ: المازندراني، علي أكبر، مباني الفقه الفعّال: ج1، ص155 ـ 159. البجنوردي، محمد حسن، القواعد الفقهية: ج5، ص299 ـ 300.
[63] اُنظر: الأنطاكي، محمد مرعي، لماذا اخترت مذهب أهل البيت^: ص470. الأنصاري، محمد علي، الموسوعة الفقهية الميسّرة: ج8، ص353.
[64] اُنظر: ابن فهد الحلي، أحمد بن محمد، عدّة الداعي: ص48. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص537.
[65] السيوري، مقداد بن عبد الله، التنقيح الرائع: ج4، ص51.
[66] الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقىٰ: ج1، ص518.
[67] العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة: ج2، ص101.
[68] اُنظر: البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج2، ص44. النجفي العراقي، عبد النبي، المعالم الزلفىٰ: ص473.
[69] اُنظر: السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج1، ص480.
[70] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص511.
[71] المصدر السابق: ج14، ص513 ـ 514.
[72] اُنظر: الآملي، محمد تقي، مصباح الهدىٰ في شرح العروة الوثقىٰ: ج2، ص43. النجفي، عبد النبي، المعالم الزلفىٰ: ج1، ص743.
[73] اُنظر: النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج6، ص98. الطهراني، حسن سعيد، دليل العروة الوثقىٰ (تقريرات بحث الشيخ حسين الحلي+): ج2، ص157.
[74] اُنظر: السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج1، ص480. الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقىٰ: ج1، ص519.
[75] اُنظر: النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج4، ص223 ـ 224. البجنوردي، محمد حسن، القواعد الفقهية: ج5، ص296 ـ 297. المازندراني، علي أكبر، مباني الفقه الفعّال: ج1، ص150 ـ 151.
[76] اُنظر: النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج6، ص98. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج1، ص480.
[77] اُنظر: الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقىٰ: ج1، ص515 ـ 518.
[78] اُنظر: الآملي، محمد تقي، مصباح الهدىٰ في شرح العروة الوثقىٰ: ج2، ص46.
[79] الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية: ج7، ص327.
[80] اُنظر: العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة: ج2، ص101.
[81] اُنظر: ابن فهد الحلي، أحمد بن
محمد، المهذّب البارع: ج4، ص220. السيوري، مقداد بن
عبد الله، التنقيح الرائع: ص4، ص51. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي،
الروضة البهية: ج7، ص327، وص337. كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء: ج2، ص362، وص396
ـ 397. الصيمري، مفلح بن الحسن، غاية المرام: ج4، ص65. النجفي، محمد حسن،
جواهر الكلام: ج6، ص98 ـ 99. النجفي العراقي، عبد النبي، المعالم الزلفىٰ: ج1،
ص473 ـ 476. الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقىٰ: ص1، ص518. العاملي، محمد جواد،
مفتاح الكرامة: ج2، ص99 ـ 102. الغروي، علي، التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ: ج3،
ص295. الصدر، محمد باقر، بحوث في شرح العروة الوثقىٰ: ج4، ص320 ـ 321. السبزواري،
عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج1، ص480. الحسيني، علي شبر، العمل الأبقىٰ: ج1،
ص446.
الطهراني، حسن سعيد، دليل العروة الوثقىٰ (تقريرات
بحث الشيخ حسين الحلي+): ج2، ص156 ـ 159، وص161. الآملي، محمد تقي، مصباح الهدىٰ
في شرح العروة الوثقىٰ: ج2، ص46. اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقىٰ: ج1، ص189. الفيّاض،
محمد إسحاق، تعاليق مبسوطة: ج1، ص113. السيستاني، علي، استفتاءات: ص13، وغيرها.
[82] اُنظر: النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج36، ص367. الطهراني، حسن سعيد، دليل العروة الوثقىٰ (تقريرات بحث الشيخ حسين الحلي+): ج2، ص261.
[83] اُنظر: كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء: ج2، ص363.
[84] اُنظر: الصدر، محمد باقر، بحوث في شرح العروة الوثقىٰ: ج4، ص320 ـ 321. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج1، ص480.
[85] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص228.
[86] اُنظر: السيوري، مقداد بن عبد الله، التنقيح الرائع: ج4، ص51.
[87] اُنظر: الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقىٰ: ج1، ص518. الحكيم، محسن، منهاج الصالحين: ج1، ص158.
[88] اُنظر: الصدر، محمد باقر، بحوث في شروح العروة الوثقىٰ: ج3، ص320 ـ 321.
[89] اُنظر: الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقىٰ: ج1، ص518. الهمداني، رضا بن محمد، مصباح الفقيه: ج8، ص58.
[90] اُنظر: النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج2، ص49.
[91] كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء: ج2، ص397.
[92] اُنظر: النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج6، ص97 ـ 98.
[93] اُنظر: الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط: ج4، ص392. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير: ص594. الجوهري، إسماعيل بن حمّاد، الصحاح: ج6، ص2502.
[94] النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج2، ص13.
[95] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف: ج1، ص103 ـ 104. الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء: ج1، ص123. العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة: ج1، ص181. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج2، ص14، وص22.
[96] اُنظر: السيّد المرتضىٰ، علي بن الحسين، الانتصار: ص119. الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد: ج1، ص108وص129. العاملي، محمد بن علي، مدارك الأحكام: ج1، ص124. الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام: ج1، ص247. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج1، ص357، وص411 ـ 414. الحكيم، محسن، مستمسك العروة: ج1، ص239.
[97] اُنظر: البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج2، ص29. العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة: ج1، ص44. النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة: ج1، ص372. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج2، ص39.
[98] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوىٰ: ص10. ابن البراج، عبد العزيز، المهذب: ج1، ص40. الحلي، الحسن بن يوسف، منتهىٰ المطلب: ج1، ص280. العاملي، محمد ابن علي، مدارك الأحكام: ج1، ص173. العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة: ج1، ص47. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج2، ص53. الحكيم، محسن، مستمسك العروة: ج2، ص218.
[99] اُنظر: النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج2، ص35.
[100] اُنظر:ابن إدريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر:ج1، ص27. الحلي، الحسن بن يوسف، منتهىٰ المطلب: ج1، ص280. العاملي، محمد بن علي، مدارك الأحكام: ج1، ص172. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج2، ص51 ـ 52. الأنصاري، محمد علي، الموسوعة الفقهية الميسرة: ج3، ص113.
[101] اُنظر: القمشه اي، محمد علي، المعالم المأثورة، (تقرير بحث الميرزا هاشم الآملي النجفي): ج4، ص117 ـ 118.
[102] الخوئي، أبو القاسم، صراط النجاة (تعليق الميرزا التبريزي): ج1، ص437.
[103]النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج2، ص51 ـ 52.
[104] يعني: ما هناك من محلّ النجاسة.
[105] الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط: ج1، ص17.
[106] الحلي، الحسن بن يوسف، منتهىٰ المطلب: ج1، ص280.
[107] البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج2، ص42.
[108] الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام: ج1، ص212.
[109] اُنظر: البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج2، ص44. الروحاني، محمد صادق، فقه الصادق×: ج1، ص208 ـ 209.
[110] اُنظر: النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج2، ص51 ـ 52.
[111] المصدر السابق: ج2، ص52.
[112] اُنظر: كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء: ج2، ص146 ـ 147.
[113] الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص320 ـ 321. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج2، ص45 ـ 46.
[114] النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج2، ص52. اُنظر: الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، المقاصد العلية: ص14. الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد: ج1، ص98. الكركي، علي ابن الحسين، رسائل الكركي: ج3، ص217. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذب الأحكام: ج2، ص202. وغيرها.
[115] اُنظر: اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقىٰ مع التعليقات: ج1، ص337. الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقىٰ: ج2، ص224. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذب الأحكام: ج2، ص206.
[116] اُنظر: اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقىٰ مع التعليقات: ج1، ص337. الخوئي، أبو القاسم، شرح العروة الوثقىٰ: ج4، ص388. الروحاني، محمد صادق، فقه الصادق:ج1، ص210.
[117] اُنظر ما تقدَّم في الهامش السابق. وأيضاً: الفيّاض، محمد إسحاق، تعاليق مبسوطة: ج1، ص217. السيستاني، علي، تعليقة علىٰ العروة الوثقىٰ: ج1، ص136.
[118] اُنظر: الشهيد الأول، محمد بن مكي، الدروس الشرعية: ج1، ص89. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام: ج1، ص29. الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد: ج1، ص98. العاملي، محمد بن علي، مدارك الأحكام: ج1، ص173. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع: ج1، ص42. الصيمري، مفلح بن الحسن، كشف الالتباس: ص22. العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة: ج1، ص213 ـ 215.
[119] اُنظر: ابن زهرة الحلبي، حمزة بن علي، غنية النزوع:ص487.
[120] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية: ج1، ص213. المحقّق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام: ج1، ص11. المحقّق الحلي، جعفر بن الحسن، المُعتبر: ج1، ص133. العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة: ج1، ص213 ـ 214. الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام: ج1، ص214. النجفي، محمد بن الحسن، جواهر الكلام: ج2، ص54.
[121] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط: ج1، ص16. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج2، ص47.
[122] اُنظر: الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام: ج1، ص214.
[[123]][123] السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج2، ص202 ـ 203.
[124] الفيّاض، محمد إسحاق، تعاليق مبسوطة: ج1، ص216.
[125] الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة: ج1، ص19.
[126] السيستاني، علي، تعليقة علىٰ العروة الوثقىٰ: ج1، ص135.
[127] الغروىٰ، علي، التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ (تقريرات أبي القاسم الخوئي): ج4، ص377.
[128] الروحاني، محمد صادق، فقه الصادق×: ج1، ص209 ـ 210.
[129] اُنظر: السبزواري، ملا محمد باقر، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد: ج1، ق1، ص22. الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقىٰ: ج2، ص246 ـ 247. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج2، ص234. كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء: ج2، ص160.
[130] تنقيح المناط هو: أن يُفتَّش عن ملاك الحكم ومناطه، فيُعمّم هذا الحكم إلىٰ مسألة أُخرىٰ يُتوافر فيها ذلك الملاك والمناط إن كان قطعيّاً، وإلّا فلا يُعمّم. اُنظر: فتح الله، أحمد، معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ص127.
[131] اُنظر: الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقىٰ: ج2، ص247 ـ 248. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج2، ص234.
[132] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج1، ص330.
[133] المصدر السابق: ج1، ص332.
[134] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج1، ص331.
[135] المصدر السابق: ج1، ص333.
[136] اُنظر: البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج2، ص82.
[[137]][137] اُنظر: النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة: ج1، ص400 ـ 401.
[138] اُنظر: الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقىٰ: ج2، ص247 ـ 248.
[139] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج4، ص186.
[140] النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة: ج1، ص400 ـ 401.
[141] اُنظر: الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقىٰ: ج2، ص246 ـ 248.
[142] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج1، ص331.
[143] اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا×: ج2، ص55.
[144] اُنظر: النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة: ج1، ص401.
[145] اُنظر: البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج2، ص82 ـ 83. النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة: ج1، ص402.
[146] اليزدي، محمد كاظم العروة الوثقىٰ: ج1، ص189 ـ 190.
[147] الخوئي، أبو القاسم، صراط النجاة (مع تعليقة الميرزا التبريزي): ج1، ص437.
[148] اُنظر: اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقىٰ (مع تعليقات الفقهاء): ج1، ص190.
[149] اُنظر: الصدر، محمد باقر، بحوث في شرح العروة الوثقىٰ: ج4، ص321. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج1، ص480.
[150] الشبهة الموضوعية: هي أن يكون الشكّ بتحقّق الموضوع مع العلم بالحكم، فمثلاً: نحن نعلم أنّ شرب الخمر حرام، لكن نشكّ في أنّ هذا السائل المُعيَّن الذي في القدح هل هو خمر أو لا؟. اُنظر: الصدر، محمد باقر، دروس في علم الأُصول: ج2، ص329.
[151] اُنظر: الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقىٰ: ج1، ص519. الطهراني، حسن سعيد، دليل العروة الوثقىٰ (تقريرات بحث الشيخ حسين الحلي+): ج2، ص162. الصدر، محمد باقر، بحوث في شرح العروة الوثقىٰ: ج4، ص321. الغروي، علي، التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ (تقرير لبحوث السيّد الخوئي&): ج3، ص295 ـ 296، (ضمن الدورة).
[152] اُنظر: الغروي، علي، التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ (تقرير لبحوث السيّد الخوئي&): ج3، ص295 ـ 296. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج1، ص480. النجفي، عبد النبي، المعالم الزلفىٰ: ج1، ص476. الآملي، محمد تقي، مصباح الهدىٰ في شرح العروة الوثقىٰ: ج2، ص47. القمشه اي، محمد علي، المعالم المأثورة (تقرير بحث الفقه في الطهارة للميرزا هاشم الآملي النجفي): ج3، ص60.
[153] النساء: آية43.
[154] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج2، ص240، وج5، ص161. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج3، ص350.
[155] اُنظر: العاملي، محمد بن علي، مدارك الأحكام: ج1، ص340. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج10، ص127.
[156] اُنظر: الكاشاني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع: ج1، ص105. ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار: ج1، ص300 ـ 320. الآبي، صالح، جواهر الإكليل: ج1، ص48. النووي، يحيىٰ ابن شرف، روضة الطالبين: ج1، ص255. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهيّة الكويتية: ج27، ص131 ـ 132، وج24، ص202.
[157] وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهيّة الكويتية: ج27، ص131 ـ 132، وج24، ص202.
[158] اُنظر: الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاج: ج1، ص168. ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد، المغني: ج1، ص524.
[159] اُنظر: البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج8، ص276. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج10، ص135. ابن رشد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد: ج1، ص330، وص382 ـ 383.
[[160]][160] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف: ج1، ص357. العلّامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء: ج2، ص434 ـ 435. العلّامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهىٰ المطلب: ج4، ص351 ـ 353. الشهيد الأوّل، محمد بن مكي، ذكرىٰ الشيعة: ج2، ص138.
[161] السجستاني، سليمان، سنن أبي داوُد: ج1، ص227.
[162] ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري: ج2، ص13. النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج1، ص433.
[163]البُسط والثياب التي لها خمل رقيق. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج1، ص47.
[164] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج5، ص348 ـ 347.
[165] المصدر السابق: ج5، ص343.
[166] الشافعي، محمد بن إدريس، الأُم: ج1، ص91. ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد، المغني: ج1، ص593. النووي، يحيى بن شرف، المجموع: ج3، ص425. ابن حزم، علي، المحلّىٰ بالآثار: ج4، ص83. المرغيناني، علي، الهداية: ج1، ص50. ابن همام، محمد، فتح القدير: ج1، ص265. الدردير، أحمد بن محمد، الشرح الكبير: ج1، ص252.
[167] الشافعي، محمد بن إدريس، الأُم: ج1، ص91.
[168] اُنظر: العلّامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء: ج2، ص435.
[169] اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج5، ص305.
[170] اُنظر: الشافعي، محمد بن إدريس، الأُم: ج1، ص91. ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد، المغني: ج1، ص593. النووي، يحيى بن شرف، المجموع: ج3، ص425. ابن حزم، علي، المحلّىٰ بالآثار: ج4، ص83. المرغيناني، علي، الهداية: ج1، ص50. ابن همام، محمد، فتح القدير: ج1، ص265. الدردير، أحمد بن محمد، الشرح الكبير: ج1، ص252.
[171] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج3، ص350. البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج1، ص113.
[172] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج6، ص380 ـ 381. النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج2، ص50.
[173] اُنظر: كاشف الغطاء، محمد حسين، الأرض والتربة الحسينيّة: ص56 ـ 57. الأحمدي، علي، السجود علىٰ الأرض: ص106، ص108، ص109. الخرسان، محمد مهدي، السجود علىٰ التربة الحسينيّة: ص353 ـ 354.
[174] الديلمي، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلويّة: ص66.
[175] ابن حمزة الطوسي، محمد بن علي، الوسيلة: ص91.
[176] الحلبي، علي بن الحسن، إشارة السبق: ص89.
[177] الحلي، يحيىٰ بن سعيد، جامع الشرائع: ص70.
[178] الشهيد الأول، محمد بن مكي، البيان: ص169.
[179] الكركي، علي بن الحسين، رسائل الكركي: ج1، ص103.
[180] الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الفوائد المليّة: ص210.
[181] البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج7، ص260.
[182] الوحيد البهبهاني، محمد باقر، مصابيح الظلام: ج8، ص55.
[183] اُنظر: كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء: ج3، ص206.
[184]النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج8، ص437.
[185] اليزدي، كاظم، العروة الوثقىٰ: ج2، ص397.
[186] اُنظر: الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج9، ص187. أبو يعلىٰ، أحمد بن علي، مسند أبي يعلىٰ: ج1، ص289. المتقي الهندي، علي بن حسام، كنز العمال: ج13، ص655. ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج1، ص85.
[187] اُنظر: الأحمدي، علي، السجود علىٰ الأرض: ص116 ـ 117.
[188] الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجِّد: ص733. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج5، ص366.
[189] السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج5، ص459 ـ 460.
[190] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج4 ص71.
[191] الخرسان، محمد مهدي، السجود علىٰ التربة الحسينيّة: ص340.
[192] الصدوق، محمد بن علي، مَن لا يحضره الفقيه: ج1، ص268. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج5، ص365 ـ 366.
[193] السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج5، ص460 ـ 461.
[194] الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص312. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج5، ص366.
[195] الديلمي، الحسن بن محمد، إرشاد القلوب: ص115. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج5، ص366.
[196] اُنظر: الأحمدي، علي، السجود علىٰ الأرض: ص108ـ 113. الأميني، عبد الحسين، السجود علىٰ التربة الحسينيّة: ص65 ـ 66. السبحاني، جعفر، الإنصاف: ج1، ص264.
[197] اُنظر: بني فضل، مرتضىٰ، مدارك تحرير الوسيلة: ج1، ص270.
[198] اُنظر: الكركي، علي بن الحسين، رسائل الكركي (المجموعة الثانية): ج2، ص91 ـ 96. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج7، ص260 ـ 261. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الفوائد المليّة: ص211.
[199] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج5، ص158. ورواه أبو هريرة بلفظ آخر قريب من هذا، اُنظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج1، ص205. البيهقي، أحمد، السنن الكبرىٰ: ج2، ص186. ابن خزيمة، محمد بن إسحاق، صحيح ابن خزيمة: ج1، ص368. النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج1، ص416.
[200] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج6، ص443. كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء: ج3، ص228. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج10، ص404 ـ 405. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج8، ص525.
[201] اُنظر: النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج10، ص399. اليزدي، كاظم، العروة الوثقىٰ: ج2، ص616. الحكيم، محسن، مستمسك العروة: ج6، ص516. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذَّب الأحكام: ج7، ص114. العاملي، محمد بن علي، مدارك الأحكام: ج15، ص637.
[202] الطبرسي، الحسن بن الفضل، مكارم الأخلاق: ص281. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج82، ص333.
[203] اُنظر: الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقىٰ: ج5، ص511.
[204] الطبرسي، أحمد بن علي، مكارم الأخلاق: ص581. الحرّ العاملي، محمد، وسائل الشيعة: ج6، ص455 ـ 456.
[205] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج6، ص456.
[206] الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجِّد: ص678. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج6، ص456.
[207] الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجِّد: ص678.
[208] الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج6، ص75.
[209] اُنظر: الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ص489.
[210] النوري، حسين، مستدرك الوسائل: ج5، ص56. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج82، ص341.
[211] نقله عنه: الحكيم، محسن، العروة الوثقىٰ: ج5، ص511.
[212] اُنظر: كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء: ج3، ص227. الأردبيلي، أحمد، مجمع الفائدة: ج2، ص312.
[213] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج3، ص342.
[214] اُنظر: النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج10، ص408. الشهيد الأول، محمد بن مكي، الدروس الشرعية: ج2، ص12. القمي، أبو القاسم، غنائم الأيام: ج2، ص627. العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة: ج7، ص614.
[215] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج6، ص456. واُنظر: الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام: ج3، ص228. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج10، ص405 ـ 406.
[216] اُنظر: المصادر السابقة.
[217] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص536. البهبهاني، محمد باقر، مصابيح الظلام: ج8، ص236.
[218] اُنظر: كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء: ج3، ص227. العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة: ج7، ص615. البهبهاني، محمد باقر، مصابيح الظلام: ج8، ص235. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج10، ص407 ـ 408.
[219] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص229.
[[220]][220] المصدر السابق: ج14، ص526.
[221] الطبرسي، الحسن بن الفضل، مكارم الأخلاق: ص167.
[222] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص227 ـ 228.
[223] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص465.
[224] اُنظر: الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام: ج7، ص282. الطباطبائي، علي، رياض المسائل: ج12، ص195. النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة: ج15، ص159 ـ 162. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج36، ص355 ـ 358.
[225] اُنظر: المصادر السابقة.
[226]اُنظر: الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص220 ـ 225.
[227]الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص225.
[228] اُنظر: الحطّاب، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل: ج4، ص265. الرملي (الشافعي الصغير)، محمد بن أبي العبّاس، نهاية المحتاج: ج8، ص148. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني: ج8، ص61. الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوىٰ الهنديّة: ج5، ص340 ـ 341. الموسوعة الكويتية: ج5، ص125، وج11، ص145.
[229] الحلبي، حمزة بن علي، غنية النزوع الىٰ علمي الأُصول والفروع: ص398.
[230] العلّامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية: ج4، ص640.
[231] العلّامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام: ج3، ص329.
[232]الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام: ج12، ص68 ـ 69.
[233] اُنظر: الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية: ج7، ص326 ـ 327.
[234] السيوري، مقداد بن عبد الله، التنقيح الرائع: ج4، ص50.
[235] الصيمري، مفلح بن الحسن، غاية المرام: ج4، ص65.
[236] الأردبيلي، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان: ج11، ص233 ـ 234.
[237] الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام: ج9، ص282.
[238] البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج10، ص274 ـ 275.
[239] الطباطبائي، علي، رياض المسائل: ج12، ص195 ـ 196.
[240] النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة: ج15، ص162.
[241] النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج36، ص358.
[242] اُنظر: الإصفهاني، أبو الحسن، وسيلة النجاة (تعليق السيّد الخميني): ص622.
[243] اُنظر: الإصفهاني، أبو الحسن، وسيلة النجاة (تعليق السيّد الكلبايكاني): ج3، ص58.
[244] اُنظر: الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة: ج2، ص164.
[245] الخوئي، أبو القاسم، منية السائل: ص178.
[246] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، صراط النجاة (تعليق الميرزا التبريزي): ج1، ص394 ـ 395.
[247] زين الدين، محمد أمين، كلمة التقوىٰ: ج6، ص362.
[248] اللنكراني، فاضل، الأحكام الواضحة: ص423.
[249] السيستاني، علي، منهاج الصالحين: ج3، ص302.
[250] الخامنئي، علي، منتخب الأحكام: ص228.
[251] الفيّاض، محمد إسحاق، منهاج الصالحين: ج3، ص173.
[252]اُنظر: الصافي، لطف الله، هداية العباد: ج2، ص302.
[253] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص226.
[254] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص226 ـ 227.
[255] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص470.
[256] المصدر السابق: ص479.
[257] الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجِّد: ص733.
[258]المصدر السابق: ص734.
[259] اُنظر: المصادر الفقهية الواردة في الأمر الثاني.
[260] اُنظر: الطباطبائي، محمد، المناهل: ص665.
[261] البقرة: آية195.
[262] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج18، ص32.
[263] اُنظر: الطباطبائي، محمد، المناهل: ص665.
[264]اُنظر: السيوري، مقداد، التنقيح الرائع: ج4، ص50. الطباطبائي، محمد، المناهل: ص665.
[265] ابن أبي جمهور الإحسائي، محمد بن علي، عوالي اللآلئ: ج2، ص149.
[266] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج101، ص138.
[267] اُنظر: السيوري، مقداد، التنقيح الرائع: ج4، ص50. الأردبيلي، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان: ج11، ص236 ـ 137. الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام: ج9، ص282. الطباطبائي، علي، رياض المسائل: ج12، ص197. النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة: ج15، ص163 ـ 164. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج36، ص358 ـ 359. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج23، ص160.
[268] اُنظر: السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج23، ص140.
[269] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص528.
[270] المفيد، محمد بن محمد، المزار: ص147.
[271] اُنظر: الطباطبائي، علي، رياض المسائل: ج12، ص197. السيوري، مقداد، التنقيح الرائع: ج4، ص50.
[272] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص229.
[273] المصدر السابق: ج24، ص226.
[274] اُنظر لوجه الاستدلال: الطباطبائي، محمد، المناهل: ص670. النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة: ج15، ص162. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج23، ص159.
[275] اُنظر: الأردبيلي، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان: ج11، ص236. الطباطبائي، علي، رياض المسائل: ج12، ص196. الطباطبائي، محمد، المناهل: ص674. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج23، ص160.
[276] اُنظر: الطباطبائي، محمد، المناهل: ص674. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج23، ص160.
[277]الإصفهاني، أبو الحسن، وسيلة النجاة (تعليق السيّد الخميني): ص623.
[278] اُنظر: المصدر السابق (تعليق السيّد الكلبايكاني): ج3، ص59.
[279] زين الدين، محمد أمين، كلمة التقوىٰ: ج6، ص362 ـ 363.
[280] السيستاني، علي، منهاج الصالحين: ج3، ص302.
[281] الصافي، لطف الله، هداية العباد: ج2، ص303.
[282]اُنظر: السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج23، ص160 ـ 161.
[283] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص227.
[284] المصدر السابق: ج24، ص229.
[285] اُنظر: الطباطبائي، محمد بن علي، المناهل (الحجرية): ص672. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج36، ص364
[286] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص522. النوري، حسين، مستدرك الوسائل: ج10، ص331.
[287]النوري، حسين، مستدرك الوسائل: ج10، ص331.
[288] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص511.
[289]اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج4، ص588.
[290]الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص511.
[291] المصدر السابق: ص513.
[292] المصدر السابق: ج24، ص227.
[293]الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص512.
[294]المصدر السابق: ص510 ـ 511.
[295] المصدر السابق: ص510.
[296] اُنظر: ابن فهد الحلي، أحمد، المهذّب البارع: ج4، ص220. الأردبيلي، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان: ج11، ص235. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج23، ص161 ـ 162.
[297] اُنظر: السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج23، ص163. زين الدين، محمد أمين، كلمة التقوىٰ: ج6، ص364.
[298] اُنظر: الشهيد الأول، محمد بن مكي، الدروس الشرعية: ج2، ص26. الطباطبائي، علي، رياض المسائل: ج12، ص197. السيوري، مقداد، التنقيح الرائع: ج4، ص51.
[299] اُنظر: الأردبيلي، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان: ج11، ص234 ـ 235. الطباطبائي، علي، رياض المسائل: ج12، ص195 ـ 196. الطباطبائي، علي، الشرح الصغير: ج3، ص109. الطباطبائي، محمد، المناهل: ص666 ـ 667. النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة: ج15، ص161.
[300] اُنظر: الإصفهاني، أبو الحسن، وسيلة النجاة (تعليق السيّد الخميني): ص623. الإصفهاني، أبو الحسن، وسيلة النجاة (تعليق الكلبايكاني): ص60 ـ 61. الصافي، لطف الله، هداية العباد: ج2، ص303. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة: ج2، ص165. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج23، ص163.
[301] الطباطبائي، محمد، المناهل: ص673.
[302] اُنظر: الشهيد الأول، محمد بن مكي، الدروس الشرعية: ج2، ص25 ـ 26. الطباطبائي، محمد، المناهل: ص673.
[303]اُنظر: الشهيد الأول، محمد بن مكي، غاية المراد: ج3، ص529. العاملي، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام: ج12، ص69. الفقعاني، علي، الدرّ المنضود: ص262. الطباطبائي، محمد، المناهل: ص670. الكلباسي، إبراهيم، منهاج الهداية: ص507. محمد أمين، زين الدين، كلمة التقوىٰ: ج6، ص363.
[304] الطباطبائي، محمد، المناهل: ص670. الكلباسي، إبراهيم، منهاج الهداية: ص507 ـ 508. زين الدين، محمد أمين، كلمة التقوىٰ: ج6، ص363.
[305] زين الدين، محمد أمين، كلمة التقوىٰ: ج6، ص363.
[306]اُنظر: الصيمري، مفلح بن الحسن، غاية المرام: ج4، ص65. ابن فهد الحلي، أحمد، المهذّب البارع: ج4، ص221. الطباطبائي، محمد، المناهل: ص670. الكلباسي، إبراهيم، منهاج الهداية: ص705.
[307] الإصفهاني، أبو الحسن، وسيلة النجاة (تعليق السيّد الخميني): ص624. اُنظر: الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة: ج2، ص165.
[308] اُنظر: الإصفهاني، أبو الحسن، وسيلة النجاة (تعليق السيّد الخميني): ص624.
[309] الإصفهاني، أبو الحسن، وسيلة النجاة (تعليق السيّد الكلبايكاني): ج3، ص60.
[310] السيستاني، علي، منهاج الصالحين: ج3، ص303.
[311] اُنظر: الصافي، لطف الله، هداية العباد: ج2، ص303.
[312] اُنظر: السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج23، ص163 ـ 164.
[313] بناءً علىٰ ثبوت قاعدة: «إنّ كلّ مَن استولىٰ علىٰ شيء يكون قوله معتبَراً فيما استولىٰ عليه»، أو أنّ ترك الأخذ بقول صاحب اليد يؤدّي إلىٰ ترك العمل بهذا الاستحباب الذي دلّت الروايات المتواترة علىٰ جوازه.
[314] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج25، ص118.
[315] اُنظر: النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة: ج15، ص167. الطباطبائي، محمد، المناهل: ص673. الإصفهاني، أبو الحسن، وسيلة النجاة: ص623 ـ 624. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة: ج2، ص165. الكلبايكاني، محمد رضا، وسيلة النجاة: ج3، ص60. الكلبايكاني، محمد رضا، هداية العباد: ج2، ص234. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج23، ص163 ـ 164.
[316] اُنظر: المصادر السابقة.
[317] اُنظر: السيستاني، علي، منهاج الصالحين: ج3، ص302.
[318] الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام: ج9، ص284.
[319] الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام: ج9، ص285.
[320]المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص137 ـ 140. اُنظر: المشهدي، محمد، المزار: ص509. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج10، ص338. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج36، ص359 ـ 361. الأنصاري، مرتضىٰ، كتاب الطهارة: ج3، ص88 ـ 89. الهمداني، رضا، مصباح الفقيه: ج6، ص60. الآملي، محمد تقي، مصباح الهدىٰ في شرح العروة الوثقىٰ: ج7، ص108.
[321] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص138.
[322]المصدر السابق.
[323]ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص469، وص472، وص477.
[324] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجِّد: ص677. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص135. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص229.
[325] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص283. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص530 ـ 531.
[326] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص227 ـ 228.
[327] اُنظر: المصدر السابق: ج14، ص405 ـ 406.
[328] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص470 ـ 471. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج23، ص162 ـ 163.
[329] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص228.
[330] المصدر السابق: ج24، ص229.
[331] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص522.
[332] اُنظر: النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة: ج15، ص168 ـ 169. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج36، ص368. زين الدين، محمد أمين، كلمة التقوىٰ: ج6، ص363. الروحاني، محمد صادق، فقه الصادق: ج24، ص176 ـ 177. الاشتهاردي، علي پناه، مدارك العروة: ج7، ص193.
[333] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص529.
[334]المصدر السابق: ج24، ص225.
[335]المصدر السابق: ج24، ص227 ـ 228.
[336] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص526.
[337] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج57، ص156، في ذيل الحديث رقم22.
[338] اُنظر: الأردبيلي، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان: ج11، ص233. النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة: ج15، ص159 وما بعدها.
[339] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص226.
[340] اُنظر: البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج10، ص273 ـ 275.
[341] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجِّد: ص771.
[342] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج57، ص161. واُنظر: البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج10، ص274 ـ 275.
[343] اُنظر: المصادر في الهوامش السابقة.
[344] الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجِّد: ص771.
[345] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج57، ص161.
[346] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج4، ص170. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج7، ص445.
[347] اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، مَن لا يحضره الفقيه: ج2، ص113.
[348] اُنظر: الشهيد الأول، محمد بن مكي، ذكرىٰ الشيعة: ج4، ص175ـ 176. الكركي، علي، جامع المقاصد: ج2، ص447. العاملي، محمد بن علي، مدارك الأحكام: ج4، ص114. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان: ج2، ص801. الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام: ج4، ص322. ابن إدريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر: ج1، ص318. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج36، ص368. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام: ج2، ص612 وغيرها.
[349] الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام: ج4، ص322 ـ 323.
[350] النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج36، ص368.
[351] الهمداني، رضا، مصباح الفقيه (ط ق): ج2، ق2، ص473.
[352] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج11، ص427. النوري، حسين، مستدرك الوسائل: ج8، ص218.
[353] الأردبيلي، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان: ج9، ص503 ـ 504.
[354] ابن طاووس، علي بن موسىٰ، الأمان من أخطار الأسفار والأزمان: ص47.
[355] الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج8، ص40. الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار: ج3، ص279.
[356] الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج6، ص75.
[357] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج7، ص228. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج28، ص279.
[358] البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج4، ص53.
[359] اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقىٰ: ج2، ص82.
[360] زين الدين، محمد أمين، كلمة التقوىٰ: ج1، ص216.
[361] اُنظر: الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، هداية الأُمّة إلىٰ أحكام الأئمّة: ج1، ص273. الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقىٰ: ج4، ص199. الآملي، محمد تقي، مصباح الهدىٰ في شرح العروة الوثقىٰ: ج6، ص208، وص250. المرعشي، شهاب الدين، منهاج المؤمنين: ج1، ص115. الغروي، علي، التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ (تقرير لبحوث السيّد الخوئي&): ج9، ص172. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج4، ص82. وغيرها.
[362] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج3، ص29.
[363] اُنظر: الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص489.
[364] اُنظر ـ لوجه الاستدلال بالرواية ـ: البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج4، ص53. الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقىٰ: ج4، ص199. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج4، ص82. الآملي، محمد تقي، مصباح الهدىٰ في شرح العروة الوثقىٰ: ج6، ص208، وص250.
[365] السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج4، ص82.
[366] الآملي، محمد تقي، مصباح الهدىٰ في شرح العروة الوثقىٰ: ج6، ص208.
[367] اُنظر: الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقىٰ: ج4، ص199. زين الدين، محمد أمين، كلمة التقوىٰ: ج1، ص216. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج4، ص82.
[368] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، المقنعة: ص78.المحقّق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: ج1، ص40. الشهيد الأول، محمد بن مكي، ذكرىٰ الشيعة: ج1، ص372. الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام عن قواعد الأحكام: ج2، ص296. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج4، ص65 ـ 69.
[369] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، المقنعة: ص78. المحقّق الحلي، جعفر بن الحسن، نكت النهاية: ج1، ص244.
[370] الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد: ج1، ص395.
[371] الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام عن قواعد الأحكام: ج2، ص298.
[372] الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقىٰ: ج4، ص183 ـ 184. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج4، ص69 ـ 70.
[373] اُنظر: العلّامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة: ج1، ص406.
[374] اُنظر: العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة: ج4، ص84 ـ 86. الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام عن قواعد الأحكام: ج2، ص299 ـ 300.
[375] الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام: ج1، ص92.
[376] الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقىٰ: ج4، ص181 ـ 182. الآملي، محمد تقي، مصباح الهدىٰ في شرح العروة الوثقىٰ: ج6، ص215. واُنظر: السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج2، ص88. وغيرها.
[377] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج3، ص29.
[378] اُنظر: النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج4، ص304.
[379] الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص311 ـ 312. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج3، ص53. واُنظر ـ لوجه الاستدلال ـ: الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد: ج1، ص395. الطباطبائي، علي، رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل: ج2، ص187. النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة: ج3، ص215. التوحيدي التبريزي، محمد علي، مصباح الفقاهة (تقرير أبحاث السيّد الخوئي&): ج5، ص305 ـ 306. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج4، ص231. السبزواري، عبد الأعلىٰ، مهذّب الأحكام: ج4، ص69 ـ 70.
[380] اُنظر: الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد: ج1، ص195ـ 196. الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام عن قواعد الأحكام: ج2، ص298. الطباطبائي، علي، رياض المسائل في بيان أحكام الشـرع بالدلائل: ج2، ص187. العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة: ج4، ص82.
[381] الشهيد الأول، محمد بن مكي، ذكرىٰ الشيعة: ج2، ص21.
[382] المحقّق الحلي، جعفر بن الحسن، نكت النهاية: ج1، ص251. الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط: ج1، ص186.
[383] العاملي، محمد بن علي، مدارك الأحكام: ج2، ص139 ـ 140.
[384] البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج4، ص111 ـ 112.
[385] العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة: ج4، ص349 ـ 351.
[386] النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج4، ص304.
[387] اُنظر: الاشتهاردي، علي پناه، مدارك العروة: ج8، ص394 ـ 395. الحكيم، محسن، منهاج الصالحين: ج1، ص124. الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين: ج1، ص88. الروحاني، محمد، منهاج الصالحين: ج1، ص119. اللنكراني، محمد فاضل، الأحكام الواضحة: ص77. السيستاني، علي، منهاج الصالحين: ج1، ص113. الفيّاض، محمد إسحاق، منهاج الصالحين: ج1، ص143. الوحيد الخراساني، حسين، منهاج الصالحين: ج1، ص97.
[388] العاملي، محمد بن علي، مدارك الأحكام: ج2، ص139 ـ 140.
[389] اُنظر: البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج4، ص111 ـ 112. العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة: ج4، ص349 ـ 351.
[390] الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج6، ص76. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج3، ص29.
[391] اُنظر: الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص311.
[392] الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجِّد: ص735. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج3، ص30.
[393] اُنظر: البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج4، ص112. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج3، ص304. القمّي، الميرزا أبو القاسم، غنائم الأيام: ج3، ص531.
[394] فقه الرضا (المنسوب للإمام الرضا×): ص184.
[395] العلّامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهىٰ المطلب: ج7، ص385. العلّامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء: ج2، ص95. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج3، ص29 ـ 30.
[396] اُنظر: الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد: ج1، ص440. العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة: ج4، ص252.
[397] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج58، ص7.
[398] ابن قولويه القمي، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص467. الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام عن قواعد الأحكام: ج2، ص385. الطباطبائي، علي، رياض المسائل في بيان أحكام الشـرع بالدلائل: ج2، ص227.
[399] اُنظر: الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع: ج2، ص365 ـ 398. الشوكاني، محمد ابن علي، نيل الأوطار: ج5، ص230.
[400] ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة: ج2، ص111.
[401] الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين: ج5، ص263.
[402] الأنصاري، محمد علي، الموسوعة الفقهية الميسرة: ج8، ص168.
[403] الفاضل الهندي، محمد، كشف اللثام: ج7، ص526.
[404] الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار: ج5، ص230.
[405] البهوتي، منصور بن يونس، كشّاف القناع: ج3، ص30.
[406] اُنظر: الأنصاري، محمد علي، الموسوعة الفقهية الميسرة: ج8، ص168وما بعدها. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية: ج10، ص276 وما بعدها.
[407] النووي، يحيىٰ بن شرف، شرح صحيح مسلم: ج1، ص122 ـ 123.
[408] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج21، ص407.
[409] المصدر السابق.
[410] المصدر السابق.
[411] البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج6، ص215 ـ 216. النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج6، ص175.
[412] اُنظر: النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج6، ص174 ـ 177. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج21، ص407 ـ 412.
[413] اُنظر: الأنصاري، محمد علي، الموسوعة الفقهية الميسرة: ج8، ص168 ـ 169.
[414] اُنظر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية: ج10، ص277.
[415] اُنظر: المحقّق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام: ج2، ص564. الأنصاري، محمد علي، الموسوعة الفقهية الميسرة: ج8، ص168.
[416] اُنظر: المحقّق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام: ج2، ص564.
[417] ابن البرّاج، عبد العزيز، المهذّب: ج2، ص259.
[418] الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية: ص500.
[419] المحقّق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام: ج2، ص564.
[420] العلّامة الحلي، الحسن بن يوسف، تلخيص المرام: ص214.
[421] الشهيد الأول، محمد بن مكي، اللمعة الدمشقية: ص175.
[422] الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام: ج7، ص526.
[423] الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع: ج2، ص365.
[424] البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج25، ص37.
[425] النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج31، ص352 ـ 353.
[426] وهي قول الإمام الباقر×: «يُحنَّك المولود بماء الفرات ويُقام في أُذنه». الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج21، ص407.
[427] كما جاء في رواية أبي بصير، عن الصادق×، قال: «قال أمير المؤمنين×: حنّكوا أولادكم بالتمر، فكذا فعل رسول الله’ بالحسن والحسين÷». الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج21، ص407.
[428] اللنكراني، محمد فاضل، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح): ص525 ـ 527.
[429] زين الدين، محمد أمين، كلمة التقوىٰ: ج7، ص144.
[430] السيستاني، علي، منهاج الصالحين: ج3، ص117.
[431] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج6، ص24.
[432] الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج7، ص436.
[433] الطبرسي، أحمد، مكارم الأخلاق: ص229.
[434] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص466.
[435]اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج6، ص74.
[436] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجِّد: ص732.
[437] اُنظر: الراوندي، سعيد بن هبة الدين، الدعوات: ص185.
[438] اُنظر: الفتّال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص412.
[439] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص106.
[440] المصدر السابق: ص107.
[441] المصدر السابق: ص110.
[442]ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص111.
[443] المصدر السابق.
[444] اُنظر: النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج16، ص2 وما بعدها. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية: ج20، ص10وما بعدها، ج23، ص226 وما بعدها.
[445] اُنظر: النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج16، ص22 وما بعدها. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهيّة الكويتية: ج20، ص12.
[446] العلّامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام: ج1، ص434. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج12، ص327.
[447] اُنظر: الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهيّة: ج2، ص66. الأنصاري، مرتضىٰ، كتاب الخمس: ص36.
[448] اُنظر: ابن عابدين، محمد أمين، حاشية ردّ المحتار: ج2، ص347.
[449] اُنظر: البهوتي، منصور بن يونس، كشّاف القناع: ج1، ص222.
[450] كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء: ج4، ص201.
[451] اُنظر: النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج16، ص22. الأنصاري، مرتضىٰ، كتاب الخمس: ص30. الآملي، محمد تقي، مصباح الهدىٰ في شرح العروة الوثقىٰ: ج11، ص26.
[452] اُنظر: المصادر السابقة.
[453]البقرة: آية275.
[454] نعم، هناك اختلاف بين الفقهاء في تعريف البيع عند إرادة تحديد معناه وحقيقته.
[455] اُنظر: مؤسسة دائرة المعارف الإسلامية، موسوعة الفقه الإسلامي: ج22، ص11 ـ 17. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية: ج9، ص7 ـ 8.
[456]الشهيد الأول، محمد بن مكي، الدروس الشرعية: ج2، ص26.
[457] الطباطبائي، محمد بن علي، المناهل: ص673.
[458] الأنصاري، مرتضىٰ، المكاسب المحرّمة: ج4، ص28.
[459] آل عصفور، حسين، سداد العباد: ص558.
[460] المروّج، جعفر، هدىٰ الطالب: ج6، ص482.
[461] الخوانساري، موسىٰ بن محمد، مُنية الطالب: ج2، ص272.
[462] كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء: ج4، ص266.
[463] الكلباسي، محمد بن إبراهيم، منهاج الهداية: ص508.
[464] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص479.
[465]اُنظر: الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص228.
[466] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص130.
[467] اُنظر: الكلباسي، محمد بن محمد، الرسائل الرجالية: ج1، ص185.
[468]اُنظر: الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص228 ـ 229.
[469] اُنظر: المصدر السابق. الأنصاري، مرتضىٰ، المكاسب المحرّمة: ج4، ص28. الخوانساري، موسىٰ بن محمد، مُنية الطالب: ج2، ص272.
[470] اُنظر: الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص228 ـ 229.
[471] اُنظر: الشهيد الأول، محمد بن مكي، الدروس الشرعية: ج2، ص26.
[472] اُنظر: آل عصفور، حسين، سداد العباد: ص558.
[473]الجحلات: جمع جحلة، وهي السقاء الضخم. والحبوب: جمع حِب، وهو الجرة الضخمة. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حمّاد، الصحاح: ج4، ص1652. الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج3، ص32.
[474] اُنظر: العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة: ج15، ص257.
[475] المائدة: آية1.
[476] البقرة: آية275.
[477] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج21، ص276. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري: ج4، ص371.
[478]ابن أبي جمهور الإحسائي، محمد بن علي، عوالي اللآلئ: ج1، ص222.
[479] اُنظر: الشهيد الأوّل، محمد بن مكي، الدروس الشرعية: ج2، ص26.
[480] النبق: ثمر شجرة السدر.
[481]اُنظر: الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج17، ص286.
[482] اُنظر: آل عصفور، حسين، الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع: ج12، ص238.
[483] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج17، ص286.
[484] المصدر السابق.
[485] المصدر السابق: ص287.
[486] المصدر السابق.
[487]الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ص289.
[488] ابن فهد الحلي، أحمد، المهذّب البارع: ج4، ص221.
[489]الشهيد الأول، محمد بن مكي، الدروس الشرعية: ج2، ص26.
[490] الطباطبائي، محمد، المناهل: ص673.
[491] الكلباسي، محمد بن إبراهيم، منهاج الهداية: ص508.
[492] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص228 ـ 229.
[493] الشهيد الأول، محمد بن مكي، الدروس الشرعية: ج2، ص26.
[494] الخوئي، أبو القاسم، صراط النجاة: ج1، ص394 ـ 395. الخوئي، أبو القاسم، مُنية السائل: ص178.
[495] التبريزي، جواد، صراط النجاة: ج5، ص325.
[496] المصدر السابق.
[497][497] السيستاني، علي، استفتاءات: ص13.
[498] المصدر السابق: ص118.
[499] المصدر السابق: ص293.
[500] المصدر السابق.
[501] المصدر السابق: ص495.
[502]السيستاني، علي، استفتاءات: ص495.
[503]المصدر السابق: ص619.
[504] المصدر السابق: ص680.
[505] الخامنئي، علي، منتخب الأحكام: ص63.
[506] اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقىٰ: ج2، ص397.
[507] الصافي، لطف الله، هداية العباد: ج1، ص94.
[508] المصدر السابق: ص117.
[509] التبريزي، جواد، صراط النجاة: ج6، ص59.
[510] السيستاني، علي، استفتاءات: ص115.
[511] التبريزي، جواد، صراط النجاة: ج6، ص58.
[512]التبريزي، جواد، صراط النجاة: ج6، ص58.
[513] الآملي، هاشم، المعالم المأثورة: ج3، ص59.