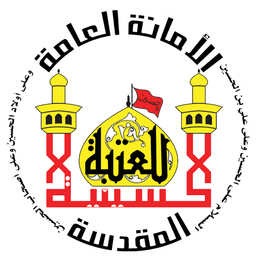test
موضوع عقائدي آخر كان ولازال من بين الأبحاث التي أولاها المتكلّمون الإسلاميّون والفلاسفة حظّاً وافراً من الاهتمام، انطلاقاً من الآيات القرآنية الكريمة والروايات الشريفة التي أشارت إليه، ألا وهو موضوع صفات الباري تعالى السلبيّة؛ ونعني بها تلك الصفات التي ينبغي سلبها عن ساحة قدسه؛ لعدم انسجامها وتوافقها مع عظمته، بل لتضادّها وتعارضها معها أيّما معارضة.
ومن بين المسائل التي بُحثت بهذا الصدد: المائز والمعيار في الصفات الثبوتيّة والسلبيّة، ورجوع الصفات السلبيّة للثبوتيّة، والدليل العام على الصفات السلبيّة، ووحدتها أم تعدّدها، وجدليّة الإلهيّات السلبيّة أو الإلهيّات التنزيهيّة؛ وأيّ النظريّتين تظهر من كلام أهل البيت^؟ فهل المستفاد من الروايات هو عودة الصفات الثبوتيّة إلى السلبيّة، أو أنّ الصفات الثبوتية ممكنة الفهم دون الرجوع إلى الصفات السلبيّة، مع ضرورة تنزيهها عن أي نقص؟ فالقائلون بعودة الصفات الثبوتيّة للسلبيّة راحوا يفسّرون صفة العلم بعدم الجهل، والقدرة بعدم العجز والنقص والضعف، وهكذا سائر الصفات الثبوتيّة الأخرى؛ ذلك لأنّ فهمها غير متيسّر دون إرجاعها إلى الصفات السلبيّة المقابلة لها.
وتبيّن لنا من خلال المراجعة الشاملة للأحاديث المنسوبة للإمام الحسين× بأنّها قد أشارت إلى خصائص الصفات الإلهيّة السلبيّة وإلى تنزيه البارئ تعالى عن الكثير من تلك الصفات، كأن يكون له نظير، أو شبيه، أو ولد، أو ولي، أو وزير، أو كفؤ، أو سمي، أو مثل، أو ندّ وضدّ، أو عدل، أو بديل، أو أن يكون مولوداً، أو جسماً، أو حادثاً، أو له جهة، أو تعرضه الذلّة، والرؤية، والحاجة، والإدراك لذاته، والحدّ، وبلوغ الغاية في حمده، والخفاء، والغيبة، والمغلوبية، والاحتجاب، والعجز، وخلف الوعد، والخوف، والسنة، والنوم، وتداول الأمور، والتغيير، وكونه محلاً للحوادث، وتوصيف حقيقة ذاته وصفاته وأفعاله، والحلول، والأكل والشرب، وأن يكون محكوماً فيقضى عليه، وأن تفوته الأمور، وأن يكون له وارث، وأن يعرض عليه النسيان، والخواطر، والهم، والغم، والحزن، والبهجة، والضحك، والبكاء، والرجاء، والرغبة، والسأم، والجوع، والشبع، والتركيب، والقياس، والبديل، حيث فصّل× الكلام في بعضها وأجمل في بعض آخر.
بدايةً سنتعرّض لبعض المقدّمات التي لها دخل وثيق بموضوع الصفات السلبية لتهيئة الأرضية، وحتّى يتسنّى فهم كلمات الإمام الحسين× وأقواله بصددها بصورة جيدة.
المقدّمة الأولى: المعيار في الصفات الثبوتيّة والسلبيّة
إنّ (الصفة السلبيّة) هي كلّ صفة لا تليق بجنابه تعالى، ويلزم منها النقص فيه، على خلاف ما عليه الصفة الثبوتيّة، إذ إنّ ثبوتها له موجب للكمال.
وحول الميزان والمعيار بين هذين النوعين من الصفات الإلهيّة، قال الإمام الخميني:
«إنّ المقياس في الصفات الثبوتيّة للذات المقدّس الواجب جلّ اسمه، والصفات السلبيّة، هو أنّ كلّ صفة من الأوصاف الكماليّة، والنعوت الجماليّة التي تعود إلى حقيقة الوجود وذاته الصرف، من دون أن تتعيّن بتعيّن، وتتواجد في عالم دون آخر، تعود لهويّة الوجود وذاته النوريّة الوجوديّة، تعتبر من الصفات اللازمة الثبوت والواجبة التحقّق للذات المقدّس تعالى شأنه؛ لأنّ هذه الصفات لو لم تثبت للذات المقدّس لأنّه لو لم يكن ثابتاً لها للزم إمّا أن تكون الذات المقدّسة ليست وجوداً صرفاً ومحضاً، أو أنّ صرف الوجود ليس محض الكمال والجمال. وهذان الأمران باطلان لدى العرفاء والحكماء. كما تقرّر في محلّه.
إنّ كلّ صفة ونعت لا تثبت للموجود، إلّا بعد تنزّله إلى منزلة من منازل التعيّنات، وتَقارنه بشكل من أشكال التقييد، وتعانقه بمرتبة من مراتب القصور، وتلازمه مع حدّ من حدود الوهن والفتور، ومجمل القول: إنّ كلّ صفة لا تُعدّ من حقيقة الوجود، بل كانت راجعة إلى الماهيّة، لكانت من الصفات المسلوبة التي يمتنع تحقّقها في الذات الكامل المطلق؛ لأنّ الذات الكامل المطلق والوجود الصرف كما يكون مصداقاً للكمال الصرف، يكون مصداقاً لسلب النقائص والحدود والأعدام والماهيّات»([i]).
المقدّمة
الثانية: رجوع الصفات السلبيّة إلى الثبوتيّة
|
|
حينما نستقرأ كلمات وأقوال المتكلمين حول الصفات السلبيّة يبرز لنا ثمّة خلاف دائر بينهم، في أنّها هل ترجع إلى صفة كمال أم لا؟ وللذين اختاروا الطرف الأوّل وهو رجوعها إلى صفة كمال، برهان يمكن بيانه وتقريره بذكر مجموعة من المقدّمات:
أ) الله واجب الوجود بالذات، وهو وجود صرف وكمال محض.
ب) صفات الله السلبيّة هي سلب للنقص والفقدان.
ج) وبما أنّ النقص والفقدان له معنى سلبي، فإنّ سلب النقص والفقدان يعود إلى سلب السلب ونتيجته الإثبات.
النتيجة: إنّ صفات الله السلبيّة مبينة لإثبات الكمالات الوجوديّة.
قال الملّا صدرا ـ خلال طرحه لسؤال وجواب ـ:
«فإن قلت: أليس للواجب تعالى صفات سلبيّة ككونه ليس بجسم ولا بجوهر ولا بعرض ولا بكم ولا بكيف؟
قلنا: كلّ ذلك يرجع إلى سلب الأعدام والنقائص، وسلب السلب وجود، وسلب النقصان كمال وجود»([ii]).
يقف الملّا صدرا في النقطة المقابلة لأتباع الإلهيّات السلبيّة إذ يرى كلّ سلب مستلزم للتركيب وأنّه مخالف لقاعدة «بسيط الحقيقة كلّ الأشياء» لأنّه إذا سلب شيء عن ذات الله تعالى كان لازمه التركيب من وجود الشيء وعدمه([iii]).
وقال أيضاً:
«قال الشيخ المتألّه شهاب الدين ـ المقتول ـ في بعض كتبه: ومما يجب أن نعلمه ونحقّقه: أنّه لا يجوز أن يلحق الواجب إضافات مختلفة توجب اختلاف حيثيّات فيه، بل له إضافة واحدة هي المبدئيّة، تصحّح جميع الإضافات كالرازقيّة والمصوّريّة ونحوهما، ولا سلوب فيه كذلك، بل له سلب واحد يتبعه جميعها وهو سلب الإمكان، فإنّه يدخل تحته سلب الجسميّة والعرضيّة وغيرهما، كما يدخل تحت سلب الجماديّة عن الإنسان سلب الحجريّة والمدريّة عنه»([iv]).
وقال العلّامة الطباطبائي في حاشيته على الأسفار ـ عند تقريره هذا البرهان ـ:
«ملخّص البرهان: أنّ كلّ هويّة صحّ أن يُسلب عنها شيء فهي متحصّلة من إيجاب وسلب، وكلّ ما كان كذلك فهي مركّبة من إيجاب (هو ثبوت نفسها لها) وسلب (هو نفي غيرها عنها) ينتج أنّ كلّ هويّة يُسلب عنها شيء فهي مركّبة، وينعكس بعكس النقيض إلى أنّ كلّ ذات بسيطة الحقيقة فإنّها لا يُسلب عنها شيء، وإن شئت فقل: (بسيط الحقيقة كلّ الأشياء)»([v]).
المقدّمة
الثالثة: الدليل العام على الصفات السلبيّة
|
|
يمكن بيان الدليل العام للصفات السلبيّة من خلال ذكر مقدّمتين، هما:
أ) الله وجود مطلق، واجد لكلّ الكمالات الوجوديّة.
ب) كلّ موجود بهذا النحو لا ينفذ إلى ذاته أيّ نقص أو محدوديّة.
النتيجة: كلّ مفهوم يتضمّن نوعاً من النقص يُسلب عن الذات الإلهيّة بالضرورة.
قال عبدالرزّاق اللاهيجي:
«أمّا الصفات السلبيّة فتعود إلى تجرّد وتنزّه الواجب
تعالى عما لا يليق بجلاله، مثل الجوهريّة والجسميّة والماديّة والتركيب والشرك
والكفو والضدّ وأمثال ذلك، والدليل على تنزّه الواجب تعالى عن ذلك اتصافه بوجوب
الوجود، وهو عين حقيقته،
إذ خواصّ وجوب الوجود مستلزمة لنفيها؛ وجميعها قد علمت ما عدا الجوهريّة، وتلك
أيضاً تلزم إذا علم أنّ وجود الواجب تعالى عين ذاته وأنّه ليس ماهيّة وراء الوجود.
فعند الحكماء الجوهر ماهيّة إذا وجدت فلا في موضوع، ويرونه جنس لما تحته. إذن فلا يمكن إطلاق الجوهر بهذا المعنى على الواجب تعالى للجهتين.
أمّا المتكلّمون فلأنّهم لا يعتبرون الماهيّة في تعريف الجوهر، بل الجوهر عندهم هو الموجود لا في موضوع، سواء كان ذا ماهية أم لم يكن، إذن فإطلاق الجوهر على الواجب تعالى عندهم غير ممتنع عقلاً، ولكن لما كانت أسماء الله توقيفيّة، أي: موقوفة على إذن الشارع، ولم يرد في الشرع إطلاق الجوهر على الواجب تعالى، صار ممتنعاً شرعاً.
ولأنّنا بيّنا خواصّ واجب الوجود سابقاً، وذلك مستلزم لنفي الصفات السلبيّة، وأشرنا بعد ذلك إلى تفرّع الصفات السلبيّة على خواصّ الواجب أيضاً، فلا حاجة هنا إلى تجديد البيان، فغرضنا في هذا الباب مقصور على ذكر الصفات الثبوتيّة»([vi]).
قال السيد عبدالله شبّر:
«إنّ صفات الله تعالى السلبيّة تنفي النقائص عنه تعالى، لأنّ إثبات الكمال لا يتمّ إلّا بنفي النقص، كما لا يتمّ إثبات الحقّ إلّا بنفي الباطل، وتسمّى أيضاً صفات الجلال كما أشير إليها بقوله تعالى: (ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ)([vii]) قيل: الجلال صفاته السلبيّة والإكرام صفاته الثبوتيّة، وقدّم الجلاليّة لأنّ دفع المضرّة أهمّ من جلب المنفعة، والتحلية بالأوصاف الجميلة تتوقّف على التخلية من الأخلاق الرذيلة، كما لا ينمو الزرع والشجر في أرض لم تصف من الشوك والحجر، ويجب سلب كلّ نقص عنه تعالى لكماله، ولا حصر فيها كما في الصفات الثبوتيّة، لأنّ الحصر يشعر بأن لا مانع من أن يكون فيه نقص غير ما حصر، ونحن لما رأينا فينا نقائص استهجنها العقل، وعلمنا أنّها من نقصنا وعجزنا، نزّهنا الواجب تعالى عنها لكماله وقدرته»([viii]).
المقدّمة
الرابعة: وحدة الصفات السلبيّة
وتعدّدها
|
|
يعتقد بعض بعودة جميع الصفات السلبيّة إلى صفة سلبيّة واحدة، وهي سلب الإمكان عن الله تعالى، أو تجرّده وتنزيهه عن الأمور غير اللائقة بساحة كبريائه.
ونقل الملّا صدرا عن شهاب الدين السهروردي قوله:
«له سلب واحد يتبعه جميعها، وهو سلب الإمكان، فإنّه يدخل تحته سلب الجسميّة والعرضيّة وغيرهما، كما يدخل تحت سلب الجماديّة عن الإنسان سلب الحجريّة والمدريّة عنه»([ix]).
وذهب الملّا صدرا إلى القول بأنّ هذا الكلام في منتهى القوّة والمتانة([x]).
قال عبدالرزّاق اللاهيجي:
«أمّا الصفات السلبيّة فترجع إلى تجرّد وتنزّه الواجب تعالى عن كلّ ما لا يليق بجلاله كالجوهريّة والجسميّة والماديّة والتركيب والشريك والكفو والضدّ وأمثال ذلك»([xi]).
وقال الملّا مهدي النراقي:
«اعلم، أنّ الصفات التي تسلب عنه ـ سبحانه ـ هي الصفات التي ثبوتها له ـ تعالى شأنه ـ يوجب تركّباً أو احتياجاً أو نقصاً، كثبوت التركيب بأيّ وجه كان، والشريك في وجوب الوجود والجوهريّة والعرضيّة والتحيّز والحلول والجهة وحلول الحوادث، ونفي كلّ منها راجع إلى تجرّده وتنزيهه عما لا يليق بساحة كبريائه»([xii]).
ولكنّ الإمام الخميني ردّ هذه النظريّة، قائلاً:
ولا نستطيع أن نقول بأنّ الأعدام والنقائص حيثيّة واحدة، وأنّه (لا مَيز في الأعدام)؛ لأنّنا إذا لاحظنا هذا الموضوع على أساس الواقع ونفس الأمر، فكما أنّ العدم المطلق حيثيّة واحدة رغم كونه كلّ الاعدام، فكذلك الوجود المطلق ـ أيضاً ـ حيثيّة واحدة وكلّ الكمالات. فلا نستطيع إثبات صفة للحقّ سبحانه في مرحلة الأحديّة وغيب الغيوب، لا الصفات الحقيقيّة الثبوتيّة، ولا الصفات السلبيّة الجلاليّة. وإذا لاحظناه على أساس مقام الواحديّة وجمع الأسماء والصفات، فكما أنّ الصفات الثبوتيّة الكماليّة متكثّرة ومتعدّدة، كانت الصفات السلبيّة متكثّرة أيضاً؛ لأنّ في مقابل كلّ صفة كماليّة، صفة ناقصة مسلوبة. فالذات المقدّس سبحانه كما يكون مصداقاً للعالم بالذات، يكون مصداقاً لعدم كونه جاهلاً بالعرض. وكما يكون قادراً يكون ليس بعاجز، وكما تقرّر في علم الأسماء، أنّ للأسماء والصفات الثبوتيّة محيطية ومحاطية ورئاسة ومرؤوسيّة، فكذلك تكون للأسماء والصفات السلبيّة هذه الاعتبارات بالتبع أيضاً»([xiii]).
|
|
المقدّمة الخامسة: حيثيّات البحث عن الله وصفاته
يتأطّر البحث عن الله تعالى وصفاته بشكل عام في مجالات ثلاثة:
1ـ وجودي
ويقتصر البحث في هذا القسم على إثبات وجود الله وصفاته وأفعاله، والكيفيّة التي تكون عليها صفاته وأفعاله.
2ـ معرفي
ويتركّز البحث في هذا القسم حول أنّ الإنسان هل يمتلك القدرة على معرفة الذات الإلهيّة وأوصافها وأفعالها، أم أنّ هذه الأمور تبقى بعيدة عن متناول فهم الإنسان وحدود معرفته؟
3ـ معنائي
يدور الحديث فيه حول إسناد بعض الأوصاف من قبيل الوجود والعلم والحياة وغيرها، إلى الله تعالى، وهل أنّها تسند إليه تعالى بذات المعنى المشهور والمعروف عند إسنادها إلى الإنسان وغيره من المخلوقات، رغم تنزيهها عمّا فيها من نقص؟ أو أنّ هذه الألفاظ تستعمل في الساحة الإلهيّة من باب الاشتراك اللفظي، فتَحمِل عند إطلاقها على الله سبحانه معنى آخر يختلف تماماً عن معناها المتعارف؟
يرى القائلون بالمعنى الثاني أنّ جميع الصفات والعناوين التي تطلق على الله ذات جنبة سلبيّة، وتحكي عن نوع من السلب، وما تقسيم الصفات الإلهيّة إلى ثبوتيّة وسلبيّة إلّا بلحاظ اللفظ لا غير.
|
|
المقدّمة
السادسة: الإلهيّات السلبيّة
|
|
لم يقع خلاف بين المتكلمين والفلاسفة بشأن تقسيم الصفات الإلهيّة إلى ثبوتيّة وسلبيّة، بيد أنّ النقاش اشتدّ بينهم بشأن معنى الصفات الثبوتيّة، فهل أنّ إدراكه ممكن بالنسبة للإنسان بشكل محدود، أو يجب إرجاع الصفات الثبوتيّة للسلبيّة حتى يتحقّق ذلك المعنى، مثل إرجاع صفة العلم إلى عدم الجهل، وصفة القدرة إلى عدم العجز وهكذا، فبعضهم سلك الطريق الأوّل وبعض على الثاني.
بما أنّ هذا البحث كان محتدماً منذ زمن بعيد ولازال، مع كثرة الآثار والنتائج المترتّبة عليه، والتي من جملتها ترك البحث عن الصفات الثبوتيّة بصورة مستقلّة؛ لذا نرى من الجدير تناول هذا الموضوع بشيء من البسط والتفصيل.
نبذة تاريخيّة عن الإلهيات السلبيّة
كان لهذا النمط من الإلهيات الكثير من الأنصار والمؤيّدين على طول التاريخ، ففي اليونان القديم حيث كان التصوّر السائد عن الإله هو التصوّر الساذج، وقد قيل: إنّ «ألبينوس»([xiv]) (تقريباً في المئة الميلادية الثانية) هو أوّل من ذهب إلى ضرورة الاستفادة من المنهج السلبي في التعرّف على الإله.
كما يمكن مشاهدة نوع من منهج السلب الإلهي في الفلسفة الأفلاطونيّة أيضاً، فذهب «أفلاطون»([xv]) (427ـ347 ق.م) إلى القول ـ في وصف الإله ـ بأنّه غير قابل للمعرفة، وسعى إلى تعريفه بطريقة سلبيّة. و«أفلوطين»([xvi]) (205ـ270 م) ـ هو من أبرز الشخصيّات في الأفلاطونيّة المحدّثة حيث تحتل الإلهيات السلبيّة مكانة خاصّة في فلسفته ـ يرى أنّ (أحد) أو (واحد) والذي يعدّ إله، له من التقديس والتنزيه ما يختصّ به، إلى درجة يرى فيها عدم لياقة حتى هذه الأسماء بساحته، ويؤكّد أنّ استعمال هذه الألفاظ من قبل الإنسان نتيجة لنقصه وضيق لغته.
كما لاقت هذه الفكرة ـ الإلهيات السلبيّة ـ تأييداً واسعاً من قبل المفكّرين المسيحيين. فهذا «بازيليد»([xvii])، المعلم الغنوصي في أواسط القرن الميلادي الثاني، كان يعتقد بأنّه لا يمكن فهم الله تعالى انطلاقاً من منظور هذا العالم، ولا يمكن وصفه عن طريق تشبيهه بشـيء من داخل هذا الكون. وذهب العالم المسيحي «إكليمندس»([xviii]) (150ـ215م) إلى أنّه لا يوجد أيّ محمول ذي معنى مناسب لحمله على الإله. وكان «نيكولاس من كوسا»([xix]) (1401ـ1464م) يعتقد بأنّ كلّ ما نقوله عن الإله ليس إلّا مجازاً واستعارة. ويرى أنّ ما يمكن معرفته عن الله هو أنّه غير معروف، فالإله عنده تضادّ المتضادّات.
وفي اليهوديّة يعتقد «فيلون»([xx]) (30 ق.م ـ50م) أنّه ليس في وسع الإنسان معرفة جوهر الإله على الرغم من وجوده الواضح للجميع. فكان يفرق بين وجود الله وحقيقة ذاته، وعلى أســاس ذلك يرى أنّ تحصيل المعرفة بالإله خارجة عن نطاق قابليّات الإنسان المفهوميّة، وقامت طريقته عند ذكر الله بأن يتعمد الإتيان بالضمير الشخصي أحياناً، وأحياناً أخرى بالضمير غير الشخصي.
ويعتقد إبراهيم بن داوود (1110ـ1180 م) بأنّه ينبغي فهم جميع الصفات الإيجابيّة للإله حتى الوحدة والضرورة على أساس المشترك اللفظي.
ويعدّ المفكر اليهودي «موسى بن ميمون» (1135ـ1204م) منأبرزالمدافعينعننظريّةالإلهيّاتالسلبيّة بلا شكّ ولا ترديد، فقد طرح في كتابه «دلالة الحائرين» هذه النظريّة بصراحة، حيث يرى أنّ الوصف الصحيح لله هو الوصف السلبي؛ لأنّه لا ينطوي على أيّ لازم باطل، وهذا النوع من الوصف لا يستلزم التشبيه ولا إسناد عيب أو نقص إلى ساحته.
وفي الإسلام كان «ضرار» على هذه العقيدة، وأنّ معنى علم الله وقدرته هو أنّه ليس جاهلاً ولا عاجزاً. ونسب «الرازي» قول ضرار إلى النظّام المعتزلي. واعتقد «النجار» بنفي صفة العلم والقدرة والحياة وغيرها من صفات الله الأزليّة. وأمّا «أبو يعقوب السجستاني» فكان يعتقد بأنّ الله ليس له صفات ماديّة ولا معنويّة، وهو وراء الايس (الوجود) والليس (العدم). وذهب «ابن مسكويه» أيضاً إلى أنّ الطريق الوحيد لمعرفة صفات الله هو النهج السلبي لا غير.
ويُذكر ـ أيضاً ـ من متكلّمي الإماميّة ممن أيّدوا هذه النظريّة شخصيات بارزة من أمثال «الشيخ الصدوق»، و«القاضي سعيد القمّي» وآخرين([xxi]).
قال الشيخ الصدوق بهذا الصدد:
«إذا وصفنا الله تبارك وتعالى بصفات الذات فإنّما ننفي عنه بكلّ صفة منها ضدّها، فمتى قلنا: إنّه حي نفينا عنه ضدّ الحياة وهو الموت، ومتى قلنا: إنّه عليم نفينا عنه ضدّ العلم وهو الجهل، ومتى قلنا: إنّه سميع نفينا عنه ضدّ السمع وهو الصمم، ومتى قلنا: بصير نفينا عنه ضدّ البصر وهو العمى، ومتى قلنا: عزيز نفينا عنه ضدّ العزّة وهو الذلّة، ومتى قلنا: حكيم نفينا عنه ضدّ الحكمة وهو الخطأ، ومتى قلنا: غنيّ نفينا عنه ضدّ الغنى وهو الفقر، ومتى قلنا: عدل نفينا عنه الجور والظلم، ومتى قلنا: حليم نفينا عنه العجلة، ومتى قلنا: قادر نفينا عنه العجز، ولو لم نفعل ذلك أثبتنا معه أشياء لم تزل معه، ومتى قلنا: لم يزل حياً عليماً سميعاً بصيراً عزيزاً حكيماً غنياً ملكاً حليماً عدلاً كريماً، فلما جعلنا معنى كلّ صفة من هذه الصفات التي هي صفات ذاته نفي ضدّها أثبتنا أنّ الله لم يزل واحداً لا شيء معه، وليست الإرادة والمشية والرضا والغضب وما يشبه ذلك من صفات الأفعال بمثابة صفات الذات، لأنّه لا يجوز أن يقال: لم يزل الله مريداً شائياً، كما يجوز أن يقال: لم يزل الله قادراً عالماً»([xxii]).
القاضي سعيد القمّي المنظّر للإلهيات السلبيّة
على الرغم من أنّ الفلاسفة المتقدّمين على القاضي سعيد القمّي كانوا على قناعة واعتقاد بالإلهيّات السلبيّة فأتوا على ذكرها في مباحثهم، ولكن يبدو أنّ المنظّر لها والمبيّن لتفاصيلها والمستدلّ عليها هو القاضي سعيد القمّي، كما جاء في (شرح توحيد الصدوق)، و(شرح الأربعين) وبقيّة كتبه، وسنشير خلال البحث إلى بعض كلماته وتوضيحاته.
قال الإمام الخميني بهذا الخصوص:
«قد أرجع بعض العلماء صفات الحقّ المتعالي إلى الأمور العدميّة، وفسّروا العلم بعدم الجهل، والقدرة بعدم العجز. ورأيت من العرفاء شخصاً يصرّ على هذا المعنى، وهو المرحوم العارف الجليل (القاضي سعيد القمّي) حيث يتبع حسب الظاهر أستاذه ملّا (رجب علي) بالبيان المذكور في كتاب (شرح التوحيد). ونحن في سالف الزمان قد أجبنا على أدلّته وعلى الأخبار التي يتمسّك بظاهرها إجابة حاسمة»([xxiii]).
وفي بيان هذه الفقرة من كلام الإمـام الرضا× وهي قوله: «وَنِظَامُ تَوْحِيدِ اللهِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ»([xxiv])، قال القاضي سعيد القمّي موضّحاً:
«أي الذي ينتظم به التوحيد الحقيقي، ويصير به العارف بالله موحّداً حقيقياً، هو نفي الصفات عنه بمعنى إرجاع جميع صفاته الحسنى إلى سلب نقائضها ونفي مقابلاتها، لا أنّ هاهنا ذاتاً، وصفة قائمة بها أو بذواتها، أو أنّها عين الذات بمعنى حيثيّة كونها ذاتاً هي بعينها حيثيّة كونها مصداقاً لتلك الصفات بأن يكون كما أنّها بنفسها فرد من الوجود كذلك يكون فرداً من العلم والقدرة وغيرها فرداً عرضياً»([xxv]).
طريق معرفة الله في رأي القاضي سعيد القمّي
ما يستشفّ من عبارة القاضي سعيد القمّي هو أنّ الله يُعرف بالآيات والعلامات لا بالأسماء والصفات.
حيث قال في شرح جملة «يُعْرَفُ بِالآيَاتِ وَيُثْبَتُ بِالعَلَامَاتِ»([xxvi]):
«لما ذكر× أنّه لا يُعرف الله إلّا بما عرّف به نفسه، بيّن تعريفه بالوجه الذي عرفه به نفسه وإثباته بالطريق الذي ينبغي له.
أمّا التعريف الإلهي: فاعلم، أنّ (التعريف) هو الكشف عن الشيء والإظهار له. والله سبحانه كان كنزاً مخفياً فأحبّ أن يعرّف نفسه لخلقه حتى يعرفوه بألوهيّته وربوبيّته فيعرف؛ فجعل الخلق مظاهر لنور جماله ومرايا كماله. فمخلوقاته آياته الظاهرة منه، الكاشفة عن أنوار جلاله وجماله. وذلك لأنّا لما رأينا الأشياء موجودة لا بأنفسها، علمنا أنّ ثمّة معطياً للوجود؛ ولما رأينا هاهنا علماً مستفاداً، علمنا أنّ له واهباً هو أهل الجود؛ ولما رأينا قدرة زائدة علمنا أنّ ثمّة من يهب القدرة؛ فمن ذلك قلنا إنّه الموجود العالم القادر إلى غير ذلك من الصفات. وإلى ذلك أشير ما ورد في أخبار أهل بيت العصمة: (هل هو عالم قادر إلّا أنّه وهب العلم للعلماء والقدرة للقادرين) فمعرفة الله بالآيات هي النظر في المخلوقات التي هي آيات سلطانه، وأدلّ دليله وبرهانه، لا من حيث أنّها خلائق وممكنات ـ لأنّ ذلك معرفة طائفة من قصراء الأنظار ـ بل لأنّها مظاهر كمالات الله ومجالي أنوار الله، حيث يكون الظاهر في كلّ شيء هو الله تعالى بأسمائه، وليس في الوجود إلّا الله المتوحّد بصفاته، فهو الظاهر، حيث أنّ له في كلّ خلق ظهوراً خاصاً، هو سبب معرفة ذلك الشيء به سبحانه، ومعرفة أهل النظر إلى ذلك الشيء به عزّ شأنه، كما ورد في دعاء عرفة لسيد الشهداء: (تعرّفت إلى كلّ شيء فما جهلك شيء) فالتعريف الإلهي هو ظهوره بآياته، وبذلك عرّف نفسه لخلقه، حيث قال: (ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ)([xxvii]).
وهو الباطن عن كلّ فهم إلّا عن فهم من عرف أنّ العالم هو مظهر سرّ الله، فهو الاسم الظاهر، كما أنّ المسمّى بمنزلة روح ما ظهر، فهو الاسم الباطن؛ وأن ليس للمظهر إلّا الانصباغ بحكم الاسم الظاهر فيه؛ وأنّها أي المظاهر على عدمها الأصلي. وما وقع اسم من الأسماء الحسنى إلّا على الله»([xxviii]).
أسس الإلهيات السلبيّة
يبدو أنّ ثمّة أسس وقواعد خاصّة أعتمدها المعتقدون بالإلهيات السلبيّة، وتوصّلوا من خلالها إلى هذه النتيجة التي مفادها أنّ معرفة صفات الله غير ممكنة، وهذا ما يستوجب إرجاعها إلى الصفات السلبيّة. وأدناه سنتعرّض لتلك الأسس والقواعد بياناً وتوضيحاً ونقداً ومناقشة:
1ـ نفي التشبيه
أحد أسس وقواعد الإلهيات السلبيّة هو نفي التشبيه بين الخالق والمخلوق، حيث يرى القائلون بها: أنّ اللازم من إمكان معرفة الله تعالى هو الاعتقاد بالاشتراك المعنوي للوجود، والتشابه بين الخالق والمخلوق في أصل الوجود والصفات، بينما الآيات والروايات تنفي أيّ تشابه بينهما.
قال القاضي سعيد القمّي في شرح جملة «فَلَيْسَ الله عَرَفَ مَنْ عَرفَ بِالتَّشْبِيه ذَاتَه»([xxix]):
«هذا تفريع على النتيجة التي هي رجوع الصفات إلى سلب النقائض لإبطال من يدّعي معرفته سبحانه بصفاته، وذلك لأنّه يستلزم التشبيه؛ إذ الوجود المطلق والعلم وغير ذلك من الصفات إنّما يتحقّق في غيره ـ سبحانه ـ على ما يدّعونه، فإذا عرفه ـ عزّ شانه ـ لا بصفة من هذه الصفات يلزم أن يشبّه به، والبارئ القيّوم لا يشبه شيئاً، ولا يشبهه شيء لمنافاته التوحيد الذي حقّقناه»([xxx]).
وقال الشهيد مطهري في بيانه لهذا الأصل:
«يعتقد بعض العلماء الإسلاميين أنّ علوّ الذات الإلهية المقدّسة وشموخها وأفضليتها على الخيال والقياس والظن والوهم، يستوجب السيطرة على طائر الفكر من أوّل الأمر، وسلوك طريق (التنزيه)، وإلّا سنقع في ورطة (التشبيه) الخطرة.
إنّ ذات الله لا يمكن تشبيهها بأيّ مخلوق من المخلوقات في أيّ جهة من الجهات (ﭡ ﭢ ﭣ)([xxxi]). ومن جانب آخر فإنّ كلّ صفة نعرفها من الصفات هي صفة من صفات المخلوق لا صفات الخالق؛ لأنّنا استللناها من أحد المخلوقات. إذ إن ارتباطنا المباشر مع المخلوقات فقط، ولذلك فإنّ كلّ صفة ترتسم في أذهاننا ونعدّها كمالاً، فهي كمال ولج إلى أذهاننا عن طريق مشاهدته في أحد المخلوقات.
وهكذا لو اعتقدنا بأنّ الخالق متصف بتلك الصفة ـ أيضاً ـ نكون من القائلين باشتراك الصفة بينه وبين مخلوقاته، وجعلنا المخلوقات شبيهة وشريكة له بالصفات. لهذا ورد في الحديث: (كُلَّ مَا مَيَّزْتُمُوهُ بِأَوْهَامِكُمْ فِي أَدَقِّ مَعَانِيهِ، فَهُوَ مَصْنُوعٌ لَكُمْ مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ، وَلَعَلَّ النَّمْلَ الصِّغَارَ يَزْعَمُ أَنَّ لِلهِ زَبَانِيَّتَيْنِ).
فقد انتقد هذا الحديث ذهن البشر بأسلوب ينطوي على أناقة وإبداع خاصين، باعتبار أنّ البشر دائماً ما يجعل نفسه المثل والأنموذج، ويقيس عليها الذات الإلهية المنزّهة.
إذن فليس أمامنا طريق لأيّ صفة من صفات الله، فلا نستطيع أن نقول هو عليم أو قدير أو حي أو مريد أو سميع أو بصير؛ ولا يمكننا أن نقول عنه شيئاً آخر. فهو تعالى ممكن أن يتصف واقعاً ببعض الصفات، ولكن ليس لنا أيّ سبيل لمعرفتها، والمتيقّن من معرفتنا، وهو أنّ صفاته ـ على فرض أن تكون ثمّة صفات في البين ـ متميّزة مئة بالمئة عن الصفات التي نعرفها والتي جميعها أو أغلبها قد نشأت من المقايسة لأنفسنا، فذات الربّ بالنسبة للبشر ذات مجهولة الصفات من جميع الجهات.
يذهب أولئك الذين هم على هكذا رأي للقول: رغم ورود أسماء وصفات لله في القرآن الكريم من قبيل: العليم والقدير وغيرها، ولكننا يجب أن ننزّه ونجرّد هذه الأسماء عن المعاني التي تخطر في أذهاننا. فمعاني هذه الألفاظ التي في أذهاننا هي نفسها تلك المعاني المقتبسة من المخلوقات، والذات الأحديّة منزّهة عنها. والمعاني الواقعيّة لها لا يعلمها إلّا الله وحسب»([xxxii]).
المناقشة
أوّلاً: ينبغي الالتفات إلى أنّ الله تعالى رغم كونه ليس مثل المخلوقات ولا شبيهها، إلّا أنّه لا يباينها؛ ولذا فدعوى: كلّ ما في المخلوق مخالف ومباين لما عند الخالق فيها إثبات لنوع من الضدّية، فكما أنّه تعالى ليس مثل المخلوقات كذلك هو ليس ضدّها. وفي الحقيقة، قد وقع خلط هنا بين المفهوم والمصداق، فالوجود الخارجي للمخلوق ليس مثل الخالق، لا أنّ كلّ مفهوم يصدق على المخلوق لابدّ أن لا يصدق على الخالق.
وقال الشهيد مطهري في نقده لهذا الأصل:
«هذا المعنى بأنّ الله ليس له مثيل (ﭡ ﭢ ﭣ) صحيح عقلاً وشرعاً، فلا يمكن تشبيهه بشيء ولا تشبيه شيء به، فلا نسبة بين التراب وعالم الطهر حتى تذكر، والمعنى الآخر صحيح ـ أيضاً ـ وهو أنّ البشر غير قادر على فهم كنه ذات الحقّ وحاقّ صفاته...، ولكن هذه الجهة لا تقتضي أن يكون الامتياز والتفاوت بين المخلوق والخالق بنحو يكون فيه كلّ معنى وكلّ صفة تصدق على المخلوق لا تصدق على الله تعالى أبداً وبالعكس. فالاختلاف بين الخالق والمخلوق في الوجوب والإمكان، وفي القدم والحدوث الذاتي، وفي التناهي واللاتناهي، وبالذات وبالغير، ومن باب المثال: الله عالم والإنسان عالم أيضاً، فإنّ العلم ليس إلّا الاطلاع والإحاطة والكشف، إنّما الاختلاف في أنّ الله عالم بالوجوب، والإنسان عالم بالإمكان، فهو قديم العلم والإنسان حادث العلم، وهو عالم بالكلّيات والجزئيات والماضي والحاضر والغيب والشهادة (ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ)([xxxiii])، والإنسان عالم بمقدار محدود، وعلمه تعالى بالذات وعلم الإنسان بالغير. وتفاوت ذاك العلم وهذا العلم تفاوت اللامتناهي عن المتناهي، بل أثبت الحكماء أنّ الله فوق لا يتناهى بما لا يتناهى.
فالصحيح أنّ الله ليس مثل مخلوقاته، ومخلوقاته ليست مثل الخالق، ولابد من نفي المثليّة والندّية، ولكن نفي المثليّة لا يستلزم إثبات الضدّية، فالتنزيه بأن نقول كلّ ما في المخلوق مغاير ومخالف ومباين لما عند الخالق فيه إثبات لنوع من الضدّ بين الخالق والمخلوق، بيد أنّ الخالق كما أنّه لا مثل له لا ضدّ له أيضاً، فالمخلوق ليس ضدّ الخالق، فالمخلوق شعاع الخالق وآية الخالق ومظهر له.
هذا النحو من التنزيه ونفي التشبيه يطل برأسه من تضادّ المخلوق والخالق الناشئ من الاختلاط الحاصل بين المفهوم والمصداق، ما يعني أنّ الوجود الخارجي للمخلوق ليس مثل الخالق، لا بمعنى أنّ كلّ مفهوم يصدق على المخلوق يجب أن لا يصدق على الخالق. بغض النظر عن هذا، إن كان مقتضى التنزيه ونفي التشبيه، هو أنّ كلّ معنى يصدق على المخلوق لا يصدق على الخالق، فلابد أن يدّعى هذا الأمر حتى بالنسبة لوصف الله بـ(موجود) و(واحد)؛ بمعنى أنّنا حينما نقول: إنّ الله موجود وواحد ينبغي علينا ـ عملاً بهذا الأصل التنزيهي ـ أن نجرّد هذين اللفظين عن معناهما، وعلى الأقل نقول إنّ قولنا (الله موجود) يعني أنّ الله ليس معدوماً، وليس لنا القول إنّ الله في الواقع موجود؛ ومعنى (الله واحد) هو أنّ الله ليس متكثّراً ولا متعدّداً، ولا يمكننا القول إنّ الله واحد في الواقع؛ لأنّه يستلزم التشبيه.
ومن البديهي أنّ هكذا نظريّة لا أنّها تستلزم تعطيل الحقّ عن الصفات، والعقل عن المعرفة وارتفاع النقيضين فقط، وإنّما نوع من الإنكار لله ووحدته»([xxxiv]).
لهذا روي عن أمير المؤمنين× أنّه قال:
«مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُقَارَنَةٍ، وَغَيْرُ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُزَايَلَةٍ»([xxxv]).
ثانياً: إنّ الاستناد إلى الآية (ﭡ ﭢ ﭣ)([xxxvi]) فراراً من تشبيه الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن صفات المخلوقين، ينسجم مع نفي التشبيه في مرحلة الوجود دون الحاجة إلى نفي التشبيه في أصل الاشتراك بالأوصاف أيضاً.
ثالثاً: في مقام نقد هذا الأصل يجب القول إنّ التفسير الثبوتي والإيجابي الذي منشؤه الاشتراك المعنوي، لا يتبعه بالضرورة التواطئ المفهومي ولا التواطئ في الحقيقة ولا ما يساوي ذلك، بل الأعم من ذلك، بحيث يصبح التفسير الثبوتي والإيجابي والقول بالاشتراك المعنوي بين الخالق والمخلوق ممكناً، ولا نقع في فخ التشبيه مع قبول التشكيك المفهومي (التشكيك العام) والتشكيك في حقيقة الوجود (التشكيك الخاص).
وتوضيح المطلب كالتالي: أنّ أموراً من قبيل الوجود والعلم والقدرة وغيرها، لها معانٍ ومفاهيم عامة، وأموراً انتزاعيّة وتعدّ من المعقولات الثانية الفلسفيّة التي تصدق على الخالق وعلى المخلوق أيضاً، وفي الوقت ذاته لا يبعث هذا الاشتراك المفهومي على التشابه؛ لأنّ وجود تلك الطبيعة وصفاتها ليست مشتركة بين الخالق والمخلوق، إذ وجود الله تعالى أعلى من التمام، ومنزّه عن التناهي والمحدوديّة، فلا يشوب ذاته عدم ولا ينفذ إلى وجوده قصور أو نقص، على خلاف وجود الممكنات الذي هو عبارة عن فيض من فيوضات الله تعالى وقائم به، ولهذا فهو محدود ومركّب من الوجود والعدم.
فمع هذا التفاوت الفاحش، ما هو وجه الشبه بين هذه المراتب الوجوديّة يا ترى؟ إنّ اشتراك الموجودات واختلافها مع بعضها البعض مثل اشتراك الأفراد والمصاديق في الكلي الطبيعي واختلافها عن بعضها ليس في أمر آخر (بأن يكون التمايز بتمام الذات والاشتراك بالعوارض أو التمايز ببعض الذات والاشتراك في أمر عام أو الاشتراك بتمام الذات والتمايز بالعوارض) بل اشتراك الموجودات واختلافها في نفس الوجود أيضاً (ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، وما به الامتيازعينما بهالاشتراك). إنّ هذا التغاير الحاكم بين المصاديق ومراتب الوجود يوجب نفي التشبيه ببساطة؛ لأنّ وجود كلّ موجود هو التعيّن والتشخّص، أي أنّ أيّ مرتبة من مراتب الوجود لا تتحقّق دون تعيّن وتشخّص، والوجود مساوي للوجود المتعيّن، بناء على هذا، فالله تعالى هو عين الوجود والوجود المحض وفي أعلى وأشدّ مرتبة وجوديّة، فلا تناهي له في شدّة وجوده، لا يشابه أيّ موجود وجوده مشوب بالنقص والمحدوديّة، فلا يوجب الاشتراك بين الخالق والمخلوق بأمر ما كالاسم، التشابه بينهما ، ومن ثم فإنّ الشدّة والنقصان والضعف والتي يكون الاختلاف بسببها هي أمور غير الوجود، بل الحقيقة هي أنّ الله تعالى ممتاز عن غيره بذاته وهويّته البسيطة التي يمثّل تمام وشدّة وجودها عين وجوده([xxxvii]).
رابعاً: نحن نعتقد كذلك بنفي التشبيه بين صفات الخالق والمخلوقين، وهذا النفي يصدق على نفي التشبيه في المصداق أيضاً، ولا ضرورة لتعميم نفي التشبيه لمفاهيم الصفات كذلك.
خامساً: كيف أنّ التفسير الثبوتي والإيجابي لوجود الله وصفاته تعالى مستلزم لتشبيه الله (الخالق) بالمخلوقات؟ والحال أنّ الاشتراك المفهومي والمعنائي في هذا الموضع مقترن بالتشكيك العامي (الصدق المفهومي) والتشكيك الخاص (الحقيقة الخارجيّة للوجود)، ولا يستلزم أيّ تشبيه ومشابهة. إنّ وجود هكذا استلزام له جذور في الفكر الذي يعتقد بمساواة التفسير الثبوتي والاشتراك المعنوي للتواطئ في الصدق وفي الحقيقة الخارجيّة، مع أنّه أعم من ذلك. إنّ الاشتراك بالمفهوم ليس باعثاً على التشبيه والمماثلة؛ لأنّ ما لدينا هنا مصاديق مختلفة، ومن الممكن أن تشترك المصاديق المختلفة في مفهوم انتزاعي خارج عن حقيقتها وعن ذات مصاديقها، ومثل هذا الاشتراك بين الواجب والممكن لا يثبت نقصاً للواجب ولا كمالاً للممكن؛ لأنّ مصاديق ذلك المفهوم الواحد لا تتماثل في مقام المصداق، ولا حتى في مقام الصدق؛ بمعنى أنّه لا الواجب الذي هو مصداق الآية الكريمة (ﭡ ﭢ ﭣ) له مثل، ولا صدق مفهوم الوجود عليه مماثل ومشابه لصدق مفهوم الوجود على الممكنات([xxxviii]).
سادساً: ما ردّ به العلّامة الطباطبائي نظريّة الإلهيات السلبيّة، وهو قوله:
«ومما تقدّم يظهر فساد قول من قال: إنّ معاني صفاته تعالى ترجع إلى النفي؛ رعاية لتنزيهه عن صفات خلقه، فمعنى العلم والقدرة والحياة هناك عدم الجهل والعجز والموت، وكذا في سائر الصفات العليا، وذلك لاستلزامه نفي جميع صفات الكمال عنه تعالى، وقد عرفت أنّ سلوكنا الفطري يدفع ذلك، وظواهر الآيات الكريمة تنافيه»([xxxix]).
2ـ التباين بين الموجودات
من العوامل الأخرى الموجبة لتبنّي نظريّة التفسير السلبي للصفات من قبل بعض العلماء هو قبولهم تباين الموجودات وعدم سنخيّتها مع بعضها. إنّ نظريّة التباين بنفسها تتطلّب أموراً كثيرة، من قبيل الاحتراز من تشبيه الخالق بالمخلوق. ففي اعتقادهم أنّ لازم قبول السنخيّة التشبيه، وبما أنّ التشبيه مردود يجب قبول التباين بين الموجودات، وبعبارة أخرى: يجب القول بعدم وجود أيّ تشابه وتماثل بين الله الغني وبين الممكن المحتاج من رأسه إلى أخمص قدميه، فهو منزّه عن مشابهة المخلوقات، وهذا يعني قبول وجود التباين بين الخالق والمخلوق.
والخلاصة: أنّ القول بتباين الموجودات يعدّ ـ أيضاً ـ أحد الأسس والأصول الأساسيّة للإلهيات السلبيّة.
قال القاضي سعيد القمّي بهذا الصدد، أثناء شرحه جملة «مُبَايِنٌ لِجَمِيعِ مَا أَحْدَثَ فِي الصِّفَاتِ»([xl]):
«الجمع المحلّى باللام يفيد الاستغراق، والمعنى: أنّه تعالى مباين لجميع ما خلقه في جميع الصفات، فوجوده مباين لسائر الوجودات، وعلمه مباين لسائر العلوم، وهكذا في جميع الصفات. والمباينة الحقيقيّة في الصفة، هي أن لا يصدق على الوصفين ـ أي وصف الخالق والمخلوق ـ معنى عام كما يقوله علماء الزور في الوجود والعلم وسائر الصفات، وإلّا لم يتحقّق المباينة التامّة؛ إذ لو كفى في المباينة الوجوديّة أنّ وجوده الخاص به مباين للوجودات لم تكن تلك المباينة مختصّة به تعالى، إذ الوجود الخاص بزيد مباين للوجود الخاص لعمرو وكذا العلم وغيره. فتبصر»([xli]).
المناقشة
أوّلاً: لا شكّ في ضرورة السنخيّة بين العلّة والمعلول؛ فبدونها يمكن أن يكون كلّ شيء علّة لشيء آخر، ولهذا فإنّ الكمالات التي في الوجود هي علامة على أنّها موجودة بنحو أشدّ وأكمل في العلّة، وبالتالي إن كان بين وجود الله وخلقه اشتراك لفظي لا معنوي، والله سبحانه مباين لخلقه بشكل تام وكامل، سيصبح صدور المخلوق منه دون توجيه أو تبرير، وكثرة الوسائط لا تغني نفعاً.
ونتيجة لضعف قوى الإنسان الإدراكيّة لا يتمكّن الإنسان من معرفة الله على ما هو عليه، ولكن لا يلزم من ذلك نفي المعرفة بصورة تامّة؛ لأنّ الله سبحانه ليس وراء الوجود، بل وجوده وراء جميع الوجودات.
كما أنّه ليس من المقرّر أن تكون لله سبحانه صورة في الذهن حتى تستوجب تحديده؛ إذ ليس له صورة، ومعرفته ليست ماهويّة، كما أنّ معرفتنا ليست منحصرة بمعرفة الماهيّات فقط؛ لأنّ معرفة الإنسان بالوجود بديهيّة، على أنّه قسيم للماهيّة لا من سنخها.
ثانياً: يجب القول بخصوص هذا الادعاء ـ بغض النظر عن الإشكالات العديدة المرافقة لنفي السنخيّة والتباين ـ: إن السنخيّة لا توجب التشبيه؛ لأنّ السنخيّة لا تستلزم المساواة في مراتب الوجود، بل المراد السنخيّة في عمليّة التشكيك؛ لأنّه مع وجود التشكيك لا تتشابه ولا تتماثل أيّ مرتبة مع مرتبة أخرى، ولا تقع الموجودات في درجة واحدة. وقد تبيّن في المناقشة السابقة إمكانيّة التفسير الثبوتي والإيجابي دون أن يلزم منه أيّ تشبيه يذكر، وأوضحنا أنّه لا يوجد أيّ تلازم بين التفسير الإيجابي والتشبيه كما أنّه لا تلازم كذلك بين نقيض هذه الموارد، أي لا يوجد تلازم بين التفسير السلبي وعدم التشبيه والمثل. فيجب الالتفات إلى أنّ عدم وجود مثل وشبيه للحقّ تعالى وإن كان صحيحاً طبقاً لنصوص مثل (لا مثل له) و(ليس كمثله شيء) وللبراهين العقليّة أيضاً، لكنّه من طرف آخر لا يتصوّر له ضدّ في الوجود طبقاً لمضمون «لا ضدّ له»، بل ولا معنى لأن تكون سائر الوجودات ضداً للواجب تعالى([xlii]).
ثالثاً: إن قلنا بالتباين بين الحقّ والخلق، فإنّنا بذلك لم نسد باب المعرفة بأسماء الحقّ وصفاته فقط، بل سيتوقف ويختلّ حصول الأنس والمحبّة أساساً؛ فمن دون معرفة لا يتحقّق للأنس والمحبّة معنى صحيح ثابت؛ فإمكان حصول المعرفة وما يتبعه من الأنس والمحبة المتبادلة أمر ضروري بحسب الشريعة والبيانات العقليّة. إذن لا معنى متأتّى لنفي السنخيّة بين الحقّ والخلق([xliii]).
رابعاً: إنّ تحقق السنخيّة بين العلّة والمعلول، أو الخالق والمخلوق، لا يعني أنّ للخالق شريكاً في الأسماء والصفات أبداً، فكثير ممن لديهم عقيدة راسخة بالسنخيّة بين العلّة والمعلول لا يرون في الوقت ذاته للخالق شريكاً ولا شبيهاً؛ لا في الذات ولا في الأسماء والصفات؛ لأنّ تحقق السنخيّة بين شيئين لا يعني أن يصبحا شبيهين أو شريكين أبداً، كما أكّد كثير من القائلين بالسنخيّة بين العلّة والمعلول على مسألة التشكيك في مراتب الوجود واعتمدوها، وهذا الترتيب من الممكن تحققه في الكثير من أمور السنخيّة والتناسب، ولا يكون هناك أي تشابه وشراكة بين المراتب بلحاظ الاختلاف في المراتب التشكيكية في الوقت ذاته، فالسنخيّة لا هي مُنزِّل حتى تعطي التنزيل وتجر الواجب إلى حدّ الإمكان، ولا هي مصعّد حتى تصعّد وتبلغ بالممكن حدّ الوجوب، بل يبقى المعلول والعلّة كلّ منهما على حاله في مرتبته، فهي كاشف ومبيّن لإعطاء العلّة للمعلول مما كان عندها، وأنّ ما لدى المعلول هو ما أعطته إيّاه العلّة، فالسنخيّة لا تعني التساوي في الرتبة لا من قريب ولا من بعيد.
ولنا أن نأتي هنا بروايات كثيرة كشواهد على هذا الأمر، ولكننا نكتفي برواية واحدة نتناولها بالبحث والمناقشة:
فقد نقل هشام بن الحكم خطاباً للإمام الصادق×، قد وجّهه لشخص ملحد منكر لوجود الله تبارك وتعالى، جاء في مقطع منه:
«لَا بُدَّ مِنْ إِثْبَاتِ صَانِعِ الأَشْيَاءِ خَارِجٍ مِنَ الجِهَتَيْنِ المَذْمُومَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا النَّفْيُ؛ إِذْ كَانَ النَّفْيُ هُوَ الإِبْطَالَ وَالعَدَمَ، وَالجِهَةُ الثَّانِيَةُ التَّشْبِيهُ؛ إِذْ كَانَ التَّشْبِيهُ مِنْ صِفَةِ المَخْلُوقِ الظَّاهِرِ التَّرْكِيبِ وَالتَّأْلِيفِ»([xliv]).
وتوضيحه: إنّ إثبات الصانع يجب أن يكون بنحو ينقذنا ويخلّصنا من ورطتين؛ إحداهما: ورطة النفي، يعني أنّنا نثبت حتى ننجو من القول بالعدم بالنسبة للحق، والثانية: يجب أن لا يجرّنا إثبات الحقّ للوقوع بورطة التشبيه. فلابد أن يكون إثباتاً لا تشبيهاً (إِثْبَاتٌ بِلَا تَشْبِيهٍ)؛ يعني بلوغ القمّة في الإثبات دون تشبيه. ففي الجهة الأولى ينقذنا الإثبات من ورطة العدم والنفي وهكذا في المخلوقات. من هذا الوجه يقول إنّ الإثبات ينبغي أن لا يجرّ إلى التشبيه؛ لأنّ هذا الإثبات النافي للعدم يستخدم في المخلوق أيضاً. إذن هذا الإثبات يتضمّن مرتبتين: إحداهما في ميدان المخلوقات ذات الصفات الإمكانية (المَخْلُوقِ الظَّاهِرِ التَّرْكِيبِ وَالتَّأْلِيفِ)، والأخرى في مرتبة صانع الأشياء، فينبغي الإثبات بنحو لا ينجر إلى التشبيه، بمعنى عدم إثبات الخصوصيّات الإمكانيّة لذاك الصانع، إذن ثمّة حقيقة إثباتية هنا مرتبتها النازلة المخلوق ومرتبتها العالية الخالق([xlv]).
3ـ الاعتقاد بالاشتراك اللفظي للوجود
يعتقد القاضي سعيد القمّي بالاشتراك اللفظي للوجود بين وجود الواجب ووجود الممكن، وقد ردّ بالنفي على السؤال القائل هل أنّ إطلاق الوجود عليهما بمعنى واحد، والواجب والممكن موجودين بمعنى واحد؟! فبحسب رأيه أنّ لفظ الوجود لا يُحمل بمعنى واحد على مصاديقهما؛ لأنّ نحو وجود الواجب يخالف نحو وجود الممكن، وهكذا الأمر بالنسبة لصفات الواجب والممكن أيضاً، فبينها اشتراك لفظي.
وبيّن القاضي سعيد القمّي مذهبه هذا بقوله:
«... وقد دريت من أوّل هذا الباب وستعلم في الأبواب الأخر أنّهم^ ينادون بأعلى صوتهم باختلاف المعنى واشتراك الاسم...»([xlvi]).
وقال أيضاً في ذيل حديثه «مَا عَرَفَ اللهَ مَنْ شَبَّهَهُ بِخَلْقِهِ»([xlvii]):
«والعجب من بعض المتكلّمين المتقشّفين أنّهم يأبون عن وجود المجرّدات العقليّة، زعماً منهم أنّ ذلك يستلزم التشبيه، مع أنّ التجرّد من الأمور السلبيّة، ولا يتحاشون عن القول بالاشتراك في جميع الصفات الثبوتيّة! وهل هذا إلّا عمى، أو تعامى، أم على قلوب أقفالها، بل طبع الله عليها، فلا يؤمنون إلّا قليلاً»([xlviii]).
وقال أيضاً في كتاب «شرح الأربعين»:
«فالحقّ المتبع ما تحققه البراهين وتؤيّده أخبار الصادقين^ وتطابقه كلمات أرباب الكشف واليقين، وهو أنّ الوجود مشترك بين الواجب ـ عزّ شأنه ـ والممكنات اشتراكاً لفظياً وإطلاقاً إسمياً؛ وأنّ الوجود العام البديهي من الأمور الخارجيّة ولا يصدق على الأوّل تعالى بوجه؛ وأنّه ليس بكلّي ولا جزئي ولا واحد ولا كثير، وليس له أفراد لا ذاتيّة ولا عرضيّة، بل إنّما يتكثر بتكثّر الماهيّات؛ وأنّ قاطبة صفات الله سبحانه راجعة إلى السلوب، بمعنى سلب مقابلها عنه تعالى، لا أنّ هاهنا ذاتاً وصفة ـ كما يقوله المحجوبون ـ أو ذاتاً هي بعينها الصفة ـ كما يقوله المحققون ـ كلّ ذلك بالبراهين القطعيّة، وليس هنا محلّ ذكرها.
ومن الأخبار من الأئمّة الأطهار^ ما روى أبو هاشم الجعفري في خطبة الرضا×، حيث قال: (وكلّ ما في الخلق لا يوجد في خالقه، وكلّ ما يمكن فيه يمتنع من صانعه) ومن المعلوم أنّ تلك الصفات من الوجود والعلم والحياة والقدرة ممكنات في الخلق فيمتنع في الله سبحانه.
وليس لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون بعض أفراد تلك الصفات ممكنات وبعضها واجبات؟
لأنّا نقول: فتنقلب الحقيقة؛ على أنّ الكلام في السبب المرجّح، مع أنّه لا يتحقّق العينيّة»([xlix]).
لم يكن القاضي سعيد القمّي قائلاً بالاشتراك اللفظي بين صفات الخالق والمخلوق فقط، بل راح ينكر الاشتراك المعنوي حيث قال:
«... فالاشتراك بين الظاهر والمظهر ليس إلّا بمجرّد اللفظ؛ إذ لو كان في المعنى لكان المظهر قد استغنى عن الظاهر فيه.
والعجب من بعض الأعلام حيث جعل الاشتراك بينهما معنوياً، واستدلّ عليه بأنّه لو لم يكن كذلك، لم يكن هذه الصور بمعانيها دلائل وشواهد على أسماء الله وأوصافه.
وأقول: لو كان كما يقول هو، لم يصح الاستدلال؛ لأنّ الاتحاد في المعنى المشترك يأبى عن الدلالة، لأنّ ذلك المعنى كما أنّه بالذات للظاهر، كذلك يكون ـ على زعمه ـ للمظهر، فأيّ ترجيح لأن يكون هذا دليلاً لا مدلولاً؟! وأمّا إذا كان الاشتراك بمجرّد اللفظ، وإطلاق المعنى على المظهر من حيث ظهوره فيه، لا من حيث أنّ ذلك له، فلا محالة يكون المظهر حينئذ دالّاً على الظاهر فيه، وذلك لأنّ تلك الصفة وهذا الاسم، ليس (له) أصلاً، وإنّما ظهر (فيه) فهو مثلاً عالم بأنّه مظهر للعلم، لا بأنّه قام به العلم؛ فهو أدلّ دليل على العلم الظاهر فيه حيث يكون بذاته ليس (له) تلك الصفة، وإنّما ظهرت (فيه)، فتدبّر. فمعرفة السالك إيّاه، إنّما يكون بالنظر إلى تلك الآيات ليتوصّل بها إلى مبدأ الموجودات. وهذه طريقة غريبة قلّ من العلماء من يتفطّن بذلك في معرفة الله»([l]).
وقال أيضاً في شرح جملة «فَكُلُّ مَا فِي الخَلْقِ لَا يُوجَدُ فِي خَالِقِهِ وَكُلُّ مَا يُمْكِنُ فِيهِ يَمْتَنِعُ مِنْ صَانِعِهِ»([li]):
«هذا تفريع على أنّ إثبات الصفة تشبيه، فكلّ ما في الخلق من الأمور الصادقة عليه ـ اعتباريّة كانت أو خارجيّة ـ لا يوجد في خالقه؛ إذ لو وجد فيه سبحانه لكان يشترك هو تعالى مع خلقه في كونه مصداقاً لذلك المفهوم، وما به الاشتراك يستدعي ما به الامتياز وإن كان بالحيثيات، فيتركّب هو ـ عزّ شأنه ـ وإن كان بالجهات»([lii]).
المناقشة
أوّلاً: الكثير من الحكماء والفلاسفة والمتكلّمين يقولون بنظرية الاشتراك المعنوي للوجود، وأقاموا الأدلّة على ذلك. ونشير هنا إلى عبارات بعض منهم:
يقول العلّامة الحلّي:
«البحث الثاني في أنّه مشترك: الحقّ أنّه كذلك، لأنّا نقسّم الوجود إلى الواجب والممكن، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، ولأنّ النفي أمر واحد، وهو نقيض الوجود، فيكون الوجود واحداً؛ لأنّه لو تعدّد لم تنحصر القسمة في قولنا (الشيء إمّا موجود أو معدوم)»([liii]).
وقال الفاضل المقداد:
«إنّه قد اختلف في الوجود هل هو مقول بالاشتراك اللفظي أو المعنوي؟ فذهب أبو الحسين البصري وأبو الحسن الأشعري إلى الأوّل، لأنّ وجود كلّ ماهية هو نفسها، فليس هناك زائد حتى يكون مشتركاً، فإن كان يقع شيء من المشاركة فذلك في اللفظ لا غير، وقد عرفت ضعف حجّتهم في ذلك.
وذهب الحكماء وأبو هاشم وأصحابه من المعتزلة وجمهور الأشاعرة إلى الثاني. ثم هؤلاء اختلفوا: فقال الحكماء: هو مقول بالتشكيك على ما تحته من الموجودات، وقال أبو هاشم وأتباعه وأثير الدين الابهري: هو مقول بالتواطؤ، واختار المصنّف والمحقّق الطوسي+ مذهب الحكماء»([liv]).
وفي ذلك قال الملّا صدرا:
«في أنّ مفهوم الوجود مشترك محمول على ما تحته حمل التشكيك لا حمل التواطؤ.
أمّا كونه مشتركاً بين الماهيات فهو قريب من الأوّليات، فإنّ العقل يجد بين موجود وموجود من المناسبة والمشابهة ما لا يجد مثلها بين موجود ومعدوم، فإذا لم يكن الموجودات متشاركة في المفهوم، بل كانت متباينة من كلّ الوجوه، كان حال بعضها مع البعض كحال الوجود مع العدم في عدم المناسبة، وليست هذه لأجل كونها متحدة في الاسم...»([lv]).
وبهذا الخصوص قال الملّا هادي السبزواري:
«سألني سائل عن أنّ إطلاق أسماء الله تعالى على غيره هل هو من باب الاشتراك المعنوي أو غيره، مع الإشارة الى الدليل؟
أقول: الحقّ أنّه من باب الاشتراك المعنوي، والدلائل كثيرة، وهى أدلّة اشتراك الوجود معنى، المذكورة في كتب المتكلّمين، من شاء فليرجع إليها.
والذى حدا بعض المعاصرين على نفى الاشتراك المعنوي التنزيه، وليس إلّا التعطيل، فإنّا نطلق عليه تعالى وعلى غيره لفظ الموجود،فإمّانرومبهمنشأالآثار،أوالذىيخبرعنه،أوالثابتالعينونحوها،فقد حصل الاشتراك المعنوي؛ إذ لا يستدعى هذا الاشتراك إلّا أنّ هنا مفهوماً واحداً عاماً يصدق على الموجودات، وهى معنونات لهذا العنوان الواحد، لا أنّ حقيقة الوجود واحدة كما يتوهّم من لا يفرّق بين المفهوم والمصداق والمشترك، والمشترك فيه.
بل حقيقة الوجود عند بعض الحكماء حقائق متخالفة بتمام ذواتها البسيطة بعد اشتراكها في المفهوم العنواني، وهو سخيف جدّاً.
وعند بعض حقيقة واحدة، والممكنات ماهيات أصيلة، فالماهيات موضوعات للكثرة، وحقيقة الوجود للوحدة، بل عين الوحدة، وعندهم الماهيات الإمكانيّة موجودة بالانتساب، والموجود بمعنى المنسوب إلى الوجود في الممكن، وفى الواجب تعالى عين الوجود، وينسبون هذا المذهب إلى أذواق المتألّهين.
أقول: حاشاهم عن ذلك، والحقّ أنّ الوجود مقول بالتشكيك، وله مراتب متفاوتة بالكمال والنقص والتقدّم والتأخّر والشدّة والضعف، وعلى أيّ تقدير لا يلزم المماثلة بين حقيقة الوجود والوجود الإمكاني؛ إذ ليس المشترك فيه إلّا المفهوم المحمول على الكل.
نعم، بين المراتب سنخيّة كسنخيّة الشّيء والفيء، لا كسنخيّة شيء وشيء، إذ يعتبر بين العلّة والمعلول السنخيّة، فمعلول الوجود وجود، ومعلول النور نور، ومعلول العدم عدم، ومعلول الماهيّة ماهيّة كلازم الماهيّة، وكذا في طرف العلّة (ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ)([lvi]).
وإمّا أن لا نقصد منه معنى، فهو تعطيل محض، وسدّ لباب الحمد والثّناء إذا أطلقنا عليه اللّفظ بلامعنى.
وهكذا في الصفات الكماليّة، فإنّ العالم مفهومه: من ينكشف لديه الشيء، ومفهوم القادر: من يفعل بالعلم والمشيّة، ومفهوم الحى هو: الدرّاك الفعّال، وقس عليه باقي الأسماء، فإذا أطلقناها على غيره تعالى نريد بها هذه المفاهيم.
واذا أطلقناها على الواجب تعالى فإمّا أن نروم هذه فقط جاءالاشتراكالمعنوي،وإنكانالانكشافكأصلالوجودفيحقّهتعالى (وكذا الفعل) فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى عدّة وشدّة، وفينا محدوداً، وفى عين محدوديّته ظلّاً وفيئاً، لا أصلاً وشيئاً.
وأيضاً علمه تعالى فعلى حضوري، وعلمنا انفعالي وحصولي، وعلمه في وحدته كلّ المعلوم، وعلمنا محاط علمه (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ)([lvii]) ومشيّته كلّ المشيّات، وما تشاؤن إلّا أن يشاء الله، وقدرته وجوبيّة وقدرتنا إمكانيّة.
وبالجملة صفاتنا الكماليّة ظهور صفاته، وظهور الشيء ليس شيئاً على حياله، بل أثر الشيء ليس بما هو أثر شيئاً باستقلاله، بل فقر محض إلى مبدئه، (ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ)([lviii]).
فكيف يكون المفتقر بالذات شريكاً للغنى المغنى، ولو كان الشّركة في المفهوم العام محذوراً، كان الشركة في اللفظ ـ أيضاً ـ محذوراًوهوواقع.
فظهر أنّ هذا النحو من التنزيه بارد مؤدّ إلى التعطيل في أصل الوجود وتوابع الوجود، والله تعالى خارج عن الحدّين حدّ التعطيل وحدّ التشبيه كما في أحاديث أئمّتنا المعصومين المرويّة في الكافي وغيره»([lix]).
قال الإمام الخميني بهذا الشأن:
«إنّي لأتعجّب من العارف المتقدّم ذكره، مع علوّ شأنه وقوّة سلوكه كيف ذهل عن ذاك المقام الّذي هو مقام نظر العرفاء العظام حتّى حكم بنفي الصفات الثبوتيّة عن الحقّ ـ جلّ شأنه ـ وحكم بأنّ الصفات كلّها ترجع إلى معان سلبيّة؛ وتحاشى، كلّ التحاشي، عن عينيّة الصفات للذات. وأعجب منه الحكم بالاشتراك اللفظي بين الأسماء الإلهيّة والخلقيّة والصفات الواقعة على الحقّ والخلق...، وظنّي أنّ ذهابه إلى ذلك لعدم استطاعته على جمع الأخبار، فوقع فيما وقع»([lx]).
وقال العلّامة الطباطبائي:
«الوجود بمفهومه مشترك معنوي، يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد، وهو ظاهر بالرجوع إلى الذهن حينما نحمله على أشياء أو ننفيه عن أشياء، كقولنا: الإنسان موجود، والنبات موجود، والشمس موجودة، واجتماع النقيضين ليس بموجود، واجتماع الضدّين ليس بموجود. وقد أجاد صدر المتألهين+ حيث قال: «إنّ كون مفهوم الوجود مشتركاً بين الماهيات قريب من الأوّليات».
فمن سخيف القول ما قال بعضهم: «إنّ الوجود مشترك لفظي، وهو في كلّ ماهية يحمل عليها بمعنى تلك الماهية».
ويردّه لزوم سقوط الفائدة في الهليّات البسيطة مطلقاً، كقولنا: الواجب موجود، والممكن موجود، والجوهر موجود، والعرض موجود.
على أنّ من الجائز أن يتردّد بين وجود الشيء وعدمه مع العلم بماهيّته ومعناه، كقولنا: هل الاتفاق موجود أو لا؟
وكذا التردّد في ماهيّة الشيء مع الجزم بوجوده، كقولنا: هل النفس الإنسانيّة الموجودة جوهر أو عرض؟ والتردّد في أحد الشيئين مع الجزم بالآخر يقضي بمغايرتهما.
ونظيره في السخافة ما نسب إلى بعضهم: (أنّ مفهوم الوجود مشترك لفظي بين الواجب والممكن).
ورُدّ بأنّا إمّا أن نقصد بالوجود الذي نحمله على الواجب معنى أو لا. والثاني يوجب التعطيل، وعلى الأوّل إمّا أن نعني به معنى الذي نعنيه إذا حملناه على الممكنات، وإمّا أن نعني به نقيضه. وعلى الثاني يلزم نفي الوجود عنه عند إثبات الوجود له، تعالى عن ذلك، وعلى الأوّل يثبت المطلوب، وهو كون مفهوم الوجود مشتركاً معنوياً.
والحقّ ـ كما ذكره بعض المحقّقين ـ أنّ القول بالاشتراك اللفظي من الخلط بين المفهوم والمصداق، فحكم المغايرة إنّما هو للمصداق دون المفهوم»([lxi]).
ثانياً: لا ينسجم الاعتقاد بالاشتراك اللفظي بين صفات الله وصفات الخلق مع الأدلّة على فاعليّة الله القائمة على أساس قاعدة الواحد المبرهنة عند القاضي سعيد القمّي وأستاذه.
توضيح المطلب: من بين النقود الموجّهة لنظريّة القاضي سعيد القمّي، وأستاذه الملّا رجب علي التبريزي بخصوص الإلهيّات السلبيّة، عدم الانسجام مع الأساس المقبول في بيان قاعدة الواحد، وعدم الانسجام في الأسس الفلسفيّة يحكي عن عدم وجود ارتباط وانسجام أساسي بين المسائل. لقد فسّر هذان العالمان الفعل الإلهي من خلال قاعدة الواحد، وذهبوا للقول بأنّ الفعل الإلهي واحد لا أكثر، حيث بيّن الملّا رجب علي التبريزي القاعدة بالصورة التالية:
«إنّ الواحد المحض البسيط من جميع الجهات لا يمكن أن يصدر عنه إلّا الواحد»([lxii]).
كما يبدو من القاعدة أنّ الواحد الأوّل هو إشارة إلى الحقّ تعالى، والواحد
الثاني ـ بحسب قول القاضي سعيد القمّي ـ إشارة إلى العقل، وهو الفعل الإلهي([lxiii]).
يدور استدلال هذين الفيلسوفين في إثبات قاعدة الواحد على مدار أصل السنخيّة، وعليه فمن لا يقول بهذا الأصل لا يكون استدلاله كافياً بالنسبة له في إثبات قاعدة الواحد، فيرجع أصل السنخيّة لدى كلا العالمين إلى الخصوصيّة والعلاقة الذاتيّة بين العلّة والمعلول، وعلى ما هم عليه، فلو لم تتوفّر هذه الخصوصيّة والعلقة الذاتيّة بين العلّة والمعلول سيلزم منه الترجيح بلا مرجّح، ولما كان الترجيح بلا مرجّح محالاً، إذن لابد من وجود خصوصيّة وعلاقة ذاتيّة بينهما. هذا في الوقت الذي يتناقض فيه هذا الكلام مع المبنى المقبول عند هذين الفيلسوفين القائم على القول بالبينونة المطلقة بين الله وسائر مخلوقاته في الأوصاف الإلهيّة، وكلّ واحد منهما يقول بالتباين التام والكامل بين الله والممكنات في الذات والصفات، ويجدر التساؤل حول أنّه إذا كانت هناك خصوصيّة وتناسب ذاتي بين العلّة والمعلول فما معنى التباين إذن؟!([lxiv]).
ثالثاً: يتضح من خلال البحوث الماضية أنّه من الممكن ـ بعد نفي التباين وقبول السنخيّة ـ انتزاع مفهوم واحد جامع، دون أن يستلزم ذلك أيّ تشبيه، والقول بالاشتراك المعنوي، بحيث يكون الاشتراك المعنوي في هذه الصورة مصحوباً بالتشكيك في الصدق والمصداق؛ بمعنى أن يكون التشكيك سار بين مصاديق ذلك المفهوم الواحد، وقد مضى بيان الدليل عليه، وهو أنّ الاشتراك المعنوي أعم من التواطئ الموجب للتشبيه والتشكيك الذي لا ينجر للتشبيه؛ لهذا نقول بمعية التشكيك للاشتراك المعنوي في هذا المورد([lxv]).
رابعاً: علاوة على ما بيّن، فإنّ نظريّة الاشتراك اللفظي تواجه إشكالات كثيرة، من جملتها حينما نقول: (الله موجود) فإن كنّا نفهم من لفظ الوجود نفس المعنى الذي نفهمه من قولنا: (الإنسان موجود) فهذا هو الاشتراك المعنوي، وإن أردنا المعنى المقابل له وهو العدم باعتبار أنّ الوجود والعدم نقيضان وارتفاعهما محال، سيلزم من ذلك نفي الوجود، وإن لم نفهم أيّ معنى يلزم منه تعطيل المعرفة([lxvi]).
4ـ مخالفة القول بعينيّة الصفات للذات
الأصل الآخر الذي بنى عليه القاضي سعيد القمّي اعتقاده بالإلهيات السلبيّة هو مخالفة وإنكار عينيّة الصفات الإلهيّة للذات المقدّسة، إذ يرى أنّ الصفات الإلهيّة لا هي عين ذاته ـ مثلما يقول به أغلب المتكلّمين ـ ولا هي زائدة عن ذاته بالشكل الذي يقول به الأشاعرة. ففي عين ردّه لنظريّة الأشاعرة لم يقبل رأي متكلّمي الشيعة في عينيّة صفات الله لذاته؛ لأنّه يرى الاعتقاد بعينيّة الصفات مع الذات الإلهيّة يواجه عدّة إشكالات، وبالتالي ومن أجل رفع الإشكالات عامة، ذهب للقول بالإلهيات السلبيّة، وعدم إمكان معرفة الصفات الإلهيّة، وإرجاع الصفات الثبوتيّة إلى الصفات السلبيّة.
وبتعبير آخر: إنّ المعتقدين بالإلهيات السلبيّة أنكروا معرفة الصفات الثبوتيّة فراراً من الوقوع في فخ الأشاعرة؛ لهذا قالوا: يلزم من عدم رجوع الصفات الثبوتيّة إلى السلبيّة زيادة الصفات على الذات، والقول بالزيادة باطل، والنتيجة لزوم رجوع الصفات الثبوتيّة إلى السلبيّة؛ لأنّ افتراض عينيّة الصفات للذات هو باطل أيضاً.
ففي شرح الحديث المروي عن أمير المؤمنين×:
«مَا دَلَّكَ القُرْآنُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَاتَّبِعْهُ لِيُوصِلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِهِ، وَأْتَمَّ بِهِ، وَاسْتَضِئْ بِنُورِ هِدَايَتِهِ؛ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ وَحِكْمَةٌ أُوتِيتَهُمَا، فَخُذْ مَا أُوتِيتَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَمَا دَلَّكَ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ مِمَّا لَيْسَ فِي القُرْآنِ عَلَيْكَ فَرْضُهُ، وَلَا فِي سُنَّةِ الرَّسُولِ وَأَئِمَّةِ الهُدَى أَثَرُهُ، فَكِلْ عِلْمَهُ إِلَى اللهِ}، فَإِنَّ ذَلِكَ مُنْتَهَى حَقِّ اللهِ عَلَيْكَ»([lxvii]).
قال القاضي سعيد القمّي:
«وملخّصه: أنّ الوصف هو ما وصف الله به نفسه، فلا تتجاوز أنت عنه، وانظر إلى القرآن الذي هو كلامه وبيان محامده وأحكامه؛ فما دلّك القرآن من صفته وبيان معنى صفته فاتبع ما يدلّك القرآن عليه؛ ليوصلك إلى معرفة الله، واجعله إمامك ومقتداك، واستضئ بنور ما فهمته ليهديك إلى أنوار أخر، فإنّ ذلك نعمة عظيمة وبيان وفضيلة أعطاكها الله، فخذ ما أوتيت على يقين إذا عاضدتك الأخبار، وأيّدتك عقول أولي الأبصار، واشكر الله على ذلك حيث أيّدك بفهمه واستأثرك بمعرفته. وما دلّك الشيطان أي المضلّات الداخلة والخارجة من القول بأنّ الصفات عين أو زائدة قائمة بأنفسها أو غير قائمة، وذلك من جملة الأمور التي ليس في القرآن فرضه عليك، ولا في سنّة الرسول وخلفائه أثر لذلك، ولم يعاضدك عقل غير مشوب بالوساوس والشبهات وتقليد الأسلاف وأولى الرئاسات، فكِل علمه إلى الله}، فإنّ ذلك نهاية أداء الحقّ الذي لله عليك»([lxviii]).
وقال كذلك في شرحه لفقرة «فَمَنْ وَصَفَ اللهَ فَقَدْ حَدَّهُ، وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ، وَمَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَلَهُ»([lxix]):
«هذا برهان آخر دالّ على أنّه لو كان لله تعالى وصف هو عينه، لأبطل ذلك أزليّته تعالى. والبرهان السابق إنّما يدلّ على عدم أزليّة واحد من الصفة والموصوف وهو الصفة، إذ هي الفرع والتابع. وتقرير هذا البرهان: أنّك قد عرفت مراراً أنّ الصفة هي جهة الإحاطة وعلامة التحديد، لأنّك تقول هاهنا ذات متصفة بهذه الأوصاف فقد حكمت بذات، ثمّ قدرت بعدها صفات عينيّة فقد حدّدته، إذ أثبت بعده صفاته؛ كأنّك قلت: هذه الذات ينتهي إلى هذه الصفات، فهي حدود تلك الذات، بها ينتهي مرتبة هذه الذات؛ فإذا حدّدته فقد عددته وجعلته في عداد المعدودات، حيث حكمت بعينيّة الاثنين واتحادهما، سواء قلت باتحاد المصداق أو الحقيقتين أو كون الذات فرداً حقيقياً لتلك المفهومات المتغايرة، فقد جعلتها معروضة للاثنينيّة التي هو أولى مراتب الأعداد، وإذ قد فرض أنّه تعالى وصفاته شيء واحد، ومع ذلك معروض للاثنينيّة فهو مسبوق بالواحد الحقيقي الذي ليس فيه اثنينيّة أصلاً؛ إذ الواحد الحقيقي متقدّم على كلّ اثنين، سواء كان التركيب اتحاديّاً أو غيره. فثبت أنّ الذات التي هي عين الصفات لأجل كونها معروضة للاثنينيّة، مسبوقة بالواحد الحقيقي، ومن ذلك يبطل أزله؛ فتبصّر فإنّ ذلك من غريب البيان»([lxx]).
وقال كذلك في شرح قوله× «لِشَهَادَةِ العُقُولِ أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ وَمَوْصُوفٍ مَخْلُوقٌ»([lxxi]):
«وأمّا على القول بالعينيّة، فبأنّه مع تسليم اتحاد حيثيّة الذات والصفات، لا شكّ من أنّ اعتبار كون تلك الحيثيّة، حيثيّة الذات متقدّم على اعتبار كونها حيثية الصفات اعتباراً واقعياً نفس أمرى؛ لأنّ الذات متقدّم بالذات على الصفات، ومنع هذا مكابرة صريحة؛ إذ الوصف مفهومه، الشيء المحتاج المتأخّر عن الموصوف لامتناع كونه متقدّماً أو معاً، بديهة. فإذا تحقّقت القبليّة والبعديّة الذاتيتين اتضحت العلّية والمعلوليّة بين الذات والصفة، وإذ قد فرضت العينيّة فالذات باعتبار علّة وباعتبار معلول، وهذا واضح بحمد الله»([lxxii]).
وقال في تتمّة ذلك:
«وبوجه آخر: انّ القائلين بالعينيّة يقولون إنّ الذات كما انّها فرد عرضي للوجود كذلك بنفس حيثيّة أنّها ذات فرد عرضي للعلم والقدرة وغير ذلك، وعندهم أنّ هذه الصفات موجودة بطبائعها في الخلق أيضاً، ومن البيّن أنّ كلّ ما في الخلق فهو معلول؛ فيلزمهم ـ بناء على ما هو الحقّ المبرهن عليه عند أهل المعرفة من جعل الطبائع بالذات والحقيقة ـ أنّ جميع تلك الطبائع العرضيّة مجعولات الحقيقة، فيلزم مجعوليّة الذات والصفات بالبديهة؛ إذ جعل الطبيعة إنّما يكون بجعل الأفراد وإن كان ذلك للأفراد بالعرض. هذا كلّه مع قطع النظر عن استحالة العينيّة وامتناع اتحاد الذات والصفة، وإلّا فذلك أفحش ما يقال؛ إذ الذات هو المحتاج إليه المستغني بذاته، والصفة هي المحتاج المفتقر إلى الموصوف. ومن البيّن امتناع اتحادهما للزوم كون المحتاج، محتاجاً إليه وبالعكس، المستلزم لاحتياج الشيء إلى نفسه»([lxxiii]).
وبخصوص ما روي عن الإمام الصادق× من قوله:
«... أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ: (ﯢ ﯣ)([lxxiv])، (العَظَمَةُ لِلهِ)، وَقَالَ: (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)([lxxv])، وَقَالَ: (ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ)([lxxvi])، فَالأَسْمَاءُ مُضَافَةٌ إِلَيْهِ، وَهُوَ التَّوْحِيدُ الخَالِصُ»([lxxvii]).
قال القاضي سعيد القمّي شارحاً:
«هذا دليل رابع على مغايرة الاسم والمسمّى، تقريره: أنّه اتفقت العصابة على أنّ أسماء الله توقيفيّة يجب أخذها من الله، والله سبحانه لما أخبرنا بأسمائه أضافها إلى نفسه، والإضافة يستلزم المغايرة؛ إذ الشيء لا يضاف إلى نفسه.
بيان الإضافة: أنّه تعالى أضاف الصفة ـ المدلول عليها الاسم ـ إلى نفسه في موضعين، وأضاف الأسماء كذلك؛ أمّا إضافة الصفة فقد قال: (ﯢ ﯣ)و(العظمة لله) فأضاف صفة (ﯢ) و(العظمة) بواسطة اللام إلى نفسه، وهي أشدّ في المغايرة، وأمّا إضافة الأسماء فقال: (ﭳ ﭴ ﭵ)، (ﮔ ﮕ ﮖ) فأضاف الأسماء أيضاً بواسطة اللام إلى نفسه، فهي غيره تعالى، وفي الآية الأخيرة دليل على أنّ كلاً من اسم الله واسم الرحمن هو الجامع لجميع الأسماء، إلّا أنّ (الله) اسم للمرتبة الجامعة، و(الرحمن) لوجودها. ثمّ قال× وصية للسائل: بأن يعتقد المغايرة في الاسم والمسمّى والصفة والموصوف، وهو التوحيد الخالص، أي المنزّه عن شركة الأسماء والصفات معه تعالى، والمقدّس عن أن يكون هي عين الذات أو من عوارضها، بل هي خلقه تعالى، خلقها وسيلة بينه وبين خلقه ليدعوه بها، ويتوصّلوا إلى معرفته من طريقها»([lxxviii]).
وقد ذهب العلّامة الحلّي للاعتقاد برجوع الصفات الثبوتيّة إلى الصفات السلبيّة على فرض نظريّة عينيّة صفات الله سبحانه لذاته، فقال في مبحث (الحياة الإلهيّة):
«والتحقيق أنّ صفاته تعالى إن قلنا بزيادتها على ذاته فالحياة صفة ثبوتيّة زائدة على الذات، وإلّا فالمرجع بها إلى صفة سلبيّة وهو الحقّ»([lxxix]).
المناقشة
أوّلاً: ثمّة محاذير عدّة تلزم فيما لو جعلنا صفات الله خارجة عن ذاته، من بينها أنّ الله سبحانه يكون في هذه الحالة فاقداً للكمالات والصفات الذاتية في أصل وجوده، وينبغي أن يحصل عليها من غيره؛ لأنّ الذات الفاقدة للكمال ستكون فقط منفعلة (مبدأ انفعالي) من أجل الحصول على ذلك الكمال، لا فاعلة (مبدأ فاعلي) إلّا مع تركّب الذات؛ بمعنى أن تكون الذات مبدأ فاعليّاً من حيثيّة، ومبدأ انفعاليّاً من حيثيّة أخرى، وهذا الفرض يتنافى ـ أيضاً ـ مع الأدلّة التي تثبت البساطة والغنى المطلق لله، وتنفي عنه الأجزاء.
وإضافة إلى ذلك، إن لم تكن صفات الله عين ذاته لزم التكثّر في الذات؛ لأنّ كثرة الصفات الكماليّة تعود للاقتضاءات المتعدّدة، وتعدّد الاقتضاءات توجب تعدّد المقتضيات والصفات، وأدلّة التوحيد تنفي أيّ نحو من تعدّد القديم الذاتي، وتثبت ذاتاً واحدة لا نظير لها، وبسيطة من جميع الجهات([lxxx]).
ثانياً: من الممكن استفادة عينيّة الصفات للذات الإلهيّة من بعض الروايات:
فقد روي عن أمير المؤمنين× أنّه قال:
«وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الإِخْلَاصُ لَهُ، وَكَمَالُ الإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ؛ لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ المَوْصُوفِ، وَشَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ؛ فَمَنْ وَصَفَ اللهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ، وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَّاهُ، وَمَنْ ثَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّأَهُ، وَمَنْ جَزَّأَهُ فَقَدْ جَهِلَهُ، وَمَنْ جَهِلَهُ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ، وَمَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَدْ حَدَّهُ، وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ...»([lxxxi]).
وقال آية الله الجوادي الآملي موضحاً هذا الحديث:
«إنّ مؤدّى الكلام أعلاه وبيانه هو أنّ توحيد الله يكون بأعلى درجات الإخلاص حينما ينفي عن الله تعالى الصفات الزائدة على الذات، ويرى العلم والقدرة والحياة عين ذاته؛ لأنّه إذا كانت هناك صفة زائدة يلزم افتراق الذات عنها وفقدانها لها، وهكذا الصفة هي الأخرى ستنفصل عن الذات، وفي النتيجة ستصير كلتاهما محدودتين متناهيتين، ولا يمكن لأيّ موجود محدود ومتناهي أن يكون هو الله تعالى، إذ كلّ محدود ومتناه محتاج إلى الأعلى منه، وبما أنّ صفات الله عين ذاته فهي مثله لامتناهية أيضاً. من هنا كان يختم علي× جميع هذه البراهين بأزليّة الحقّ تعالى وعدم تناهيه ومحدوديّته، ويقول: إنّ الصفة المحدودة والزائدة على الذات تشهد بأنّها غير الموصوف؛ لأنّها زائدة عليه، والموصوف الذي كان فاقداً لهذه الصفة والمتصف بها فيما بعد يشهد بأنّه غيرها، إذن لا يمكن وصف الله تعالى بالصفات الزائدة على ذاته.
وجملة (وَكَمَالُ الإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ) دليل على أنّ المراد من الصفات المنفيّة هي الصفات الزائدة على الذات، لا أصل الاتصاف؛ إذ من يصف الله بالصفات الزائدة قد جعل له قريناً، وقد قرنه بما هو خارج عنه، مع أنّ الله تعالى لا محدود ولا متناهي، واللامحدود لا يترك مكاناً للقرين؛ (و من قرنه فقد ثنّاه).
والنتيجة هي: من قال بزيادة الصفة على ذات الله وأنّه مركّب من الموصوف والصفة وقرن بين الذات والوصف فقد أخرج الله من الوحدة إلى التثنية، وخرج بذلك عن التوحيد؛ إذ يلزم منه وجود موجودات قديمة بعدد الأوصاف الإلهيّة. فإذا كان تصور المسيحيين الباطل في التثليث مستلزم لثلاثة موجودات قديمة، فإنّ لازم هذا القول الاعتقاد بالقدماء السبعة أو الثمانية أو الأكثر من ذلك، بينما الأدلّة القطعيّة على التوحيد تثبت ذاتاً قديمةً واحدة فقط لا غير»([lxxxii]).
عن الحسين بن خالد، قال:
«سَمِعْتُ الرِّضَا عَلِيَّ بْنَ مُوسَى÷ يَقُولُ: لَمْ يَزَلِ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلِيماً قَادِراً حَيّاً قَدِيماً سَمِيعاً بَصِيراً. فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ، إِنَّ قَوْماً يَقُولُونَ: إِنَّهُ} لَمْ يَزَلْ عَالِماً بِعِلْمٍ، وَقَادِراً بِقُدْرَةٍ، وَحَيّاً بِحَيَاةٍ، وَقَدِيماً بِقِدَمٍ، وَسَمِيعاً بِسَمْعٍ، وَبَصِيراً بِبَصَرٍ. فَقَالَ×: مَنْ قَالَ ذَلِكَ وَدَانَ بِهِ فَقَدِ اتَّخَذَ مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخْرى، وَلَيْسَ مِنْ وَلَايَتِنَا عَلَى شَيْءٍ، ثُمَّ قَالَ×: لَمْ يَزَلِ اللهُ} عَلِيماً قَادِراً حَيّاً قَدِيماً سَمِيعاً بَصِيراً لِذَاتِهِ، تَعَالَى عَمَّا يَقُولُ المُشْرِكُونَ وَالمُشَبِّهُونَ عُلُوّاً كَبِيراً»([lxxxiii]).
وعن أبي بصير، قال:
«سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ× يَقُولُ: لَمْ يَزَلِ اللهُ} رَبَّنَا وَالعِلْمُ ذَاتُهُ وَلَا مَعْلُومَ، وَالسَّمْعُ ذَاتُهُ وَلَا مَسْمُوعَ، وَالبَصَرُ ذَاتُهُ وَلَا مُبْصَرَ، وَالقُدْرَةُ ذَاتُهُ وَلَا مَقْدُورَ، فَلَمَّا أَحْدَثَ الأَشْيَاءَ وَكَانَ المَعْلُومُ، وَقَعَ العِلْمُ مِنْهُ عَلَى المَعْلُومِ، وَالسَّمْعُ عَلَى المَسْمُوعِ، وَالبَصَرُ عَلَى المُبْصَرِ، وَالقُدْرَةُ عَلَى المَقْدُورِ. قَالَ: قُلْتُ: فَلَمْ يَزَلِ اللهُ مُتَحَرِّكاً؟ قَالَ: فَقَالَ: تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ، إِنَّ الحَرَكَةَ صِفَةٌ مُحْدَثَةٌ بِالفِعْلِ. قَالَ: قُلْتُ: فَلَمْ يَزَلِ اللهُ مُتَكَلِّماً؟ قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ الكَلَامَ صِفَةٌ مُحْدَثَةٌ لَيْسَتْ بِأَزَلِيَّةٍ، كَانَ اللهُ} وَلَا مُتَكَلِّمَ»([lxxxiv]).
وقال الإمام الخميني في شرحه لهذا الحديث:
«اعلم أنّه قد أشير في هذا الحديث الشريف إلى عينيّة الذات المقدّسة للحقّ مع الصفات الكماليّة الحقيقيّة، مثل العلم والقدرة والسمع والبصر، وهذا من المباحث المهمّة التي يكون الإسهاب فيها خارجاً عن حدود هذا الكتاب، ونحن نشير إلى المذهب الحقّ الموافق للبراهين السديدة للفلاسفة، والمطابق لمنهج أهل المعرفة.
اعلم أنّه قد ثبت في محلّه، أنّ ما هو من سنخ الكمال والجمال والتمام، فهو راجع إلى عين الوجود، وحقيقته، وأنّ الشيء الوحيد الأصيل الشريف في هذا الكون الذي يكون مصدراً لكلّ الكمالات، ومصدراً لكافّة الخيرات، هو حقيقة الوجود، وإذا لم تكن الكمالات عين حقيقة الوجود، وكانت مغايرة في حاق الواقع مع حقيقة الوجود، للزم تحقّق أصلين في عالم الوجود، ولبعث على مفاسد كثيرة، فكل ما يكون كمالاً، لا يكون بحسب المفهوم والماهية كمالاً، وإنّما يكون كمالاً بواسطة تحقّقه وتحصّله في عالم الأعيان، وما هو موجود ومتحقّق في حاقّ الأعيان ونفس الأمر هو أصل واحد، وهو الوجود، فيعود كلّ ما هو كمال إلى أصل واحد وهو حقيقة الوجود.
وقد ثبت ـ أيضاً ـ أنّ حقيقة الوجود، أمر بسيط من جميع الجهات، وبريء من التركيب بصورة مطلقة، ما دام محافظاً وباقياً على ذاته الأصيلة، وحقيقته الخالصة، وإذا تنزّل عن أصالته وحقيقته، لغدا مركّباً عقليّاً أو خارجيّاً حسب مشهده ومنزلته، فهو بسيط ذاتاً، ومركّب نتيجة طرو أمر غريب عرضي خارج عن ذاته. وتستفاد من هذا البيان المذكور، قاعدتان:
القاعدة الأولى: أنّ البسيط من جميع الجهات هو بنفسه جميع الكمالات من حيثيّة واحدة، وجهة فريدة، فمن الحيثيّة التي بها صار البسيط من جميع الجهات موجوداً، يكون عالماً وقادراً وحياً ومريداً، ويصدق عليه جميع الأسماء والصفات الجماليّة والجلاليّة، فهو عالم من حيث أنّه قادر، وقادر من حيث أنّه عالم، من دون أدنى اختلاف اعتباري حتى لدى العقل. وأمّا تغاير مفاهيم الأسماء، والموضوع له في اللغة، والتي تكون مفاهيم عقليّة متصوّرة على نحو لا بشرط ـ من دون تقييدها بالمدلول البسيط أو المركّب ـ فهذا التغاير لا يتسرّب إلى الحقيقة العينيّة، ومن الواضح أنّ المفاهيم المختلفة للكمال، تنتزع من شيء واحد، بل حسب البيان المتقدّم: أنّ بسيط الحقيقة، بسيط من جميع الجهات، وعليه لا بدّ من انتزاع كلّ المفاهيم الكماليّة من حيثيّة واحدة. وإذا انتزعت مفاهيم الكمال من حيثيّات مختلفة ومصادر متعدّدة كما هو شأن بعض الممكنات، لكان هذا التغاير أمراً عرضياً طارئاً وناتجاً من تنزّل حقيقة الوجود، وتشابكه مع العدم بالعرض.
القاعدة الثانية: أنّ الكامل من جميع الجهات، وأنّ ما هو صرف الكمال والخير، لا بدّ وأن يكون بسيطاً من جميع الجهات.
وتستفاد أيضاً بالتبع قاعدتان أُخريتان، هما: أنّ المركب من أيّ نوع كان التركيب، لم يكن بكامل من جميع الجهات، إذ إنّ النقص والعدم قد تسرّبا إليه، وأنّ الناقص لا يكون بسيطاً بشكل مطلق.
إذن لما كان الحقّ المتعالي بسيطاً تاماً، وبعيداً كلّ البعد عما يستلزم الإمكان والفقر والتعلّق بالغير، كان كاملاً من جميع الجهات، ومشتملاً على جميع الأسماء والصفات، وحقيقة أصيلة، ووجوداً صريحاً من دون أن يخامره غير الوجود، ويخالط الكمال غير الكمال، فهو وجود صرف، إذ لو تدخّل غير الوجود فيه لتحقّق شرّ التراكيب، وهو عبارة عن التركيب بين الوجود والعدم. فهو صرف العلم وصرف الحياة وصرف القدرة وصرف البصر والسمع وكافّة الكمالات. وعليه يصحّ كلام الإمام الصادق×: (والعلم ذاته والقدرة والسّمع والبصر ذاته)»([lxxxv]).
وقال أيضاً:
«وملخّص الكلام أنّ التحقيق في أوصاف الحقّ سبحانه في ظلّ الفلسفة النظريّة، يفضي إلى القول بأنّ الأوصاف الحقيقيّة والإضافيّة، على ضوء المفاهيم، متغايرة ومختلفة، ولا تكون إحداها عين الأخرى. وعلى ضوء الحقيقة والواقع، فإنّ جميع الأوصاف تعود جميعاً إلى الذات المقدّس وتكون عينه. ولكن توجد للأوصاف مرتبتان:
إحداهما: مرتبة الذات والأوصاف الذاتيّة، حيث نستطيع أن ننتزع من هذه المرتبة العلم والعالميّة والقدرة والقادريّة.
ثانيهما: مقام الأوصاف الفعليّة، الذي يكون أيضاً من انتزاع مفهوم العلم والعالميّة والقدرة والقادريّة.
وأمّا الأوصاف السلبيّة مثل القدّوس والسبّوح والأسماء التنزيهيّة، فإنّها من لوازم الذات المقدّس، ويكون الذات المقدّس مصداقاً بالعرض لتلك الأوصاف السلبيّة؛ لأنّ الحقّ المتعالي كمال مطلق، ويصدق عليه سبحانه الكمال المطلق بالذات ـ لا بالعرض ـ لأنّه سبحانه أساس الحقيقة وأصلها، ومن لوازمه سلب النقائص، فيكون الكمال مصداقاً عرضياً لسلب النقائص. ويرى أهل المعرفة وأصحاب القلوب أنّ مقام التجلّي بالفيض الأقدس مبدأ للأسماء الذاتيّة، وأنّ مقام التجلّي بالفيض المقدّس، مبدأ للأوصاف الفعليّة، ويعتقدون بأنّ هذا المقام ـ التجلّي بالفيض المقدّس ـ لا يكون (غيراً) ـ غير الذات ـ كما لا يكون (عيناً) ـ عين الذات»([lxxxvi]).
وقال العلّامة المجلسي:
«اعلم أنّ أكثر أخبار هذا الباب تدلّ على نفي زيادة الصفات؛ أي على نفي صفات موجودة زائدة على ذاته تعالى، وأمّا كونها عين ذاته تعالى؛ بمعنى أنّها تصدق عليها، أو أنّها قائمة مقام الصفات الحاصلة في غيره تعالى، أو أنّها أمور اعتباريّة غير موجودة في الخارج واجبة الثبوت لذاته تعالى، فلا نصّ فيها على شيء منها، وإن كان الظاهر من بعضها أحد المعنيين الأولين. ولتحقيق الكلام في ذلك مقام آخر»([lxxxvii]).
وعلّق العلّامة الطباطبائي على كلام العلّامة المجلسي بقوله:
«وهذا من عجيب الكلام، ودلالة الروايات على عينيّة الصفات للذات ممّا لا غبار عليها؛ بمعنى أنّ لله سبحانه مثلاً علماً حقيقة بالأشياء، لا مجازاً، ولا أثر العلم ونتيجته، وهذا العلم بذاته، لا بصفة غير ذاته»([lxxxviii]).
ثالثاً: ما أورده القاضي سعيد القمّي من إشكالات على المعتقدين بعينيّة صفات الله لذاته، ناشئة من استنتاج لا يقولون به؛ إذ لا يعنون من العينيّة في كلامهم اتحاد الذات والصفات مع بعضهما بحيث يصيرا واحداً مركّباً، وبالتالي لا يكون منسجماً مع البساطة المطلقة للذات الإلهيّة. نعم، الاتحاد يطرح فيما لو كان في البين اثنينيّة وازدواجيّة بدورها تنجرّ للوحدة، بينما بحث العينيّة لم يطرح فيه شيء من ذلك.
حول ذلك قال الملّا صدرا:
«واعلم أنّ كثيراً من العقلاء المدقّقين ظنّوا أنّ معنى كون صفاته تعالى عين ذاته هو أنّ معانيها ومفهوماتها ليست متغايرة، بل كلّها ترجع إلى معنى واحد. وهذا ظنّ فاسد ووهم كاسد، وإلّا لكانت ألفاظ العلم والقدرة والإرادة والحياة وغيرها في حقّه ألفاظاً مترادفة، يفهم من كلّ منها ما يفهم من الآخر، فلا فائدة في إطلاق شيء منها بعد إطلاق أحدها، وهذا ظاهر الفساد، ومؤدّ إلى التعطيل والإلحاد. بل الحقّ في معنى كون صفاته عين ذاته أنّ هذه الصفات المتكثّرة الكماليّة كلّها موجودة بوجود الذات الأحديّة، بمعنى أنّه ليس في الوجود ذاته تعالى متميّزاً عن صفته بحيث يكون كلّ منها شخصاً على حدة، ولا صفة منه متميّزة عن صفة أخرى له بالحيثيّة المذكورة، بل هو قادر بنفس ذاته وعالم بعين ذاته، أي يعلم هو نفس ذاته المنكشفة عنده بذاته، ومريد بإرادة هي نفس ذاته، بل نفس علمه المتعلّق بنظام الوجود وسلسلة الأكوان، من حيث أنّها ينبغي أن توجد...»([lxxxix]).
رابعاً: رغم إصرار القاضي سعيد القمّي على إبطال القول بالعينيّة حتى يتمكّن من إثبات نظريّته في الإلهيات السلبيّة، إلّا أنّه قَبِل هذه الحقيقة، أي: عينيّة صفات الله لذاته في بعض المواضع، مثل:
قوله ـ أثناء الإجابة على أحد الإشكالات ـ:
«... إنّ ذاته ذات علامة قادرة، فعلمه ذاته وقدرته ذاته، لا أنّ هاهنا ذاتاً وقدرة هي عينها، بل بمعنى أن لا شيء سوى الذات التي لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء، وهذه الصفات الوجوديّة التي حكمنا بغيريّتها إنّما هي وسائل الخلق إليه تعالى، حيث لا يمكن لها أن يستنير من نور الذات إلّا بتوسّط تلك الصفات»([xc]).
خامساً: إنّ التغاير بين الشيئين اللذين يشكّلان طرفي النسبة يكون في بعض الأحيان مفهوميّاً لا مصداقياً؛ ولهذا قال المعتقدون بعينيّة صفات البارئ لذاته: إنّ صفاته في الخارج عين ذاته، والنسبة بينهما باعتبار التغاير في عالم المفهوم بين الذات والصفات.
سادساً: الاعتقاد بالعينيّة يرفع مشكلة تقدّم الذات على الصفات، ويزيل محدوديّة الذات بسبب الصفات أيضاً.
سابعاً: الصفة الزائدة على الذات هي التي توجب التجزّأ والتكثّر والتناهي في الذات، لا الصفة التي تكون عين الذات؛ لذا لا يصحّ الاستدلال بجملة (فَمَنْ وَصَفَ اللهَ فَقَدْ حَدَّهُ) بإطلاقها على نفي الصفة.
ثامناً: ادعاء الاثنينيّة بين الشيئيّة والوجود ادعاء باطل؛ لأنّ المقصود من الشيئيّة إن كان هو الماهيّة، فهي بناء على القول بأصالة الوجود لا تعدّ شيئاً، فضلاً عن كونها منشأ للأثنينيّة مع الوجود.
تاسعاً: مناقشة آية الله الجوادي الآملي لكلام العلّامة الحلّي، حيث قال:
«إنّه يرى ثبوتيّة الصفات متفرّعة على زيادتها على الذات الإلهيّة. وبالنتيجة إن لم نعتقد بزيادة الصفات على الذات، لابد من عودة الصفات الثبوتيّة إلى السلبيّة، ولما كان الحقّ هو أنّ صفات الله ليست زائدة على ذاته، فصفاته الثبوتيّة ترجع إلى السلبيّة.
ولكن التخلّص من زيادة الأوصاف على الذات لا يتمّ بإنكار الصفات الثبوتيّة أبداً، كما لا ترجع صفات الحقّ الثبوتيّة إلى الصفات السلبيّة كذلك. إنّ ما يسلب عن الله هو النقص والعجز والفقدان، وسلب النقص معناه سلب العدم، وسلب العدم يعني سلب السلب؛ إذن يعود سلب النقص لثبوت الكمال؛ لأنّ الموجود الغني بالذات الذي هو عين الوجود والكمال لا سبيل للفقدان والنقص إليه.
فمن جانب قد أسندت بعض الروايات الصفات الثبوتيّة لله بنحو لا يصحّ إرجاعها إلى الصفات السلبيّة مثل هذه الرواية عن الإمام الصادق×: (وَاللهُ نُورٌ لَا ظَلَامَ فِيهِ، وَحَيٌّ لَا مَوْتَ لَهُ، وَعَالِمٌ لَا جَهْلَ فِيهِ، وَصَمَدٌ لَا مَدْخَلَ فِيهِ)([xci])؛ فإن عادت الصفات الثبوتيّة إلى السلبيّة لزم التكرار في هذه الرواية.
وعلى هذا، لا يصحّ كلام الصدوق ولا العلّامة الحلّي (رحمهما الله). ففي الظاهر أنّهما حاولا الفرار من الوقوع في فخ الأشاعرة فوقعا في وهم الاعتزال؛ لأنّ طائفة المعتزلة رغم نجاتهم من القول بزيادة الصفات على الذات التي ما استطاع الأشاعرة الإفلات منها، لم يتمكّنوا من بلوغ قمّة عينيّة الصفات الثبوتيّة للذات الإلهيّة. حيث قال العلّامة& أيضاً: إنّ صفات الله إمّا زائدة على الذات، أو أنّها ترجع إلى الصفات السلبيّة.
ولكنّ الحقّ أنّ هناك أمراً ثالثاً في البين وهو عينيّة الصفات الثبوتيّة للذات»([xcii]).
عاشراً: ذهب علماء الطائفة الإماميّة بحكمائها ومتكلّميها إلى القول بعينيّة الصفات للذات ونفي زيادتها، على ضوء روايات الأئمّة المعصومين^. بمعنى أنّ صفات الله تعالى رغم أنّها من حيث اللفظ والمفهوم يختلف بعضها عن بعض وعن ذات الحقّ، ولكنّها بلحاظ المصداق والانطباق كلّها عين واحدة([xciii]).
قال الشيخ المفيد:
«إنّ الله} اسمه حي لنفسه لا بحياة، وأنّه قادر لنفسه، وعالم لنفسه، لا بمعنى كما ذهب إليه المشبّهة من أصحاب الصفات، ولا الأحوال المختلفات، كما أبدعه أبو هاشم الجبائي، وفارق به سائر أهل التوحيد، وارتكب أشنع من مقال أهل الصفات. وهذا مذهب الإماميّة كافّة، والمعتزلة إلّا من سمّيناه، وأكثر المرجئة، وجمهور الزيديّة، وجماعة من أصحاب الحديث والمحكمة»([xciv]).
وصرح أبو الصلاح الحلبي ـ بعد ذكره لبعض الصفات الذاتيّة لله مثل القدرة والعلم والحياة ـ قائلاً:
«وهذه الصفات نفسيّة؛ لوجوبها له تعالى، وكون الصفة الواجبة نفسيّة، بدليل استغناء ما وجب من الصفات للموصوف عن مؤثّر، ووقوف الجائز منها على مقتض»([xcv]).
5ـ الملازمة بين الإلهيات الإيجابيّة وإمكانيّة إدراك كنه الذات
يرى القائلون بنـظريّة الإلهيات السلبيّة أنّ التفسير الإيجابي والثبوتي للصفات ملازم للاكتناه الذاتي لله تعالى. ويعتقدون أنّ التفسير السلبي لا يلزم منه المعرفة بالذات ولا بالصفات، إذ يكتفى فيه ببعض الأمور الحاكية عن النقص والفقدان، والتي نقوم بنفيها عن الواجب تعالى دون أن نعرف حقيقة ذاته وصفاته، بينما في التفسير الإيجابي (الثبوتي) فعلاوة على فهم الأشياء المعدومة تفهم الكينونة ونحوها، وهذا معناه إدراك ومعرفة كنه ذات الواجب وهو محال؛ لأنّه يلزم من إدراك الذات الإلهيّة تناهي اللامتناهي، أو لا تناهي المتناهي، وكلاهما باطل، مضافاً إلى نفي الروايات لهذا الأمر.
روى الشيخ الصدوق بسنده:
«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ‘ فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ، صِفْ لِي رَبَّكَ حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَأَطْرَقَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ‘ مَلِيّاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ أَوَّلٌ مَعْلُومٌ، وَلَا آخِرٌ مُتَنَاهٍ، وَلَا قَبْلٌ مُدْرَكٌ، وَلَا بَعْدٌ مَحْدُودٌ، وَلَا أَمَدٌ بِحَتَّى، وَلَا شَخْصٌ فَيَتَجَزَّأَ، وَلَا اخْتِلَافُ صِفَةٍ فَيَتَنَاهَى...»([xcvi]).
قال القاضي سعيد القمّي في شرحه لهذا الحديث:
«لما سأل الرجل أن يعرّف الإمام× إيّاه المبدأ الأوّل تعالى بالصفات وليست له تعالى صفة تنالها العقول فضلاً عن أن تصير واسطة لمعرفة الموصوف بها، فلذلك بدأ بالتحميد، متعقّباً بالتنزيه عن الصفات، والتقديس عن الجهات والحيثيّات، منبّهاً على انّه تعالى مع ما هو من استجماعه جميع الصفات، فلا سبيل للخلق إلى معرفة صفته سوى ما أقروا بها حيث وصف الله نفسه بجميعها.
ثمّ لا سبيل لتلك الصفات ـ الغير المعلومة حقائقها وكنهها للبشر ـ إلى حضرة الذات حتى تكون هي المعرف للذات والدليل عليها، كما أشار إلى ذلك سيد الشهداء×، على ما نقلنا قبل من قوله: (كيف يستدلّ عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟! ألغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟!)»([xcvii]).
وقال ـ أيضاً ـ في شرح هذه الجملة «وَلَمْ تُحِطْ بِهِ الصِّفَاتُ فَيَكُونَ بِإِدْرَاكِهَا إِيَّاهُ بِالحُدُودِ مُتَنَاهِياً»([xcviii]):
«قوله (بالحدود) متعلّق بقوله (متناهياً) كما أنّ قوله (عن صفة المخلوقين) متعلّق (بمتعالياً). وجملة (ليس كمثله شيء) وقع اعتراضاً للمدح بل للتعليل. وإحاطة الصفة، صدقها وحملها سواء كان بالعينيّة أو الزيادة، إذ المحمول لا بد أن يكون أعم بالمفهوم كما تقرّر في علم الميزان. وجملة (ما زال) إلى قوله: (متعالياً) دليل ثان على الجملة الأولى. والدليل الأوّل قوله (فيكون) إلى آخره. أي لم تصدق ولم تحمل عليه تعالى الصفات، إذ لو صدقت عليه يكون ـ عزّ شأنه ـ بسبب إدراك الصفات إيّاه وصدقها عليه متناهياً بالحدود، لأنّ الذات من حيث هي هي متقدّمة على الصفة سواء كانت عينيّة أو زائدة، فينتهي الذات إلى الصفة بأن يكون الصفة بعد الذات، وذلك هو التحديد»([xcix]).
المناقشة
أوّلاً: سنثبت في محلّه أنّ هناك فرقاً بين الإلهيات السلبيّة والتنزيهيّة وأنّ مؤدّى جميع الروايات بعد الجمع الدلالي بينها هو إثبات الصفات الثبوتيّة لله تعالى بعد سلب نواقصها، كما يستفاد من بعضها عدم إمكان فهم وإدراك كنه الذات وحقيقة الصفات الإلهيّة.
وبتعبير آخر: من الوظائف الحتميّة الملقاة على عهدة المحقّقين في عمليّة الفهم والاستنتاج من الروايات ذات المضامين المختلفة هو الجمع بينها، ولهذا إذا دلّت رواية على نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وكان في المقابل روايات تنسب إليه بعض الصفات أو تنفي إدراك الناس كنه صفاته يلجأ إلى الجمع بين هاتين المجموعتين من الروايات والخروج بنتيجة مفادها أنّ المقصود من روايات المجموعة الأولى ليس نفي الصفات بصورة مطلقة، ولهذا ذهب الشرّاح إلى أنّ المراد منها نفي الصفات الزائدة عن الذات.
ثانياً: إنّه لم يلتفت إلى أنّ معنى هذا الكلام أن لا أحد لديه القدرة على اكتناه صفات الله، لا أنّ معنى الصفات ومفهومها غير معلوم لأحد، ولابد من إرجاعها للمعنى السلبي. وفي الواقع حصل خلط بين المفهوم والمصداق هنا، فعدم قابليّة اكتناه المصداق والحقيقة الخارجيّة، لا يعني عدم إمكان أن يكون له مفهوم، وهذان الأمران ليسا متلازمين.
فما كان ليس قابلاً للاكتناه هو حقيقة الوجود وحقيقة العلم وحقيقة القدرة وهكذا، فلكونه لا متناهياً لا يستطيع المتناهي الإحاطة به، وإلّا إذا أحاط بجميع اللامتناهي أصبح المتناهي لا متناهياً واللامتناهي متناهياً، وإن أحاط علماً ببعض اللامتناهي لزم منه التركيب في اللامتناهي، ورجع كلّ تركيب إلى التركب من الوجود والعدم، ومن ثمّ التناهي والمحدوديّة، أمّا ما هو قابل للإدراك والفهم من اللامتناهي هو مفهومه، ولا يلزم من إدراك المفهوم وتفسيره الوجودي اكتناهاً وجوديّاً، فما نقوله لأنّ حقيقة العلم والقدرة الإلهيين و... ليست قابلة للاكتناه، ولهذا نقول بالتفسير السلبي، هو عين الخلط بين المفهوم والمصداق، أمّا هل التفسير السلبي للصفات يستتبع عدم الاكتناه؟!
فإن كان من المقرّر أن يكون الفهم الوجودي والإيجابي للصفات ملازماً للإكتناه، لماذا الفهم السلبي للصفات لا يستتبع الاكتناه بالضرورة؟ فإن فهم أحد من (ليس مركبا) بأنّ الذات المقدّسة خالية من أيّ نحو من أنحاء التركيب، وأخبر عن ذلك، فهو في هذه الصورة عن أيّ شيء يتحدّث، من المقطوع به أنّه يتحدّث عن الذات، ولأنّه يتحدّث عن الذات لابد أن يحصل لديه اكتناه بها حتى يتحدّث عنها، وإلّا فماذا يعرف عن الذات حتى يسلب شيئاً ما عنها؟ إذن حتى التفسير السلبي يجب أن يلازمه اكتناه للذات الإلهيّة. هنا ندرك أنّ إدراك مفهوم أو بعبارة أخرى امتلاك مفهوم عن شيء في الذهن هو أمر غير الفهم الاكتناهي للذات (إدراك كنه الذات).
وعلى هذا، إن كان لدينا تصوّر مفهومي في موضع ما، علينا أن نذكر وبلا فاصلة إلى جانب ذلك المعنى الثبوتي (الإيجابي) معنى سلبيّاً؛ حتى لا نظنّ أنّ الحقيقة الخارجيّة متحقّقة في الخارج بنفس تلك الصورة التي في أذهاننا. وسنشير في المقدّمة التالية (الإلهيات التنزيهيّة)([c]) إلى هذا النوع من الروايات.
ثالثاً: لقد ادّعى أنّ المحمول يجب أن يكون أعمّ من الموضوع، بينما المصرّح به في كتب المنطق المعتبرة: أنّ المحمول بإمكانه أن يكون مساوياً للموضوع أو أخصّ منه، بيد أنّه لو كان أخصّ منه وجب أن يكون سور القضيّة جزئيّاً.
رابعاً: لا يخرج الموصوف بصفات وعناوين عن واحدة من ثلاث حالات:
1ـ أن يكون الموصوف أمراً معقولاً ومعلوماً، وفي هذه الصورة لا شكّ في معقوليّة الصفات وفهمها وإدراكها.
2ـ أن يكون الموصوف أمراً مجهولاً، وفي هذه الصورة، لا إشكال في جواز وصفه أيضاً؛ لأنّ الوصف في هذه الصورة بحكم التعريف بأمر مجهول ومحدود، بأمر محدود وأجلى من الموصوف والمعرّف.
3ـ أن يكون الموصوف بنحو يستحيل على الإنسان إدراك كنه ذاته وصفاته، مثل الله تعالى؛ لأنّ شدّة قدسه وعدم تناهيه في نفسه وفي جميع شؤونه وكمالاته، مانع من تعلّق العلم المحدود للإنسان به، وهذا الأمر لا ينبع من ظلمة أو مجهوليّة حقيقة الله تعالى في ذاته، وإنّما لعجز عقول البشر المحدودة عن إدراك حقيقة ذاته وصفاته.
قال آية الله الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي بهذا الشأن:
«وأمّا إذا كان الموصوف مما يستحيل العلم به ودركه ونيله بالعلم الحضوري أو الحصولي، لشدّة قدسه وكونه نوري الذات وظاهر الذات في شدّة غير متناهية، أو لعدم تناهي الموصوف من حيث نفسه وجميع شؤونه وكمالاته، فيستحيل بالضرورة العلم به حضوراً أو حصولاً، لامتناعه وتأبّيه عن المعلوميّة. وهذا القدس والامتناع من أجل نعوته تعالى وكمالاته، وكلّ نعوته جليلة. فليس امتناع العلم به من حيث كونه منغمراً في المجهوليّة والمظلميّة، بل العقول الثاقبة والألباب الراسخة هالكة ومضمحلّة في قبال الحقّ المبين الذي ملأ الدهر قدسه ويغشي الأبد نوره. فمن رام التفكّر في ساحته، رجع عقله تائهاً ولبّه حيراناً، فلا يمكن أن ينال من قدسه ومجده شيئاً قليلاً ولا كثيراً بالعلم الحضوري أو الحصولي. ودركه بالمفاهيم العامّة ونيله بالعناوين الكلّية الذي سمّوه معرفة وتصوّراً بالوجه، عين التوصيف المنهي عنه ومن أظهر مصاديقه. إذ هو متوقّف على القول بأنّ الألفاظ موضوعة في مقابل المفاهيم المعقولة، ومتوقّف أيضاً على ثبوت الاشتراك المعنوي، وانطباق المفهوم عليه تعالى وعلى غيره في إطلاق واحد، وكلا الدعويين أمران وهميان وخلاف ما هو التحقيق، لقيام ضرورة مذهب أهل البيت^ بالبينونة الصفتيّة بين الخالق والمخلوق، وامتناع انطباق المفهوم المحدود على حقيقة غير متناهية من حيث النوريّة والظاهريّة»([ci]).
ولكن هذا ليس بمعنى رجوع صفات الله الكماليّة إلى الصفات السلبيّة، ولهذا يقول في تتمّة كلامه:
«وضروري عند أولي الألباب أنّ تقديسه تعالى عن التوصيفات والتعريفات لا يلازم نفي صفاته ونعوته التي هي كمال حقيقي لابد من إثباته في حقّه تعالى، سواء كانت من نعوته الذاتيّة مثل العلم والقدرة والحياة، أو ما يدلّ على جلاله وكبريائه، أو أفعاله الحكيمة وسننه القيّمة الفاضلة، مثل الربوبيّة والرحمانيّة والرحيميّة وغيرها. فإنّ الصفة المنفيّة هي المعنى المصدري، يقال: وصف، يصف، صفة، مثل وعد، يعد، عدة. وجمعها صفات مثل عدات. وأمّا صفاته تعالى، فهي أمور عينيّة واقعيّة، فالكلام في توصيف تلك النعوت والصفات عين الكلام في توصيف الذات أيضاً.
وبهذا البيان يتبيّن الفرق بين لفظ الصفات الواقعة تحت المنع وتنزيهه تعالى عنها، وبين الصفات التي صرّح بثبوتها وإثباتها الكتاب والسنّة»([cii]).
وقال أيضاً في موضع آخر:
«قد تبيّن مما ذكرنا أنّه لا محصّل لقول من يقول: إنّ المراد من التمجيد، مثل العالم والقادر ونظائرهما، تأويلها بغير الجاهل وغير العاجز وأمثالها، ضرورة أنّ غير الجاهل وغير العاجز ليسا مرادفين للعالم والقادر، فينهدم أساس التمجيدات والتقديسات من أصلها، ولابد من حفظها، فإنّها من قطعيّات الكتاب والسنّة»([ciii]).
6ـ استلزام الفاعليّة والقابليّة والتكثّر في ذات الله
قال القاضي سعيد القمّي بشأن هذا الأصل:
«قد بيّنا أنّ تلك المفهومات التي عندنا أمور وجوديّة، وأنّها لا سبيل لها إلى حضرة الأحديّة تعالى شأنه، فالذي عند الله جلّ جلاله منها، لو كانت على المعنى الذي يليق بعزّ جلاله أموراً وجوديّة، ولا ريب أنّها صفات وأنّ الصفة ما يكون معه الشيء بحال، وكلّ ما يكون معه الشيء بحال لا محالة يكون غير ذلك الشيء بالضرورة، وكلّ ما يكون غير المبدأ الأوّل وكان أمراً ثبوتياً فهو معلول البتة، فيكون تلك المحمولات مخلوقات له تعالى، والله سبحانه لا يوصف بخلقه ولا يستكمل به؛ لأنّه يلزم كونه تعالى فاعلاً وقابلاً، وأيضاً يلزم تعدّد الجهات فيه سبحانه لصدورها عنه تعالى؛ وأيضاً يلزم أن يكون صدورها عنه ـ عزّ وعلا ـ غير مسبوق بما يتوقّف عليه الإيجاد من العلم والقدرة وغيرهما، وأيضاً يلزم من كون صدورها أوّلاً تقدّم العرض على الجوهر، وكون العرض مبدأ صدور الجواهر، وأيضاً يلزم أن يكون وجودها بعد مرتبة الذات، فلا يكون في مرتبة الذات متصفاً بها، وأيضاً إن كانت واجبة لزم التعدّد وإن كانت ممكنة يلزم إمكان زوالها عن الذات لإمكانها في ذاتها، إلى غير ذلك من الاستحالات التي لا تحصى»([civ]).
وقال أيضاً:
«لو كانت الصفات هناك أموراً ثبوتيّة ومفهومات وجوديّة فإمّا أن يشترك معانيها مع ما يوجد في الخلق أو لا يشترك، فإن كان الأوّل لزم المحال المذكور في المقام الأوّل، وإن كان الثاني فإمّا أن يكون المفهوم منها هو المفهوم من الذات، وذلك باطل لما عرفت أنّ الصفة ما يكون معه الشيء بحال غير ما لذاته، والخصم يساعدنا على ذلك، وإن كان المفهوم منها غير المفهوم من الذات ـ والمفروض أنّها أمور ثبوتيّة ـ يلزم أن يكون عوارض للذات ومعلولات لها، إن كانت أموراً حقيقية كما هو رأي الحقّ من بطلان الاعتباريّات، وإن كانت أموراً اعتباريّة كما زعمه الخصم لزم تكثّر حيثيّات في الذات، لأنّ حيثيّة كونه كذا غير حيثيّة كونه ذلك، وقد ثبت لك بالبراهين القاطعة من العقل والنقل أنّه لا تكثّر في المرتبة الأحديّة، لا في المعاني الحقيقيّة، ولا في الجهات والحيثيّات الاعتباريّة»([cv]).
المناقشة
أوّلاً: جعل هذا الاستنتاج غير الصحيح لمعنى الوصف، الملازم للزيادة والمغايرة للموصوف أساساً وأصلاً يقوم عليه هذا الاستدلال.
ولو لاحظنا اللغة لما وجدنا أنّ معنى «الصفة» يتضمّن المغايرة للموصوف.
فهذا ابن منظور يقول بخصوص معنى الوصف والصفة:
«وصف الشيء له وعليه وصفاً وصفة: حلاه، والهاء عوض من الواو، وقيل: الوصف المصدر والصفة الحلية»([cvi]).
والفراهيدي يقول:
«الوصف: وصفك الشيء بحليته ونعته»([cvii]).
وبيّن العلّامة الطباطبائي المعنى للصفة هكذا:
«الصفة تدلّ على معنى من المعاني يتلبّس به الذات، أعمّ من العينيّة والغيريّة»([cviii]).
وبناء على هذا نستنتج: عدم تضمّن المعنى اللغوي لـ(الوصف والصفة) الغيريّة والزيادة على الموصوف. طبعاً من الممكن في مقام الاستعمال أن يؤتى بالوصف وفيه زيادة على الموصوف؛ كما استعمله بعض المتكلّمين في هذه الموارد، ولكن يجب الالتفات إلى أنّ مقام الوضع غير مقام الإطلاق والاستعمال.
قال الملّا عبدالله الزنوزي:
«علماً بأنّ الصفة تطلق على ما يقابل الذات، والذات هي ما يكون قائماً بنفسه، يعني وجوده في نفسه لا يكون عين وجوده في غيره. والصفة هي ما كان وجوده في نفسه عين وجوده في غيره سواء كان وجوده في نفسه خارجيّاً أم عقليّاً؛ ففي الصورة الأولى يكون القيام قياماً خارجيّاً وفي الصورة الثانية يكون عقليّاً.
إنّ المشهور في معنى الصفة لدى الجمهور هو ما ذكر، والظاهر من هذا التعريف ومن كلماتهم أنّه لا محالة يجب أن يكون وجود الصفة مغايراٍ لوجود الموصوف في الخارج أو في العقل، ويطلق على ذلك الوجود، الوجود الرابط والوجود لغيره، ولكن مقتضى البحث والفحص والبرهان أنّ القيام بالمعنى المذكور غير معتبر في معنى الصفة؛ لأنّ عوارض الوجود هي صفات الوجود وعناوينه، وفي وسط تلك العوارض والحقائق الوجوديّة، لا يتصور القيام في أيّ نشأة من النشآت حتى عند العقل؛ لأنّ القيام العقلي فرع تحصّل كلّ من العارض والمعروض في العقل كلّ على حده.
وأشرت سابقاً وبعد ذلك سيتحقّق أنّ عوارض الوجود بما أنّها وجود، فهي عين الوجود بحسب الذات والهويّة وغيره بلحاظ العنوان والمفهوم، إذن عوارض الوجود عين الحقائق الوجوديّة في الأذهان والأعيان، ولكنّها في الأعيان عين الوجودات العينيّة وفي الأذهان عين الوجودات الذهنيّة، ولا مغايرة بين الوجود وبينها إلّا بمجرّد تعمل العقل وتعريه من الذهن، بمعنى أنّ العقل يحكم بسنخين من الشيئيّة؛ إحداهما: الشيئيّة المفهوميّة وهي جهة الإبهام والقوّة، والأخرى الشيئيّة الوجوديّة، وهي جهة التحصّل والفعليّة، والشواهد والنصوص الأخرى ـ أيضاً ـ قائمة على هذه الدعوى (فتفطّن) إذن الصفة عند البحث والبرهان عبارة عن معنى نعتي، موجوديّته ليست لنفسه سواء كانت موجوديّته غير موجوديّة الموصوف أو لم تكن كذلك.
وبعبارة أخرى: صفة الشيء عبارة عن معنى وصفي ينتزع من ذلك الشيء بالذات أو بالعرض، ويكون عنواناً له وحاكياً عنه. وبعبارة أخرى: أنّ الصفة عبارة عن معنى وصفي يكون ثبوته في نفسه عين ثبوته لموصوفه سواء كان ذلك الثبوت في نفسه عين ثبوت الموصوف أو كان غيره.
وتعريف الصفة بهذه العبارات المختلفة في كتب الفن الإلهي والكلام لم تصل إلى نظري القاصر، ولكن مقتضى كلمات المحقّقين من الحكماء والمتكلّمين هو ما قد ذكرته»([cix]).
ثانياً: ردّ الإمام الخميني استدلالي القاضي سعيد القمّي الأوّل والثاني بقوله:
«إنّ المصابيح السالفة رفعت الظلام عن وجه قلبك، وعلّمتك ما لم تكن تعلم من كيفيّة عينيّة الذات والصفات والأسماء. وعلمت أنّ الصفات لم تكن من قبيل الحالات والعوارض الزائدة عليها؛ بل هي عبارة عن تجلّيها بفيضها الأقدس في الحضرة (الواحديّة) وظهورها في الكسوة الأسمائيّة والصفاتيّة؛ وحقيقة الأسماء بباطن ذاتها هي الحقيقة المطلقة الغيبيّة. فبالمراجعة إليها يعرف ما في كلام هذا العارف الجليل، رضوان الله عليه، من أنّ برهانه يرجع إلى المناقشة اللفظيّة والمباحثة اللغويّة الّتي هي من وظيفة علماء اللغة والاشتقاق؛ وليس للعارف الكامل شأن معها، ولا من جبلّته أن يحوم حولها؛ فإنّها الحجاب عن معرفة الله والقاطع طريق السلوك إليه، مع أنّ هذا العارف السالك كرّ على ما فرّ منه.
فلقائل أن يقول: أيّها الشيخ العارف ـ جعلك الله في أعلى درجات النعيم ـ أنت الّذي فررت من الاشتراك المعنوي بين الحقّ والخلق، وجعلت التنزيه ملاذ التشبيه، ما الّذي دعاك إلى الذهاب إلى أنّ الصفة ما معه الشيء بحال في أيّ موطن من المواطن حصل، وفي أيّ موجود من الموجودات وجد، بمجرّد أنّ الصفة في الخلق، لا مطلقاً؛ بل في عالم المادّة والهيولى كذلك؟. هل هذا إلّا التشبيه الّذي وردت الأخبار الصحيحة من أهل بيت العصمة والطهارة ـ صلوات الله عليهم ـ بل الكتاب العزيز، على نفيه؟ وفررت منه حتى وقعت من نفي الصفات الّتي قال الله تعالى في حقّها: (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)([cx]). وقال تعالى شأنه: (ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ)([cxi]). وهل زعمت أنّ من قال من الحكماء العظام والأولياء الكرام ـ رضوان الله عليهم ـ بعينيّة الصفات للذات المقدّسة أنّها بما ذكرت عينها؟ وهل المراد إلّا أنّ الوجود الحقيقي بأحديّة جمعه يصلح فيه المتغايرات ويجمع فيه الكثرات بالهويّة الوحدانيّة الجمعيّة المنزّهة عن شائبة الكثرة؟ فنطق لسان الحكماء المتألّهين لإفادة ذلك الأمر العظيم الّذي كان العلم به من أجلّ المعارف الإلهيّة بأنّ بسيط الحقيقة كلّ الأشياء بالوحدة الجمعيّة الإلهيّة. وقالت العرفاء الكاملون إنّ الذات الأحديّة تجلّى بالفيض الأقدس، أي الخليفة الكبرى، في الحضرة الواحديّة، وظهر في كسوة الصفات والأسماء؛ وليس بين الظاهر والمظهر اختلاف إلّا بالاعتبار»([cxii]).
ثالثاً: من أدلّة القاضي سعيد القمّي على نفي الصفات الإلهيّة هو أنّه لم يعثر على طريق صحيح لانتزاع مفاهيم كثيرة من الذات البسيطة؛ لذا جعل انتزاع المفاهيم المتعدّدة أساساً وعلّة لنفوذ التركيب إلى الذات الإلهيّة، وبالنتيجة نفي الصفات عن الله تعالى، بينما منشأ إشكاله في انتزاع المفهوم بواسطة معنى مناسب في الذات؛ لذا كلّ مفهوم غير المفهوم الآخر يجب أن ينتزع لمناسبة في المعنى تختلف عن المناسبة في المعنى التي انتزع منها المفهوم الآخر، بناء عليه يكون انتزاع المفاهيم المتعدّدة مستلزم لتركيب محلّ الانتزاع من حيثيّات مختلفة، وبما أنّ ذات الله تعالى بسيطة فلا يمكن انتزاع أوصاف متعدّدة منها.
نقول في الإجابة على إشكال القاضي سعيد: إذا كانت الأوصاف المتعدّدة في مقام الألوهيّة لا تصير سبباً للكثرة، فكيف أصبحت نفس تلك الأوصاف سبباً لها في مقام الأحديّة؟ بينما رابطة الوصف والموصوف أشدّ وأقوى من رابطة الأوصاف المتعدّدة مع بعضها البعض.
رابعاً: إنّنا حتى إذا اعتقدنا أنّ معنى (الموجود) هو ذات ثبت لها الوجود، لا يلزم منه إثبات وجود للذات مغاير لها، بل يمكن أن تكون الذات نفسها ثابتة للذات، ويكون مفاد (الله موجود) هو تحقّق الله تعالى في الواقع وموجوديّته بمعنى وجوده في الخارج. ومن الواضح أنّ كلّ شيء ثابت لنفسه محقّق لها.
وعلى مستوى الحمل ـ أيضاً ـ لعلّ التغاير يكون مفهوميّاً صرفاً لا مصداقيّاً؛ لذا في جملة «الله تعالى موجود» رغم أنّه بلحاظ المصداق ليس الله سبحانه شيئاً غير الوجود، ويمكن أن يكون المصحّح للحمل هو التغاير المفهومي بين الموضوع والمحمول.
|
|
المقدّمة
السابعة: الإلهيات التنزيهيّة
|
|
رغم إنكار جماعة للمعرفة بالله تعالى عن طريق صفاته، ذهب آخرون إلى الاعتقاد بمعرفة الله عن طريق صفاته، واختاروا نظريّة الاشتراك المعنوي في ذلك، وقالوا بأنّ صفاته تعالى منزهة ومبرأة عن أيّ عيب ونقص، وهذه هي الإلهيات التنزيهيّة التي تستفاد من ظاهر الروايات جمعاً بين روايات السلب المطلق والتنزيه من النواقص. والآن نذكر بعض الآيات والروايات وعبارات العلماء التي أشارت إلى جنبة سلب النقص في صفات المخلوق عن الخالق:
1ـ القرآن وتنزيه البارئ تعالى
يستفاد من آيات كثيرة أنّ الله تعالى نزّه نفسه عمّا وصفه به بعض الأفراد، ولكن هذه الآيات لم تشتمل على العموم، إذ اختصّت بفئة من الناس مثل المشركين، ولهذا لا يمكن استنتاج الإلهيات السلبيّة منها بصورة عامّة.
حيث يقول تعالى:
(ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)([cxiii]).
و أيضاً:
(ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ)([cxiv]).
وكذلك:
(ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)([cxv]).
ويقول أيضاً:
(ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﯕﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)([cxvi]).
هذه الآيات تدلّ على تنزيه الله تعالى عمّا يصفه به المشركون بحسب الموارد الخاصّة، يعني تنزيهه عن أوصاف ما سوى الله من الأفراد المخلوقين والمحدودين، مثل: اتخاذ البنين والبنات والشريك والمثل، ونحو ذلك.
2ـ الروايات وتنزيه البارئ تعالى
لقد جاء في الكثير من الروايات الحديث عن تنزيه البارئ تعالى عن الوصف، بمعنى نفي إمكان الوصول إلى كنه ذاته تعالى، بيد أنّه لا يمكن من خلالها إثبات الإلهيات السلبيّة وإرجاع الصفات الثبوتيّة إلى السلبيّة، مثل ما ورد عن أمير المؤمنين علي×، حيث قال:
«الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي انْحَسَرَتِ الأَوْصَافُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ، وَرَدَعَتْ عَظَمَتُهُ العُقُولَ، فَلَمْ تَجِدْ مَسَاغاً إِلَى بُلُوغِ غَايَةِ مَلَكُوتِهِ! هُوَ اللهُ الحَقُّ المُبِينُ، أَحَقُّ وَأَبْيَنُ مِمَّا تَرَى العُيُونُ، لَمْ تَبْلُغْهُ العُقُولُ بِتَحْدِيدٍ فَيَكُونَ مُشَبَّهاً، وَلَمْ تَقَعْ عَلَيْهِ الأَوْهَامُ بِتَقْدِيرٍ فَيَكُونَ مُمَثَّلًا»([cxvii]).
كما أنّ بعض الروايات كانت بصدد إثبات صفات ثبوتيّة كماليّة لله تعالى عن طريق تنزيهه عن النقص الموجود في صفات المخلوقين، وإليك من هذه الروايات:
روي عن الإمام الصادق×، أنّه قال:
«وَاللهُ نُورٌ لَا ظَلَامَ فِيهِ، وَحَيٌّ لَا مَوْتَ لَهُ، وَعَالِمٌ لَا جَهْلَ فِيهِ، وَصَمَدٌ لَا مَدْخَلَ فِيهِ»([cxviii]).
بناءً على رجوع الصفات الثبوتيّة إلى الصفات السلبيّة فإنّ كلام الإمام× سيستلزم التكرار. ويبدو أنّ الإتيان بالسلب في هذه الرواية بصيغة النكرة في سياق النفي من أجل نفي أيّ نوع من النواقص المسلوبة عن الله تعالى.
روي عن الإمام علي× أنّه قال:
«الأَوَّلُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْلٌ فَيَكُونَ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وَالآخِرُ الَّذِي [لَمْ يَكُنْ] لَيْسَ لهُ بَعْدٌ فَيَكُونَ شَيْءٌ بَعْدَهُ»([cxix]).
و كما روي عنه ـ أيضاً ـ قوله في الله تعالى:
«بَصِيرٌ لَا يُوصَفُ بِالحَاسَّةِ»([cxx]).
وقال الإمام علي× ـ أيضاً ـ في إحدى خطبه:
«كَانَ إِلَهاً حَيّاً بِلَا حَيَاةٍ»([cxxi]).
نقل أبو بصير قول الإمام الصادق×:
«لَمْ يَزَلِ اللهُ} رَبَّنَا، وَالعِلْمُ ذَاتُهُ وَلَا مَعْلُومَ، وَالسَّمْعُ ذَاتُهُ وَلَا مَسْمُوعَ، وَالبَصَرُ ذَاتُهُ وَلَا مُبْصَرَ، وَالقُدْرَةُ ذَاتُهُ وَلَا مَقْدُورَ»([cxxii]).
وفي خطاب الإمام الصادق× لزنديق قد سأله: فتقول: «إنّه سميع بصير؟» قال:
«هُوَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، سَمِيعٌ بِغَيْرِ جَارِحَةٍ، وَبَصِيرٌ بِغَيْرِ آلَةٍ، بَلْ يَسْمَعُ بِنَفْسِهِ وَيُبْصِرُ بِنَفْسِهِ، وَلَيْسَ قَوْلِي: إِنَّهُ سَمِيعٌ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ شَيْءٌ وَالنَّفْسُ شَيْءٌ آخَرُ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ عِبَارَةً عَنْ نَفْسِي إِذْ كُنْتُ مَسْئُولًا، وَإِفْهَاماً لَكَ إِذْ كُنْتَ سَائِلًا. فَأَقُولُ: يَسْمَعُ بِكُلِّهِ لَا أَنَّ كُلَّهُ لَهُ بَعْضٌ؛ لِأَنَّ الكُلَّ لَنَا لَهُ بَعْضٌ، وَلَكِنْ أَرَدْتُ إِفْهَامَكَ، وَالتَّعْبِيرُ عَنْ نَفْسِي وَلَيْسَ مَرْجِعِي فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا أَنَّهُ السَّمِيعُ البَصِيرُ العَالِمُ الخَبِيرُ، بِلَا اخْتِلَافِ الذَّاتِ وَلَا اخْتِلَافِ مَعْنًى»([cxxiii]).
روي عن الإمام الكاظم×، أنّه قال:
«إِنَّهُ الحَيُّ الَّذِي لا يَمُوتُ، وَالقَادِرُ الَّذِي لَا يَعْجِزُ، وَالقَاهِرُ الَّذِي لَا يُغْلَبُ، وَالحَلِيمُ الَّذِي لَا يَعْجَلُ، وَالدَّائِمُ الَّذِي لَا يَبِيدُ، وَالبَاقِي الَّذِي لَا يَفْنَى، وَالثَّابِتُ الَّذِي لَا يَزُولُ، وَالغَنِيُّ الَّذِي لَا يَفْتَقِرُ»([cxxiv]).
روي عن الإمام الرضا×، أنّه قال:
«قُلْنَا: إِنَّهُ بَصِيرٌ لَا بِبَصَرٍ؛ لِأَنَّهُ يَرَى أَثَرَ الذَّرَّةِ السَّحْمَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ عَلَى الصَّخْرَةِ السَّوْدَاءِ، وَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلِ فِي اللَّيْلَةِ الدَّجِيَّةِ، وَيَرَى مَضَارَّهَا وَمَنَافِعَهَا وَأَثَرَ سِفَادِهَا وَفَرَاخِهَا وَنَسْلِهَا، فَقُلْنَا عِنْدَ ذَلِكَ: إِنَّهُ بَصِيرٌ لَا كَبَصَرِ خَلْقِهِ»([cxxv]).
3ـ التصريح بالإلهيات التنزيهية
بهذا الصدد قال العلّامة الطباطبائي:
«وأمّا صفات الكمال التي نثبتها له سبحانه كالحياة والقدرة والعلم ونحو ذلك، فقد عرفت أنّا نثبتها بالإذعان بملكه جميع الكمالات المثبتة في دار الوجود، غير أنّا ننفي عنه تعالى جهات الحاجة والنقص التي تلازم هذه الصفات بحسب وجودها في مصاديقها.
فالعلم في الإنسان مثلاً إحاطة حضوريّة بالمعلوم من طريق انتزاع الصورة وأخذها بقوى بدنيّة من الخارج، والذي يليق بساحته أصل معنى الإحاطة الحضوريّة، وأمّا كونه من طريق أخذ الصورة المحوج إلى وجود المعلوم في الخارج قبلاً، وإلى آلات بدنيّة ماديّة مثلاً، فهو من النقص الذي يجب تنزيهه تعالى منه، وبالجملة نثبت له أصل المعنى الثبوتي ونسلب عنه خصوصيّة المصداق المؤدّية إلى النقص والحاجة»([cxxvi]).
وقال في موضع آخر:
«إنّ المعاني التي قد استعملت فيها هذه الأسماء الشريفة في القرآن الكريم وبقيّة الاستعمالات تتبعها لا محالة، لا شكّ في أنّها تطابق المصاديق التي لها في نفس الأمر، ولا شكّ أنّ للحق سبحانه كمالات وصفات موجودة حقيقيّة، كشف عنها أو عن بعضها بهذه البيانات القرآنيّة التي تشتمل على هذه الأسماء بطريق الأفراد تارة، وعن أعيان هذه المعاني بجمل وتركيبات كلاميّة تارة أخرى، كلّ ذلك في مقام الثناء والحمد وإبداء الكمال، فحمل ذلك كلّه على نفي النواقص على أنّه يوجب رجوع كلّ كمال ذاتي إلى عدم وخلو الذات عن كمال موجود مع تراكم البراهين عليه أوّلاً، وعلى أنّه مع الغضّ عن الكمال الوجودي لا يوجب كمالاً ومزيّة، كما أنّ المعدوم المطلق ـ أيضاً ـ كذلك، ثانياً بعيد عن الإنصاف واعتاف يكذبه الوجدان هذا فالأسماء جلّها تشتمل على معان ثبوتيّة غير سلبيّة.
ثمّ أنّ هذه المعاني ليست من غير جنس المعاني التي نفهمها ونعقلها كما ذكره بعضهم والتزم أنّ هذه الأسماء كلّها إمّا مجازات مفردة، وإمّا استعارات تمثيليّة بيانيّة؛ إذ الذي نفهمه من قولنا علم زيد وقولنا علم الله، معنى واحد، وهو انكشاف ما للمعلوم عند العالم، غير أنّا نعلم أنّ علم زيد إنّما هو بالصورة الذهنيّة التي عنده، وأنّ الله سبحانه يستحيل في حقّه ذلك؛ إذ لا ذهن هناك، وهذا ليس إلّا خصوصيّة في المصداق، وهي لا توجب تغيّراً في ناحية المعنى بالضرورة، فإذن المفهوم مفهوم واحد، وأمّا خصوصيّات المصاديق فغير دخيلة في المفهوم البتة، وهذا هو الحقّ الذي عليه أهل الحقّ.
فإذن الميزان الكلّي في تفسير أسمائه سبحانه وصفاته تخلية مفاهيمها عن الخصوصيّات المصداقيّة، وبعبارة أخرى عن الجهات العدميّة والنقص.
وهذا هو الذي يظهر من تفاسير الأئمّة^ في خطبهم وبياناتهم، فعن التوحيد ونهج البلاغة في خطبة له×: أنّ ربّي لطيف اللطافة فلا يوصف باللطف، عظيم العظمة لا يوصف بالعظم، كبير الكبرياء لا يوصف بالكبر، جليل الجلالة لا يوصف بالغلظ، قبل كلّ شيء لا يقال شيء قبله، وبعد كلّ شيء لا يقال له بعد، شاء الأشياء لا بهمّة، درّاك لا بخديعة، هو في الأشياء كلّها، غير متمازج بها ولا باين عنها، ظاهر لا بتأويل المباشرة، متجلّ لا باستهلال رؤية، باين لا بمسافة، قريب لا بمداناة، لطيف لا بتجسّم، موجود لا بعد عدم، فاعل لا باضطرار، مقدّر لا بحركة، مريد لا بهمامة، سميع لا بآلة، بصير لا بأداة. الخطبة، وبياناتهم^ مشحونة بهذا النوع من التفسير، وفي كثير من الأخبار النهي عن التعطيل والتشبيه»([cxxvii]).
4ـ الإلهيات التنزيهيّة في كلام الإمام الحسين×
من الممكن جدّاً عند التأمّل في أحاديث وكلمات الإمام الحسين× استنتاج الإلهيات التنزيهيّة أيضاً؛ إذ إنّ الإمام× كان بصدد التعريف بصفات الله سبحانه للناس من خلال رفع النواقص وسلبها عنها عند نسبتها إليه، وإليك بعضاً منها:
فقد قال الإمام الحسين× في دعاء عرفة، واصفاً الله تعالى:
«وَلَا تَخْفَى عَلَيْهِ الطَّلَائِعُ»([cxxviii]).
وكلمة «طلائع» جمع «طليعة» من مادة «طلوع» بمعنى الظهور والبروز، والمقصود هنا الموجودات التي لها ظهور وبروز في عالم الخارج.
وطبقاً لهذه الجملة لا شيء يخفى على الله تعالى، على خلاف المخلوقات التي يخفى عليها أكثر الطلائع، وهذا هو تنزيه الله عن نواقص علم الآخرين؛ بعبارة أخرى: في هذه الجملة تمّ نفي الخفاء عن ساحة الله تعالى لا سلبه، وبين هذين الأمرين فرق؛ لأنّ النفي يتناسب مع التنزيه لا مع السلب، وذلك أنّ السلب عبارة عن سلب شيء بعد وجوده خلافاً للنفي إذ هو عبارة عن انتفاء الشيء قبل وجوده.
و ورد ـ أيضاً ـ عن الإمام الحسين× وصفه لله تعالى في دعاء عرفه، قائلاً:
«يَعْلَمُ خائِنَةَ الأَعْيُنِ وَما تُخْفِي الصُّدُورُ، وَغَيْبَ مَا تَأْتِي بِهِ الأَزْمِنَةُ وَالدُّهُورُ»([cxxix]).
على خلاف المخلوقات التي ليست كذلك وعلمها محدود متناهي.
و جاء ـ أيضاً ـ في دعاء عرفة قوله× مخاطباً الحقّ تعالى:
«يَا مَنْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً»([cxxx]).
على خلاف المخلوقات التي علمها ليس فيه إحاطة بكلّ شيء، وهذا هو معنى تنزيه الله تعالى عن النقص الموجود في علم الآخرين.
كما ورد عنه× في دعاء عرفة ـ أيضاً ـ مخاطباً البارئ تعالى:
«يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ إِغْمَاضُ الجُفُونِ، وَلَا لَحْظُ العُيُونِ، وَلَا مَا اسْتَقَرَّ فِي المَكْنُونِ، وَلَا مَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ مُضْمَرَاتُ القُلُوبِ، أَلَا كُلُّ ذَلِكَ قَدْ أَحْصَاهُ عِلْمُكَ»([cxxxi]).
على عكس المخلوقات التي يغيب عنها الكثير الكثير من الأمور.
وورد عنه× ـ أيضاً ـ قوله في دعاء المظلوم ـ مخاطباً الله جلّ وعلا ـ:
«تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا وَسِرَّنَا وَعَلَانِيَتَنَا، وَتَطَّلِعُ عَلَى نِيَّاتِنَا وَتُحِيطُ بِضَمَائِرِنَا»([cxxxii]).
خلافاً لما عليه المخلوقات التي يكون علمها محدوداً.
وأمّا بخصوص القدرة الإلهيّة، فالإمام الحسين× من خلال تعريفها للإنسان يكون بصدد رفع النواقص الموجودة بخصوص هذه الصفة لديه عن الله تعالى، ولهذا عنه× قوله في دعاء عرفة، واصفاً الله تعالى:
«وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»([cxxxiii]).
فهذا الحديث جاء في الحقيقة بصدد بيان هذا المطلب، وهو أنّ الله سبحانه قادر على كلّ شيء، وقدرته تتعلّق بكلّ شيء على خلاف مخلوقاته التي تكون قدرتها محدودة لا عموم فيها، فلا تتعلّق بأيّ شيء.
وجاء ـ أيضاً ـ عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة، مخاطباً الحقّ سبحانه:
«وَلَيْسَ دُونَكَ ظَهِيرٌ، وَلَا فَوْقَكَ قَدِيرٌ»([cxxxiv]).
على عكس ما عليه المخلوقات، إذ لا تخلو من قدرة فوقها.
وروي ـ أيضاً ـ عن الإمام الحسين× قوله في دعاء التسبيح:
«سُبْحَانَ المَلِكِ المُقْتَدِرِ»([cxxxv]).
خلافاً للمخلوقات التي تكون قدرتها ناقصة حتى لو كان أحدها ملكاً.
و روي ـ أيضاً ـ عن الإمام الحسين× قوله في دعاء المظلوم، داعياً على الظالم:
«وَأَرِهِ بَطْشَتَكَ الكُبْرَى، وَنَقِمَتَكَ المُثْلَى، وَقُدْرَتَكَ الَّتِي هِيَ فَوْقَ كُلِّ قُدْرَةٍ، وَسُلْطَانَكَ الَّذِي هُوَ أَعَزُّ مِنْ سُلْطَانِهِ، وَاغْلِبْهُ لِي بِقُوَّتِكَ القَوِيَّةِ، وَمِحَالِكَ الشَّدِيدِ، وَامْنَعْنِي مِنْهُ بِمَنْعَتِكَ الَّتِي كُلُّ خَلْقٍ فِيهَا ذَلِيلٌ»([cxxxvi]).
على خلاف المخلوقات التي تحت سلطة قدرة فوق قدرتها، وتلك القدرة هي قدرة الله تعالى؛ وهذا معنى تنزيه الله سبحانه من النقص الموجود في قدرة غيره.
وبخصوص الحياة الإلهية جاء عنه×، أنّه قال في وصفه لله تعالى:
«وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ»([cxxxvii]).
على خلاف المخلوقات الحيّة التي ستموت يوماً ما.
وروي أيضاً عن الإمام الحسين× قوله في دعاء العشرات:
«أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ»([cxxxviii]).
وبخصوص الدوام الإلهي، قال الإمام الحسين× في دعاء عرفة مخاطباً الحقّ سبحانه:
«يَا اللهُ يَا بَدِيءُ لَا بَدْءَ لَكَ، [دَائِماً] يَا دَائِماً لَا نَفَادَ لَكَ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ»([cxxxix]).
على خلاف المخلوقات التي هي ليست بحيّة قيّومة؛ وهذا هو تنزيه الصفات الثبوتيّة للبارئ تعالى من النواقص الموجودة في صفات الآخرين.
وقد ورد عن الإمام الحسين× بخصوص الملك الإلهي في دعاء العشرات قوله:
«سُبْحَانَ ذِي المُلْكِ»([cxl]).
على خلاف الحكام الذين ملكهم ناقص.
وحول العزة والعظمة الإلهيّة، قال الإمام الحسين× في دعاء العشرات في وصف الله سبحانه:
«سُبْحَانَ ذِي العِزَّةِ وَالعَظَمَةِ وَالجَبَرُوتِ»([cxli]).
خلافاً لما لدى البشر من العزّة والعظمة والجبروت المصحوبة بالنواقص، ومنها عدم الاستقلال.
وحول صفة قدم البارئ تعالى روى ابن شعبة الحرّاني في تحف العقول عن الإمام الحسين×، أنّه قال:
«لَيْسَ عَنِ الدَّهْرِ قِدَمُهُ، وَلَا بِالنَّاحِيَةِ أَمَمُهُ»([cxlii]).
بينما قدم المخلوقات بناء على رأي الفلاسفة دهري وزماني لا ذاتي.
وحول المعرفة الإلهية، روي عن الإمام الحسين× قوله في دعاء المظلوم مخاطباً الله سبحانه:
«مَعْرِفَتُكَ بِمَا نُبْطِنُهُ كَمَعْرِفَتِكَ بِمَا نُظْهِرُهُ»([cxliii]).
بينما معرفتنا بالنسبة إلى الظاهر والباطن ليست متساوية.
و حول إحاطة الله تعالى بالموجودات، روي عن الإمام الحسين× قوله:
«هُوَ فِي الأَشْيَاءِ كَائِنٌ لَا كَيْنُونَةَ مَحْظُورٍ بِهَا عَلَيْهِ، وَمِنَ الأَشْيَاءِ بَائِنٌ لَا بَيْنُونَةَ غَائِبٍ عَنْهَا»([cxliv]).
والحال نحن إمّا محاصرون بالأشياء
أو غائبون عنها.
|
|
|
|
1ـ عموم الصفات السلبية
|
|
|
|
عموم الصفات السلبيّة في كلام الإمام الحسين×
روى ابن شعبة الحرّاني في «تحف العقول» عن الإمام الحسين× أنّه قال ـ حول الله تعالى ـ:
«لَا تَتَدَاوَلُهُ الأُمُورُ، وَلَا تَجْرِي عَلَيْهِ الأَحْوَالُ، وَلَا تَنْزِلُ عَلَيْهِ الأَحْدَاثُ، وَلَا يَقْدِرُ الوَاصِفُونَ كُنْهَ عَظَمَتِهِ، وَلَا يَخْطُرُ عَلَى القُلُوبِ مَبْلَغُ جَبَرُوتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي الأَشْيَاءِ عَدِيلٌ، وَلَا تُدْرِكُهُ العُلَمَاءُ بِالبَابِهَا، وَلَا أَهْلُ التَّفْكِيرِ بِتَفْكِيرِهِمْ إِلَّا بِالتَّحْقِيقِ إِيقَاناً بِالغَيْبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ المَخْلُوقِينَ، وَهُوَ الوَاحِدُ الصَّمَدُ، مَا تُصُوِّرَ فِي الأَوْهَامِ فَهُوَ خِلَافُهُ»([cxlv]).
يتحصّل من جملة «لَا يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ المَخْلُوقِينَ»، أنّ بعض الصفات التي تعبّر عن خصوصيّات المخلوقين تُسلب عن الله تعالى، وهي ما يُطلق عليها اسم الصفات السلبيّة، مثل:
1ـ التركيب.
2ـ الجسميّة.
3ـ الرؤية.
4ـ محلّ للحوادث والحالات.
5ـ له شريك.
وغيرها.
نُقل عن يونس بن ظبيان أنّه قال:
«دَخَلْتُ عَلَى الصَّادِقِ×، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ، إِنِّي دَخَلْتُ عَلَى مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، فَسَمِعْتُ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: إِنَّ الله له [لِلهِ] وَجْهاً كَالوُجُوهِ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: لَهُ يَدَانِ، وَاحْتَجُّوا بِذَلِكَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: (ﯤﯥ ﯦ)([cxlvi]) وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: هُوَ كَالشَّابِّ مِنْ أَبْنَاءِ ثَلَاثِينَ سَنَةً، فَمَا عِنْدَكَ فِي هَذَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ؟
قَالَ: فَكَانَ مُتَّكِئاً فَاسْتَوَى جَالِساً، وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ!
ثُمَّ قَالَ: يَا يُونُسُ، مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلهِ وَجْهاً كَالوُجُوهِ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلهِ جَوَارِحَ كَجَوَارِحِ المَخْلُوقِينَ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ، فَلَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ وَلَا تَأْكُلُوا ذَبِيحَتَهُ، تَعَالَى اللهُ عَمَّا يَصِفُهُ المُشَبِّهُونَ بِصِفَةِ المَخْلُوقِينَ، فَوَجْهُ اللهِ أَنْبِيَاؤُهُ، وَقَوْلُهُ: (ﯣ ﯤﯥ ﯦ)([cxlvii]) فَاليَدُ القُدْرَةُ كَقَوْلِهِ: (ﭝ ﭞ)([cxlviii]).
فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللهَ فِي شَيْءٍ أَوْ عَلَى شَيْءٍ، أَوْ تَحَوَّلَ مِنْ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ، أَوْ يَخْلُو مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ يَشْغَلُ بِهِ شَيْءٌ، فَقَدْ وَصَفَهُ بِصِفَةِ المَخْلُوقِينَ، وَاللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا يُقَاسُ بِالقِيَاسِ وَلَا يُشَبَّهُ بِالنَّاسِ، لَا يَخْلُو مِنْهُ مَكَانٌ، وَلَا يَشْغَلُ بِهِ مَكَانٌ، قَرِيبٌ فِي بُعْدِهِ، بَعِيدٌ فِي قُرْبِهِ، ذَلِكَ اللهُ رَبُّنَا لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، فَمَنْ أَرَادَ اللهَ وَأَحَبَّهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَهُوَ مِنَ المُوَحِّدِينَ، وَمَنْ أَحَبَّهُ بِغَيْرِ هَذِهِ الصِّفَةِ فَاللهُ مِنْهُ بَرِيءٌ وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَآءُ»([cxlix]).
|
|
|
|
2ـ التنزيه الإلهي
|
|
|
|
أ) التنزيه العام لله في كلام الإمام الحسين×
روي عن الإمام الحسين× قوله في دعاء العشرات عن الله تعالى:
«سُبْحَانَ اللهِ»([cl]).
تبيّن من ذكر التسبيح المطلق الذي ورد هنا أنّ الله تعالى منزّه عن كلّ عيب ونقص وعلى الخصوص في الألوهيّة.
روي عن الإمام الحسين× أنّه قال:
«إِذَا صَاحَ الشَّاهِينُ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ حَقّاً حَقّاً»([cli]).
في هذه الجملة تمّ التأكيد مرّتين على حقّانية تنزيه الله تعالى عن كلّ عيب ونقص.
يقول الله تعالى:
(ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﯕﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)([clii]).
نقل الشيخ الصدوق بسنده عن يزيد بن الأصم أنّه قال:
«سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مَا تَفْسِيرُ: سُبْحَانَ اللهِ؟
قَالَ: إِنَّ فِي هَذَا الحَائِطِ رَجُلًا كَانَ إِذَا سُئِلَ أَنْبَأَ، وَإِذَا سَكَتَّ ابْتَدَأَ.
فَدَخَلَ الرَّجُلُ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ×، فَقَالَ: يَا أَبَا الحَسَنِ، مَا تَفْسِيرُ سُبْحَانَ اللهِ؟
قَالَ: هُوَ تَعْظِيمُ جَلَالِ اللهِ}، وَتَنْزِيهُهُ عَمَّا قَالَ فِيهِ كُلُّ مُشْرِكٍ، فَإِذَا قَالَهَا العَبْدُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ»([cliii]).
روى الكليني بسنده عن هشام الجواليقي أنّه قال:
«سَالتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ× عَنْ قَوْلِ اللهِ}: (ﭰ ﭱ) مَا يُعْنَى بِهِ؟ قَالَ: تَنْزِيهُهُ»([cliv]).
قال العلّامة المصطفوي في شرح مادّة «سبح»:
«إنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الحركة في مسير الحقّ من دون انحراف ونقطة ضعف، أو كون على الحقّ منزّهاً عن نقطة ضعف.
فيلاحظ فيها جهتان: جهة الحركة في مسير الحقّ، وجهة التباعد عن الضعف...، فإنّ الحقيقة في المادة إنّما تختلف مصاديقها باختلاف مواردها: فالحركة في مسير الحقّ مع التباعد عن الانحراف والضعف والنقص: إنّما يتحقّق ... وفي الله}: بجريان أمره على الحقّ الثابت مع التنزّه عن أيّ ضعف ونقص وانحراف...، فالسبح في الله} إنّما يتحقّق ويصدق بمعناه الحقيقي ومفهومه التام الكامل، فهو في مجرى الحقّ في ذاته وصفاته وأفعاله وجميع أموره منزّهاً عن أيّ ضعف ونقص وحدّ وفقر.
وتوضيح ذلك: أنّ نور الوجود في مقاماته ومراتبه كلّما قوي واشتدّ يكون الضعف والحدّ والفقر والنقص فيه أقل، فنور الوجود وآثاره البارزة في مرتبة النبات أقوى من مرتبة الجماد، وهو في الحيوان أقوى من النبات، وفي الملكوت أقوى من الحيوان، وفي الروح والجبروت أقوى من الملكوت، فيكون القدرة والكمال والعلم والحياة والإرادة في الأرواح أوسع وأقوى من المراتب النازلة، والضعف والنقص والفقر فيه أقل.
والإنسان موجود جامع لجميع المراتب، من عالم الجماد إلى الروح الكامل، ولازم له السلوك والحركة من مرتبة إلى ما فوقها، حتى يستكمل المراحل ويصل إلى مقام الروحانيّة الكاملة والنورانيّة التامّة، ويتنزّه عن العيوب والنواقص، ويتقرّب من مبدأ الجمال والكمال والجلال والنور التام.
والضعف العام بجميع مراتب العوالم: هو الإمكان والحدّ المطلق، فيبقى هذا الضعف وهو الحدّ الذاتي في مرتبة عالم الأرواح، ولا يمكن رفعه والتنزّه منه، لأنّ الحدّ من لوازم الإمكان ذاتاً.
وفوق هذا العالم: عالم الألوهيّة، وهو نور الوجود الحق الواجب الأزلي الأبدي المنزّه عن أيّ نقص وضعف وحدّ في ذاته وصفاته.
وله تعالى بذاته وفي ذاته ومن ذاته ولذاته حياة وقدرة وعلم وإرادة وغنى، وليس له فقر ولا ضعف ولا حدّ، فهو سبّوح قدّوس.
وأمّا المعرفة بذلك شهوداً وحضوراً، فيتوقّف على التنزّه والتخلّي والتخلّص والفراغ عن المراتب النازلة، وبل عن وجوه الإمكاني المحدود، بحيث يفرغ عن كلّ ما سوى الله} ويفنى فيه تعالى، وترتفع الحجب الظلمانيّة والنورانيّة، ولا يرى إلّا الله، ولا يشاهد إلّا نور جماله ـ فارفع الأنانية من البين.
فحينئذ يشاهده ـ جلّ وعزّ ـ فارغاً ونزيهاً عن أيّ حدّ ووصف وإشارة، قيّوماً على كلّ شيء، محيطاً على جميع مراتب الوجود، بل يشاهد الكلّ فانياً فيه، ليس إلّا هو.
وإذ لا ضعف في ذاته ولا فقر ولا حدّ: فهو على الحقّ الصريح في وجوده وصفاته العليا وأفعاله، وفي جميع تجلّياته ومراحل ظهوره، ويبقى وجهه»([clv]).
وقال العلّامة الطباطبائي:
«(سبحانه) مصدر بمعنى التسبيح، وهو لا يستعمل إلّا مضافاً، وهو مفعول مطلق لفعل محذوف، أي: سبّحته تسبيحاً، فحذف الفعل وأضيف المصدر إلى الضمير المفعول وأقيم مقامه، وفي الكلمة تأديب إلهي بالتنزيه فيما يذكر فيه ما لا يليق بساحة قدسه تعالى وتقدّس»([clvi]).
وقال الشيخ البهائي:
«إنّ التنزيه المستفاد من سبحان الله ثلاثة أنواع:
[أ]: تنزيه الذات عن نقص الإمكان الذي هو منبع السوء.
[ب]: وتنزيه الصفات عن وصمة الحدوث، بل عن كونها مغايرة للذات المقدّسة، وزائدة عليها.
[ج]: وتنزيه الأفعال عن القبح والعبث، وعن كونها جالبة إليه تعالى نفعاً أو دافعة عنه سبحانه ضرراً كأفعال العباد»([clvii]).
ب)
أوقات تنزيه الله تعالى في كلام الإمام الحسين×
|
|
تنزيه الله في الصبح والعصر
روي عن الإمام الحسين× أنّه قال في دعاء العشرات ـ منزّهاً الحقّ سبحانه ـ:
«سُبْحَانَ اللهِ بِالغُدُوِّ وَالآصالِ»([clviii]).
و(غدوّ) جمع غدوة، بمعنى أوّل النهار، وما بين طلوع الفجر وشروق الشمس.
و(آصال) جمع أصيل، بمعنى آخر النهار، واستعمل بمعنى الرجوع أيضاً؛ لأنّ الشمس في هذا الوقت ترجع إلى أفقها.
يستفاد من مضمون هذا الكلام أنّ الله تعالى منزّه عن كلّ عيب ونقص في الصبح والعصر.
وقال حسن المصطفوي في شرح مادة (غدو):
«إنّ الأصل الواحد في المادّة: هو تحوّل مع جريان، وهذا المفهوم له مصاديق: كالتحوّل في الليل وجريانه إلى أن يزول آثار الليل، وهذا المعنى يتحقّق من أوّل الفجر إلى طلوع الشمس، وكتحوّل في مجموع اليوم والليلة إلى يوم آخر وجريانه، وكتحوّل في أمر مكان مستمرّاً أو حالة ممتدّة إلى أمر أو حالة أخرى، وهكذا.
فلا بدّ في تحقّق هذا الأصل من لحاظ قيدين: التحوّل، وجريانه. وهذا المعنى مفهوم كلّى تختلف خصوصيّاته باختلاف الموارد»([clix]).
قال الله تعالى:
(ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ)([clx]).
تنزيه الله تعالى في ساعات الليل
روي عن الإمام الحسين× قوله في دعاء العشرات مسبّحاً:
«سُبْحَانَ اللهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ»([clxi]).
و(آناء) جمع إني، بمعنى الوقت أو حلوله، و(آناء الليل) بمعنى ساعات الليل؛ ويستفاد ضمناً من هذا الكلام أنّ ما يقوم به الله تعالى من أعمال في ساعات الليل تكون منزّهة عن العيب والنقص، ولذا يجب تنزيهه وتسبيحه وتقديسه في هذه الساعات.
يقول الله تعالى:
(ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ)([clxii]).
قال العلّامة حسن المصطفوي في شرح مادة (أني):
«إنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو البلوغ والنضج من جهة الوقت. وهذا المعنى يختلف بحسب اختلاف الموارد والمفاهيم. كما في بلوغ وقت اشتداد الحرارة، والبلوغ في أوقات الليل وساعاته، وبلوغ مرتبة الحلم والطمأنينة، وبلوغ وقت الاستفادة من الظروف، وبلوغ وقت إدراك الطعام والأكل منه. ويؤيّد هذا المعنى: ما يفهم من مادّة أين، أون، أنو»([clxiii]).
تنزيه الله تعالى أطراف النهار
روي عن الإمام الحسين× تسبيحه في دعاء العشرات:
«سُبْحَانَ اللهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ»([clxiv]).
وكلمة (أطراف) جمع طرف، بمعنى الناحية والجانب و(أطراف النهار) بمعنى ساعات النهار الواقعة عند طرفيه؛ ويستنتج من مضمون هذا الكلام أيضاً أنّ ما يقوم بها الله تعالى في أطراف النهار منزّه من كلّ عيب ونقص، ولهذا يجب تنزيهه وتقديسه في النهار أيضاً.
قال الله تعالى:
(ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ)([clxv]).
وجاء في شرح العلّامة المصطفوي لمادّة (طرف):
«إنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو منتهى الشيء وآخر خطّ من الجسم أو آخر نقطة من الخط.
وقلنا في الشطر: إنّ الجنب هو ما يلي الشيء من غير انفصال. والشطر: ما يعمّ الجنب والطرف.
ولا يبعد أن يكون مفهوم الحركة في الجفون وامتداد اللحظ مأخوذاً من العبريّة ـ كما رأيت ـ أو أنّ هذا المعنى أيضاً مأخوذ من الأصل في المادّة، باعتبار أنّ تحريك الجفن واللحظ إنّما يتحقّق في الجفن وهو غطاء العين، وهو آخر عضو أو آخر خطّ من مراتب العين وطبقاتها.
فيقال: طَرَفَتْ تَطْرِفُ طَرْفاً العين: إذا صارت ذات طرف، وذلك تحرّك طرفها وينسب العمل إلى طرفها. وطَرَفْتُ البصر عنه: إذا جعلت طرف الإبصار والرؤية منحرفاً عنه، وهكذا.
فمفهوم الطَّرْفِيَّةِ ملحوظ في جميع موارد استعمالاتها، كَالتَّطْرِيفِ والخضاب في أطراف الأصابع. والطَّرِيفُ في المال الجديد اللاحق في منتهى الزمان السابق.
والمُطْرَفُ في الثوب له خطوط في أطرافه. والطَّرِفَةُ للناقة الراعية في أطراف المرعى»([clxvi]).
قال الإمام السجاد× في الدعاء الثاني والأربعين من الصحيفة السجاديّة ـ مخاطباً الله تبارك وتعالى ـ:
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاحْطُطْ بِالقُرْآنِ عَنَّا ثِقْلَ الأَوْزَارِ، وَهَبْ لَنَا حُسْنَ شَمَائِلِ الأَبْرَارِ، وَاقْفُ بِنَا آثَارَ الَّذِينَ قَامُوا لَكَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ»([clxvii]).
وقال السيد علي خان المدني في شرح ذلك:
«وآناء الليل: ساعاته، جمع (إني) بالكسر والقصر، وأناء بالفتح والمدّ.
وأطراف النّهار: أي طرفيه، ومجيئه بلفظ الجمع للمبالغة، وأمن الالتباس، أو لأنّ أقلّ الجمع اثنان، وأراد طرفيّ كلّ نهار، لأنّ النهار جنس أو أجزاء النهار، لأنّ كلّ جزء كالطرف له، وإنّما قدمت آناء الليل على أطراف النهار هنا وفي قوله تعالى: (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ)([clxviii]) تنبيهاً على زيادة الاهتمام بشأن العبادة بالليل؛ لأنّ الليل وقت السكون والراحة وهدوّ الأصوات، فالقيام بالعبادة فيه أشقّ على النفس وأدخل في الإخلاص، وأقرب من المحافظة على الخشوع والإخبات، والكلام إمّا استعارة تمثيليّة أن جعل المشبّه به فيه صورة منتزعة من اتباع شخص آثار قوم تقدموه يمشي خلفهم ويسلك طرقهم، والمشبّه صورة منتزعة من تصيير حاله كحالهم في القيام بما قاموا به توفيقه للعمل كأعمالهم، أو استعارة مكنية تخييليّة إن قصد فيه إلى تشبيه القائمين بالقرآن، والمجتهدين في تلاوته، والعمل به بقوم تقدّموه في المسير وجعل إثبات الآثار لها تنبيهاً على ذلك، وهو التخييل وذكر القفو ترشيح»([clxix]).
تنزيه الله تعالى حين دخول المساء والصباح
روي عن الإمام الحسين× قوله في دعاء العشرات مسبّحاً:
«سُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ»([clxx]).
وكلمة (تمسون) بمعنى الدخول في المساء، و(تصبحون) بمعنى الدخول في الصباح، ويستفاد من هذا الكلام أنّ الله تبارك وتعالى منزّه عن كلّ عيب ونقص حين دخول الناس في المساء والصباح.
إنّ كلمة (مساء) تطلق على معنيين:
1ـ خلاف الصبح؛ فالصبح يطلق على ما قبل الظهر من النهار، والمساء على ما بعد الظهر حتى المغرب.
2ـ خلاف النهار، فبناء على هذا الإطلاق يكون شروع ذلك من غروب الشمس إلى قبيل وقت العشاء.
يقول الله}:
(ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)([clxxi]).
|
|
ج)
ما نُزّه عنه الله تعالى في كلام الإمام الحسين×
|
|
تنزيه الله عن الشريك
ورد عن الامام الحسين× قوله في دعاء عرفة عن الله سبحانه:
«فَسُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا»([clxxii]).
إذ يستفاد من مضمون هذه الجملة وسياقها تنزيه الله سبحانه عن أيّ نوع من الشريك.
يقول الله تعالى: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯕﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ)([clxxiii]).
تنزيه الله تعالى عن المضادّ له في صنعه
ورد عن الإمام الحسين× في دعاء عرفة قوله عن الله جلّ وعلا:
«الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً فَيَكُونَ مَوْرُوثاً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ فَيُضَادَّهُ فِيمَا ابْتَدَعَ، وَلَا وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ فَيُرْفِدَهُ فِيمَا صَنَعَ، فَسُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ»([clxxiv]).
حيث يستفاد من تفريع التسبيح على عبارة «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ فَيُضَادَّهُ فِيمَا ابْتَدَعَ» أنّ الله تعالى منزّه عن أن يكون له ضدّ في صنعه.
يقول الله تعالى:
(ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)([clxxv]).
تنزيه الله عن الولي
كما يتبيّن أيضاً من الحديث الأخير للإمام الحسين× ـ لمكان مجيء الكلام عن الولي قبل التسبيح ـ أنّ الحق} لا يكون له ولي؛ لكماله المطلق وعدم حاجته لغيره حتى يتولّاه.
يقول عزّ من قائل:
(ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ)([clxxvi]).
تنزيه الله تعالى في الواحديّة
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة:
«سُبْحَانَ اللهِ الوَاحِدِ»([clxxvii]).
إن كان هذا التسبيح متعلّق بـ(واحد)، تكون له دلالة على تنزيه الله تعالى في الواحديّة، على أنّ واحديّته حقيقيّة لا عدديّة.
قال الله تعالى:
(ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ)([clxxviii]).
تنزيه الله تعالى في الأحديّة
ورد عن الإمام الحسين× في دعاء عرفة قوله:
«سُبْحَانَ اللهِ الوَاحِدِ الأَحَدِ»([clxxix]).
إن كان التسبيح متعلّق بما بعد ذلك دلّ كلام الإمام على تنزيه الله تعالى في الأحديّة، فهو منزّه عن أيّ شرك في جميع الجهات ذهناً وخارجاً ووهماً.
روي عن رسول الله| قوله في دعاء ـ مخاطباً الله تعالى ـ:
«سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللهُ الوَاحِدُ الأَحَدُ»([clxxx]).
تنزيه الله تعالى في الصمديّة
روي عن الإمام الحسين× في دعاء عرفة قوله عن الله تعالى:
«سُبْحَانَ اللهِ الوَاحِدِ الأَحَدِ الصَّمَدِ»([clxxxi]).
فمن سياق هذا التسبيح يستفاد أنّ الله منزّه في صمديّته وعدم حاجته، وعدم احتياجه ذاتي لا عرضي، على خلاف الأولياء الإلهيين؛ إذ عدم احتياجهم ليس ذاتيّاً بل عرضيّاً من الله، نشأ نتيجة اتصالهم به سبحانه.
فقد روي عن رسول الله| في أحد الأدعية مخاطباً الحقّ جلّ وعلا:
«سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللهُ السَّيِّدُ الصَّمَدُ»([clxxxii]).
تنزيه الله تعالى عن الابن
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة مسبّحاً:
«سُبْحَانَ اللهِ الوَاحِدِ الأَحَدِ الصَّمَدِ، الَّذِي (ﭙ ﭚ)»([clxxxiii]).
فيتأتى من مجموع هذا الكلام أنّ الله واحد أحد صمد غير محتاج لأن يكون له ولد، وذلك لتنزّهه عن النقص الذي يتحصّل نتيجة ذلك.
يقول الله عزّت أسماؤه:
(ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ)([clxxxiv]).
تنزيه الله تعالى عن الولادة
روي عن الإمام الحسين× في دعاء عرفة:
«سُبْحَانَ اللهِ الوَاحِدِ الأَحَدِ الصَّمَدِ، الَّذِي (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)»([clxxxv]).
فيستفاد من مجموع هذا الكلام ومضمونه أنّ الله الذي هو واحد وأحد وصمد لم يولد من أحد ولا من شيء؛ لأنّ ذلك مستلزم للنقص.
روي عن الإمام الصادق× أنّه قال:
«(ﭙ ﭚ) لِأَنَّ الوَلَدَ يُشْبِهُ أَبَاهُ، (ﭛ ﭜ) فَيُشْبِهَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، (ﭞ ﭟ ﭠ) مِنْ خَلْقِهِ (ﭡ ﭢ)، تَعَالَى عَنْ صِفَةِ مَنْ سِوَاهُ عُلُوّاً كَبِيراً»([clxxxvi]).
تنزيه الله تعالى عن الكفو
روي عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة مسبّحاً:
«سُبْحَانَ اللهِ الوَاحِدِ الأَحَدِ الصَّمَدِ، الَّذِي (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﯕﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)»([clxxxvii]).
فمن مضمون هذه الجملة يستفاد أنّ الله الواحد الأحد الصمد ليس بحاجة إلى نظير، ومنزّه عنه.
روى الكليني بسنده عن حمزة بن محمد، قال:
«كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الحَسَنِ× أَسْأَلُهُ عَنِ الجِسْمِ وَالصُّورَةِ، فَكَتَبَ: سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، لَا جِسْمٌ وَلَا صُورَةٌ»([clxxxviii]).
وقال العلّامة الطباطبائي في تفسير سورة الإخلاص حول هذا الأمر:
«وهذه الصفات الثلاث المنفيّة وإن أمكن تفريع نفيها على صفة أحديّته تعالى بوجه، لكن الأسبق إلى الذهن تفرّعها على صفة صمديّته...
فقد تبيّن أنّ ما في الآيتين من النفي متفرّع على صمديّته تعالى، ومآل ما ذكر من صمديّته تعالى وما يتفرّع عليه إلى إثبات توحّده تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله، بمعنى أنّه واحد لا يناظره شيء ولا يشبهه، فذاته تعالى بذاته ولذاته من غير استناد إلى غيره واحتياج إلى من سواه وكذا صفاته وأفعاله، وذوات من سواه وصفاتهم وأفعالهم بإفاضة منه على ما يليق بساحة كبريائه وعظمته، فمحصّل السورة وصفه تعالى بأنّه أحد واحد»([clxxxix]).
تنزيه الله تعالى عن الحاجة للطاعة
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة مخاطباً الحقّ جلّ وعلا:
«وَأَسْعِدْنَا بِطَاعَتِكَ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»([cxc]).
يستفاد من الإتيان بالتسبيح ـ بعد هذا الدعاء ـ أنّ الله تعالى منزّه عن الحاجة إلى طاعاتنا، وأنّ الفائدة والآثار المترتّبة عليها تعود للإنسان المطيع.
يقول أمير المؤمنين× في ذلك:
«فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ الخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ غَنِيّاً عَنْ طَاعَتِهِمْ، آمِناً مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ، لِأَنَّهُ لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَاهُ، وَلَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ»([cxci]).
تنزيه الله تعالى في الألوهيّة
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة مخاطباً الحقّ جلّ وعلا:
«سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»([cxcii]).
حيث يستفاد من الإتيان بذكر التوحيد بعد التسبيح أنّ الله تعالى جامع لجميع صفات الجمال والكمال والجلال، وهو منزّه فيها عن كلّ العيوب والنواقص.
يقول الله تعالى:
(ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﯕﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ)([cxciii]).
تنزيه الله تعالى عما يقول الظالمون
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة:
«سُبْحَانَكَ وَتَعَالَيْتَ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوّاً كَبِيراً»([cxciv]).
إذ يتبيّن من مضمون هذا الكلام أنّ الحقّ تبارك وتعالى منزّه عما يقوله الظالمون بشأنه وعن نسبة ذنوبهم إليه أيضاً.
يقول الله تباركت آلاؤه:
(ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ)([cxcv]).
وفي شرح كلام الإمام× قال السيد علي خان المدني:
«سبحانك: منصوب على المصدريّة.
قيل: هو اسم مصدر وقع موقع المصدر وهو التسبيح بمعنى التنزيه.
وقيل: هو مصدر كالغفران وهو غير متصرّف، أي لا يستعمل إلّا محذوف الفعل منصوباً على المصدريّة، ولا يكاد يستعمل إلّا مضافاً، وإذا استعمل غير مضاف كان علماً للتسبيح غير مصروف للعلميّة، والألف والنون المزيدتين كعثمان علماً لرجل، فإنّ العلميّة كما تجري في الأعيان تجري في المعاني، والمعنى على الأوّل نسبّحك تسبيحاً عمّا لا يليق بشأنك الأقدس من الأمور التي من جملتها عدم عبادتنا لك حقّ عبادتك وعنوا بذلك تسبيحاً ناشئاً عن كمال الاعتراف والإيقان بالعجز عمّا يليق بمقامه الأعلى من العبادة، وعلى الثاني تنزّهت عن ذلك تنزّهاً ناشئاً عن ذاتك، ولا يبعد أن يحمل على التعجّب، كأنّه قيل ما أبعد من له هذه القدرة والقهر عن جميع النقائص فلا يكون خلقه لجهنّم وزفيرها على أهل معصيته إلاّ حكمة وصواباً، وأتعجّب من حال أهل معصيته كيف عصوا من هو قادر على ذلك فاستحقّوا هذا النوع من الانتقام، كأنّه قيل: ما أبعد من عقابه وانتقامه بهذه المثابة عن أن يرتكب مخلوق معصيته»([cxcvi]).
تنزيه الله تعالى عن شرك المشركين
روى صفوان الجمّال عن الإمام الصادق، عن أبيه الإمام الباقر، عن أبيه الإمام زين العابدين^، أنّه قال:
«إنَّ رَجُلًا اشْتَكَى إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ÷، فَقَالَ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ، إِنِّي أَجِدُ وَجَعاً فِي عَرَاقِيبِي قَدْ مَنَعَنِي مِنَ النُّهُوضِ إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكَ مِنَ العُوذَةِ؟ قَالَ: لَسْتُ أَعْلَمُهَا. قَالَ: فَإِذَا أَحْسَسْتَ بِهَا فَضَعْ يَدَكَ عَلَيْهَا وَقُلْ: (بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ|) ثُمَّ اقْرَأْ عَلَيْهِ: (ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ)([cxcvii]). فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَشَفَاهُ اللهُ تَعَالَى»([cxcviii]).
فيستفاد من الآية (ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) أنّ الله تعالى منزّه عما جعله المشركون شريكاً لله تعالى. قال سبحانه:
(ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ)([cxcix]).
تنزيه ذات الله وصفاته عن النقص
روي عن الإمام الحسين× أنّه سبّح الله في دعاء العشرات، قائلاً:
«سُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ...، سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ»([cc]).
فمن إضافة سبحان إلى الله وإلى ربّ، وكلمة ربّ إلى العزة، يتحصّل أنّ الله مبرّأ ومنزّه عن كلّ عيب ونقص في الذات والصفات والأسماء.
قال الله تعالى: (ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ)([cci]).
تنزيه الله تعالى عن أوصاف الخلق الناقصة
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء العشرات مسبّحاً:
«سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ»([ccii]).
حيث يستنتج من مضمون هذه الجملة أنّ الله تعالى منزّه عما يصفه به الناس أو الكفار من أوصاف ناقصة.
يقول الله تعالى:
(ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)([cciii]).
تنزيه الله تعالى عن النقص في ربوبيّة عرشه
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء العشرات:
«سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ»([cciv]).
يستفاد من التسبيح الوارد هنا أنّ الله تعالى منزّه ومبرّأ عن أيّ عيب ونقص في ربوبيّة عرشه العظيم الذي هو مركز إدارة كلّ العالم.
يقول الله تعالى:
(ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ)([ccv]).
تنزيه الله تعالى في ملكه
روي عن الإمام الحسين× أنّه في دعاء العشرات قال مسبّحاً لله تعالى:
«سُبْحَانَ ذِي المُلْكِ»([ccvi]).
فيتحصّل من هذه الجملة أنّ الله منزّه في ملكه وسلطانه.
روي عن الإمام أمير المؤمنين× قوله في أحد الأدعية:
«سُبْحَانَ ذِي المُلْكِ وَالمَلَكُوتِ»([ccvii]).
تنزيه الله تعالى في ملكوته
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء العشرات عن الله سبحانه:
«سُبْحَانَ ذِي المُلْكِ وَالمَلَكُوت»([ccviii]).
فيتبيّن من هذا الكلام أنّ الله تعالى منزّه في ملكوته.
يقول الله تعالى:
(ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ)([ccix]).
تنزيه الله تعالى في عزّته
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء العشرات عن الله سبحانه:
«سُبْحَانَ ذِي العِزَّةِ»([ccx]).
فمن إضافة (سبحان) إلى ما بعدها يتحصّل أنّ الله جلّ وعلا منزّه ومبرّأ عن جميع العيوب والنقائص في عزّته.
قال الله تعالى: (ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)([ccxi]).
تنزّه صاحب العظمة
فقد ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء العشرات عن الله تعالى:
«سُبْحَانَ ذِي العِزَّةِ وَالعَظَمَةِ»([ccxii]).
فمن مضمون هذا التسبيح نتوصّل إلى أنّ صاحب العظمة منزّه ومبرّأ من كلّ عيب ونقص، ولذا فإنّ الله تعالى دون نقص وعيب.
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء التوفيق:
«سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ»([ccxiii]).
قال الله تعالى: (ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ)([ccxiv]).
تنزّه صاحب الجبروت
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء العشرات:
«سُبْحَانَ ذِي العِزَّةِ وَالعَظَمَةِ وَالجَبَرُوتِ»([ccxv]).
فمن مضمون هذا التسبيح يتبيّن أنّ صاحب الجبروت منزّه عن كلّ عيب ونقص، ولهذا فإنّ الله تعالى مبرأ عن أي نقص أوعيب.
فقد روي عن الإمام أمير المؤمنين× أنّه قال داعياً:
«سُبْحَانَ ذِي العِزِّ وَالجَبَرُوتِ»([ccxvi]).
تنزّه الملك الحي القدّوس
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء العشرات:
«سُبْحَانَ المَلِكِ الحَيِّ القُدُّوسِ»([ccxvii]).
فيستفاد من هذا التسبيح أنّ الملك الحي الذي لا يموت أبداً ـ أي الله تعالى ـ مبرّأ ومنزّه عن كلّ عيب ونقص.
يقول الله تعالى:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)([ccxviii]).
تنزيه الله القائم الدائم
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء العشرات:
«سُبْحَانَ القَائِمِ الدَّائِمِ»([ccxix]).
فمن هذا التسبيح يستفاد أنّ الله تعالى قائم دائم منزّه عن أيّ عيب ونقص في ذلك.
فقد روي عن رسول الله| أنّه دعا قائلاً:
«سُبْحَانَ القَائِمِ الدَّائِمِ، سُبْحَانَ الجَلِيلِ الجَمِيلِ»([ccxx]).
تنزيه الله في الدوام الذاتي
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء العشرات:
«سُبْحَانَ الدَّائِمِ القَائِمِ»([ccxxi]).
إذ يتحصّل من التسبيح أعلاه أنّ الله تعالى منزّه في دوامه الذاتي ـ إذ لا يتكأ ولا يعتمد على أحد ـ عن كلّ العيوب والنقائص.
روي عن الإمام أمير المؤمنين× أنّه قال بشأن الحقّ تعالى:
«سُبْحَانَ الوَاحِدِ الَّذِي لَيْسَ غَيْرُهُ، سُبْحَانَ الدَّائِمِ الَّذِي لَا نَفَادَ لَهُ»([ccxxii]).
تنزيه الله العلي الأعلى
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء العشرات عن الله تعالى:
«سُبْحَانَ العَلِيِّ الأَعْلَى»([ccxxiii]).
يتحصّل من هذا التسبيح أنّ الله العلي الأعلى منزّه ومبرّأ في علوّ مرتبته وعظمة شأنه عن كلّ عيب ونقص.
يقول الله سبحانه وتعالى:
(ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ)([ccxxiv]).
تنزيه الله تعالى عن ظلم المبتلين
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء الاستجابة ـ مخاطباً الحقّ جلّ وعلا ـ:
«وَأَنْتَ الَّذِي اسْتَجَبْتَ لِذِي النُّونِ حِينَ نَادَاكَ مِنَ (ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ)([ccxxv])، فَنَجَّيْتَهُ مِنَ الغَمِّ»([ccxxvi]).
إنّ إشارة النبي يونس× إلى ظلم النفس هنا لعلّها جاءت للتنويه إلى أمر هو أنّ الإنسان إذا أذنب وظلم نفسه فإنّ الله تعالى لا دخل في ذلك.
قال الله تعالى:
(ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﯕﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ)([ccxxvii]).
تنزيه الله الرفيع الأعلى
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء التسبيح:
«سُبْحَانَ الرَّفِيعِ الأَعْلَى»([ccxxviii]).
يتبيّن من التسبيح الوارد هنا أنّ الله تعالى منزّه عن أيّ عيب ونقص بلحاظ كونه رفيعاً أعلى.
روي عن الإمام الصادق× أنّه قال ـ في أحد أدعيته ـ:
«سُبْحَانَ القَاضِي بِالحَقِّ، سُبْحَانَ الرَّفِيعِ الأَعْلَى»([ccxxix]).
تنزيه الله العظيم الأعظم
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء التسبيح:
«سُبْحَانَ العَظِيمِ الأَعْظَمِ»([ccxxx]).
فيتضح من هذا التسبيح أن الله تعالى بلحاظ كونه عظيماً أعظم منزّه عن كلّ عيب ونقص.
روي عن أمير المؤمنين× أنّه قال:
«فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنْ عَظِيمٍ مَا أَعْظَمَهُ، وَجَلِيلٍ مَا أَجَلَّهُ، وَعَزِيزٍ مَا أَعَزَّهُ، وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوّاً كَبِيراً»([ccxxxi]).
تنزيه الله تعالى لقدرته الخارقة
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء التسبيح:
«سُبْحَانَ العَظِيمِ الأَعْظَمِ، سُبْحَانَ مَنْ هُوَ هَكَذَا، وَلَا يَكُونُ هَكَذَا غَيْرُهُ، وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ قُدْرَتَهُ»([ccxxxii]).
يتحصّل من التسبيح الوارد في هذه الجملة أنّ الله تعالى بلحاظ قدرته الخارقة منزّه عن كلّ عيب ونقص، أو أنّ قدرته الخارقة دون عيب أو نقص، وإذا قرأت (لا يقدر) بالتشديد يفهم من التسبيح حينها أنّ قدرة الله ـ جلّ وعلا ـ لا حدّ لها ولا مقدار، وهي منزّهة من هذه الجهة عن أيّ عيب أو نقص يذكر.
يقول الله تعالى:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ)([ccxxxiii]).
تنزيه الله عن أيّ عيب أو نقص في العلم
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء التسبيح عن الله جلّ جلاله:
«سُبْحَانَ مَنْ أَوَّلُهُ عِلْمٌ لَا يُوصَفُ، وَآخِرُهُ عِلْمٌ لَا يَبِيدُ»([ccxxxiv]).
فيستفاد من التسبيح الوارد في هذه الجملة أنّ علم الله منزّه عن جميع العيوب والنقائص.
روي عن الإمام الصادق× أنّه قال:
«سُبْحَانَ مَنْ هُوَ عَالِمٌ لَا يَسْهُو، سُبْحَانَ مَنْ هُوَ مُحِيطٌ بِخَلْقِهِ لَا يَغِيبُ، سُبْحَانَ مَنْ هُوَ مُحْتَجِبٌ لَا يُرَى»([ccxxxv]).
تنزيه الله في أفضليّته على خلقه
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء التسبيح:
«سُبْحَانَ مَنْ عَلَا فَوْقَ البَرِيَّاتِ بِالإِلَهِيَّةِ»([ccxxxvi]).
فيستفاد من التسبيح الوارد في هذه الجملة أنّ الله تعالى منزّه في أفضليّته على خلقه عن أيّ عيب أو نقص.
روي عن الإمام الصادق× أنّه قال ـ في دعاء مخاطباً ربّ الجلالة ـ:
«لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ المَعْبُودُ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ، تَعَالَيْتَ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوّاً كَبِيراً»([ccxxxvii]).
تنزيه الإله الذي لا تراه العيون
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء التسبيح:
«سُبْحَانَ مَنْ عَلَا فَوْقَ البَرِيَّاتِ بِالإِلَهِيَّةِ؛ فَلَا عَيْنَ تُدْرِكُهُ»([ccxxxviii]).
فيتحصّل من التسبيح الوارد في هذه الجملة أنّ الله وهو المجرد التام والذي لا يرى بالعين، منزّه عن العيوب والنقائص بأسرها.
يقول الله عزّت آلاؤه:
(ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ)([ccxxxix]).
تنزيه الإله الذي لا يمثّله العقل
روي عن الإمام الحسين× قوله في دعاء التسبيح عن الله جلّ وعلا:
«سُبْحَانَ مَنْ عَلَا فَوْقَ البَرِيَّاتِ بِالإِلَهِيَّةِ؛ فَلَا عَيْنَ تُدْرِكُهُ، وَلَا عَقْلَ يُمَثِّلُهُ»([ccxl]).
فيتحصّل من هذه الجملة أنّ الإله الذي لا يمثّل بالعقل، وهو الله منزّه عن كلّ عيب أو نقص.
روي عن أمير المؤمنين× أنّه قال ـ في وصف الله جلّ وعلا ـ:
«سُبْحَانَهُ مَنْ إِذَا تَنَاهَتِ العُقُولُ فِي وَصْفِهِ كَانَتْ حَائِرَةً عَنْ دَرْكِ السَّبِيلِ إِلَيْهِ»([ccxli]).
تنزيه الإله الذي لا يتصوّر بالخيال
روي عن الإمام الحسين× قوله في دعاء التسبيح:
«سُبْحَانَ مَنْ عَلَا فَوْقَ البَرِيَّاتِ بِالإِلَهِيَّةِ؛ فَلَا عَيْنَ تُدْرِكُهُ، وَلَا عَقْلَ يُمَثِّلُهُ، وَلَا وَهْمَ يُصَوِّرُهُ»([ccxlii]).
فمن التسبيح الوارد في الجملة أنّ الله الذي لا يمكن تصويره في خيال الناس منزّه عن أيّ عيب أو نقص.
قال الإمام الباقر× لجابر الجُعفي:
«يَا جَابِرُ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا نَظِيرَ لَهُ وَلَا شَبِيهَ، تَعَالَى عَنْ صِفَةِ الوَاصِفِينَ، وَجَلَّ عَنْ أَوْهَامِ المُتَوَهِّمِينَ، وَاحْتَجَبَ عَنْ أَعْيُنِ النَّاظِرِينَ، لَا يَزُولُ مَعَ الزَّائِلِينَ، وَلَا يَأْفِلُ مَعَ الآفِلِينَ»([ccxliii]).
تنزيه الإله الذي لا تصفه الألسن
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء التسبيح عن الله جلّ وعلا:
«سُبْحَانَ مَنْ عَلَا فَوْقَ البَرِيَّاتِ بِالإِلَهِيَّةِ؛ فَلَا عَيْنَ تُدْرِكُهُ، وَلَا عَقْلَ يُمَثِّلُهُ، وَلَا وَهْمَ يُصَوِّرُهُ، وَلَا لِسَانَ يَصِفُهُ بِغَايَةِ مَا لَهُ مِنَ الوَصْفِ»([ccxliv]).
فمن التسبيح الوارد في هذه الجملة والمتعلّق بالمقطع الأخير من هذا الدعاء يتحصّل أنّ الإله الذي لا يوصف بالألسن وهو الله تعالى، منزّه عن كلّ عيب أو نقص.
يقول الله تعالى: (ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)([ccxlv]).
تنزيه الله في قضائه بالموت على عباده
روي عن الإمام الحسين× أنّه قال في دعاء التسبيح:
«سُبْحَانَ مَنْ قَضَى المَوْتَ عَلَى العِبَادِ»([ccxlvi]).
إذ يستفاد من التسبيح الوارد في هذه الجملة أنّ الله تعالى ما قضى بالموت على عباده وكتبه عليهم إلّا لنفعهم، وهو في هذا الأمر منزّه ومبرّأ عن الظلم والتعدّي عليهم.
روي عن رسول الله| أنّه قال في دعاء المجير ـ مخاطباً البارئ ـ }:
«سُبْحَانَكَ يَا مُحْيِي، تَعَالَيْتَ يَا مُمِيتُ»([ccxlvii]).
تنزيه الله في أوج اقتداره
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء التسبيح:
«سُبْحَانَ المَلِكِ المُقْتَدِرِ»([ccxlviii]).
رغم أنّ بعض الملوك مقتدرون، غير أنّه سيأتي يوم تتلاشى فيه قدرتهم، بيد أنّ الله تعالى ملك مقتدر، لا ينفذ إلى قدرته أيّ عيب أو نقص.
روي عن رسول الله| أنّه قال في أحد أدعيته:
«سُبْحَانَ القَادِرِ المُقْتَدِرِ، سُبْحَانَ العَلِيِّ المُتَعَالِ»([ccxlix]).
تنزيه قداسة ملك الله
ورد عن الإمام الحسين× أنّه قال في دعاء التسبيح عن الله تعالى:
«سُبْحَانَ المَلِكِ القُدُّوسِ»([ccl]).
يتبيّن من التسبيح الوارد هنا تنزيه قداسة الله تعالى وملكه وسلطانه من جميع العيوب والنقائص.
روي عن الإمام الباقر× أنّه قال:
«سُبْحَانَ رَبِّيَ المَلِكِ القُدُّوسِ»([ccli]).
تنزيه الله الباقي الدائم
روي عن الإمام الحسين× أنّه قال في دعاء التسبيح عن الله تعالى:
«سُبْحَانَ البَاقِي الدَّائِمِ»([cclii]).
فيتحصّل من التسبيح الوارد في هذا الدعاء أنّ الله الدائم الباقي منزّه عن أيّ عيب أو نقص.
روي عن الإمام علي× أنّه قال عن الله سبحانه وتعالى:
«سُبْحَانَ مَنْ هُوَ إِلَى غَيْرِ غَايَةٍ يَدُومُ بَقَاؤُهُ»([ccliii]).
تنزيه خالق النور
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء التوفيق ـ مخاطباً الحقّ تعالى ـ:
«سُبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ»([ccliv]).
يتبيّن من التسبيح الوارد في هذا الدعاء أنّ الله الخالق للنور منزّه عن كلّ عيب أو نقص.
روي عن الإمام الرضا× أنّه قال في أحد الأدعية ـ مخاطباً الحقّ جلّ وعلا ـ:
«سُبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ، سُبْحَانَ خَالِقِ الظُّلْمَةِ»([cclv]).
تنزيه الله في تسخير الأمور للإنسان
روى الطبراني بسنده عن أبي مجلز أنّه قال ـ حول ما شاهده وسمعه من الحسين بن علي÷ ـ:
«أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا رَكِبَ دَابَّةً فَقَالَ: (ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)، فَقَالَ لَهُ الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّG: وَبِهَذَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: فَكَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: تَقُولُ الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ عَلَيَّ بِمُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، فَهَذِهِ النِّعْمَةُ، فَقَالَ: تَبْدَأُ بِهَذَا لِقَوْلِهِ}: (ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)([cclvi])»([cclvii]).
حيث يستفاد من آية (ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) أنّ الله الذي سخر للإنسان كلّ أمور العالم منزّه عن العيوب والنقائص بأسرها.
تنزيه الإله الذي لا يخفى عليه شيء
ورد عن الإمام الحسين× أنّه قال:
«إِذَا صَاحَ العَقْعَقُ يَقُولُ: سُبْحَانَ مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ»([cclviii]).
فيفهم من هذا التسبيح أنّ الإله الذي لا تخفى عليه الأمور الخفيّة على الآخرين، منزّه عن جميع العيوب والنقائص.
روي عن الإمام الحسن× أنّه قال ـ في أحد الأدعية عن الله سبحانه ـ:
«سُبْحَانَ مَنْ هُوَ مُطَّلِعٌ عَلَى خَوَازِنِ القُلُوبِ، سُبْحَانَ مَنْ هُوَ مُحْصِي عَدَدِ الذُّنُوبِ، سُبْحَانَ مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، سُبْحَانَ المُطَّلِعِ عَلَى السَّرَائِرِ عَالِمِ الخَفِيَّاتِ، سُبْحَانَ مَنْ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، سُبْحَانَ مَنِ السَّرَائِرُ عِنْدَهُ عَلَانِيَةٌ، وَالبَوَاطِنُ عِنْدَهُ ظَوَاهِرُ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ»([cclix]).
تنزيه الله المذلّ للجبّارين
روي عن الإمام الحسين× أنّه قال:
«إِذَا صَاحَ الجَمَلُ يَقُولُ: سُبْحَانَ مُذِلِّ الجَبَّارِينَ سُبْحَانَهُ»([cclx]).
يستفاد من هذا التسبيح أنّ الله المذلّ للجبّارين منزّه عن أيّ عيب أو نقص.
روي عن رسول الله| قوله في دعاء المجير ـ مخاطباً الحقّ جلّ جلاله ـ:
«سُبْحَانَكَ يَا مُعِزُّ، تَعَالَيْتَ يَا مُذِلُّ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ»([cclxi]).
تنزيه الله في ربوبيّته
ورد عن الإمام الحسين× أنّه قال:
«إِذَا صَهَلَ الفَرَسُ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّنَا سُبْحَانَهُ»([cclxii]).
يتحصّل من إضافة (سبحان) إلى ربّ أنّ الله تعالى منزّه ومبرّأ في ربوبيّته عن أيّ عيب أو نقص يفترض. يقول الله تعالى:
(ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ)([cclxiii]).
تنزيه الله في العزّة الناشئة عن القدرة
ورد عن الإمام الحسين× أنّه قال:
«إِذَا صَاحَ النَّمِرُ يَقُولُ: سُبْحَانَ مَنْ تَعَزَّزَ بِالقُدْرَةِ سُبْحَانَهُ»([cclxiv]).
يستنتج من هذا التسبيح تنزيه الله العزيز بقدرته عن كلّ عيب أو نقص.
روي عن رسول الله| أنّه قال في أحد الأدعية ـ مخاطباً الحقّ سبحانه ـ:
«سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللهُ العَزِيزُ المُهَيْمِنُ»([cclxv]).
تنزيه الله عن وصف الناس له
نقل ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال ـ عن الله جلّ جلاله ـ:
«يُصِيبُ الفِكْرُ مِنْهُ الإِيمَانَ بِهِ مَوْجُوداً، وَوُجُودَ الإِيمَانِ لَا وُجُودَ صِفَةٍ، بِهِ تُوصَفُ الصِّفَاتُ لَا بِهَا يُوصَفُ، وَبِهِ تُعْرَفُ المَعَارِفُ لَا بِهَا يُعْرَفُ، فَذَلِكَ اللهُ لَا سَمِيَّ لَهُ، سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ»([cclxvi]).
من التسبيح الذي أورده الإمام× في آخر هذا الحديث يتحصّل أنّ الله تعالى منزّه عن وصف عامّة الناس؛ إذ ليس منهم من لديه معرفة بكنه الذات والأسماء والصفات والأفعال الإلهيّة حتى يتمكّن من وصفه.
يقول الله تعالى:
(ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﯕﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)([cclxvii]).
|
|
|
|
ـ3ـ النظير
|
|
|
|
عدم النظير لله في كلام الإمام الحسين×
عدم النظير للقدرة الإلهيّة
ورد عن الإمام الحسين× قوله عن الله تعالى في دعاء التسبيح:
«وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ قُدْرَتَهُ»([cclxviii]).
إذا قُرئت «لا يقدر» بدون تشديد كانت بمعنى عدم النظير للقدرة الإلهيّة، فلا أحد ـ حتى الأولياء ـ لديه قدرة تضاهي قدرته. وإذا قُرئت بالتشديد تكون بمعنى لا نهاية للقدرة الإلهيّة وعدم حدّها، فلا أحد يمكنه تقديرها ولا إحصاءها.
روي عن أمير المؤمنين× أنّه قال:
«كُلُّ قَادِرٍ غَيْرَهُ يَقْدِرُ وَيَعْجَزُ»([cclxix]).
|
|
|
|
4ـ الشبيه
|
|
|
|
مقدّمة
من الممكن استفادة نفي التشبيه بين الخالق والمخلوق من الأدلّة العقليّة والنقليّة:
أ) الدليل العقلي
قال العلّامة الحلّي:
«العقل والسمع تطابقا على عدم ما يشبهه تعالى، فيكون مخالفاً لجميع الأشياء بنفس حقيقته»([cclxx]).
وقال البيهقي في كتاب الاعتقاد:
«ثمّ يعلم أنّ صانع العالم لا يشبه شيئاً من العالم؛ لأنّه لو أشبه شيئاً من المحدثات بجهة من الجهات لأشبهه في الحدوث من تلك الجهة، ومحال أن يكون القديم محدثاً، أو يكون قديماً من جهة حديثاً من جهة»([cclxxi]).
ب) الدليل القرآني
قال الله تعالى:
(ﭡ ﭢ ﭣ)([cclxxii]).
وعن كيفيّة دلالة الآية على نفي أيّ نوع من المشابهة بين الخلق والخالق، فإنّ اجتماع أداتي التشبيه (الكاف) و(مثل) جاءت في سياق النفي المفيد لنفي أدنى وأقلّ تشابه؛ لأنّه متى ما حذفت أداتي التشبيه دلّت الجملة على التأكيد.
ولأنّه عندما يصير التأكيد بأكثر من أداة يضعف وجه الشبه؛ مثل قولنا: (زيد كمثل الأسد) الدال على اتصاف زيد بالشجاعة بنسبة أقل من قولنا (زيد كالأسد).
وبخصوص الآية أعلاه ففي الصورة التي تكون أداة التشبيه (الكاف) هي الزائدة فيها، فإنّها ستدلّ على نفي المماثلة، وإذا كانت (مثل) هي الزائدة، فإنّها ستنفي المشابهة، وفيما لو ثبت كلاهما دلّت الآية على نفي المشابهة والمماثلة معاً، ولأنّ الله تعالى أراد نفي المشابهة والمماثلة عنه قال: (ﭡ ﭢ ﭣ) فدلّت على المبالغة التامّة في نفي الاشتراك بين الخلق والخالق ولو بنحو بعيد.
ومن جانب آخر فإنّ كلمة (شيء) جاءت نكرة، وإن جاءت النكرة في سياق النفي أفادت العموم؛ ولذا فإنّ الآية موضع البحث تنفي جميع وجوه الشبه بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات والأفعال.
مضافاً إلى أنّ كلمة (مثل) من الألفاظ العامة الموضوعة للمشابهة، كما أشار إليه الفيروزآبادي في كتاب (بصائر ذوي التمييز) حيث قال بخصوص لفظ (مثل):
«وهو أعمّ الألفاظ الموضوعة للمشابهة؛ وذلك أنّ الند يقال فيما يشاركه في الجوهريّة فقط، والشكل يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة، والشبه يقال فيما يشاركه في الكيفيّة فقط، والمساوي يقال فيما يشاركه في الكمّية فقط، والمثل عام في جميع ذلك، ولهذا لما أراد الله نفى التشبيه من كلّ وجه خصّه بالذكر، فقال تعالى: (ﭡ ﭢ ﭣ)»([cclxxiii]).
ج) الدليل الروائي
روي عن رسول الله’ أنّ الله تعالى قال:
«مَا عَرَفَنِي مَنْ شَبَّهَنِي بِخَلْقِي»([cclxxiv]).
وعن أمير المؤمنين× أنّه قال:
«مَنْ وَحَّدَ اللهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يُشَبِّهْهُ بِالخَلْقِ»([cclxxv]).
وقال أيضاً:
«فَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ شَبَّهَكَ بِتَبَايُنِ أَعْضَاءِ خَلْقِكَ وَتَلَاحُمِ حِقَاقِ مَفَاصِلِهِمُ المُحْتَجِبَةِ لِتَدْبِيرِ حِكْمَتِكَ لَمْ يَعْقِدْ غَيْبَ ضَمِيرِهِ عَلَى مَعْرِفَتِكَ، وَلَمْ يُبَاشِرْ قَلْبَهُ اليَقِينُ بِأَنَّهُ لَا نِدَّ لَكَ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ تَبَرُّؤَ التَّابِعِينَ مِنَ المَتْبُوعِينَ إِذْ يَقُولُونَ: (ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﯕﮤ ﮥ ﮦ ﮧ)([cclxxvi])»([cclxxvii]).
الوهابيّة والاعتقاد بالتشبيه
يستنتج من كلام الوهابيّة وتصريحاتهم اعتقادهم بمشابهة صفات الله تعالى لصفات المخلوقات بما هو أكثر من التشابه اللفظي، وهو ما أبطله نصّ الآيات والروايات وحكم العقل.
وقال ابن تيمية في كتاب (بيان تلبيس الجهميّة):
«فمن أثبت لله سبحانه وتعالى أمراً من الصفات فإنّما أثبته بعد أن فهم نظير ذلك من الموجودات، وأثبت به القدر المطلق مع وصفه له بخاصّة تمتنع فيها الشركة»([cclxxviii]).
يدلّ كلام ابن تيمية على إثبات التشابه في حقيقة الصفات بين الخالق والمخلوق مع وجود الاختلاف بينهما في الكيفيّات، وكأنّما يرى أنّ التشبيه المذموم هو تشبيه الكيفيّة بالكيفيّة، بينما لا يعلم أنّ التشابه والاشتراك في الحقيقة وأصل المعنى أوضح وأهمّ من التشابه والاشتراك في الكيفيّة؛ ولهذا نُفي التشابه في الحقيقة وأصل المعنى بقوله تعالى (ﭡ ﭢ ﭣ) بصورة قطعيّة.
ووقع ـ أيضاً ـ بهذا المحذور من علماء الوهابيّة الشيخ صالح آل الشيخ تبعاً لابن تيمية، حيث قال في (شرح العقيدة الطحاوية):
«فإذاً إذا قيل لا نُشَبِّه فلا يندرج في ذلك إثبات أصل المعنى، يعني التشابه في المعنى، لأنّه لا يستقيم إثبات الصفات إلّا بمشابَهَةٍ في المعنى، ولكن ليس مُشَابَهَة في كلّ المعنى، ولا في الكيفيّة؛ لأنّ هذا تمثيل. فلهذا لا يُطلق النفي للتشبيه، لا نقول التشبيه منتفياً مطلقاً، كما يقوله من لا يحسن، بل يقال التمثيل منتفٍ مطلقاً، أمّا التشبيه فنقول: التشبيه منتف؛ فالله لا يماثله شيء ولا يشابهه شيء، وينصرف هذا النفي للتشبيه في الكيفيّة أو في تمام المعنى في كماله»([cclxxix]).
عدم
الشبيه لله في كلام الإمام الحسين×
|
|
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال:
«أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا هَؤُلَاءِ المَارِقَةَ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ اللهَ بِأَنْفُسِهِمْ، يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، بَلْ هُوَ اللهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ، لا تُدْرِكُهُ الأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصارَ، وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ»([cclxxx]).
إذ يتحصّل من كلام الإمام× أنّ بعض الأفراد يشبّهون الله الخالق بمخلوقاته، وبعملهم هذا يخرجون عن الدين.
قال القاضي سعيد القمّي في شرحه لهذا الحديث:
«كذلك المشبّهة خرجوا من الدين وأخرجوا رقابهم عن ربقة المسلمين.
ثمّ إنّ المشبّهة طوائف:
إحداها المجسّمة، منهم الحنابلة، حيث زعموا الله على صورة أمرد، وخرافاتهم في ذلك أكثر من أن تحدّ.
والثانية من ذهب إلى أنّه تعالى جسم صمديّ نوريّ.
والثالثة من ذهب إلى أنّه صورة، يترجم عنها بالفارسيّة (پيكر).
والرابعة من قال بزيادة الصفات سواء قامت بذواتها أو بالذّات.
والخامسة من حسب أنّ في آدم أو بني آدم جزء من الألوهيّة أو سنخاً منها.
السادسة من زعم من المتصوّفة أنّه تعالى هو الوجود المطلق المنبسط على هياكل الماهيات. ومن زعم منهم أنّه الوجود بشرط لا واللّابشرط، أمره الفائض على الكلّ وبشرط شيء معلولاته، وكذا من زعم عكس ذلك في الأولين.
السابعة من اعتقد أنّه الوجود الحقّ الحقيقيّ الغير المتناهي في الشدّة، وأنّ وجودات الممكنات مراتب حقيقة الوجود من الأشدّ فالأشدّ إلى ما لا أضعف منه.
الثامنة من ذهب إلى عينيّة الصّفات بأيّ معنى اعتقده، مع اشتراكها لصفات الخلق في المعنى.
التاسعة من تخلّص عن ذلك، لكن زعم اجتماع تلك المعاني المخالفة لصفات الخلق في ذاته تعالى، سواء كان بطريق العينيّة أو الزّيادة. وهذا، وأكثر ما سبق عليه من نظائره من القول بالمعاني المتّفق عليه امتناعه على الله تعالى، والمجمع عليه على استحالته. وإن تصفّحت المذاهب والآراء وجدت تحت واحدة من هذه التسعة مع عدم حصر المذاهب في ذلك، ولذا قال تبارك وتعالى: (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)([cclxxxi]) أعاذنا الله من أنحاء الشرك وأنواعه»([cclxxxii]).
ويقول في تتمّة ذلك:
«ثمّ أنّه× أبطل كافّة أقاويل المشبّهين بدليل عامّ، وبعد ذلك يكرّ على كلّ واحد من تلك الآراء الباطلة على ما هو طريق المحاجّة وسبيل الهداية»([cclxxxiii]).
|
|
|
|
5ـ البنوة
|
|
|
|
مقدّمة
المسيحيّون والاعتقاد ببنوّة عيسى لله
كثيراً ما يرد استعمال (ابن الله) في كلمات المسيحيين، وهذا التعبير مأخوذ من الأناجيل، فقد ورد في:
1ـ إنجيل مرقس (فصل 14، الآية 61 و 62):
«فسأله رئيس الكهنة أيضاً، وقال له: أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع: (أنا هو...)».
2ـ إنجيل متّى (فصل 3، الآية 17):
«وصوت من السماوات قائلاً: (هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت)».
3ـ إنجيل لوقا (فصل 1، الآية 30ـ35):
«فقال لها الملاك: (لا تخافي ـ يا مريم ـ لأنّك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمّينه يسوع، هذا يكون عظيماً، وابن العلي يدعى، ويعطيه الربّ الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية)، فقالت مريم للملاك: (كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلاً؟) فأجاب الملاك وقال لها: (الروح القدس يحلّ عليك، وقوّة العلي تظلّلك، فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن الله...)».
4ـ إنجيل يوحنّا (فصل 1، آية 32ـ34):
«وشهد يوحنا قائلاً: (... وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله)».
يقول العلّامة الطباطبائي:
«فالمسيحيّون مع وجود الاختلاف الكبير في دينهم، قد انقسموا في قضيّة البنوّة (بنوّة المسيح) إلى ثلاثة أقسام:
الأوّل: مذهب المَلْكانيّة، الذين يقولون بأنّ عيسى ابن حقيقيّ لله.
الثاني: مذهب النَّسْطوريّة، الذين يقولون إنّ بنوّة عيسى لله كإشراق النور على الجسم الشفاف (مثل البلور)، وهذا في الواقع القول بالحلول.
الثالث: مذهب اليعقوبيّة، وهم يقولون بالانقلاب، أي أنّ الله المعبود المجرّد قد انقلب إلى عيسى ذي اللحم والدم»([cclxxxiv]).
من جانب آخر، سيلاحظ كلّ من يطالع العهد الجديد، التأكيد الكثير من قبل المسيح× على بنوّته للإنسان.
فجاء في إنجيل متّى (فصل 24، الآية 30):
«وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض، ويبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوّة ومجد كثير...».
فيدرك الإنسان من خلال هذا التأكيد الشديد من قبل عيسى× أنّه كان بصدد توجيه الناس وإعلامهم بجنبته البشريّة والإنسانيّة حتى لا يدّعي أحد ألوهيّته؛ فكيف لبعض التعبيرات أن تجعلهم يغضّون الطرف عن بنوّته للإنسان، خصوصاً مع إمكان تبريرها وتوجيهها بأنّه لشدّة ارتباطه بالله سبحانه وتعالى جاء التعبير عنه بابن الله، كما هو الحال فيما ورد عن النبي| بخصوص سلمان، حيث قال بشأنه:
«سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ البَيْتِ»([cclxxxv]).
وفي تبرير آخر يمكن القول: إنّ أرباب الكنائس أبدعوا هذا التعبير للمسيح×، وأقحموه في الأناجيل؛ تكميلاً لفصول الاعتقاد بالصلب والفداء وعقيدة التثليث.
القرآن ونفي الابن عن الله
لقد أبطل القرآن الكريم أن يكون لله تعالى ابناً بطرق متنوّعة، مثل:
أ) الآيات التي تدلّ على نفي أن يكون لله ابناً بشكل مطلق، وهي عبارة عن:
قول الله تعالى:
(ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ)([cclxxxvi]).
و قوله أيضاً:
(ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ)([cclxxxvii]).
ب) نسبة هذه العقيدة في بعض الآيات لليهود والنصارى وعبدة الأصنام، حيث يقول:
(ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ)([cclxxxviii]).
ج) الإشارة إلى حياة المسيح، وبيان ولادته البشريّة وتفاصيلها بصورة كاملة.
عندما اعتمد النصارى في قولهم ببنوّة المسيح لله، واستدلّوا على ذلك بولادته من غير أب، ردّ عليهم الحقّ تعالى استدلالهم هذا بذكر قصّة خلق آدم× دون والدين، حيث قال:
(ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ)([cclxxxix]).
إنّ مسألة التوجيه ـ أيضاً ـ لا يمكنها رفع المشكلة الأساسيّة من الأوساط الاجتماعيّة؛ لأنّ العلماء حتى لو تمكّنوا من إقناع أنفسهم بتبريراتهم حول إطلاق البنوّة لله على المسيح، ولكن عامّة الناس يحملون هذه الكلمات على معناها الحقيقي، ويغرقون أنفسهم بالشرك والكفر. لهذا ورد في القرآن الكريم في الآية 30 من سورة التوبة ذمّ هكذا تعبيرات بصورة عامّة، حيث قال:
(ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ).
د) إقامة البرهان في بعض الآيات على عدم وجود ولد لله تعالى:
فقال الله سبحانه:
(ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ)([ccxc]).
وقال العلّامة الطباطبائي في تفسير هاتين الآيتين:
«قوله تعالى: (ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ) يعطي السياق، أنّ المراد بالقائلين بهذه المقالة هم اليهود والنصارى: إذ قالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله، فإنّ وجه الكلام مع أهل الكتاب.
وإنّما قال أهل الكتاب هذه الكلمة أعني قولهم: اتخذ الله ولداً، أوّل ما قالوها تشريفاً لأنبيائهم كما قالوا: نحن أبناء الله وأحبّاؤه، ثمّ تلبّست بلباس الجدّ والحقيقة، فردّ الله سبحانه عليهم في هاتين الآيتين، فأضرب عن قولهم بقوله: (ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) إلخ، ويشتمل على برهانين ينفي كلّ منهما الولادة وتحقق الولد منه سبحانه، فإنّ اتخاذ الولد هو أن يجزي موجود طبيعي بعض أجزاء وجوده، ويفصله عن نفسه فيصيره بتربية تدريجية فرداً من نوعه مماثلاً لنفسه، وهو سبحانه منزّه عن المثل، بل كلّ شيء مما في السموات والأرض مملوك له، قائم الذات به، قانت ذليل عنده ذلّة وجوديّة، فكيف يكون شيء من الأشياء ولداً له مماثلاً نوعيّاً بالنسبة إليه؟ وهو سبحانه بديع السموات والأرض، إنّما يخلق ما يخلق على غير مثال سابق، فلا يشبه شيء من خلقه خلقاً سابقاً، ولا يشبه فعله فعل غيره في التقليد والتشبيه ولا في التدريج، والتوصل بالأسباب، إذا قضى أمراً فإنّما يقول له كن فيكون، من غير مثال سابق ولا تدريج، فكيف يمكن أن ينسب إليه اتخاذ الولد؟ وتحققه يحتاج إلى تربية وتدريج، فقوله: (ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ) برهان تام، وقوله: (ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ) برهان آخر تام»([ccxci]).
وقال تعالى أيضاً:
(ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)([ccxcii]).
وجاء عن العلّامة الطباطبائي في تفسيره لهذه الآية:
«قوله تعالى: (ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) احتجاج على نفي قولهم: إنّ الله اتخذ ولداً، وقول بعضهم: الملائكة بنات الله. والقول بالولد دائر بين عامّة الوثنيّة على اختلاف مذاهبهم، وقد قالت النصارى: المسيح ابن الله، وقالت اليهود على ما حكاه القرآن عنهم: عزير ابن الله، وكأنّها بنوّة تشريفيّة.
والبنوّة كيفما كانت تقتضي شركة ما بين الابن والأب والولد والوالد، فإن كانت بنوّة حقيقيّة وهي اشتقاق شيء من شيء وانفصاله منه، اقتضت الشركة في حقيقة الذات والخواص والآثار المنبعثة من الذات كبنوّة إنسان لإنسان المقتضية لشركة الابن لأبيه في الإنسانيّة ولوازمها، وإن كانت بنوّة اعتباريّة كالبنوّة الاجتماعيّة وهو التبنّي، اقتضت الاشتراك في الشئونات الخاصّة بالأب كالسؤدد والملك والشرف والتقدّم والوراثة وبعض أحكام النسب، والحجّة المسوقة في الآية تدلّ على استحالة اتخاذ الولد عليه تعالى بكلا المعنيين.
فقوله: (ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) شرط صدر بلو، الدالّ على الامتناع للامتناع، وقوله: (ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) أي لاختار لذلك مما يخلق ما يتعلّق به مشيئته، على ما يفيده السياق، وكونه مما يخلق لكون ما عداه سبحانه خلقاً له.
وقوله: (ﯗ) تنزيه له سبحانه، وقوله: (ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) بيان لاستحالة الشرط، وهو إرادة اتخاذ الولد ليترتّب عليه استحالة الجزاء، وهو اصطفاء ما يشاء مما يخلق، وذلك لأنّه سبحانه واحد في ذاته المتعالية لا يشاركه فيها شيء ولا يماثله فيها أحد لأدلّة التوحيد، وواحد في صفاته الذاتيّة التي هي عين ذاته كالحياة والعلم والقدرة، وواحد في شئونه التي هي من لوازم ذاته كالخلق والملك والعزّة والكبرياء، لا يشاركه فيها أحد.
وهو سبحانه قهار يقهر كلّ شيء بذاته وصفاته، فلا يستقلّ قبال ذاته ووجوده شيء في ذاته ووجوده، ولا يستغني عنه شيء في صفاته وآثار وجوده، فالكلّ أذلّاء داخرون بالنسبة إليه، مملوكون له، فقراء إليه.
فمحصّل حجّة الآية: قياس استثنائي ساذج يستثني فيه نقيض المقدّم لينتج نقيض التالي، وهو نحو من قولنا: لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى لذلك بعض من يشاء من خلقه، لكن إرادته اتخاذ الولد ممتنعة؛ لكونه واحداً قهّاراً، فاصطفاؤه لذلك بعض من يشاء من خلقه ممتنع»([ccxciii]).
ﻫ) الإشارة في بعض الآيات إلى برهان رفض الاعتقاد باتخاذ الله ولداً:
فقال الله تعالى:
(ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﯕﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)([ccxciv]).
|
|
عدم
الولد لله في كلام الإمام الحسين×
|
|
ليس لله تعالى ولد
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة:
«سُبْحَانَ اللهِ الوَاحِدِ الأَحَدِ الصَّمَدِ، الَّذِي (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﯕﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)»([ccxcv]).
حيث يتحصّل من استشهاده× بجملة (ﭙ ﭚ) في الآية الشريفة أنّ الله تعالى ليس له ولد.
و روي أيضاً عن الإمام الحسين× قوله في إجابة كتاب البصريين الذين سألوه فيه عن معنى (ﭙ ﭚ):
«(ﭙ ﭚ): لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيفٌ؛ كَالوَلَدِ وَسَائِرِ الأَشْيَاءِ الكَثِيفَةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ المَخْلُوقِينَ، وَلَا شَيْءٌ لَطِيفٌ كَالنَّفْسِ، وَلَا يَتَشَعَّبُ مِنْهُ البَدَوَاتُ كَالسِّنَةِ وَالنَّوْمِ، وَالخَطْرَةِ وَالهَمِّ، وَالحَزَنِ وَالبَهْجَةِ، وَالضَّحِكِ وَالبُكَاءِ، وَالخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، وَالرَّغْبَةِ وَالسَّأْمَةِ، وَالجُوعِ وَالشِّبَعِ؛ تَعَالَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَتَوَلَّدَ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيفٌ أَوْ لَطِيفٌ»([ccxcvi]).
من الواضح دلالة هذا الكلام على أنّ الله تبارك وتعالى ليس له ولد.
وروي عن الإمام الصادق× أنّه قال:
«(ﭙ ﭚ) لِأَنَّ الوَلَدَ يُشْبِهُ أَبَاهُ، (ﭛ ﭜ) فَيُشْبِهَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، (ﭞ ﭟ ﭠ) مِنْ خَلْقِهِ (ﭡ ﭢ)، تَعَالَى عَنْ صِفَةِ مَنْ سِوَاهُ عُلُوّاً كَبِيراً»([ccxcvii]).
قال القاضي سعيد القمّي:
«يجب أن تكون متذكّراً ـ وإن كان ذلك عندك متكرّراً ـ أنّ المعاني السابقة للصمد اشتركت في أنّه لا يشذّ عنه تعالى مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء، وأنّ معنى (ﭙ ﭚ) حسبما فسّره× أفاد أنّه ليست الأشياء خبايا في زوايا الهويّة الأحديّة، أو خفايا في مكامن غيب الألوهيّة، فيخرج منها ويظهر في عالم الشهود ويلبس لباس الوجود؛ وبالجملة، ليس الأمر بأن يكون هو ـ جلّ مجده ـ مظهراً للأشياء، ومحلّاً لظهوراتها، حتى يكون الظاهر والمظهر معروضاً للأثنوّة ومحلّاً لحوادث الكثرة. ثمّ هاهنا أراد ـ صلوات الله عليه ـ أن يبطل كون الأشياء مظاهر له ومواد شهود نوره تعالى ومراكز لظهوره عزّ وعلا، ويلزم من ذلك استحالة أن تكون له سبحانه علّة، أو تحمل وجوده قوّة، وبذلك حصحص الحقّ عن محضه، وخلص له التوحيد الذي استأثره الله لنفسه، وبيّنه في سورة التوحيد للعالمين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقد مضى بيان الحكمين الأوّلين فيما يليق من الشرح»([ccxcviii]).
عدم تبنّي الله تعالى للولد
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة:
«الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً»([ccxcix]).
إذ يستفاد من كلمة (اتخاذ): أنّ الله سبحانه كما أنّه لم يلد ولم يولد ولم يكن له مولود عن طريق النكاح، كذلك لم يتخذ له من الآخرين ولداً، أي لم يكن له ولد حتى بالتبنّي.
يقول عزّ من قائل:
(ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ)([ccc]).
حسن الثناء على الله لعدم اتخاذه ولداً
روي عن الإمام الحسين× أنّه قال في دعاء عرفة:
«وَأَقُولُ مُؤْمِناً مُوقِناً: الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً فَيَكُونَ مَوْرُوثاً»([ccci]).
يستفاد من كلام الإمام بخصوص هذه الصفة السلبيّة أنّ الله تعالى مستحقّ للحمد والثناء لهذا النوع من الصفات أيضاً، والتي من جملتها ليس له ولد؛ للزوم المحال من ضدّه وهو أنّ له ولد.
وتوضيح ذلك: إن كان لله تعالى ولد فلا محالة يكون موجوداً، والموجود لا يخلو من أحد أمرين: إمّا واجب أو ممكن، ولا شق ثالث لهما، فإذا كان ممكناً لزم ولادة وإنجاب الممكن من الواجب، وهذا محال؛ لأنّ نسبة الممكن إلى الوجود والعدم متساوية، وإن كان واجب الوجود، فلا تلائم ولا انسجام بين أن يكون كذلك وأن يكون ابناً وحادثاً.
كما يستفاد من هذا الإقرار من قبل الإمام×، شهادته واعترافه× بلسانه بالصفات السلبيّة، والتي من جملتها لزوم خلو الله تعالى من الولد.
يقول الله تعالى:
(ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ)([cccii]).
شدّة الغضب الإلهي من عقيدة أهل الكتاب
روي عن الإمام الحسين× أنّه بعد مناشدته لجيش عمر بن سعد، قال:
«اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى اليَهُودِ حِينَ قَالُوا: عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى النَّصَارَى حِينَ قَالُوا: المَسِيحُ ابْنُ اللهِ، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى المَجُوسِ حِينَ عَبَدُوا النَّارَ مِنْ دُونِ اللهِ، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ قَتَلُوا نَبِيَّهُمْ، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى هَذِهِ العِصَابَةِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ قَتْلَ ابْنِ نَبِيِّهِمْ»([ccciii]).
فيتحصّل من هذا الكلام شدّة غضب الله تعالى على أولئك الذين قالوا إنّ لله ولداً.
يقول}:
(ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ)([ccciv]).
|
|
|
|
6ـ الولادة
|
|
|
|
عدم ولادة الله في كلام الإمام الحسين×
الله الذي لم يولد
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة:
«سُبْحَانَ اللهِ الوَاحِدِ الأَحَدِ الصَّمَدِ، الَّذِي (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﯕﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)»([cccv]).
وحول تفسير هاتين الآيتين، قال العلّامة الطباطبائي:
«الآيتان الكريمتان تنفيان عنه تعالى أن يلد شيئاً بتجزيه في نفسه...
وتنفيان عنه أن يكون متولّداً من شيء آخر ومشتقّاً منه بأيّ معنى أريد من الاشتقاق كما يقول الوثنيّة، ففي آلهتهم من هو إله أبو إله، ومن هو آلهة أم إله، ومن هو إله ابن إله»([cccvi]).
وفي التتمة قال:
«وأمّا كونه لم يولد فإنّ تولّد شيء من شيء لا يتمّ إلّا مع حاجة من المتولّد إلى ما ولد منه في وجوده، وهو سبحانه صمد لا حاجة له»([cccvii]).
روي عن أمير المؤمنين× أنّه قال:
«(ﭙ ﭚ) فَيَكُونَ مَوْلُوداً، (ﭛ ﭜ) فَيَصِيرَ مَحْدُوداً، جَلَّ عَنِ اتِّخَاذِ الأَبْنَاءِ، وَطَهُرَ عَنْ مُلَامَسَةِ النِّسَاءِ»([cccviii]).
عدم ولادة الله من موجود آخر
ورد عن الإمام الحسين× في إجابته على كتاب البصريين حينما سألوه عن معنى (ﭛ ﭜ) قال:
«(ﭛ ﭜ) لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنْ شَيْءٍ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ شَيْءٍ، كَمَا يَخْرُجُ الأَشْيَاءُ الكَثِيفَةُ مِنْ عَنَاصِرِهَا؛ كَالشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ، وَالدَّابَّةِ مِنَ الدَّابَّةِ، وَالنَّبَاتِ مِنَ الأَرْضِ، وَالمَاءِ مِنَ اليَنَابِيعِ، وَالثِّمَارِ مِنَ الأَشْجَارِ، وَلَا كَمَا يَخْرُجُ الأَشْيَاءُ اللَّطِيفَةُ مِنْ مَرَاكِزِهَا؛ كَالبَصَرِ مِنَ العَيْنِ، وَالسَّمْعِ مِنَ الأُذُنِ، وَالشَّمِّ مِنَ الأَنْفِ، وَالذَّوْقِ مِنَ الفَمِ، وَالكَلَامِ مِنَ اللِّسَانِ، وَالمَعْرِفَةِ وَالتَّمَيُّزِ مِنَ القَلْبِ، وَكَالنَّارِ مِنَ الحَجَرِ»([cccix]).
إذ يستفاد من هذا الكلام أنّه تعالى لم يولد ولم يخلق ولم يخرج من موجود آخر.
فقد روي عن أمير المؤمنين× أنّه قال:
«لَمْ يُولَدْ سُبْحَانَهُ فَيَكُونَ فِي العِزِّ مُشَارَكاً، وَلَمْ يَلِدْ فَيَكُونَ مَوْرُوثاً هَالِكاً»([cccx]).
وقال القاضي سعيد القمّي في شرحه لحديث الإمام الحسين×:
«... وأمّا بيان الحكم الثالث المتعلّق بشرح هذا العنوان، فبأن تعلم أنّ الخارج من الشيء الظاهر منه: إمّا أن يكون من الأوّل شيء في الثاني، أو لا يكون منه فيه شيء، وبالحري أن يسمّى الأوّل (عنصراً) بمعنى ما فيه قوّة وجود الشيء؛ والثاني (مراكز) بمعنى ما يدور عليه وجود الشيء كما فعله الإمام×، وهذا يشمل جميع ماله مدخل في وجود الشيء وظهوره. فالعنصر: إمّا أن يكون بوحدانيّة في الشيء، أو بشركة غيره، والذي يكون بالشركة: إمّا أن يكون هو نفسه في ذلك الشيء الكائن منه، أو لا يكون هو فيه، بل شيء منه فيه، ومع ذلك يكون معدّاً، إذ لا معنى لكون شيء من شيء مع عدم الإعداد؛ فالذي هو في الشيء مع الشركة: إمّا أن يكون هاهنا تركيب من اجتماع فقط، سواء كان مع ذلك ضرب من الاستحالة كالمعجون، أو لا كالسرير من الخشب والبيت من اللبنات والشكل من المقدّمات، أو مع فوات أمر من المجتمعات، فإمّا فوات أمر من جوهرها كما للممتزجات عندنا حيث يخلع كلّ صورته ويلبس المجتمع صورة وحدانيّة، خلافاً لرئيس مشائيّة الإسلام؛ وإمّا فوات أمر غير جوهرها كالتركيبات الحاصلة من الاستحالة إن كان يمكن ذلك.
وأمّا الذي منه شيء في الشيء الحاصل منه: فإمّا مع إعداد فاعلي، وذلك ككون الدابّة من الدابّة، فإنّ في الثاني شيئاً من الأوّل وهو المني مع شركة غيره من الغذاء المنمي، وإمّا مع إعداد قابلي، وذلك ككون النبات من الأرض، فإنّ في النبات شيئاً من الأرض مع شركة غيرها من الماء والبذر؛ وإمّا مع إعداد غائي بأن يكون الثاني غاية لوجود الأوّل، وذلك ككون الثمر من الشجر، أو إعداد صوري بأن يكون الثاني صورة للأوّل، ككون الماء من الينابيع حيث يكون فيه جزء من المنبع وهو الأرض، مع بعض العناصر وينقلب الكلّ إلى الماء؛ وأمّا الذي يكون منه الشيء بوحدانيّته، وهو الذي عبّر عنه الإمام× بقوله: «كالشيء من الشيء»: فإمّا أن لا يحتاج في ما يكون منه إلّا إلى الخروج بالفعل، وإمّا أن يحتاج إلى شيء: إمّا زيادة شيء كحركة، أو فوات أمر من جوهره كالكون والفساد، أو غير جوهره كالاستحالة، والذي لا يحتاج: فإمّا أن يكون الأوّل مما يتقوّم بالثاني، وذلك ككون الصورة من المادّة، أو لا يتقوّم ككون العرض من الموضوع. وعندي: أنّ هذا الحصر أجود ما قيل في أقسام العنصر عند التدبّر.
وأمّا المختصّ باسم (المركز): فإمّا أن يكون منه الشيء ـ لست أعني أنّ منه كون الشيء فقد عرفت أنّه العنصر ـ بل منه نفس الشيء وهو الفاعل لماهيّة الشيء ومذوت الشيء، وإمّا أن يكون له وإليه الشيء وهو الغاية والقصد، وإمّا أن يكون فيه الشيء، فإمّا على سبيل الحلول وهو العرض، أو لا كذلك وهو المكان والزمان وأمثالهما، وإمّا أن يكون به الشيء، فإمّا على أنّه آلة، أو قوام، والقوام: إمّا أن يكون الشيء معه بالقوّة وقد سبق أنّه العنصر، أو بالفعل وهو الصورة.
إذا عرفت هذا، فتذكّر ما تلونا عليك من أنّه نفى× بقوله في تفسير لم يولد: (لم يخرج من شيء كما تخرج الأشياء الكثيفة من عناصرها)، أن يكون شيء من الأشياء مادّة لظهوره تعالى، ومحلّاً لشهود نوره ـ عزّ وعلا ـ وتكون هي كما يقوله الجاهلون مجالي ذاته ومرايا جماله. ونفى بقوله: (ولا كما تخرج الأشياء اللطيفة من مراكزها)، أن يكون شيء آلة أو سبباً أو واسطة لبروزه من مكامن غيب الهويّة أو وسيلة لظهوره من تحت أستار العزّة والعظمة إلى مشاهد عالم الشهادة ومشاعر القوى الحسيّة والعقليّة؛ وبالجملة، نفى× بهذا الكلام كون الموجودات مما يتوقّف عليها ظهوره سبحانه، أو يتفرّع عليها كماله، وأقلّ ذلك أن يكون للأشياء دخل في ذلك، وأقلّ الأقل أن يكون مما اتفق ظهوره بها وإن لم يكن أسباباً حقيقيّة كلّا وحاشاه من ذلك. وفي دعاء عرفة لسيد الشهداء: «ألغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك! متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدلّ عليك؟! ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟! عميت عين لا تراك ولا تزال عليها رقيباً» بل هو جلّ جلاله الظاهر بنفسه لنفسه في نفسه، وهذا بعينه هو كونه ظاهراً بآياته لعباده في مجاليه بناء على اتحاد الظهور والظاهر والمظهر من وجه يعرفه ويراه أهل البصيرة والبصر»([cccxi]).
عدم إيجاد الله من قبل أيّ موجود
روي عن الإمام الحسين× أنّه قال في جوابه لسؤال أهل البصرة عن معنى (الصمد):
«... لَا، بَلْ هُوَ (ﭖ ﭗ) الَّذِي لَا مِنْ شَيْءٍ، وَلَا فِي شَيْءٍ، وَلَا عَلَى شَيْءٍ، مُبْدِعُ الأَشْيَاءِ وَخَالِقُهَا، وَمُنْشِئُ الأَشْيَاءِ بِقُدْرَتِهِ، يَتَلَاشَى مَا خَلَقَ لِلْفَنَاءِ بِمَشِيَّتِهِ، وَيَبْقَى مَا خَلَقَ لِلْبَقَاءِ بِعِلْمِهِ، فَذَلِكُمُ (ﭖ ﭗ) الَّذِي (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)، (ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)، (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)»([cccxii]).
فيدلّ قوله «لَا مِنْ شَيْءٍ» أنّ الله تعالى لم يخلق من شيء باعتبار أنّ كلمة (من) هنا نشوية.
وبحسب التعبير العلمي: لا علّة فاعليّة لله تعالى، إذ المقصود من العلّة الفاعليّة هي ذلك الشيء الذي خلقت منه نفس حقيقة الموجود.
فقد روي عن الإمام الصادق× أنّه قال:
«(ﭙ ﭚ) لِأَنَّ الوَلَدَ يُشْبِهُ أَبَاهُ، (ﭛ ﭜ) فَيُشْبِهَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، (ﭞ ﭟ ﭠ) مِنْ خَلْقِهِ (ﭡ ﭢ)، تَعَالَى عَنْ صِفَةِ مَنْ سِوَاهُ عُلُوّاً كَبِيراً»([cccxiii]).
|
|
|
|
7ـ الولي
|
|
|
|
لا وليّ لله في كلام الإمام الحسين×
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة:
«الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً فَيَكُونَ مَوْرُوثاً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ فَيُضَادَّهُ فِيمَا ابْتَدَعَ، وَلَا وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ فَيُرْفِدَهُ فِيمَا صَنَعَ»([cccxiv]).
من خلال عطف عبارة «وَلَا وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ» على ما قبله يستفاد أنّ الله سبحانه لا وليّ له.
كما يستفاد العموم أيضاً من مجيء كلمة (ولي) نكرة في سياق النفي، وبالتالي فالمتحصّل هو أنّه لا يتصوّر لله سبحانه أيّ ولي.
يقول الله تبارك وتعالى:
(ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ)([cccxv]).
|
|
|
|
8ـ الضد
|
|
|
|
عدم الضدّ لله في كلام الإمام الحسين×
عدم الضدّ المنازع لله
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال واصفاً الحقّ سبحانه:
«لَا مُنَازِعَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ، وَلَا كُفْوَ لَهُ يُعَادِلُهُ، وَلَا ضِدَّ لَهُ يُنَازِعُهُ، وَلَا سَمِيَّ لَهُ يُشَابِهُهُ، وَلَا مِثْلَ لَهُ يُشَاكِلُهُ»([cccxvi]).
يتحصّل من مفهوم قوله «وَلَا ضِدَّ لَهُ يُنَازِعُهُ» عدم وجود الضدّ المنازع لله جلّ وعلا، أمّا غيره تعالى، فله أضداد وهو في نزاع معهم.
روي عن أمير المؤمنين× أنّه قال:
«فَلَيْسَ لَهُ فِيمَا خَلَقَ ضِدٌّ»([cccxvii]).
عدم الضدّ للقادر المطلق
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال عن الله سبحانه:
«لَيْسَ بِقَادِرٍ مَنْ قَارَنَهُ ضِدٌّ»([cccxviii]).
إذ يتحصّل من مضمون هذا الحديث أنّ الدليل على عدم الضدّ لله تعالى هو قدرته المطلقة.
قال أمير المؤمنين×:
«اسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ»([cccxix]).
قال القاضي سعيد القمّي:
«قوله×: (ليس بقادر من قارنه ضدّ أو ساواه ندّ) بيان لصفة قدرته تعالى، وهي القدرة المطلقة والاختيار المطلق. و(الضدّ) هنا المخالف. وقد جاء بمعنى المثل وهو من الأضداد»([cccxx]).
وقال أيضاً:
«و(القادر المطلق) هو الذي لا يعجزه شيء، ولا يخرج من قدرته شيء، ولا يعوقه شيء. ولا ريب أنّ الضدّ من شأنه أن يردّ الضدّ الآخر عن فعله، بل عن نفسه»([cccxxi]).
|
|
|
|
9 الوزير
|
|
|
|
عدم الوزير لله في كلام الإمام الحسين×
ورد عن الإمام الحسين× في دعاء عرفة:
«يَا مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا وَزِيرَ»([cccxxii]).
فبما أنّ النكرة في سياق النفي تفيد العموم، يستفاد من هذه الجملة أنّ الله ليس له أيّ وزير. قال العلّامة المصطفوي في شرحه لمادّة (وزر):
«إنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الثقل المحمول على شيء. ومن مصاديقه: الجبل الثقيل المحمول على الأرض، والإثم على رقبة الإنسان، والسلاح الثقيل الذى يحمله أهل الحرب، وما على عهدة الموازر للسلطان من إدارة أمور المملكة، والكارة المحمولة من لباس أو طعام، والغلبة التي أوجبت ثقلاً على المغلوب...، (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯕﯯ ﯰﯕﯲ ﯳ ﯴ)([cccxxiii]). أي من يحمل ثقالة إدارة الأمور ويشترك في تكليف أمر التبليغ وفي أداء وظائف الرسالة»([cccxxiv]).
وجاء في دعاء الجوشن الكبير:
«يَا مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا وَزِيرَ، يَا مَنْ لَا شَبِيهَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ»([cccxxv]).
|
|
|
|
10ـ الذلة
|
|
|
|
عدم ذلّة الله في كلام الإمام الحسين×
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة:
«الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً فَيَكُونَ مَوْرُوثاً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ فَيُضَادَّهُ فِيمَا ابْتَدَعَ، وَلَا وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ فَيُرْفِدَهُ فِيمَا صَنَعَ»([cccxxvi]).
فيستفاد من مضمون قوله «وَلَا وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ» أنّ الله ـ جلّ وعلا ـ ليس لأحد أن يذلّه أو يحتقره أو يزدريه.
قال الله تعالى:
(ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ)([cccxxvii]).
|
|
|
|
11ـ الرؤية
|
|
|
|
مقدّمة
بما أنّ موضوع رؤية الله تبارك وتعالى من المباحث المعقّدة ومحلّ خلاف بين المذاهب الإسلاميّة؛ لهذا وجدنا من الجدير بنا ـ قبل استعراضنا لكلام الإمام الحسين× في هذه المسألة ـ أن نذكر مجموعة من المقدّمات:
الكلمات المتشابهة بهذا الخصوص
ثمّة كلمات في موضوع بحثنا تتشابه في الظاهر مع بعضها، لكنّها تفترق عند إطلاقها على الله تعالى:
1ـ الرؤية
يستفاد من آيات القرآن امتناع رؤية الله تعالى بالعين على كلّ كائن وأينما كان؛ في هذه الدنيا أم الآخرة.
إذ يقول عزّ من قائل:
(ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ)([cccxxviii]).
نعم، يستفاد إمكان الرؤية القلبيّة والشهوديّة، مما ورد عن الإمام الباقر×، حيث قال:
«لَمْ تَرَهُ العُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الأَبْصَارِ، وَلَكِنْ رَأَتْهُ القُلُوبُ بِحَقَائِقِ الإِيمَانِ»([cccxxix]).
2ـ المشاهدة
يستفاد من روايات أهل البيت^ أنّ الله تعالى لا يمكن مشاهدته بهذه العيون، ولهذا نقل قول أمير المؤمنين×:
«لَا تُدْرِكُهُ العُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ العِيَانِ»([cccxxx]).
ولكن الشهود القلبي والوجداني ممكن.
3ـ اللقاء
تشير الكثير من الآيات إلى إمكانيّة لقاء الله سبحانه.
حيث يقول الله تعالى:
(ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ)([cccxxxi]).
4ـ النظر
يستفاد من الآيات والروايات إمكانية النظر إلى الله تعالى، بمعنى انتظار رحمته والاحساس والشهود الوجداني بالنسبة إليه.
يقول الله تعالى:
(ﭙ ﭚ ﭛﯕﭝ ﭞ ﭟ)([cccxxxii]).
وجاءت كلمة (نظر) بهذا المعنى في القرآن في قصّة النبي سليمان× وبلقيس، حيث قال تعالى:
(ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ)([cccxxxiii]).
ويقول أيضاً:
(ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)([cccxxxiv]).
5ـ الإدراك
يستفاد من آيات القرآن أنّ إدراك الله تعالى غير ممكن عن طريق البصر، حيث جاء التعبير القرآني بهذا النحو:
(ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)([cccxxxv]).
و هذا لأنّه تعالى منزّه عن الجسميّة ولوازمها.
6ـ الإبصار
كتب العلّامة الطباطبائي:
«ولا نشكّ ولن نشكّ أنّ الرؤية والإبصار يحتاج إلى عمل طبيعي في جهاز الأبصار، يهيّئ للباصر صورة مماثلة لصورة الجسم المبصر في شكله ولونه.
وبالجملة، هذا الذي نسمّيه الإبصار الطبيعي يحتاج إلى مادّة جسميّة في المبصر والباصر جميعاً، وهذا لا شكّ فيه.
والتعليم القرآني يعطي إعطاء ضرورياً أنّ الله تعالى لا يماثله شيء بوجه من الوجوه البتة، فليس بجسم ولا جسماني، ولا يحيط به مكان ولا زمان، ولا تحويه جهة، ولا توجد صورة مماثلة أو مشابهة له بوجه من الوجوه في خارج ولا ذهن البتة.
وما هذا شأنه لا يتعلّق به الإبصار بالمعنى الذي نجده من أنفسنا البتة، ولا تنطبق عليه صورة ذهنيّة لا في الدنيا ولا في الآخرة ضرورة، ولا أنّ موسى ذاك النبي العظيم أحد الخمسة أولي العزم وسادة الأنبياء^ ممن يليق بمقامه الرفيع وموقفه الخطير أن يجهل ذلك، ولا أن يمنّي نفسه بأنّ الله سبحانه أن يقوّي بصر الإنسان على أن يراه ويشاهده سبحانه منزّها عن وصمة الحركة والزمان، والجهة والمكان، وألواث المادّة الجسميّة وأعراضها، فإنّه قول أشبه بغير الجدّ منه بالجدّ، فما محصّل القول: أنّ من الجائز في قدرة الله أن يقوّي سبباً مادّياً أن يعلّق عمله الطبيعي المادّي ـ مع حفظ حقيقة السبب وهويّة أثره ـ بأمر هو خارج عن المادّة وآثارها، متعال عن القدر والنهاية؟ فهذا الإبصار الذي عندنا وهو خاصّة مادّية، من المستحيل أن يتعلّق بما لا أثر عنده من المادّة الجسميّة وخواصّها، فإن كان موسى يسأل الرؤية فإنّما سأل غير هذه الرؤية البصريّة، وبالملازمة ما ينفيه الله سبحانه في جوابه فإنّما ينفي غير هذه الرؤية البصريّة، فأمّا هي فبديهيّة الانتفاء، لم يتعلّق بها سؤال ولا جواب...»([cccxxxvi]).
العامّة والاعتقاد بالرؤية بالعين
قال أبو الحسن الأشعري:
«وندين بأنّ الله يُرى في الآخرة بالأبصار، كما يُرى القمر ليلة البدر»([cccxxxvii]).
وقال الطحاوي:
«والرؤية حقّ لأهل الجنّة، بغير إحاطة ولا كيفيّة، كما نطق به كتاب ربّنا: (ﭙ ﭚ ﭛﯕﭝ ﭞ ﭟ)([cccxxxviii])، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه»([cccxxxix]).
وقال الشيخ صالح بن فوزان:
«فإنّ المؤمنين يرون ربّهم سبحانه وتعالى في الآخرة، يرونه عياناً بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحواً ليس دونها سحاب»([cccxl]).
ومثلهم قال محمد ناصرالدين الألباني:
«ومن قال: يرى لا في جهة، فليراجع عقله، فإمّا أن يكون مكابراً لعقله أو في عقله شيء، وإلّا فإذا قال: يرى لا أمام الرائي ولا خلفه، ولا عن يمينه ولا عن يساره، ولا فوقه ولا تحته، ردّ عليه كلّ من سمعه بفطرته السليمة»([cccxli]).
وقال أيضاً:
«وأمّا رؤيته تعالى في الدنيا، فقد أخبر رسول الله| في الحديث الصحيح: (أنّ أحداً منّا لا يراه حتى يموت). رواه مسلم.
وأمّا هو نفسه عليه الصلاة والسلام فلم يرد في إثباتها له ما تقوم به الحجّة...»([cccxlii]).
الرؤية في النوم عند ابن تيمية
يعتقد ابن تيمية بإمكان الرؤية والمشاهدة لله، بل وقوعها أثناء النوم.
حيث قال:
«وقد يرى المؤمن ربّه في المنام في صور متنوّعة على قدر إيمانه ويقينه؛ فإذا كان إيمانه صحيحاً لم يره إلّا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه...»([cccxliii]).
ويقول أيضاً:
«ومن رأى الله} في المنام فإنّه يراه في صورة من الصور بحسب حال الرائي، إن كان صالحاً رآه في صورة حسنة؛ ولهذا رآه النبي (صلى الله عليه وسلم) في أحسن صورة»([cccxliv]).
المناقشة
أوّلاً: كيف للإنسان تحديد الصورة التي رآها في المنام على أنّها صورة الله تعالى؟
ثانياً: يلزم من رؤية الله في النوم المحدوديّة والحاجة والجهة والمكان والحدوث، وهذه اللوازم كلّها محال عليه.
ثالثاً: يأبى ابن تيمية من التصريح بأنّ الإنسان حينما لا يكون مؤمناً أو ناقص الإيمان فإنّه والعياذ بالله سيرى الله بصورة قبيحة أو ناقصة، مع أنّ لازم كلامه سيكون بهذا النحو.
رابعاً: قال عبدالله بن صديق الغماري:
«حديث المنام، رواه الترمذي بلفظ: (رأيت ربّي في صورة حسنة). وهذا اللفظ لا نكارة فيه، والصورة معناها الصفة وفي المسند: (رأيت ربّي).
فزيادة في صورة شابّ أمرد، تجسيم صريح، لا يعتقده مسلم، وإنّما يليق بعقيدة اليهود ـ لعنهم الله ـ »([cccxlv]).
أدلّة عدم إمكان الرؤية بالعين
استدلّ منكرو رؤية الله بالعين المجرّدة حتى في القيامة، بعدّة أنواع من الأدلّة:
أ) الادلّة العقليّة
أقام منكرو رؤية البارئ تعالى بالعين بعض الأدلّة العقليّة، ونشير أدناه إلى بعضها:
1ـ كلّ مرئيّ يجب أن يكون في مقابل الإنسان أو في حكم مقابله، وكلّ موجود كان في المقابل لابدّ أن يكون مستقرّاً في جهة من الجهات، وبالتالي إن كان الله سبحانه يُرى فلابدّ أن يكون في جهة، وهذا أمر محال؛ لأنّ الله سبحانه لا تحدّه جهة خاصّة.
2ـ إنّ الله تعالى ليس بجسم، فضلاً عن كونه جسماً تامّاً؛ ولهذا لا يكون قابلاً للرؤية، وإلّا لوجب رؤية العلم والشجاعة، بل الأمور الواقعيّة مثل استحالة المحالات وإمكان الممكنات وملازمة الزوجيّة للأربعة وأمثالها أيضاً، ولأنّ التالي باطل كان المقدّم باطل أيضاً، ولذا فإنّ رؤية البارئ تعالى محالة.
3ـ تحصل الرؤية عند انعكاس الشعاع وخروجه من المرأى، ولذا أصبحت رؤية البارئ تعالى محالة؛ لأنّه ليس بجسم ذي أبعاد، كما أنّه ليس في معرض الأحكام والعوارض الجسمانيّة، ولا يولد منه أيّ شيء.
4ـ إن كان من المفترض رؤية الله سبحانه، فهذه الرؤية إمّا أن تقع عليه بتمامه أو على بعض أجزائه، فيلزم من الصورة الأولى المحدوديّة والتناهي وهو محال، مضافاً إلى أنّه يستلزم خلو الأماكن الأخرى منه، ويلزم من الصورة الثانية التركيب وانقلاب واجب الوجود إلى ممكن الوجود الفقير المحتاج، وهو باطل أيضاً.
5ـ كلّ مرئيّ لابدّ أن يكون مشاراً إليه، بينما الله تعالى قديم وغير مشار إليه عقلاً، وإلّا وجب أن يكون في محلّ خاص.
6ـ إن كان الله تعالى مرئياً لأحد لابدّ أن يكون معلوماً، بينما لا يمكن لأحد أن يدّعي الإحاطة العلميّة بحقيقة الذات الإلهيّة.
ب) الأدلّة القرآنيّة
1ـ يقول الله تعالى:
(ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)([cccxlvi]).
إنّ الإدراك إذا اقترن بالبصر فُهم منه أنّ الرؤية لا تتمّ إلّا بالعين، كما أنّ الإدراك إذا كان مقترناً بآلة السمع؛ يستفاد منه السماع، ولهذا عُدّ هذا القول: (إنّني أدركته بعيني، ولكنّي لم أره بها) تناقضاً.
2ـ وقال تعالى كذلك:
(ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ)([cccxlvii]).
فالرؤية سواء وقعت على جميع الذات أو على جزء منها، فإنّها تتضمّن نوعاً من الإحاطة العلميّة للبشر بالله تعالى، وهذا ما نفاه القرآن الكريم في هذه الآية.
3ـ وقال أيضاً:
(ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ)([cccxlviii]).
هذه الآية تدلّ على نفي الرؤية لله تعالى من عدّة جهات:
أ) الجواب بالنفي المؤبّد في قوله (ﯝ ﯞ) الظاهر بالنفي الأبدي.
إذ يتبيّن من خلال مراجعة استعمالات كلمة (لن) في القرآن الكريم بأنّها للتأبيد.
يقول الله تعالى:
(ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ)([cccxlix]).
ويقول أيضاً:
(ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)([cccl]).
ب) تعليق الرؤية على أمر غير واقع: (ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ).
ج) تنزيه الله عن الرؤية بعدما أفاق قائلاً: (ﯶ).
د) توبة النبي موسى× لطلبه الرؤية: (ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ).
ﻫ) التصديق والإيمان بعدم إمكان الرؤية: (ﯹ ﯺ ﯻ).
ج) روايات أهل البيت^
روى الإمام الصادق× عن آبائه أنّهم قالوا:
«مَرَّ النَّبِيُّ| عَلَى رَجُلٍ، وَهُوَ رَافِعٌ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَدْعُو، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ|: غُضَّ بَصَرَكَ فَإِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ. وَقَالَ: وَمَرَّ النَّبِيُّ| عَلَى رَجُلٍ رَافِعٍ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَهُوَ يَدْعُو، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ|: اقْصُرْ مِنْ يَدَيْكَ فَإِنَّكَ لَنْ تَنَالَهُ»([cccli]).
نُقل عن عاصم بن حميد أنّه قال:
«ذَاكَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ× فِيمَا يَرْوُونَ مِنَ الرُّؤْيَةِ، فَقَالَ: الشَّمْسُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنْ نُورِ الكُرْسِيِّ، وَالكُرْسِيُّ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنْ نُورِ العَرْشِ، وَالعَرْشُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنْ نُورِ الحِجَابِ، وَالحِجَابُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنْ نُورِ السِّتْرِ، فَإِنْ كَانُوا صَادِقِينَ فَلْيَمْلَئُوا أَعْيُنَهُمْ مِنَ الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ»([ccclii]).
وعن أحمد بن إسحاق، قال:
«كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الحَسَنِ الثَّالِثِ×، أَسْأَلُهُ عَنِ الرُّؤْيَةِ وَمَا فِيهِ النَّاسُ، فَكَتَبَ×: لَا يَجُوزُ الرُّؤْيَةُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الرَّائِي وَالمَرْئِيِّ هَوَاءٌ يَنْفُذُهُ البَصَرُ، فَإِذَا انْقَطَعَ الهَوَاءُ وَعُدِمَ الضِّيَاءُ بَيْنَ الرَّائِي وَالمَرْئِيِّ لَمْ تَصِحَّ الرُّؤْيَةُ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الِاشْتِبَاهُ؛ لِأَنَّ الرَّائِيَ مَتَى سَاوَى المَرْئِيَّ فِي السَّبَبِ المُوجِبِ بَيْنَهُمَا فِي الرُّؤْيَةِ وَجَبَ الِاشْتِبَاهُ وَكَانَ فِي ذَلِكَ التَّشْبِيهُ؛ لِأَنَّ الأَسْبَابَ لَا بُدَّ مِنِ اتِّصَالِهَا بِالمُسَبَّبَاتِ»([cccliii]).
وقال القاضي سعيد القمّي في شرح الحديث الأخير:
«إنّا وجدنا العين الحاسّة تبصر الشيء إذا كان بينها وبينه هواء ينفذ نورها فيه إلى أن يصل المرئي، وإذا لم يكن توسّط ذلك الهواء لم يتحقّق الإبصار، وهذا واضح بحكم العادة، مع أنّ البرهان يعاضده، وذلك لأنّ الإبصار إنّما يكون للشيء الخارج عن النفس بقوّة جسمانيّة بالضرورة، ولما كان الإدراك وصولاً لا محالة، فالقوى الجسمانيّة إنّما تدرك الشيء إمّا بوصوله إليها أو بوصولها إليه، والأوّل يحتاج إلى حركة الشيء أو ما في حكمه، والثاني يفتقر إلى حركة القوّة أو شيء منها، ولما امتنعت حركة القوّة بالضرورة بقي أن يكون بحركة أمر من القوّة، ولا معنى للحركة هاهنا إلّا الأينيّة، فوجب من ذلك أن يتوسّط الهواء البتة وهو المطلوب. وعلى مذهب من ينفي الانطباع كما يظهر من هذا الخبر، نقول: فالإبصار إنّما يكون من القسم الذي يتحرّك من القوّة شيء إلى أن يصل بالمرئي؛ أمّا على مذهب القائل بخروج الشعاع فظاهر، وأمّا على القول بتكيّف الهواء بكيفيّة نوريّة مفاضة من النفس فكذلك، لأنّ الإفاضة تدريجيّة؛ أو نقول: لما كان الإدراك إمّا بوصول المدرك بالكسر إلى المدرك بالفتح، أو بالعكس من ذلك، والإبصار لا يمكن أن يكون من القسم الأوّل؛ لأنّ القرب المفرط مانع من هذا والإدراك، فكيف بالمماسّة والوصول، فيجب أن يكون من القسم الثاني وبالبعد المعتدل. ولما كانت القوّة جسمانيّة فالبعد عنها يكون بتوسّط بعد جسماني، سواء كان المرئي جسماً أو غير جسم، إلى أن يثبت أنّه لا يمكن أن يكون غير جسم»([cccliv]).
د) موقف بعض الصحابة
روى مسلم بسنده عن مسروق، قال:
«سَالتُ عَائِشَةَ، هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ لَقَدْ قَفَّ شَعَرِي لِمَا قُلْتَ»([ccclv]).
و نقل ـ أيضاً ـ مسلم عن مسروق بطريق آخر، قال:
«كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَائِشَةَ، ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الفِرْيَةَ، قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الفِرْيَةَ، قَالَ: وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، أَنْظِرِينِي، وَلَا تُعْجِلِينِي، أَلَمْ يَقُلِ اللهُ}: (ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)([ccclvi])، (ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ)([ccclvii])؟ فَقَالَتْ: أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فَقَالَ: (إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ، لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ المَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ)، فَقَالَتْ: أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللهَ يَقُولُ: (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)([ccclviii])»([ccclix]).
وروى النسائي بسنده عن أبي ذر أنّه قال:
«رَأَى النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِقَلْبِهِ، وَلَمْ يَرَهُ بِبَصَرِهِ»([ccclx]).
عن ابن عباس، قال:
«لَمْ يَرَهُ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِعَيْنِهِ، إِنَّما رَآهُ بِقَلْبِهِ»([ccclxi]).
هـ) اتفاق الشيعة
كتب الشيخ المفيد:
«أنّه لا يصحّ رؤية الباري سبحانه بالأبصار، وبذلك شهد العقل ونطق القرآن وتواتر الخبر عن أئمّة الهدى من آل محمد|، وعليه جمهور أهل الإمامة وعامّة متكلّميهم إلّا من شذّ منهم لشبهة عرضت له في تأويل الأخبار. والمعتزلة بأسرها توافق أهل الإمامة في ذلك وجمهور المرجئة وكثير من الخوارج والزيدية وطوائف من أصحاب الحديث، ويخالف فيه المشبّهة وإخوانهم من أصحاب الصفات»([ccclxii]).
وقال العلّامة الحلّي:
«من علم شيئاً ثمّ رآه تجدّدت له حالة لم يكن حالة العلم، وهل هي نفس تأثّر الحاسّة أو أمر زائد عليه؟ قد مضى البحث فيه، وعلى كلا التقديرين لا بدّ في حصول تلك الحالة من المقابلة، وهي لا يعقل إلّا في المتحيّزات، وهذا أمر ضروري قد اتفق عليه جميع العقلاء، ونازع فيه الأشاعرة كافّة، وزعموا أنّه تعالى مرئي مع أنّه ليس في جهة، فإن عنوا بالرؤية العلم، فقد مضى البحث في أنّه هل تُعلم حقيقته أم لا؟ وإن عنوا بها الأمر الحاصل عند المقابلة، فهو منتف في حقّه، وإن عنوا بها شيئاً ثالثاً فهو غير معقول»([ccclxiii]).
وقال محمد جعفر الاسترآبادي المعروف بشريعتمدار:
«ذهب الأشاعرة إلى أنّه تعالى يجوز أن يُرى، وأنّ المؤمنين في الجنّة يرونه منزّها عن المقابلة والجهة والمكان، وخالفهم في ذلك جميع الفرق؛ فإنّ المشبّهة والكراميّة إنّما يقولون برؤيته في الجهة والمكان؛ لكونه عندهم جسماً، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.
ولا نزاع للنافين في جواز الانكشاف التام العلمي، ولا للمثبتين في امتناع ارتسام صورة من المرئي في العين، أو اتصال الشعاع الخارج من العين بالمرئي، وإنّما محلّ النزاع أنّا إذا عرفنا الشمس ـ مثلاً ـ بحدّ أو رسم، كان نوعاً من المعرفة، ثمّ إذا أبصرناها وغمضنا العين، كان نوعاً آخر فوق الأوّل، ثمّ إذا فتحنا العين حصل نوع آخر من الإدراك فوق الأوّلين، نسمّيها الرؤية، ولا يتعلّق في الدنيا إلّا بما هو في جهة ومكان، فمثل هذه الحالة الإدراكيّة هل يصحّ أن يقع بدون المقابلة والجهة، وأن يتعلّق بذات الله تعالى منزّها عن الجهة والمكان، أو لا؟...»([ccclxiv]).
وقال العلّامة المجلسي:
«اعلم أنّ الأمّة اختلفوا في رؤية الله تعالى على أقوال، فذهبت الإماميّة والمعتزلة إلى امتناعها مطلقاً، وذهبت المشبّهة والكراميّة إلى جواز رؤيته تعالى في الجهة والمكان؛ لكونه تعالى عندهم جسماً، وذهبت الأشاعرة إلى جواز رؤيته تعالى منزّها عن المقابلة والجهة والمكان»([ccclxv]).
الاجماع على عدم جواز الرؤية في الدنيا
قام إجماع المسلمين على امتناع رؤية البارئ تعالى بالعين المجرّدة في الدنيا، ووقع الاختلاف بأنّ هذا الإجماع هل هو شامل لعالم الآخرة أم لا؟ يعتقد الشيعة الإماميّة بعدم إمكان الرؤية بالعين حتى في عالم الآخرة، بينما ذهب السنّة للقول بإمكان ذلك، بل وقوعه في عالم الآخرة.
فقال محمد ناصرالدين الألباني:
«وأمّا رؤيته تعالى في الدنيا فقد أخبر رسول الله| في الحديث الصحيح: (أنّ أحداً منّا لا يراه حتى يموت). رواه مسلم.
وأمّا هو نفسه عليه الصلاة والسلام فلم يرد في إثباتها له ما تقوم به الحجّة...»([ccclxvi]).
أدلّة القائلين بجواز الرؤية في الآخرة
أقام المعتقدون بجواز رؤية البارئ تعالى في الآخرة بأنواع مختلفة من الأدلّة، سنقوم بعرضها ومناقشتها كالتالي:
أ) الدليل العقلي
عرض الفاضل المقداد السيوري تقرير الدليل العقلي الذي أقامه القائلون بالجواز على هذا النحو:
«أنّه تعالى موجود، وكلّ موجود مرئي، وبيّنوا الكبرى بأنّ الجسم والعرض مرئيّان، ولهذا الحكم المشترك علّة مشتركة، ولا مشترك بينهما إلّا الوجود أو الحدوث، والعلّة ليست هي الحدوث، لعدميّته فيكون الوجود، وهو المطلوب»([ccclxvii]).
فردّ الفاضل المقداد هذا الاستدلال، قائلاً:
«وهذا في غاية السخافة لمنع رؤية الجسم، بل العرض كما تقدّم، وبمنع تعليل كلّ حكم، ويمنع كون كلّ حكم مشترك معلّلاً بمشترك، ولمنع الحصر في الاثنين، لحصول الإمكان، أو لكون أحدهما علّة بشرط الآخر، وبمنع مساواة وجوده تعالى لوجودهما، ويلزمهم رؤية كلّ موجود حتى الروائح وغيرها، وجواز كونها ملموساً لانصباب دليلهم عليه، وهو محال»([ccclxviii]).
ب) الأدلّة القرآنيّة
1ـ قول الله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﯕﭖ ﭗﯕﭙ ﭚ ﭛﯕﭝ ﭞ ﭟﯕﭡ ﭢ ﭣﯕﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ)([ccclxix]).
الرد:
أولاً: تمّت الاستفادة في هذه الآية من كلمة (وجوه) لا (عيون)، فلو كان المراد هو الرؤية لوجب استعمال كلمة (عيون).
ثانياً: ثمّة آيات ست، وقفت ثلاثة منها مقابل ثلاثة، وهي:
أ) (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)، (ﭖ ﭗ).
ب) (ﭙ ﭚ ﭛ)، (ﭡ ﭢ ﭣ).
ج) (ﭝ ﭞ ﭟ)، (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ).
(ناضرة) يعني مشرقة مبتهجة، و(باسرة) يعني عابسة مغمومة، و(فاقرة) يعني مصيبة عظيمة، والفاقرة من فقره إذا أصاب فقار ظهره.
بقرينة المقابلة بين الآيات يصبح معنى الآية كالتالي: وجوه عابسة تظنّ (أي: تنتظر) أنّ حادثة من العذاب الإلهي ستصيبها، وفي المقابل هناك وجوه مستبشرة تنتظر رحمة ربّها.
والمؤيّد لهذا المعنى، الحديث المروي عن الإمام الرضا× في تفسير قوله: (ﭙ ﭚ ﭛﯕﭝ ﭞ ﭟ)، حيث قال:
«يَعْنِي مُشْرِقَةٌ تَنْتَظِرُ ثَوَابَ رَبِّهَا»([ccclxx]).
ونقل القاضي عبدالجبّار المعتزلي هذا المعنى عن بعض المفسّرين([ccclxxi]).
2ـ أشارت بعض الآيات إلى لقاء المؤمنين بربّهم في يوم القيامة، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم:
(ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ)([ccclxxii]).
الردّ:
إنّ كلمة (لقاء) طبقاً للقرآن والحديث والعرف، ليست بمعنى الرؤية:
أ) قال الله جلّ وعلا:
(ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ)([ccclxxiii]).
من الواضح أنّ المنافقين لن يلاقوا ربّهم، وإنّما سيلاقون الموت والحساب وأنواع العذاب فقط.
ب) ورد في حديث عن النبي| أنّه قال:
«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَخِيهِ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»([ccclxxiv]).
ج) في عرف المسلمين، حيث يقال عمّن يموت: لقد ذهب إلى لقاء الله.
وكتب القاضي عبدالجبّار المعتزلي في ذلك:
«أنّ اللقاء ليس هو بمعنى الرؤية، ولهذا استعمل أحدهما حيث لا يستعمل الآخر، ولهذا فإنّ الأعمى يقول: لقيت فلاناً وجلست بين يديه وقرأت عليه، ولا يقول رأيته...، فثبت أنّ اللقاء ليس هو بمعنى الرؤية، وأنّهم إنّما يستعملونه فيها مجازاً، وإذا ثبت ذلك، فيجب أن نحمل هذه الآية على وجه يوافق دلالة العقل»([ccclxxv]).
3ـ قول الله جلّ وعلا:
(ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﯕﮋ ﮌ ﮍ ﮎ)([ccclxxvi]).
حيث تدلّ الآية على أنّ الكفّار يوم القيامة محجوبون عن رؤية الله، ويفهم من هذا أنّ المؤمنين ليسوا بمحجوبين.
الردّ:
أوّلاً: ظاهر هذه الآية أنّ الكفّار محجوبون عن رحمة الله لذنوبهم لا عن رؤية الله، ولهذا لم يأت التعبير القرآني: «كلاّ إنّهم عن رؤية ربّهم...».
ثانياً: أنّ المعرفة التامّة بالله تعالى، والتي هي فوق الرؤية الحسيّة القائمة بهذه العيون المادّية ممكنة للجميع في يوم القيامة.
إذ يقول الله سبحانه:
(ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ)([ccclxxvii]).
4ـ قول الله سبحانه:
(ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)([ccclxxviii]).
رغم أنّ القائلين بعدم جواز المشاهدة قد استدلّوا بهذه الآية على مدّعاهم إلّا أنّ القائلين بها ادعوا عدم دلالة الآية على عدم الجواز، بل ذهبوا للقول بدلالتها على الجواز، ومن جملتهم ابن تيمية والفخر الرازي.
قال ابن تيمية:
«وأمّا احتجاجه واحتجاج النفاة ـ أيضاً ـ بقوله تعالى: (ﭥ ﭦ ﭧ)، فالآية حجّة عليهم لا لهم؛ لأنّ الإدراك: إمّا أن يراد به مطلق الرؤية، أو الرؤية، أو الرؤية المقيّدة بالإحاطة، والأوّل باطل، لأنّه ليس كلّ من رأى شيئاً يقال: إنّه أدركه، كما لا يقال: أحاط به، كما سئل ابن عباسG عن ذلك فقال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى، قال: أكلّها ترى؟ قال: لا.
ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة، لا يقال: إنّه أدركها، وإنّما يقال: أدركها إذا أحاط بها رؤية، ونحن في هذا المقام ليس علينا بيان ذلك، وإنّما ذكرنا هذا بياناً لسند المنع، بل المستدلّ بالآية عليه أن يبيّن أنّ الإدراك في لغة العرب مرادف للرؤية، وأنّ كلّ من رأى شيئاً يقال في لغتهم إنّه أدركه، وهذا لا سبيل إليه، كيف وبين لفظ الرؤية ولفظ الإدراك عموم وخصوص أو اشتراك لفظي، فقد تقع رؤية بلا إدراك، وقد يقع إدراك بلا رؤية، فإنّ الإدراك يستعمل في إدراك العلم وإدراك القدرة، فقد يدرك الشيء بالقدرة وإن لم يشاهد، كالأعمى الذي طلب رجلاً هارباً منه فأدركه ولم يره، وقد قال تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﯕﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)([ccclxxix])، فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي، فعلم أنّه قد يكون رؤية بلا إدراك، والإدراك هنا هو إدراك القدرة، أي ملحوقون محاط بنا، وإذا انتفى هذا الإدراك فقد تنتفي إحاطة البصر أيضاً.
ومما يبيّن ذلك أنّ الله تعالى، ذكر هذه الآية يمدح بها نفسه سبحانه وتعالى، ومعلوم أنّ كون الشيء لا يُرى ليس صفة مدح، لأنّ النفي المحض لا يكون مدحاً إن لم يتضمّن أمراً ثبوتيّاً، ولأنّ المعدوم أيضاً لا يُرى، والمعدوم لا يمدح، فعلم أنّ مجرّد نفي الرؤية لا مدح فيه.
وهذا أصل مستمر، وهو أنّ العدم المحض الذي لا يتضمّن ثبوتاً، لا مدح فيه ولا كمال، فلا يمدح الربّ نفسه به، بل ولا يصف نفسه به، وإنّما يصفها بالنفي المتضمّن معنى ثبوت، كقوله: (ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) وقوله: (ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ)، وقوله: (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ)، وقوله: (ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ)([ccclxxx])، وقوله: (ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)([ccclxxxi])، وقوله: (ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ)([ccclxxxii])، ونحو ذلك من القضايا السلبيّة التي يصف الربّ تعالى بها نفسه، وأنّها تتضمّن اتصافه بصفات الكمال الثبوتيّة، مثل كمال حياته وقيّوميّته وملكه وقدرته وعلمه وهدايته وانفراده بالربوبيّة والإلهيّة ونحو ذلك. وكلّ ما يوصف به العدم المحض فلا يكون إلّا عدماً محضاً، ومعلوم أنّ العدم المحض يقال فيه: إنّه يرى، فعلم أنّ نفي الرؤية عدم محض، ولا يقال في العدم المحض: لا يدرك، وإنّما يقال: هذا فيما لا يدرك لعظمته لا لعدمه.
وإذا كان المنفي هو الإدراك، فهو سبحانه وتعالى لا يحاط به رؤية، كما لا يحاط به علماً، ولا يلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية نفي العلم والرؤية، بل يكون ذلك دليلاً على أنّه يرى ولا يحاط به كما يعلم ولا يحاط به، فإنّ تخصيص الإحاطة بالنفي يقتضي أنّ مطلق الرؤية ليس بمنفي، وهذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهم، وقد روي معناه عن ابن عباسG وغيره. وقد روي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي (صلى الله عليه وسلم). ولا تحتاج الآية إلى تخصيص، ولا خروج عن ظاهر الآية، فلا نحتاج أن نقول: لا نراه في الدنيا، أو نقول: لا تدركه الأبصار بل المبصرون، أو لا تدركه كلّها بل بعضها، ونحو ذلك من الأقوال التي فيها تكلّف.
ثمّ نحن في هذا المقام يكفينا أن نقول: الآية تحتمل ذلك، فلا يكون فيها دلالة على نفي الرؤية، فبطل استدلال من استدلّ بها على الرؤية، وإذا أردنا أن نثبت دلالة الآية على الرؤية مع نفيها للإدراك الذي هو الإحاطة أقمنا الدلالة على أنّ الإدراك في اللغة ليس هو مرادفاً للرؤية، بل هو أخصّ منها، وأثبتنا ذلك باللغة وأقوال المفسّرين من السلف وبأدلّة أخرى سمعيّة وعقليّة»([ccclxxxiii]).
المناقشة
أوّلاً: قال العلّامة الكاظمي القزويني في ردّ كلام ابن تيمية:
«ما زعمه من كون المقصود من مادّة (أدرك) معنى من المعنيين المذكورين فإنّه معلوم الفساد لغة وعرفاً؛ لأنّ (أدرك) وما هو من مادّتها له معنى معلوم معيّن غير ما زعمه السنّي. قال صاحب (النهاية) في بيانها: (الدرك: إلحاق والوصول إلى الشيء). وقال في (القاموس): الدرك بالتحريك: اللحاق. يقال أدركه أي لحقه وغيرهما. قال: مثلها وهي مستعملة في مطلق الوصول إلى الشيء، والوصول إلى كلّ شيء بحسبه. قال شاعرهم: (وإلّا فادركني ولما امزق). وفي حديث حذيفة المتقدّم في الخير والشر: (فإن أدركني ذلك الزمان). وروى البخاري وغيره: (فأدرك بعضهم العصر في الطريق). وقال سبحانه: (ﯯ ﯰ ﯱ)([ccclxxxiv]) وقال سبحانه: (ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)([ccclxxxv])، فعلم أنّ معنى هذه المادّة هو اللحاق والوصول. وقال سبحانه: (ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ)([ccclxxxvi]) يعني لملحقون بفرعون وقومه وسيصلون إلينا. ولم ترد هذه المادّة في لغة العرب بمعنى ما زعمه السنّي من أنّ أدركه بمعنى أحاطه، وهذه نبذة مما استعملت فيه، فإنّها في جميعها دلّت على اللحوق والوصول. يقال: أدركه البصر أي لحقه ووصل إليه، ومثله أدركه الموت وأدركهم العصر في الطريق وأدركهم الجيش وأدرك الجبل والبستان والمدينة؛ يعني وصل إليها. فأدرك قد يكون بغير البصر مثل أدركهم العصر وغيره وقد يكون بالبصر، فبين هذه المادّة ومادّة الرؤية عموم وخصوص مطلق؛ فإنّ الرؤية مختصّة بالبصرة وأدرك شامل للوصول إلى الشي بالبصر وغيره. فقوله سبحانه: (ﭥ ﭦ ﭧ)([ccclxxxvii]) معناه نفي وصول البصر إليه. فعلم بهتان السنّي على اللغة وعلى الكتاب وعلى السنّة في بيانه لمعنى مادّة أدرك في المقام بما زعمه»([ccclxxxviii]).
قال العلّامة المصطفوي في شرح مادّة (درك):
«والتحقيق: أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الوصول والإحاطة، سواء كان المحيط أمراً مادّياً أو معنوياً، وكذلك فيما يحاط ويسلّط عليه»([ccclxxxix]).
ثانياً: قال العلّامة الطباطبائي في تفسير هذه الآية:
«وأمّا قوله: (ﭥ ﭦ ﭧ) فهو لدفع الدخل الذي يوهمه قوله: (ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ)([cccxc]) بحسب ما تتلقّاه أفهام المشركين الساذجة والخطاب معهم، وهو أنّه إذا صار وكيلاً عليهم كان أمراً جسمانيّاً كسائر الجسمانيّات التي تتصدّى الأعمال الجسمانيّة فدفعه بأنّه تعالى لا تدركه الأبصار لتعاليه عن الجسميّة ولوازمها، وقوله: (ﭨ ﭩ ﭪ) دفع لما يسبق إلى أذهان هؤلاء المشركين الذين اعتادوا بالتفكّر المادّي، وأخلدوا إلى الحسّ والمحسوس وهو أنّه تعالى إذا ارتفع عن تعلّق الأبصار به خرج عن حيطة الحسّ والمحسوس، وبطل نوع الاتصال الوجودي الذي هو مناط الشعور والعلم، وانقطع عن مخلوقاته فلا يعلم بشيء كما لا يعلم به شيء، ولا يبصر شيئاً كما لا يبصره شيء، فأجاب تعالى عنه بقوله: (ﭨ ﭩ ﭪ)...»([cccxci]).
ثالثاً: كتب السيد شرف الدين العاملي في شرح قوله تعالى (ﭥ ﭦ ﭧ):
«فإنّ الإدراكمتىقرنبالبصر لا يفهم منه إلّا الرؤية بالعين، كما أنّه إذا قرن بآلة السمع فقيل: أدركته باذني، لا يفهم منه إلّا السماع، وكذلك إذا أضيف إلى كلّ واحدةمنالحواسّأفادماتلكالحاسّةآلةفيه،فقولهم: أدركتهبفمي،معناه: وجدتطعمه؛وأدركته بأنفي، معناه: وجدت رائحته.
وقد دلّت هذه الآية على أنّه سبحانه وتعالى قد تعالى على جميع الموجودات بمجموع هذين الأمرين اللذين اشتملت عليهما الآية الكريمة؛ لأنّ منالأشياءمايرىويرىكالأحياءمنالناس. ومنها: ما يرىولايرىكالجماداتوالأعراضالمرئيّة. ومنها: مالايرىولايرى،كالأعراضالتيلا ترى،فاللهتعالىخالقهاجميعها، وتعالى عليها، وتفرّد بأن يرى ولا يرى وتمدّح بمجموع الأمرين، كما تمدّح بقوله: (ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ)([cccxcii]) وقوله: (ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ)([cccxciii])»([cccxciv]).
رابعاً: قال العلّامة الكاظمي القزويني:
«ما زعمه من كون الشيء غير مرئي ليس بصفة مدح فإنّه من عجيب جهله بمعنى آية المقام؛ لأنّه سبحانه لم يمدح نفسه فيها بأنّه غير مرئي بالبصر فقط وصف نفسه بشيء خارق للعادة وهو محال فيها، وهو شيء مركّب من شيئين، شيء عدمي وهو عدم رؤية إبصار المخلوقين له، وشيء وجودي وهو رؤيته سبحانه لها. فانظر ـ يا طالب الحقّ ـ إلى هذه الصفة العجيبة الغريبة الخارقة، فإنّ العادة قد جرت على أنّه متى قام بصير لمثله فنظر كلّ واحد منهما بعينه إلى مقابله أبصر كلّ منهما وصاحب، والله سبحانه جلّ عن ذلك، فإنّه يرى العيون الناظرة وهي لن ترى الله سبحانه، فهو يرى العيون مبصرة وهو في هذه الحالة محجوب عنها غير مرئي بها، فرؤية العيون لن تصل إليه ورؤيته تصل إليها في هذه الحالة. وهذه العجيبة مختصّة به سبحانه فإنّه قد يكون الموجود من المعاني الغير القابلة لرؤية البصر مثل الصفات القلبيّة والأحوال النفسانيّة من نيّات الخير والشر والعقائد وغيرها، فهذه وما هو من قبيلها لن ترى ولن ترى، وقد يكون الموجود محسوساً يرى بالبصر لكنه هو بنفسه ليس له حاسّة البصر مثل الجماد والنبات وما هو من قبيلها، فإنّ هذه ترى ولن ترى، وقد يكون الموجود محسوساً يرى ويرى وذلك مثل البشر فإنّه يرى ويرى، فأمّا الموجود الذي يرى نفس البصر والبصر في هذه الحالة محجوب عن رؤيته فالله سبحانه وحده. فعلم مما بيّناه كون تمدحه سبحانه في الآية ليس بشيء عدمي، بل بصفة عجيبة مركّبة من نفي وإثبات، خارقة للعادة، مختصّة به سبحانه.
ومما بيّناه علم فساد ما زعمه بعضهم من كون نفي الرؤية مختصاً بالدنيا، وما زعمه بعضهم من كون المبصرين يرونه دون أبصارهم وغير ذلك، فأيّ معنى فرض يستلزم وجود مشابه له في ذلك وهو مناف لمدحه نفسه بهذه الصفة»([cccxcv]).
خامساً: وقال أيضاً:
«ما نقله عن ابن عباس، فإنّه حجّة بيّنة عليه؛ لأنّ السنّي قد زعم أنّ الله سبحانه قد مدح نفسه بعدم إحاطة الرؤية به، فأي مدحة تتصوّر في ذلك والحال أنّ الرؤية هذه حالها بالنسبة إلى بعض مخلوقاته مثل سمائها وغيرها حسب ما قاله ابن عباس في الخبر الذي نقله عنه، فقد شارك بعض الخلوقات ربّه في هذه الصفة بزعم السنّي، وهل يتصوّر مدحة الربّ نفسه بصفة هي موجودة في بعض مخلوقاته، وقد قال سبحانه: (ﭡ ﭢ ﭣ) وما معنى مدحته في المقام ومخلوقه مثله في عدم إحاطة الرؤية به. وليعرض ذلك على السوقة دون أهل العلم من المسلمين فإنّهم يفهمون غاية المدحة للمخلوق الذي ساوى ربّه في صفة من الصفات. فأمّا كون هذه الصفة فيها مدحة للربّ تعالى، فمنفي لديهم من حيث قيام ضرورة فطرتهم على كون المدحة مختصّة بصفة الجمال المتفرّد بها سبحانه، فمن هنا تعلم بأنّ ما رووه في مسألة الرؤية كذب؛ لمنافاته لقوله سبحانه: (ﭡ ﭢ ﭣ)»([cccxcvi]).
ج) الأدلّة الروائيّة
نقل البخاري بسنده عن جرير بن عبدالله، قال:
«كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةً ـ يَعْنِي البَدْرَ ـ فَقَالَ: (إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ، كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ...)»([cccxcvii]).
و نقل جرير بن عبدالله ـ أيضاً ـ عن النبي| أنّه قال:
«إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا»([cccxcviii]).
المناقشة
وعلّق السيد شرف الدين العاملي على روايتين نقلهما من المصادر الحديثيّة لأهل السنّة كالبخاري ومسلم تدلّان على إمكان وقوع الرؤية في القيامة، قائلاً:
«هذان الحديثان باطلان من حيث سنديهما، ومن حيث متنيهما...، أمّا بطلانهما من حيث المتن؛ فلظهوره في كون الله تعالى جسماً ذا صورة مركّبة تعرض عليها الحوادث من التحوّل والتغيّر، وأنّه سبحانه ذو حركة وانتقال، يأتي هذه الأمّة يوم حشرها، وفيها مؤمنوها ومنافقوها، فيرونه بأجمعهم، ماثلاً لهم في صورة غير الصورة التي كانوا يعرفونها من ذي قبل، فيقول لهم: أنا ربّكم، فينكرونه متعوّذين بالله منه، ثمّ يأتيهممرّةثانيةفيالصورةالتييعرفون،فيقوللهم: أناربّكم،فيقولالمؤمنونوالمنافقونجميعاً: نعمأنتربّنا،وإنّماعرفوهبالساق،إذكشفلهمعنها،فكانتهيآيتهالدالّةعليه،فيتسنّى حينئذ السجود للمؤمنين منهم دون المنافقين، وحين يرفعون رؤوسهم يرون الله مائلاً فوقها بصورته التي يعرفون لا يمارون فيه، كما كانوا في الدنيا لا يمارون في الشمس والقمر، ماثلين فوقهم بجرميهما النيّرين، ليس دونهما سحاب، وإذا به بعد هذا يضحك ويعجب من غير ما عجب، كما هو يأتي ويذهب. إلى آخر ما اشتمل عليه الحديثان ممّا لا يجوز على الله تعالى، ولا على رسوله بإجماع أهل التنزيه من أشاعرة وغيرهم، فلا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم»([cccxcix]).
وقال في التتمّة أيضاً:
«على أنّ هذينالحديثينوسائرالأحاديثالتيتشبّثبهاالقائلون بالرؤية ـ لو فرضنا صحّتها متناً وسنداً ـ لا تخرج بالصحّة عن كونها من الآحاد، وخبر الواحد مع صحّته إنّما يكون حجّة في الفروع لا في العقائد، كما هو مقرّر في أصول الفقه مفروغ عنه؛ لأنّ غايةمايحصلمنهالظنّ،والمسألةالتيهيمحلّالبحثليستبفرعيّةلترتّبالأثر فيها على الخبر الواحد الصحيح وإن كان ظنّيّاً، بل نرتّب الأثر عليه وإن لم يفدنا الظنّ تعبّداًبتصديقالعدل،وترتيبالأثرفيالفروععلىمايحدّثنابهعنالشارعالمقدّس.
وإنّما المسألة عقيدة، والعقيدة لا تحصل من الآحاد، بل لا تحصل في مسألتنا هذه حتّى من التواتر شأن كلّ ممتنععقلاً؛إذلوفرضحصولالتواترفيها،لوجبتأويله،أوردّالعلمبالمرادمنه إلى الله تعالى، كما لا يخفى»([cd]).
إمكان الرؤية والشهود القلبي
رغم عدم إمكان مشاهدة البارئ تعالى بالعين المادّية في الدنيا والآخرة، غير أنّه من الممكن أن يستفاد إمكان المشاهدة القلبيّة من الآيات والروايات.
أشار الله تعالى إلى إمكان الرؤية القلبيّة في القيامة بالنسبة للمؤمنين الذين لم يعصوا الله في الدنيا، حيث قال تعالى:
(ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)([cdi]).
فيستفاد من منطوق هذه الآية أنّ الفسقة محرومون من المشاهدة القلبيّة يوم القيامة نتيجة للحجاب الذي ران على قلوبهم بسبب الذنوب التي اقترفوها، كما قد يستفاد من مفهومها أنّ المؤمنين المطيعين لأوامر الله ليسوا محرومين من هذا النوع من الرؤية.
قال الإمام الصادق×:
«جَاءَ حِبْرٌ إِلَى أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ (صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ) فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ حِينَ عَبَدْتَهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: وَيْلَكَ مَا كُنْتُ أَعْبُدُ رَبّاً لَمْ أَرَهُ، قَالَ: وَكَيْفَ رَأَيْتَهُ؟ قَالَ: وَيْلَكَ لَا تُدْرِكُهُ العُيُونُ فِي مُشَاهَدَةِ الأَبْصَارِ، وَلَكِنْ رَأَتْهُ القُلُوبُ بِحَقَائِقِ الإِيمَانِ»([cdii]).
وروى أبو بصير أنّه سأل الإمام الصادق×:
«قُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنِ اللهِ}، هَلْ يَرَاهُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَدْ رَأَوْهُ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ، فَقُلْتُ: مَتَى؟ قَالَ: حِينَ قَالَ لَهُمْ: (ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ)([cdiii]) ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّ المُؤْمِنِينَ لَيَرَوْنَهُ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ، أَلَسْتَ تَرَاهُ فِي وَقْتِكَ هَذَا؟! قَالَ أَبُو بَصِيرٍ: فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَأُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْكَ؟ فَقَالَ: لَا؛ فَإِنَّكَ إِذَا حَدَّثْتَ بِهِ فَأَنْكَرَهُ مُنْكِرٌ جَاهِلٌ بِمَعْنَى مَا تَقُولُهُ، ثُمَّ قَدَّرَ أَنَّ ذَلِكَ تَشْبِيهٌ كَفَرَ، وَلَيْسَتِ الرُّؤْيَةُ بِالقَلْبِ كَالرُّؤْيَةِ بِالعَيْنِ، تَعَالَى اللهُ عَمَّا يَصِفُهُ المُشَبِّهُونَ وَالمُلْحِدُونَ»([cdiv]).
روى مسلم بسنده عن ابن عباس أنّه قال ـ بشأن قوله: (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﯕﮈ ﮉ ﮊ ﮋﯕﮍ ﮎ ﮏ ﮐ)([cdv]) ـ:
«رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ»([cdvi]).
وقال العلّامة الطباطبائي ـ بعد ذكره للآيات المثبتة للرؤية ولقاء الله والآيات النافية للرؤية بالعين المادّية ـ:
«لا ريب أنّ الآيات تثبت علماً ما ضرورياً، لكن الشأن في تشخيص حقيقة هذا العلم الضروري، فإنّا لا نسمّي كلّ علم ضروري رؤية وما في معناه من اللقاء ونحوه، كما نعلم بوجود إبراهيم الخليل وإسكندر وكسرى فيما مضى ولم نرهم، ونعلم علماً ضرورياً بوجود لندن وشيكاغو ومسكو ولم نرها، ولا نسمّيه رؤية وإن بالغنا، فأنت تقول: أعلم بوجود إبراهيم× وإسكندر وكسرى كأنّي رأيتهم، ولا تقول رأيتهم أو أراهم، وتقول: أعلم بوجود لندن وشيكاغو ومسكو، ولا تقول: رأيتها أو أراها.
وأوضح من ذلك علمنا الضروري بالبديهيّات الأوليّة التي هي لكلّيتها غير مادّية ولا محسوسة، مثل قولنا: (الواحد نصف الاثنين) و(الأربعة زوج) و(الإضافة قائمة بطرفين) فإنّها علوم ضرورية يصحّ إطلاق العلم عليها، ولا يصحّ إطلاق الرؤية البتة.
ونظير ذلك جميع التصديقات العقليّة الفكريّة، وكذا المعاني الوهميّة، وبالجملة ما نسمّيها بالعلوم الحصوليّة لا نسمّيها رؤية، وإن أطلقنا عليها العلم فنقول: علمناها ولا نقول: رأيناها إلّا بمعنى القضاء والحكم، لا بمعنى المشاهدة والوجدان.
لكن بين معلوماتنا ما لا نتوقّف في إطلاق الرؤية عليه واستعمالها فيه، نقول: أرى أنّي أنا، وأراني أريد كذا وأكره كذا، وأحب كذا وأبغض كذا وأرجو كذا وأتمنّى كذا، أي أجد ذاتي وأشاهدها بنفسها من غير أن أحتجب عنها بحاجب، وأجد وأشاهد إرادتي الباطنة التي ليست بمحسوسة ولا فكريّة، وأجد في باطن ذاتي كراهة وحبّاً وبغضاً ورجاء وتمنياً، وهكذا.
وهذا غير قول القائل: رأيتك تحبّ كذا وتبغض كذا وغير ذلك، فإنّ معنى كلامه أبصرتك في هيئة استدللت بها على أنّ فيك حبّاً وبغضاً ونحو ذلك، وأمّا حكاية الإنسان عن نفسه أنّه يراه يريد ويكره ويحبّ ويبغض، فإنّه يريد به أنّه يجد هذه الأمور بنفسها وواقعيّتها لا أنّه يستدلّ عليها، فيقضي بوجودها من طريق الاستدلال، بل يجدها من نفسه من غير حاجب يحجبها ولا توسّل بوسيلة تدلّ عليها البتة.
وتسمية هذا القسم من العلم الذي يجد فيه الإنسان نفس المعلوم بواقعيّته الخارجيّة رؤية مطّردة، وهي علم الإنسان بذاته وقواه الباطنة وأوصاف ذاته وأحواله الداخليّة، وليس فيها مداخلة جهة أو مكان أو زمان أو حالة جسمانيّة أخرى غيرها، فافهم ذلك وأجد التدبّر فيه.
والله سبحانه فيما أثبت من الرؤية يذكر معها خصوصيّات، ويضمّ إليها ضمائم، يدلّنا ذلك على أنّ المراد بالرؤية هذا القسم من العلم الذي نسمّيه فيما عندنا أيضاً رؤية، كما في قوله: (ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﯕﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ)([cdvii]) الآية. حيث أثبت أوّلاً أنّه على كلّ شيء حاضر أو مشهود، لا يختصّ بجهة دون جهة وبمكان دون مكان وبشيء دون شيء، بل شهيد على كلّ شيء، محيط بكلّ شيء، فلو وجده شيء لوجده على ظاهر كلّ شيء وباطنه، وعلى نفس وجدانه وعلى نفسه، وعلى هذه السمة لقاؤه لو كان هناك لقاء، لا على نحو اللقاء الحسي الذي لا يتأتّى البتة إلّا بمواجهة جسمانيّة وتعيّن جهة ومكان وزمان، وبهذا يشعر ما في قوله: (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ)([cdviii]) من نسبة الرؤية إلى الفؤاد الذي لا شبهة في كون المراد به هو النفس الإنسانيّة الشاعرة دون اللحم الصنوبري المعلّق على يسار الصدر داخلاً.
ونظير ذلك قوله تعالى: (ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﯕﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)([cdix])، دلّ على أنّ الذي يحجبهم عنه تعالى رين المعاصي والذنوب التي اكتسبوها فحال بين قلوبهم ـ أي أنفسهم ـ وبين ربّهم، فحجبهم عن تشريف المشاهدة، ولو رأوه لرأوه بقلوبهم ـ أي أنفسهم ـ لا بأبصارهم وأحداقهم.
وقد أثبت الله سبحانه في موارد من كلامه قسماً آخر من الرؤية وراء رؤية الجارحة كقوله تعالى: (ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﯕﮡ ﮢﯕﮤ ﮥ ﮦ ﮧ)([cdx])، وقوله: (ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)([cdxi])، وقد تقدّم تفسير الآية في الجزء السابع من الكتاب، وبيّنا هناك أنّ الملكوت هو باطن الأشياء لا ظاهرها المحسوس.
فبهذه الوجوه يظهر أنّه تعالى يثبت في كلامه قسماً من الرؤية والمشاهدة وراء الرؤية البصريّة الحسيّة، وهي نوع شعور في الإنسان يشعر بالشيء بنفسه من غير استعمال آلة حسيّة أو فكريّة، وأنّ للإنسان شعوراً بربّه غير ما يعتقد بوجوده من طريق الفكر واستخدام الدليل، بل يجده وجداناً من غير أن يحجبه عنه حاجب، ولا يجرّه إلى الغفلة عنه إلّا اشتغاله بنفسه وبمعاصيه التي اكتسبها، وهي مع ذلك غفلة عن أمر موجود مشهود لا زوال علم بالكلّية ومن أصله، فليس في كلامه تعالى ما يشعر بذلك البتة، بل عبّر عن هذا الجهل بالغفلة، وهي زوال العلم بالعلم لا زوال أصل العلم.
فهذا ما بيّنه كلامه سبحانه، ويؤيّده العقل بساطع براهينه، وكذا ما ورد من الأخبار عن أئمّة أهل البيت^ على ما سننقلها ونبحث عنها في البحث الروائي الآتي إن شاء الله تعالى.
والذي ينجلي من كلامه تعالى أنّ هذا العلم المسمّى بالرؤية واللقاء يتمّ للصالحين من عباد الله يوم القيامة كما يدلّ عليه ظاهر قوله تعالى: (ﭙ ﭚ ﭛﯕﭝ ﭞ ﭟ)([cdxii])، فهناك موطن التشرّف بهذا التشريف، وأمّا في هذه الدنيا والإنسان مشتغل ببدنه، ومنغمر في غمرات حوائجه الطبيعيّة، وهو سالك لطريق اللقاء والعلم الضروري بآيات ربّه، كادح إلى ربّه كدحاً ليلاقيه، فهو بعد في طريق هذا العلم لن يتم له حقّ يلاقي ربّه، قال تعالى: (ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)([cdxiii])، وفي معناه آيات كثيرة أخرى تدلّ على أنّه تعالى إليه المرجع والمصير والمنتهى، وإليه يرجعون وإليه يقلبون.
فهذا هو العلم الضروري الخاص الذي أثبته الله تعالى لنفسه وسمّاه رؤية ولقاء، ولا يهمّنا البحث عن أنّها على نحو الحقيقة أو المجاز، فإنّ القرائن كما عرفت قائمة على إرادة ذلك، فإن كانت حقيقة كانت قرائن معيّنة، وإن كانت مجازاً كانت صارفة، والقرآن الكريم أوّل كاشف عن هذه الحقيقة على هذا الوجه البديع، فالكتب السماويّة السابقة على ما بأيدينا ساكتة عن إثبات هذا النوع من العلم بالله، وتخلو عنه الأبحاث المأثورة عن الفلاسفة الباحثين عن هذه المسائل، فإنّ العلم الحضوري عندهم كان منحصراً في علم الشيء بنفسه حتى كشف عنه في الإسلام، فللقرآن المنّة في تنقيح المعارف الإلهيّة»([cdxiv]).
رؤية
الله في كلام الإمام الحسين×
|
|
عدم رؤية الله بالعين (آلة البصر)
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء القنوت ـ مخاطباً العزيز الجبّار ـ:
«اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَرَى وَلَا تُرَى»([cdxv]).
حيث تشير الجملة الثانية لهذا المطلب، ألا وهو أنّ الله سبحانه لا يُرى بهذه العيون؛ لأنّه مجرّد تام.
يقول الله جلّ وعلا:
(ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ)([cdxvi]).
عدم إدراك الله بالعيون
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال:
«أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا هَؤُلَاءِ المَارِقَةَ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ اللهَ بِأَنْفُسِهِمْ، يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، بَلْ هُوَ اللهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ، لا تُدْرِكُهُ الأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصارَ، وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ»([cdxvii]).
فجملة «لا تُدْرِكُهُ الأَبْصارُ» تدلّ على عدم إدراك الله بالأبصار.
يقول الله}:
(ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)([cdxviii]).
احتجاب الله عن الإدراك بالأبصار
ورد عن الإمام الحسين× قوله عن الله جلّ وعلا في دعاء عرفة:
«يَا مَنِ احْتَجَبَ فِي سُرَادِقَاتِ عَرْشِهِ عَنْ أَنْ تُدْرِكَهُ الأَبْصَارُ»([cdxix]).
إذ يستفاد من مضمون هذه الجملة أنّ الله تعالى لا يُرى ولا يدرك بهذه العيون أبداً.
و أيضاً روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال عن الله تعالى:
«احْتَجَبَ عَنِ العُقُولِ كَمَا احْتَجَبَ عَنِ الأَبْصَارِ، وَعَمَّنْ فِي السَّمَاءِ احْتِجَابهُ كَمَنْ [عَمَّنْ] فِي الأَرْضِ»([cdxx]).
فيتضح من هذه الجملة أنّ ثمّة حجاب بين العيون وبين الله سبحانه.
وروي عن الزهراء‘ قولها عن الله تعالى في أحد الأدعية:
«الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي احْتَجَبَ عَنْ كُلِّ مَخْلُوقٍ يَرَاهُ بِحَقِيقَةِ الرُّبُوبِيَّةِ وَقُدْرَةِ الوَحْدَانِيَّةِ، فَلَمْ تُدْرِكْهُ الأَبْصَارُ»([cdxxi]).
احتجاب الله عن الموجودات الأرضيّة والسماويّة
يتحصّل من القسم الثاني في الحديث الأخير للإمام الحسين× أنّ كنه الذات الإلهيّة مثلما أنّها محجوبة عن الموجودات الأرضيّة، كذلك هي محجوبة عن الموجودات السماويّة كالملائكة.
ورد عن رسول الله| أنّه خاطب الله تعالى داعياً:
«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مَنِ احْتَجَبَ بِشُعَاعِ نُورِهِ عَنْ نَوَاظِرِ خَلْقِهِ»([cdxxii]).
|
|
|
|
12ـ الحاجة
|
|
|
|
مقدّمة
من الصفات السلبيّة لله تعالى الحاجة والافتقار للغير.
يقول العلّامة الحلّي في الاستدلال على غنى الله تعالى وعدم حاجته:
«وجوب الوجود يستدعي الاستغناء عن الغير في كلّ شيء، فهو ينافي الحاجة، ولأنّه لو افتقر إلى غيره لزم الدور؛ لأنّ ذلك الغير محتاج إليه لإمكانه.
لا يقال: الدور غير لازم؛ لأنّ الواجب مستغن في ذاته وبعض صفاته عن ذلك الغير، وبهذا الوجه يؤثّر في ذلك الغير، فإذا احتاج في جهة أخرى إلى ذلك الغير انتفى الدور.
لأنّا نقول: هذا بناء على أنّ صفاته تعالى زائدة على الذات، وهو باطل لما سيأتي، وأيضاً فالدور لا يندفع لأنّ ذلك الممكن بالجهة التي يؤثّر في الواجب تعالى صفة يكون محتاجاً إليه، وحينئذ يلزم الدور المحال.
ولأنّ افتقاره في ذاته يستلزم إمكانه، وكذا في صفاته؛ لأنّ ذاته موقوفة على وجود تلك الصفة أو عدمها المتوقّفين على الغير، فيكون متوقّفاً على الغير، فيكون ممكناً، وهذا برهان عوّل عليه الشيخ ابن سينا»([cdxxiii]).
|
|
|
|
عدم حاجة الله في كلام الإمام الحسين×
عدم حاجة الله لخلق الإنسان
ورد عن الإمام الحسين× خطابه لله سبحانه في دعاء عرفة، قائلاً:
«لَكَ الحَمْدُ كَمَا خَلَقْتَنِي فَجَعَلْتَنِي خَلْقاً سَوِيّاً رَحْمَةً بِي وَقَدْ كُنْتَ عَنْ خَلْقِي غَنِيّاً»([cdxxiv]).
فيستفاد من عبارة «وَقَدْ كُنْتَ عَنْ خَلْقِي غَنِيّاً» أنّ الله تعالى غني بالذات؛ ولهذا فهو كان ولا يزال غنيّاً عن خلق الإنسان.
قال أمير المؤمنين×:
«مَا كَانَ لِلهِ فِي أَهْلِ الأَرْضِ حَاجَةٌ مِنْ مُسْتَسِرِّ الامَّةِ وَمُعْلِنِهَا»([cdxxv]).
عدم حاجة الله لخلق الإنسان من البداية
بما أنّه قد ورد في الحديث الأخير للإمام الحسين× الفعل (كنت) بصيغة الماضي، يستنتج أنّ الله تعالى غنيّ عن خلق آدم، وغير محتاج لخلق الإنسان من البداية.
ويؤيّده قول الإمام الكاظم×:
«وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى شَيْءٍ، بَلْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ»([cdxxvi]).
عدم حاجة الله لخلق الأولياء
يستفاد ـ أيضاً ـ من الحديث الأخير للإمام الحسين× من إضافة كلمة (خلق) إلى الضمير العائد على سيد الشهداء× أنّ الله تعالى غني وغير محتاج حتى إلى خلق أوليائه، وأنّ الناس هم المحتاجون إلى خلق الأولياء من أجل هديهم ورشدهم في حياتهم.
قال الله تعالى:
(ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ)([cdxxvii]).
وكتب العلّامة السيد محمد حسين الحسيني الطهراني في تفسيره لهذه الآية:
«المجاهدة والجهاد مبالغة من الجهد بمعنى بذل الطاقة. وفيه تنبيه لهم أنّ مجاهدتهم في الله بلزوم الإيمان والصبر على المكاره دونه، ليست مما يعود نفعه إلى الله سبحانه حتى لا يهمّهم ويلغوه لغناهم عنه، بل إنّما يعود نفعه إليهم أنفسهم، لغناه تعالى عن العالمين، فعليهم أن يلزموا الإيمان، ويصبروا على المكاره دونه، فقوله: (ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ) تأكيد لحجّة الآية السابقة. وقوله: (ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) تعليل لما قبله»([cdxxviii]).
عدم حاجة الله لطاعة عباده
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة ـ مخاطباً البارئ تعالى ـ:
«يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ ذُنُوبُ عِبَادِهِ، وَهُوَ الغَنِيُّ عَنْ طَاعَتِهِمْ»([cdxxix]).
فيفهم من منطوق قوله «وَهُوَ الغَنِيُّ عَنْ طَاعَتِهِمْ» رغم أنّ الله سبحانه قد أمر عباده بطاعته وعبادته، لكنّه غير محتاج إلى طاعتهم، وغني عن عبادتهم؛ لأنّه المولى الحقيقي لهم، وإن كان لطاعتهم أثر فسيعود إليهم.
قال أمير المؤمنين×:
«فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ الخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ غَنِيّاً عَنْ طَاعَتِهِمْ، آمِناً مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَاهُ، وَلَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ»([cdxxx]).
وروي عنه× أيضاً:
«وَهُوَ الغَنِيُّ عَنْ عِبَادِهِ، لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَى أَعْمَالِ خَلْقِهِ»([cdxxxi]).
عدم حاجة الله لشكوى الإنسان
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة:
«كَيْفَ أَشْكُو إِلَيْكَ حَالِي وَهُوَ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ»([cdxxxii]).
فيستفاد من مضمون هذه الجملة أنّ الله تعالى بما أنّه عالم ومطلع بحال الناس واضطرارهم، فلا يحتاج في ذلك إلى شكواهم، رغم حاجتهم أنفسهم للشكوى عنده تعالى.
يقول الله تعالى على لسان الخليل إبراهيم×:
(ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)([cdxxxiii]).
عدم حاجة الله لعرض الفاقة والعوز
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة ـ مخاطباً الله تعالى ـ:
«... أَمْ كَيْفَ أُتَرْجِمُ بِمَقَالِي وَهُوَ مِنْكَ بَرَزَ إِلَيْكَ»([cdxxxiv]).
حيث يتبيّن لنا من مضمون هذا الدعاء عدم حاجة الله إلى شرح الإنسان لأحواله وما هو فيه؛ لعلمه سبحانه بالحقائق، رغم أنّ الإنسان محتاج إلى ذلك.
قال مرتضى فرج في شرحه لهذه الفقرة من الدعاء:
«بل بأيّ موجب أعبر لك عن حالي التي أعاني منها، بالكلمات التي أصوغها وأخاطبك بها، وإنّما تصدر كلماتي هذه من إلهامك لي وعونك بي، فهي منك عوناً وتوفيقاً، وهي إليك تظهر نهاية ومآباً؟»([cdxxxv]).
وندعو في دعاء الجوشن الكبير:
«يَا مَنْ يَعْلَمُ مُرَادَ المُرِيدِينَ، يَا مَنْ يَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ، يَا مَنْ يَسْمَعُ أَنِينَ الوَاهِنِينَ»([cdxxxvi]).
عدم وصول النفع لله تعالى منه
روي عن الإمام الحسين× أنّه قال في دعاء عرفة ـ مخاطباً الله تعالى ـ:
«إِلَهِي، أَنْتَ الغَنِيُّ بِذَاتِكَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْكَ النَّفْعُ مِنْكَ»([cdxxxvii]).
حيث يستفاد من هذه العبارة أنّ الله تعالى لغناه الذاتي لا يحتاج أن يصل إليه أيّ نفع حتى منه سبحانه.
وفي ذلك قال الإمام الرضا×:
«لَمْ يَخْلُقِ اللهُ العَرْشَ لِحَاجَةٍ بِهِ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ غَنِيٌّ عَنِ العَرْشِ وَعَنْ جَمِيعِ مَا خَلَقَ»([cdxxxviii]).
عدم حاجة الله إلى غيره
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة:
«إِلَهِي، أَنْتَ الغَنِيُّ بِذَاتِكَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْكَ النَّفْعُ مِنْكَ، فَكَيْفَ لَا تَكُونُ غَنِيّاً عَنِّي؟»([cdxxxix]).
فمن مضمون هذه الجملة يتبيّن عدم احتياج الله لغيره، وعدم وصول أيّ نفع من الآخرين إليه؛ لغناه الذاتي؛ ويعود نفع العبادة والطاعة إلى العباد أنفسهم.
روي عن السيدة الزهراء‘ أنّها قالت:
«ابْتَدَعَ الأَشْيَاءَ لَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ قَبْلَهَا، وَأَنْشَأَهَا بِلَا احْتِذَاءِ أَمْثِلَةٍ امْتَثَلَهَا، كَوَّنَهَا بِقُدْرَتِهِ، وَذَرَأَهَا بِمَشِيَّتِهِ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَى تَكْوِينِهَا، وَلَا فَائِدَةٍ لَهُ فِي تَصْوِيرِهَا، إِلَّا تَثْبِيتاً لِحِكْمَتِهِ، وَتَنْبِيهاً عَلَى طَاعَتِهِ، وَإِظْهَاراً لِقُدْرَتِهِ، تَعَبُّداً لِبَرِيَّتِهِ، وَإِعْزَازاً لِدَعْوَتِهِ»([cdxl]).
قال الإمام السجاد× في الدعاء الثالث عشر من الصحيفة السجاديّة ـ مخاطباً البارئ تعالى ـ:
«اللَّهُمَّ يَا مُنْتَهَى مَطْلَبِ الحَاجَاتِ، وَيَا مَنْ عِنْدَهُ نَيْلُ الطَّلِبَاتِ، وَيَا مَنْ لَا يَبِيعُ نِعَمَهُ بِالأَثْمَانِ، وَيَا مَنْ لَا يُكَدِّرُ عَطَايَاهُ بِالامْتِنَانِ، وَيَا مَنْ يُسْتَغْنَى بِهِ وَلَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ، وَيَا مَنْ يُرْغَبُ إِلَيْهِ وَلَا يُرْغَبُ عَنْهُ، وَيَا مَنْ لَا تُفْنِي خَزَائِنَهُ المَسَائِلُ، وَيَا مَنْ لَا تُبَدِّلُ حِكْمَتَهُ الوَسَائِلُ، وَيَا مَنْ لَا تَنْقَطِعُ عَنْهُ حَوَائِجُ المُحْتَاجِينَ، وَيَا مَنْ لَا يُعَنِّيهِ دُعَاءُ الدَّاعِينَ. تَمَدَّحْتَ بِالغَنَاءِ عَنْ خَلْقِكَ وَأَنْتَ أَهْلُ الغِنَى عَنْهُمْ»([cdxli]).
عدم حاجة الله للخلائق
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء الشدّة ـ مخاطباً الله العزيز الجبار ـ:
«اللَّهُمَّ انْتَ مُتَعَالِي المَكَانِ، عَظِيمُ الجَبَرُوتِ، شَدِيدُ المُحَالِ، غَنِيٌّ عَنِ الخَلَائِقِ»([cdxlii]).
حيث يتحصّل من الصفة الأخيرة غنى الله تعالى عن جميع الخلائق.
قال الله تبارك وتعالى:
(ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ)([cdxliii]).
|
|
13ـ الادراك
|
|
|
|
عدم إدراك الله في كلام الإمام الحسين×
بين يدينا صفة أخرى من الصفات السلبيّة، وهي سلب إمكان إدراك كنه ذاته تعالى وصفاته، وقد وردت الإشارة إلى هذا المطلب بشكل واسع في كلمات الإمام الحسين×:
عدم إدراك الهويّة الذاتيّة لله من قبل أحد
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة ـ مخاطباً الله جلّ وعلا ـ:
«يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ إِلَّا هُوَ»([cdxliv]).
فيدلّ الحصر الوارد في هذه الجملة على أنّه ليس لأحد العلم والاطلاع على الهويّة الذاتيّة وكيفها، وحقيقة الصفات والأسماء الإلهيّة.
ورد عن الإمام الهادي× أنّه قال:
«يَا بَارُّ يَا وَصُولُ، يَا شَاهِدَ كُلِّ غَائِبٍ، وَيَا قَرِيبُ غَيْرَ بَعِيدٍ، وَيَا غَالِبُ غَيْرَ مَغْلُوبٍ، وَيَا مَنْ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ إِلَّا هُوَ»([cdxlv]).
عدم إدراك حقيقة الله من قبل أحد
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة ـ مخاطباً الجليل ـ:
«يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُوَ»([cdxlvi]).
إذ يتضح من مفاد هذه الجملة: ليس لأحد الاطلاع التام والكامل على حقيقة ووجود الله المتعال.
روي عن أمير المؤمنين× أنّه دعا ـ مخاطباً ربّ العزّة والجلالة ـ:
«يَا مَوْلَاهْ، يَا غَايَةَ رَغْبَتَاهْ، يَا هُوَ، يَا مَنْ هُوَ، يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُوَ، وَلَا كَيْفَ هُوَ إِلَّا هُوَ»([cdxlvii]).
عدم إدراك الله بالعيون
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء التسبيح:
«سُبْحَانَ مَنْ عَلَا فَوْقَ البَرِيَّاتِ بِالإِلَهِيَّةِ؛ فَلَا عَيْنَ تُدْرِكُهُ»([cdxlviii]).
فمن الممكن استفادة هذه النقطة من مضمون هذا الكلام، وهي أنّ الله غير قابل للإدراك بهذه العيون.
وروى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× ـ أيضاً ـ أنّه قال:
«أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا هَؤُلَاءِ المَارِقَةَ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ اللهَ بِأَنْفُسِهِمْ، يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، بَلْ هُوَ اللهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ، لا تُدْرِكُهُ الأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصارَ، وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ»([cdxlix]).
فيتحصّل من جملة «لا تُدْرِكُهُ الأَبْصارُ» أنّ الله لا يُرى بهذه العيون، ولن يُدرك بهذا الطريق.
وقال القاضي سعيد القمّي في شرحه لهذه العبارة:
«قوله×: (ولا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير) ردّ للمجسمة الظاهريّة حيث يقولون: إنّه يجيء في ليالي الجمعة في صورة أمرد على حمار. وفي الخبر: إنّ معناه (لا تدركه أبصار القلوب، فضلاً عن أبصار العيون)»([cdl]).
يقول الله تعالى:
(ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)([cdli]).
عدم خطور مبلغ جبروته على قلوب الناس
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال ـ واصفاً الله جلّ جلاله ـ:
«لَا تَتَدَاوَلُهُ الأُمُورُ، وَلَا تَجْرِي عَلَيْهِ الأَحْوَالُ، وَلَا تَنْزِلُ عَلَيْهِ الأَحْدَاثُ، وَلَا يَقْدِرُ الوَاصِفُونَ كُنْهَ عَظَمَتِهِ، وَلَا يَخْطُرُ عَلَى القُلُوبِ مَبْلَغُ جَبَرُوتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي الأَشْيَاءِ عَدِيلٌ، وَلَا تُدْرِكُهُ العُلَمَاءُ بِالبَابِهَا، وَلَا أَهْلُ التَّفْكِيرِ بِتَفْكِيرِهِمْ إِلَّا بِالتَّحْقِيقِ إِيقَاناً بِالغَيْبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ المَخْلُوقِينَ، وَهُوَ الوَاحِدُ الصَّمَدُ، مَا تُصُوِّرَ فِي الأَوْهَامِ فَهُوَ خِلَافُهُ»([cdlii]).
فيتحصّل من جملة «وَلَا يَخْطُرُ عَلَى القُلُوبِ مَبْلَغُ جَبَرُوتِهِ» عدم خطور مبلغ ومقدار جبروته سبحانه على قلب أيّ أحد؛ لأنّ جبروته لا متناهي.
وكتب القاضي سعيد القمّي في شرحه هذا الحديث:
«ردّ على من تفكّر في ذاته تعالى، إذ الجبروت كثيراً ما يستعمل في مرتبة الأحديّة الصرفة بجبرها الذوات بالاستهلاك، وقهرها الأشياء بالوصول إلى هناك.
وقوله×: (لأنّه ليس له في الأشياء عديل) دليل على ذلك»([cdliii]).
ورد عن الإمام الكاظم× أنّه قال ـ داعياً الله تعالى ـ:
«لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ؛ خَلَوْتَ فِي المَلَكُوتِ، وَاسْتَتَرْتَ بِالجَبَرُوتِ، وَحَارَتْ أَبْصَارُ مَلَائِكَتِكَ المُقَرَّبِينَ، وَذَهَلَتْ عُقُولُهُمْ فِي فِكْرِ عَظَمَتِكَ»([cdliv]).
عدم الإدراك الكامل لله بالألباب
يستفاد ـ أيضاً ـ من الحديث الأخير للإمام الحسين× من قوله «وَلَا تُدْرِكُهُ العُلَمَاءُ بِالبَابِهَا» أنّ الله تعالى لا يمكن أن يُنال أو يدرك بعقول عامّة العلماء وعلومهم؛ لأنّ ذات الله وصفاته وأسماءه وأفعاله لا متناهية، والموجود اللامتناهي لا يمكن جمعه من جميع جهاته في وجود محدود.
عن أمير المؤمنين×، قال:
«الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ القَائِلُونَ، وَلَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ العَادُّونَ، وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ المُجْتَهِدُونَ، الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الهِمَمِ، وَلَا يَنَالُهُ غَوْصُ الفِطَنِ»([cdlv]).
عدم إمكان الإدراك الكامل لله بالفكر البشري
يتضح ـ أيضاً ـ من قوله «... وَلَا أَهْلُ التَّفْكِيرِ بِتَفْكِيرِهِمْ» في الحديث الأخير للإمام الحسين×، أنّ الإدراك الكامل لذات الله وصفاته وأسمائه وأفعاله غير متيسّر بالفكر البشري.
ورد عن أمير المؤمنين علي× أنّه قال:
«لَمْ يُطْلِعِ العُقُولَ عَلَى تَحْدِيدِ صِفَتِهِ، وَلَمْ يَحْجُبْهَا عَنْ وَاجِبِ مَعْرِفَتِهِ»([cdlvi]).
عدم إدراك الله بالأوهام
يتحصّل ـ أيضاً ـ من قول «مَا تُصُوِّرَ فِي الأَوْهَامِ فَهُوَ خِلَافُهُ» الوارد في الحديث الأخير للإمام الحسين× عدم استطاعة الوهم والخيال على إدراك الله تعالى.
قال القاضي سعيد القمّي:
«قوله×: (وهو الله الواحد الصمد ما تصوّر في الأوهام فهو خلافه) يمكن أن يكون تأكيداً لنفي وصول الأفكار وامتناع إحاطة عقول ذوي الألباب إليه تعالى. ويظهر لي أنّ قوله×: (وهو الله الواحد الصّمد) دليل برأسه على استحالة تصوّر الأوهام إيّاه سبحانه، من قبيل تقدّم الدليل على المدلول، بيان ذلك:
إنّه قد ثبت بالبراهين القاطعة أنّه ـ عزّ شأنه ـ واحد وحدة حقيقيّة مقدّسة عن وجوه الكثرة مطلقاً، وهي التي نقول نحن إنّها وحدة غير عدديّة، ومن خواصّ تلك الوحدة أن لا ثاني له بوجه من الوجوه، فكلّ ما فرضته ثانياً له فهو هو لا غيره تعالى شأنه.
وأيضاً من صفات تلك الأحديّة البسيطة أنّها صمديّة، بمعنى أن لا ماهيّة للواحد بها ولا قوّة، ولا خرجت منه الأشياء، ولا هو خرج من شيء. وبالجملة، لم يكن من شيء ولم يبن عن شيء ولم يبن عنه شيء؛ فإذا كان الأمر على هذا فكلّ ما تصوّره الأوهام ـ سواء على القول بحصول الحقائق في الأذهان أو الأشباح، أو على القول بالإضافة، سواء كانت إضافة إشراقيّة أو غيرها ـ يكون ثانياً له جلّ شأنه، أمّا على القول بالحصول فظاهر، وأمّا على الإضافة مطلقاً فإنّها تستدعي جهة مناسبة بين المتضائفين ـ أيّة مناسبة قيلت ـ وليست له تعالى جهة أصلاً، وإلّا لزم الحدّ، فيكون ذلك المتصوّر غيره تعالى وثانياً له، فهو تعالى بخلاف ذلك كلّه؛ فتبصّر»([cdlvii]).
قال الإمام الصادق×:
«إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُشْبِهُ شَيْئاً، وَلَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ، وَكُلُّ مَا وَقَعَ فِي الوَهْمِ فَهُوَ بِخِلَافِهِ»([cdlviii]).
وأيضاً روي عنه× أنّه قال:
«وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الوَهْمُ، وَلَا تَصِفُهُ الالسُنُ»([cdlix]).
عدم إدراك كنه ذات الله بعقول البشر
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال ـ في وصف الله سبحانه ـ:
«احْتَجَبَ عَنِ العُقُولِ كَمَا احْتَجَبَ عَنِ الأَبْصَارِ، وَعَمَّنْ فِي السَّمَاءِ احْتِجَابهُ كَمَنْ [عَمَّنْ] فِي الأَرْضِ»([cdlx]).
يتحصّل من الجملة الأولى عدم تمكّن عقول البشر من إدراك كنه ذات الله سبحانه.
عن أمير المؤمنين×، قال:
«وَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ سَاوَاكَ بِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِكَ فَقَدْ عَدَلَ بِكَ، وَالعَادِلُ بِكَ كَافِرٌ بِمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ مُحْكَمَاتُ آيَاتِكَ، وَنَطَقَتْ عَنْهُ شَوَاهِدُ حُجَجِ بَيِّنَاتِكَ، وَأنَّكَ أَنْتَ اللهُ الَّذِي لَمْ تَتَنَاهَ فِي العُقُولِ فَتَكُونَ فِي مَهَبِّ فِكْرِهَا مُكَيَّفاً، وَلَا فِي رَوِيَّاتِ خَوَاطِرِهَا فَتَكُونَ مَحْدُوداً مُصَرَّفاً»([cdlxi]).
احتجاب الله عن المجرّدات
بما أنّ المراد من عبارة «مَن في السماء» الواردة في الحديث الأخير للإمام الحسين× هم الملائكة، وهي موجودات مجرّدة، يستنتج أنّ كنه ذاته سبحانه محجوبة حتى عن المجرّدات كالملائكة.
وبناء على هذا، فالموجودات السماويّة والأرضيّة تشترك في أنّها جميعها لا يمكنها أن تدرك حقيقة وجود الله سبحانه.
قال القاضي سعيد القمّي في شرح هذا الحديث:
«قوله×: (احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار) تأكيد لما سبق، وتأسيس لما يتلوه من قوله: (وعمن في السماء احتجابه كمن في الأرض) أي احتجب عن أهل السماء كاحتجابه عن أهل الأرض. وفي الخبر: (إنّ الملأ الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم). فإنّ الإحساس إنّما يتعلّق بما في عالم الخلق، والتعقّل إنّما يتعلّق بما في عالم الأمر، فالذي له (الخلق) و(الأمر) وفوق ذلك بما لا يتناهى يكون محتجباً عن الحسّ والعقل، بل غاية إدراك العقل أن يتصوّر الوجود بما هو عليه، ويحكم بموجب البرهان أنّ له مبدءاً يحكم في بادئ الأمر بوجوده بحكم البرهان، لكن بعد ذلك بالبراهين القاطعة يظهر له أنّه يمتنع الوصول إلى إدراكه تعالى بوجه من الوجوه، سوى ما ظهر له أوّلاً أنّ للوجود مبدءاً مبائناً لقاطبة الوجودات والموجودات.
وبالجملة، يمتنع إدراكه تعالى بالعلم الانطباعي وبالعلم الحضوري الإشراقي، لأنّه لما لم يكن له سبحانه وجه ولا حيثيّة سوى حيثيّة ذاته الأحديّة الصرفة البسيطة، فلو تعلّق به العلم على الإطلاق لكان متعلّقاً بذاته جلّ قدسه، وما حضر عند العالم ـ سواء كان صورة ذهنيّة أو موجوداً عينياً ـ لابدّ وأن يكون بينه وبين العالم علاقة وجوديّة ونسبة خاصّة وارتباط مخصوص، يصحّح العلم المطلق، وذلك الربط ليس يمكن إلّا بأن يكون وجود المعلوم حيث فرض أنّه الذات البسيطة الأحديّة هي وجودها للعالم، وإلّا لتكثّرت جهاته، وذلك مستحيل على الله تعالى، إذ العلاقة المتصوّرة بين الممكن وذات البارئ تعالى ليست إلّا علاقة المعلوليّة؛ ولا ريب أنّها علاقة ضعيفة لا يوجب حصوله تعالى للممكن، فإنّ وجود المعلول من حيث إنّه معلول هو بعينه وجوده لعلّته، أمّا وجود العلّة فليس كذلك، ولا مستلزم لذلك. كذا قيل»([cdlxii]).
فقد روي عن الزهراء‘ أنّها قالت داعية:
«الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي احْتَجَبَ عَنْ كُلِّ مَخْلُوقٍ يَرَاهُ بِحَقِيقَةِ الرُّبُوبِيَّةِ وَقُدْرَةِ الوَحْدَانِيَّةِ»([cdlxiii]).
محدوديّة الفكر في فهم ذات الله وصفاته
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال عن الله جلّ جلاله:
«يُصِيبُ الفِكْرُ مِنْهُ الإِيمَانَ بِهِ مَوْجُوداً، وَوُجُودَ الإِيمَانِ لَا وُجُودَ صِفَةٍ، بِهِ تُوصَفُ الصِّفَاتُ لَا بِهَا يُوصَفُ، وَبِهِ تُعْرَفُ المَعَارِفُ لَا بِهَا يُعْرَفُ، فَذَلِكَ اللهُ لَا سَمِيَّ لَهُ، سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ»([cdlxiv]).
يستفاد من الدلالة التضمّنية للجملة الأولى أنّ فكر البشر وعقولهم قاصرة عن فهم ذات الله وحقيقة صفاته.
قال القاضي سعيد القمّي في شرح كلام الإمام الحسين×:
«قوله×: (ويصيب الفكر منه الإيمان موجوداً) لمّا نفى× وصول الفكر إليه تعالى، ومن الضروريّ في العبوديّة وفي العبادة معرفة المعبود، والله سبحانه أمر عباده بالتفكّر وذمّ على تركه، بل المقصود من الخلق حصول المعرفة، وذلك لا يمكن إلّا بالفكر، أرشد× إلى غاية أفكار المتفكّرين وقصارى إصابة أنظار العارفين، وهو الإذعان بأنّه موجود، أي: بأنّ لعالم الوجود مبدأ من دون معرفة بحقيقة ذلك الوجود الذي نسب إليه بالقياس إلى الممكن؛ حتى أنّه× لم يجعله محكوماً عليه بذلك الوجود المقيس إلى الممكنات، فجعله حالاً من الضمير المجرور في (به) إشارة إلى أنّه ليس محكوماً عليه بذلك الوجود الذي أصاب الفكر منه بالنظر إلى عالم الإمكان، إذ الحكم بالشيء فرع معرفة المحكوم، ولا سبيل إلى معرفة وجوده الخاصّ به جلّ شأنه، ففي بادئ الفكر يحصل الإيمان الإقراري.
ثمّ بعد الأنظار العميقة والأفكار الصائبة الدقيقة يظهر للطالب أن ليس وجوده كوجودات الأشياء؛ فهو موجود لا كالموجودات، كما أنّه شيء لا كالأشياء، وعالم لا كالعلماء، وهكذا في سائر صفاته وكمالاته تعالى شأنه وتقدّست أسماؤه»([cdlxv]).
يقول أمير المؤمنين علي×:
«(اللهُ) مَعْنَاهُ المَعْبُودُ الَّذِي يَأْلَهُ فِيهِ الخَلْقُ وَيُؤْلَهُ إِلَيْهِ، وَاللهُ هُوَ المَسْتُورُ عَنْ دَرْكِ الأَبْصَارِ، المَحْجُوبُ عَنِ الأَوْهَامِ وَالخَطَرَاتِ»([cdlxvi]).
عدم إدراك الله بالحواس
ورد عن الإمام الحسين× قوله ـ مخاطباً نافع بن الأزرق ـ:
«أَصِفُ إِلَهِي بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَأُعَرِّفُهُ بِمَا عَرَّفَ بِهِ نَفْسَهُ: لَا يُدْرَكُ بِالحَوَاسِّ، وَلَا يُقَاسُ بِالنَّاسِ، فَهُوَ قَرِيبٌ غَيْرُ مُلْتَصِقٍ، وَبَعِيدٌ غَيْرُ مُتَقَصٍّ، يُوَحَّدُ وَلَا يُبَعَّضُ، مَعْرُوفٌ بِالآيَاتِ، مَوْصُوفٌ بِالعَلَامَاتِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الكَبِيرُ المُتَعالِ»([cdlxvii]).
يستفاد من جملة «لَا يُدْرَكُ بِالحَوَاسِّ» أنّ الحواس الظاهريّة لا يمكنها إدراك الله تعالى.
قال القاضي سعيد القمّي في شرحه لهذه الجملة:
«هذا بيان لوصفه سبحانه بما وصف به نفسه ولذا لم يعطف. أمّا أنّه تعالى لا يدرك بالحواس، فهو مأخوذ من قوله عز شأنه: (ﭥ ﭦ ﭧ) وذلك لأنّ المعني بها أبصار القلوب كما في الأخبار، وظاهر أنّ الحواس جواسيس القلب وعيون سلطان اللب، فكلّ شيء أدركته الحواس فإنّما توصله إلى الملك من دون التباس، فالذي لا يدركه بصائر القلوب لا يمكن أن يدركه هذه الشعوب»([cdlxviii]).
يؤيّده قول الإمام الرضا×:
«مَنْ يَصِفُ رَبَّهُ بِالقِيَاسِ لَا يَزَالُ الدَّهْرَ فِي الِالتِبَاسِ، مَائِلًا عَنِ المِنْهَاجِ، ظَاعِناً فِي الِاعْوِجَاجِ، ضَالّاً عَنِ السَّبِيلِ، قَائِلًا غَيْرَ الجَمِيلِ، أُعَرِّفُهُ بِمَا عَرَّفَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ، وَأَصِفُهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ صُورَةٍ، لَا يُدْرَكُ بِالحَوَاسِّ، وَلَا يُقَاسُ بِالنَّاسِ، مَعْرُوفٌ بِغَيْرِ تَشْبِيهٍ، وَمُتَدَانٍ فِي بُعْدِهِ لَا بِنَظِيرٍ، لَا يُمَثَّلُ بِخَلِيقَتِهِ...»([cdlxix]).
|
|
14ـ الحدّ
|
|
|
|
مقدّمة
إحدى الصفات السلبيّة لله تعالى صفة المحدوديّة والتناهي، التي يُسلب بها عنه ـ سبحانه ـ كلّ أنواع المحدوديّة، سواء ما كان منها في الذات أو الصفات أو الأفعال أو المكان أو الزمان، خلافاً لرأي الوهابيّة المعتقدون بتناهي الله تعالى ومحدوديّته.
السلفية والاعتقاد بالحدّ
قال ابن تيمية المنظّر للفكر الوهابي:
«... هذه الصفات السلبيّة وإبطال نقيضها مثل قولهم: ليس فوق العالم ولا هو داخل العالم ولا خارجه، وليس في مكان دون مكان، وليس بمتحيز ولا جوهر ولا جسم ولا له نهاية ولا حد ونحو هذه العبارات، فإنّ هذه العبارات جميعها وما يشبهها لا تُؤثَر عن أحد من الصحابة والتابعين، ولا من أئمّة الدين المعروفين، ولا يروى بها حديث عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولا توجد في شيء من كتب الله المنزلة من عنده، بل هذه هي من أقوال الجهميّة، ومن الكلام الذي اتفق السلف على ذمّه لما أحدثه من أحدثه...»([cdlxx]).
وقال أيضاً:
«... فهذا كلّه وما أشبهه شواهد ودلائل على الحدّ، ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله، وجحد آيات الله»([cdlxxi]).
مخالفة الحدّ للأزليّة الإلهيّة
عن أمير المؤمنين× أنّه قال:
«فَمَنْ وَصَفَ اللهَ فَقَدْ حَدَّهُ، وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ، وَمَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَلَهُ»([cdlxxii]).
المخالفون للحدّ من أهل السنّة
1ـ أبو جعفر الطحاوي (321 ﻫ):
«وتعالى عن الحدود والغايات، والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست»([cdlxxiii]).
2ـ ابن حبّان (354 ﻫ) في مقدّمة كتاب (الثقات):
«الحمد لله الذي ليس له حدّ محدود فيتوى، ولا له أجل معدود فيفنى، ولا يحيط به جوامع المكان، ولا يشتمل عليه تواتر الزمان، ولا يدرك نعمته بالشواهد والحواس، ولا يقاس صفات ذاته بالناس»([cdlxxiv]).
3ـ قال ابن حجر العسقلاني (852 ﻫ) حول استدلال المعتقدين بالحدّ بقولهم: «ساويت ربّك بالشيء المعدوم إذ المعدوم لا حدّ له»:
«فإنّا لا نسلّم أنّ القول بعدم الحدّ يفضي إلى مساواته بالمعدوم بعد تحقّق وجوب وجوده»([cdlxxv]).
دليل المعتقدين بالحدّ
يستفاد من ظاهر كلام المعتقدين بالحدّ والمحدوديّة لله تعالى، أنّهم ذهبوا إلى هذا القول، فراراً من الوقوع في وادي الحلول، ومن أجل التمييز وتحقيق التباين بين الخالق والمخلوق.
روى أبو سعيد الدارمي (280 ﻫ) بسنده عن ابن المبارك أنّه قد سئل:
«بم نعرف ربّنا؟ قال: بأنّه فوق العرش، فوق السماء السابعة على العرش، بائن من خلقه. قال: قلت: بحدّ؟ قال: فبأيّ شيء؟!»([cdlxxvi]).
وقال ابن عثيمين (1421ﻫ):
«فمن قال: إنّ الله محدود، أراد أنّه بائن من الخلق»([cdlxxvii]).
ويستفاد من كلام بعض المعتقدين بالحدّ، أنّ سبب عقيدة بعضهم بمحدوديّة الله سبحانه هو الردّ على الجهميّة.
قال الشيخ محمود الدشتي (665 ﻫ):
«لما كانت الجهميّة ينفون عُلوّ الله تعالى على خلقه، واستواءه على عرشه، ويقولون: إنّ الله تعالى لا يباين خلقه، وليس بينه وبينهم حدّ، ولا يتميّز عنهم؛ أنكر عليهم أهل السنّة من السلف الصالح، واشتدّ نكيرهم عليهم، حتى كفّروهم، وحذّروا منهم، وبيّنوا للناس أمرهم وتلبيسهم»([cdlxxviii]).
المناقشة
أوّلاً: أنّ السبب وراء الاعتقاد بعدم المحدوديّة عند أهل البيت^، هو الاعتقاد بأزليّة الله سبحانه؛ لأنّ حدّه يستلزم عدم أزليّته ـ كما تقدّم ذكره ـ.
ثانياً: مشكلة البينونة بين الخلق والخالق وعدم حلول الخالق في الخلق قد حلّ بنحو خاص في روايات أهل البيت^، مع الاعتقاد بعدم الحدّ والمحدوديّة للبارئ تعالى.
عن أمير المؤمنين×، قال:
«سُبْحَانَهُ هُوَ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ، وَالوَاصِفُونَ لَا يَبْلُغُونَ نَعْتَهُ، وَحَدَّ الأَشْيَاءَ كُلَّهَا عِنْدَ خَلْقِهِ، إِبَانَةً لَهَا مِنْ شَبَهِهِ وَإِبَانَةً لَهُ مِنْ شَبَهِهَا، لَمْ يَحْلُلْ فِيهَا فَيُقَالَ: هُوَ فِيهَا كَائِنٌ، وَلَمْ يَنْأَ عَنْهَا فَيُقَالَ: هُوَ مِنْهَا بَائِنٌ، وَلَمْ يَخْلُ مِنْهَا فَيُقَالَ لَهُ: أَيْنَ، لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَحَاطَ بِهَا عِلْمُهُ، وَأَتْقَنَهَا صُنْعُهُ، وَأَحْصَاهَا حِفْظُهُ، لَمْ يَعْزُبْ عَنْهُ خَفِيَّاتُ غُيُوبِ الهَوَاءِ، وَلَا غَوَامِضُ مَكْنُونِ ظُلَمِ الدُّجَى، وَلَا مَا فِي السَّمَاوَاتِ العُلَى إِلَى الأَرَضِينَ السُّفْلَى، لِكُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا حَافِظٌ وَرَقِيبٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا بِشَيْءٍ مُحِيطٌ، وَالمُحِيطُ بِمَا أَحَاطَ مِنْهَا»([cdlxxix]).
ونقل ـ أيضاً ـ عن الإمام الرضا× أنّه قال:
«خَلْقُ اللهِ الخَلْقَ حِجَابٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، وَمُبَايَنَتُهُ إِيَّاهُمْ مُفَارَقَتُهُ إِنِّيَّتَهُمْ»([cdlxxx]).
يتحصّل ـ في النتيجة ـ من روايات أهل البيت^ أنّهم مع اعتقادهم بالبينونة الخاصّة بين الخالق وخلقه، ذهبوا إلى إنكار الحدّ والمحدوديّة؛ لعدم الملازمة بين الاعتقادين.
|
|
عدم الحدّ لله في كلام الإمام الحسين×
عدم محدوديّة الكمالات الإلهيّة
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة ـ مخاطباً الله جلّ جلاله ـ:
«لَا يُبْلَغُ ثَنَاؤُكَ»([cdlxxxi]).
إنّ السبب وراء عدم قدرة أحد على بلوغ المدح والثناء الإلهي مبلغه وكما يستحقه تعالى، هو عدم محدوديّة كمالاته.
يشهد له قول أمير المؤمنين الإمام علي×:
«الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ القَائِلُونَ، وَلَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ العَادُّونَ، وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ المُجْتَهِدُونَ، الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الهِمَمِ، وَلَا يَنَالُهُ غَوْصُ الفِطَنِ»([cdlxxxii]).
عدم المحدوديّة المكانيّة لله
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال عن الله سبحانه:
«لَا تَحُلُّهُ فِي، وَلَا تُوَقِّتُهُ إِذْ، وَلَا تُؤَامِرُهُ إِنْ»([cdlxxxiii]).
إذ يتحصّل من جملة «لَا تَحُلُّهُ فِي» أنّ الله تعالى لا يحدّه مكان، ولا يحلّ في محلّ خاصّ.
قال القاضي سعيد القمّي في شرح هذه الجملة:
«معنى قوله: (لا تحلّه) على مضارع الأفعال: لا تجعل له تعالى كلمة (في) محلّاً، أي لا يصحّ إطلاق تلك الكلمة في شأنه تعالى، وإلّا لزم أن يكون له محل»([cdlxxxiv]).
ومثله ما روي عن أمير المؤمنين× حيث قال ـ واصفاً الله جلّ جلاله ـ:
«وَلَا يُقَالُ لَهُ حَدٌّ وَلَا نِهَايَةٌ، وَلَا انْقِطَاعٌ وَلَا غَايَةٌ؛ وَلَا أَنَّ الأَشْيَاءَ تَحْوِيهِ فَتُقِلَّهُ أَوْ تُهْوِيَهُ، أَوْ أَنَّ شَيْئاً يَحْمِلُهُ فَيُمِيلَهُ أَوْ يُعَدِّلَهُ [يَعْدِلَهُ]، لَيْسَ فِي الأَشْيَاءِ بِوَالِجٍ، وَلَا عَنْهَا بِخَارِجٍ»([cdlxxxv]).
عدم المحدوديّة الزمانيّة لله
جاء في الحديث الأخير للإمام الحسين×، كلمة (إذ) وهي ظرف زمان، فيكون المقصود من قوله× «لَا تُوَقِّتُهُ إِذْ» أنّ الله سبحانه لازمان له ولا بداية ولانهاية؛ لأنّه أزلي وأبدي.
قال القاضي سعيد القمّي شارحاً هذه الجملة:
«إي لا تعيّن كلمة (إذ) وإطلاقه عليه تعالى وقتاً له سبحانه، إذ تلك الكلمة للظرفيّة الزمانيّة، فلو أطلق له ـ عزّ شأنه ـ لزم أن يدخل في الوقت والزمان، وهو منزّه عن ذلك»([cdlxxxvi]).
يعضده قول أمير المؤمنين× في وصف الله سبحانه:
«إِنَّهُ لَبِكُلِّ مَكَانٍ، وَفِي كُلِّ حِينٍ وَأَوَانٍ، وَمَعَ كُلِّ إِنْسٍ وَجَانٍّ»([cdlxxxvii]).
وجود الله في كلّ مكان
قال العلّامة المجلسي: «رُوِيَ أَنَّ الحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ‘ جَاءَهُ رَجُلٌ وَقَالَ: أَنَا رَجُلٌ عَاصٍ، وَلَا أَصْبِرُ عَنِ المَعْصِيَةِ، فَعِظْنِي بِمَوْعِظَةٍ، فَقَالَ: افْعَلْ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ وَأَذْنِبْ مَا شِئْتَ، فَأَوَّلُ ذَلِكَ: لَا تَأْكُلْ رِزْقَ اللهِ وَأَذْنِبْ مَا شِئْتَ، وَالثَّانِي: اخْرُجْ مِنْ وَلَايَةِ اللهِ وَأَذْنِبْ مَا شِئْتَ، وَالثَّالِثُ: اطْلُبْ مَوْضِعاً لَا يَرَاكَ اللهُ وَأَذْنِبْ مَا شِئْتَ، وَالرَّابِعُ: إِذَا جَاءَ مَلَكُ المَوْتِ لِيَقْبِضَ رُوحَكَ فَادْفَعْهُ عَنْ نَفْسِكَ وَأَذْنِبْ مَا شِئْتَ، وَالخَامِسُ: إِذَا أَدْخَلَكَ مَالِكٌ فِي النَّارِ فَلَا تَدْخُلْ فِي النَّارِ وَأَذْنِبْ مَا شِئْتَ»([cdlxxxviii]).
حيث يتحصّل من مضمون قوله «اطْلُبْ مَوْضِعاً لَا يَرَاكَ اللهُ وَأَذْنِبْ مَا شِئْتَ» أنّ الله تعالى كان ولايزال وسيبقى في كلّ مكان، ومحيط بكلّ شيء علماً.
وروى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال عن الله سبحانه:
«لَيْسَ عَنِ الدَّهْرِ قِدَمُهُ، وَلَا بِالنَّاحِيَةِ أَمَمُهُ»([cdlxxxix]).
و(ناحية) بمعنى جانب، ويتحصّل من الجملة الثانية أنّ الله سبحانه موجود في جميع النواحي والأماكن.
قال القاضي سعيد القمّي في شرح الحديث الأخير:
«فإنّ (الناحية) بمعنى الجانب و(الأمم) بالتحريك: القصد، أي ليس يقصد ويختار لنفسه جانباً وحداً مقابلاً لحدود خلقه كأنّه جعل نفسه في حدّ وجانب اختار لنفسه، بل هو سبحانه حادّ كلّ محدود من المعقولات والمحسوسات، لا يتجاوز كلّ عن حدّه المعيّن له، كما قال: (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ)([cdxc]) وهذا ردّ على من زعم أنّ الأزل ظرف يستقرّ فيه الأزلي، وأنّ الله سبحانه جالس على العرش، أو أنّه في السماء، أو فوقها»([cdxci]).
يقول الله تعالى: (ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)([cdxcii]).
|
|
15ـ المدح والثناء
|
|
|
|
عدم إمكان المدح الكامل لله في كلام الإمام الحسين×
ورد عن الإمام الحسين× في دعاء عرفة قوله ـ مخاطباً الحقّ تعالى ـ:
«لَا يُبْلَغُ ثَنَاؤُكَ»([cdxciii]).
حيث يستفاد من إطلاق ومضمون هذه الجملة أنّ الإنسان كما أنّه لا يمكنه بلوغ مدحة الله والثناء عليه بما هو حقّه وبما يليق به بلحاظ الكم، كذلك لا يمكنه ذلك بلحاظ الكيف.
يشهد له قول الإمام الصادق×:
«لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَكَ قَوْلُ قَائِلٍ، أَنْتَ كَمَا تَقُولُ وَفَوْقَ مَا نَقُولُ»([cdxciv]).
|
|
|
|
16ـ الخفاء
|
|
|
|
عدم خفاء الأمور على الله في كلام الإمام الحسين×
عدم خفاء عالم الوجود على الله
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة ـ واصفاً الحقّ تعالى ـ:
«وَلَا تَخْفَى عَلَيْهِ الطَّلَائِعُ»([cdxcv]).
يتحصّل من مفهوم هذه الجملة أنّ عالم الوجود مكشوف بأسره لله تعالى، لا يخفى عليه شيء منه.
قال الله تعالى:
(ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ)([cdxcvi]).
عدم خفاء أحوال الإنسان عن الله
قال الإمام الحسين× في دعاء عرفة ـ مخاطباً الله سبحانه ـ:
«يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ إِغْمَاضُ الجُفُونِ، وَلَا لَحْظُ العُيُونِ، وَلَا مَا اسْتَقَرَّ فِي المَكْنُونِ، وَلَا مَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ مُضْمَرَاتُ القُلُوبِ، أَلَا كُلُّ ذَلِكَ قَدْ أَحْصَاهُ عِلْمُكَ»([cdxcvii]).
يستفاد من الكلام أعلاه أنّ حالات الإنسان لا تخفى على الله سبحانه.
وروي عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة ـ مخاطباً الله تعالى ـ:
«كَيْفَ أَشْكُو إِلَيْكَ حَالِي وَهُوَ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ، أَمْ كَيْفَ أُتَرْجِمُ بِمَقَالِي وَهُوَ مِنْكَ بَرَزَ إِلَيْكَ»([cdxcviii]).
وروي أيضاً عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة:
«وَهَذَا حَالِي لَا يَخْفَى عَلَيْكَ»([cdxcix]).
من مضمون هذا الدعاء يستفاد أنّ كلّ ما يمرّ به الإنسان واستغاثته وضوائقه معلومة عند الله تعالى.
و نقل عن الإمام الحسين× ـ أيضاً ـ قوله في دعاء المظلوم:
«تَعْلَمُ مُسْتَقَرَّنَا وَمُسْتَوْدَعَنَا، وَتَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا، وَسِرَّنَا وَعَلَانِيَتَنَا، وَتَطَّلِعُ عَلَى نِيَّاتِنَا، وَتُحِيطُ بِضَمَائِرِنَا، عِلْمُكَ بِمَا نُبْدِيهِ كَعِلْمِكَ بِمَا نُخْفِيهِ، وَمَعْرِفَتُكَ بِمَا نُبْطِنُهُ كَمَعْرِفَتِكَ بِمَا نُظْهِرُهُ، وَلَا يَنْطَوِي عَنْكَ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِنَا، وَلَا يَسْتَتِرُ دُونَكَ حَالٌ مِنْ أَحْوَالِنَا»([d]).
قال الله تعالى:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ)([di]).
و قال أيضاً:
(ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ)([dii]).
|
|
|
|
17ـ الغيبة
|
|
|
|
عدم غيبة الله في كلام الإمام الحسين×
عدم غياب الله
ورد عن الإمام الحسين× قوله ـ مخاطباً الحقّ تعالى ـ:
«كَيْفَ تَغِيبُ وَأَنْتَ الرَّقِيبُ الحَاضِرُ»([diii]).
ما يستفاد من مضمون هذه الجملة أنّ الله تعالى لا يغيب عن أيّ موجود، وإذا نسبت إليه غيبة فمنشؤها الآخرون.
قال الله تعالى: (ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)([div]).
الدليل على عدم غَيبة الله
يستفاد من الحديث الأخير للإمام الحسين× وعلى الخصوص من مضمون هذه الجملة المتقدّمة أنّ الموجود الحاضر المراقب لهذا العالم لا يغيب عن أحد أبداً، ولأنّ الله تعالى مراقب حاضر فهو لا يغيب.
نقل الكليني بسنده عن عيسى بن يونس أنّه قال:
«قَالَ ابْنُ أَبِي العَوْجَاءِ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ× فِي بَعْضِ مَا كَانَ يُحَاوِرُهُ: ذَكَرْتَ اللهَ، فَأَحَلْتَ عَلَى غَائِبٍ.
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَيْلَكَ، كَيْفَ يَكُونُ غَائِباً مَنْ هُوَ مَعَ خَلْقِهِ شَاهِدٌ، وَإِلَيْهِمْ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ، يَسْمَعُ كَلَامَهُمْ، وَيَرَى أَشْخَاصَهُمْ، وَيَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ؟!»([dv]).
|
|
|
|
ـ 18ـ المغلوبية
|
|
|
|
عدم إمكان مغلوبيّة الله في كلام الإمام الحسين×
ورد عن الإمام الحسين× خطابه في دعاء المظلوم، قائلاً:
«وَلَا يُغَالِبُكَ مُغَالِبٌ بِمَنْعَةٍ»([dvi]).
يستفاد من هذا الخطاب الموجّه إلى الله تعالى، عدم إمكان مغالبة الله تعالى من أيّ أحد حتى من قبل الظلمة والمتسلّطين، فليس لديهم أيّ وسيلة أو قدرة على ذلك مطلقاً.
ندعو في الجوشن الكبير:
«يَا غَالِباً غَيْرَ مَغْلُوبٍ»([dvii]).
|
|
|
|
19ـ الحجاب
|
|
|
|
عدم الحجاب بين الخلق والخالق في كلام الإمام الحسين×
روي عن الإمام الحسين× قوله في مناجاة عرفة:
«إِلَهِي، مَا أَقْرَبَكَ مِنِّي وَأَبْعَدَنِي عَنْكَ، وَمَا أَرْأَفَكَ بِي، فَمَا الَّذِي يَحْجُبُنِي عَنْكَ»([dviii]).
يتحصّل من صدر وذيل هذه الفقرة عدم وجود أيّ حجاب بين الله تعالى وعباده، وإن كان هناك حجاب فمن جهة العباد.
وروي ـ أيضاً ـ عن الإمام الحسين× قوله في دعاء المظلوم ـ مخاطباً الله تبارك وتعالى ـ:
«وَيَصِلُ إِلَيْكَ إِذَا احْتَجَبَتْ عَنْهُ المُلُوكُ الغَافِلَةُ»([dix]).
والمعنى المستفاد من هذه الجملة هو عدم وجود أيّ حجاب بين الله سبحانه وخلقه، ولاسيما المظلومين منهم.
قال أمير المؤمنين×:
«الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَا تُدْرِكُهُ الشَّوَاهِدُ، وَلَا تَحْوِيهِ المَشَاهِدُ، وَلَا تَرَاهُ النَّوَاظِرُ، وَلَا تَحْجُبُهُ السَّوَاتِرُ»([dx]).
|
|
|
|
20ـ العجز
|
|
|
|
عدم عجز الله في كلام الإمام الحسين×
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء المظلوم ـ مخاطباً الحقّ تعالى ـ:
«اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي سَابِقِ عِلْمِكَ، وَمُحْكَمِ قَضَائِكَ، وَجَارِي قَدَرِكَ، وَمَاضِي حُكْمِكَ، وَنَافِذِ مَشِيئَتِكَ فِي خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ، سَعِيدِهِمْ وَشَقِيِّهِمْ وَبَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ، أَنْ جَعَلْتَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عَلَيَّ قُدْرَةً فَظَلَمَنِي بِهَا، وَبَغَى عَلَيَّ لِمَكَانِهَا، وَتَعَزَّزَ عَلَيَّ بِسُلْطَانِهِ الَّذِي خَوَّلْتَهُ إِيَّاهُ، وَتَجَبَّرَ عَلَيَّ بِعُلُوِّ حَالِهِ الَّتِي جَعَلْتَهَا لَهُ، وَغَرَّهُ إِمْلَاؤُكَ لَهُ، وَأَطْغَاهُ حِلْمُكَ عَنْهُ، فَقَصَدَنِي بِمَكْرُوهٍ عَجَزْتُ عَنِ الصَّبْرِ عَلَيْهِ، وَتَغَمَّدَنِي بِشَرٍّ ضَعُفْتُ عَنِ احْتِمَالِهِ، وَلَمْ أَقْدِرْ عَلَى الِانْتِصَارِ مِنْهُ لِضَعْفِي، وَالِانْتِصَافِ مِنْهُ لِذُلِّي، فَوَكَلْتُهُ إِلَيْكَ، وَتَوَكَّلْتُ فِي أَمْرِهِ عَلَيْكَ، وَتَوَعَّدْتُهُ بِعُقُوبَتِكَ، وَحَذَّرْتُهُ سَطْوَتَكَ، وَخَوَّفْتُهُ نَقِمَتَكَ، فَظَنَّ أَنَّ حِلْمَكَ عَنْهُ مِنْ ضَعْفٍ، وَحَسِبَ أَنَّ إِمْلَاءَكَ لَهُ مِنْ عَجْزٍ»([dxi]).
يتحصّل من ذيل هذه الجملة وسياقها أنّ الله تعالى غير عاجز عن أيّ عمل مقدور، ولهذا إن أراد الانتقام من الظالمين ومعاقبتهم فله أن يفعل ذلك مباشرة، وله أن يؤخّر العقوبة نظراً لمقتضيات المصلحة، من قبيل زيادة الضرر عليه، إذ إنّ معاصيه وذنوبه ستكثر وعقوبته ستشتدّ يوماً بعد آخر، بينما الآخرون العاجزون عن الانتقام من الظلمة يقدّمون لهم الفداء ليتخلّصوا من شرّهم، حتى ظنّ الظالمون أنّ تأخير العقوبة من الله عن ضعف، والإملاء لهم عن عجز، وهيهات هيهات، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.
قال أمير المؤمنين× عن الحقّ تعالى: «كُلُّ قَادِرٍ غَيْرَهُ يَقْدِرُ وَيَعْجَزُ»([dxii]).
|
|
|
|
21ـ خُلف الوعد
|
|
|
|
عدم خلف الوعد في كلام الإمام الحسين×
روي عن الإمام الحسين× قوله في دعاء المظلوم ـ مخاطباً ربّ العزّة والجلالة ـ:
«يَا مَنْ لا يُخْلِفُ المِيعادَ»([dxiii]).
إذ يستفاد من هذه الجملة أنّ الوعود الإلهيّة قطعيّة لا تتخلّف أبداً.
ووروي ـ أيضاً ـ عن الإمام الحسين× قوله في دعاء المظلوم ـ يخاطب الله سبحانه ـ:
«وَكَادَ القُنُوطُ يَسْتَوْلِي عَلَيَّ لَوْ لَا الثِّقَةُ بِكَ وَاليَقِينُ بِوَعْدِكَ»([dxiv]).
فيتبيّن من مضمون هذا الدعاء أنّ الله سبحانه لا يخلف وعده؛ ولذا لا ييأس أولياؤه مما وعد به أبداً.
يقول الله تعالى:
(ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ)([dxv]).
|
|
|
|
22ـ الخوف
|
|
|
|
عدم عروض الخوف على الله في كلام الإمام الحسين×
ورد عن الإمام الحسين× في دعاء المظلوم ـ مخاطباً الله جلّ وعلا ـ:
«وَلَا تَخَافُ فَوْتَ فَائِتٍ»([dxvi]).
فمن مضمون وسياق هذه الجملة الواردة بشأن الظالم والمظلوم، يستنتج عدم عروض أيّ خوف على الله تعالى، ومن موارده خوف فوت أمر من أمور الظلمة أو المظلومين.
وورد عنه× إجابته على كتاب البصريين حينما سألوه عن معنى: (ﭙ ﭚ) حيث قال:
«(ﭙ ﭚ): لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيفٌ؛ كَالوَلَدِ وَسَائِرِ الأَشْيَاءِ الكَثِيفَةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ المَخْلُوقِينَ، وَلَا شَيْءٌ لَطِيفٌ كَالنَّفْسِ، وَلَا يَتَشَعَّبُ مِنْهُ البَدَوَاتُ كَالسِّنَةِ وَالنَّوْمِ، وَالخَطْرَةِ وَالهَمِّ، وَالحَزَنِ وَالبَهْجَةِ، وَالضَّحِكِ وَالبُكَاءِ، وَالخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، وَالرَّغْبَةِ وَالسَّأْمَةِ، وَالجُوعِ وَالشِّبَعِ؛ تَعَالَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَتَوَلَّدَ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيفٌ أَوْ لَطِيفٌ»([dxvii]).
ووقع في هذا الكلام أن عطفت كلمة (الخوف) على ما قبلها، ما يدلّ على عدم عروض الخوف على الله بتاتاً؛ لأنّ هذه الحالة من خواص الجسم، وهو تعالى مجرّد تام.
وروي عن الإمام الباقر× أنّه قال عن الله تعالى:
«وَلَا يَصْعَقُ لِشَيْءٍ، وَلَا يُخَوِّفُهُ شَيْءٌ، تَصْعَقُ الأَشْيَاءُ كُلُّهَا مِنْ خِيفَتِهِ»([dxviii]).
|
|
|
|
23 السِنة
|
|
|
|
عدم عروض السنة على الله في كلام الإمام الحسين×
روي عن الإمام الحسين× أنّه قال عن الله تعالى:
«وَلَا يَتَشَعَّبُ مِنْهُ البَدَوَاتُ كَالسِّنَةِ وَالنَّوْمِ»([dxix]).
و(السنة) تعني الاغفاءة، ويتأتى من كلام الإمام عدم عروض السنة والغفوة أو الإغفاءة عليه تعالى.
فقال تعالى في كتابه العزيز:
(ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)([dxx]).
قال العلّامة الطباطبائي:
«السنة بكسر السين، الفتور الذي يأخذ الحيوان في أوّل النوم، والنوم هو الركود الذي يأخذ حواس الحيوان لعوامل طبيعيّة تحدث في بدنه، والرؤيا غيره، وهي ما يشاهده النائم في منامه»([dxxi]).
|
|
|
|
24ـ النوم
|
|
|
|
عدم عروض النوم على الله في كلام الإمام الحسين×
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء الفرج ـ مخاطباً الحقّ تعالى ـ:
«اللَّهُمَّ يَا عُدَّتِي عِنْدَ شِدَّتِي، يَا غَوْثِي عِنْدَ كُرْبَتِي، احْرُسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ»([dxxii]).
من هذه الصفة «التي لا تنام» حيث يخاطب بها الله ـ جلّ جلاله ـ يتحصّل أنّ النوم لا يعرضه سبحانه أبداً.
كما ورد أيضاً عن الإمام الحسين× قوله عن الله تعالى:
«وَلَا يَتَشَعَّبُ مِنْهُ البَدَوَاتُ كَالسِّنَةِ وَالنَّوْمِ»([dxxiii]).
ومعنى (النوم) الرقاد العميق، ويتحصّل من كلام الإمام× عدم عروض النوم على الله سبحانه أبداً.
وقد ورد عن الإمام الباقر عن أبيه الإمام زين العابدين عن أبيه الإمام الحسين^ أنّه قال في شرحه لكلمة (الصمد):
«الصَّمَدُ الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ، وَالصَّمَدُ الَّذِي قَدِ انْتَهَى سُؤْدَدُهُ، وَالصَّمَدُ الَّذِي لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ، وَالصَّمَدُ الَّذِي لَا يَنَامُ، وَالصَّمَدُ الدَّائِمُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ»([dxxiv]).
فيستنتج من جملة «وَالصَّمَدُ الَّذِي لَا يَنَامُ» عدم عروض النوم على الله تعالى.
قال القاضي سعيد القمّي في شرح هذه الجملة:
«ورابعاً، بالذي لا ينام. وقد عرفت أقسام النوم، وأنّها منفيّة عن الله تعالى. وعدم النوم من لوازم التماميّة؛ لأنّ عروضه لأجل كلام القوى، أو هو نفس الكلال والضعف عن العمل، وذلك ينافي التماميّة كما شرحنا»([dxxv]).
وكتب أيضاً:
«واعلم، أنّ جميع الموجودات إنّما تأخذها السنة والنوم، ولذلك وقع في القرآن والأدعية والخطب من تقديس الله تعالى عنهما أكثر من غيرهما، أمّا نوم الحيوانات في الأيام والليالي، وكذا النبات في أيّام الشتاء، فظاهر، وكذا المعادن على ما يراه أرباب المعرفة بها، وأمّا نوم النفوس فبتعطيل قواها العقليّة وغفلتها عن عالم الأنوار الإلهيّة، وانغمارها في المحسوسات، وقعودها عن القيام بوظائف العبادات، وأمّا نوم العقول فإنّما هو بخفاء أحكامها، واستتار آثارها حين غلبة أحكام عقل آخر من جنسه، فإنّ للأسماء الإلهيّة اتصالات عقليّة وامتزاجات أحكاميّة يعرفها أهل المشارب الذوقيّة؛ فإذا غلب سلطان بعضها حسبما قدر الله برهة من الزمان اختفى آثار البعض الآخر في ذلك الأوان إلى أن يرجع الإمارة إليه ويؤول الأمر إلى ما عليه، وهكذا جرت سنّة الله التي لا تبديل لها (ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)([dxxvi]) والله ـ عزّ شأنه ـ متعال عن أن يشبه أحداً من مخلوقاته، أو يجري عليه ما هو أجراه في غيره (ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)([dxxvii]) بل، (ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ )([dxxviii]) ولا يشغله شأن عن شأن (ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ)([dxxix])(ﮨ ﮩ ﮪ)([dxxx])»([dxxxi]).
وجاء في الدعاء الحادي والثلاثين من الصحيفة السجّاديّة قول الإمام السجّاد×:
«اللَّهُمَّ وَعَلَيَّ تَبِعَاتٌ قَدْ حَفِظْتُهُنَّ، وَتَبِعَاتٌ قَدْ نَسِيتُهُنَّ، وَكُلُّهُنَّ بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ، وَعِلْمِكَ الَّذِي لَا يَنْسَى، فَعَوِّضْ مِنْهَا أَهْلَهَا، وَاحْطُطْ عَنِّي وِزْرَهَا، وَخَفِّفْ عَنِّي ثِقْلَهَا، وَاعْصِمْنِي مِنْ أَنْ أُقَارِفَ مِثْلَهَا»([dxxxii]).
قال السيد علي خان المدني في شرح هذا الدعاء:
«والعين: حقيقة في الجارحة، وهي هنا جارية مجرى التمثيل، والكلام استعارة تمثيليّة، كما صرّح به الزمخشري في آخر سورة الطور في قوله تعالى: (ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ)([dxxxiii])، قال: وهو مثل، أي: بحيث نراك ونكلؤك، انته.
وبيانه: أنّه مثّل إحاطته تعالى بجميع تبعاته بحيث لا يشذّ ولا يغيب عنه شيء منها، بإحاطة الناظر بعينه إلى الشيء به، بحيث لا يعزب ولا يغيب عنه شيء منه. ووصف العين بعدم النوم لبيان استمرار الإحاطة، إذ لو اتّصفت به احتمل شذوذ شيء من مدركاتها عنها في حالة النوم»([dxxxiv]).
|
|
|
|
25ـ الجسم
|
|
|
|
مقدّمة
عقيدة التجسيم أو القول بالجسم لله سبحانه من بين المباحث التي احتدم فيها الخلاف، واضطرم حولها الجدل بين المسلمين؛ حيث يبدو من كلمات بعضهم كابن تيمية والوهابيّة الاعتقاد بجسمانيّة البارئ تعالى، وهو ما يوجب الكفر؛ ولهذا يجدر بنا عرض هذا الموضوع بشكل تفصيلي مع ما يتخلّله من نقد ومناقشة، وقبل ذلك نشير إلى مجموعة من الأمور كتمهيد.
المعنى اللغوي للجسم
قال ابن فارس:
«الجيم والسين والميم يدلّ على تجمّع الشيء»([dxxxv]).
وقال الأزهري:
«جسم: قال الليث: الجسم يجمع البدن وأعضاءه من الناس والإبل والدواب ونحو ذلك مما عظم من الخلق الجسيم»([dxxxvi]).
وكتب الجوهري في ذلك:
«وقد جسم الشيء، أي عظم»([dxxxvii]).
وعن الفيروزآبادي:
«الجسم، (بالكسر) جماعة البدن، أو الأعضاء، ومن الناس وسائر الأنواع العظيمة الخلق»([dxxxviii]).
وبما أنّ كلّ موجود كبير أو مجتمع له امتداد وأبعاد؛ لهذا عرّف الراغب الأصفهاني الجسم بهذا النحو:
«الجسم: ما له طول وعرض وعمق»([dxxxix]).
المعنى الاصطلاحي للجسم
يتحصّل من بعض تعريفات المتكلّمين أنّ معنى (الجسم) عندهم هو نفس المعنى اللغوي المذكور في تعريفه.
فقال الباقلاني في تعريفه:
«إنّ حقيقة الجسم أنّه مؤلّف مجتمع بدليل قولهم: رجل جسيم، وزيد أجسم من عمرو، وعلماً بأنّهم يقصرون هذه المبالغة على ضرب من ضروب التأليف في جهة العرض والطول»([dxl]).
وفي تعريفه قال السيد الشريف الجرجاني:
«جوهر قابل للأبعاد الثلاثة. وقيل: الجسم هو المركّب المؤلّف من الجوهر»([dxli]).
اعتقاد ابن تيمية بالقدر المشترك بين الأجسام
يذهب ابن تيمية للاعتقاد بوجود قدر مشترك بين الأجسام في جنس المقدار، وإلى القول في الوقت ذاته بجسميّة الله تعالى.
فجاء تعبيره بهذا الصدد كالتالي:
«إنّ الأجسام بينها قدر مشترك، وهو جنس المقدار، كما يقولون ما يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه، وبينها قدر مميز، وهو حقيقة كلّ واحد وخصوص ذاته التي امتاز بها عن غيره، كما يعلم أنّ الجبل والبحر مشتركان في أصل القدر، مع العلم بأنّ حقيقة الحجر ليست حقيقة الماء»([dxlii]).
الوهابيّة والاعتقاد بالتجسيم
كلّ من فهم حقيقة التجسيم في اللغة والاصطلاح وقارنها مع آراء ابن تيمية والوهابيّة وعقائدهم، سيدرك تماماً أنّهم يعتقدون بحقيقة الجسميّة بالنسبة لله تعالى، وإن نفوا ذلك في الظاهر أو توقّفوا أحياناً. وهذا المعنى من الممكن إثباته من خلال ما يلي:
1ـ تفسير صمديّة الله
على غير المألوف يفسّر الوهابيّة (الصمد) بالنسبة لله تعالى بما هو متعارف في وصف الأجسام فقط، من قبيل: (الاجتماع) و(القوّة) التي تتنافى مع التفرّق والتمزّق والانفصال والانحلال والانضمام.
فقال ابن تيمية عن المجسّمة في (مجموع الفتاوى):
«قالوا: هو صمد، والصمد لا جوف له، وهذا إنّما يكون في الأجسام المصمتة، فإنّها لا جوف لها كما في الجبال والصخور...، وقالوا: أصل الصمد الاجتماع، ومنه تصميد المال، وهذا إنّما يعقل في الجسم المجتمع»([dxliii]).
ولكن ابن تيمية أراد من (الصمد) معنى لا يعقل في غير الجسم، وهو اقتضاء الجمع والانضمام، وأن نفي الجوف والبطن عن الله سبحانه، مستلزم لإثبات الجمع والضمّ.
فقد قال:
«قد أخبر الله تعالى في كتابه أنّه الصمد، وقد قال عامّة السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم: إنّ الصمد هو الذي لا جوف له، وقالوا: أمثال هذه العبارات التي تدلّ على أنّ معناه أنّه لا يتفرّق، واللغة تدلّ على ذلك، فإنّ هذا اللفظ وهو لفظ الصمد يقتضي الجمع والضم»([dxliv]).
إذا كانت صمديّة الله سبحانه تقتضي الجمع والانضمام، فإنّ لازمه وجود الأعيان والأشياء مجتمعة مع بعضها فيه، وهذا هو التجسيم المحال في حقّ الله سبحانه وتعالى.
2ـ تفسير كبر الله وعظمته
فسّر ابن تيمية وأنصاره كبر الله وعظمته بالمعنى الحسي.
فقال ابن تيمية:
«فإذا قيل: إنّه ما يفضل من العرش أربع أصابع، كان المعنى: ما يفضل منه شيء، والمقصود هنا بيان أنّ الله أعظم وأكبر من العرش»([dxlv]).
وهنا قاس ابن تيمية الله تعالى وعرشه بالموجودات الجسميّة.
وقال ابن عثيمين:
«وإن أردتم بكونه محدوداً: أنّ العرش محيط به، فهذا باطل، وليس بلازم، فإنّ الله تعالى مستوٍ على العرش، وإن كان} أكبر من العرش ومن غير العرش، ولا يلزم أن يكون العرش محيطاً به، بل لا يمكن أن يكون محيطاً به؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى أعظم من كلّ شيء، وأكبر من كلّ شيء، والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويّات بيمينه»([dxlvi]).
وقال ـ أيضاً ـ في موضع آخر:
«واستفهام النبي (صلى الله عليه وسلم) بـ(أين) يدلّ على أنّ لله مكاناً. ولكن يجب أن نعلم أنّ الله تعالى لا تحيط به الأمكنة؛ لأنّه أكبر من كلّ شيء»([dxlvii]).
3ـ إثبات الجزء والبعض لله
قال ابن تيمية في ردّ كلام الفخر الرازي حول نسبة القول بالأجزاء والأبعاض للحنابلة والدفاع عنهم:
«... وإن أردت أنّهم وصفوه بالصفات الخبريّة، مثل الوجه واليد، وذلك يقتضي تجزئة التبعيض، أو أنّهم وصفوه بما يقتضي أن يكون جسمًا، والجسم متبعّض ومتجزّئ، وإن لم يقولوا هو جسم. فيقال له: لا اختصاص للحنابلة بذلك، بل هو مذهب جماهير أهل الإسلام، بل وسائر أهل الملل وسلف الأمّة وأئمّتها»([dxlviii]).
وكتب أيضاً في موضع آخر:
«والكبد والطحال ونحو ذلك: هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزّه عن ذلك، منزّه عن آلات ذلك بخلاف اليد، فإنّها للعمل والفعل، وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل؛ إذ ذاك من صفات الكمال»([dxlix]).
وقال ابن عثيمين:
«مذهب أهل السنّة والجماعة أنّ لله عينين، اثنتين، ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به. وهما من الصفات الذاتيّة الثابتة بالكتاب، والسنّة...، فهما عينان حقيقيتان لا تشبهان أعين المخلوقين»([dl]).
يتحصّل من التعبير (أنّ لله عينين ... ينظر بهما حقيقة) أنّ الوهابيّة تثبت له سبحانه وتعالى آلة البصر، ولكنّهم يحترزون عن إثبات لفظها له.
قال ابن قيم الجوزية:
«وقال تعالى في آلهة المشركين المعطّلين: (ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ)([dli])، فجعل سبحانه عدم البطش والمشي والسمع والبصر دليلاً على عدم إلهيّة مَن عُدمت فيه هذه الصفات، فالبطش والمشي من أنواع الأفعال، والسمع والبصر من أنواع الصفات. وقد وصف نفسه سبحانه بضدّ صفة أربابهم، وبضدّ ما وصفه به المعطّلة والجهميّة، فوصف نفسه بالسمع والبصر، والفعل باليدين، والمجيء والإتيان، وذلك ضدّ صفات الأصنام التي جعل امتناع هذه الصفات عليها منافياً لإلهيّتها»([dlii]).
وقال الشيخ محمد خليل هراس في شرح (العقيدة الواسطيّة):
«وكيف يتأتّى حمل اليد على القدرة أو النعمة؛ مع ما ورد من إثبات الكفّ والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلّا لليد الحقيقيّة؟!»([dliii]).
4ـ إثبات الثقل لذات الله سبحانه
وكتب ابن تيمية عن رواية (الاطيط):
«وقد رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في (مختاره)، وطائفة من أهل الحديث تردّه لاضطرابه، كما فعل ذلك أبو بكر الإسماعيلي وابن الجوزي وغيرهم، لكن أكثر أهل السنّة قبلوه. وفيه قال: (إنّ عرشه أو كرسيّه وسع السموات والأرض، وإنّه يجلس عليه فما يفضل منه قدر أربعة أصابع، أو فما يفضل منه إلّا قدر أربعة أصابع، وإنّه ليئطّ به أطيط الرحل الجديد براكبه)»([dliv]).
لا شكّ أنّ الصوت ناشئ من ثقل الجسم، ولذا فإنّ هذا النقل، والذي كما يبدو في الظاهر مرضيّاً من قبل ابن تيمية، فيه دلالة ـ أيضاً ـ على عقيدته بالتجسيم.
5ـ إثبات الحركة والانتقال لله سبحانه
قال ابن باز في الإجابة على رسالة:
«فقد وصلني كتابكم الكريم الذي ذكرتهم فيه أنّكم أثناء تحقيقكم لكتاب (فضائل الأوقات) للبيهقي مرّ عليكم هذا النص: سمعت أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا محمد أحمد بن عبد الله المزي يقول: حديث النزول قد ثبت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من وجوه صحيحة، وورد في النزول ما يصدّقه وهو قوله: (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)([dlv]) والنزول والمجيء صفتان منفيتان عن الله من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال، بل هما صفتان من صفات الله بلا تشبيه، جلّ عما يقول المعطّلة لصفاته والمشبّهة بها، علوّاً كبيراً. أهـ. ولا شكّ أنّ هذا القول باطل، مخالف لما عليه أهل السنّة والجماعة»([dlvi]).
6ـ إثبات الطواف في الأرض لله سبحانه
علّق ابن قيّم الجوزية على حديث جاء فيه: «... فَأَصْبَحَ رَبُّكَ يُطِوفُ فِي الأَرْضِ...»([dlvii]):
«هذا حديث كبير جليل، تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنّه قد خرج من مشكاة النبوّة»([dlviii]).
الأدلّة العقليّة على نفي الجسميّة
استدلّ القاضي سعيد القمّي على عدم جسميّة الله سبحانه بأدلّة مستوحاة من بعض الروايات النافية للتجسيم، نشير إليها أدناه:
1ـ لقد قال:
«... لأنّه إذا كان جسماً وعرف بالجسميّة ثبتت الكيفيّة؛ إذ المعلوميّة كيفيّة، سيما بالجسميّة الصمدانيّة النورانيّة، وكذا الجسميّة والصمديّة والنوريّة كلّها كيفيّات»([dlix]).
2ـ وقال أيضاً:
«قوله: (وهو السميع البصير) إبطال ثالث، وهو أنّ الجسم إنّما يكون إدراكه للشيء ووصوله إليه بالمساس، فلا يكون من حيث هو جسم سميعاً بصيراً، فلو كان شيء نفس الجسم فلا يكون بذاته سميعاً بصيراً. وهؤلاء الأئمّة^ يثبتون السمع والبصر بذاته، وهشام ـ أيضاً ـ قائل بأنّه سميع بصير بذاته، فكيف يقولون بالجسميّة كما هو الظاهر»([dlx]).
3ـ وقال كذلك:
«إبطال رابع لهذا وهو أنّ الجسم محدود، والله تعالى لا يحدّ، فليس بجسم: أمّا أنّ الجسم محدود فلأنّه من حيث الصورة ينتهي بالبسيط وهو حدّه، وأمّا من حيث المعنى فلأنّه ينتهي تركّبه في الخارج إلى الهيولى والصورة، وفي الذهن إلى الجنس والفصل، وإلى الماهية والوجود، وكلّ ذلك تحديد؛ وأمّا أنّه تعالى ليس بمحدود فلأنّ كلّ محدود بأحد الوجوه فهو محدود، أي مركّب من أمر يعدّ أوّلاً، ومن آخر يعدّ ثانياً، فيتقدّمه جزؤه، فيكون الجزء أولى بالمبدئيّة، وقد سبق ذلك بالبيانات اللائقة»([dlxi]).
4ـ وقال أيضاً:
«قوله: (ولا يحسّ ولا يمسّ ولا يدركه الحواس) إبطال خامس؛ لأنّه لو كان جسماً لكان إدراكه الضروري بالإحساس والمساس وبالجملة، لكان مدركاً بالحواس لما قد سبق أنّ إدراك الجسم والوصول إليه إنّما يكون بالإحساس، وأقلّه إمكان ذلك، وكلّ ما يدرك بالحواس فله كيفيّة، إذ الحواس تدرك الأشياء بكيفيّاتها، وكلّ ما له كيف فهو مخلوق، إذ الكيف لا بدّ له من موضوع قابل، والقابل من حيث هو قابل لا يكون فاعلاً، والمبدأ الأوّل فاعل محض»([dlxii]).
5ـ وقال في شرح حديث آخر:
«إنّ الله سبحانه خالق الأشياء لوجوب انتهاء سلسلة الوجود إليه عزّ شأنه، والجسم والصورة من جملة الأشياء، فيكون مخلوقاً له تعالى، والله ـ جلّ مجده ـ لا يوصف بخلقه»([dlxiii]).
6ـ وقال في شرح حديث آخر:
«إنّه إذا كان جسماً أو صورة كان محدوداً متناهياً، وإذا كان محدوداً متناهياً كان محتملاً للزيادة والنقصان، وكلّ ما يحتمل ذلك يكون مخلوقاً؛ أمّا استلزام الجسم والصورة للحدّ والتناهي فلأنّ الجسم ينتهي ببسطه، وهو بالخط، وهو بالنقطة، ولأنّه قابل لفرض الأبعاد، ولأنّه يفرض فيه جزء دون جزء، وذلك حدّ هذا بحسب الظاهر، وأمّا بحسب الحقيقة فلأنّه ينتهي في التركيب الخارجي إلى المادّة والصورة، وفي التركيب العقلي إلى الأجناس والفصول وإلى الماهيّة والوجود؛ أمّا التناهي فلأنّه لو كان غير متناه لم يحتمل الزيادة والنقيصة؛ أمّا الزيادة فلأنّ إمكان الزيادة في المقدار المتصل يأبى عن اللانهاية، كما تشهد به الفطرة السليمة، وأمّا النقيصة فلأنّه إذا أفرز منه قطعة: فإمّا أن لا يصدق عليه الجسم فذلك أفحش القول، وإمّا أن يصدق فيبطل اللاتناهي، وأمّا الصورة فلأنّ تميّز الأعضاء عن بعض يستلزم التحديد، ومن البيّن أنّ الشكل والتحديد من لوازم التناهي، فما لم يكن متناهياً لم يتحقّق الصورة، وأمّا استلزام الحدّ والتناهي للزيادة والنقصان فذلك ظاهر؛ لأنّ وجود الحدّ من لوازم الكمّية، ومن خواصّ الكم قبول الزيادة والنقصان، وأمّا استلزام الزيادة والنقصان للمخلوقيّة فلأنّ الاحتمال والقبول لا بدّ له من فاعل بالضرورة»([dlxiv]).
7ـ كما قال كذلك في شرح قسم من حديث الإمام× في ردّ جسميّة البارئ تعالى:
«... إنّ مجسّم الجسم ـ أي جاعله جسماً بالجعل البسيط ـ يمتنع أن يكون جسماً، وإلّا يلزم أن يكون فاعلاً لنفسه، بناء على ما هو الحقّ من أنّ الجعل للطبيعة أوّلاً، وللأفراد بالعرض...»([dlxv]).
8ـ وقال أيضاً:
«إنّه لا شكّ في كون بعض الأشياء جسماً وبعضها مصوّرة، فلو كان الخالق جسماً أو صورة تشارك الأجسام والصورة في الحقيقة المشتركة، فكونه فاعلاً لهذا الجسم وتلك الصورة ترجيح بلا مرجّح أصلاً، لكنّه هو المنشئ بالاتفاق منّا ومن الخصم، فلا يكون جسماً ولا صورة»([dlxvi]).
9ـ وبيّن أيضاً في شرح حديث آخر:
«إنّ طبيعة الجسم والصورة تقبل الوصف، والله سبحانه لا يوصف، إذ الوصف جهة الكيفيّة، وهي توجب في موصوفها القبول، وهو تعالى فاعل محض»([dlxvii]).
10ـ كما قال كذلك في شرح حديث آخر:
«إنّه قد ثبت انتهاء سلسلة الوجود إلى واحد محض هو خالق الكثرة، فإذا كان واحداً محضاً فلا كثرة فيه بجهة من الجهات، وكان أوّل كلّ شيء، فلو كان مولود لم يكن واحداً محضاً وأوّل كلّ شيء، ولو كان مخلوقاً لم يكن أيضاً واحداً وأوّلاً، وقد فرض كذلك، وإذا كان خالقاً فلو كان جسماً فكان مخلوقاً، لأنّ الطبيعة الجسميّة طبيعة مجعولة، وهو تعالى خالق ليس بمخلوق، وكذا حكم الصورة»([dlxviii]).
11ـ وقال أيضاً:
«إنّه ليس له تعالى مكافئ، فلو كان جسماً أو صورة لكان مشابهاً للأجسام والصور، فتتركّب ذاته، سواء قيل بذاتيّة الجسم والصورة له وهو ظاهر، أو بعرضيّتهما له، إذ العرض العام يجب أن يستند إلى الذاتي العام»([dlxix]).
القرآن ونفي الجسميّة عن الله
يتأتّى من النظرة الفاحصة المتأمّلة للآيات القرآنيّة أنّ الله سبحانه منزّه ومبرّأ عن الجسم والجسمانيّة.
1ـ قال الله تعالى في كتابه العزيز:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)([dlxx]).
حيث تدلّ الآية بصراحة على سعة وجود الله سبحانه، وأنّه معنا في كلّ مكان، ومن كان هذا شأنه لا يمكنه أن يكون جسماً أو حالّاً في محلّ ما.
2ـ قال الله جلّ وعلا:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)([dlxxi]).
هذه الآية هي الأخرى تدلّ بوضوح على سعة وجود الله تعالى، وأنّه حاضر في كلّ مكان ومع كلّ أحد، وعندما يكون الإله بهذا الشكل كيف يتصوّر بشأنه الجسميّة؛ لأنّ الجسم لابدّ له من مكان؛ فإذا وجد في مكان ما خلى منه مكان آخر.
3ـ قال تبارك وتعالى:
(ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)([dlxxii]).
هذه الآية كالسابقة تدلّ على نفي الجسميّة عن الله سبحانه.
4ـ قال عزّ من قائل:
(ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)([dlxxiii]).
من الواضح جداً أنّ الله تعالى لو كان جسماً وجب أن يكون مثل جميع الأجسام وشبيهاً لها.
5ـ قال جلّ جلاله:
(ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)([dlxxiv]).
من المعلوم أنّ الله سبحانه لو كان جسماً لكان مركّباً من أجزاء، وكلّ مركّب محتاج إلى أجزائه، وهذا لا ينسجم بتاتاً مع الغنى الإلهي.
6ـ قال تبارك وتعالى:
(ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ)([dlxxv]).
وصف الله تعالى نفسه في هذه الآية بالظاهر والباطن، وإن كان جسماً لوجب أن يكون ظاهره غير باطنه (عمقه)، وفي النتيجة يلزم أنّه ليس ظاهراً وباطناً.
7ـ قال تعالى أيضاً:
(ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)([dlxxvi]).
وإن كان الله جسماً لماذا لا تدركه الأبصار؟!
أهل البيت^ ونفي الجسميّة عن الله
هناك الكثير من الروايات الصادرة عنهم^ بهذا الخصوص، نشير هنا إلى بعض منها:
فقد روي عن الإمام الهادي والإمام الجواد÷ أنّهما قالا:
«مَنْ قَالَ بِالجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ وَلَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ»([dlxxvii]).
روى سهل بن زياد عن بعض أصحابه، قال:
«كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الحَسَنِ× أَسْأَلُهُ عَنِ الجِسْمِ وَالصُّورَةِ، فَكَتَبَ: سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَلَا جِسْمٌ وَلَا صُورَةٌ»([dlxxviii]).
إلصاق تهمة (القول بالتجسيم) ببعض شخصيّات الشيعة
من الاتهامات التي أُلصقت بالشيعة القول بالتجسيم، ويعني أنّهم يعتقدون بأنّ لله تعالى جسم وأبعاد وحدود، وبهذا الصدد يعتبرون هشام بن الحكم ويونس بن عبد الرحمن أوّل القائلين بذلك.
فكتب ابن تيمية قائلاً:
«وأوّل من عرف عنه في الإسلام أنّه قال: إنّ الله جسم، [هو] هشام بن الحكم»([dlxxix]).
ويقول الدكتور القفاري:
«اشتهرت ضلالة التّجسيم بين اليهود، أوّل من ابتدع ذلك بين المسلمين هم الرّوافض، ولهذا قال الرّازي: (اليهود أكثرهم مشبّهة، وكان بدء ظهور التّشبيه في الإسلام من الرّوافض مثل هشام بن الحكم، وهشام بن سالم الجواليقي، ويونس بن عبد الرحمن القمّي وأبي جعفر الأحول)»([dlxxx]).
ومن الجدير بنا مناقشة هذه التهمة لنطهّر ثوب الشيعة من أدران هذا الزعم.
تبرئة هشام بن الحكم من القول بالتجسيم
حينما نراجع كتب المخالفين نشاهد أنّ الدليل الوحيد الذي تمسّكوا به في اتهام هشام بالتجسيم، مقولة رويت عنه وصف فيها الله تعالى بقوله: «جسم لا كالأجسام».
وهنا سنناقش هذه النسبة على مرحلتين: إحداهما في أصل هذه النسبة، وهل حقّاً صدر عنه ذلك القول، والثانية على فرض الصحّة هل فيه دلالة على التجسيم أم لا؟
المرحلة الأولى: مناقشة إسناد العبارة
ثمّة شواهد في البين تقوّي احتمال أن تكون هذه النسبة ليست سوى افتراء وتهمة. وأدناه نشير إلى بعض منها:
1ـ يعدّ هشام من أصحاب أئمّة أهل البيت^ الذين عرفوا بدفاعهم عن الحق والحقيقة، فكانت له جولات في مقارعة الحركات والتيارات المنحرفة، وسعى لإبطال شبهاتهم، فمن كان بهذا الوصف كيف يصح اتهامه بهكذا عقيدة أجنبيّة عن الفكر الإسلامي؟
2ـ عند مراجعة الكتب الرجاليّة يتبيّن أنّ هشام ويونس قد واجها مشكلة نشأت من قبل بعض أصحابهما؛ ذلك أنّ بعضهم لم يستوعبوا مشاهدة مقامهما ومنزلتهما، وهذا ما دفعهم لاتهامهما بالقول بالتجسيم؛ حسداً من عند أنفسهم، فقد نقل الكشي في رجاله عن سليمان بن جعفر أنّه قال:
«سَالتُ أَبَا الحَسَنِ الرِّضَا× عَنْ هِشَامِ بْنِ الحَكَمِ، قَالَ: فَقَالَ لِي: رَحِمَهُ اللهُ كَانَ عَبْداً نَاصِحاً، أُوذِيَ مِنْ قِبَلِ أَصْحَابِهِ؛ حَسَداً مِنْهُمْ لَهُ»([dlxxxi]).
ويونس بن عبدالرحمن هو الآخر لما رأى بعض أصحابه جلالة قدره وقربه من الإمام سعوا به عند الإمام حتى وبخه× ولامه وصار مطارداً؛ ولهذا فمن المحتمل قويّاً أن تكون الروايات الواردة في ذمّه الدالّة على التجسيم من جعل هؤلاء الأشخاص.
3ـ لم يكن هشام بن الحكم ـ بحسب اعتراف الشيعة والسنّة ـ فرداً عاديّاً، بل من متكلّمي الإماميّة وبحراً عميقاً من المعارف العقليّة.
قال الشهرستاني:
«وهذا هشام بن الحكم صاحب غور في الأصول، لا يجوز أن يغفل عن إلزاماته على المعتزلة»([dlxxxii]).
خصوصاً وأنّ عظماء الشيعة وتبعاً لأهل البيت^ قد مجّدوه وأثنوا عليه كثيراً. فهل مع وجود تلك التعبيرات يمكن اتهام هشام بهكذا تهمة؟ أو ليس مقامه ومنزلته شاهد على كذب هذه التهمة، وأنّ هذه النسبة ليست سوى افتراء؟!
4ـ بما أنّ البحث عن الله تعالى وصفاته الثبوتيّة والسلبيّة كان صعباً في ذلك العصر، وفتيّاً جدّاً في الأجواء الإسلاميّة، وأذهان الناس لم تأنس به بعد، يبدو من الطبيعي جدّاً عدم فهم كلامه بصورة دقيقة ـ على فرض صحّة النسبة ـ ومن ثمّ اتهموه بالتجسيم.
إذ من الممكن أن يكون هشام قد قال: «شيء لا كالأشياء» ولكن المستمع خال أنّه قال: «جسم لا كالأجسام» أو أنّه نقل ذلك بالمعنى، أو تصوّر أنّ لازم كلامه هو هذا، ونحن نعلم أنّ بعض الاستنتاجات والتصوّرات الخاطئة لكلام شخص ما وأقواله قد تكون مدعاة لنسبة بعض الأمور المرفوضة إليه أحياناً.
5ـ حينما نطالع كتب التراجم والسير نجد أنّ هشام كان محلّ مدح وثناء من قبل الأئمّة^ بصورة لا تتلائم أبداً مع وجود انحراف عقائدي عنده. وأدناه نشير إلى بعضها:
أ) ورد في حديث عن الإمام الصادق× أنّه قال بشأنه: «نَاصِرُنَا بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَيَدِهِ»([dlxxxiii]).
وقال أيضاً: «مِثْلُكَ فَلْيُكَلِّمِ النَّاسَ»([dlxxxiv]).
ب) لقد دعا الإمام الصادق× له، قائلاً:
«نَفَعَكَ اللهُ بِهِ، وَثَبَّتَكَ يَا هِشَامُ»([dlxxxv]).
ج) جاء في قصّة كافر قد آمن على يد الإمام الصادق×، أنّ الإمام يوكل أمر تعليمه الدين والعقيدة والشريعة إلى هشام بن الحكم([dlxxxvi]).
د) وورد ـ أيضاً ـ في حديث عن الإمام الصادق× أنّه قال بشأن هشام بن الحكم:
«هِشَامُ بْنُ الحَكَمِ رَائِدُ حَقِّنَا، وَسَائِقُ قَوْلِنَا، المُؤَيّدُ لِصِدْقِنَا، وَالدَّامِغُ لِبَاطِلِ أَعْدَائِنَا، مَنْ تَبِعَهُ وَتَبِعَ أَثَرَهُ تَبِعَنَا، وَمَنْ خَالَفَهُ وَالحَدَ فِيهِ فَقَدْ عَادَانَا وَالحَدَ فِينَا»([dlxxxvii]).
هـ) كتب الإمام الكاظم× إلى من وافى الموسم من شيعته في بعض السنين في حاجة له، فما قام بها غير هشام بن الحكم، فقال داعياً له:
«جَعَلَ اللهُ ثَوَابَكَ الجَنَّةَ»([dlxxxviii]).
و) في حديث عن الإمام الرضا× أمر فيه بولاية هشام بن الحكم([dlxxxix]).
ووردت أيضاً روايات عديدة في مدح يونس بن عبدالرحمن والثناء عليه. يكفينا في هذا الأمر خبر عبدالعزيز بن المهتدي، حيث قال:
«سَالتُ الرِّضَا×، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا القَاكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ، فَعَنْ مَنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي؟ قَالَ: خُذْ مِنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ»([dxc]).
فهل يمكن اتهام من ورد بشأنه المدح والثناء من قبل أهل البيت^ بهذه الصورة؟!
6ـ عند مراجعة روايات هشام بن الحكم ويونس بن عبدالرحمن التي نقلاها عن المعصومين حول توحيد الله وصفاته، نلاحظ عدم انسجامها مع عقيدة التجسيم بتاتاً. وأدناه نشير إلى بعض من هذه الروايات:
أ) روى هشام بن الحكم مناظرة وقعت بين الإمام الصادق× وأحد الكفّار، جاء فيها:
«... غَيْرَ أَنَّهُ لَا جِسْمَ وَلَا صُورَةَ وَلَا يُحَسُّ وَلَا يُجَسُّ وَلَا يُدْرَكُ بِالحَوَاسِّ الخَمْسِ، لَا تُدْرِكُهُ الأَوْهَامُ، وَلَا تَنْقُصُهُ الدُّهُورُ، وَلَا يُغَيِّرُهُ الزَّمَانُ»([dxci]).
ب) وروى يونس بن عبدالرحمن، قال:
«قُلْتُ لِأَبِي الحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ÷: لِأَيِّ عِلَّةٍ عَرَجَ اللهُ بِنَبِيِّهِ| إِلَى السَّمَاءِ، وَمِنْهَا إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى، وَمِنْهَا إِلَى حُجُبِ النُّورِ، وَخَاطَبَهُ وَنَاجَاهُ هُنَاكَ، وَاللهُ لَا يُوصَفُ بِمَكَانٍ؟ فَقَالَ×: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُوصَفُ بِمَكَانٍ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ زَمَانٌ، وَلَكِنَّهُ} أَرَادَ أَنْ يُشَرِّفَ بِهِ مَلَائِكَتَهُ وَسُكَّانَ سَمَاوَاتِهِ، وَيُكْرِمَهُمْ بِمُشَاهَدَتِهِ، وَيُرِيَهُ مِنْ عَجَائِبِ عَظَمَتِهِ مَا يُخْبِرُ بِهِ بَعْدَ هُبُوطِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَا يَقُولُ المُشَبِّهُونَ، (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)([dxcii])»([dxciii]).
فيونس بعد سؤاله للإمام وقناعته واعتقاده بجوابه، ذهب للقول بعدم التجسيم؛ ولهذا فهو روى هذه الرواية عن الإمام موسى بن جعفر÷ إيماناً واعتقاداً بجوابه.
المرحلة الثانية: مناقشة محتوى العبارة
أثبتنا في المرحلة المتقدّمة أنّ أصل هذا الإسناد غير صحيح، ولا يعدو عن كونه اتهاماً لا أساس له، ونحن الآن بصدد مناقشة تلك العبارة المنسوبة إليه على فرض صحّتها، والتي أدّت إلى اتهام هشام بعقيدة التجسيم، وهي وصفه لله تعالى: «جسم لا كالأجسام».
وقبل كلّ شيء لابدّ من التنبيه على نقطة مفصليّة، وهي عدم الاكتفاء بالرجوع إلى اللغة فقط في فهم جملة أو كلمة، وعلى الخصوص حينما تكون قد صدرت من خبير متخصّص، فلابدّ من ملاحظة قصد المتكلّم؛ وبعبارة أخرى: ينبغي فهم الاصطلاح الخاص؛ لأنّ المتكلّم لربّما أراد من كلامه معنى آخر لا يمكن فهمه بمراجعة المصادر اللغويّة.
بعد هذه الملاحظة نتساءل هل أنّ هشام بن الحكم أراد من هذه الجملة المنسوبة إليه معنى خاصّاً أو أنّه أراد نفس المعنى اللغوي لكلمة (الجسم)؟
عند ملاحظة القرائن الخاصّة المحيطة بكلام هشام بن الحكم وهو قوله «جسم لا كالأجسام» ندرك أنّه أراد وقصد معنى خاصّاً، ينسجم تماماً مع تنزيه الله تعالى عن الجسميّة ولوازمها، وهو أنّ مقصوده من كلمة (جسم) موجود ثابت وشيء قائم بالنفس.
وهذا المعنى نفسه نقله أبو الحسن الأشعري عن هشام بخصوص المراد من (الجسم)، فقد ذكر في كتابه (مقالات الإسلاميين) عن هشام بن الحكم ذلك، حيث قال:
«معنى الجسم أنّه موجود، وكان يقول: إنّما أريد بقولي جسم: أنّه موجود، وأنّه شيء، وأنّه قائم بنفسه»([dxciv]).
كما نقل الكشي ـ أيضاً ـ عن هشام ويونس أنّهما زعما أنّ إثبات الشيء أن يقال: جسم([dxcv]).
والنتيجة هي أنّ رأي هشام ويونس بالنسبة لله لا يختلف عن الآخرين بلحاظ المعنى، ما عدا الاختلاف في التعبير. ومن القرائن الأخرى التي يمكن عدّها شواهد على هذا المعنى:
1ـ القرينة اللفظيّة
رغم أنّ هشام وصف الله بالجسميّة ولكنّه أتبع وصفه ذلك بكلمة يمكنها صرف كلمة (جسم) عن معناها اللغوي إلى معنى آخر؛ لأنّه قال: «جسم لا كالأجسام» ، وهذا يدلّ على إرادة هشام معنى خاصّاً من تلك الكلمة.
2ـ القرينة الخارجيّة
عند ملاحظة القرينة الخارجيّة المكتنفة لتعبير «هو جسم لا كالأجسام» المنسوب لهشام بن الحكم، ندرك ـ أيضاً ـ عدم انسجامه مع مدّعى الخصم، وهو الاعتقاد بالتجسيم، لأنّ هذه الجملة أوردها هشام عند المحاجّة مع العلاف ـ شيخ المعتزلة ـ بناءً على نقل الشهرستاني، حيث قال له:
«إنّك تقول: الباري تعالى عالم بعلم، وعلمه ذاته، فيشارك المحدثات في أنّه عالم بعلم، ويباينها في أنّ علمه ذاته، فيكون عالماً لا كالعالمين، فلم لا تقول: إنّه جسم لا كالأجسام، وصورة لا كالصور؟...»([dxcvi]).
فمن مثل هذا التعبير يفهم جيّداً أنّ هشام كان بصدد معارضة العلاف والنقض عليه، لا بصدد بيان عقيدته هو، وليس من الضرورة الاعتقاد بكلّ ما يقال عند المحاجّة والنقض على الخصوم؛ لاحتمال أن يكون قصده من ذلك اختبار العلاف، كما فهم الشهرستاني هذا الأمر أيضاً.
وعلى فرض استفادة التجسيم من هذه العبارة فمن الممكن أن يكون صدورها منه حينما كان على مذهب الجهميّة([dxcvii])وقبل أن يهديه الله ببركة آل محمد^؛ باعتبار أنّ الجهميّة قائلون بالتجسيم، ولكنّه بعد الدخول إلى مذهب أهل البيت^ عارض التجسيم وواجهه تبعاً لهم.
3ـ الاختلاف في معنى الجسم
صرّح متكلّمو الفريقين على أنّ كلمة (الجسم) من الألفاظ الاصطلاحيّة التي وقع الاختلاف في معناها، فقال أبو الحسن الأشعري ـ من أئمّة أهل السنّة ـ:
«اختلف المتكلّمون في الجسم ما هو، على اثنتي عشرة مقالة»([dxcviii]).
وقال ابن تيمية:
«وحقيقة الأمر أنّ لفظ (الجسم) فيه منازعات لفظيّة ومعنويّة»([dxcix]).
وقال في موضع آخر:
«لفظ (الجسم) و(الحيّز) و(الجهة) ألفاظ فيها إجمال وإبهام، وهي ألفاظ اصطلاحيّة، وقد يراد بها معان متنوّعة»([dc]).
وكتب كذلك:
«فمن هؤلاء من أطلق عليه لفظ (الجسم)، وأراد به القائم بنفسه أو الموجود»([dci]).
4ـ «جسم لا كالأجسام» عبارة شائعة
حينما نتصفّح كتب أهل السنّة، نلاحظ كثرة استعمال مقولة «جسم لا كالأجسام» المنسوبة لهشام، وشيوعها بين علماء أهل السنّة، وإليك منها:
قول ابن تيمية:
«ولهذا صار كثير من أهل الإسلام إلى أن يعتقد في الخالق أنّه جسم لا يشبه سائر الأجسام، وعلى هذا الحنابلة وكثير ممن تبعهم»([dcii]).
قول ابن حزم:
«ومن قال أنّ الله تعالى جسم لا كالأجسام فليس مشتبهاً، لكنّه ألحد في أسماء الله تعالى؛ إذ سمّاه} بما لم يسمّ به نفسه»([dciii]).
بالإجابة عن هذه الجملة المنسوبة لهشام بن الحكم نتوصّل إلى أنّ تهمة التجسيم بمعنى الجسميّة اللغوية غير مقبولة أبداً.
ولا يتبقّى سوى بعض العبارات في كتب السير والتراجم الواردة في ذمّه، والتي منشؤها إمّا هذه الجملة المعروفة (جسم لا كالأجسام) وقد قمنا بمناقشتها، أو الحسد والعداء له.
مناقشة الروايات الذامّة لهشام بلحاظ القول بالتجسيم
هناك عدّة ردود ومناقشات للروايات التي نقلتها كتب التراجم والسير والتي اشتملت على توجيه الذمّ بلحاظ القول بالتجسيم لهشام، منها:
1ـ إنّ أغلب هذه الروايات ضعيفة من حيث السند([dciv]).
2ـ إنّها تتعارض ـ بالإضافة إلى قلّتها ـ مع الروايات الصحيحة والمستفيضة المرويّة عن الأئمّة^ في بيان منزلة ومقام وفضيلة هشام.
3ـ من الممكن أن تحمل تلك الروايات على التجسيم اللفظي واللغوي، بمعنى أنّ هشام رغم عقيدته الصحيحة والسالمة ولكنّه اُنتقد وذُم لاستعماله هذا التعبير، الذي أصبح سُبّة ومثلبة على الشيعة بيد الأعداء.
4ـ من الممكن القول: إنّ أئمّة الشيعة قد ذمّوا وانتقدوا أصل هذه الفكرة والعقيدة المنسوبة لهشام، وإن لم يقبلوا نسبتها إليه، من باب أنّه لو فرض صدور ذلك منه لكان باطلاً واستحقّ الذمّ عليه؛ لأنّ الإمام حينما أحسّ بالخطر نتيجة إشاعة نظريّة التجسيم في المجتمع، صار بصدد إفهام الناس أنّ هذا الكلام باطل من أيّ أحد صدر؛ رغم أنّكم تنسبون هكذا شيء لهشام، وعليه لم يكن الإمام بصدد تأييد هشام أو ردّه.
آراء علماء الشيعة في مسألة التجسيم
بما أنّ الوهابيّة نسبوا لعلماء الشيعة القول بالتجسيم، اقتضى ذلك ملاحظة هذا الموضوع في ثنايا كلماتهم، للإطّلاع على صحّة أو سقم هذه الدعوى، وإليك بعض آراء علماء الشيعة بهذا الخصوص:
1ـ الشيخ الكليني (329ﻫ) عقد باباً في كتاب (الكافي) تحت عنوان (باب النهي عن الجسم والصورة)([dcv]) بحسب الروايات، وهذا بنفسه يدلّ على عدم اعتقاده بالتجسيم.
2ـ الشيخ الصدوق (381ﻫ) خصّص باباً في كتاب (التوحيد) باسم (باب أنّه} ليس بجسم ولا صورة)([dcvi]).
3ـ أبو الفتح الكراجكي (449ﻫ) أفرد باباً في كتاب (كنز الفوائد) تحت عنوان (فصل من الاستدلال على أنّ الله تعالى ليس بجسم)([dcvii]).
4ـ الشيخ الطوسي (460ﻫ) ذكر في تفسير (التبيان) جملة ممن تحرم ذبيحتهم، ومن بينهم المجسّمة([dcviii]). كما حكم في (المبسوط) بنجاسة المجسّمة، وعدّهم في زمرة الكفّار([dcix]).
5ـ العلّامة المجلسي (1110ﻫ) عقد في كتاب (بحار الأنوار) باباً عنوانه (نفي الجسم والصورة والتشبيه والحلول والاتحاد وأنّه لا يدرك بالحواسّ والأوهام والعقول والأفهام)([dcx]). وأورد بعده باباً آخر تحت عنوان (نفي الزمان والمكان والحركة والانتقال عنه تعالى وتأويل الآيات والأخبار في ذلك)([dcxi]).
6ـ آية الله الخوئي (1413ﻫ) صرّح في كتاب (الطهارة) ببطلان عقيدة التجسيم([dcxii]).
وهذا المقدار كاف في بيان اتفاق علماء الشيعة وإجماعهم على تنزيه الله تعالى من الجسم ولوازمه.
كما أنّنا بمراجعتنا للروايات المنقولة عن أهل البيت^ نجد بينها الكثير من الأحاديث الدالّة على عدم التجسيم، فوحده العلّامة المجلسي قد ذكر في كتابه (بحار الأنوار) سبعة وأربعين حديثاً حول هذه المسألة، وهذا إن دلّ على شيء إنّما يدلّ على أنّ تنزيه البارئ عن الجسم وعدم القول بالتجسيم من الأصول المسلّمة عند الشيعة.
عدم
جسميّة الله في كلام الإمام الحسين×
|
|
عدم شباهة الله بمخلوقاته
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال:
«أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا هَؤُلَاءِ المَارِقَةَ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ اللهَ بِأَنْفُسِهِمْ، يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، بَلْ هُوَ اللهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ»([dcxiii]).
بما أنّ الإمام× كان بصدد ذمّ جماعة يعتقدون أنّ الله يشبههم مع كونهم أجساماً، يفهم ضمناً عدم جسميّة الله تعالى.
روي عن أمير المؤمنين× أنّه قال:
«فَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ شَبَّهَكَ بِتَبَايُنِ أَعْضَاءِ خَلْقِكَ وَتَلَاحُمِ حِقَاقِ مَفَاصِلِهِمُ المُحْتَجِبَةِ لِتَدْبِيرِ حِكْمَتِكَ لَمْ يَعْقِدْ غَيْبَ ضَمِيرِهِ عَلَى مَعْرِفَتِكَ، وَلَمْ يُبَاشِرْ قَلْبَهُ اليَقِينُ بِأَنَّهُ لَا نِدَّ لَكَ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ تَبَرُّؤَ التَّابِعِينَ مِنَ المَتْبُوعِينَ إِذْ يَقُولُونَ: (ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﯕﮤ ﮥ ﮦ ﮧ)([dcxiv])»([dcxv]).
عدم إدراك الله بالعيون
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال:
«لا تُدْرِكُهُ الأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ»([dcxvi]).
بما أنّ كلّ ما يرى بآلة البصر (العين) فهو جسم، والله سبحانه لا يرى بهذه العين، فهو مجرّد تام، منزّه عن الجسم ولوازمه.
ورد عن الزهراء‘ قولها في دعاء:
«الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي احْتَجَبَ عَنْ كُلِّ مَخْلُوقٍ يَرَاهُ بِحَقِيقَةِ الرُّبُوبِيَّةِ وَقُدْرَةِ الوَحْدَانِيَّةِ، فَلَمْ تُدْرِكْهُ الأَبْصَارُ»([dcxvii]).
عدم الكفو لله
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه وصف الله تعالى بقوله:
«لَا مُنَازِعَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ، وَلَا كُفْوَ لَهُ يُعَادِلُهُ»([dcxviii]).
إن كان الله جسماً فسيكون له شبيه وكفو من الجسمانيّات، وطبقاً لهذا الحديث، فإنّ الله تعالى لا كفو له.
ورد في القرآن الكريم قوله تعالى:
(ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)([dcxix]).
عدم المثل المشاكل لله
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال عن الله سبحانه:
«وَلَا ضِدَّ لَهُ يُنَازِعُهُ، وَلَا سَمِيَّ لَهُ يُشَابِهُهُ، وَلَا مِثْلَ لَهُ يُشَاكِلُهُ»([dcxx]).
إنّ الله تعالى لو كان جسماً لشاكل الجسمانيّات وأشبهها، بينما الحقّ تعالى ـ وفقاً لهذا الحديث ـ لا مشاكل له.
يقول الله تبارك وتعالى:
(ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)([dcxxi]).
عدم جريان الأحوال على الله
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال عن الله سبحانه:
«لَا تَتَدَاوَلُهُ الأُمُورُ، وَلَا تَجْرِي عَلَيْهِ الأَحْوَالُ»([dcxxii]).
إنّ من خصائص الأجسام أنّها تعرضها الأحوال وتجري عليها، بيد أنّ هذا الحديث يصرّح بعدم جريان الأحوال المختلفة على الله وعدم عروضها عليه.
قال الإمام أمير المؤمنين× عن الله تعالى:
«لَا تَنَالُهُ الأَوْهَامُ فَتُقَدِّرَهُ، وَلَا تَتَوَهَّمُهُ الفِطَنُ فَتُصَوِّرَهُ، وَلَا تُدْرِكُهُ الحَوَاسُّ فَتُحِسَّهُ، وَلَا تَلْمِسُهُ الأَيْدِي فَتَمَسَّهُ، وَلَا يَتَغَيَّرُ بِحَالٍ، وَلَا يَتَبَدَّلُ فِي الأَحْوَالِ، وَلَا تُبْلِيهِ اللَّيَالِي وَالأَيَّامُ، وَلَا يُغَيِّرُهُ الضِّيَاءُ وَالظَّلَامُ»([dcxxiii]).
عدم نزول الحوادث على الله
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال:
«وَلَا تَنْزِلُ عَلَيْهِ الأَحْدَاثُ»([dcxxiv]).
إنّ من خصائص الجسم عروض الحوادث عليه، وهذا الحديث ينفي نزول الحوادث على الله تعالى.
يؤيّده ما ورد عن أمير المؤمنين× أنّه قال: «مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ دَهْرٌ فَيَخْتَلِفَ مِنْهُ الحَالُ، وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزَ عَلَيْهِ الِانْتِقَالُ»([dcxxv]).
عدم وصف الله بصفات المخلوقات
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال عن الله سبحانه: «وَلَا تُدْرِكُهُ العُلَمَاءُ بِالبَابِهَا، وَلَا أَهْلُ التَّفْكِيرِ بِتَفْكِيرِهِمْ إِلَّا بِالتَّحْقِيقِ إِيقَاناً بِالغَيْبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ المَخْلُوقِينَ»([dcxxvi]).
إنّ الجسمانيّة من صفات المخلوقات، وطبقاً لهذا الحديث لا يوصف الله تعالى بأيّ وصف من صفات المخلوقات.
روي عن الإمام الصادق× أنّه قال:
«مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلهِ وَجْهاً كَالوُجُوهِ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلهِ جَوَارِحَ كَجَوَارِحِ المَخْلُوقِينَ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ، فَلَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ وَلَا تَأْكُلُوا ذَبِيحَتَهُ، تَعَالَى اللهُ عَمَّا يَصِفُهُ المُشَبِّهُونَ بِصِفَةِ المَخْلُوقِينَ، فَوَجْهُ اللهِ أَنْبِيَاؤُهُ، وَقَوْلُهُ: (ﯣ ﯤﯥ ﯦ)([dcxxvii]) فَاليَدُ القُدْرَةُ كَقَوْلِهِ: (ﭝ ﭞ)([dcxxviii])»([dcxxix]).
مجيء الله دون تنقّل
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال:
«عُلُوُّهُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّلٍ، وَمَجِيئُهُ مِنْ غَيْرِ تَنَقُّلٍ»([dcxxx]).
إنّ المجيء دون تنقّل بين الأماكن لا ينسجم مع الجسمانيّة؛ لأنّ الحركة القائمة على التنقل بين الأماكن من خصائص الجسم، وبالنتيجة إنّ الله تعالى منزّه عن الجسميّة.
روي عن الإمام الصادق× أنّه قال: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُوصَفُ بِزَمَانٍ وَلَا مَكَانٍ وَلَا حَرَكَةٍ وَلَا انْتِقَالٍ وَلَا سُكُونٍ، بَلْ هُوَ خَالِقُ الزَّمَانِ وَالمَكَانِ وَالحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ، تَعَالَى اللهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيراً»([dcxxxi]).
عدم قياس الله بالجسمانيّات
روي عن الإمام الحسين× قوله ـ مخاطباً نافع بن الأزرق ـ:
«أَصِفُ إِلَهِي بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَأُعَرِّفُهُ بِمَا عَرَّفَ بِهِ نَفْسَهُ: لَا يُدْرَكُ بِالحَوَاسِّ، وَلَا يُقَاسُ بِالنَّاسِ، فَهُوَ قَرِيبٌ غَيْرُ مُلْتَصِقٍ، وَبَعِيدٌ غَيْرُ مُتَقَصٍّ، يُوَحَّدُ وَلَا يُبَعَّضُ، مَعْرُوفٌ بِالآيَاتِ، مَوْصُوفٌ بِالعَلَامَاتِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الكَبِيرُ المُتَعالِ»([dcxxxii]).
إنّ أوصاف الله تعالى التي ساقها الإمام× في هذا الحديث لا تتلائم مع كونه جسماً، بل تتناسب تماماً مع تجرّده.
روي عن الإمام الرضا× قوله عن الله سبحانه:
«عُرِفَ بِغَيْرِ رُؤْيَةٍ، وَوُصِفَ بِغَيْرِ صُورَةٍ، وَنُعِتَ بِغَيْرِ جِسْمٍ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الكَبِيرُ المُتَعَالِ»([dcxxxiii]).
تجرّد الله التام
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء الفرج:
«اللَّهُمَّ يَا عُدَّتِي عِنْدَ شِدَّتِي، يَا غَوْثِي عِنْدَ كُرْبَتِي، احْرُسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ»([dcxxxiv]).
فعدم نوم الله تعالى، إنّما هو لتجرّده التام وعدم جسميّته، إذ النوم من خواص الأجسام النامية.
ووصف القرآن الكريم الله تعالى بقوله:
(ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)([dcxxxv]).
لم يخرج منه شيء كثيف
ورد عن الإمام الحسين× قوله في ردّه على الكتاب الذي أرسله إليه البصريّون يسألونه فيه عن معنى (ﭙ ﭚ):
«(ﭙ ﭚ): لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيفٌ؛ كَالوَلَدِ وَسَائِرِ الأَشْيَاءِ الكَثِيفَةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ المَخْلُوقِينَ، وَلَا شَيْءٌ لَطِيفٌ كَالنَّفْسِ، وَلَا يَتَشَعَّبُ مِنْهُ البَدَوَاتُ كَالسِّنَةِ وَالنَّوْمِ، وَالخَطْرَةِ وَالهَمِّ، وَالحَزَنِ وَالبَهْجَةِ، وَالضَّحِكِ وَالبُكَاءِ، وَالخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، وَالرَّغْبَةِ وَالسَّأْمَةِ، وَالجُوعِ وَالشِّبَعِ؛ تَعَالَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَتَوَلَّدَ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيفٌ أَوْ لَطِيفٌ»([dcxxxvi]).
فالله تعالى لم يلد ولم يخرج منه جسم مادي كثيف؛ لأنّه ليس بجسم؛ لأنّ كلّ جسم فيه قابليّة على التحليل والتفكك، وإمكانيّة استخراج أشياء منه.
عن حمزة بن محمد، قال:
«كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الحَسَنِ× أَسْأَلُهُ عَنِ الجِسْمِ وَالصُّورَةِ، فَكَتَبَ×: سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَا جِسْمٌ وَلَا صُورَةٌ»([dcxxxvii]).
لم يخرج منه شيء لطيف
يتبيّن أيضاً من قول الإمام الحسين× «وَلَا شَيْءٌ لَطِيفٌ كَالنَّفْسِ» في الحديث المتقدّم، كما أنّ الله جلّ وعلا لا يخرج منه شيء كثيف كذلك هو منزّه ومبرّأ من أن يخرج منه شيء لطيف.
روى علي بن أبي حمزة عن أَبِي عَبْدِ اللهِ× أنه قال: سُبْحَانَ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ كَيْفَ هُوَ إِلَّا هُوَ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ، لَا يُحَدُّ وَلَا يُحَسُّ وَلَا يُجَسُّ وَلَا يُمَسُّ وَلَا تُدْرِكُهُ الحَوَاسُّ وَلَا يُحِيطُ بِهِ شَيْءٌ، لَا جِسْمٌ وَلَا صُورَةٌ وَلَا تَخْطِيطٌ وَلَا تَحْدِيدٌ»([dcxxxviii]).
ملازمة أحديّة الله لنفي التجسيم
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء الاستجابة ـ مخاطباً الحقّ تعالى ـ:
«أَسْأَلُكَ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الحَيُّ القَيُّومُ، الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﯕﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)»([dcxxxix]).
تمّت الإشارة في بحث التوحيد الأحدي بأنّ الله تعالى بسيط ومنزّه عن كلّ أنواع التركيب، وموجود يتصف بهذا الوصف لن يكون جسماً؛ لأنّ الجسم موجود ذو أبعاد ثلاثة.
روي عن الإمام الباقر× أنّه قال:
«الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا وَوَفَّقَنَا لِعِبَادَتِهِ، الأَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِي (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﯕﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)»([dcxl]).
|
|
|
|
26ـ الكفؤ
|
|
|
|
عدم الكفؤ لله في كلام الإمام الحسين×
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال:
«لَا مُنَازِعَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ، وَلَا كُفْوَ لَهُ يُعَادِلُهُ، وَلَا ضِدَّ لَهُ يُنَازِعُهُ، وَلَا سَمِيَّ لَهُ يُشَابِهُهُ، وَلَا مِثْلَ لَهُ يُشَاكِلُهُ»([dcxli]).
يتحصّل من مفهوم «وَلَا كُفْوَ لَهُ يُعَادِلُهُ» أنّ غير الله سبحانه لهم أكفّاء يعادلونهم.
وورد ـ أيضاً ـ عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة:
«سُبْحَانَ اللهِ الوَاحِدِ الأَحَدِ الصَّمَدِ، الَّذِي (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﯕﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)([dcxlii])»([dcxliii]).
و ورد ـ أيضاً ـ عن الإمام الحسين× أنّه قال في الإجابة عن سؤال أهل البصرة عن معنى (الصمد):
«... لَا، بَلْ هُوَ (ﭖ ﭗ) الَّذِي لَا مِنْ شَيْءٍ، وَلَا فِي شَيْءٍ، وَلَا عَلَى شَيْءٍ، مُبْدِعُ الأَشْيَاءِ وَخَالِقُهَا، وَمُنْشِئُ الأَشْيَاءِ بِقُدْرَتِهِ، يَتَلَاشَى مَا خَلَقَ لِلْفَنَاءِ بِمَشِيَّتِهِ، وَيَبْقَى مَا خَلَقَ لِلْبَقَاءِ بِعِلْمِهِ، فَذَلِكُمُ (ﭖ ﭗ) الَّذِي (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)، (ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)، (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)»([dcxliv]).
إذ يستنتج من مجيء النكرة في سياق النفي (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) الدالّة على العموم نفي أن يكون لله تعالى أيّ كفو.
قال العلّامة الطباطبائي في شرح قوله تعالى (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ):
«... وتنفيان أن يكون له كفؤ يعدله في ذاته، أو في فعله وهو الإيجاد والتدبير، ولم يقل أحد من المليين وغيرهم بالكفؤ الذاتي، بأن يقول بتعدّد واجب الوجود عزّ اسمه، وأمّا الكفؤ في فعله وهو التدبير فقد قيل به كآلهة الوثنيّة من البشر كفرعون ونمرود من المدّعين للألوهيّة، وملاك الكفاءة عندهم استقلال من يرون ألوهيّته في تدبير ما فوّض إليه تدبيره، كما أنّه تعالى مستقلّ في تدبير من يدبّره، وهم الأرباب والآلهة، وهو ربّ الأرباب وإله الآلهة...»([dcxlv]).
قال العلّامة المصطفوي في شرح مادة (كفؤ):
«إنّ الأصل الواحد في المادّة: هو المماثلة من جهة الصفات والخصوصيّات، يقال:
هذا كفؤه أي نظيره ومثله...، ولما كان الله تعالى نوراً أزليّاً حيّاً، لا نهاية له، ولا حدّ له بوجه: فلا بدّ أن يكون كفؤه أيضاً كذلك، وهذا ممتنع، فإنّ وجود مماثل في هذه الصفات يلازم محدوديّة الواجب بسبب وجود الشريك في قباله، وكونه متناهياً وضعيفاً، وهذه الصفات من لوازم الإمكان. فالوجود الواجب لذاته وبذاته: لا بدّ أن لا يكون له كفؤ، وعلى هذا يذكر الأحد نكرة بعد النفي، وهو يدلّ على النفي الكلّى»([dcxlvi]).
|
|
|
|
27ـ السمي
|
|
|
|
عدم السميّ لله في كلام الإمام الحسين×
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال عن الله تعالى:
«يُصِيبُ الفِكْرُ مِنْهُ الإِيمَانَ بِهِ مَوْجُوداً، وَوُجُودَ الإِيمَانِ لَا وُجُودَ صِفَةٍ، بِهِ تُوصَفُ الصِّفَاتُ لَا بِهَا يُوصَفُ، وَبِهِ تُعْرَفُ المَعَارِفُ لَا بِهَا يُعْرَفُ، فَذَلِكَ اللهُ لَا سَمِيَّ لَهُ، سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ»([dcxlvii]).
يتحصّل من عبارة «لَا سَمِيَّ لَهُ» أنّ الله في وحدانيّته لا شبيه له ولا سميّ.
وعن ابن شعبة الحرّاني ـ أيضاً ـ روى في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال:
«لَا مُنَازِعَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ، وَلَا كُفْوَ لَهُ يُعَادِلُهُ، وَلَا ضِدَّ لَهُ يُنَازِعُهُ، وَلَا سَمِيَّ لَهُ يُشَابِهُهُ، وَلَا مِثْلَ لَهُ يُشَاكِلُهُ»([dcxlviii]).
فيتضح من جملة «وَلَا سَمِيَّ لَهُ يُشَابِهُهُ» عدم وجود أيّ سميّ لله تعالى يشبهه؛ لمكان مجيء النكرة في سياق النفي الدال على العموم.
قال القاضي سعيد القمّي:
«وكذا لا سميّ له تعالى يشابهه في صفاته الحقيقية وكمالاته الذاتيّة، حيث لا يطلق على غيره اسمه الخصيص به عزّ شأنه كالاسم (الله) و(الرحمن) لا في الجاهليّة ولا في الإسلام. ومفاسد الاشتراك في الصفات الذاتيّة ـ حسبما يصطلحونها ـ قد سبقت الإشارة إليها، مع أنّا قد بسطنا القول في ذلك في بعض مسفوراتنا»([dcxlix]).
يشهد له ما ورد عن الإمام السجّاد× في أحد الأدعية، حيث قال ـ واصفاً الله جلّ جلاله ـ:
«لَا ضِدَّ لَهُ، وَلَا نِدَّ لَهُ، وَلَا وَلَدَ لَهُ، وَلَا صَاحِبَةَ لَهُ، وَلَا سَمِيَّ لَهُ، وَلَا قَرِيبَ لَهُ، وَلَا كُفْوَ لَهُ، وَلَا شَبِيهَ لَهُ، وَلَا نَظِيرَ لَهُ»([dcl]).
|
|
28ـ المثل الموافق
|
|
|
|
مقدّمة
من الصفات السلبيّة الأخرى لله تعالى نفي المثل والمثال عنه سبحانه.
وكتب العلّامة المصطفوي في بيانه لمادّة (مثل):
«إنّ الأصل الواحد في المادّة: هو مساواة شيء بشيء في الصفات الممتازة المنظورة، وهذا مشابهة تامة، والشكل متشابهة في الصفات الظاهريّة الصوريّة، والشبه: مطلق مشابهة كلّاً أو جزءاً في الصفات الظاهريّة أو من جهات معنويّة...، والمماثلة والتماثل: يلاحظ فيهما جهة التداوم والاستمرار...»([dcli]).
أدلّة نفي المثل
1ـ المماثلة تقع في الماهيّة، ولما كان الله تعالى لا ماهيّة له، فلا مثل له.
2ـ التماثل بين شيئين يقتضي اشتراكهما في اللوازم الذاتيّة، ومن لوازم الله الذاتيّة (القدم)، ومن اللوازم الذاتيّة لغير الله (الحدوث)، وإذا كانت ذات الله تعالى متماثلة مع ذات غيره، فمعنى ذلك أنّ (الحدوث) من لوازم الله القديم و(القدم) من لوازم الموجود الحادث، وبالتالي يلزم انقلاب الموجود الحادث إلى قديم، والقديم إلى حادث، وهذا خلف، فالمتحصّل امتناع مماثلة الله لغيره.
3ـ الذاتيّان إذا اشتركا في أمر لابدّ أن يتميّزا عن بعضهما في أمر عرضي، ولذا يكون (ما به الامتياز) جزء من كلّ منهما، وبالتالي إذا كان الله مشتركاً مع غيره في شيء لزم منه التركيب، وبما أنّ الله سبحانه منزّه عن التركيب، نخرج بنتيجة مفادها أنّه لا مثل له.
قال الزمخشري:
«سَأَلَ أَعْرَابِيٌّ جَعْفَرَ الصَّادِقَ عَنِ التَّوْحِيدِ، فَتَنَاوَلَ بَيْضَةً بَيْنَ يَدَيْهِ، فَوَضَعَهَا عَلَى رَاحَتِهِ، وَقَالَ: هَذَا حِصْنٌ مُمْلَقٌ لَا صَدْعَ فِيهِ، ثُمَّ مِنْ وَرَائِهِ غِرْقِيءٌ مُسْتَشِفٌّ، ثُمَّ مِنْ وَرَائِهِ دَمْعَةٌ سَائِلَةٌ، ثُمَّ مِنْ وَرَائِهَا ذَهَبٌ مَائِعٌ، ثُمَّ لَا تَنْفَكُّ الأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى تَنْفَلِقَ عَنْ طَاوُوسٍ مُلَمَّعٍ. فَأَيُّ شَيْءٍ فِي العَالَمِ إِلَّا وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»([dclii]).
عدم
المثل لله في كلام الإمام الحسين×
|
|
لا مثل لله
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال عن الله سبحانه:
«لَا مُنَازِعَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ، وَلَا كُفْوَ لَهُ يُعَادِلُهُ، وَلَا ضِدَّ لَهُ يُنَازِعُهُ، وَلَا سَمِيَّ لَهُ يُشَابِهُهُ، وَلَا مِثْلَ لَهُ يُشَاكِلُهُ»([dcliii]).
يتضح من جملة «وَلَا مِثْلَ لَهُ يُشَاكِلُهُ» عدم وجود أيّ مماثل لله جلّ وعلا؛ لأنّ النكرة في سياق النفي تفيد العموم.
وقال القاضي سعيد القمّي:
«وكذا لا مثل له في صفاته الغير الحقيقيّة كالخالقيّة والرازقيّة، وإلّا لتفرّد كلّ بما خلقه ورزقه، ولبطل هذا التدبير والنظام، حيث يرى من ارتباط الكلّ بالكلّ حتى أنّ الكلّ بمنزلة شخص واحد بأعضائه وقواه تامّ الخلقة مؤتلفاً تأليفاً طبيعيّاً مرتبطاً ارتباطاً حقيقيّاً منتظماً في رباط واحد، كما قيل: إنّ استحالة الخلأ وامتناع خلوّ الأجسام المستقيمة الحركات عما يحدّدها يدلّ على التلازم بين العلويّات والسفليّات؛ وامتناع قيام العرض بذاته وخلو الجوهر عن الأعراض يوجب التلازم بينهما، واللزوم والتلازم مما يجب فيهما الانتهاء إلى علّة واحدة، والأمور العالية عن الأجسام هي وسائط الفيوضات مما فوقها على ما تحتها؛ فالأجسام والجسمانيّات والأمور العالية عن المواد ينتهي إلى واحد هو القيّوم للكلّ، فثبت أنّ العالم شخص واحد، يدبّره مدبّر واحد بلا شريك»([dcliv]).
وعن الإمام الرضا×، قال:
«مَنْ يَصِفُ رَبَّهُ بِالقِيَاسِ لَا يَزَالُ الدَّهْرَ فِي الِالتِبَاسِ، مَائِلًا عَنِ المِنْهَاجِ، ظَاعِناً فِي الِاعْوِجَاجِ، ضَالًا عَنِ السَّبِيلِ، قَائِلًا غَيْرَ الجَمِيلِ، أُعَرِّفُهُ بِمَا عَرَّفَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ، وَأَصِفُهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ صُورَةٍ، لَا يُدْرَكُ بِالحَوَاسِّ، وَلَا يُقَاسُ بِالنَّاسِ، مَعْرُوفٌ بِغَيْرِ تَشْبِيهٍ، وَمُتَدَانٍ فِي بُعْدِهِ لَا بِنَظِيرٍ، لَا يُمَثَّلُ بِخَلِيقَتِهِ...»([dclv]).
الصفات المؤثّرة في عدم المثل لله
ورد عن الإمام الحسين× في دعاء عرفة أنّه قال:
«فَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ، وَلَا شَيْءٌ يَعْدِلُهُ، وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»([dclvi]).
إذ يتأتّى من عطف جملة «وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» على «فَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ» المتفرّع على أفعال وصفات الله سبحانه، التي تقدّم ذكرها في بداية دعاء عرفة، أنّ الصفات المؤثّرة في عدم وجود المماثل والنضير لله هي تلك المذكورة في البداية.
وأيضاً روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الامام الحسين× قوله:
«أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا هَؤُلَاءِ المَارِقَةَ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ اللهَ بِأَنْفُسِهِمْ، يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، بَلْ هُوَ اللهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ، لا تُدْرِكُهُ الأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصارَ، وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ»([dclvii]).
حيث يتحصّل من جملة «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» أنّ الله تعالى لا نظير له.
قال القاضي سعيد القمّي:
«ثمّ أنّه× أبطل كافّة أقاويل المشبّهين بدليل عام، وبعد ذلك يكرّ على كلّ واحد من تلك الآراء الباطلة على ما هو طريق المحاجّة وسبيل الهداية.
فقوله×: (ليس كمثله شيء) إلى قوله×: (السميع البصير) هو الدليل العام.
بيان ذلك: أمّا على تقدير كون الكاف زائدة، فظاهر في نفي المثل والشبه على الإطلاق، وأمّا على تقدير عدم الزيادة، فإنّه وإن أثبت المثل وكان تشبيهاً وذلك لسلطان الوهم على العقل في هذه النشأة، فإنّه كلّما جرّد العقل شيئاً من الغواشي واللوازم والصفات وبالغ في ذلك كمال المبالغة في نفي الجهات والحيثيّات فالوهم يلبس عليه ويتصوّر موجوداً ما في الخارج مشخّصاً مفارقاً عن غيره، منزّهاً عن سمات الجسمانيّة وجهات العقليّة، وذلك هو التشبيه، لكن لما وقع على تقدير عدم الزيادة نفي المماثلة عن المثل فهو يوجب نفي المماثل عن نفسه بالطريق الأولى.
وكذا وقع هذا التشبيه مع التصريح بنفسه في قوله: (وهو السميع البصير) لأنّهما يطلقان على الخلق أيضاً، لكن تقدّم الضمير يوجب الحصر، فنزّه عن المشاركة مع الغير، فتبصّر»([dclviii]).
قال الله جلّ وعلا:
(ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)([dclix]).
قال العلّامة المصطفوي في تفسير هذه الآية:
«الكاف حرف تشبيه، ويدلّ على معنى في غيره، ولا ينبئ عن معنى مستقلّ، بل يوجد معنى في غيره، والنفي يتعلّق بالمثل الذى وجد فيه شباهة ما، والمعنى أنّه ليس شيء وهو كالمثل له، فيكون انتفاء المثل على طريق أولى، فإنّ شيئاً شبيهاً وقريباً من المثلية إذا كان منفياً، فانتفاء نفس المثل يكون بطريق أولى.
فكلمة المثل مستعملة بمعناها الحقيقي، وليست بمعنى الذات ولا بزائدة، بل لطف التعبير في نفى المثل الذى وجد فيه شباهة بالمثليّة، وهذا التعبير أبلغ من التعبير بنفي المثل نفسه.
ولا يصحّ ـ أيضاً ـ القول بأنّ الكاف زائدة، أو أنّ المثل بمعنى الصفة: فإنّ زيادة كلمة في كلام الله تعالى غير معقولة، وقلنا إن المثل معناه المشابه في الصفات الممتازة، ولعلّ مفهوم الصفة قد جاء من صيغة المثل ـ بفتحتين ـ صفة، وأوجب اشتباهاً في تعيين حقيقة معنى المادّة»([dclx]).
|
|
29ـ الند
|
|
|
|
عدم الندّ لله في كلام الإمام الحسين×
لا ندّ لله
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة ـ مخاطباً الحقّ تعالى ـ:
«يَا اللهُ يَا اللهُ يَا بَدِيءُ يَا بَدِيعُ لَا نِدَّ لَكَ»([dclxi]).
المقصود بالندّ المثل المخالف، فيتحصّل من نفيه في هذا الدعاء عن الله تعالى عدم وجود هكذا مثل لله أيضاً.
يقول تبارك وتعالى:
(ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ)([dclxii]).
وكتب ابن الأثير:
«الأنداد: جمع ند، بالكسر، وهو مثل الشيء الذى يضادّه في أموره، وينادّه: أي يخالفه»([dclxiii]).
قال العلّامة المصطفوي في شرح مادة (ندّ):
«إنّ الأصل الواحد في المادّة: هو ما يكون مقابلاً ومخالفاً للشيء، وهو يدعى مماثلته في الأعمال والأمور، فيلاحظ في الأصل ثلاثة قيود: المقابلة، والمخالفة، والمماثلة، ومن مصاديقه: ندّ البعير، وهو خروجه عن الطاعة، واستقراره في مقام مخالف، وعمله ضدّ عمله الموافق.
والشخص النديد الذى يخالف رأى صاحبه ويقابله. والأنداد الذين يعتقد المشركون أنّهم آلهة في قبال الربّ} ويفعلون مثل فعله تعالى، وإذا لم يلاحظ في مورد هذه القيود: فهو تجوّز، كما في مطلق مفاهيم النفور، ومطلق المماثلة، ومطلق المعاداة. فظهر أنّ الندّ ليس بمعنى المثل والشبيه، كما في أغلب كتب اللغة...
قلنا: إنّ الندّ هو المخالف المقابل المماثل، فالندّ لله} يشمل كلّ ما يقع في مقابل الله مخالفاً لما يريده ومدّعياً كونه معبوداً ومطاعاً، وهذا المعنى يصدق على هوى متبع وأمير مطاع ومال محبوب وامرأة وولد وآلهة أخرى وأصنام، يعتقدون تأثيرها في الأمور. فالنظر في الند إلى جهة المقابل المخالف المماثل. وفي الآلهة إلى جهة المعبوديّة والعبادة. وفي المال والأولاد إلى جهة المحبّة والتعلّق. وفي الهوى والأمير إلى جهة الاتباع، وفي الأصنام إلى جهة التوجّه والتوسّل. ففي كلّ مورد يكون الملحوظ جهة المقابل المخالف المماثل: يكون من مصاديق الندّ، سواء كان من الآلهة أو غيرها. ثمّ إنّ التوجّه إلى الندّ وهو في مقابل الربّ وفي جهة خلافه، قطع توجّه وانحراف عن مسير الحقّ وعن خالق الخلق الذى بيده أزمّة الأمور، وهذا ضلال وإضلال، ويصير صاحبه إلى النار»([dclxiv]).
لا ندّ للقادر المطلق
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× قوله عن الله جلّ جلاله:
«لَيْسَ بِقَادِرٍ مَنْ قَارَنَهُ ضِدٌّ أَوْ سَاوَاهُ نِدٌّ»([dclxv]).
إذ يتحصّل من مضمون الجملة الثانية وعطفها على الجملة الأولى أنّ القادر المطلق لا ندّ له.
قال الله}:
(ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ)([dclxvi])
وقال القاضي سعيد القمّي:
«الندّ من شأنه الإتيان بما يأتي الندّ الآخر، فيخرج ذلك عن قدرته»([dclxvii]).
جعل الندّ لله من قبل الكافرين
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة:
«يَا مَنِ اسْتَنْقَذَ السَّحَرَةَ مِنْ بَعْدِ طُولِ الجُحُودِ، وَقَدْ غَدَوْا فِي نِعْمَتِهِ يَأْكُلُونَ رِزْقَهُ وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ، وَقَدْ حَادُّوهُ وَنَادُّوهُ»([dclxviii]).
فيتبيّن من مضمون هذه الجملة وسياقها أنّ الكافرين يجعلون لله أنداداً.
يقول الله تعالى:
(ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ)([dclxix]).
معارضة جميع الرسل للتمثيل
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة ـ مخاطباً الحقّ تعالى ـ:
«يَا مَنِ اسْتَنْقَذَ السَّحَرَةَ مِنْ بَعْدِ طُولِ الجُحُودِ، وَقَدْ غَدَوْا فِي نِعْمَتِهِ يَأْكُلُونَ رِزْقَهُ وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ، وَقَدْ حَادُّوهُ وَنَادُّوهُ وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ»([dclxx]).
إذ تستنتج مخالفة الرسل^ لجعل المثل لله وتمثيله بالمخلوقات، من الإتيان بكلمة (رسله) بصيغة الجمع، ومجيئها في سياق الحديث عن كفر السحرة.
يقول عزّ من قائل:
(ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ)([dclxxi]).
جحود المعتقدين بالندّ لله
من خلال التأمّل في الدعاء الأخير للإمام الحسين×، يتبيّن كذلك مدى جحود السحرة، حيث أتى على ذكر حالهم وانتفاعهم من نعم الله وأكلهم من رزقه، وفي الوقت ذاته لم يشكروه، بل أنكروا الجميل، وراحوا يعبدون غيره، ويجعلون له أنداداً.
يقول الله تبارك وتعالى:
(ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ)([dclxxii]).
|
|
30ـ العِدل
|
|
|
|
عدم العِدل لله في كلام الإمام الحسين×
من الصفات السلبيّة لله سبحانه عدم وجود عدل وعديل ومساوي له، وبما أنّ ذكرها جاء في أحاديث الإمام الحسين بصورة مستقلّة، سنتناولها بصورة مستقلّة أيضاً، رغم أنّها في الأصل بمعنى المثل القريب.
لا عديل لله في الموجودات
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال عن الله سبحانه:
«لَا تَتَدَاوَلُهُ الأُمُورُ، وَلَا تَجْرِي عَلَيْهِ الأَحْوَالُ، وَلَا تَنْزِلُ عَلَيْهِ الأَحْدَاثُ، وَلَا يَقْدِرُ الوَاصِفُونَ كُنْهَ عَظَمَتِهِ، وَلَا يَخْطُرُ عَلَى القُلُوبِ مَبْلَغُ جَبَرُوتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي الأَشْيَاءِ عَدِيلٌ، وَلَا تُدْرِكُهُ العُلَمَاءُ بِالبَابِهَا، وَلَا أَهْلُ التَّفْكِيرِ بِتَفْكِيرِهِمْ إِلَّا بِالتَّحْقِيقِ إِيقَاناً بِالغَيْبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ المَخْلُوقِينَ، وَهُوَ الوَاحِدُ الصَّمَدُ، مَا تُصُوِّرَ فِي الأَوْهَامِ فَهُوَ خِلَافُهُ»([dclxxiii]).
إذ يتحصّل من قوله: «لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي الأَشْيَاءِ عَدِيلٌ» والذي جاء كتعليل لما قبله، أنّ الله لا مثل له ولا نظير.
قال القاضي سعيد القمّي:
«وقوله×: (ولا يخطر على القلوب مبلغ جبروته) ردّ على من تفكّر في ذاته تعالى، إذ الجبروت كثيراً ما يستعمل في مرتبة الأحديّة الصّرفة بجبرها الذّوات بالاستهلاك، وقهرها الأشياء بالوصول إلى هناك. وقوله×: (لأنّه ليس له في الأشياء عديل) دليل على ذلك، بيان ذلك على ما قيل: إنّك إذا راجعت وجدانك علمت أنّك لا تعرف الغائب بالشاهد، معناه أنّ كلّ ما سألت عن كيفيّته فلا سبيل إلى تفهيمك إلّا أن يضرب لك مثال من مشاهداتك الظاهرة بالحسّ أو الباطنة في نفسك بالعقل.
فإذا قلت: كيف يكون الأوّل تعالى عالماً بنفسه؟
فجوابك الشافي أن يقال كما تعلم أنت نفسك فتفهم.
وإذا قلت: كيف يعلم بعلم واحد بسيط سائر المعلومات؟
فيقال: كما تضرب جواب مسألة دفعة واحدة من غير تفصيل، ثمّ تشتغل بالتفصيل.
وإذا قلت: كيف يكون علمه بشيء مبدأ وجود ذلك الشيء؟
فيقال: كما يكون توهّمك السّقوط عن الجذع مبدءاً للسّقوط.
وإذا قلت: كيف يعلم الممكنات كلّها؟
فيقال: يعلمها بالعلم بأسبابها كما تعلم حرارة الهواء في الصيف بمعرفتك تحقيقاً بأسباب الحرارة.
وإذا قلت: كيف ابتهاجه بكماله؟
فيقال: كما يكون ابتهاجك إذا كان لك كمال تتميّز به عن الخلق واستشعرت ذلك الكمال.
وبالجملة، فالمقصود أنّك لا تقدر أن تفهم شيئاً من الله إلّا بالمقايسة على نفسك.
نعم، تدرك عن نفسك أشياء تتفاوت بالكمال والنقص، فتعلم من هذا أنّ ما فهمته في حقّ الأوّل تعالى أشرف وأعلى ممّا فهمته في حقّ نفسك، فيكون ذلك إيماناً بالغيب مجملاً؛ وإلّا فتلك الزيادة التي توهّمتها لا تعرف حقيقتها، لأنّ مثل تلك الزيادة لا يوجد في حقّك؛ فإذا كان للأوّل أمر ليس له نظير فيك، فلا سبيل لك إلى فهمه ألبتّة، وذلك هو ذاته، فإنّه وجود بلا ماهيّة، هو منبع كلّ وجود.
فإذا قلت: كيف يكون وجود بلا ماهيّة؟
فلا يمكن أن يضرب لك مثال من نفسك، فلا يمكنك إذن فهم حقيقة الوجود بلا ماهيّة ـ انتهى كلامه.
وهذا التحقيق وإن كان مبنيّاً على ما استقرّ عليه رأيهم من إطلاق الوجود بلا ماهيّة على حقيقة الأوّل تعالى، إذ يرد عليه أنّه إذا لم يكن للأوّل تعالى نظير فكيف تحكم بأنّه وجود بلا ماهيّة؟ والدليل من أيّ طريق كان إنّما دلّ على أنّه موجود.
غاية ما في الباب لأجل أن يستخلص من مفاسد زيادة الوجود وموانع كونه تعالى شيئاً ذا وجود وغير ذلك من المحذورات، صحّ القول بأنّه موجود لا كالموجودات وشيء لا كالأشياء. ومن أين انحصر القول بكونه سبحانه وجوداً ومن أين ظهر أنّه وجود مع أنّه لم يرد في الأخبار والآثار عن أهل البيت^ إطلاق لفظ (الوجود) عليه تعالى، وقد ورد أنّه (علم كلّه، قدرة كلّه) وفي هذا أقوى دلالة على المنع من إطلاق لفظ (الوجود) على الله تعالى؛ إذ لو صحّ لكان هذا أولى في مقام الّتمدّح والتمجّد لله سبحانه، لأنّه كما قيل: وهو الأصل وسائر الكمالات والصّفات تابعة للوجود»([dclxxiv]).
قال الله تبارك وتعالى:
(ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ)([dclxxv]).
قال العلّامة المصطفوي في تفسير هذه الآية:
«يراد جعل شيء عدلاً وعديلاً بالله تعالى، والباء للتعدية، أي يجعلون عديلاً بربّهم، يقال عدل فلاناً بفلان: سوّى بينهما، وعدلت هذا بهذا: إذا جعلته مثله قائماً مقامه، فالمراد جعل شيء معادلاً ومثالاً بربّهم»([dclxxvi]).
معرفة الموجودات بالنظير
يستفاد ـ أيضاً ـ من مفهوم جملة «لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي الأَشْيَاءِ عَدِيلٌ» الواردة في الحديث الأخير للإمام الحسين× أنّ غير الله تعالى من الممكن معرفته بواسطة معرفة عديله ونظيره، ولكن هذه القاعدة لا تجري بالنسبة لله سبحانه؛ لأنّه ليس له عديل ولا نظير لتتسنّى معرفته من خلاله.
وروى ابن شعبة الحرّاني ـ أيضاً ـ في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× قوله عن الله سبحانه:
«لَا مُنَازِعَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ، وَلَا كُفْوَ لَهُ يُعَادِلُهُ، وَلَا ضِدَّ لَهُ يُنَازِعُهُ، وَلَا سَمِيَّ لَهُ يُشَابِهُهُ، وَلَا مِثْلَ لَهُ يُشَاكِلُهُ»([dclxxvii]).
فيستفاد من مفهوم قوله «لَا كُفْوَ لَهُ يُعَادِلُهُ» أنّ غير الله تعالى لهم أكفّاء يعادلونهم ويساوونهم.
روي عن رسول الله| أنّه قال:
«لَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا وَلَهُ شَيْءٌ يَعْدِلُهُ، إِلَّا اللهَ}، فَإِنَّهُ لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ»([dclxxviii]).
لا عدل لله في الموجودات
قال الإمام الحسين× في دعاء عرفة:
«وَلَا شَيْءٌ يَعْدِلُهُ»([dclxxix]).
و(يعدله) من مادّة (عِدل) بمعنى نظير ومثل، وبما أنّ كلمة (شيء) جاءت نكرة في سياق النفي أفادت العموم، ويكون المتأتّى من هذه الجملة: لا يمكن لأيّ شيء وموجود أن يكون نظيراً ومثلاً لله، ويساويه ويعادله.
قال الإمام أمير المؤمنين× عن الله سبحانه:
«لَا يَتَغَيَّرُ بِحَالٍ، وَلَا يَتَبَدَّلُ فِي الأَحْوَالِ، وَلَا تُبْلِيهِ اللَّيَالِي وَالأَيَّامُ، وَلَا يُغَيِّرُهُ الضِّيَاءُ وَالظَّلَامُ، وَلَا يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنَ الأَجْزَاءِ وَلَا بِالجَوَارِحِ وَالأَعْضَاءِ، وَلَا بِعَرَضٍ مِنَ الأَعْرَاضِ، وَلَا بِالغَيْرِيَّةِ وَالأَبْعَاضِ، وَلَا يُقَالُ: لَهُ حَدٌّ وَلَا نِهَايَةٌ، وَلَا انْقِطَاعٌ وَلَا غَايَةٌ، وَلَا أَنَّ الأَشْيَاءَ تَحْوِيهِ فَتُقِلَّهُ أَوْ تُهْوِيَهُ، أَوْ أَنَّ شَيْئاً يَحْمِلُهُ فَيُمِيلَهُ أَوْ يُعَدِّلَهُ»([dclxxx]).
|
|
35
|
|
ـ31ـ التداول
|
|
|
|
عدم تداول الأمور على الله في كلام الإمام الحسين×
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× قوله:
«لَا تَتَدَاوَلُهُ الأُمُورُ، وَلَا تَجْرِي عَلَيْهِ الأَحْوَالُ، وَلَا تَنْزِلُ عَلَيْهِ الأَحْدَاثُ»([dclxxxi]).
و(تداول) يعني تعاقب، ومجيء أمر عقب آخر، ويفهم من مضمون هذا الكلام أنّ الله تعالى ليس مثل الآخرين حتى تتعاقب عليه الأمور واحداً تلو الآخر، فيمنعه الانشغال بها عن غيرها.
ورد في دعاء الجوشن الكبير:
«يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ، يَا مَنْ لَا يَمْنَعُهُ فِعْلٌ عَنْ فِعْلٍ، يَا مَنْ لَا يُلْهِيهِ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ، يَا مَنْ لَا يُغَلِّطُهُ سُؤَالٌ عَنْ سُؤَالٍ، يَا مَنْ لَا يَحْجُبُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ، يَا مَنْ لَا يُبْرِمُهُ الحَاحُ المُلِحِّينَ»([dclxxxii]).
|
|
|
|
32ـ التغيير
|
|
|
|
عدم عروض التغيير على الله في كلام الإمام الحسين×
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× قوله:
«لَا تَتَدَاوَلُهُ الأُمُورُ، وَلَا تَجْرِي عَلَيْهِ الأَحْوَالُ، وَلَا تَنْزِلُ عَلَيْهِ الأَحْدَاثُ»([dclxxxiii]).
حيث يستفاد من جملة «لَا تَجْرِي عَلَيْهِ الأَحْوَالُ»، عدم عروض الحالات المختلفة على ذات الله سبحانه.
وكتب القاضي سعيد القمّي في شرحه لهذا الحديث:
«قوله×: (لا تجرى عليه الأحوال): جريان الأحوال على الشيء هو تحوّله من حال إلى حال، وهذا إنّما يكون من حدوث شيء فيه أو نزوله عليه بعد شيء، ولذلك عقّب ذلك بقوله: (ولا تنزل عليه الأحداث)»([dclxxxiv]).
وقال أيضاً:
«وبالجملة، ردّ على القائلين بقيام الصفة بالذات من المعتزلة القائلين بالأحوال، والأشاعرة القائلين بالزيادة، ونفي لتوهّم كون المرادات المتفاوتة توجب التفاوت في الذات، سواء كانت الإرادة مأخوذة من صفات الذات ـ كما عليه جمهور الحكماء وأكثر المنسوبين إلى التألّه والتحقيق من أهل الإسلام ـ أو مأخوذة من صفات الفعل، كما عليه أهل الحقّ من مقتفي آثار أهل بيت العصمة (صلوات الله عليهم)»([dclxxxv]).
وبهذا الصدد قال أمير المؤمنين×:
«لَمْ يُحْدَثْ فَيُمْكِنَ فِيهِ التَّغَيُّرُ وَالِانْتِقَالُ، وَلَمْ يُتَصَرَّفْ فِي ذَاتِهِ بِكُرُورِ الأَحْوَالِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ حُقْبُ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ...»([dclxxxvi]).
|
|
33ـ محل نزول الحوادث
|
|
|
|
مقدّمة
من جملة الصفات السلبيّة لله سبحانه عدم كونه محلّاً للحوادث.
أدلّة نفي قيام الحوادث
الدليل الأول
أ) إذا قام شيء من الحوادث في ذات الله لزم منه التغيّر، والتغيّر يعني الانتقال من حالة إلى أخرى، وبتقدير حدوث الأمر الحادث في ذات الله يلزم منه أنّ شيئاً ما قد حدث في ذاته لم يكن فيها من قبل.
ب) إنّ التغيير في الذات الإلهيّة محال؛ لأنّه يستلزم الانفعال والتأثّر، وإلّا لما عدّ تغيّراً، وهذا من صفات الماديّات، والله تعالى منزّه عنها.
النتيجة: أنّ الله تعالى ليس محلّاً للحوادث.
الدليل الثاني
أ) إنّ التغيّر وحدوث الحوادث، نتيجة لوجود الاستعداد في المادّة، وخروجه في ظلّ ظروف خاصّة من القوّة إلى الفعل.
ب) إن كان هذا المعنى صادقاً على الله لزم منه أن يكون في وجوده استعداد للخروج من القوّة إلى الفعل.
ج) هذه الحالة من شؤون الأمور الماديّة.
د) والله ليس مادّة ولا مادّي.
النتيجة: الله ليس محلّاً للحوادث.
قال العلّامة الحلّي بهذا الشأن:
«وجوب الوجود ينافي حلول الحوادث في ذاته تعالى، وهو معطوف على الزائد، وقد خالف فيه الكرامية.
والدليل على الامتناع أنّ حدوث الحوادث فيه تعالى يدلّ على تغيّره وانفعاله في ذاته، وذلك ينافي الوجوب، وأيضاً فإنّ المقتضي للحادث إن كان ذاته كان أزلياً، وإن كان غيره كان الواجب مفتقراً إلى الغير وهو محال، ولأنّه إن كان صفة كمال استحال خلوّ الذات عنه، وإن لم يكن استحال اتصاف الذات به»([dclxxxvii]).
اعتقاد ابن تيمية بقيام الحوادث في الله سبحانه
قال ابن تيمية:
«فإنّا نقول: إنّه يتحرّك وتقوم به الحوادث والأعراض، فما الدليل على بطلان قولنا؟»([dclxxxviii]).
وقال أيضاً:
«وقلنا: الكلام لا بدّ أن يقوم بالمتكلّم.
فإن قلتم لنا: قد قلتم بقيام الحوادث بالربّ. قالوا لكم: نعم، وهذا قولنا الذي دلّ عليه الشرع والعقل...»([dclxxxix]).
المناقشة
أوّلاً: إذا كانت الذات الإلهيّة قديمة، فكيف ترد عليها الأمور الحادثة وتقوم بها؟!
ثانياً: بما أنّ الحوادث مخلوقة وناقصة، كيف لها أن تكون قائمة بالموجود الكامل، ألا يلزم منه اتصاف الكامل بالناقص؟
ثالثاً: يلزم من قيام الحوادث بالله حصول التغيّر والتأثّر والانفعال في ذات الله تعالى، وهو منزّه عن مثل هذه الأمور.
أهل السنّة وامتناع قيام الحوادث بالله
قال الفخر الرازي:
«الأوّل: أنّ قيام الحوادث بذات الله محال؛ لأنّ تلك الذات إن كانت كافية في وجود تلك الصفة أو دوام عدمها لزم دوام وجود تلك الصفة أو دوام عدمها بدوام تلك الذات، وإن لم تكن كافية فيه فحينئذ تكون تلك الذات واجبة الاتصاف بوجود تلك الصفة أو عدمها، وذلك الوجود والعدم يكونان موقوفين على شيء منفصل، والموقوف على الموقوف على الغير موقوف على الغير، والموقوف على الغير ممكن لذاته، ينتج أنّ الواجب لذاته ممكن لذاته، وهو محال.
والثاني: أنّ ذاته لو كانت قابلة للحوادث لكانت قابليّة تلك الحوادث من لوازم ذاته، فحينئذ يلزم كون تلك القابليّة أزليّة لأجل كون تلك الذات أزليّة، لكن يمتنع كون قابليّة الحوادث أزليّة؛ لأنّ قابليّة الحوادث مشروط بإمكان وجود الحوادث، وإمكان وجود الحوادث في الأزل محال، فكان وجود قابليّتها في الأزل محالاً»([dcxc]).
وقال الاسفرايني:
«إنّ الحوادث لا يجوز حلولها في ذاته وصفاته؛ لأنّ ما كان محلّاً للحوادث لم يخل منها، وإذا لم يخل كان محدثاً مثلها، ولهذا قال الخليل (عليه الصلاة والسلام): (ﭺ ﭻ ﭼ)([dcxci]) بيّن به أنّ من حلّ به من المعاني ما يغيّره من حال إلى حال كان محدثاً لا يصحّ أن يكون إلهاً»([dcxcii]).
|
|
|
|
عدم نزول الحوادث على الله في كلام الإمام الحسين×
الله تعالى ليس محلّاً للحوادث
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× قوله:
«لَا تَتَدَاوَلُهُ الأُمُورُ، وَلَا تَجْرِي عَلَيْهِ الأَحْوَالُ، وَلَا تَنْزِلُ عَلَيْهِ الأَحْدَاثُ»([dcxciii]).
يتحصّل من جملة «وَلَا تَنْزِلُ عَلَيْهِ الأَحْدَاثُ» أنّ الله سبحانه لا يكون محلّاً للحوادث.
و روي أيضاً عن الإمام الحسين× قوله في الجواب على كتاب البصريين حينما سألوه عن معنى (ﭙ ﭚ):
«(ﭙ ﭚ): لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيفٌ؛ كَالوَلَدِ وَسَائِرِ الأَشْيَاءِ الكَثِيفَةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ المَخْلُوقِينَ، وَلَا شَيْءٌ لَطِيفٌ كَالنَّفْسِ، وَلَا يَتَشَعَّبُ مِنْهُ البَدَوَاتُ كَالسِّنَةِ وَالنَّوْمِ، وَالخَطْرَةِ وَالهَمِّ، وَالحَزَنِ وَالبَهْجَةِ، وَالضَّحِكِ وَالبُكَاءِ، وَالخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، وَالرَّغْبَةِ وَالسَّأْمَةِ، وَالجُوعِ وَالشِّبَعِ؛ تَعَالَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَتَوَلَّدَ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيفٌ أَوْ لَطِيفٌ»([dcxciv]).
فيتحصّل من هذا الكلام أنّ الله تعالى لا يكون محلّاً لحوادث الدهر.
قال القاضي سعيد القمّي في شرحه لهذا الحديث:
«... الغرض منه أنّ الأشياء ليست مما كانت داخلة في العلّة الأولى بوجه من الوجوه المحتملة، ثمّ خرجت منه وظهرت في عالم الشهادة كالولد من الحيوان، وكالنفس الذي يخرج منه، وكالبدوات التي للإنسان حيث كانت في باطنه ويظهر أخيراً بحسب الآثار في ظاهره»([dcxcv]).
روي عن الإمام الباقر× قوله عن الله سبحانه:
«... وَلَا تَنْزِلُ بِهِ الأَحْدَاثُ»([dcxcvi]).
عدم عروض شيء على الله
روي عن الإمام الحسين× قوله في الإجابة على سؤال أهل البصرة عن مفهوم «الصمد»:
«... لَا، بَلْ هُوَ (ﭖ ﭗ) الَّذِي لَا مِنْ شَيْءٍ، وَلَا فِي شَيْءٍ، وَلَا عَلَى شَيْءٍ، مُبْدِعُ الأَشْيَاءِ وَخَالِقُهَا، وَمُنْشِئُ الأَشْيَاءِ بِقُدْرَتِهِ، يَتَلَاشَى مَا خَلَقَ لِلْفَنَاءِ بِمَشِيَّتِهِ، وَيَبْقَى مَا خَلَقَ لِلْبَقَاءِ بِعِلْمِهِ، فَذَلِكُمُ (ﭖ ﭗ) الَّذِي (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)، (ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)، (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)»([dcxcvii]).
فيستنتج من كلمة «لَا عَلَى شَيْءٍ» عدم عروض شيء على الله حتى يكون من توابعه ولواحقه كما هي الأعراض بالنسبة للموضوعات.
وجاء في شرح القاضي سعيد القمّي لهذا الكلام:
«لما ظهر مما سبق أنّه ليس له سبحانه علّة فاعليّة بمعنى ما منه نفس حقيقة الشيء، ولا علّة قابليّة بمعنى ما منه كون الشيء، وأنّ الثاني ينقسم إلى ما فيه قوّة وجود الشيء، بمعنى أنّه مشتمل على الشيء بالقوّة كالصور والمركّبات بالنظر إلى المادّة، وإلى ما يعرضه الشيء ويكون من توابعه ولواحقه كالأعراض بالنسبة إلى موضوعاتها، والأوّل اختصّ في الاصطلاح الأكثري للأخبار بـ (ما منه الشيء) والثاني بـ (ما فيه الشيء) والثالث بـ (ما عليه الشيء) وإن كان يصدق على الكلّ أنّه (ما منه الشيء).
إذا عرفت هذا، فاعلم، أنّه أراد الإمام× أن يبيّن خلاصة هذا النفي، فقال: (بل هو الله الذي لا من شيء ولا في شيء ولا على شيء) إشارة إلى الحصر المستفاد مما ذكر سابقاً، وينتج من ذلك أنّه لا نسبة له سبحانه إلى شيء، بل هو ـ جلّ مجده ـ خلو من خلقه وكذا خلقه خلو منه، وأنّ عليّته ـ عزّ برهانه ـ ليس بمناسبة، وأنّ ظهوره لا يتوقّف على شيء. وهذا أحد معاني كون تلك السورة المباركة (نسبة الربّ)؛ فبطل بذلك قول العادلين بالله من متهوسة الفلسفة والتصوّف، واضمحلّ زعم القائلين بالسنخيّة والرشح وأمثالها من أرباب التكلّف والتعسّف»([dcxcviii]).
يشهد له قول الإمام الصادق× عن الله تعالى:
«لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الحُدُوثُ، وَلَا يَحُولُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ»([dcxcix]).
|
|
عدم قابليّة الوصف الحقيقي لله في كلام الإمام الحسين×
من الصفات السلبيّة الأخرى عدم إمكان وصف حقيقة الذات والصفات والأفعال الإلهيّة، وقد أشارت إليها كلمات الإمام الحسين× أيضاً.
عدم إمكان وصف العلم الذاتي لله
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء التسبيح:
«سُبْحَانَ مَنْ أَوَّلُهُ عِلْمٌ لَا يُوصَفُ، وَآخِرُهُ عِلْمٌ لَا يَبِيدُ»([dcc]).
روى عبد الأعلى عن العبد الصالح موسى بن جعفر÷ أنّه قال:
«عِلْمُ اللهِ لَا يُوصَفُ مِنْهُ بِأَيْنٍ، وَلَا يُوصَفُ العِلْمُ مِنَ اللهِ بِكَيْفٍ، وَلَا يُفْرَدُ العِلْمُ مِنَ اللهِ، وَلَا يُبَانُ اللهُ مِنْهُ، وَلَيْسَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ عِلْمِهِ حَدٌّ»([dcci]).
عدم إمكان وصف كنه عظمة الله
ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين×، قال عن الله سبحانه:
«لَا تَتَدَاوَلُهُ الأُمُورُ، وَلَا تَجْرِي عَلَيْهِ الأَحْوَالُ، وَلَا تَنْزِلُ عَلَيْهِ الأَحْدَاثُ، وَلَا يَقْدِرُ الوَاصِفُونَ كُنْهَ عَظَمَتِهِ، وَلَا يَخْطُرُ عَلَى القُلُوبِ مَبْلَغُ جَبَرُوتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي الأَشْيَاءِ عَدِيلٌ»([dccii]).
يتحصّل من جملة «وَلَا يَقْدِرُ الوَاصِفُونَ كُنْهَ عَظَمَتِهِ» أنّه ليس لأيّ أحد من الواصفين أن يصف كنه وحقيقة عظمة الله تعالى؛ لعدم بلوغ أحد كنه عظمته.
وقال القاضي سعيد القمّي في شرحه لهذه الجملة:
«قوله×: (و لا يقدر الواصفون كنه عظمته) ردّ على من خاض في صفاته تعالى بالعينيّة والزيادة، وادعى معرفة ذلك، أي: لا يصف الواصفون كنه عظمته في صفاته، فضلاً عن كبرياء ذاته؛ لأنّه كلّما بالغوا في تقدس أسمائه وعلوّ صفاته فهو سبحانه فوق وصف الواصفين بما لا يتناهى؛ ولأنّ الوصول إلى كنه الشيء فرع الإحاطة به؛ لأنّ العلم بالشيء بطريق الكنه لابدّ أن يكون بحصول ذاته للعالم، وهو منحصر في حصول الشيء لنفسه ـ مع تجرّده ـ أو لعلّته، ولا يتصوّر شيء منهما للممكن بالنظر إلى الحق تعالى شأنه؛ فإذن (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ)([dcciii]) أي بالقدر الذي شاء وأخبر هو سبحانه من كمالاته، وهو أيضاً على ما أخبرنا في كتابه بألسنة تراجمة وحيه من دون تصرّف لعقولنا فيه»([dcciv]).
وورد عن أمير المؤمنين× أنّه قال:
«فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنْ عَظِيمٍ مَا أَعْظَمَهُ، وَجَلِيلٍ مَا أَجَلَّهُ، وَعَزِيزٍ مَا أَعَزَّهُ، وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوّاً كَبِيراً»([dccv]).
عدم وصف الله بصفات المخلوقين
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× قوله عن الله سبحانه:
«وَلَا تُدْرِكُهُ العُلَمَاءُ بِالبَابِهَا، وَلَا أَهْلُ التَّفْكِيرِ بِتَفْكِيرِهِمْ إِلَّا بِالتَّحْقِيقِ إِيقَاناً بِالغَيْبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ المَخْلُوقِينَ»([dccvi]).
فيتأتّى من الجملة الأخيرة عدم إمكان وصف الله ـ جلّ جلاله ـ بصفات مخلوقاته.
قال القاضي سعيد القمّي في شرحه لهذه الجملة:
«استدلال على عدم إدراك العقول والأفكار له تعالى، واستحالة وصولها إليه جلّ وعلا، إلّا القدر الذي ذكره× من الإيقان بالغيب والإقرار بأنّه الحقّ الثّابت بذاته؛ وذلك لأنّ ضوابط معرفة الحقائق تنحصر في طريقي التحليل والتّركيب وقواعد الإذعان بالمطالب إنّما هي من سلوك سبيلي الإنّ واللّمّ على ما هو المقرّر في صناعة الميزان، وهذه الطرق كلّها يجمعها كون المطلوب تحت مفهوم من الأمور العامّة التي تعرض الوجود بما هو شيء ـ على ما حقّقنا في بعض مسفوراتنا العقليّة ـ والله سبحانه منزّه عن كونه تحت حكم من هذه الأحكام؛ لأنّه سبحانه موجود لا كالموجودات، وشيء لا كالأشياء؛ على أنّ التحليل والتركيب إنّما يتأتّى فيما له المقوّمات أو العوارض. وطريق (اللّمّ) في حقّه تعالى مستحيل، ولا تسمع بما يقول بعضهم ـ وتبجّح به ـ أنّ النظر في الوجود وإثبات المبدأ بذلك تنبيه باللّم؛ وذلك لأنّا قد برهنّا على عدم عروض الوجود له تعالى لا ذهناً ولا خارجاً، على أنّ محقّقيهم أيضاً صرّحوا بذلك، حيث قالوا: وجوده تعالى مبائن لسائر الوجودات، وليس هو تعالى محلّاً للعوارض؛ والتّخصيص في القواعد العقليّة ليس طريق البارعين.
قال بعضهم ـ وهو من أجلّة المتألّهين في الحكمة المتعالية ـ (إنّ الأسامي كلّها إذا أطلقت على الله وعلى غيره لم يطلق عليهما بمعنى واحد في درجة واحدة، حتى أنّ اسم (الوجود) الّذي هو أعمّ الأشياء اشتراكاً لا يشمل الواجب والممكن على نهج واحد، بل كلّ ما سوى الله وجوداتها أظلال وأشباح محاكية لوجود الحقّ، ومع ذلك ليس إطلاق الوجود على ما سوى الله مجازاً لغويّاً، بل مجازاً عرفانيّاً عند أهل الله، وهكذا في سائر الأسامي كالعلم والإرادة والقدرة وغيرها؛ فكلّ ذلك لا يشبه فيه الخالق الخلق. وواضع اللغات إنّما وضع هذه الأسامي أوّلاً للخلق لأنّها أسبق للعقول والأفهام من الخالق؛ فلهذا وقع السّفر منها إليه) ـ انتهى كلامه.
بقي هنا في سلوك سبيل المعرفة طريق (الإنّ) وهو أيضاً قياس الغائب على الشاهد، على أنّه لابدّ للممكن الذي هو في ذاته ليس محضاً، من مخرج إيّاه إلى الأيس.
وهذا مبلغهم من العلم، وظاهر أن لا قدر لهذه المعرفة و(ليس فوق عبّادان قرية) ولذلك قال الإمام× في آخر الخبر ـ بعد ما سدّ جميع طرق معرفة الأشياء إليه تعالى ـ: (يصيب الفكر منه الإيمان به موجوداً) صدق ولي الله عن الله تعالى وتقدّس»([dccvii]).
وقال الإمام أمير المؤمنين× عن الله جلّت آلاؤه:
«لَا تَنَالُهُ الأَوْهَامُ فَتُقَدِّرَهُ، وَلَا تَتَوَهَّمُهُ الفِطَنُ فَتُصَوِّرَهُ، وَلَا تُدْرِكُهُ الحَوَاسُّ فَتُحِسَّهُ، وَلَا تَلْمِسُهُ الأَيْدِي فَتَمَسَّهُ، وَلَا يَتَغَيَّرُ بِحَالٍ، وَلَا يَتَبَدَّلُ فِي الأَحْوَالِ، وَلَا تُبْلِيهِ اللَّيَالِي وَالأَيَّامُ، وَلَا يُغَيِّرُهُ الضِّيَاءُ وَالظَّلَامُ، وَلَا يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنَ الأَجْزَاءِ، وَلَا بِالجَوَارِحِ وَالأَعْضَاءِ، وَلَا بِعَرَضٍ مِنَ الأَعْرَاضِ، وَلَا بِالغَيْرِيَّةِ وَالأَبْعَاضِ، وَلَا يُقَالُ لَهُ حَدٌّ وَلَا نِهَايَةٌ، وَلَا انْقِطَاعٌ وَلَا غَايَةٌ»([dccviii]).
عدم إمكان وصف ربّ العالم
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× قوله عن الله سبحانه:
«لَيْسَ بِرَبٍّ مَنْ طُرِحَ تَحْتَ البَلَاغِ، وَمَعْبُودٍ مَنْ وُجِدَ فِي هَوَاءٍ أَوْ غَيْرِ هَوَاءٍ»([dccix]).
حيث يفهم من هذه الجمل أنّ حقيقة ربّ العالم لا يمكن وصفها كما لا يمكن إدراكها.
قال الله تبارك وتعالى:
(ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ)([dccx]).
عدم وصف الله بالعقل
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء التسبيح:
«سُبْحَانَ مَنْ عَلَا فَوْقَ البَرِيَّاتِ بِالإِلَهِيَّةِ؛ فَلَا عَيْنَ تُدْرِكُهُ، وَلَا عَقْلَ يُمَثِّلُهُ»([dccxi]).
فمن التسبيح الوارد في هذه الجملة يتحصّل أنّ الله تعالى لا يوصف ولا يمثّل بالعقل.
وقد ورد عن أمير المؤمنين× أنّه قال:
«سُبْحَانَهُ مَنْ إِذَا تَنَاهَتِ العُقُولُ فِي وَصْفِهِ، كَانَتْ حَائِرَةً عَنْ دَرْكِ السَّبِيلِ إِلَيْهِ»([dccxii]).
عدم وصف الله بالوهم
روي عن الإمام الحسين× قوله في دعاء التسبيح:
«سُبْحَانَ مَنْ عَلَا فَوْقَ البَرِيَّاتِ بِالإِلَهِيَّةِ؛ فَلَا عَيْنَ تُدْرِكُهُ، وَلَا عَقْلَ يُمَثِّلُهُ، وَلَا وَهْمَ يُصَوِّرُهُ»([dccxiii]).
فيستنتج من التسبيح الوارد في هذه الجملة عدم إمكان البشر وصف الله وتصويره بوهمهم ومخيّلتهم.
قال الإمام الباقر× لجابر الجُعفي:
«يَا جَابِرُ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا نَظِيرَ لَهُ وَلَا شَبِيهَ، تَعَالَى عَنْ صِفَةِ الوَاصِفِينَ، وَجَلَّ عَنْ أَوْهَامِ المُتَوَهِّمِينَ، وَاحْتَجَبَ عَنْ أَعْيُنِ النَّاظِرِينَ، لَا يَزُولُ مَعَ الزَّائِلِينَ، وَلَا يَأْفِلُ مَعَ الآفِلِينَ»([dccxiv]).
عدم وصف الله باللسان
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء التسبيح:
«سُبْحَانَ مَنْ عَلَا فَوْقَ البَرِيَّاتِ بِالإِلَهِيَّةِ؛ فَلَا عَيْنَ تُدْرِكُهُ، وَلَا عَقْلَ يُمَثِّلُهُ، وَلَا وَهْمَ يُصَوِّرُهُ، وَلَا لِسَانَ يَصِفُهُ بِغَايَةِ مَا لَهُ مِنَ الوَصْفِ»([dccxv]).
من التسبيح الوارد في هذه الجملة والمتعلّق بالقسم الأخير من هذا الدعاء، يتحصّل أنّ الله تعالى لا يمكن أن يصفه لسان بحقيقة ما له من الوصف.
يقول الله تعالى:(ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)([dccxvi]).
عدم إمكان الوصف الحقيقي لله
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال:
«يُصِيبُ الفِكْرُ مِنْهُ الإِيمَانَ بِهِ مَوْجُوداً، وَوُجُودَ الإِيمَانِ لَا وُجُودَ صِفَةٍ، بِهِ تُوصَفُ الصِّفَاتُ لَا بِهَا يُوصَفُ، وَبِهِ تُعْرَفُ المَعَارِفُ لَا بِهَا يُعْرَفُ، فَذَلِكَ اللهُ لَا سَمِيَّ لَهُ، سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ»([dccxvii]).
يتحصّل من تسبيح الإمام في آخر الحديث أنّ الله منزّه عن وصف الناس كافّة؛ لأنّه ليس لأحد معرفة كنه ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله حتى يتمكّن من وصفه.
قال الله تعالى: (ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﯕﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)([dccxviii]).
عدم حدوث الله في كلام الإمام الحسين×
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× قوله عن الله سبحانه:
«لَيْسَ عَنِ الدَّهْرِ قِدَمُهُ، وَلَا بِالنَّاحِيَةِ أَمَمُهُ»([dccxix]).
تنفي الجملة الأولى زمانيّة الله تعالى، وتدلّ على أنّه ليس حادثاً.
قال أمير المؤمنين× عن الله جلّ وعلا:
«كَائِنٌ لَا عَنْ حَدَثٍ، مَوْجُودٌ لَا عَنْ عَدَمٍ»([dccxx]).
وقال عن الله} أيضاً:
«لَا يُقَالُ: كَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، فَتَجْرِيَ عَلَيْهِ الصِّفَاتُ المُحْدَثَاتُ»([dccxxi]).
وعرّف العلّامة الطباطبائي الحادث والقديم بقوله:
«فالموجود ينقسم إلى قديم وحادث، والقديم ما ليس بمسبوق الوجود بالعدم، والحادث ما كان مسبوق الوجود بالعدم»([dccxxii]).
حيث يقسّم الحدوث إلى ذاتي وزماني، عرّف العلّامة الطباطبائي الحدوث الزماني بقوله:
«الحدوث الزماني كون الشيء مسبوق الوجود بعدم زماني، وهو حصول الشيء بعد أن لم يكن بعديّة لا تجامع القبليّة، ولا يكون العدم زمانياً إلّا إذا كان ما يقابله من الوجود زمانيّاً، وهو أن يكون وجود الشيء تدريجيّاً منطبقاً على قطعة من الزمان مسبوقة بقطعة ينطبق عليها عدمه، ويقابل الحدوث بهذا المعنى القدم الزماني الذي هو عدم كون الشيء مسبوق الوجود بعدم زماني، ولازمه أن يكون الشيء موجوداً في كلّ قطعة مفروضة قبل قطعة من الزمان منطبقاً عليها»([dccxxiii]).
والحدوث الذاتي، بقوله:
«الحدوث الذاتي كون وجود الشيء مسبوقاً بالعدم المتقرّر في مرتبة ذاته، والقدم الذاتي خلافه. قالوا: إنّ كلّ ذي ماهيّة فإنّه حادث ذاتاً، واحتجّوا عليه بأنّ كلّ ممكن فإنّه يستحقّ العدم لذاته، ويستحقّ الوجود من غيره، وما بالذات أقدم مما بالغير، فهو مسبوق الوجود بالعدم لذاته»([dccxxiv]).
|
|
36ـ الجهة
مقدّمة
من الصفات السلبيّة الأخرى نفي الجهة والمكان عن الله تعالى، وبما أنّ الوهابيّة كان لهم رأي آخر حيث جعلوا لله مكاناً معيّناً وجهة؛ وهي فوق العالم، اقتضى ذلك منّا أن نتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل، مع النقد والمناقشة.
تعريف المكان
قال الراغب الأصفهاني:
«المكان عند أهل اللّغة: الموضع الحاوي للشيء»([dccxxv]).
وكتب كمال الدين البياضي الحنفي:
«المكان هو الفراغ الذى يشغله الجسم»([dccxxvi]).
تعريف الجهة
قال ابن منظور:
«الجِهَةُ والوِجْهَةُ جميعاً: الموضعُ الذي تتوجّه إليه وتقصده»([dccxxvii]).
وقال كمال الدين البياضي:
«والجهة اسم لمنتهى مأخذ الإشارة ومقصد المتحرّك، فلا يكونان إلّا للجسم والجسمانى»([dccxxviii]).
العقل وتنزيه الله عن الجهة والمكان
كثير من علماء السنّة والشيعة انبروا لإقامة الأدلّة على نفي الجهة والمكان عن الله سبحانه وتعالى، نشير هنا إلى بعضها:
قال العلّامة الحلّي في نفي الجهة والمكان عن العزيز الجبّار:
«هذا حكم من الأحكام اللازمة لوجوب الوجود، وهو معطوف على الزائد، وقد نازع فيه جميع المجسّمة، فإنّهم ذهبوا إلى أنّه تعالى جسم في جهة. وأصحاب أبي عبد الله بن كرام اختلفوا: فقال محمد بن الهيصم: إنّه تعالى في جهة فوق العرش لا نهاية لها، والبعد بينه وبين العرش أيضاً غير متناه. وقال بعضهم: البعد متناه، وقال قوم منهم: إنّه تعالى على العرش كما تقوله المجسّمة. وهذه المذاهب كلّها فاسدة؛ لأنّ كلّ ذي جهة فهو مشار إليه ومحلّ للأكوان الحادثة، فيكون حادثاً، فلا يكون واجباً»([dccxxix]).
قال أبو حامد الغزالي الشافعي:
«الأصل الرابع: العلم بأنّه تعالى ليس بجوهر يتحيّز، بل يتعالى ويتقدّس عن مناسبة الحيّز، وبرهانه أنّ كلّ جوهر متحيّز فهو مختصّ بحيّزه، ولا يخلو من أن يكون ساكناً فيه أو متحرّكاً عنه، فلا يخلو عن الحركة أو السكون وهما حادثان، وما يخلو عن الحوادث فهو حادث»([dccxxx]).
وقال الفخر الرازي:
«فلو كان علوّ الله تعالى بسبب المكان لكان علوّ المكان الذي بسببه حصل هذا العلوّ لله تعالى صفة ذاتيّة، ولكان حصول هذا العلوّ لله تعالى حصولاً بتبعيّة حصوله في المكان، فكان علوّ المكان أتمّ وأكمل من علوّ ذات الله تعالى، فيكون علوّ الله ناقصاً، وعلوّ غيره كاملاً، وذلك محال»([dccxxxi]).
البياضي الحنفي، قال:
«إنّه تعالى لو كان في مكان وجهة لزم قدمهما، وأن يكون تعالى جسماً، لأنّ المكان هو الفراغ الذى يشغله الجسم، والجهة اسم لمنتهى مأخذ الإشارة ومقصد المتحرّك، فلا يكونان إلّا للجسم والجسماني، وكلّ ذلك مستحيل، كما مرّ بيانه»([dccxxxii]).
القرآن ونفي الجهة والمكان عن الله
يستفاد من بعض الآيات تنزيه الله عن الجهة والمكان.
1ـ يقول الله تعالى:
(ﭡ ﭢ ﭣ)([dccxxxiii]).
بما أنّ النكرة في سياق النفي تفيد العموم، يستنتج من هذه الآية أنّ الله تعالى لا شبيه له، بأيّ نحو كان وفي أيّ جهة تفرض، فإن وجد في جهة أو مكان لزم منه مشابهته للمخلوقات التي تحتاج إلى هذين الأمرين.
2ـ يقول الله تعالى:
(ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)([dccxxxiv]).
وكتب أبو حيّان الأندلسي:
«وفي قوله: (ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) ردّ على من يقول: إنّه في حيّز وجهة، لأنّه لما خيّر في استقبال جميع الجهات دلّ على أنّه ليس في جهة ولا حيّز، ولو كان في حيّز لكان استقباله والتوجّه إليه أحقّ من جميع الأماكن. فحيث لم يخصّص مكاناً، علمنا أنّه لا في جهة ولا حيّز، بل جميع الجهات في ملكه وتحت ملكه، فأيّ جهة توجّهنا إليه فيها على وجه الخضوع كنّا معظّمين له ممتثلين لأمره»([dccxxxv]).
الروايات ونفي الجهة والمكان عن الله
يمكن استنتاج نفي الجهة والمكان من بعض الروايات أيضاً:
أ) روايات رسول الله|
1ـ أنّه| قال:
«اللهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ»([dccxxxvi]).
قال أبو بكر البيهقي الشافعي الأشعري:
«واستدلّ بعض أصحابنا في نفي المكان عنه بقول النبي (صلى الله عليه وسلم) (أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء)، وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان»([dccxxxvii]).
2ـ أنّه| قال:
«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّكُمْ دَلَّيْتُمْ بِحَبْلٍ إِلَى الأَرْضِ السُّفْلَى لَهَبَطَ عَلَى اللهِ»([dccxxxviii]).
قال أبو بكر البيهقي:
«والذي روي في آخر هذا الحديث إشارة إلى نفي المكان عن الله تعالى، وأنّ العبد أينما كان فهو في القرب والبعد من الله تعالى سواء، وأنّه الظاهر، فيصح إدراكه بالأدلّة، الباطن فلا يصحّ إدراكه بالكون في مكان»([dccxxxix]).
ب) روايات أهل البيت^
روي عن أمير المؤمنين× أنّه قال:
«تَأْوِيلُ الصَّمَدِ لَا اسْمٌ وَلَا جِسْمٌ، وَلَا مِثْلٌ وَلَا شِبْهٌ، وَلَا صُورَةٌ وَلَا تِمْثَالٌ، وَلَا حَدٌّ وَلَا مَحْدُودٌ، وَلَا مَوْضِعٌ وَلَا مَكَانٌ، وَلَا كَيْفٌ وَلَا أَيْنٌ، وَلَا هُنَا وَلَا ثَمَّةَ، وَلَا عَلَاءٌ وَلَا خَلَاءٌ، وَلَا مَلَأٌ، وَلَا قِيَامٌ وَلَا قُعُودٌ، وَلَا سُكُونٌ وَلَا حَرَكَاتٌ، وَلَا ظُلْمَانِيٌّ وَلَا نُورَانِيٌّ، وَلَا رُوحَانِيٌّ وَلَا نَفْسَانِيٌّ، وَلَا يَخْلُو مِنْهُ مَوْضِعٌ وَلَا يَسَعُهُ مَوْضِعٌ، وَلَا عَلَى لَوْنٍ، وَلَا عَلَى خَطَرِ قَلْبٍ، وَلَا عَلَى شَمِّ رَائِحَةٍ، مَنْفِيٌّ مِنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ»([dccxl]).
أهل السنّة والاعتقاد بنفي الجهة والمكان عن الله سبحانه
لقد صرّح الكثير من علماء السنّة بنفي الجهة والمكان عن الله تبارك وتعالى، ونشير إلى أقوال بعضهم:
1ـ الطحاوي الحنفي (321 ﻫ):
«تعالى عن الحدود والغايات، والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات»([dccxli]).
2ـ أبو حامد الغزالي (505 ﻫ):
«تعالى عن أن يحويه مكان، كما تقدّس عن أن يحدّه زمان، بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان»([dccxlii]).
3ـ محمد بن عبدالكريم الشهرستاني (548 ﻫ):
«فمذهب أهل الحقّ أنّ الله سبحانه لا يشبه شيئاً من المخلوقات، ولا يشبهه شيء منها بوجه من وجوه المشابهة والمماثلة (ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) فليس الباري سبحانه بجوهر، ولا جسم، ولا عرض، ولا في مكان، ولا في زمان، ولا قابل للأعراض، ولا محلّ للحوادث»([dccxliii]).
4ـ القرطبي المفسر المعروف المالكي (671 ﻫ):
« (العلي) يراد به علوّ القدر والمنزلة، لا علوّ المكان؛ لأنّ الله منزّه عن التحيّز»([dccxliv]).
5ـ السيد شريف الجرجاني (812 ﻫ) في شرح كلام القاضي الإيجي (756 ﻫ):
«المقصد الأوّل أنّه تعالى ليس في جهة من الجهات، ولا في مكان من الأمكنة، وخالف فيه المشبّهة وخصّصوه بجهة الفوق، اتفاقاً»([dccxlv]).
6ـ ابن حجر العسقلاني الشافعي الأشعري (852 ﻫ):
«ولا يلزم من كون جهتي العلوّ والسفل محال على الله أن لا يوصف
بالعلوّ؛ لأنّ وصفه بالعلوّ من جهة المعنى، والمستحيل كون ذلك من جهة الحسّ، ولذلك
ورد في صفته العالي والعلي والمتعالي، ولم يرد ضدّ ذلك، وإن كان قد أحاط بكلّ شيء
علماً ـ جلّ وعزّـ »([dccxlvi]).
7ـ بدر الدين العيني (855 ﻫ):
«وقد تقرّر أنّ الله ليس بجسم، فلا يحتاج إلى مكان يستقرّ فيه، فقد كان ولا مكان»([dccxlvii]).
الوهابيّة وعقيدتهم بالجهة والمكان
الوهابيّة ـ وتبعاً لقولهم وإيمانهم بالتجسيم ـ اعتقدوا بالجهة والمكان لله تعالى، وأنّه سبحانه في جهةٍ فوق العالم.
فقال ابن تيمية:
«وجمهور الخلق على أنّ الله فوق العالم، وإن كان أحدهم لا يلفظ بلفظ (الجهة) فهم يعتقدون بقلوبهم ويقولون بألسنتهم أنّ ربّهم فوق»([dccxlviii]).
وقال أيضاً:
«والبارئ سبحانه وتعالى فوق العالم فوقيّة حقيقيّة، ليست فوقيّة الرتبة»([dccxlix]).
وله كذلك:
«وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين: أنّ الله في السماء، وحدّوه بذلك»([dccl]).
وله أيضاً:
«... ولم يقل أحد منهم قط: إنّ الله ليس في السماء، ولا إنّه ليس على العرش، ولا إنّه بذاته في كلّ مكان، ولا إنّ جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا إنّه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا إنّه لا متصل ولا منفصل، ولا إنّه لا تجوز الإشارة الحسيّة إليه بالأصابع ونحوها»([dccli]).
وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز:
«فاعلم ـ بارك الله فيك ـ أنّ أهل السنّة والجماعة من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وسلم) والتابعين لهم بإحسان مجمعون على أنّ الله في السماء، وأنّه فوق العرش، وأنّ الأيدي ترفع إليه سبحانه، كما دلّت على ذلك الآيات والأحاديث الصحيحة»([dcclii]).
المناقشة
أوّلاً: تمسّك المعتقدون بالفوقيّة لله سبحانه بمجموعة من الأدلّة، من قبيل رفع اليدين نحو السماء، بينما هذا الأمر يعدّ من آداب الدعاء لا لكون الله تعالى في الجهة الفوقانيّة، ويعلّل بأنّ خزائن الرزق الإلهي في السماء.
فيقول تعالى:
(ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)([dccliii]).
وقال النووي (676 ﻫ) في شرح صحيح مسلم:
«إنّ الخالق المدبّر الفعّال هو الله وحده، وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء، كما إذا صلّى المصلّي استقبل الكعبة، وليس ذلك لأنّه منحصر في السماء، كما أنّه ليس منحصراً في جهة الكعبة، بل ذلك لأنّ السماء قبلة الداعين كما أنّ الكعبة قبلة المصلّين»([dccliv]).
قال البياضي الحنفي (1098 ﻫ) في شرح كلمات أبي حنيفة:
«بأنّ رفع الأيدي عند الدعاء إلى جهة السماء ليس لكونه تعالى فوق السموات العلى، بل لكونها قبلة الدعاء، إذ منها يتوقّع الخيرات، ويستنزل البركات لقوله تعالى: (ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)([dcclv]) مع الإشارة إلى اتصافه تعالى بنعوت الجلال وصفات الكبرياء، وكونه تعالى فوق عباده بالقهر والاستيلاء»([dcclvi]).
ثانياً: إنّ الأدلّة العقليّة والنقليّة لا أنّها لا تثبت الجهة لله وحسب، بل تدلّ على خلاف ذلك أيضاً، ولهذا نُقل عن سليمان بن مهران أنّه قال:
«قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ‘: هَلْ يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ اللهَ} فِي مَكَانٍ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ، إِنَّهُ لَوْ كَانَ فِي مَكَانٍ لَكَانَ مُحْدَثاً؛ لِأَنَّ الكَائِنَ فِي مَكَانٍ مُحْتَاجٌ إِلَى المَكَانِ، وَالِاحْتِيَاجُ مِنْ صِفَاتِ المُحْدَثِ لَا مِنْ صِفَاتِ القَدِيمِ»([dcclvii]).
اعتقاد ابن تيمية بثبوت الجهة العدميّة
حينما نراجع تعبيرات ابن تيمية الذي يعتقد بالجهة لله سبحانه، نجد أنّه يفسّر الجهة على أنّها أمر عدمي وفوق العالم، حيث قال:
«وإن أريد بالجهة أمر عدمي، وهو ما فوق العالم، فليس هناك إلّا الله وحده»([dcclviii]).
وقال ابن عثيمين حول الجهة لله سبحانه ومعناها:
«... وإن أردت أنّه في جهة عليا عدميّة لا تحيط به، ما ثمّ إلّا هو} فهذا حقّ»([dcclix]).
المناقشة
أوّلاً: نلاحظ أنّ تفسير ابن تيمية ـ الذي يعتبر نفسه سلفيّاً وتابعاً للسلف الصالح ـ للجهة لم يُذكر في قرآن ولا في سنّة نبويّة ولا في كلام أيّ أحد من سلفه.
ثانياً: لا ينسجم تفسير ابن تيمية للجهة مع معناها اللغوي الذي تقدّم ذكره.
الأحاديث المثبتة للجهة ومناقشتها
سنشرع هنا بذكر ومناقشة أنموذجين من الأحاديث التي استدلّ بها الوهابيّة لإثبات الجهة لله}.
الحديث الأوّل: عن أبي هريرة، قال:
«إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَقَالَ لَهَا: (أَيْنَ اللهُ؟) فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ بِأُصْبعِهَا، فَقَالَ لَهَا: (فَمَنْ أَنَا؟) فَأَشَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَإِلَى السَّمَاءِ يَعْنِي أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ: (أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ)»([dcclx]).
ونُقل شبيه هذا الحديث عن بعض الصحابة مثل معاوية بن الحكم([dcclxi]).
وقد ردّ عبدالله بن صدّيق الغماري على كلّ من يستدلّ بهذا الحديث من أجل إثبات الجهة لله ووجوده في السماء:
«... وحديث معاوية بن الحكم، في صحيح مسلم، لكنّه شاذّ مردود لوجوه:
(أوّلاً): مخالفته لما تواتر عن النبي (صلى الله عليه وسلم): أنّه كان إذا أتاه شخص يريد الإسلام، سأله عن الشهادتين؟ فإذا قبلهما، حكم بإسلامه. وفي الموطّأ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أنّ رجلاً من الأنصار، جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بجارية سوداء، فقال: يا رسول الله، عليّ رقبة مؤمنة، فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (أتشهدين أن لا إله إلّا الله؟) قالت: نعم. قال: (أتشهدين أنّ محمداً رسول الله؟) قالت: نعم، قال: (أتوقنين بالبعث بعد الموت؟) قالت: نعم. قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (أعتقها) وهذا هو المعلوم من حال النبي (صلى الله عليه وسلم) ضرورة.
(ثانياً): إنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) بيّن أركان الإيمان، في حديث سؤال جبريل، حيث قال (الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشرّه) ولم يذكر فيها عقيدة أنّ الله في السماء.
(ثالثاً): إنّ العقيدة المذكورة، لا تثبت توحيداً ولا تنفي شركاً، فكيف يصف النبي (صلى الله عليه وسلم) صاحبها بأنّه مؤمن؟ كان المشركون يعتقدون أنّ الله في السماء، ويشركون معه آلهة في الأرض، ولما جاء حصين بن عتبة أو ابن عبيد والد عمران إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فسأله: (كم تعبد من إله؟) قال: ستة في الأرض، وواحداً في السماء، وقال فرعون لهامان: (ابن لي صرحاً لعلّي أطّلع إلى إله موسى) لاعتقاده أنّ الله في السماء. ومع ذلك قال لقومه: أنا ربّكم الأعلى.
(رابعاً): إنّ كون الله في السماء ليس على حقيقته عند جماعة من العلماء، بل هو مؤوّل عندهم على معنى العلوّ المعنوي. قال الباجي على قول الجارية: في السماء، لعلّها تريد وصفه بالعلوّ، وبذلك يوصف من كان شأنه العلوّ، يقال: مكان فلان في السماء، يعني علوّ حاله، ورفعته وشأنه. وذكر السبكي في طبقات الشافعيّة (1/265) الأبيات المنسوبة لعبد الله بن رواحة:
|
شهدت
بأنّ وعد الله حقّ |
|
وأنّ
النار مثوى الكافرينا |
|
وأنّ
العرش فوق الماء طاف |
|
وفوق
العرش ربّ العالمينا |
وقال عقبها: ما أحسن قول الإمام الرافعي في كتاب الأمالي ـ وقد ذكر هذه الأبياتـ: هذه الفوقيّة فوقيّة العظمة والاستغناء، في مقابلة صفة الموصوفين بصفة العجز والفناء اهـ وأركان الإيمان لا يدخلها التأويل»([dcclxii]).
الحديث الثاني: عن رسول الله| أنّه قال:
«إِنَّ المُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ}، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ»([dcclxiii]).
المناقشة
قال عبدالله بن صدّيق الغماري في مقام نقده لهذا الحديث:
«والحديث في صحيح مسلم، وفيه ما يدلّ على نفي الجهة عن الله تعالى، فقوله: «وكلتا يديه يمين» قال القاضي عياض: هو تنبيه على أنّه لم يرد باليمين ولا باليد: الجارحة؛ لأنّه لو أريد به ذلك، لكان المقابل لليمين الشمال، وتستحيل نسبة الجارحة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنّ ذلك إنّما يكون في الأجسام المتحيّزة المقدّرة ذوات الجهة، وكلّ ذلك على الله سبحانه محال اهـ. فظهر أنّ الحديث ينفي الجهة، وأنّ فهم المؤلّف خطأ...»([dcclxiv]).
عدم
الجهة لله في كلام الإمام الحسين×
|
|
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× قوله عن الله سبحانه:
«لَا تَحُلُّهُ فِي، وَلَا تُوَقِّتُهُ إِذْ، وَلَا تُؤَامِرُهُ إِنْ»([dcclxv]).
يتحصّل من جملة «لَا تَحُلُّهُ فِي» عدم وجود محدوديّة مكانيّة تحدّه، وأنّه ليس في ظرف مكاني خاص.
روى العلّامة المجلسي أيضاً:
«رُوِيَ أَنَّ الحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ÷ جَاءَهُ رَجُلٌ، وَقَالَ: أَنَا رَجُلٌ عَاصٍ، وَلَا أَصْبِرُ عَنِ المَعْصِيَةِ، فَعِظْنِي بِمَوْعِظَةٍ، فَقَالَ: افْعَلْ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ وَأَذْنِبْ مَا شِئْتَ، فَأَوَّلُ ذَلِكَ: لَا تَأْكُلْ رِزْقَ اللهِ وَأَذْنِبْ مَا شِئْتَ، وَالثَّانِي: اخْرُجْ مِنْ وَلَايَةِ اللهِ وَأَذْنِبْ مَا شِئْتَ، وَالثَّالِثُ: اطْلُبْ مَوْضِعاً لَا يَرَاكَ اللهُ وَأَذْنِبْ مَا شِئْتَ، وَالرَّابِعُ: إِذَا جَاءَ مَلَكُ المَوْتِ لِيَقْبِضَ رُوحَكَ فَادْفَعْهُ عَنْ نَفْسِكَ وَأَذْنِبْ مَا شِئْتَ، وَالخَامِسُ: إِذَا أَدْخَلَكَ مَالِكٌ فِي النَّارِ فَلَا تَدْخُلْ فِي النَّارِ وَأَذْنِبْ مَا شِئْتَ»([dcclxvi]).
فيستنتج ضمناً من جملة «اطْلُبْ مَوْضِعاً لَا يَرَاكَ اللهُ وَأَذْنِبْ مَا شِئْتَ» أنّ الله كان ولايزال وسيظلّ موجوداً في كلّ مكان، وله إحاطة علميّة تامّة بكلّ شيء.
ونقل ابن شعبة الحرّاني ـ أيضاً ـ في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× قوله:
«لَيْسَ عَنِ الدَّهْرِ قِدَمُهُ، وَلَا بِالنَّاحِيَةِ أَمَمُهُ»([dcclxvii]).
وكلمة (ناحية) بمعنى جانب، ويتحصّل من الجملة الثانية أنّ الله موجود في كلّ الأماكن، وفي جميع النواحي.
قال القاضي سعيد القمّي في شرح هذا الحديث:
«فإنّ (الناحية) بمعنى الجانب و(الأمم) بالتحريك: القصد، أي ليس يقصد ويختار لنفسه جانباً وحدّاً مقابلاً لحدود خلقه، كأنّه جعل نفسه في حدّ وجانب اختار لنفسه، بل هو سبحانه حادّ كلّ محدود من المعقولات والمحسوسات، لا يتجاوز كلّ عن حدّه المعيّن له كما قال: (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ)([dcclxviii]) وهذا ردّ على من زعم أنّ الأزل ظرف يستقرّ فيه الأزلي، وأنّ الله سبحانه جالس على العرش، أو أنّه في السماء أو فوقها»([dcclxix]).
روي عن أمير المؤمنين× أنّه قال ـ واصفاً الله سبحانه ـ:
«وَلَا يُقَالُ لَهُ حَدٌّ وَلَا نِهَايَةٌ، وَلَا انْقِطَاعٌ وَلَا غَايَةٌ؛ وَلَا أَنَّ الأَشْيَاءَ تَحْوِيهِ فَتُقِلَّهُ أَوْ تُهْوِيَهُ، أَوْ أَنَّ شَيْئاً يَحْمِلُهُ فَيُمِيلَهُ أَوْ يُعَدِّلَهُ [يَعْدِلَهُ]، لَيْسَ فِي الأَشْيَاءِ بِوَالِجٍ، وَلَا عَنْهَا بِخَارِجٍ»([dcclxx]).
|
|
|
|
37ـ الحلول
|
|
نفي الحلول عن الله في كلام الإمام الحسين×
روى ابن شعبة الحرّاني في (تحف العقول) عن الإمام الحسين× أنّه قال:
«لَا تَحُلُّهُ فِي، وَلَا تُوَقِّتُهُ إِذْ، وَلَا تُؤَامِرُهُ إِنْ»([dcclxxi]).
إنّ (في) موضوعة لظرف الزمان، وبهذا يتحصّل من الجملة الأولى أنّ الله جلّت قدرته لا يحلّ في أيّ موجود ولو كان من أوليائه، كما ليس له أيّ محلّ خاصّ.
و روي أيضاً عن الإمام الحسين× قوله في جواب سؤال أهل البصرة حول معنى (الصمد):
«... لَا، بَلْ هُوَ (ﭖ ﭗ) الَّذِي لَا مِنْ شَيْءٍ، وَلَا فِي شَيْءٍ، وَلَا عَلَى شَيْءٍ، مُبْدِعُ الأَشْيَاءِ وَخَالِقُهَا، وَمُنْشِئُ الأَشْيَاءِ بِقُدْرَتِهِ، يَتَلَاشَى مَا خَلَقَ لِلْفَنَاءِ بِمَشِيَّتِهِ، وَيَبْقَى مَا خَلَقَ لِلْبَقَاءِ بِعِلْمِهِ، فَذَلِكُمُ (ﭖ ﭗ) الَّذِي (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)، (ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)، (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)»([dcclxxii]).
من كلمة (في) الموضوعة لظرف الزمان الواردة في قوله «لَا فِي شَيْءٍ» يستفاد أنّ الله تعالى لا يحلّ في شيء أو موجودٍ قط، حتى أوليائه مثل عيسى المسيح×؛ لأنّ النكرة في سياق النفي تفيد العموم.
روي عن أمير المؤمنين× أنّه قال في وصف الله سبحانه:
«لَمْ يَحْلُلْ فِيهَا فَيُقَالَ: هُوَ فِيهَا كَائِنٌ، وَلَمْ يَنْأَ عَنْهَا فَيُقَالَ: هُوَ مِنْهَا بَائِنٌ، وَلَمْ يَخْلُ مِنْهَا فَيُقَالَ لَهُ: أَيْنَ، لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَحَاطَ بِهَا عِلْمُهُ، وَأَتْقَنَهَا صُنْعُهُ، وَأَحْصَاهَا حِفْظُهُ»([dcclxxiii]).
هناك الكثير من الإشكالات والمحاذير التي تكتنف الاعتقاد بحلول الله في غيره، من قبيل:
إنّ المعنى المعقول والمفهوم عن الحلول، هو قيام موجود بموجود آخر بنحو التابعيّة له، على شرط أن لا يكون قيام الموجود الحال ممتنع بذاته، وهذا المعنى يمتنع على الله سبحانه بشكل قطعي؛ لأنّه ثبت في محلّه أنّه واجب الوجود، وهذا المعنى من الحلول يستلزم احتياج الله جلّ وعلا للمكان، والحاجة تستلزم الإمكان، وبهذا تتعارض مع وجوب الوجود.
|
|
|
|
38ـ الأكل والشرب
|
|
عدم جواز الأكل والشرب على الله في كلام الإمام الحسين×
روى الإمام الباقر، عن أبيه الإمام زين العابدين، عن أبيه الإمام الحسين^ أنّه قال في بيان معنى كلمة (الصمد):
«الصَّمَدُ الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ، وَالصَّمَدُ الَّذِي قَدِ انْتَهَى سُؤْدَدُهُ، وَالصَّمَدُ الَّذِي لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ، وَالصَّمَدُ الَّذِي لَا يَنَامُ، وَالصَّمَدُ الدَّائِمُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ»([dcclxxiv]).
يفهم من جملة «لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ» أنّ الله تعالى لا يحتاج للأكل والشرب، ولهذا لا يأكل ولا يشرب شيئاً.
قال القاضي سعيد القمّي في شرحه لهذا الحديث:
«... ثمّ فسّر ثالثاً، بالذي لا يأكل ولا يشرب، بمعنى أن ليس له نقصان ذاتي، ولا قوّة في الذات لحصول شيء ينضم إلى ذاته ويصير جزءاً له حتى يستكمل ذاته، وهذا هو الأكمل الحقيقي، وكذا ليس له في كماله حالة منتظرة للتقوى ذاته بتماميّة هذا الكمال. وهذا هو الشرب الذي يعين الغذاء على الاغتذاء»([dcclxxv]).
قال الله تبارك وتعالى:
(ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ)([dcclxxvi]).
|
|
|
|
39ـ المحكومية
|
|
عدم محكوميّة الله في كلام الإمام الحسين×
روى أبو يعلى بسنده عن أبي الحوراء أنّ الحسين بن علي÷، قال:
«عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الوِتْرِ: رَبِّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّكَ لَا تُذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ»([dcclxxvii]).
يتحصّل من جملة «فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ» التي يخاطب بها العزيز الجبّار، أنّ الله ليس محكوماً لأيّ أحد من خلقه.
وجاء في دعاء الجوشن الكبير:
«يَا مَنْ يَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ، يَا مَنْ يَحْكُمُ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ»([dcclxxviii]).
|
|
40ـ الفوت
|
|
عدم فوت أمر على الله في كلام الإمام الحسين×
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء المظلوم ـ مخاطباً الحقّ تعالى ـ:
«لَا تَخَافُ فَوْتَ فَائِتٍ»([dcclxxix]).
يتبيّن من مضمون وسياق هذه الجملة المتعلّقة بالظالم والمظلوم عدم فوات أيّ أمر من الأمور، وعلى الخصوص أمور الظلمة والمظلومين على الله سبحانه؛ ولذا فمحاكمته دقيقة، وتتمّ طبقاً للعدالة.
يقول الله تبارك وتعالى:
(ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ)([dcclxxx]).
|
|
|
|
41ـ الوارث
|
|
عدم الوارث لله في كلام الإمام الحسين×
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء عرفة:
«الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً فَيَكُونَ مَوْرُوثاً»([dcclxxxi]).
يستنتج من مضمون هذه الجملة أنّ الله سبحانه لا وارث له؛ لأنّه لا ولد عنده.
روي عن أمير المؤمنين× أنّه قال:
«لَمْ يُولَدْ سُبْحَانَهُ فَيَكُونَ فِي العِزِّ مُشَارَكاً، وَلَمْ يَلِدْ فَيَكُونَ مَوْرُوثاً هَالِكاً»([dcclxxxii]).
|
|
42ـ النسيان
|
|
عدم النسيان بالنسبة لله في كلام الإمام الحسين×
علم الله لا يبيد
ورد عن الإمام الحسين× قوله في دعاء التسبيح:
«سُبْحَانَ مَنْ أَوَّلُهُ عِلْمٌ لَا يُوصَفُ، وَآخِرُهُ عِلْمٌ لَا يَبِيدُ»([dcclxxxiii]).
إذ يستفاد من الجملة الثانية (علم لا يبيد) أنّ علم الله بما أنّه ذاتي له، لا يفنى ولا يتلف؛ لأنّ كلمة (يبيد) مأخوذة من مادة (بَيد) بمعنى هلك.
قال أبو علي القصّاب:
«كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ×، فَقُلْتُ: الحَمْدُ لِلهِ مُنْتَهَى عِلْمِهِ، فَقَالَ: لَا تَقُلْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِعِلْمِهِ مُنْتَهًى»([dcclxxxiv]).
عدم نسيان الله لتصرّفات الناس غير اللائقة
نقل البلاذري:
«وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (رض): أَمَّا بَعْدُ، فَقَدِ انْتَهَتْ إِلَيَّ عَنْكَ اُمُورٌ أَرغَبُ بِكَ عَنْهَا، فَإِنْ كَانَتْ حَقّاً لَمْ اُقَارَّكَ عَلَيْهَا، وَلَعَمْرِي إِنَّ مَنْ أَعْطَى صَفْقَةَ يَمِينِهِ وَعَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَحَرِيٌّ بِالوَفَاءِ، وَإِنْ كَانَتْ بَاطِلاً فَأَنْتَ أَسْعَدُ النَّاسِ بِذَلِكَ، وَبِحَظِّ نَفْسِكَ تَبْدَأُ، وَبِعَهْدِ اللهِ تُوفِي، فَلَا تَحْمِلْنِي عَلَى قَطِيعَتِكَ وَالإِسَاءَةِ بِكَ، فَإِنِّي مَتَى اُنْكِرْكَ تُنْكِرْنِي، وَمَتَى تَكِدْنِي أَكِدْكَ، فَاتَّقِ شَقَّ عَصَا هَذِهِ الاُمَّةِ وَأَنْ يَرْجِعُوا عَلَى يَدِكَ إِلَى الفِتْنَةِ، فَقَدْ جَرَّبْتَ النَّاسَ وَبَلَوْتَهُمْ، وَأَبُوكَ كَانَ أَفْضَلَ مِنْكَ، وَقَدْ كَانَ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ رَأْيُ الَّذِينَ يَلُوذُونَ بِكَ، وَلَا أَظُنُّهُ يَصْلُحُ لَكَ مِنْهُمْ مَا كَانَ فَسَدَ عَلَيْهِ، فَانْظُرْ لِنَفْسِكَ وَدِينِكَ (ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ)([dcclxxxv]).
فَكَتَبَ إلَيْهِ الحُسَيْنُ: أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ أَنَّهُ بَلَغَتْكَ عَنِّي اُمُورٌ تَرْغَبُ عَنْهَا، فَإِنْ كَانَتْ حَقّاً لَمْ تُقَارَّنِي عَلَيْهَا، وَلَنْ يَهْدِيَ إِلَى الحَسَنَاتِ وَيُسَدِّدَ لَهَا إِلَّا اللهُ. فَأَمَّا مَا نُمِّيَ إِلَيْكَ فَإِنَّمَا رَقَّاهُ المَلَّاقُونَ المَشَّاؤُونَ بِالنَّمَائِمِ، المُفَرِّقُونَ بَيْنَ الجَمِيعِ، وَمَا اُرِيدُ حَرْباً لَكَ وَلَا خِلَافاً عَلَيْكَ، وَأيْمُ اللهِ لَقَدْ تَرَكْتُ ذَلِكَ وَأَنَا أَخَافُ اللهَ فِي تَرْكِهِ، وَمَا أَظُنُّ اللهَ رَاضِياً عَنِّي بِتَرْكِ مُحَاكَمَتِكَ إِلَيْهِ، وَلَا عَاذِرِي دُونَ الإِعْذَارِ إلَيْهِ فِيكَ وَفِي أَوْلِيَائِكَ القَاسِطِينَ المُلْحِدِينَ، حِزْبِ الظَّالِمِينَ وَأَوْلِيَاءِ الشَّيَاطِينِ، أَلَسْتَ قَاتِلَ حجْرِ بْنِ عَدِيٍّ وَأَصْحَابِهِ المُصَلِّينَ العَابِدِينَ، الَّذِينَ يُنْكِرُونَ الظُّلْمَ وَيَسْتَعْظِمُونَ البِدَعَ وَلَا يَخَافُونَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ظُلْماً وَعُدْواناً، بَعْدَ إِعْطَائِهِمُ الأَمَانَ بِالمَوَاثِيقِ وَالأَيْمَانِ المُغَلَّظَةِ؟ أوَلَسْتَ قَاتِلَ عَمْرِو بْنِ الحَمِقِ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، الَّذِي أَبْلَتْهُ العِبَادَةُ وَصَفَّرَتْ لَوْنَهُ وَأَنْحَلَتْ جِسْمَهُ؟ أَوَلَسْتَ المُدَّعِيَ زِيَادَ بْنَ سُمَيَّةَ المَوْلُودَ عَلَى فِرَاشِ عُبَيْدِ عَبْدِ ثَقِيفٍ، وَزَعَمْتَ أَنَّهُ ابْنُ أَبِيكَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): (الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ)، فَتَرَكْتَ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَخَالَفْتَ أَمْرَهُ مُتَعَمِّداً، وَاتَّبَعْتَ هَوَاكَ مُكَذِّباً بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللهِ، ثُمَّ سَلَّطْتَهُ عَلَى العِرَاقَيْنِ فَقَطَعَ أَيْدِي المُسْلِمِينَ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَصَلَبَهُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ؛ كَأَنَّكَ لَسْتَ مِنَ الاُمَّةِ وَكَأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْكَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): (مَنْ الحَقَ بِقَوْمٍ نَسَباً لَيْسَ لَهُمْ فَهُوَ مَلْعُونٌ). أوَلَسْتَ صَاحِبَ الحَضْرَمِيِّينَ الَّذِينَ كَتَبَ إِلَيْكَ ابْنُ سُمَيَّةَ أَنَّهُمْ عَلَى دِينِ عَلِيٍّ، فَكَتَبْتَ إِلَيْهِ: اُقْتُلْ مَنْ كَانَ عَلَى دِينِ عَلِيٍّ وَرَأْيِهِ؟ فَقَتَّلَهُمْ وَمَثَّلَ بِهِمْ بِأَمْرِكَ، وَدِينُ عَلِيٍّ دِينُ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الَّذِي كَانَ يَضْرِبُ عَلَيْهِ أَبَاكَ، وَالَّذِي انْتِحَالُكَ إِيَّاهُ أَجْلَسَكَ مَجْلِسَكَ هَذَا، وَلَولَا هُوَ كَانَ أَفْضَلُ شَرَفِكَ تَجَشُّمَ الرِّحْلَتَيْنِ فِي طَلَبِ الخُمُورِ. وَقُلْتَ: اُنْظُر لِنَفْسِكَ وَدِينِكَ وَالاُمَّةِ، وَاتَّقِ شَقَّ عَصَا الالفَةِ، وَأَنْ تَرُدَّ النَّاسَ إِلَى الفِتْنَةِ! فَلَا أَعْلَمُ فِتْنَةً عَلَى الاُمَّةِ أَعْظَمَ مِنْ وِلَايَتِكَ عَلَيْهَا، وَلَا أَعْلَمُ نَظَراً لِنَفْسِي وَدِينِي أَفْضَلَ مِنْ جِهَادِكَ، فَإِنْ أَفْعَلْهُ فَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّي، وَإِنْ أَتْرُكْهُ فَذَنْبٌ أَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْهُ فِي كَثِيرٍ مِنْ تَقْصِيرِي، وَأَسْأَلُ اللهَ تَوْفِيقِي لِأَرْشَدِ اُمُورِي. وَأَمَّا كَيْدُكَ إِيَّايَ، فَلَيْسَ يَكُونُ عَلَى أَحَدٍ أَضَرَّ مِنْهُ عَلَيْكَ، كَفِعْلِكَ بِهَؤُلَاءِ النَّفَرِ الَّذِينَ قَتَلْتَهُمْ وَمَثَّلْتَ بِهِمْ بَعْدَ الصُّلْحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا قَاتَلُوكَ وَلَا نَقَضُوا عَهْدَكَ، إِلَّا مَخَافَةَ أَمْرٍ لَوْ لَمْ تَقْتُلْهُمْ مِتَّ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلُوهُ، أَوْ مَاتُوا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكُوهُ. فَأَبْشِرْ يَا مُعَاوِيَةُ بِالقِصَاصِ، وَأَيْقِنْ بِالحِسَابِ، وَاعْلَمْ أَنَّ لِلهِ كِتَاباً لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، وَلَيْسَ اللهُ بِنَاسٍ لَكَ أَخْذَكَ بِالظِّنَّةِ، وَقَتْلَكَ أَوْلِيَاءَهُ عَلَى الشُّبْهَةِ وَالتُّهْمَةِ، وَأَخْذَكَ النَّاسَ بِالبَيْعَةِ لِابْنِكَ غُلَامٍ سَفِيهٍ يَشْرَبُ الشَّرَابَ وَيَلْعَبُ بِالكِلَابِ، وَلَا أَعْلَمُكَ إِلَّا خَسِرْتَ نَفْسَكَ، وَأَوْبَقْتَ دِينَكَ، وَأَكَلْتَ أَمَانَتَكَ، وَغَشَشْتَ رَعِيَّتَكَ، وَتَبَوَّأْتَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، فَـ(ﯹ ﯺ ﯻ)([dcclxxxvi])»([dcclxxxvii]).
فيستنتج من قوله: «وَلَيْسَ اللهُ بِنَاسٍ لَكَ...» أنّ الله تعالى لا ينسى أبداً أيّ ظلم قام بعضٌ بارتكابه في حقّ الآخرين. وهذا التعبير كناية عن حتميّة الانتقام الإلهي من الظلمة.
يقول الله تعالى: (ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ)([dcclxxxviii]).
|
|
|
|
43ـ الخواطر
|
|
عدم عروض الخواطر على الله في كلام الإمام الحسين×
عن الإمام الحسين× في جواب كتاب البصريين حيث سألوه عن معنى (ﭙ ﭚ) قال:
«(ﭙ ﭚ): لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيفٌ؛ كَالوَلَدِ وَسَائِرِ الأَشْيَاءِ الكَثِيفَةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ المَخْلُوقِينَ، وَلَا شَيْءٌ لَطِيفٌ كَالنَّفْسِ، وَلَا يَتَشَعَّبُ مِنْهُ البَدَوَاتُ كَالسِّنَةِ وَالنَّوْمِ، وَالخَطْرَةِ...»([dcclxxxix]).
و(خطرة) بمعنى الخاطرة، ويفهم من كلام الإمام× أنّ الله سبحانه لا ترد عليه الخواطر؛ لأنّها من خواصّ الجسم، والله تعالى مجرّد تام.
فقد ورد عن أمير المؤمنين× أنّه قال في وصف الله جلّ جلاله:
«مُقَدِّرٌ لَا بِجَوْلِ فِكْرَةٍ، مُدَبِّرٌ لَا بِحَرَكَةٍ»([dccxc]).
|
|
44ـ الهم والغم
|
|
عدم عروض الهمّ على الله في كلام الإمام الحسين×
ورد عن الإمام الحسين× قوله في جواب كتاب البصريين وقد سألوه فيه عن معنى (ﭙ ﭚ):
«(ﭙ ﭚ): لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيفٌ؛ كَالوَلَدِ وَسَائِرِ الأَشْيَاءِ الكَثِيفَةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ المَخْلُوقِينَ، وَلَا شَيْءٌ لَطِيفٌ كَالنَّفْسِ، وَلَا يَتَشَعَّبُ مِنْهُ البَدَوَاتُ كَالسِّنَةِ وَالنَّوْمِ، وَالخَطْرَةِ وَالهَمِّ...»([dccxci]).
يتضح من هذا الكلام عدم عروض الهمّ على الله تبارك وتعالى؛ لأنّ هذه الحالة من خواصّ الجسم، وهو مجرّد تام.
نُقل عن صفوان بن يحيى أنّه قال:
«قُلْتُ لِأَبِي الحَسَنِ×: أَخْبِرْنِي عَنِ الإِرَادَةِ مِنَ اللهِ وَمِنَ الخَلْقِ؟ قَالَ: فَقَالَ: الإِرَادَةُ مِنَ الخَلْقِ الضَّمِيرُ وَمَا يَبْدُو لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الفِعْلِ، وَأَمَّا مِنَ اللهِ تَعَالَى فَإِرَادَتُهُ إِحْدَاثُهُ لَا غَيْرُ؛ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُرَوِّي وَلَا يَهُمُّ وَلَا يَتَفَكَّرُ، وَهَذِهِ الصِّفَاتُ مَنْفِيَّةٌ عَنْهُ وَهِيَ صِفَاتُ الخَلْقِ، فَإِرَادَةُ اللهِ الفِعْلُ لَا غَيْرُ ذَلِكَ، يَقُولُ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ، بِلَا لَفْظٍ وَلَا نُطْقٍ بِلِسَانٍ وَلَا هِمَّةٍ وَلَا تَفَكُّرٍ وَلَا كَيْفَ لِذَلِكَ، كَمَا أَنَّهُ لَا كَيْفَ لَهُ»([dccxcii]).
|
|
|
|
45ـ الحزن
|
|
عدم عروض الحزن على الله في كلام الإمام الحسين×
ورد عن الإمام الحسين× في جوابه على سؤال البصريين عن معنى (ﭙ ﭚ) حيث قال:
«(ﭙ ﭚ): لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيفٌ؛ كَالوَلَدِ وَسَائِرِ الأَشْيَاءِ الكَثِيفَةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ المَخْلُوقِينَ، وَلَا شَيْءٌ لَطِيفٌ كَالنَّفْسِ، وَلَا يَتَشَعَّبُ مِنْهُ البَدَوَاتُ كَالسِّنَةِ وَالنَّوْمِ، وَالخَطْرَةِ وَالهَمِّ، وَالحَزَنِ...»([dccxciii]).
يتحصّل من هذا الجواب أنّ الحزن والضيق والأسى لا تعرض على الله تعالى؛ لأنّ هذه الحالات من خواصّ الأجسام، بينما هو مجرّد تام.
يؤيّده قول الإمام أمير المؤمنين×:
«لَمْ يُحْدَثْ فَيُمْكِنَ فِيهِ التَّغَيُّرُ وَالِانْتِقَالُ، وَلَمْ يُتَصَرَّفْ فِي ذَاتِهِ بِكُرُورِ الأَحْوَالِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ حُقْبُ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ...»([dccxciv]).
|
|
46ـ الابتهاج
|
|
عدم عروض البهجة على الله في كلام الإمام الحسين×
ورد عن الإمام الحسين× أنّه قال في جواب سؤال البصريين عن معنى (ﭙ ﭚ):
«(ﭙ ﭚ): لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيفٌ؛ كَالوَلَدِ وَسَائِرِ الأَشْيَاءِ الكَثِيفَةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ المَخْلُوقِينَ، وَلَا شَيْءٌ لَطِيفٌ كَالنَّفْسِ، وَلَا يَتَشَعَّبُ مِنْهُ البَدَوَاتُ كَالسِّنَةِ وَالنَّوْمِ، وَالخَطْرَةِ وَالهَمِّ، وَالحَزَنِ وَالبَهْجَةِ...»([dccxcv]).
ويتضح منه عدم عروض البهجة والسرور على الله جلّت عظمته؛ لأنّ هذه الحالة من خواصّ الجسم، وهو مجرّد تام.
وروي ـ أيضاً ـ عن الإمام الحسين× قوله في دعاء القنوت:
«وَاحْرُسْنِي فِي بَلْوَايَ مِنِ افْتِنَانِ الِامْتِحَانِ، وَلَمَّةِ الشَّيْطَانِ، بِعَظَمَتِكَ الَّتِي لَا يَشُوبُهَا وَلَعُ نَفْسٍ بِتَفْتِينٍ، وَلَا وَارِدُ طَيْفٍ بِتَظْنِينٍ، وَلَا يَلُمُّ بِهَا فَرَحٌ»([dccxcvi]).
(يلمّ) من مادّة (لمّ)، وكلّما تعدّت بالـ(باء) كانت بمعنى المجيء والنزول بالشخص، ومن إرجاع الضمير (بها) إلى العظمة يستنتج أنّ الله تعالى لا يلمّ به فرح لعظمته الحقيقيّة، بينما الآخرون يبتهجون ويفرحون بعظمتهم المزيّفة.
روي عن أمير المؤمنين× أنّه قال:
«وَلَا يَتَغَيَّرُ بِحَالٍ، وَلَا يَتَبَدَّلُ فِي الأَحْوَالِ، وَلَا تُبْلِيهِ اللَّيَالِي وَالأَيَّامُ، وَلَا يُغَيِّرُهُ الضِّيَاءُ وَالظَّلَامُ»([dccxcvii]).
إنّ الفرح حالة تعرض على نفس الإنسان وتؤدّي إلى تبدّل الحالة التي تعيشها النفس من الضدّ وهو الحزن والأسى؛ ولذا طبقاً لجملة «لَا يَتَبَدَّلُ فِي الأَحْوَالِ» سلبت هذه الصفة عن الله}. وإن وردت رواية يدور فيها الحديث عن ابتهاج الله وفرحه لأمور مثل التوبة، فلابدّ من تأويلها وحمل ذلك الوصف على المعنى المجازي.
|
|
47ـ الضحك
|
|
عدم عروض الضحك على الله في كلام الامام الحسين×
ورد في جواب الإمام الحسين× عن سؤال البصريين حول معنى (ﭙ ﭚ) قوله:
«(ﭙ ﭚ): لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيفٌ؛ كَالوَلَدِ وَسَائِرِ الأَشْيَاءِ الكَثِيفَةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ المَخْلُوقِينَ، وَلَا شَيْءٌ لَطِيفٌ كَالنَّفْسِ، وَلَا يَتَشَعَّبُ مِنْهُ البَدَوَاتُ كَالسِّنَةِ وَالنَّوْمِ، وَالخَطْرَةِ وَالهَمِّ، وَالحَزَنِ وَالبَهْجَةِ، وَالضَّحِكِ...»([dccxcviii]).
يتبيّن من هذا الكلام أنّ الضحك لا يعرض على الله جلّ وعلا؛ لأنّه من خصائص الأجسام، والله تعالى مجرّد تام.
روي عن الإمام الصادق× قوله عن الله سبحانه:
«لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الحُدُوثُ وَلَا يَحُولُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ»([dccxcix]).
|
|
48ـ البكاء
|
|
عدم عروض البكاء على الله في كلام الإمام الحسين×
جاء في جواب الإمام الحسين× لكتاب أهل البصرة وسؤالهم عن معنى (ﭙ ﭚ) حيث قال:
«(ﭙ ﭚ): لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيفٌ؛ كَالوَلَدِ وَسَائِرِ الأَشْيَاءِ الكَثِيفَةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ المَخْلُوقِينَ، وَلَا شَيْءٌ لَطِيفٌ كَالنَّفْسِ، وَلَا يَتَشَعَّبُ مِنْهُ البَدَوَاتُ كَالسِّنَةِ وَالنَّوْمِ، وَالخَطْرَةِ وَالهَمِّ، وَالحَزَنِ وَالبَهْجَةِ، وَالضَّحِكِ وَالبُكَاءِ...»([dccc]).
يتبيّن عدم إمكان عروض البكاء على الله جلّت قدرته؛ لأنّ البكاء من خواصّ الاجسام، والبارئ تعالى مجرّد تام.
يشهد له قول أمير المؤمنين×:
«مَنْ وَحَّدَ اللهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يُشَبِّهْهُ بِالخَلْقِ»([dccci]).
وبما أنّ البكاء من بين صفات المخلوقات التي ينزّه عنها الله تعالى، فلابدّ إذن من سلب هذه الصفة عنه سبحانه.
|
|
49ـ الرجاء
|
|
عدم عروض الرجاء على الله في كلام الإمام الحسين×
ورد عن الإمام الحسين× قوله في جواب سؤال أهل البصرة عن معنى (ﭙ ﭚ):
«(ﭙ ﭚ): لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيفٌ؛ كَالوَلَدِ وَسَائِرِ الأَشْيَاءِ الكَثِيفَةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ المَخْلُوقِينَ، وَلَا شَيْءٌ لَطِيفٌ كَالنَّفْسِ، وَلَا يَتَشَعَّبُ مِنْهُ البَدَوَاتُ كَالسِّنَةِ وَالنَّوْمِ، وَالخَطْرَةِ وَالهَمِّ، وَالحَزَنِ وَالبَهْجَةِ، وَالضَّحِكِ وَالبُكَاءِ، وَالخَوْفِوَالرَّجَاءِ...»([dcccii]).
يدلّ هذا الكلام على عدم عروض حالة الرجاء والأمل على الله تعالى؛ لأنّ هذه الحالة من خواصّ الأجسام، والله جلّ شأنه مجرّد تام.
يؤيّده قول أمير المؤمنين× عن الله سبحانه:
«لَا يَتَغَيَّرُ بِحَالٍ، وَلَا يَتَبَدَّلُ فِي الأَحْوَالِ، وَلَا تُبْلِيهِ اللَّيَالِي وَالأَيَّامُ، وَلَا يُغَيِّرُهُ الضِّيَاءُ وَالظَّلَامُ»([dccciii]).
|
|
50ـ الرغبة
|
|
عدم عروض الرغبة على الله في كلام الامام الحسين×
ورد عن الإمام الحسين× قوله في جواب كتاب البصريين وقد سألوه فيه عن معنى (ﭙ ﭚ):
«(ﭙ ﭚ): لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيفٌ؛ كَالوَلَدِ وَسَائِرِ الأَشْيَاءِ الكَثِيفَةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ المَخْلُوقِينَ، وَلَا شَيْءٌ لَطِيفٌ كَالنَّفْسِ، وَلَا يَتَشَعَّبُ مِنْهُ البَدَوَاتُ كَالسِّنَةِ وَالنَّوْمِ، وَالخَطْرَةِ وَالهَمِّ، وَالحَزَنِ وَالبَهْجَةِ، وَالضَّحِكِ وَالبُكَاءِ، وَالخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، وَالرَّغْبَةِ...»([dccciv]).
يتأتّى من هذا الكلام أنّ مثل الميل والرغبة لا يمكن عروضها على الله تبارك وتعالى؛ لأنّها من خواصّ الجسم، والله جلّ جلاله مجرّد تام.
يشهد له قول أمير المؤمنين×:
«وَلَا يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنَ الأَجْزَاءِ وَلَا بِالجَوَارِحِ وَالأَعْضَاءِ، وَلَا بِعَرَضٍ مِنَ الأَعْرَاضِ، وَلَا بِالغَيْرِيَّةِ وَالأَبْعَاضِ، وَلَا يُقَالُ: لَهُ حَدٌّ وَلَا نِهَايَةٌ، وَلَا انْقِطَاعٌ وَلَا غَايَةٌ، وَلَا أَنَّ الأَشْيَاءَ تَحْوِيهِ فَتُقِلَّهُ أَوْ تُهْوِيَهُ، أَوْ أَنَّ شَيْئاً يَحْمِلُهُ فَيُمِيلَهُ أَوْ يُعَدِّلَهُ»([dcccv]).
|
|
|
|
51ـ السأم
عدم عروض السأم على الله في كلام الإمام الحسين×
روي عن الإمام الحسين× أنّه قال في جواب كتاب أهل البصرة حينما سألوه عن معنى (ﭙ ﭚ):
«(ﭙ ﭚ): لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيفٌ؛ كَالوَلَدِ وَسَائِرِ الأَشْيَاءِ الكَثِيفَةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ المَخْلُوقِينَ، وَلَا شَيْءٌ لَطِيفٌ كَالنَّفْسِ، وَلَا يَتَشَعَّبُ مِنْهُ البَدَوَاتُ كَالسِّنَةِ وَالنَّوْمِ، وَالخَطْرَةِ وَالهَمِّ، وَالحَزَنِ وَالبَهْجَةِ، وَالضَّحِكِ وَالبُكَاءِ، وَالخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، وَالرَّغْبَةِ وَالسَّأْمَةِ...»([dcccvi]).
وكلمة (السأمة) تعني الملل والضجر والتبرم، ويتحصّل من كلام المولى أبي عبد الله الحسين× أنّ الملل والسأم لا يعرض على الله جلّ وعلا؛ لأنّه من خواصّ الأجسام، والله سبحانه وتعالى تامّ التجرّد.
فقد ورد عن أمير المؤمنين× أنّه قال في وصف الحقّ تعالى:
«وَلَا اعْتَوَرَتْهُ فِي تَنْفِيذِ الأُمُورِ وَتَدَابِيرِ المَخْلُوقِينَ مَلَالَةٌ وَلَا فَتْرَةٌ»([dcccvii]).
|
|
|
|
عدم عروض الجوع على الله في كلام الإمام الحسين×
ورد عن الإمام الحسين× قوله في جواب كتاب البصريين وقد سألوه فيه عن معنى (ﭙ ﭚ):
«(ﭙ ﭚ): لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيفٌ؛ كَالوَلَدِ وَسَائِرِ الأَشْيَاءِ الكَثِيفَةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ المَخْلُوقِينَ، وَلَا شَيْءٌ لَطِيفٌ كَالنَّفْسِ، وَلَا يَتَشَعَّبُ مِنْهُ البَدَوَاتُ كَالسِّنَةِ وَالنَّوْمِ، وَالخَطْرَةِ وَالهَمِّ، وَالحَزَنِ وَالبَهْجَةِ، وَالضَّحِكِ وَالبُكَاءِ، وَالخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، وَالرَّغْبَةِ وَالسَّأْمَةِ، وَالجُوعِ...»([dcccviii]).
يتحصّل من كلام الإمام× أنّ الجوع لا يعرض على البارئ تعالى؛ لكونه من خواصّ الأجسام، والله سبحانه مجرّد تام.
وقد ورد عن الإمام الكاظم× في أحد الأدعية:
«أَنْتَ الصَّمَدُ الَّذِي لَا يطْعَمُ»([dcccix]).
|
|
|
|
53ـ الشبع
عدم عروض الشبع على الله في كلام الإمام الحسين×
روي عن الإمام الحسين× أنّه أجاب كتاب البصريين حيث سألوه عن معنى (ﭙ ﭚ) بقوله:
«(ﭙ ﭚ): لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيفٌ؛ كَالوَلَدِ وَسَائِرِ الأَشْيَاءِ الكَثِيفَةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ المَخْلُوقِينَ، وَلَا شَيْءٌ لَطِيفٌ كَالنَّفْسِ، وَلَا يَتَشَعَّبُ مِنْهُ البَدَوَاتُ كَالسِّنَةِ وَالنَّوْمِ، وَالخَطْرَةِ وَالهَمِّ، وَالحَزَنِ وَالبَهْجَةِ، وَالضَّحِكِ وَالبُكَاءِ، وَالخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، وَالرَّغْبَةِ وَالسَّأْمَةِ، وَالجُوعِ وَالشِّبَعِ»([dcccx]).
إذ يدلّ كلام الإمام× على عدم عروض الشبع على الله جلّ جلاله؛ لأنّ هذه الحالة من خواصّ الأجسام، وهو تعالى مجرّد تام.
يقول عزّ من قائل:
(ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ)([dcccxi]).
|
|
54ـ التركيب
نفي التركيب عن الله في كلام الإمام الحسين×
ورد عن الإمام الحسين× قوله مخاطباً نافع بن الأزرق:
«أَصِفُ إِلَهِي بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَأُعَرِّفُهُ بِمَا عَرَّفَ بِهِ نَفْسَهُ: لَا يُدْرَكُ بِالحَوَاسِّ، وَلَا يُقَاسُ بِالنَّاسِ، فَهُوَ قَرِيبٌ غَيْرُ مُلْتَصِقٍ، وَبَعِيدٌ غَيْرُ مُتَقَصٍّ، يُوَحَّدُ وَلَا يُبَعَّضُ، مَعْرُوفٌ بِالآيَاتِ، مَوْصُوفٌ بِالعَلَامَاتِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الكَبِيرُ المُتَعالِ»([dcccxii]).
يتبيّن من جملة «لَا يُبَعَّضُ» أنّ الله جلّت قدرته ليس مركّباً من أجزاء.
وفي ذلك قال القاضي سعيد القمّي:
«(ولا يبعّض) عطف تفسيري له، أي هو واحد حقيقة الوحدانيّة وأشدّها، بمعنى أنّه ليس له جزء ولا يصير جزء الشيء من عدد وغيره. والتعبير بالفعل المضارع للإشارة إلى أنّ اللائق بالعباد أن يقروا بوحدانيّته الصرفة من غير تعمل فيه تعالى، بل إن كان فبالتعمل في نفس الموحّد على اسم الفاعل لا الموحّد على المفعول»([dcccxiii]).
وقال الملّا مهدي النراقي:
«اعلم أنّ التركيب والكثرة المنفيين عنه ـ سبحانه ـ إمّا تركيب وكثرة مع الذات، وهو الكثرة التي يتصوّر باعتبار الذات والوجود أو الذات والعكس، أو كثرة بعد الذات، وهو الكثرة التي يتصوّر باعتبار الانقسام إلى الذات والصفات الكمالية، أو كثرة قبل الذات، وهي الكثرة التي تكون باعتبار تركب الذات والماهيّة من الأجزاء، وهذا على قسمين:
أحدهما: التركيب من الأجزاء العقليّة الذهنيّة كالجنس والفصل.
وثانيهما: من الأجزاء الخارجيّة، سواء كانت أجزاء مقداريّة متشابهة أو غير متشابهة، أو أجزاء غير مقداريّة كالمادّة والصورة.
ثمّ إنّ تجرّده ـ سبحانه ـ عن هذه التركيبات يسمّى بالأحديّة، كما أنّ تفرّده عن الشريك في وجوب الوجود يسمّى بالواحديّة؛ لأنّ الأحديّة إنّما هو معنى عدم الانقسام إلى الأجزاء ـ سواء كانت أجزاء من قبل الذات أو معه أو بعده ـ والواحديّة هو عدم الانقسام إلى الأجزاء والجزئيّات. والمفهوم من كلام الشيخ في الإشارات أنّ الأحديّة هي عدم قبول القسمة إلى الأجزاء والجزئيّات والصفات القائمة بذاته، وعدم التحليل إلى الماهيّة والوجود؛ وعلى هذا يكون الأحديّة أخصّ من الواحديّة»([dcccxiv]).
عن شريح بن هاني، قال:
«إِنَّ أَعْرَابِيّاً قَامَ يَوْمَ الجَمَلِ إِلَى أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ×، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَتَقُولُ: إِنَّ اللهَ وَاحِدٌ؟ قَالَ: فَحَمَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ، قَالُوا: يَا أَعْرَابِيُّ، أَمَا تَرَى مَا فِيهِ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ مِنْ تَقَسُّمِ القَلْبِ؟! فَقَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ×: دَعُوهُ؛ فَإِنَّ الَّذِي يُرِيدُهُ الأَعْرَابِيُّ هُوَ الَّذِي نُرِيدُهُ مِنَ القَوْمِ. ثُمَّ قَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ إِنَّ القَوْلَ فِي أَنَّ اللهَ وَاحِدٌ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: فَوَجْهَانِ مِنْهَا لَا يَجُوزَانِ عَلَى اللهِ}، وَوَجْهَانِ يَثْبُتَانِ فِيهِ.
فَأَمَّا اللَّذَانِ لَا يَجُوزَانِ عَلَيْهِ فَقَوْلُ القَائِلِ: (وَاحِدٌ) يَقْصِدُ بِهِ بَابَ الأَعْدَادِ، فَهَذَا مَا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ مَا لَا ثَانِيَ لَهُ لَا يَدْخُلُ فِي بَابِ الأَعْدَادِ، أَمَا تَرَى أَنَّهُ كَفَرَ مَنْ قَالَ: ثالِثُ ثَلاثَةٍ. وَقَوْلُ القَائِلِ: (هُوَ وَاحِدٌ مِنَ النَّاسِ) يُرِيدُ بِهِ النَّوْعَ مِنَ الجِنْسِ، فَهَذَا مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ تَشْبِيهٌ، وَجَلَّ رَبُّنَا عَنْ ذَلِكَ وَتَعَالَى.
وَأَمَّا الوَجْهَانِ اللَّذَانِ يَثْبُتَانِ فِيهِ فَقَوْلُ القَائِلِ: (هُوَ وَاحِدٌ لَيْسَ لَهُ فِي الأَشْيَاءِ شِبْهٌ) كَذَلِكَ رَبُّنَا، وَقَوْلُ القَائِلِ: (إِنَّهُ} أَحَدِيُّ المَعْنَى) يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ لَا يَنْقَسِمُ فِي وُجُودٍ وَلَا عَقْلٍ وَلَا وَهْمٍ، كَذَلِكَ رَبُّنَا}»([dcccxv]).
فأشير في ذيل كلام أمير المؤمنين× إلى
نفي أنواع التركيب عن الله سبحانه.
|
|
عدم قياس الله بالناس في كلام الإمام الحسين×
ورد في خطاب الإمام الحسين× لنافع بن الأزرق قوله له:
«أَصِفُ إِلَهِي بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَأُعَرِّفُهُ بِمَا عَرَّفَ بِهِ نَفْسَهُ: لَا يُدْرَكُ بِالحَوَاسِّ، وَلَا يُقَاسُ بِالنَّاسِ، فَهُوَ قَرِيبٌ غَيْرُ مُلْتَصِقٍ، وَبَعِيدٌ غَيْرُ مُتَقَصٍّ، يُوَحَّدُ وَلَا يُبَعَّضُ، مَعْرُوفٌ بِالآيَاتِ، مَوْصُوفٌ بِالعَلَامَاتِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الكَبِيرُ المُتَعالِ»([dcccxvi]).
من جملة «لَا يُقَاسُ بِالنَّاسِ» يستفاد أنّ ذات الله وصفاته يجب أن لا تقاس بالناس، ولا تشبّه بهم.
قال القاضي سعيد القمّي في شرحه لهذه الجملة:
«وأمّا أنّه لا يقاس بالناس فهو مأخوذ من قوله جلّ برهانه: (ﭡ ﭢ ﭣ)([dcccxvii]) وهو ظاهر»([dcccxviii]).
وعن يونس بن ظبيان أنّه قال:
«دَخَلْتُ عَلَى الصَّادِقِ× فَقُلْتُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ، إِنِّي دَخَلْتُ عَلَى مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فَسَمِعْتُ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: إِنَّ الله له [لِلهِ] وَجْهاً كَالوُجُوهِ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: لَهُ يَدَانِ، وَاحْتَجُّوا بِذَلِكَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: (ﯤﯥ ﯦ)([dcccxix]) وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: هُوَ كَالشَّابِّ مِنْ أَبْنَاءِ ثَلَاثِينَ سَنَةً، فَمَا عِنْدَكَ فِي هَذَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ؟
قَالَ: فَكَانَ مُتَّكِئاً فَاسْتَوَى جَالِساً، وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ، ثُمَّ قَالَ: يَا يُونُسُ، مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلهِ وَجْهاً كَالوُجُوهِ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلهِ جَوَارِحَ كَجَوَارِحِ المَخْلُوقِينَ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ، فَلَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ وَلَا تَأْكُلُوا ذَبِيحَتَهُ، تَعَالَى اللهُ عَمَّا يَصِفُهُ المُشَبِّهُونَ بِصِفَةِ المَخْلُوقِينَ، فَوَجْهُ اللهِ أَنْبِيَاؤُهُ، وَقَوْلُهُ: (ﯣ ﯤﯥ ﯦ)([dcccxx]) فَاليَدُ القُدْرَةُ كَقَوْلِهِ: (ﭝ ﭞ)([dcccxxi]). فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللهَ فِي شَيْءٍ أَوْ عَلَى شَيْءٍ، أَوْ تَحَوَّلَ مِنْ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ، أَوْ يَخْلُو مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ يَشْغَلُ بِهِ شَيْءٌ، فَقَدْ وَصَفَهُ بِصِفَةِ المَخْلُوقِينَ، وَاللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، لَا يُقَاسُ بِالقِيَاسِ وَلَا يُشَبَّهُ بِالنَّاسِ، لَا يَخْلُو مِنْهُ مَكَانٌ، وَلَا يَشْغَلُ بِهِ مَكَانٌ، قَرِيبٌ فِي بُعْدِهِ، بَعِيدٌ فِي قُرْبِهِ، ذَلِكَ اللهُ رَبُّنَا لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، فَمَنْ أَرَادَ اللهَ وَأَحَبَّهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَهُوَ مِنَ المُوَحِّدِينَ، وَمَنْ أَحَبَّهُ بِغَيْرِ هَذِهِ الصِّفَةِ فَاللهُ مِنْهُ بَرِيءٌ، وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَآءُ»([dcccxxii]).
عدم البديل لله في كلام الإمام الحسين×
عن الإمام الحسين× أنّه كان يدعو إذا أصبح وأمسى:
«اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَكْفِينِي مِنْ كُلِّ
أَحَدٍ، وَلَا يَكْفِينِي أَحَدٌ مِنْكَ، فَاكْفِنِي مِنْ كُلِّ أَحَدٍ
مَا أَخَافُ وَأَحْذَرُ»([dcccxxiii]).
يتحصّل من مضمون هذه الجملة عدم قدرة أيّ أحد على القيام بالأمور المرتبطة بالله سبحانه والاكتفاء به.
ويؤيّده دعاء الإمام الرضا× حيث يقول:
«يَا مَنْ يَكْفِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا يَكْفِي مِنْهُ شَيْءٌ»([dcccxxiv]).
لمصادر والمراجع
المصادر والمراجع
* القرآن الكريم.
* نهج البلاغة، قم ـ إيران، مؤسّسة دار الهجرة، 1414 ﻫ.ق.
* الصحيفة السجاديّة، قم ـ إيران، نشر الهادي، 1376 ﻫ.ش.
1. ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله، شرح نهج البلاغة، دار إحياء الكتب العربيّة، 1385 ﻫ.ق.
2. ابن أبي العزّ، علي بن علي، شرح العقيدة الطحّاوية، بغداد ـ العراق، دار الكتاب العربي، 2005 م.
3. ابن أبي شيبة، عبدالله بن محمد، المصنّف في الأحاديث والآثار، بيروت ـ لبنان، دار التاج، 1409 ﻫ.ق.
4. ابن الأثير، مبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر، قم ـ إيران، مؤسسة مطبوعات إسماعيليان، 1367 ﻫ.ش.
5. ابن الصبّاغ، علي بن محمد، الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة، قم ـ إيران، مؤسّسة دار الحديث العلميّة الثقافيّة، مؤسّسة الطباعة والنشر، 1422 ﻫ.ق.
6. ابن بسطام، عبدالله، وابن بسطام، حسين، طب الأئمّة^، النجف الأشرف ـ العراق، المطبعة الحيدريّة، 1385 ﻫ.ق.
7. ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح، الرياض ـ السعوديّة، دار العاصمة، 1419 ﻫ.ق.
8. ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة، المدينة ـ السعوديّة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1426 ﻫ.ق.
9. ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، مجموع الفتاوى، المدينة ـ السعوديّة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1416 ﻫ.ق.
10. ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، منهاج السنّة النبويّة، الرياض ـ السعوديّة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة، 1406 ﻫ.ق.
11. ابن حبّان، محمد بن حبان بن أحمد، الثقات، حيدرآباد ـ هند، دائرة المعارف العثمانيّة، 1393 ﻫ.ق.
12. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت ـ لبنان، دار المعرفة، 1379 ﻫ.ق.
13. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، لسان الميزان، بيروت ـ لبنان، دار البشائر الإسلاميّة، 1423 ﻫ.ق.
14. ابن حزم، علي بن أحمد، الفصل في الملل والأهواء والنحل، القاهرة ـ مصر، مكتبة الخانجي، بلا تا.
15. ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، بيروت ـ لبنان، مؤسّسة الرسالة، 1421 ﻫ.ق.
16. ابن شعبة، حسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليهم)، قم ـ إيران، جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة بقم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1404 ﻫ.ق.
17. ابن شهرآشوب، محمد بن علي، معالم العلماء، النجف الأشرف ـ العراق، المطبعة الحيدريّة، 1380 ﻫ.ق.
18. ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال، طهران ـ إيران، دار الكتب الإسلاميّة، 1409 ﻫ.ق.
19. ابن طاووس، علي بن موسى، الدروع الواقية، بيروت ـ لبنان، مؤسّسة آل البيت^ لإحياء التراث، 1415 ﻫ.ق.
20. ابن طاووس، علي بن موسى، جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع، قم ـ إيران، الشريف الرضي، 1330 ﻫ.ق.
21. ابن طاووس، علي بن موسى، فلاح السائل، قم ـ إيران، الحوزة العلميّة بقم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1406 ﻫ.ق.
22. ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات، قم ـ إيران، دار الذخائر، 1411 ﻫ.ق.
23. ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، قم ـ إيران، مكتب الإعلام الإسلامي، 1404 ﻫ.ق.
24. ابن قيم الجوزيّة، محمد بن أبي بكر، الصواعق المرسلة في الردّ على الجهميّة والمعطلة، الرياض ـ السعوديّة، دار العاصمة، 1408 ﻫ.ق.
25. ابن قيم الجوزيّة، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، بيروت ـ لبنان، مؤسّسة الرسالة، 1418 ﻫ.ق.
26. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت ـ لبنان، دار صادر، 1414 ﻫ.ق.
27. أبو الصلاح الحلبي، تقي بن نجم، تقريب المعارف، محقق، 1417 ﻫ.ق.
28. أبو حيان، محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير، بيروت ـ لبنان، دار الفكر، 1420 ﻫ.ق.
29. أبو داود السجستاني، سليمان بن أشعث، سنن أبي داود، صيدا ـ بيروت، المكتبة العصريّة، بلا تا.
30. أبو يعلى الموصلي، أحمد بن علي، مسند أبي يعلى، دمشق ـ سورية، دار المأمون للتراث، 1404 ﻫ.ق.
31. الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1421 ﻫ.ق.
32. الاسترآبادي، محمد جعفر بن سيف الدين، البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة، قم ـ إيران، بوستان كتاب قم (نشر مكتب الإعلام الإسلامي في الحوزة العلميّة في قم)، 1382 ﻫ.ش.
33. الاسفرايني، شهفور بن طاهر، التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، القاهرة ـ مصر، المكتبة الأزهريّة للتراث، بلا تا.
34. الأشعري، علي بن إسماعيل، الإبانة عن أصول الديانة، القاهرة ـ مصر، دار الأنصار، 1397 ﻫ.ق.
35. الأشعري، علي بن إسماعيل، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، فيسبادن ـ ألمانيا، دار النشر فرانز شتاينر، 1400 ﻫ.ق.
36. آل الشيخ، صالح بن عبد العزيز، شرح العقيدة الطحّاوية، المنصورة ـ مصر، دار المودّة، 1431 ﻫ.ق.
37. الألباني، محمد ناصرالدين، موسوعة الألباني في العقيدة، صنعاء ـ اليمن، مركز النعمان، 1431 ﻫ.ق.
38. الآمدي، عبد الواحد بن محمد، غرر الحكم ودرر الكلم، قم ـ إيران، دار الكتاب الإسلامي، 1410 ﻫ.ق.
39. الباقلاني، محمد بن الطيب، تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل، بيروت ـ لبنان، مؤسّسة الكتب الثقافية، 1407 ﻫ.ق.
40. البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، بيروت ـ لبنان، دار طوق النجاة، 1422 ﻫ.ق.
41. برنجكار، رضا، وشاه چراغ، سيد مسيح، «إلهيات سلبي در مدرسه كلاميحله»، المجلة الفصلية (تحقيقات كلامي)، العدد. 15، الصفحة 61ـ82، 1395 ﻫ.ش.
42. البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف، بيروت ـ لبنان، دار الفكر، 1417 ﻫ.ق.
43. بن باز، عبدالعزيز بن عبدالله، مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة، بلا تا.
44. البياضي، أحمد بن حسن، إشارات المرام من عبارات الإمام، القاهرة ـ مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1368 ﻫ.ق.
45. البيهقي، أحمد بن حسين، الأسماء والصفات، بيروت ـ لبنان، دار الجيل، 1417 ﻫ.ق.
46. البيهقي، أحمد بن حسين، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، بيروت ـ لبنان، دار الآفاق الجديدة، 1401 ﻫ.ق.
47. الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، القاهرة ـ مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1395 ﻫ.ق.
48. الجرجاني، علي بن محمد، شرح المواقف، قم ـ إيران، الشريف الرضي، 1325 ﻫ.ق.
49. الجرجاني، علي بن محمد، كتاب التعريفات، طهران ـ إيران، ناصر خسرو، 1412 ﻫ.ق.
50. الجوادي الآملي،عبدالله، توحيد در قرآن، تفسير موضوعي قرآن كريم، قم ـ إيران، دار الإسراء، 1383 ﻫ.ش.
51. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربيّة، بيروت ـ لبنان، دار العلم للملايين، 1376 ﻫ.ق.
52. الحسيني الطهراني، محمد حسين، الشمس الساطعة: رسالة في ذكرى العالم الرباني العلّامة السيد محمد حسين الطباطبائي التبريزي، ترجمة عباس نور الدين وعبد الرحيم مبارك، بيروت ـ لبنان، دار المحجّة البيضاء، 1417 ﻫ.ق.
53. الحسيني الطهراني، محمد حسين، معرفة الله، ترجمة عباس جواد الصافي، بيروت ـ لبنان، دار المحجّة البيضاء، 1420 ﻫ.ق.
54. الخادمي، حميد رضا، «بررسي ونقد ديدگاه ملّا رجبعلي تبريزي وقاضي سعيد قمي در الهيات سلبي»، مجلّة (پژوهش هاي هستي شناختي)، العدد. 14، صفحة 125ـ142، 1397 ﻫ.ش.
55. الخزاز الرازي، علي بن محمّد، كفاية الأثر في النص على الأئمّة الاثني عشر، قم ـ إيران، بيدار، 1401 ﻫ.ق.
56. الخميني، روح الله، (الأربعون حديثاً)، قم ـ إيران، ترجمة: محمد الغروي، دار الكتاب الإسلامي، بلا تا.
57. الخميني، روح الله، مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، طهران ـ إيران، مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1376 ﻫ.ش.
58. الخوئي، أبو القاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقى، قم ـ إيران، لطفي، 1418 ﻫ.ق.
59. الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، مركز نشر الثقافة الإسلاميّة في العالم، 1413 ﻫ.ق.
60. الدارمي، عثمان بن سعيد، الردّ على الجهميّة، الكويت، دار ابن الأثير، 1416 ﻫ.ق.
61. الدشتي، محمود بن أبي القاسم، إثبات الحدّ لله}، جدة ـ السعوديّة، 1430 ﻫ.ق.
62. الراغب الأصفهاني، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، دمشق ـ بيروت، دار القلم ـ الدار الشاميّة، 1412 ﻫ.ق.
63. الزمخشري، محمود بن عمر، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، بيروت ـ لبنان، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، 1412 ﻫ.ق.
64. الزنوزي، عبد الله، لمعات إلهيّة، طهران ـ إيران، مؤسّسة پژوهشي حكمت وفلسفه إيران، 1381 ﻫ.ش.
65. السبزواري، محمد بن محمد، جامع الأخبار، بيروت ـ لبنان، مؤسّسة آل البيت^ لإحياء التراث، 1413 ﻫ.ق.
66. السبزواري، هادي بن مهدي، رسائل الحكيم السبزواري، طهران ـ إيران، أسوة، 1376 ﻫ.ش.
67. شبّر، عبد الله، حقّ اليقين في معرفة أصول الدين، قم ـ إيران، أنوار الهدى، 1424 ﻫ.ق.
68. شرف الدين، عبد الحسين، موسوعة الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين، بيروت ـ لبنان، دار المورّخ العربي، 1431 ﻫ.ق.
69. الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، بيروت ـ لبنان، دار المعرفة، 1415 ﻫ.ق.
70. الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، نهاية الإقدام في علم الكلام، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلميّة، 1425 ﻫ.ق.
71. الشيخ البهائي، محمد بن الحسين، الحديقة الهلاليّة، بيروت ـ لبنان، مؤسّسة آل البيت^ لإحياء التراث، 1411 ﻫ.ق.
72. صالح بن فوزان، التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية، الرياض ـ السعوديّة، دار العاصمة للنشر والتوزيع، بلا تا.
73. صدر الدين الشيرازي، محمد بن إبراهيم، الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1981 م.
74. الصدوق، محمد بن علي، الأمالي، طهران ـ إيران، مؤسّسة البعثة، 1435 ﻫ.ق.
75. الصدوق، محمد بن علي، التوحيد، قم ـ إيران، جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة بقم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1398 ﻫ.ق.
76. الصدوق، محمد بن علي، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، قم ـ إيران، الشريف الرضي، 1406ﻫ.ق.
77. الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا×، طهران ـ إيران، جهان، 1378 ﻫ.ق.
78. الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم ـ إيران، جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة بقم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1413 ﻫ.ق.
79. الطباطبائي، محمد حسين، الرسائل التوحيديّة، بيروت ـ لبنان، مؤسّسة النعمان، 1999 م.
80. الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت ـ لبنان، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، 1390 ﻫ.ق.
81. الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، قم ـ إيران، جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة بقم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1416 ﻫ.ق.
82. الطبراني، سليمان بن أحمد، الدعاء، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلميّة، 1413 ﻫ.ق.
83. الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج، مشهد المقدّسة ـ إيران، نشر المرتضى، 1403 ﻫ.ق.
84. الطبرسي، الحسن بن الفضل، مكارم الأخلاق، قم ـ إيران، الشريف الرضي، 1412 ﻫ.ق.
85. الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشّي، مشهد المقدّسة ـ إيران، جامعة مشهد، كليّة الإلهيّات والمعارف الإسلاميّة، مركز تحقيقات ومطالعات، 1409 ﻫ.ق.
86. الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، بلا تا.
87. الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإماميّة، طهران ـ إيران، المكتبة المرتضويّة لإحياء الآثار الجعفريّة، 1387 ﻫ.ق.
88. الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد، بيروت ـ لبنان، مؤسّسة فقه الشيعة، 1411 ﻫ.ق.
89. العثيمين، محمد بن صالح، شرح العقيدة السفارينيّة، الرياض ـ السعوديّة، دار الوطن للنشر، 1426 ﻫ.ق.
90. العثيمين، محمد بن صالح، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الرياض ـ السعودية، دار الوطن ـ دار الثريا، 1413 ﻫ.ق.
91. العلّامة الحلّي، الحسن بن يوسف، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (قسم الإلهيّات)، قم ـ إيران، مؤسّسة الإمام الصادق×، 1382ﻫ.ش.
92. العلّامة الحلّي، الحسن بن يوسف، مناهج اليقين في أصول الدين، طهران ـ إيران، منظمة الأوقاف والشؤون الخيريّة، دار الأسوة للطباعة والنشر، 1415 ﻫ.ق.
93. العلّامة الحلّي، الحسن بن يوسف، نهج الحق وكشف الصدق، بيروت ـ لبنان، دار الكتاب اللبناني، 1982 م.
94. العيني، محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، بلا تا.
95. الغزالي، محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، بيروت ـ لبنان، دار الكتاب العربي، بلا تا.
96. الغماري، عبدالله بن صديق، فتح المعين بنقد كتاب الأربعين، 1428 ﻫ.ق.
97. الفاضل المقداد، مقداد بن عبدالله، إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين، قم ـ إيران، المكتبة العامّة لسماحة آية الله العظمى المرعشي النجفي، 1405 ﻫ.ق.
98. الفاضل المقداد، مقداد بن عبدالله، اللوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة، قم ـ إيران، الحوزة العلميّة قم، مكتب الإعلام الإسلامي، مركز انتشارات، 1422 ﻫ.ق.
99. الفخر الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1420 ﻫ.ق.
100. الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، قم ـ إيران، مؤسّسه انتشارات هجرت، 1409 ﻫ.ق.
101. فرج، مرتضى، شرح دعاء الإمام الحسين× يوم عرفة، 1433 ﻫ.ق.
102. الفيروآبادي، محمد بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، القاهرة ـ مصر، المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة ـ لجنة إحياء التراث الإسلامي، 1416 ﻫ.ق.
103. الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلميّة، 1415 ﻫ.ق.
104. القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد بن محمد مفيد، شرح الأربعين، طهران ـ إيران، مركز تحقيق ميراث مكتوب، 1379ﻫ.ش.
105. القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد بن محمد مفيد، شرح توحيد الصدوق، طهران ـ إيران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، مكتب الطباعة والنشر، 1415ﻫ.ق.
106. القاضي عبدالجبار بن أحمد، المغني في أبواب التوحيد والعدل، بلا تا.
107. القاضي عبدالجبار بن أحمد، شرح الأصول الخمسة، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1422ﻫ.ق.
108. القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، القاهرة ـ مصر، دار الكتب المصريّة، 1384ﻫ.ق.
109. القشيري النيسابوري، مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، القاهرة ـ مصر، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، 1374ﻫ.ق.
110. قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الخرائج والجرائح، قم، مؤسّسة الإمام المهدي×، 1409 ﻫ.ق.
111. قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات، قم ـ إيران، مدرسة الإمام المهدي×، 1407 ﻫ.ق.
112. القفاري، ناصر بن عبدالله، أصول مذهب الشيعة الإماميّة الاثني عشريّة: عرض ونقد، 1414 ﻫ.ق.
113. الكاظمي القزويني، محمد مهدي، منهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية، النجف الأشرف ـ العراق، المطبعة العلويّة، 1346 ﻫ.ق.
114. الكراجكي، محمد بن علي، كنز الفوائد، قم ـ إيران، دار الذخائر، 1410 ﻫ.ق.
115. الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين، طهران ـ إيران، مكتبة الصدوق، بلا تا.
116. الكفعمي، إبراهيم بن علي، مصباح الكفعمي، قم ـ إيران، دار الرضي ـ زاهدي، 1405 ﻫ.ق.
117. الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران ـ إيران، دار الكتب الإسلاميّة، 1407 ﻫ.ق.
118. اللاهيجي، عبد الرزاق بن علي، گوهر مراد، طهران ـ إيران، نشر سايه، 1383 ﻫ.ش.
119. المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1403 ﻫ.ق.
120. المدني، علي خانبنأحمد، رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد الساجدين (صلوات الله عليه)، قم ـ إيران، جامعه مدرّسي الحوزة العلميّة في قم، مكتب النشر الإسلامي، 1409 ﻫ.ق.
121. مشكاتي، محمد مهدي، والمنصوري، مهدي، «واكاوي ونقد مباني إلهيات سلبي با تأكيد بر آراء ملّا صدرا»، تاريخ فلسفه، العدد. 11، صفحة 159ـ204، 1391 ﻫ.ش.
122. المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، طهران ـ إيران، مركز نشر آثار العلّامة المصطفوي، 1385 ﻫ.ش.
123. مطهري، مرتضى، مجموعه آثار استاد شهيد مطهري، طهران ـ إيران، صدرا، 1377 ﻫ.ش.
124. المفيد، محمد بن محمد، أوائل المقالات، قم ـ إيران، المؤتمر العالمي لألفيّة الشيخ المفيد، 1413 ﻫ.ق.
125. الملكي الميانجي، محمد باقر، توحيد الإماميّة، طهران ـ إيران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، دائرة الطباعة والنشر، 1415 ﻫ.ق.
126. النراقي، مهدي بن أبي ذر، جامع الأفكار وناقد الأنظار، طهران ـ إيران، حكمت، 1423 ﻫ.ق.
127. النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، بيروت ـ لبنان، مؤسّسة الرسالة، 1421 ﻫ.ق.
128. النووي، يحيى بن شرف، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1392 ﻫ.ق.
129. هرّاس، محمد خليل، شرح العقيدة الواسطيّة، الخبر ـ السعوديّة، دار الهجرة للنشر والتوزيع، 1415 ﻫ.ق.
130.
واحد التبريزي، رجبعلي، الأصل الأصيل
(أصول آصفيه)، طهران ـ إيران، اتحاد آثار ومفاخر فرهنگي، 1386 ﻫ.ش.
المحتويات
TOC \o "1-3" \h \z \u توطئة
المقدّمة الأولى: المعيار في الصفات الثبوتيّة والسلبيّة
المقدّمة الثانية: رجوع الصفات السلبيّة إلى الثبوتيّة
المقدّمة الثالثة: الدليل العام على الصفات السلبيّة
المقدّمة الرابعة: وحدة الصفات السلبيّة وتعدّدها
المقدّمة الخامسة: حيثيّات البحث عن الله وصفاته
المقدّمة السادسة: الإلهيّات السلبيّة
نبذة تاريخيّة عن الإلهيات السلبيّة
القاضي سعيد القمّي المنظّر للإلهيات السلبيّة
طريق معرفة الله في رأي القاضي سعيد القمّي
3ـ الاعتقاد بالاشتراك اللفظي للوجود
4ـ مخالفة القول بعينيّة الصفات للذات
5ـ الملازمة بين الإلهيات الإيجابيّة وإمكانيّة إدراك كنه الذات
6ـ استلزام الفاعليّة والقابليّة والتكثّر في ذات الله
المقدّمة السابعة: الإلهيات التنزيهيّة
2ـ الروايات وتنزيه البارئ تعالى
3ـ التصريح بالإلهيات التنزيهية
4ـ الإلهيات التنزيهيّة في كلام الإمام الحسين×
عموم الصفات السلبيّة في كلام الإمام الحسين×
أ) التنزيه العام لله في كلام الإمام الحسين×
ب) أوقات تنزيه الله تعالى في كلام الإمام الحسين×
تنزيه الله تعالى في ساعات الليل
تنزيه الله تعالى حين دخول المساء والصباح
ج) ما نُزّه عنه الله تعالى في كلام الإمام الحسين×
تنزيه الله تعالى عن المضادّ له في صنعه
تنزيه الله تعالى عن الحاجة للطاعة
تنزيه الله تعالى عما يقول الظالمون
تنزيه الله تعالى عن شرك المشركين
تنزيه ذات الله وصفاته عن النقص
تنزيه الله تعالى عن أوصاف الخلق الناقصة
تنزيه الله تعالى عن النقص في ربوبيّة عرشه
تنزيه الله تعالى عن ظلم المبتلين
تنزيه الله تعالى لقدرته الخارقة
تنزيه الله عن أيّ عيب أو نقص في العلم
تنزيه الله في أفضليّته على خلقه
تنزيه الإله الذي لا تراه العيون
تنزيه الإله الذي لا يمثّله العقل
تنزيه الإله الذي لا يتصوّر بالخيال
تنزيه الإله الذي لا تصفه الألسن
تنزيه الله في قضائه بالموت على عباده
تنزيه الله في تسخير الأمور للإنسان
تنزيه الإله الذي لا يخفى عليه شيء
تنزيه الله في العزّة الناشئة عن القدرة
عدم النظير لله في كلام الإمام الحسين×
عدم الشبيه لله في كلام الإمام الحسين×
المسيحيّون والاعتقاد ببنوّة عيسى لله
عدم الولد لله في كلام الإمام الحسين×
حسن الثناء على الله لعدم اتخاذه ولداً
شدّة الغضب الإلهي من عقيدة أهل الكتاب
عدم ولادة الله في كلام الإمام الحسين×
عدم إيجاد الله من قبل أيّ موجود
لا وليّ لله في كلام الإمام الحسين×
عدم الضدّ لله في كلام الإمام الحسين×
عدم الوزير لله في كلام الإمام الحسين×
عدم ذلّة الله في كلام الإمام الحسين×
العامّة والاعتقاد بالرؤية بالعين
الاجماع على عدم جواز الرؤية في الدنيا
أدلّة القائلين بجواز الرؤية في الآخرة
رؤية الله في كلام الإمام الحسين×
عدم رؤية الله بالعين (آلة البصر)
احتجاب الله عن الإدراك بالأبصار
احتجاب الله عن الموجودات الأرضيّة والسماويّة
عدم حاجة الله في كلام الإمام الحسين×
عدم حاجة الله لخلق الإنسان من البداية
عدم حاجة الله لعرض الفاقة والعوز
عدم إدراك الله في كلام الإمام الحسين×
عدم إدراك الهويّة الذاتيّة لله من قبل أحد
عدم إدراك حقيقة الله من قبل أحد
عدم خطور مبلغ جبروته على قلوب الناس
عدم الإدراك الكامل لله بالألباب
عدم إمكان الإدراك الكامل لله بالفكر البشري
عدم إدراك كنه ذات الله بعقول البشر
محدوديّة الفكر في فهم ذات الله وصفاته
مخالفة الحدّ للأزليّة الإلهيّة
عدم الحدّ لله في كلام الإمام الحسين×
عدم محدوديّة الكمالات الإلهيّة
عدم إمكان المدح الكامل لله في كلام الإمام الحسين×
عدم خفاء الأمور على الله في كلام الإمام الحسين×
عدم خفاء أحوال الإنسان عن الله
عدم غيبة الله في كلام الإمام الحسين×
عدم إمكان مغلوبيّة الله في كلام الإمام الحسين×
عدم الحجاب بين الخلق والخالق في كلام الإمام الحسين×
عدم عجز الله في كلام الإمام الحسين×
عدم خلف الوعد في كلام الإمام الحسين×
عدم عروض الخوف على الله في كلام الإمام الحسين×
عدم عروض السنة على الله في كلام الإمام الحسين×
عدم عروض النوم على الله في كلام الإمام الحسين×
اعتقاد ابن تيمية بالقدر المشترك بين الأجسام
4ـ إثبات الثقل لذات الله سبحانه
5ـ إثبات الحركة والانتقال لله سبحانه
6ـ إثبات الطواف في الأرض لله سبحانه
الأدلّة العقليّة على نفي الجسميّة
أهل البيت^ ونفي الجسميّة عن الله
إلصاق تهمة (القول بالتجسيم) ببعض شخصيّات الشيعة
تبرئة هشام بن الحكم من القول بالتجسيم
المرحلة الأولى: مناقشة إسناد العبارة
المرحلة الثانية: مناقشة محتوى العبارة
مناقشة الروايات الذامّة لهشام بلحاظ القول بالتجسيم
آراء علماء الشيعة في مسألة التجسيم
عدم جسميّة الله في كلام الإمام الحسين×
ملازمة أحديّة الله لنفي التجسيم
عدم الكفؤ لله في كلام الإمام الحسين×
عدم السميّ لله في كلام الإمام الحسين×
عدم المثل لله في كلام الإمام الحسين×
الصفات المؤثّرة في عدم المثل لله
عدم الندّ لله في كلام الإمام الحسين×
عدم العِدل لله في كلام الإمام الحسين×
عدم تداول الأمور على الله في كلام الإمام الحسين×
عدم عروض التغيير على الله في كلام الإمام الحسين×
اعتقاد ابن تيمية بقيام الحوادث في الله سبحانه
أهل السنّة وامتناع قيام الحوادث بالله
عدم نزول الحوادث على الله في كلام الإمام الحسين×
عدم قابليّة الوصف الحقيقي لله في كلام الإمام الحسين×
عدم إمكان وصف العلم الذاتي لله
عدم حدوث الله في كلام الإمام الحسين×
العقل وتنزيه الله عن الجهة والمكان
القرآن ونفي الجهة والمكان عن الله
الروايات ونفي الجهة والمكان عن الله
أهل السنّة والاعتقاد بنفي الجهة والمكان عن الله سبحانه
الوهابيّة وعقيدتهم بالجهة والمكان
اعتقاد ابن تيمية بثبوت الجهة العدميّة
الأحاديث المثبتة للجهة ومناقشتها
عدم الجهة لله في كلام الإمام الحسين×
نفي الحلول عن الله في كلام الإمام الحسين×
عدم جواز الأكل والشرب على الله في كلام الإمام الحسين×
عدم محكوميّة الله في كلام الإمام الحسين×
عدم فوت أمر على الله في كلام الإمام الحسين×
عدم الوارث لله في كلام الإمام الحسين×
عدم النسيان بالنسبة لله في كلام الإمام الحسين×
عدم نسيان الله لتصرّفات الناس غير اللائقة
عدم عروض الخواطر على الله في كلام الإمام الحسين×
عدم عروض الهمّ على الله في كلام الإمام الحسين×
عدم عروض الحزن على الله في كلام الإمام الحسين×
عدم عروض البهجة على الله في كلام الإمام الحسين×
عدم عروض الضحك على الله في كلام الامام الحسين×
عدم عروض البكاء على الله في كلام الإمام الحسين×
عدم عروض الرجاء على الله في كلام الإمام الحسين×
عدم عروض الرغبة على الله في كلام الامام الحسين×
عدم عروض السأم على الله في كلام الإمام الحسين×
عدم عروض الجوع على الله في كلام الإمام الحسين×
عدم عروض الشبع على الله في كلام الإمام الحسين×
نفي التركيب عن الله في كلام الإمام الحسين×
عدم قياس الله بالناس في كلام الإمام الحسين×
عدم البديل لله في كلام الإمام الحسين×
([i]) الخميني، روح الله، الأربعون حديثاً: ص553ـ554.
([ii]) صدر الدين الشيرازي، محمد بن إبراهيم، الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة: ج6، ص114.
([iii]) المصدر السابق: ج6، ص110ـ111.
([iv]) المصدر السابق: ج6، ص121.
([v]) المصدر السابق: ج6، ص110.
([vi]) اللاهيجي، عبد الرزّاق بن علي، گوهر مراد: ص238ـ 239.
([vii]) الرحمن: آية78.
([viii]) شبّر، عبد الله، حقّ اليقين في معرفة أصول الدين: ج1، ص59ـ60.
([ix]) صدر الدين الشيرازي، محمد بن إبراهيم، الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة: ج6، ص121.
([x]) المصدر السابق: ج6، ص121.
([xi]) اللاهيجي، عبد الرزّاق بن علي، گوهر مراد: ص238.
([xii]) النراقي، مهدي بن أبي ذر، جامع الأفكار وناقد الأنظار: ج2، ص518.
([xiii]) الخميني، روح الله، الأربعون حديثاً: ص554.
([xiv]) Albinus.
([xv]) Plato.
([xvi])Plotinus.
([xvii])Basilides.
([xviii])Clemens.
([xix])Nicholas of Cusa.
([xx])Philo.
([xxi]) رضا برنجكار وسيد مسيح شاه چراغ، (إلهيات سلبي در مدرسه كلامي حلّه)، مجلّة تحقيقات كلامي، العدد: 15، 1395 ﻫ.ش، ص62ـ63.
([xxii]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص148.
([xxiii]) الخميني، روح الله، الأربعون حديثاً: ص547.
([xxiv]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص34ـ35، حديث 2.
([xxv]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج1، ص116.
([xxvi]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص47، حديث 9.
([xxvii]) فصلت: آية53.
([xxviii]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق، ج1، ص242ـ243.
([xxix]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص35، حديث 2.
([xxx]) القاضي سعيد القمي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج1، ص122.
([xxxi]) الشورى: آية11.
([xxxii]) مطهري، مرتضى، مجموعه آثار استاد شهيد مطهري: ج6، ص1030ـ1031.
([xxxiii]) سبأ: آية3.
([xxxiv]) مطهري، مرتضى، مجموعه آثار استاد شهيد مطهري: ج6، ص1033ـ1035.
([xxxv]) نهج البلاغة: خطبة 1.
([xxxvi]) الشورى: آية11.
([xxxvii]) محمد مهدي مشكاتي ومهدي منصوري، (واكاوي ونقد مباني إلهيات سلبي با تأكيد بر آراء ملا صدرا)، تاريخ فلسفه، العدد: 11، 1391 ﻫ.ش، ص163ـ164.
([xxxviii]) المصدر السابق: ص166.
([xxxix]) الطباطبائي،محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج8، ص351.
([xl]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص69ـ70، حديث 26.
([xli]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج1، ص364ـ365.
([xlii]) مشكاتي ومنصوري، (واكاوي ونقد مباني إلهيات سلبي با تأكيد بر آراء ملا صدرا): ص168ـ169.
([xliii]) المصدر السابق: ص169ـ170.
([xliv]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص246، حديث 1.
([xlv]) مشكاتي ومنصوري، (واكاوي ونقد مباني إلهيات سلبي با تأكيد بر آراء ملا صدرا): ص170ـ171.
([xlvi]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج1، ص318.
([xlvii]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص47، حديث 9.
([xlviii]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج1، ص247.
([xlix]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح الأربعين: ص94.
([l]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج1، ص243ـ244.
([li]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص40، حديث 2.
([lii]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج1، ص180.
([liii]) الفاضل المقداد، مقداد بن عبدالله، إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين: ص37.
([liv]) المصدر السابق: ص38ـ39.
([lv]) صدر الدين الشيرازي، محمد بن إبراهيم، الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة: ج1، ص35.
([lvi]) الإسراء: آية84.
([lvii]) البقرة: آية255.
([lviii]) فاطر: آية15.
([lix]) السبزواري، هادي بن مهدي، رسائل الحكيم السبزواري: ص605ـ607.
([lx]) الخميني، روح الله، مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية: ص23.
([lxi]) الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة: ص8ـ9.
([lxii]) واحد التبريزي، رجبعلي، الأصل الأصيل (أصول آصفيه): ص26.
([lxiii]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح الأربعين: ص282.
([lxiv]) حميد رضا خادمي، (بررسي ونقد ديدگاه ملا رجبعلي تبريزي وقاضي سعيد قمّي در إلهيات سلبي)، تحت عنوان: پژوهش هاي هستي شناختي، العدد: 14، 1397 ﻫ.ش: ص136ـ137.
([lxv]) مشكاتي ومنصوري، (واكاوي ونقد مباني إلهيات سلبي با تأكيد بر آراء ملا صدرا): ص172.
([lxvi]) المصدر السابق: ص173.
([lxvii]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص55، حديث 13.
([lxviii]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج1، ص283.
([lxix]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص57، حديث 14.
([lxx]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج1، ص298ـ299.
([lxxi]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص35، حديث 2.
([lxxii]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج1، ص118.
([lxxiii]) المصدر السابق: ج1، ص118ـ 119.
([lxxiv]) النساء: آية139.
([lxxv]) الأعراف: آية180.
([lxxvi]) الإسراء: آية110.
([lxxvii]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص59، حديث 16.
([lxxviii]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج1، ص309ـ310.
([lxxix]) العلّامة الحلّي، الحسن بن يوسف، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (قسم الإلهيّات): ص29.
([lxxx]) الجوادي الآملي، عبد الله، توحيد در قرآن، (تفسير موضوعي قرآن كريم): ج2، ص305ـ306.
([lxxxi]) نهج البلاغة: خطبة 1.
([lxxxii]) الجوادي الآملي، عبد الله، توحيد در قرآن (تفسير موضوعي قرآن كريم): ص306ـ307.
([lxxxiii]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص139ـ140، حديث 3.
([lxxxiv]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص107، حديث 1.
([lxxxv]) الخميني، روح الله، الأربعون حديثاً: ص544ـ545.
([lxxxvi]) المصدر السابق: ص546ـ547.
([lxxxvii]) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: ج4، ص62ـ63.
([lxxxviii]) المصدر السابق في هامش ج 4، ص62.
([lxxxix]) صدر الدين الشيرازي، محمد بن إبراهيم، الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة: ج6، ص145ـ146.
([xc]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج3، ص195.
([xci]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص140، حديث 4.
([xcii]) الجوادي الآملي، توحيد در قرآن: ص255ـ256.
([xciii]) المصدر السابق: ص304ـ305.
([xciv]) المفيد، محمد بن محمد، أوائل المقالات: ص52.
([xcv]) أبو الصلاح الحلبي، تقي بن نجم، تقريب المعارف: ص83.
([xcvi]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص45، حديث 5.
([xcvii]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج1، ص226ـ227.
([xcviii]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص50، حديث 13.
([xcix]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج1، ص258.
([c]) مشكاتي ومنصوري، (واكاوي ونقد مباني إلهيات سلبي با تأكيد بر آراء ملا صدرا): ص188ـ 189.
([ci])الملكي الميانجي، محمد باقر ، توحيد الإماميّة: ص222ـ223.
([cii]) المصدر السابق: ص223ـ224.
([ciii]) المصدر السابق: ص240.
([civ]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج3، ص112ـ113.
([cv]) المصدر السابق: ج3، ص113.
([cvi]) ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج9، ص356.
([cvii]) الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين: ج7، ص162.
([cviii]) الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج8، ص352.
([cix]) الزنوزي، عبد الله، لمعات إلهيّة: ص224ـ225.
([cx]) الأعراف: آية180.
([cxi]) الإسراء: آية110.
([cxii]) الخميني، روح الله، مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية: ص25ـ26.
([cxiii]) الأنعام: آية100.
([cxiv]) الأنبياء: آية22.
([cxv]) المؤمنون: آية91.
([cxvi]) الصافات: آية159ـ160.
([cxvii]) نهج البلاغة: خطبة 155.
([cxviii]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص140، حديث 4.
([cxix]) نهج البلاغة: خطبة 91.
([cxx]) المصدر السابق: خطبة 179.
([cxxi]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج8، ص31، حديث 5.
([cxxii]) المصدر السابق: ج1، ص107، حديث 1.
([cxxiii]) المصدر السابق: ج1، ص108ـ 109، حديث 2.
([cxxiv]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص140، حديث 4.
([cxxv]) المصدر السابق: ص252، حديث 3.
([cxxvi]) الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج8، ص351.
([cxxvii]) الطباطبائي، محمد حسين، الرسائل التوحيديّة: ص34ـ35.
([cxxviii]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص251.
([cxxix]) المصدر السابق: ص254.
([cxxx]) المصدر السابق: ص257.
([cxxxi]) المصدر السابق: ص258.
([cxxxii]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص267.
([cxxxiii]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص251.
([cxxxiv]) المصدر السابق، ص256.
([cxxxv]) القطب الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات: ص92.
([cxxxvi]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص270.
([cxxxvii]) المصدر السابق: ص151.
([cxxxviii]) المصدر السابق: ص151.
([cxxxix]) ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1، ص344.
([cxl]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص149.
([cxli]) المصدر السابق: ص149.
([cxlii]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص245.
([cxliii]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص267.
([cxliv]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244.
([cxlv]) المصدر السابق: ص244.
([cxlvi]) ص: آية75.
([cxlvii]) ص: آية75.
([cxlviii]) الأنفال: آية26.
([cxlix]) الخزاز الرازي، علي بن محمد، كفاية الأثر في النصّ على الأئمّة الاثني عشر: ص255ـ257.
([cl]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص149.
([cli]) القطب الراوندي، سعيد بن هبة الله، الخرائج والجرائح: ج1، ص249، حديث 5.
([clii]) الصافات: آية159ـ160.
([cliii]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص311ـ312، حديث 1.
([cliv]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص118، حديث 11.
([clv]) المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ج5، ص23ـ 28.
([clvi]) الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج1، ص262.
([clvii]) الشيخ البهائي، محمد بن حسين، الحديقة الهلاليّة: ص125ـ126.
([clviii]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص149.
([clix]) المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ج7، ص241.
([clx]) النور: آية36.
([clxi]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص149.
([clxii]) طه: آية130.
([clxiii]) المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ج1، ص181.
([clxiv]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص149.
([clxv]) طه: آية130.
([clxvi]) المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ج7، ص78ـ 79.
([clxvii]) الصحيفة السجاديّة: ص178.
([clxviii]) طه: آية130.
([clxix]) المدني، علي خان بن أحمد، رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين: ج5، ص455.
([clxx]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص149.
([clxxi]) الروم: آية17.
([clxxii]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص253.
([clxxiii]) الأنبياء: آية21ـ22.
([clxxiv]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص253.
([clxxv]) المؤمنون: آية91.
([clxxvi]) الفرقان: آية18.
([clxxvii]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص253.
([clxxviii]) التوبة: آية31.
([clxxix]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص253.
([clxxx]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، مصباح الكفعمي: ص281.
([clxxxi]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص253.
([clxxxii]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، مصباح الكفعمي: ص281.
([clxxxiii]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص253.
([clxxxiv]) النساء: آية171.
([clxxxv]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص253.
([clxxxvi]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص104، حديث 19.
([clxxxvii]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص253.
([clxxxviii]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص104، حديث 2.
([clxxxix]) الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج20، ص389.
([cxc]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص256.
([cxci]) نهج البلاغة: خطبة 193.
([cxcii]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص256.
([cxciii]) الأنبياء: آية87 ـ 88 .
([cxciv]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص258.
([cxcv]) الإسراء: آية43.
([cxcvi]) المدني، علي خان بن أحمد، رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين: ج2، ص41ـ42.
([cxcvii]) الزمر: آية67.
([cxcviii]) عبدالله ابن بسطام وحسين ابن بسطام، طبّ الأئمة^: ص34.
([cxcix]) يونس: آية18.
([cc]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص149.
([cci]) الحديد: آية1.
([ccii]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص149.
([cciii]) المؤمنون: آية91.
([cciv]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص149.
([ccv]) الأنبياء: آية22.
([ccvi]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص149.
([ccvii]) ابن طاووس، علي بن موسى، فلاح السائل: ص202.
([ccviii]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص149.
([ccix]) يس: آية83.
([ccx]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص149.
([ccxi]) الصافّات: آية180.
([ccxii]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص149.
([ccxiii]) المصدر السابق: ص157.
([ccxiv]) الواقعة: آية74.
([ccxv]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص149.
([ccxvi]) ابن طاووس، علي بن موسى، فلاح السائل: ص202.
([ccxvii]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص149.
([ccxviii]) الجمعة: آية1.
([ccxix]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص149.
([ccxx]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص375.
([ccxxi]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص149.
([ccxxii]) ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله، شرح نهج البلاغة: ج20، ص348، حديث 997.
([ccxxiii]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص149.
([ccxxiv]) الأعلى: آية1.
([ccxxv]) الأنبياء: آية87.
([ccxxvi]) ابن طاووس، علي بن موسى، جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع: ص271.
([ccxxvii]) الأنبياء: آية87ـ88.
([ccxxviii]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات، ص92.
([ccxxix]) علي بن موسى ابن طاووس، الدروع الواقية، ص113.
([ccxxx]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات: ص92.
([ccxxxi]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص44، حديث 3.
([ccxxxii]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات، ص92.
([ccxxxiii]) التغابن: آية1.
([ccxxxiv]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات: ص92.
([ccxxxv]) المصدر السابق: ص93.
([ccxxxvi]) المصدر السابق: ص92.
([ccxxxvii]) ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1، ص477.
([ccxxxviii]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات: ص92.
([ccxxxix]) الأعراف: آية143.
([ccxl]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات: ص92.
([ccxli]) الكراجكي، محمد بن علي، كنز الفوائد: ج2، ص107.
([ccxlii]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات: ص92.
([ccxliii]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص179، حديث 13.
([ccxliv]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات: ص92.
([ccxlv]) الصافات: آية180.
([ccxlvi]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات: ص92.
([ccxlvii]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص362.
([ccxlviii]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات: ص92.
([ccxlix]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص375.
([ccl]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات: ص92.
([ccli]) الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه: ج1، ص494، حديث 1422.
([cclii]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات: ص92.
([ccliii]) المصدر السابق: ص91.
([ccliv]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص157.
([cclv]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات: ص92.
([cclvi]) الزخرف: آية13.
([cclvii]) الطبراني، سليمان بن أحمد، الدعاء: ص246ـ247، حديث 775.
([cclviii]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الخرائج والجرائح: ج1، ص250، حديث 5.
([cclix]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات: ص91.
([cclx]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الخرائج والجرائح: ج1، ص251، حديث 5.
([cclxi]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص363.
([cclxii]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الخرائج والجرائح: ج1، ص252، حديث 5.
([cclxiii]) الإسراء: آية108.
([cclxiv]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الخرائج والجرائح: ج1، ص252، حديث 5.
([cclxv]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص351.
([cclxvi]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص245.
([cclxvii]) الصافّات: آية159ـ160.
([cclxviii]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات: ص92.
([cclxix]) نهج البلاغة: خطبة 65.
([cclxx]) العلّامة الحلّي، الحسن بن يوسف، نهج الحقّ وكشف الصدق: ص54.
([cclxxi]) البيهقي، أحمد بن حسين، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: ص42.
([cclxxii]) الشورى: آية11.
([cclxxiii]) الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ج4، ص481.
([cclxxiv]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص68، حديث 23.
([cclxxv]) الآمدي، عبد الواحد بن محمد، غرر الحكم ودرر الكلم: ص628، حديث 994.
([cclxxvi]) الشعراء: آية97ـ 98.
([cclxxvii]) الشريف الرضي، محمد، نهج البلاغة: خطبة 91.
([cclxxviii]) ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة: ج4، ص111.
([cclxxix]) آل الشيخ، صالح بن عبد العزيز، شرح العقيدة الطحاوية: ج1، ص281.
([cclxxx]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244.
([cclxxxi]) يوسف: آية106.
([cclxxxii]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح الأربعين: ص395.
([cclxxxiii]) المصدر السابق: ص396.
([cclxxxiv]) الطهراني، محمد حسين الحسيني، الشمس الساطعة (رسالة في ذكرى العالم الربّاني العلّامة السيد محمد حسين الطباطبائي التبريزي، ترجمة عباس نور الدين وعبد الرحيم مبارك): ص189.
([cclxxxv]) الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا×: ج2، ص64، حديث 282.
([cclxxxvi]) الأنعام: آية101.
([cclxxxvii]) الفرقان: آية2.
([cclxxxviii]) التوبة: آية30.
([cclxxxix]) آل عمران: آية59.
([ccxc]) البقرة: آية116ـ117.
([ccxci]) الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج1، ص261.
([ccxcii]) الزمر: آية4.
([ccxciii]) الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج17، ص235ـ236.
([ccxciv]) الكهف: آية4ـ5.
([ccxcv]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص253.
([ccxcvi]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص91، حديث 5.
([ccxcvii]) المصدر السابق: ص104، حديث 19.
([ccxcviii]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج2، ص67ـ 68.
([ccxcix]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص253.
([ccc]) الفرقان: آية2.
([ccci]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص253.
([cccii]) الإسراء: آية111.
([ccciii]) الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص223، حديث 239.
([ccciv]) التوبة: آية30.
([cccv]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص253.
([cccvi]) الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج20، ص388ـ 389.
([cccvii]) المصدر السابق: ج20، ص389.
([cccviii]) نهج البلاغة: خطبة 186.
([cccix]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص91، حديث 5.
([cccx]) نهج البلاغة: خطبة 182.
([cccxi]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج2، ص68ـ70.
([cccxii]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص91، حديث 5.
([cccxiii]) المصدر السابق: ص104، حديث 19.
([cccxiv]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص253.
([cccxv]) الإسراء: آية111.
([cccxvi]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244.
([cccxvii]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص136، حديث 1.
([cccxviii]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244ـ245.
([cccxix]) الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه: ج1، ص427، حديث 1263.
([cccxx]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح الأربعين: ص410.
([cccxxi]) المصدر السابق: ص411.
([cccxxii]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص256.
([cccxxiii]) طه: آية29ـ31.
([cccxxiv]) المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ج13، ص101ـ103.
([cccxxv]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص409.
([cccxxvi]) المصدر السابق: ص253.
([cccxxvii]) الإسراء: آية111.
([cccxxviii]) الأعراف: آية143.
([cccxxix]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص97، حديث 5.
([cccxxx]) نهج البلاغة: خطبة 179.
([cccxxxi]) الكهف: آية110.
([cccxxxii]) القيامة: آية22ـ23.
([cccxxxiii]) النمل: آية35.
([cccxxxiv]) البقرة: آية280.
([cccxxxv]) الأنعام: آية103.
([cccxxxvi]) الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج8، ص237ـ 238.
([cccxxxvii]) الأشعري، علي بن إسماعيل، الإبانة عن أصول الديانة: ص25.
([cccxxxviii]) القيامة: آية22ـ23.
([cccxxxix]) ابن أبي العز، علي بن علي، شرح العقيدة الطحاويّة: ص188.
([cccxl]) ابن فوزان، صالح، التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاويّة: ص72.
([cccxli]) الألباني، محمد ناصرالدين، موسوعة الألباني في العقيدة: ج7، ص709.
([cccxlii]) المصدر السابق: ج7، ص748.
([cccxliii]) ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، مجموع الفتاوى: ج3، ص390.
([cccxliv]) المصدر السابق: ج5، ص251.
([cccxlv]) الغماري، عبدالله بن صديق، فتح المعين بنقد كتاب الأربعين: ص20ـ21.
([cccxlvi]) الأنعام: آية103.
([cccxlvii]) طه: آية110.
([cccxlviii]) الأعراف: آية143.
([cccxlix]) الحج: آية73.
([cccl]) التوبة: آية80.
([cccli]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص107، حديث 1.
([ccclii]) المصدر السابق: ص108، حديث 3.
([cccliii]) المصدر السابق: ص109، حديث 7.
([cccliv]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج2، ص280.
([ccclv]) النيسابوري، مسلم بن الحجّاج، صحيح مسلم: ج1، ص160، حديث 177.
([ccclvi]) التكوير: آية23.
([ccclvii]) النجم: آية13.
([ccclviii]) الأنعام: آية103.
([ccclix]) النيسابوري، مسلم بن الحجّاج، صحيح مسلم: ج1، ص159، حديث 177.
([ccclx]) النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى: ج10، ص276، حديث 11472.
([ccclxi])ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج8، ص608.
([ccclxii]) المفيد، محمد بن محمد، أوائل المقالات: ص57.
([ccclxiii]) العلّامة الحلّي، الحسن بن يوسف، مناهج اليقين في أصول الدين: ص333.
([ccclxiv]) الاسترابادي، محمد جعفر بن سيف الدين، البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة: ج2، ص305.
([ccclxv]) المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: ج4، ص59ـ60.
([ccclxvi]) الألباني، ناصر الدين، موسوعة الألباني في العقيدة: ج7، ص748.
([ccclxvii]) الفاضل المقداد، المقداد بن عبدالله، اللوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة: ص164.
([ccclxviii]) المصدر السابق: ص165.
([ccclxix]) القيامة: آية20ـ25.
([ccclxx]) الصدوق، محمد علي، التوحيد: ص116، حديث 19.
([ccclxxi]) القاضي عبد الجبار، عبد الجبار بن أحمد، المغني في أبواب التوحيد والعدل: ج4، ص212ـ213.
([ccclxxii]) الكهف: آية110.
([ccclxxiii]) التوبة: آية77.
([ccclxxiv]) ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد بن حنبل: ج33، ص414، حديث 20296.
([ccclxxv]) القاضي عبد الجبار، عبد الجبار بن أحمد، شرح الأصول الخمسة: ص178.
([ccclxxvi]) المطفّفين: آية15ـ16.
([ccclxxvii]) النور: آية25.
([ccclxxviii]) الأنعام: آية103.
([ccclxxix]) الشعراء: آية61ـ62.
([ccclxxx]) البقرة: آية255.
([ccclxxxi]) سبأ: آية3.
([ccclxxxii]) ق: آية38.
([ccclxxxiii]) ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، منهاج السنّة النبويّة: ج2، ص317ـ321.
([ccclxxxiv]) النساء: آية100.
([ccclxxxv]) يونس: آية90.
([ccclxxxvi]) الشعراء: آية61.
([ccclxxxvii]) الأنعام: آية103.
([ccclxxxviii])الكاظمي القزويني، محمد مهدي، منهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية: ج1، ص581ـ582.
([ccclxxxix]) المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ج3، ص222.
([cccxc]) الأنعام: آية102.
([cccxci]) الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج7، ص292.
([cccxcii]) الأنعام: آية14.
([cccxciii]) المؤمنون: آية88.
([cccxciv]) شرف الدين، عبد الحسين، موسوعة الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين: ج4، ص7ـ 8.
([cccxcv]) الكاظمي القزويني، محمد مهدي، منهاج الشريعة في الردّ على ابن تيمية: ج1، 584ـ585.
([cccxcvi]) المصدر السابق: ج1، ص583ـ584.
([cccxcvii]) البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج1، ص115، حديث 554.
([cccxcviii]) المصدر السابق: ج9، ص127، حديث 7435.
([cccxcix]) عبد الحسين، شرف الدين، موسوعة الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين: ج4، ص65ـ66.
([cd]) المصدر السابق: ج4، 66.
([cdi]) المطفّفين: آية16.
([cdii]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص97ـ 98، حديث 6.
([cdiii]) الأعراف: آية172.
([cdiv]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص117، حديث 20.
([cdv]) النجم: آية11ـ13.
([cdvi]) النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج1، ص158، حديث 176.
([cdvii]) فصّلت: آية53ـ54.
([cdviii]) النجم: آية11.
([cdix]) المطفّفين: آية14ـ15.
([cdx]) التكاثر: آية5ـ7.
([cdxi]) الأنعام: آية75.
([cdxii]) القيامة: آية22ـ23.
([cdxiii]) الانشقاق: آية6.
([cdxiv]) الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج8، ص238ـ241.
([cdxv]) ابن أبي شيبة، عبدالله بن محمد، المصنّف في الأحاديث والآثار: ج6، ص89، حديث 29706.
([cdxvi]) الأعراف: آية143.
([cdxvii]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244.
([cdxviii]) الأنعام: آية103.
([cdxix]) ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1، ص350.
([cdxx]) ابن شعبة، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص245.
([cdxxi]) ابن طاووس، علي بن موسى، فلاح السائل: ص203.
([cdxxii]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص76.
([cdxxiii]) العلّامة الحلّي، الحسن بن يوسف، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (قسم الإلهيّات): ص42ـ43.
([cdxxiv]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص253.
([cdxxv]) نهج البلاغة: خطبة 189.
([cdxxvi]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص125، حديث 1.
([cdxxvii]) العنكبوت: آية6.
([cdxxviii]) الحسيني الطهراني، محمد حسين، معرفة الله، ترجمة عباس جواد الصافي: ج1، ص323.
([cdxxix]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص255.
([cdxxx]) نهج البلاغة: خطبة 193.
([cdxxxi]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص239، حديث 1.
([cdxxxii]) ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1، ص348.
([cdxxxiii]) إبراهيم: آية38.
([cdxxxiv]) ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1، ص348.
([cdxxxv]) مرتضى فرج، شرح دعاء الإمام الحسين× يوم عرفة: ص98.
([cdxxxvi]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، مصباح الكفعمي: ص255.
([cdxxxvii]) ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1، ص349.
([cdxxxviii]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص320، حديث 2.
([cdxxxix]) ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1، ص349.
([cdxl]) الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج1، ص98.
([cdxli]) الصحيفة السجاديّة: ص68.
([cdxlii]) ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج2، ص690.
([cdxliii]) آل عمران: آية97.
([cdxliv]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص254.
([cdxlv]) ابن طاووس، علي بن موسى، جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع: ص278.
([cdxlvi]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص254.
([cdxlvii]) المصدر السابق: ص361.
([cdxlviii]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات: ص92.
([cdxlix]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244.
([cdl]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح الأربعين: ص396ـ397.
([cdli]) الأنعام: آية103.
([cdlii]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244.
([cdliii]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح الأربعين: ص402.
([cdliv]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص389.
([cdlv]) الشريف الرضي، محمد، نهج البلاغة: خطبة 1.
([cdlvi]) المصدر السابق: خطبة 49.
([cdlvii]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح الأربعين: ص408.
([cdlviii]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص80، حديث 36.
([cdlix]) المصدر السابق: ص60، حديث 17.
([cdlx]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص245.
([cdlxi]) نهج البلاغة: خطبة 91.
([cdlxii]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح الأربعين: ص411ـ412.
([cdlxiii]) ابن طاووس، علي بن موسى، فلاح السائل: ص203.
([cdlxiv]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص245.
([cdlxv]) القاضي سعيد القمّي، محمد بن سعيد، شرح الأربعين: ص420.
([cdlxvi]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص89، حديث 2.
([cdlxvii]) المصدر السابق: ص79ـ80، حديث 35.
([cdlxviii]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج1، ص506.
([cdlxix]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص47، حديث 9.
([cdlxx]) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة: ج3، ص683ـ684.
([cdlxxi]) المصدر السابق: ج3، ص689.
([cdlxxii]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص57، حديث 14.
([cdlxxiii]) ابن أبي العز، علي بن علي، شرح العقيدة الطحاوية: ص218.
([cdlxxiv]) ابن حبان، محمد بن حبان، الثقات: ج1، ص1.
([cdlxxv])ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ، لسان الميزان: ج7، ص49ـ50، رقم6619.
([cdlxxvi]) الدارمي، عثمان بن سعيد، الردّ على الجهميّة: ص98، ش 162.
([cdlxxvii]) العثيمين، محمد بن صالح، شرح العقيدة السفارينيّة: ص237.
([cdlxxviii]) الدشتي، محمود بن أبي القاسم، إثبات الحدّ لله}: ص28.
([cdlxxix]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص135، حديث 1.
([cdlxxx]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص35ـ36، حديث 2.
([cdlxxxi]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص256.
([cdlxxxii]) الشريف الرضي، محمد، نهج البلاغة: خطبة 1.
([cdlxxxiii]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص193.
([cdlxxxiv]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح الأربعين: ص413.
([cdlxxxv]) نهج البلاغة: خطبة 186.
([cdlxxxvi]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح الأربعين: ص413.
([cdlxxxvii]) نهج البلاغة: خطبة 195.
([cdlxxxviii]) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: ج75، ص126، حديث 7.
([cdlxxxix]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص245.
([cdxc]) الصافّات: آية164.
([cdxci]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح الأربعين: ص411.
([cdxcii]) الحديد: آية4.
([cdxciii]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص256.
([cdxciv]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج2، ص594، حديث 33.
([cdxcv]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص251.
([cdxcvi]) آل عمران، آية 5.
([cdxcvii]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص258.
([cdxcviii]) ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1، ص348.
([cdxcix]) المصدر السابق: ج1، ص349.
([d]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص267.
([di]) الملك: آية13.
([dii]) هود: آية5.
([diii]) ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1، ص350.
([div]) الحديد: آية4.
([dv]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص125ـ126، حديث 3.
([dvi]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص267.
([dvii]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، مصباح الكفعمي: ص253.
([dviii]) ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1، ص348.
([dix]) ابن طاووس، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص267ـ 268.
([dx]) نهج البلاغة: خطبة 185.
([dxi]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص268.
([dxii]) الشريف الرضي، محمد، نهج البلاغة: خطبة 65.
([dxiii]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص269.
([dxiv]) المصدر السابق: ص269.
([dxv]) آل عمران: آية9.
([dxvi]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص269.
([dxvii]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص91، حديث 5.
([dxviii]) المصدر السابق: ص174، حديث 2.
([dxix]) المصدر السابق: ص91، حديث 5.
([dxx]) البقرة: آية255.
([dxxi]) الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج2، ص331.
([dxxii]) ابن الصبّاغ، علي بن محمد، الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة: ج2، ص918.
([dxxiii]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص91، حديث 5.
([dxxiv]) المصدر السابق: ص90، حديث 3.
([dxxv]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج2، ص56.
([dxxvi]) فاطر: آية43.
([dxxvii]) البقرة: آية255.
([dxxviii]) الرحمن: آية29.
([dxxix]) الأنعام: آية18.
([dxxx]) إبراهيم: آية4.
([dxxxi]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج1، ص154ـ155.
([dxxxii]) الصحيفة السجاديّة: ص142.
([dxxxiii]) الطور: آية48.
([dxxxiv]) المدني، علي خان بن أحمد، رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين: ج4، ص434.
([dxxxv]) ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج1، ص457.
([dxxxvi]) الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة: ج10، ص316.
([dxxxvii]) الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربيّة): ج5، ص1887.
([dxxxviii]) الفيروزابادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط: ج4، ص27.
([dxxxix]) الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن: ص196.
([dxl]) الباقلاني، محمد بن طيب، تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل: ص220.
([dxli]) الجرجاني، علي بن محمد، كتاب التعريفات: ص34.
([dxlii]) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة: ج1، ص363ـ364.
([dxliii]) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى: ج17، ص296.
([dxliv]) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة: ج4، ص98.
([dxlv]) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، منهاج السنّة النبويّة: ج2، ص630.
([dxlvi]) العثيمين، محمد بن صالح، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ج8، ص321.
([dxlvii]) المصدر السابق: ج8، ص423.
([dxlviii]) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة: ج1، ص251.
([dxlix]) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى: ج3، ص86.
([dl]) العثيمين، محمد بن صالح، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ج4، ص58.
([dli]) الأعراف: آية195.
([dlii]) ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، الصواعق المرسلة في الردّ على الجهميّة والمعطّلة: ج3، ص915ـ916.
([dliii]) هرّاس، محمد خليل، شرح العقيدة الواسطيّة: ص117.
([dliv]) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى: ج16، ص435.
([dlv]) الفجر: آية22.
([dlvi]) ابن باز، عبدالعزيز بن عبدالله، مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: ج5، ص54.
([dlvii]) ابن حنبل، أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل: ج26، ص123، حديث 16206.
([dlviii]) ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر ، زاد المعاد في هدي خير العباد: ج3، ص591.
([dlix]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج2، ص205.
([dlx]) المصدر السابق: ج2، ص206.
([dlxi]) المصدر السابق: ج2، ص206.
([dlxii]) المصدر السابق: ج2، ص206.
([dlxiii]) المصدر السابق: ج2، ص214.
([dlxiv]) المصدر السابق: ج2، ص217.
([dlxv]) المصدر السابق: ج2، ص218.
([dlxvi]) المصدر السابق: ج2، ص219.
([dlxvii]) المصدر السابق: ج2، ص224.
([dlxviii]) المصدر السابق: ج2، ص229.
([dlxix]) المصدر السابق: ج2، ص229.
([dlxx]) الحديد: آية4.
([dlxxi]) المجادلة: آية7.
([dlxxii]) البقرة: آية115.
([dlxxiii]) الشورى: آية11.
([dlxxiv]) محمد: آية38.
([dlxxv]) الحديد: آية3.
([dlxxvi]) الأنعام: آية103.
([dlxxvii]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص101، حديث 11.
([dlxxviii]) المصدر السابق: ص102، حديث 16.
([dlxxix]) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، منهاج السنّة النبويّة: ج1، ص72ـ73.
([dlxxx]) القفاري، ناصر بن عبدالله، أصول مذهب الشيعة الإماميّة الاثني عشريّة (عرض ونقد): ج2، ص528.
([dlxxxi]) الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): ص270، حديث 486.
([dlxxxii]) الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل: ج1، ص217ـ 218.
([dlxxxiii]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص172، حديث 4.
([dlxxxiv]) المصدر السابق: ج1، ص173، حديث 4.
([dlxxxv]) المصدر السابق: ج1، ص87، حديث 2.
([dlxxxvi]) المصدر السابق: ج1، ص74، حديث 1.
([dlxxxvii]) ابن شهرآشوب، محمد بن علي، معالم العلماء: ص128.
([dlxxxviii]) الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): ص270، حديث 487.
([dlxxxix]) المصدر السابق: ص268ـ 269، حديث 483.
([dxc]) المصدر السابق: ص483، حديث 910.
([dxci]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص245، حديث 1.
([dxcii]) القصص: آية68.
([dxciii]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص175، حديث 5.
([dxciv]) الأشعري، علي بن إسماعيل، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: ص304.
([dxcv]) الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): ص284، حديث 503.
([dxcvi]) الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل: ج1، ص218.
([dxcvii] ) الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشي)، ص256
([dxcviii]) الأشعري، علي بن إسماعيل، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: ص301.
([dxcix]) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، منهاج السنّة النبويّة: ج2، ص136.
([dc]) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى: ج5، ص298.
([dci]) ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح: ج4، ص430.
([dcii]) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة: ج1، ص236.
([dciii]) ابن حزم، علي بن أحمد، الفصل في الملل والأهواء والنحل: ج2، ص94.
([dciv]) الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة: ج20، ص313ـ316.
([dcv]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص104ـ106.
([dcvi]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص97ـ104.
([dcvii]) الكراجكي، محمد بن علي، كنز الفوائد: ج2، ص37ـ42.
([dcviii]) الطوسي، محمد بن حسن، التبيان في تفسير القرآن: ج3، ص429ـ430.
([dcix]) الطوسي، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإماميّة: ج1، ص14.
([dcx]) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: ج3، ص287ـ 308.
([dcxi]) المصدر السابق: ج3، ص309ـ 339.
([dcxii]) الخوئي، أبو القاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة: ج2، ص77.
([dcxiii]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244.
([dcxiv]) الشعراء: آية97ـ 98.
([dcxv]) نهج البلاغة: خطبة 91.
([dcxvi]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244.
([dcxvii]) ابن طاووس، علي بن موسى، فلاح السائل: ص203.
([dcxviii]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244.
([dcxix]) الإخلاص: آية4.
([dcxx]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244.
([dcxxi]) الشورى: آية11.
([dcxxii]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244.
([dcxxiii]) نهج البلاغة: خطبة 186.
([dcxxiv]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244.
([dcxxv]) الشريف الرضي، محمد، نهج البلاغة: خطبة 91.
([dcxxvi]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244.
([dcxxvii]) ص: آية75.
([dcxxviii]) الأنفال: آية26.
([dcxxix]) الخزّاز الرازي، علي بن محمد، كفاية الأثر في النصّ على الأئمّة الاثني عشر: ص256.
([dcxxx]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص245.
([dcxxxi]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص183ـ184، حديث 20.
([dcxxxii]) المصدر السابق: ص79ـ80، حديث 35.
([dcxxxiii]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص105، حديث 3.
([dcxxxiv]) ابن الصبّاغ المالكي، علي بن محمد، الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة: ج2، ص918.
([dcxxxv]) البقرة: آية255.
([dcxxxvi]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص91، حديث 5.
([dcxxxvii]) المصدر السابق: ص97ـ 98، حديث 3.
([dcxxxviii]) المصدر السابق: ص98، حديث 4.
([dcxxxix]) ابن طاووس، علي بن موسى، جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع: ص273.
([dcxl]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص93، حديث 6.
([dcxli]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244.
([dcxlii]) الإخلاص: آية3ـ4.
([dcxliii]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص253.
([dcxliv]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص91، حديث 5.
([dcxlv]) الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج20، ص389.
([dcxlvi]) المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ج10، ص83 ـ84.
([dcxlvii]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص245.
([dcxlviii]) المصدر السابق: ص244.
([dcxlix]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح الأربعين: ص399.
([dcl]) الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد: ج2، ص691.
([dcli]) المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ج11، ص24.
([dclii]) الزمخشري، محمود بن عمر، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: ج5، ص411، حديث 41.
([dcliii]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244.
([dcliv]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح الأربعين: ص399ـ400.
([dclv]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص47، حديث 9.
([dclvi]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص251.
([dclvii]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244.
([dclviii]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح الأربعين: ص396.
([dclix]) الشورى: آية11.
([dclx]) المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ج11، ص25.
([dclxi]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص254ـ255.
([dclxii]) البقرة: آية22.
([dclxiii]) ابن الأثير، مبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج5، ص35.
([dclxiv]) المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ج12، ص72ـ73.
([dclxv]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244ـ245.
([dclxvi]) فصّلت: آية9.
([dclxvii]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح الأربعين: ص411.
([dclxviii]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص254.
([dclxix]) فصّلت: آية9.
([dclxx]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص254.
([dclxxi]) سبأ: آية33.
([dclxxii]) الزمر: آية8.
([dclxxiii]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244.
([dclxxiv]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح الأربعين: ص402ـ404.
([dclxxv]) النمل: آية60.
([dclxxvi]) المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ج8، ص70.
([dclxxvii]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244.
([dclxxviii]) الصدوق، محمد بن علي، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ص3.
([dclxxix]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص251.
([dclxxx]) الشريف الرضي، محمد، نهج البلاغة: خطبة 186.
([dclxxxi]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244.
([dclxxxii]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، مصباح الكفعمي: ص260.
([dclxxxiii]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244.
([dclxxxiv]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح الأربعين: ص401.
([dclxxxv]) المصدر السابق: ص401ـ402.
([dclxxxvi]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص50، حديث 13.
([dclxxxvii]) العلّامة الحلّي، الحسن بن يوسف، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (قسم الإلهيات): ص41.
([dclxxxviii]) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، منهاج السنّة النبويّة: ج2، ص263.
([dclxxxix]) المصدر السابق: ج2، ص380.
([dcxc]) الفخر الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير: ج1، ص124.
([dcxci]) الأنعام: آية76.
([dcxcii]) الاسفراييني، شهفور بن طاهر، التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: ص137.
([dcxciii]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244.
([dcxciv]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص91، حديث 5.
([dcxcv]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج2، ص65.
([dcxcvi]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص174، حديث 2.
([dcxcvii]) المصدر السابق: ص91، حديث 5.
([dcxcviii]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج2، ص81 ـ82.
([dcxcix]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص116، حديث 6.
([dcc]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات: ص92.
([dcci]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: 138، صحديث 16.
([dccii]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244.
([dcciii]) البقرة: آية255.
([dcciv]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح الأربعين: ص402.
([dccv]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص44، حديث 3.
([dccvi]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول ص 244.
([dccvii]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح الأربعين: ص406ـ 408.
([dccviii]) الشريف الرضي، محمد، نهج البلاغة: خطبة 186.
([dccix]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص244.
([dccx]) الأنبياء: آية22.
([dccxi]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات: ص92.
([dccxii]) الكراجكي، محمد بن علي، كنز الفوائد: ج2، ص107.
([dccxiii]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات: ص92.
([dccxiv]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص179، حديث 13.
([dccxv]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات: ص92.
([dccxvi]) الصافّات: آية180.
([dccxvii]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص245.
([dccxviii]) الصافّات: آية159ـ160.
([dccxix]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص245.
([dccxx]) نهج البلاغة: خطبة 1.
([dccxxi]) المصدر السابق: خطبة 186.
([dccxxii]) الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة: ص230.
([dccxxiii]) المصدر السابق: ص231.
([dccxxiv]) المصدر السابق: ص232ـ233.
([dccxxv]) الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن: ص772ـ773.
([dccxxvi]) البياضي، أحمد بن حسن، إشارات المرام من عبارات الإمام: ص197.
([dccxxvii]) ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج13، ص556.
([dccxxviii]) البياضي، أحمد بن حسن، إشارات المرام من عبارات الإمام: ص197.
([dccxxix]) العلّامة الحلّي، الحسن بن يوسف، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (قسم الإلهيات): ص40ـ41.
([dccxxx]) الغزالي، محمد بن محمد، إحياء علوم الدين: ج1، ص184.
([dccxxxi]) الفخر الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير: ج7، ص14.
([dccxxxii]) البياضي، أحمد بن حسن، إشارات المرام من عبارات الإمام: ص197.
([dccxxxiii]) الشورى: آية11.
([dccxxxiv]) البقرة: آية115.
([dccxxxv]) أبو حيان، محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير: ج1، ص578.
([dccxxxvi]) النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج4، ص2084، حديث 2713.
([dccxxxvii]) البيهقي، أحمد بن الحسين، الأسماء والصفات: ص562.
([dccxxxviii]) الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص403، حديث 3298.
([dccxxxix]) البيهقي، أحمد بن الحسين، الأسماء والصفات: ص561ـ562.
([dccxl]) السبزواري، محمد بن محمد، جامع الأخبار: ص38، حديث 25.
([dccxli]) ابن أبي العز، علي بن علي، شرح العقيدة الطحاوية: ص218.
([dccxlii]) محمد بن محمد، الغزالي، إحياء علوم الدين: ج1، ص155.
([dccxliii]) الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، نهاية الإقدام في علم الكلام: ص63.
([dccxliv]) القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن: ج3، ص278.
([dccxlv]) الجرجاني، علي بن محمد، شرح المواقف: ج8، ص19.
([dccxlvi]) ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج6، ص136.
([dccxlvii]) العيني، محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ج25، ص117.
([dccxlviii]) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، منهاج السنّة النبويّة: ج2، ص642.
([dccxlix]) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة: ج1، ص390.
([dccl]) المصدر السابق: ج2، ص610ـ611.
([dccli]) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى: ج5، ص15.
([dcclii]) ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله، مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: ج2، ص105ـ106.
([dccliii]) الجاثية: آية5.
([dccliv]) النووي، يحيى بن شرف، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج: ج5، ص24.
([dcclv]) الذاريات: آية22.
([dcclvi]) البياضي، أحمد بن حسن، إشارات المرام من عبارات الإمام: ص198.
([dcclvii]) الصدوق محمد بن علي، التوحيد: ص178، حديث 11.
([dcclviii]) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، منهاج السنّة النبويّة: ج2، ص323.
([dcclix]) العثيمين، محمد بن صالح، شرح العقيدة السفارينيّة: ص120.
([dcclx]) أبو داوود السجستاني، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود: ج3، ص230، حديث 3284.
([dcclxi]) النيسابوري، مسلم بن الحجّاج، صحيح مسلم: ج1، ص381، حديث 537.
([dcclxii]) الغماري، عبد الله بن صديق، فتح المعين بنقد كتاب الأربعين: ص27ـ 29.
([dcclxiii]) النيسابوري، مسلم بن الحجّاج، صحيح مسلم: ج3، ص1458، حديث 1827.
([dcclxiv]) الغماري، عبد الله بن صديق، فتح المعين بنقد كتاب الأربعين: ص32ـ33.
([dcclxv]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص193.
([dcclxvi]) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: ج75، ص126، حديث 7.
([dcclxvii]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص245.
([dcclxviii]) الصافّات: آية164.
([dcclxix]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح الأربعين: ص411.
([dcclxx]) نهج البلاغة: خطبة 186.
([dcclxxi]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص193.
([dcclxxii]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص91، حديث 5.
([dcclxxiii]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص135، حديث 1.
([dcclxxiv]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص90، حديث 3.
([dcclxxv]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج2، ص55ـ56.
([dcclxxvi]) الأنعام: آية14.
([dcclxxvii]) أبو يعلى الموصلي، أحمد بن علي ، مسند أبي يعلى: ج12، ص156، حديث 6786.
([dcclxxviii]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، مصباح الكفعمي: ص253.
([dcclxxix]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص269.
([dcclxxx]) سبأ: آية51.
([dcclxxxi]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص253.
([dcclxxxii]) نهج البلاغة: خطبة 182.
([dcclxxxiii]) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات: ص92.
([dcclxxxiv]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص134، حديث 1.
([dcclxxxv]) الروم: آية60.
([dcclxxxvi]) هود: آية44.
([dcclxxxvii]) البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج5، ص128ـ130.
([dcclxxxviii]) إبراهيم: آية42.
([dcclxxxix]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص91، حديث 5.
([dccxc]) ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص63.
([dccxci]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص91، حديث 5.
([dccxcii]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص109ـ110، حديث 3.
([dccxciii]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص91، حديث 5.
([dccxciv]) المصدر السابق: ص50، حديث 13.
([dccxcv]) المصدر السابق: ص91، حديث 5.
([dccxcvi]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص49.
([dccxcvii]) نهج البلاغة: خطبة 186.
([dccxcviii]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص91، حديث 5.
([dccxcix]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص116، حديث 6.
([dccc]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص91، حديث 5.
([dccci]) الآمدي، عبد الواحد بن محمد، غرر الحكم ودرر الكلم: ص628، حديث 994.
([dcccii]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص91، حديث 5.
([dccciii]) نهج البلاغة: خطبة 186.
([dccciv]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص91، حديث 5.
([dcccv]) نهج البلاغة: خطبة 186.
([dcccvi]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص91، حديث 5.
([dcccvii]) الشريف الرضي، محمد، نهج البلاغة: خطبة 91.
([dcccviii]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص91، حديث 5.
([dcccix]) الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص389.
([dcccx]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص91، حديث 5.
([dcccxi]) الأنعام: آية14.
([dcccxii]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص79ـ80، حديث 35.
([dcccxiii]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج1، ص506.
([dcccxiv]) النراقي، مهدي بن أبي ذر، جامع الأفكار وناقد الأنظار: ج2، ص520ـ521.
([dcccxv]) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص83ـ84، حديث 3.
([dcccxvi]) المصدر السابق: ص79ـ80، حديث 35.
([dcccxvii]) الشورى: آية11.
([dcccxviii]) القاضي سعيد القمّي، محمد سعيد، شرح توحيد الصدوق: ج1، ص506.
([dcccxix]) ص: آية75.
([dcccxx]) ص: آية75.
([dcccxxi]) الأنفال: آية26.
([dcccxxii]) الخزاز الرازي، علي بن محمد، كفاية الأثر في النصّ على الأئمّة الاثني عشر: ص255ـ257.
([dcccxxiii]) ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص157.
([dcccxxiv]) الطبرسي، الحسن بن الفضل، مكارم الأخلاق: ص348.